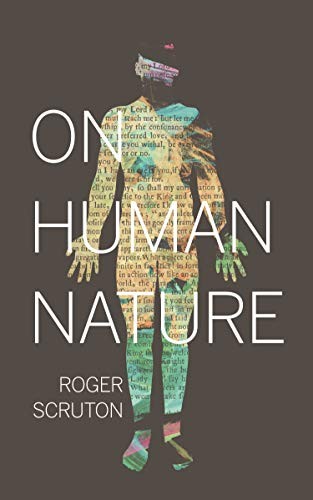لروجر سكروتون
مُحمد الشيخ
ألَّف أزيد من ثلاثين كتابا في مختلف فروع الفلسفة: من فلسفة الجمال إلى فلسفة السياسة، مرورا بفلسفة الثقافة، وفلسفة الاجتماع، وفلسفة الدين. لكنَّنا لا نكاد نعرف عنه في العالم العربي إلا كتابا واحدا تُرجم له هو كتاب "الجمال" (2017)؛ وذلك بما يشي عن هول "التأخر الترجمي" الذي نعاني منه اليوم، والذي كان قد نبه إليه عبدالرحمن بدوي منذ ثلاثة عقود، حين أشار إلى أن عدد الكتب الفلسفية المنقولة إلى اللسان العربي لا يتجاوز عشرة بالمائة. فأي تفاوت ذاك الذي نعيشه! وأي استدراك تأخر هذا الذي ينتظرنا!
وهذا كتاب جديد من تأليف ذاك الفيلسوف الجمالي والسياسي والروائي والمؤلف الأوبرالي الإنجليزي المحافظ روجر سكروتون (1944-). وهو عضو في الأكاديمية البريطانية (منذ عام 2008)، وحائز على جائزة الاستحقاق من جمهورية تشيكيا، وصاحب أزيد من ثلاثين مؤلفا؛ أهمها: "الفن والخيال" (1974)، و"الرغبة الجنسية" (1986)، و"جماليات الموسيقى" (1997)، و"الفلسفة السياسية: دفاعا عن النزعة المحافظة" (2006)، و"معجم الفكر السياسي" (2007)، و"الجمال" (2010)، و"كنيستنا" (2012)، و"روح العالم..." (2014).
ويتكوَّن كتاب "في الطبيعة البشرية" (2017) من مقدمة وأربعة فصول (الفصل الأول: الجنس البشري، الفصل الثاني: العلاقات البشرية، الفصل الثالث: الحياة الخلقية، الفصل الرابع: الإلزامات المقدسة)؛ فيكون الكتاب بذلك دائرا على أربعة مباحث فلسفية: "الأنتربولوجيا الفلسفية" (وهي التي تنظر في معنى الإنسان وطبيعته)، و"الأنطولوجيا الاجتماعية" (وهي التي تعتبر وجود الإنسان الاجتماعي)، وفلسفة الأخلاق (وهي التي تنظر في الإنسان الخلقي)، وفلسفة الدين (وهي التي تعتبر مفهوم "المقدس"). هذا، فضلا عن كشافين: واحد بالأسماء المذكورة في متن الكتاب، وثان بالموضوعات المطروقة فيه.
هذا.. وقد تضمنت المقدمة القصيرة التي وضعها المؤلف كلمة شكر إلى القيمين على برنامج جيمس مادسون بجامعة برينستون، وإلى جمهور من حضروا محاضرات المؤلف (2013). ومن أطرف ما ذكر في هذه المقدمة أنه صحبته في بعض محاضراته جملة أسئلة بعضها أجاب عنه في كتابه "روح العالم" (2014)، وبعضها سوف يظل يصحبه لربما إلى رمسه.
الفصل الأول: الجنس البشري
كان غرض المؤلف في هذا الفصل الرد على من يريد من علماء البيولوجيا وعلماء النفس والاجتماع البشري ارجاع سلوك البشر إلى أساس حيواني، وعلى من يميل لطبع متأصل فيه إلى أن يختزل إلى ما هو بيولوجي كل ما يحتاج إلى تفسير. والذي يراه المؤلف أن ابتغاء بناء نظرية حول "طبيعة البشر" إنما يقتضي مقاومة هذا المنزع البيولوجي. ويمثل لهذا المنزع القوي في الثقافة الحديثة والمعاصرة بنظريتين بيولوجيتين سائدتين: 1- نظرية النوع التي تختزل كل سلوكات الأجناس الحية إلى نوع واحد ووحيد (داروين وأتباعه)، 2- ونظرية الهندسة الوراثية التي ترد كل شيء إلى "المورثات" أو "الجينات" (داوكينز وأنصاره). والنظريتان معا، عنده، غير مناسبتين لوصف السلوك البشري أو لتفسيره. وهما تخفقان معا لأنها تخطئان في تقدير مقصودهما -الإنسان- إذ الإنسان الذي تصفانه ليس هو الإنسان على حقيقته.
وإذ يؤكد المؤلف على أننا -وبكل تأكيد- نشارك الحيوانات في بعض سماتها وفي بعض سلوكاتها، وأننا كائنات حية بالأولى، فإنه يلح، بالمقابل، على أننا "أشخاص" ذوو أجسام، ولنا قدرات معرفية لا تشاركنا فيها الحيوانات الأخرى، وهي مقدرات تمنحنا حياة وجدانية مباينة تتميز بالوعي بالذات الذي لا تملكه أي من الكائنات الأخر.
إذن، لا يجادل المؤلف كثيرا في أننا "نحن معشر الكائنات البشرية كائنات حية محكومة بقوانين علم الأحياء"، ففي محيانا وفي مماتنا نشهد على سيرورات حيوية، مثلنا في ذلك تماما مثل باقي الحيوانات. وهذا ما تشهد عليه أيضا بعض جوانب حياتنا الوجدانية. وكل ذلك من شأنه أن يذكرنا بأننا مدينون بالكثير إلى أجسامنا. ولا يناقش الكاتب فكرة أن هذه الحقيقة تظل، في الكثير من الأحايين، محجوبة عنا. فهي المنسي في مروياتنا عن أنفسنا نحن معشر البشر. ويمثل المؤلف لذلك بالحب العذري الذي لطالما فصله الشعراء والفلاسفة القدامى عن أساسه الجسمي. ويؤكد، بالمقابل، أنه حتى بعض سلوكاتنا "الراقية" تظل مدينة لبيولوجيتنا؛ شأن قيمة تضحية الأم مثلا.
على أنه ليس يقبل بالقول أن لا فارق أنطولوجيا بيننا وبين بقية الكائنات. وهنا يتساءل عما إذا كانت بعض سماتنا "العليا" -نظير "الأخلاق" و"الوعي بالذات" و"الرمزية" و"الفن" و"الانفعالات"- تخلق "هوة" بيننا وبين الحيوانات "الدنيا"؛ بحيث تقتضي منا تفسيرا من نوع آخر لسلوكياتنا. وهنا يستأنس بآراء "حيوية" مختلفة، من داروين إلى جيوفري سيلر، مرورا بوالاس وبينكر وغيرهم، كما يستعرض ما بني عليها من نظريات تقول بفكرة اللاوعي؛ مثيل "الإيديولوجيا" عند ماركس، و"اللاشعور" عند فرويد، و"الخطاب" عند فوكو... ويقف الوقفة الطويلة على نظرية "الجينات والميمات" عند ريتشارد داوكينز الذي تلعب فيها التصورات الإحيائية دورا بارزا. والذي عنده أن نظريات الطبيعة البشرية ذات الأساس البيولوجي إنما تعتزم أن "تفسر"، ولا تطمح إلى أن "تفهم". مع العلم أن من شأن الإنسان باعتباره "ذاتا" -وعلى خلاف الكائنات الأخرى بحسبانها "موضوعات"- أن يُفهَم" وليس من أمره أن "يُفسَّر".
وما زال الجدل قائما حول "الطبيعة البشرية": إلى أي "نوع" ننتمي نحن؟ وهنا يستحضر المؤلف نظرية الفيلسوف الألماني كانط ضد النزعة السوسيو-بيولوجية المعاصرة: نحن -معشر البشر- "أشخاص" أحرار بالطبيعة، ونحن ذوو وعي مميَّز، ونحن كائنات عاقلة، ونحن مزودون بالعقل ومرتبطون بالقانون الخلقي؛ وذلك على عكس نظرية "الجينة الأنانية" التي قال بها عالم الإحياء وسلوك الحيوان ريتشارد داوكينز (1941-)، والتي ترى أننا مجرد كائنات تنتمي إلى جنس "الحيوان البشري" تتحكم فيها مورثاتها الجينية كل التحكم. والذي عند كانط أن ثمة هوة سحيقة بيننا وبين الكائنات الأخرى، بينما عند علماء الاجتماع الإحيائي لا وجود لمثل هذه الهوة السحيقة. فهم يختزلون الإنسان إلى أنموذج أصلي حيواني قديم، ويدعون أن ما نحن إياه هو ما نحن كناه، وأن الحقيقة حول الجنس البشري تنبئ عنها النسالة، وأن كل شيء فينا ذو أساس بيولوجي؛ بما في ذلك حسنا الخلقي الذي لطالما ازدهينا به ولا نزال نفعل.
ولا ينكر صاحب الكتاب أبدا أننا ننتمي إلى نوع الكائنات الحية، لكنه يريد أن يأخذ بمأخذ الجد الاقتراح الذي يرى أن علينا أن "نُفهَم" -نحن معشر البشر- من خلال نظام تفسير آخر غير ذاك الذي تمدنا به الهندسة الوراثية، وأننا ننتمي إلى جنس من الكائنات لا يتحدد بالتنظيم البيولوجي لأعضائه. فمن المستحيل، عنده، السعي إلى "فهم" الشخص البشري باستكشاف "تطور" هذا الكائن الحي، وكل من فعل ذلك فكأنما حاول استكشاف دلالة سمفونية لبتهوفن عن طريق رسم سيرورة تأليفها، وإننا لحقيقة أكبر من أن نكون مجرد سيرورة.
ويدلل الفيلسوف على طرحه هذا من خلال أمثلة عدة، يقف على اثنين منها أساسيين:
- أولهما: الضحك؛ إذ يرى أن لا حيوانات أخرى، عدا الإنسان، كائنات ضاحكة. وما يبدو من ضحك الحيوانات الأخرى إنما هو يشبه الضحك وليس من جنسه. إنما الضحك الحقيقي ما نجم عن تسلية. ويستعرض المؤلف آراء كل من هوبز وشوبنهاور وبرجسون، كما فرويد، في الضحك وعلله، فلا يجدها مقنعة. أما الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني هلموت بليسنر (1892-1985)، فإن الضحك والبكاء هما ما يشكل، عنده، مفتاحا لفهم الوضع البشري، وهما ما يميزاننا نحن البشر. لكنه يعيب على بليسنر استغلاق لغته. والبديل الذي يراه أن الضحك هو ما يدل على بشريتنا من حيث أنه يشي بتهكمنا نحن البشر من أشكال الأفعال غير المتقنة التي نأتيها، كما يؤدي وظيفة تأنيسنا ببعضنا البعض.
- ثانيهما: المسؤولية؛ ذلك أن عالمنا -معشر البشر- عالم يختلف عن محيط أي حيوان، من حيث أنه عالم حقوق وواجبات، فهو عالم ذوات واعية بذاتها، بحيث الأحداث تنقسم إلى ما هو حر وما هو غير حر، وما له دواع وما له أسباب، وما يتسبب فيه كائن واع وما لا. ومن ثمة، نتصرف في هذا العالم تصرفا يقع في ما وراء مملكة الحيوانات: الإدانة والحقد والحسد والإعجاب والإلتزام والدعاء... بما يفترض أن الآخرين مسؤولون عما أتوه من أفعال، وعن أفكارهم باعتبارهم ذواتا واعية لها حقوق وواجبات ونظرة واعية إلى الماضي واستشراف واع بالمستقبل.
وهذا يعيدنا إلى العلاقة بين "الحيوان البشري" و"الشخص"، وهو مشكل "فلسفي" وليس مشكلا "بيولوجيا". إذ علينا أن "نفهم" الشخص في ما وراء الجسد باعتباره كيانا منبثقا، صحيح أنه "متجذر" في الكائن البشري، لكنه ينتمي إلى نظام تفسير "آخر" غير ذاك الذي من شأن البيولوجيا استكشافه. إنما الإنسان أكثر من مجرد جسد، وإنه لشخص، مثلما أن رسم "وجه" لهو أكثر من مجرد "طلاء صباغة"، وإنه "لملامح".
الفصل الثاني: العلاقات البشرية
نواة هذا الفصل فكرة الفيلسوف الأخلاقي الأمريكي ستيفن داروال (1946-) التي يذهب فيها إلى أن الحياة الخلقية متعلقة لا فحسب بالأنا -الشخص الأول- وإنما بوجهة نظر "الشخص الثاني" -الغير- أي وجهة نظر من تكون دواعي تصرفه موجهة نحو الأغيار. ذلك أننا ما نفتأ "نتحاكم": أحكم على تصرف الغير، وأترك له حرية أن يحكم على تصرفي. فلا وجود لسلوك بمعزل عن وجهة نظر الذات والغير، وكأن سلوك الذات يتم عن الغير بمنأى. وذاك هو "الحوار الأخلاقي" الذي من خلاله نعطي مسوغات للغير ويعطينا تبريرات لسلوكه... ويذكرنا المؤلف بكتاب الفيلسوف اليهودي المؤسس مارتن بوبر (1878-1965) "أنا وأنت" (1923). لكنه يرى أن بعض مناحي فكر الرجل في هذا الأمر بقيت مشكَلة مبهمة، لا سيما ما تعلق منها بالحياة الخلقية، ولهذا قام داروال بتوضيح الأمر في كتابه "وجهة نظر الشخص الثاني"، محتجا بأن المعايير الخلقية تستمد قوتها النهائية من مسوغات الغير -الشخص الثاني- وأن المفاهيم الحيوية للحياة الخلقية -كالمسؤولية والحرية والإحساس بالذنب واللوم- تستمد معناها، في نهاية المطاف، من صلة أنا/أنت حيث يتم تبادل المسوغات. وقس على ذلك المشاعر، نظير الحقد والكراهية والعرفان والغضب، التي ليست هي من صنف الاستجابات البشرية التي يمكن أن تلاحظ أيضا لدى الحيوانات، وإنما هي طرائق تنبع عفوا بين مخلوقات بمكنتها أن تعلم عن نفسها باللفظ "أنا"، وأن تترجم إلى لغة إحاسيس. وفي قلب هذه المشاعر يثوي الإيمان بحرية الغير الجوهرية. ذلك أن ما نحن إياه إنما هو ما نحن إياه بالنظر إلى الغير؛ ومن ثمة فإن الصلات تقوم بين فكرة الشخص البشري، الذي هو "الشخص الأول" المرتبط بوجهة نظر "الشخص الثاني"، على نحو ما يرتبط العيار بحقل مغناطيسي.
وهكذا يتبدى أن "الشخص الأول" -الأنا- إنما هو "منتوج اجتماعي" لا وجود له إلا في صلته بالأغيار، ولا معرفة له بذاته إلا في هذه الصلة. والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها بالخصوص شاهد اللغة (فيتجنشتين)، إذ لا تواصل حق من غير تخاطب، وشاهد الاعتراف (هيجل)، إذ لا تواصل حق من غير تعارف.
ويلتمَّس المؤلف لذلك أمثلة من مجال الوجدانيات والرغبيات والأهوائيات والفنيات والهويات، ويقوم بجولة على أهم النظريات الدائرة على هذه المجالات؛ مميزا من جديد بين التصورات "التفسيرية" البيولوجية وغيرها من التصورات "الفهمية"، ومفضلا النظريات التي تستند إلى "الفهم" على تلك التي تستند إلى "التفسير". ذلك أن من شأن العلاقات بين البشر أن "تُفهَم"، وما كان من شأنها أن "تُفسَّر".
الفصل الثالث: الحياة الخلقية
ينطلق هذا الفصل من حقيقة أن الأشخاص -بني البشر- إنما هم كائنات خلقية واعية بالصواب والخطأ تحكم على شركائها في الخلق ويحكمون عليها بالمقابل والتلقاء. إنما الأشخاص "أفراد"، وما من اعتبار للحياة الخلقية إلا وينبغي أن يبدأ من التوتر الظاهر الذي يقوم بين طبيعتنا باعتبارنا كائنات حرة وانتمائنا بحسباننا أعضاء في جماعات عليها يتوقف إمكان اكتمالنا.
ويتصدى سكروتون للزعم القائل بأن "الفرد" اختراع حديث؛ فيرى -بناء على ما انتهى إليه في الفصلين السابقين- أن سمة "الفردية" إنما هي جزء من الشرط البشري نفسه؛ أي من أن نكون بالفعل بشرا. والشواهد على ذلك كثيرة: منها ميل الأفراد إلى التميز عن غيرهم، واعتبار كل حياة فردية مروية مخصوصة لا تشبه أخرى، واحتفاء العديد من الثقافات بالفرديات... وبهذا تكون "الفردانية" تأكيدا على الأفراد باعتبارهم صانعي حياتهم وقيمتها. وتلك هي ما يدعوه المؤلف "الفردية العميقة"، والتي يرى أنها شرط ميتافيزيقي للإنسان نتقاسمها -معشر البشر- حميعا، أكنا مساندين للمذهب الفردي أم معارضين له.
على أن كوننا فردانيين لا يعني أننا أنانيون. فالمجتمع المبني على الأنانيات لا يمكن أن تقوم له قائمة. ذلك أن اكتمال الكائن البشري لا يمكن أن يتم إلا بالتحاب والتواد والتضحية، لكن لا تحاب من غير تطوير المرء فرديته نحو الجماعية؛ أي بكسب "الفضائل المدنية" التي ذكرها أرسطو.
الفصل الرابع: إلزامات مقدسة
كانت الفصول السابقة جولة في فلسفة الوجود والفلسفة الاجتماعية، بينما خصص المؤلف هذا الفصل للفلسفة السياسية وفلسفة الحق وفلسفة الدين. وقد وقف عند الموضع المشترك لأغلب فلاسفة أمريكا اليوم: القول باستقلال الفرد، والدعوة إلى احترام حقوقه. وفي ذلك تصوران جذريان للنظام الأخلاقي وللنظام السياسي وقد تم تصور هذا النظام على أنه أداة لصون الاستقلال، أو حتى لتقويم التمييز بين الأفراد سعيا إلى تحقيق "العدالة الاجتماعية". وقد أسند هؤلاء الفلاسفة موقفهم هذا إلى مسوغات دنيوية مساواتية، وبنوها على فكرة الاختيار الحر المجردة.
ويبدو أن هذه المسوغات جذابة؛ وذلك بما يظهر أنها تسوغ الأخلاق العمومية والنظام السياسي المشترك الساعي إلى تواجد سلمي لألوان من الاعتقادات متباينة وأشكال من الالتزامات مختلفة وأصناف من الخلافات عميقة. لكن المؤلف يوجه ضربين من النقد إلى هذا الموقف شبه المشترك:
- النقد الأول موجَّه إلى الاتجاه التعاقدي (راولز ومناصريه)، بحيث يرى المؤلف أن هذا الموقف يخفق في الأخذ بعين الاعتبار وضعنا نحن البشر بحسباننا كائنات عضوية. إذ نحن ذوات مجسدة في أجسام، وصلاتنا يتوسطها حضورنا الجسدي، وكل عواطفنا مرتبطة بذلك: الحب الشبقي، وحب الأطفاء للآباء والعكس، والتعلق بالبيت، والخوف من الموت ومن المعاناة، والتعاطف مع الآخرين في شقوتهم وفرحهم... كل هذا يفترض أننا كائنات عضوية، وأننا لسنا كائنات عقلية أو ذهنية مجردة منسلخة.
- النقد الثاني يتمثل في أن الإلزامات التي تلزمنا ليست ولا يمكن أن تختزل إلى تلك التي تتضمنها حريتنا المتبادلة فحسب. فنحن لا نحيا في عالم فراغ، وإنما نوجد في مواقف مشخصة. وعالم الإلزام والإكراه أوسع من عالم الاختيار بمقدار. ونحن مرتبطون بروابط لا نختارها أبدا، وعالمنا يتضمن قيما تتجاوز ما نقبله ونوافق عليه... وهي قيم لا تجد مكانا في نظريات التعاقد الليبرالية؛ شأن قيم "المقدس" و"الجليل"، و"الشر" و"الافتداء"... فهي قيم تفترض توجها آخر في العالم غير ذاك الذي تؤمن به الفلسفة الأخلاقية الحديثة.
وهذان النقدان هما ما يعتبره المؤلف تحديين يستدعيان الاستجابة. واستجابته تتمثل في اعتبارنا فواعل اجتماعيين منغرسين في جماعة منغمسين في أجساد، وعلينا أن نأخذ بعين النظر هذا الأمر في تفكيرنا الأخلاقي، وأن نعتبر كيف أن حتى الإلزامات التي لم نخترها أمر يمكن تسويغه، وكيف أن تجارب "الشر" و"المقدس" ما تفتأ تسائل وعينا بما يهم في الحياة. وإذا فهمنا هذا الأمر، أمكننا أن ندرك كيف يشكل الدين دعامة للحياة الخلقية وليس منافسا لها. وذاك هو بعد "التعالي" الذي ركز عليه سكروتون في كتاب آخر هو "روح العالم" حين اعتبر "المقدس" بعدا ضروريا في حياة الإنسان، وأن فقده مؤذن بفقد الكثير من معنى أن نكون بشرا، ومسؤول عن جعل العالم عالما بلا روح.
-----------------------------------
- الكتاب: "في الطبيعة البشرية".
- المؤلف: روجر سكروتون.
- الناشر: Princeton University Press، Princeton and Oxford، بالإنجليزية، 2017م.
- عدد الصفحات: 151 صفحة.