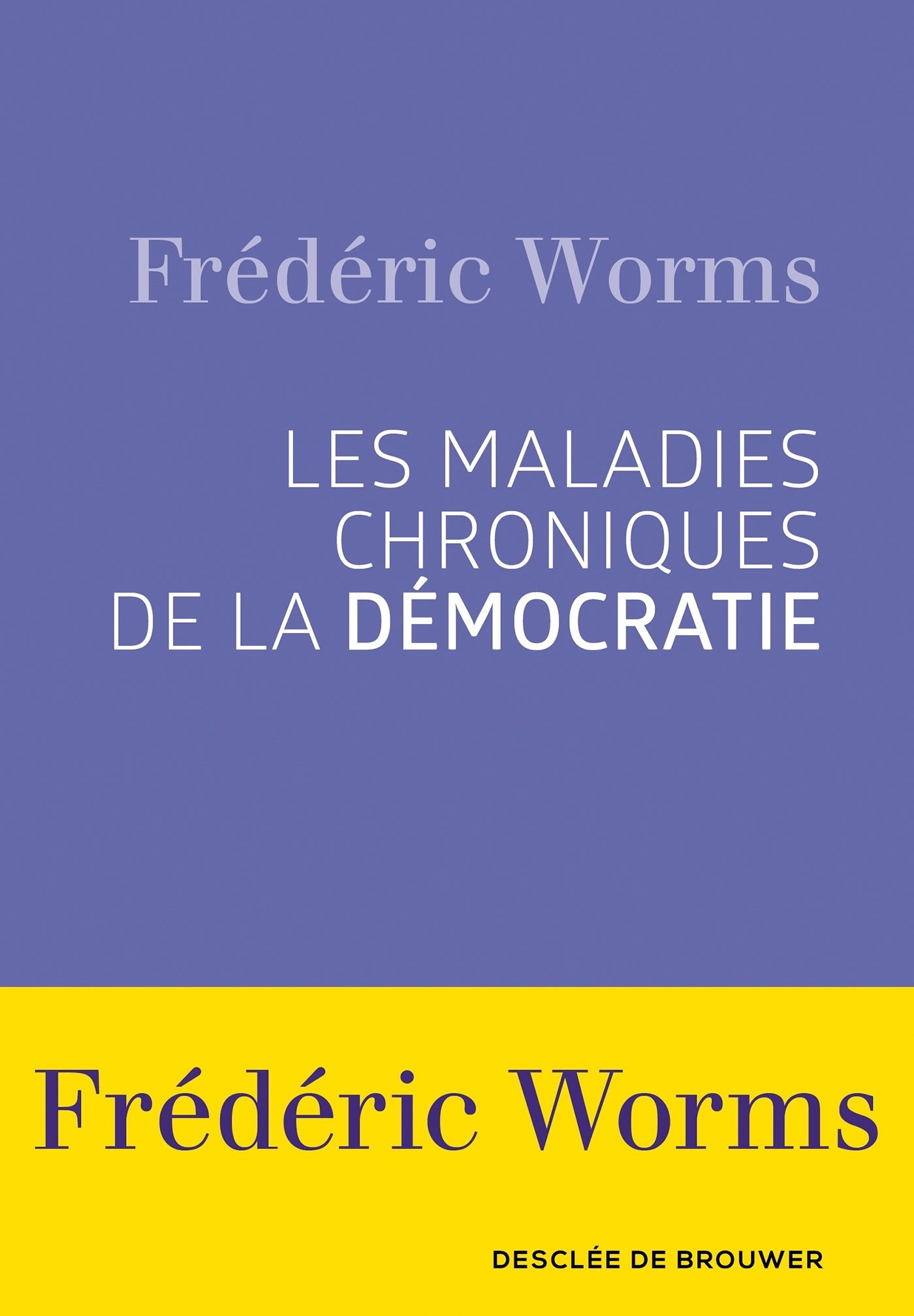لفريدريك وارمز
محمد الحدّاد
من المفارقات التي يعيشها الفكر العالمي حاليا أن الديمقراطية، فلسفةً ومفهومًا وشعارات سياسية، تكتسح العالم اليوم وتفرض نفسها في أجزاء كثيرة منه، بما في ذلك العالم العربي، كجزء أساسي من النقاش العام، في حين أنها، أي الديمقراطية، تشهد مراجعات عميقة وانتقادات حادة في عقر دارها ومنشأها وفي صلب المجتمعات العريقة في الديمقراطية التي اعتمدتها منذ عقود طويلة وأغرت بها غيرها، فهي التي تتعالى فيها الأصوات اليوم بالتشكيك في قدرة الديمقراطية على مواصلة تجسيد الحكم الصالح.
كتاب "الأمراض المزمنة للديمقراطية" لفريدريك وارمز من أحدث الكتب التي تعبر عن هذا التوجه، ويقدم محاولة يقول صاحبها أنه يرمي من خلالها إلى "إنقاذ" الديمقراطية من الانهيار وتخليصها من الأعراض الخطيرة التي توشك أن تعصف بها. والكاتب متخصص في فلسفة هنري برغسون، وقد سعى إلى المساهمة في الجدل حول الديمقراطية من منظور فلسفي لا قانوني، ولن تكون محاولته الأخيرة التي تطرح بحيرة سؤال مستقبل الديمقراطية في العالم الحالي.
يستفتح وارمز كتابه بالمعاينة التالية: خلال الثلاثين السنة التي تفصلنا عن سقوط حائط برلين، انتقل الخطاب حول الديمقراطية من التفاؤل المفرط إلى التشاؤم الواسع. في السابق، كانت تبدو الديمقراطية الليبرالية "نهاية التاريخ" والأفق المفتوح للعالم كله، اليوم أصبحت تحيط بالفكرة الديمقراطية تساؤلات شتّى وشكوك قويّة.
أطروحة ربط نهاية التاريخ بالديمقراطية أصبحت في ذاتها تحتمل معنيين متناقضين: النهاية بمعنى انتصار الفكرة الديمقراطية على كل منافساتها، أو النهاية بمعنى أن الفكرة الديمقراطية لم تعد تحمل الآمال والأحلام بتقديم الحلّ المطلوب لمعضلة الحكم. يؤكّد الكاتب منذ البداية اقتناعه بأن الديمقراطية لم تنته وأنّها تظلّ أفضل الحلول المطروحة، لكنه يؤكّد أنّها تمرّ بأزمة عميقة وهيكلية، وأنّ الطريقة الوحيدة لإنقاذها هي الاعتراف بهذه الأزمة ومناقشتها بكل صراحة.
نرى اليوم مظاهر هذه الأزمة في كل مكان، لقد تخلص أعداء الديمقراطية من عقدهم وأصبح رائجا أن نرى أشخاصا وتيارات تشكّك في المساواة بين البشر وتهاجم أديانا معينة وتدعو إلى العنف لحلّ المشاكل وتحدّ من الحريات العامّة باسم مقاومة الإرهاب، الخ. لكن علينا قبل ذلك أن نتساءل هل أنّ الديمقراطيّة نظام سياسي أم أنها تطلع ومثل أعلى في الحكم؟ إذا عرّفناها بالمعنى الأوّل، سنسلّم بأن تصاعد الحركات العنصرية والانفصالية والعنيفة شاهد على فشل الديمقراطيات في إدارة شؤون البشر، إما إذا احتفظنا بالتعريف الثاني فإنّنا نمنح الفرصة لانطلاقة جديدة للتجربة الديمقراطية، تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الحالية وما يترتّب عليها من تحديات غير مسبوقة أمام دعاة الديمقراطية.
وإلى حدّ سقوط حائط برلين، كانت الديمقراطية هوية للبلدان الغربية المناهضة للشيوعية، وكانت معركة الديمقراطية تخاض ضدّ عدوّ من الخارج. لكن المعركة حاليا هي في الداخل ولذلك هي تفرض مراجعات جذرية للفكرة الديمقراطية ذاتها. ولقد كانت الفكرة الديمقراطية محاصرة في السابق بـ "الكليانية" أو الشمولية، أي زعم بعض الأنظمة السياسية القدرة على تقديم "المعنى" الكلي أو الشامل للتاريخ والمجتمع (النازية، الفاشية، الشيوعية)، لكنها تواجه اليوم "العدمية" لدى المواطنين العاديين الذين يفقدون الإيمان بوجود "معنى" للتاريخ أو المجتمع، ويميلون إلى الفردانية المطلقة التي تحرّرهم من الانتماء الاجتماعي، بل المواطني أيضا، مستفيدين من التكنولوجيات الاتصالية الحديثة التي تشعر الفرد بأنّه "مواطن عولمي" وليس مواطن مجتمع أو دولة بعينها.
يؤكّد الكاتب أنّ من الخطأ تصنيف الديمقراطية على أنها نظام بين نظم سياسية، على غرار ما فعل أفلاطون أو أرسطو سابقا، ويصرّ على الديمقراطية بالمعنى الحديث هي قبل كل شيء اختيار قيمي (أخلاقي) يندرج ضمن فلسفة الحداثة، وأنه يظل هدفا ومثلا أعلى للبشرية. على عكس الديمقراطية القديمة كما تصورتها الفلسفة السياسية الإغريقية، نشأت الديمقراطية الحديثة في سياق التأمّل في الطبيعة الإنسانية وليس في النظـــــم السياســـية. عـمـل إيتـيان دي لابوسـي (De la Boétie) في رسالته المشهورة "الاستعباد الطوعي" على إبراز التناقض العميق في "الطبيعة" الإنسانية بين الرغبة في الحربة والرغبة في الهيمنة، وأقرّ بتوجّه البشر بصفة طوعية إلى قبول أغلال الاستبداد والعادات ليعيشوا سالمين آمنين. هذا التناقض داخل كل إنسان بين الحرية ذات التكلفة الباهظة والتقليد الآمن هو التحدّي الأبرز الذي واجهته الفكرة الديمقراطية منذ بداياتها (عاش لابوسي في القرن السادس عشر وبداية النهضة الأوروبية)، وتواجهه اليوم بفعل العولمة. المطروح علينا حينئذ أن نختار في النظر إلى المسألة بين إحدى طريقتين: طريقة هيغل وماركس اللذين ظنا أنه يمكن تجاوز المفارقة بتجاوز نظام سياسي معيّن، أو طريقة المنظّرين "الأخلاقيين" للديمقراطيّة، على غرار لابوسي، الذين نبهوا منذ البداية إلى أن القضية قيميّة قبل أن تكون سياسية، وأنّ الديمقراطية لا تنجح بمجرد تغيير نظام سياسي وإنما تنجح بتغيير الإنسان وثقافته، ليصبح قادرا على لجم رغباته المجحفة وأنانيته ويقبل بالآخر في كل المستويات: مستوى المشاركة مع الآخرين في الاستفادة من خيرات المعمورة مثل مستوى قبول الاختلاف مع الآخرين في العرق والدين. دون وجود أغلبية تحمل قيم التعايش المشترك، يصبح عسيرا أن نتحدث عن ديمقراطية ولو في ظل مؤسسات سياسية وانتخابات وصحافة وغيرها. وهذا ما يفسّر لماذا تنهار الديمقراطية اليوم في البلدان الأكثر حرصا على المؤسسات والانتخابات، فهي تتحوّل إلى سلوكيات شكلية مفصولة عن مضامينها القيمية الكبرى، تغيب عنها الشخصيات التي كان هنري برغسون يدعوها "الشخصيّات الخيّرة العظيمة"، تلك التي تطرح مبادرات قويّة لتحسين أوضاع البشر، مستفيدة من الحريات التي توفرها الأنظمة الديمقراطية، على غرار حركات تحرير العبيد أو حقوق النساء والعمّال أو استقلال المستعمرات. أمّا اليوم، فلم يعد المواطن في البلدان الديمقراطية يعبأ بالعمل السياسي لأنّ هذا العمل لم يعد يرتبط بقضايا إنسانية كبرى يمكن أن تحشد اهتمامات الناس وطاقاتهم. وفي هذا السياق، يذكر فريدريك وارمز بمفكر آخر من مفكري الديمقراطية الحديثة: جون جاك روسو. لقد اشتهر بكتابة "العقد الاجتماعي" لكنه في الواقع قد كتب هذا الكتاب بالتزامن مع آخر أقلّ شهرة عنوانه "أميل أو التربية"، عرض فيه برنامجا لتربية الشباب كي يكونوا قادرين في المستقبل على إنجاز العقد الاجتماعي المطلوب. إنّ شهرة الكتاب الأوّل دون الثاني مؤشّر على أحد الأمراض العميقة للديمقراطية، أي غياب التربية والثقافة الديمقراطية.
لقد انتبه الفيلسوف هنري برغسون إلى هذا الأمر عندما نبّه إلى أنّ المهمّ في الأحكام القيمية ليس مضمونها ولكن قابليتها للتعميم. الحكم مثلا بأن "لا تقتل" يكون حكما قيميا رائعا عندما يطبق على الجميع ويساهم في إيقاف الحروب بين جميع البشر، من هنا كانت الديمقراطية تعني القابلية للتحوّل القيمي من مجالات مغلقة إلى مجالات مفتوحة، وكانت المعارك الديمقراطية تلك التي تسعى إلى فتح أبواب جديدة لتعميم مكاسبها على عدد أكبر من الناس.
أزمة الديمقراطية حاليا تتمثل في أنها تعمل بالاتجاه المعاكس: الفردانية تتحوّل في المجتمعات الديمقراطية إلى انفصال الفرد عن مجتمعه، والمواطنة تتحوّل إلى عنصرية ضدّ الآخرين، والحرية تتحوّل إلى اقتصاد ليبرالي مفرط يسحق الفقراء والعمّال. وكلّ مظهر من هذه المظاهر الثلاث، أو الأمراض المزمنة، كما يدعوها الكاتب، قد تفاقم لأسباب ترتبط بالمجتمع الديمقراطي ذاته.
ينخرط هذا الكتاب، كما ذكرنا، ضمن موجة من المؤلفات النقدية للديمقراطية، تواترت في السنوات الأخيرة، ويمكن القول إنها تمثل تيارا يجد له جذورا بعيدة في الفكر الفلسفي والسياسي الحديث، كما أن كثرة هذه المؤلفات وتقاطعها في الأطروحات الرئيسية تبرّر استعمالنا كلمة "تيّار"، لأن المبحث المطروح قد استعاده كتّاب مختلفون ومن وجهات نظر متباينة، لكنّ الجامع بينهم هو نزعة التشكيك.
فأمّا الجذور فمحورها الفيلسوف فريدريك نيتشة، ثمّ فلسفة ما بعد الحداثة المستندة إليه والقائمة على نقد السرديات الكبرى، ومنها السرديّة الديمقراطية. يمثل الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو لحظة أساسية في هذا النقد، من خلال كتابه المشهور "نهاية الحداثة"، حيث استند إلى نيتشة وهيدغر والهرمنطيقا. يمكن أن نذكر أيضا عالم الاجتماع الفرنسي ألان توران، صاحب كتاب "نقد الحداثة" (ترجمة عربية صادرة عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر) وقد دعمه بكتاب صادر بعده يحمل عنوان "ما هي الديمقراطية؟" (ترجمة عربية صادرة عن دار الساقي) وقد حاول فيه أن يجيب عن السؤال المطروح برفض فكرة الدولة المهيمنة والصراع بين السوق والبنى التقليدية للمجتمع، واقتراح تعريفا للديمقراطية محوره منح الضمانات التي تحول دون تسلط الأغلبيّة على الأقليات، وافترض أن هذه الضمانات هي التي ستحول دول صعود الأيديولوجيات "الهوية" (نسبة إلى الهوية) أو سيطرة أحكام السوق على السياسة. ولقد تفطّن توران مبكّرا إلى أنّ اختصار الديمقراطية في آليات مثل تنظيم الانتخابات النزيهة لن يكون كافيا لإدارة تجارب المجتمعات المنضمة حديثا إلى العالم الديمقراطي (وكان ينظر أساسا باتجاه أوروبا الشرقية بعد انهيار الشيوعية)، مؤكّدا ضرورة أن تكون الديمقراطية "ثقافة"، وأن تتحوّل إلى مكاسب ملموسة للفرد، وأن تقبل تنوّع المواطنين وطلباتهم وتقترح عليهم في الآن ذاته طرق التعايش المشترك بينهم.
لكنّ محاولات "تجديد" الثقافة الديمقراطية سرعان ما تحوّلت إلى تشكيك صريح في قدراتها على إدارة مجتمعات تتجه نحو التعقيد. ولقد أثار الكاتب الإسباني دانيال إينراريتي (Daniel Innerarity) جدلا واسعا عندما نشر كتابه "الديمقراطية دون الدولة : محاولة في حكم المجتمعات المعقدة"، فلم يتردّد في القول بأنّ السياسة أصبحت عاجزة عن إدارة المجتمعات المعقدة وأنّ علينا أن نعيد التفكير جذريا في معنى السياسة ومفاهيمها، منها مثلا أنّ الدولة لم تعد المعبّر الوحيد عن السيادة، ولا السياسة عقدا مع الشعب، ففي ظلّ العولمة، تصبح السيادة موزعة على أكثر من مؤسّسة، بعضها يتجاوز حدود دولة معينة، كما أنّ "الشعب" لم يعد موحّدا في مطالبه ورغباته. وعليه، فإن الوظيفة الديمقراطية هي تلك التي تسعى إلى التنسيق بين عدة أطراف متدخلة، كي لا يهيمن أحدها على الآخرين.
لكنّ آخرين يذهبون أبعد من ذلك، فلا يكتفون بما يدعوه إينراريتي بتراجع الدولة الديمقراطية. هكذا نشر جيرالد برونر سنة 2014 كتابا ذا عنوان مستفزّ: "ديمقراطية المغفلين"، دافع فيه على أطروحة أنّ الديمقراطية أصبحت ثقافة لصناعة المغفلين، من خلال الصناعة الإعلامية التي توجّه المواطنين إلى مسائل جانبية وتافهة وتتلاعب بعقولهم وبأصواتهم في الانتخابات. وهذا الموقف المتشائم من الديمقراطية نجده أيضا لدى الكاتب نيكو غريمالدي الذي نشر سنة 2014 كتابا عنوانه "أقول الديمقراطية"، حيث أعلن أن الأنظمة التي ندعوها بالديمقراطيات (في الغرب) لا تعدو أن تكون "أولغرشيات" تسيرها المصالح الخاصة، إلاّ أنّ الآلات الإعلامية والثقافية تحوّل فيها هذه المصالح إلى مصالح عامة ووطنية وتقنع جزءا كبيرا من الشعب بذلك. وإلى مثل هذا الموقف المتشائم ذهب الفيلسوف الألماني بيتر سلوتردجيك (Peter Sloterdijik) في كتابه "الطوفان بعدنا". وفي سنة 2016، أصدر الكاتب الإيطالي رافئييل سيمون (Raffaele Simone) كتابه "ماذا لو أفلست الديمقراطية؟" وقد طرح فيه تاريخ الديمقراطية على مدى القرنين الماضيين، مبينا أنّ تطوّر هذا المبدأ كان على أساس الانتقال من أوضاع "طبيعية" وهي رغبة البشر في التفوق والجشع والهيمنة إلى عالم شبه مثالي يقوم على العدل والحرية والسيادة واحترام الأغلبية. لكنّ العولمة أوقفت هذا الانتقال وأعادت تأجيج المشاعر "الطبيعية" المباينة، بما يجعل الديمقراطية تتجه حتما نحو الإفلاس.
يختلف الكتاب الذي عرضناه هنا عن هذا التشاؤم، وقد يقترب أكثر من كتاب جون بيار لوغوف الصادر سنة 2016 بعنوان "قلق في الديمقراطية" (عنوان يذكر بكتاب فرويد المشهور "قلق في الحضارة" وقد كتبه قبل فترة قصيرة من اندلاع الحرب العالمية الثانية) أو كتاب دومينيك روسو "تجذير الديمقراطية" (صدر سنة 2015). ففي هاذين الكتابين، نجد مقترحات عملية للخروج من أزمة الديمقراطية. فدومينيك روسو يميّز بين الديمقراطية "التقليدية" التي يدعوها بالديمقراطية التمثيلية، ويراها قد استنفذت أغراضها ولم تعد قادرة على التفاعل مع تعقيدات المجتمع وأوضاع العولمة، وبين الديمقراطية "المتواصلة" (أو التشاركية)، ويقصد تلك التي تتواصل بعد العمليات الانتخابية وتمارس في مستويات جزئية في المجتمع وتحشد الطاقات الفردية ومبادرات المجتمع المدني لإيجاد حلول للقضايا العملية التي تواجه المواطنين، فهذا الشكل هو الذي سيصمد أمام تحيدي الشكلانية التمثيلية وضغوطات الأسواق المعولمة. بل ذهب الكاتب إلى حدّ عرض مقترحات ملموسة مثل إلغاء وزارات العدل وتعويضها بمجالس عليا للقضاء تكون مسؤولة أمام البرلمانات، واعتماد طريقة الاقتراع النسبي في الانتخابات، ومنع تراكم المسؤوليات السياسية للفرد الواحد، الخ.
أمّا جون بيار لوغوف، فقد دعا إلى الخروج من "الفقاعة الفردانية" التي يعيش فيها المواطن في البلدان الديمقراطية، إذ أن هذا المواطن لا يهتم إلاّ بعمله ومسكنه، ويصرف باقي وقته في الترفيه، ويحدّد علاقاته مع الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فينفصل بذلك عن تعقيدات المجتمع. صحيح أن الديمقراطية قد قامت منذ الأصل على تأكيد فردانية المواطن وتحريره من انتماءاته التقليدية أو الطبيعية ليكون في علاقة مباشرة مع الدولة، دون واسطات، لكن ذلك لم يكن يعني عزله عن المجتمع وعن مشاكل الآخرين.
يمكن أن نذكر عناوين أخرى عديدة في موضوع أزمة الديمقراطية، ولا شكّ أنّ تواتر العناوين يمثل شاهدا على عمق الأزمة. ورغم ذلك، لا يمكن الجزم بأنّ واحدا من هذه الكتب قد طرح بديلا مقنعا أو حلاّ عميقا للأزمة، بل الغالب فيها الوصف وإبراز مظاهر الأزمة. وعلى هذا الأساس، فإن الكتاب موضوع هذا التقديم ينخرط بدوره في محاولات تشريح الأزمة أكثر من تقديم الحلول لها. بيد أن من المهم للقراء العرب، وهم يدخلون عصر الديمقراطية، أن يكونوا على بينة من المآزق التي وصلتها هذه الفكرة في المجتمعات التي احتضنتها قبل قرنين من الآن، على الأقل كي يقع تعديل المسار منذ البداية وتنسيب العديد من المقولات والمفاهيم المرتبطة بسياقات تاريخية معينة وقد تتحوّل إلى عقائد سياسية جامدة وغير مناسبة إذا ما أسقطت على سياقات أخرى مختلفة.
------------------------------------
اسم الكتاب: الأمراض المزمنة للديمقراطية
المؤلف: فريدريك وارمز
الناشر: باريس- ديسكلي دي برور، 2017
اللغة: الفرنسية