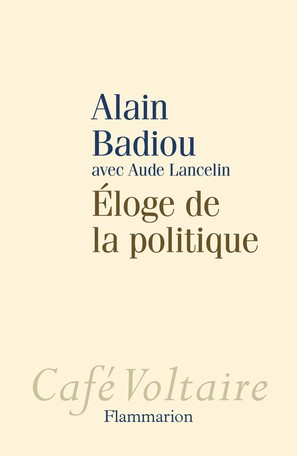تأليف: لألان باديو وأود لانسولان
عرض: محمد الشيخ
هذا كتاب جمع بين دفتيه حوارا غنيا في شأن"السياسة" بين الفيلسوف الفرنسي المعروف ألان باديو (من مواليد الرباط عام 1937) والصحافية الفرنسية خريجة كلية الفلسفة سابقًا والمديرة المساعدة لمجلتين فرنسيتين شهيرتين أود لانسلان. والحال أن المرء يحتار إن هو علم أنه بعد أن ألف باديو في "مديح الحب" (2009)، وبعده في "مديح المسرح" (2013)، وعقبه في "مديح الرياضيات" (2015)، ها هو يعود إلينا بكتاب في "مديح السياسة" (2017)! فلعل من بين ما مدحه هذا الفيلسوف المداح، فإنّ الأقل مدعاة لكيل المديح هو السياسة، لاسيما إذا ما نحن استحضرنا ما يتخبط فيه عالمنا السياسي من مآسٍ.
يتكون هذا الكتاب من خمسة فصول، فضلا عن خاتمة. ويفتتح الفصل الأول هكذا فجأة عن غدارة بلا مقدمة، اللهم إلا ترويسة مستلة من الكتاب تلخص فحواه،فضلا عن تعريف مقتضب بالفيلسوف وبمحاوِرته. ويدور هذا الفصل على السؤال: ما السياسة؟ وتذكرنا واضعة السؤال بالسياق الصعب الذي يطرح فيه: إدارة الكثير من الشباب ظهورهم للسياسة وقد تصوروها باعتبارها مجال المواجهة بين أشكال من الإمعان والتلذذبالمواقف الرعناء وألوان من الانتهازية. وجواب الفيلسوف أنه لا يمكن فهم هذا الإحساس إلا بإعادة اكتشاف اشتقاق لفظة "السياسة". ذلك أن لهذا اللفظ تاريخا مديدا. في البدء، منذ آلاف السنين، كانت فكرة أن "السياسة" إنما هي السلطة ليس إلا، فهي الاستئثار بسلطة الدولة وممارستها على الجماعات المعروفة الأعضاء.فإذن؛ التحديد الأول الذي أعطي للسياسة كان يعتبر أن الشغل الأساس، بل الوحيد، للسياسة،إنما هو الاستئثار بسلطة الدولة. هذا تعريف راسخ في تاريخ الفكر السياسي، ولا يزال سائدا إلى حد اليوم.ومن شأنه أن يختزل السياسة فيانتخاب من يستأثر بالسلطة.
تأسيسا على هذا التعريف، يتولد تصور "كلبي" للسياسة ـ أي ممعن في التشفي والجراءة الفظة والتلذذ بها ـ يرى فيها أنها أمر قائم على ألوان المنافسة وأشكال المحاسدة، بل وأضرب العدوانيات من أجل الاستحواذ على السلطة، وممارستها بحسب أهواء المستحوذين عليها. وقد وجد قديما من نظَّر لهذا التصور (مكيافلي). واليوم، مع الأسف، يشهد العالم على هذا الفهم حيث يتصور أن مملكة السياسة هي مملكة الدناءة والفظاعة والفظاظة والرشوة والكذب والعنف ...
ضد هذه الرؤية، تبلورت رؤية أخرى للسياسة في صلة بالفلسفة ترى أن ثمة تعالقا بين السياسة والعدالة. إذ بدل أن يصير شغل السياسة كامنا في كيفية الاستحواذ على السلطة، يمسي شغلها النظر في كيفية تحقيق السلطة العادلة. وهكذا، يضحى النقاش حول "السياسة" لا يتعلق بممارسة السلطة، بقدر ما يدور على المعايير التي تخضع إليها هذه السلطة، وعلى علاقتها بالجماعة وبالغايات التي تتغياها.وبين تعريف "السياسة" من حيث هي سعي إلى السلطة، وتعريفها من حيث هي سعي إلى العدالة ثمة تآلف وتخالف. ثمة تآلف؛ لأن فكرة "العدالة" ما كان من شأنها أن تبقى فكرة مجردة، وإنما تحتاج إلى تنزيل في الواقع؛ ومن ثم يمسي الأمر أمر سلطة عادلة. وثمة تخالف؛ لأن السلطة إذا عزلت عن مفهوم "العدالة"أمست عرضة للتآكل والتفسخ. هذا مع تقدم العلم أن للتناقض بين "العدالة" و"السلطة" تاريخا طويلا: من أفلاطون إلى ماركس، مرورا بروسو وفلاسفة الثورة الفرنسية الذي فضحوا التناقض القائم بين السلطة والعدالة، حد القول:إذا تحققت العدالة آذن ذلك بزوال السلطة.
وعن سؤال اعتبار باديو "السياسة" "سعيا نحو الحقيقة وتقصيا لها"، إلى جانب كل من الحب والفن والعلم، بدل حسبانها بالضد "سعيا لتمرير الكذب"، يقر الفيلسوف بأن ثمة من وَصَل بين السياسة والكذب، حتى عد مكيافلي السياسة فنا سياديا للكذب (تستهدف الاستحواذ على السلطة بإطلاق وعود كاذبة)، أما هو فلا يقصد بتعريفه للسياسة معناها الأول ـ السلطة ـ وإنما يعني معناها الثاني ـ العدالة.
ويتساءل الفيلسوف: هل يتعلق الأمر، يا ترى والحال هذه، برؤية مثالية؟ وجوابه: "لا أعتقد ذلك قطعا". ويُشهد على ذلك الثورات التي ما تزال تجذب الكثير من الشعوب في ترجمة عن الرغبة في إحقاق العدالة (المعنى الثاني للسياسة) وليس التسلط (معناها الأول). هو ذا ما يدعوه بالتمثل الجماعي للأمر العادل، وهو الحقيقة عينها. حقيقة ماذا؟ حقيقة مقدرة الجماعة ـ والبشرية كافة ـعلى تقرير مصيرها بنفسها، وعلى تشكيله. وتُسائله المحاوِرة: وماذا عن "الديمقراطية"؟ ويأتي جوابه: ثمة تصور كلاسيكي للديمقراطية: الديمقراطية هي التمثيلية؛ أي اضطلاع ممثلي الشعب، عن طريق الانتخابات، بتسيير شؤون الدولة. وبهذا المعنى، يمكن القول إن الأنظمة الغربية أنظمة ديمقراطية ... لكن ثمة معنى آخر للديمقراطية لا يقل عراقة عن المعنى السابق: الديمقراطية حكم الناس. ولهذا، فإننا حين نستخدم مفهوم "الديمقراطية"، علينا أن نعيِّن بأي المعنيين نستخدمها: أبمعنى أنها مجرد آلية انتخابية وتمثيلية تابعة إلى سلطة الدولة؟ أم بمعنى أنها تعبير ممكن عن إرادة الناس في قضايا معينة (روسو)؟ وفق هذا المعنى الأخير، ما كانت الأنظمة الغربية بالأنظمة الديمقراطية؛ وذلك لأن ممثلي الجماعة من الناس لا يعدون ممثلين على الحقيقة وإنما هم أشباه ممثلين في خدمة من يدفع أكثر،وهم فاقدون ـ أمام إغراءات عالم الأعمال والشركات العملاقة ـ أي سلطان حقيقي.
من هنا يخلص باديو إلى ضرورة تصور "السياسة" عن الصلة المباشرة بالدولة بمعزل. ذلك أنه إذا ما استبدت بنا فكرة "الدولة"، استبد بنا تصور للسياسة بحسبانها استئثارا بالدولة ـ أو بالحكم ـ فحسب؛ لأنه من دون هذا "الاستئثار" نعتقد أن لا شيء يمكن القيام به. وهذا أمر غير صحيح؛ لأن السياسة تتضمن رؤية حول الجماعة ـ بل حول البشرية ـ ومصيرها، وهو أمر لا يتم بدون ديمقراطية تشاورية تداولية ـ بدل الديمقراطية التمثيلية الشكلية ـتقضي برؤية واعية وخاضعة إلى النقاش العام حول ما الذي تستطيعه الجماعة وما الذي يمكنها أن تصيره. وإذن، علينا أن نختار بين مجرد التسيير ـ الذي نعتقد أنه سياسة، وما هو بسياسة ـ أي تدبير الهيمنة السياسية وقد اعتُبرت قدرا محتوما، وبين السياسة بمعناها الأصيل، حيث تبدأ السياسة حين يوجد خياران كبيران ـ وليس خيارا واحدا ذا لوينات كما هو الحال اليوم ـ أي طريقان: الطريق الأول هو الطريق الرأسمالي، والطريق الثاني هو الطريق الجماعي [المشاعي]، وأما الطريق الإصلاحي، فيراه المؤلف ـ وهو من قدماء ماركسيي مثقفي فرنسا، وتلميذ للفيلسوف الماركسي الشهير ألتوسير (1918-1990) ـمجرد ترميق للطريق الرأسمالي وترتيق له. ويختم الفصل بنقد لليسار الفرنسي وتعثراته. أما الفوضوية، فلا يرى فيها سوى "سلبية خلاقة"، لكنها أبدا لن تشكل سياسة أو تنهض بها. صحيح أن هناك بعدا"وجوديا" و"تلقائيا" في الفوضوية، لكن غالبا ما يخفي عدم تسامح فظحيث لا يشعر صاحب هذه النزعة براحته إلا في القيام بنشاط سياسي متقطع غير طويل النفس.
ويبسط المؤلف هذه الخيارات في الفصول اللاحقة. وهكذا، فإنه في الفصل الثانيـ الفرضية الشيوعية ـ يرى أن "الشيوعية" أمست لفظا مدانا في حقل السياسة بالغرب، ويحاول باديو أن يزرع فيها الروح من جديد. ويعتبر الأمر معركة تحتاج إلى إزالة الخوف منها والجهل بدلالتها البدئية وعدم السماح بالتخلي عنها. ويقر بأن العديد من الناس دعاه إلى عدم الاحتفاظ باسم "الشيوعية"، وأنه ألح على التشبث به؛ لأن من شأنه التخلص من الطريق الآخر للسياسة ـ طريق الرأسمالية ـبدل التحالف "المخجل" مع همينته المطلقة.
ويدعو باديو إلى القيام بتقديم حصيلة مستقلة للتجارب الشيوعية منذ انطلاقتها لا تكون متحالفة مع "الانتصار الظاهري" لليبرالية المعاصرة الذي يقوِّم هذه التجربة على أنها "جريمة" حدثت في التاريخ وانتهت ولا سبيل إلى فتح الكلام عنها. وقد بدأت هذه الحصيلة المغرضة تقدم منذ الثمانينات من القرن الماضي. والحال أن الحصيلة البديلة تقتضي طرح استفسارين: لماذا اندرست الدول الاشتراكية؟ ولماذا ينبغي الانتقال إلى ما بعد هذا الفشل نحو زرع الحياة في السياسة من جديد؟ يجب إذن تجاوز "التجريم المهيمن"، ويجب طرح السؤال: كيف أدى هذا التحرير الذي شكلته الفكرة الشيوعية إلى ضده؛ أي إلى تعزيز سلطان الدولة؟ وكيف قاد إلى تقوية الفوارق في الدول الاشتراكية نفسها بدل إلغائها؟ وجواب الفيلسوف: كلا؛ ما فشلت الدول الاشتراكية لأنها كانت شيوعية، وإنما حدث ذلك لأنها ما كانت شيوعية ـ مساواتية، تشاورية مع الجماهير ـ بما فيه الكفاية، وما كانت تنتهج نهج السياسة الحق ـ التشاور المستديم.ثم يذكرنا المؤلف بمبادئ الشيوعية الأربعة تدقيقا لمعناها: 1- نزع جهاز الإنتاج من بين يدي الملكية الخاصة. 2-السعي إلى القضاء على التقسيم المتخصص للشغل، لا سيما التراتبي. 3-السعي إلى القضاء على هوس الهويات، لا سيما منها القوميات. 4-وهو المبدأ الحاكم: السعي لا إلى تعزيز سلطان الدولة، وإنما إلى إفقاره لصالح "تجمع للناس حر". على أنه تنبغي مناقشة فشل الدول الاشتراكية بالقياس إلى هذه المبادئ الأربعة. وحينذاك يبدو أنالفشل متأت من خيانة الدول الاشتراكية لنفسها، وليس من التشبث بمبادئها كما يمال إلى ادعاء ذلك. وهكذا، فإنه في الصين، مثلا، صير إلى التخلي عن الشيوعية باسم الشيوعية نفسها، وتخلى الحزب الشيوعي عن شيوعيته وأخذ بمبادئ الرأسمالية وما صار له اليوممن الشيوعية سوى الإسم.
وهكذا، يرى الفيلسوف أنه منذ عهد الفراعنة والأباطرة الصينيين نُشِّئْنا على فكرتي "التفاوت" و"التنافس"، بينما الفكرة الشيوعية ـ القائلة بضدي هذين المبدأين ـ هي الفكرة الأولى التي ثارت ضد هذا الطراز من الدعاوى. على أن الستالينية عملت على "دوللة" الفكرة الشيوعية ـ مائلة إلى السلطوية والعنف ـ خائنة بذلك جوهر الفكرة الشيوعية الثوري.
وفي الفصل الثالث من الكتاب ـ الثورات على محك التاريخ ـ يستعيد المؤلف الفكرة الأساسية في الكتاب: ما كانت السياسة بقابلة للاختزال إلى السيطرة على حركة شعبية من قبل تنظيم قادر على الاستحواذ على السلطة [الحزب الحاكم أو الحزب- الدولة في الأنظمة الاشتراكية] وإنما السياسة تؤلف بين أطراف في جدلية تشاورية. وأحد هذه الأطراف الجدلية وجود حركات شعبية حقيقية. وهنا على الثورة التي سمحت بالمجيء إلى السلطة بقوى جديدة ألا تمسي هي آخر فعل تقوم به الجموع، بل على الجموع ألا تكف عن الفعل على طريقة الثورة الثقافية الصينية التي لا يخفي المؤلف إعجابه بها!ثم إن من خطأ أي ثورة أن تقوم بتذويب الحزب الثوري في جهاز الدولة، وعليها أن تصير هذا الحزب واسطة بين الجماهير الثورية وجهاز الدولة. ثمة إذن جدل مكون من ثلاثة أطراف: الجماهير والحزب والدولة. وخطأ الأنظمة الشيوعية كامن في أنها تصورت نفسها في إطار فكرة نجاح سريع وتام ... والحال أن السعي إلى النجاح المباشر من شأنه أن يجعل من مقولة "الثورة" المقولة الجوهرية، من غير أن يعي أن مقولة "الثورة" لا يمكن أن تكون إلا مقولة "حدثية"؛ أي قطيعة تؤدي إلى صعوبات جمة أكثر مما تحلها. فالثورة مفتتح السياسة وليس خاتمتها. ذلك أنه حين تُسقط وجها من وجوه الدولة وتعوضه بآخر، فليس يعني هذا أن المجتمع قد تغير. الناس يعشقون الظفر، لكن يجب تغيير تصور "الظفر" نفسه. ومن ثم، كان ظفر الثورتين الروسية والصينية ظفرا شبيهيا لا حقيقيا.
وفي الفصل الرابع ـ ما الذي يحمله اسم اليسار اليوم؟ ـ يتناول الفيلسوف ومحاوِرَته نقد اليسار، لا سيما منه الفرنسي، والذي ما عاد في رأي الفيلسوف يسارا بالمعنى الحقيقي؛ أي ما عاد يقدم بديلا حقيقيا للوضع القائم؛ أي للطريق الرأسمالي المهيمن. ويرى باديو أن جزءا كبيرا من التخبط الذي يعيش فيه اليسار يكمن في غياب المثقف اليساري الحق ذي القناعة بأن ثمة طرقا أخرى غير الطريق المهيمن، على طريقة ماركس وإنجلز ولينين وماو الشاب وتروتسكي وروزا لوكسمبورغ وكاسترو. هذا مع العلم أن طبيعة الأنظمة السياسية اليوم تسعى إلى استدامة هذا الوضع حيث يغيب المثقف، مخافة أن يفقه الناس أن ثمة طريقا آخر للعيش غير الطريق السائد.
وتختتم الفصول بفصل يتناول السياسة المحلية للرئيس الفرنسي الجديد ـ ماكرون والانقلاب الديمقراطي ـحيث يصف الفيلسوف انتخاب الرئيس الفرنسي في مايو من عام 2017 بأنه "انقلاب ديمقراطي" . ويرى أن ما يسميه "الماكرونية" أحدثت بالفعل "انقلابا" على نظام التناوب على السلطة بين الحزبين التقليديين يمين/يسار. والحال أن ملل الناس من هذا النظام وتطلعهم إلى طريق آخر هو الظرف الذي شجع ماكرون على "انقلابه". وهو "انقلاب"؛ لأن الرجل استحوذ على السلطة من غير المرور بالمراحل التقليدية: إنشاء حزب يتطور شيئا فشيئا إلى أن يمسك بمقاليد الحكم، بل عمد إلى العكس تماما: هنا شخصية تنشئ حزبا مصطنعا، وليس حزبا تبرز فيه شخصية.وكان الشعار الذي اتكأ عليه شعارا تخويفيا: إما أنا أو اليمين المتطرف!وبه يديم لعبة البديل الرأسمالي الأوحد. ولهذا يدعو الفيلسوف إلى مقاومة شعبية لهذا النظام بإطلاق نقاش حول المسارين: الرأسمالي والشيوعي.
في خاتمة الحوار، يعود الفيلسوف ليؤكد على أن الفكرة الشيوعية التي يجدد الدعوة إليها ما كانت مجرد ثورة، بل هي وجه من وجوه الوجود البشري بعامة الذي يقطع مع حال أشياء دامت منذ آلاف السنين: مجتمعات لا تقوم على المساواة يسيرها فريق مهيمن يستهدي بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحميه الدولة. ولا يؤمن الرجل بحتمية سقوط النموذج الرأسمالي الوشيك. ولا هو مع الناعين الرأسمالية الذين يعتبرون أنها ماتت منذ أمد وأن غبار جثتها قريب التطاير. والحقيقة عنده أن الرأسمالية لا تنهار، وإنما بالضد تنتشر وتغزو آخر معاقل العالم. والذي عنده أن فشل الأنظمة الاشتراكية ما كان دق مسمار في إسفين نعشها، وإنما هي بدايات جديدة. فضدا على ستالين، يعلن الفيلسوف أن الثورة لم تنته، وإنما الثورة الروسية كانت بداية وحدثا استثنائيا في التاريخ.
تتساءل المحاوِرة: أيشكل حقا كل ما تم تداوله إلى الآن مديحا للسياسة؟ وهلّا يمكن للسياسة أن تجعل الإنسان يحيا سعيدا؟ وكيف يمكن أن يبدو شيوعي ناجح ومكتمل حقا؟ وجواب الفيلسوف: أجل، هذا مديح للسياسة بلا مرية. إذ من بين كل المبادرات الفنية والعلمية والعشقية والسياسية، التي أظهرت البشرية أنها قادرة عليها، فإن الشيوعية، بلا شك، هي المبادرة الأكثر طموحا والأشمل التي سوف تعلوبالجنس البشري فوق قوانين المنافسة والبقاء بأي ثمن، وفوق المصلحة الخاصة، وفوق العداء للآخرين ـ يعني أنها ستحلق به فوق قوانين الحياة الفظة، وقوانين الحيوانية، وقوانين الطبيعة، وقوانين الغاب. هي، أخيرا، الخروج من عصر البشرية الحجري. أما السعادة فيها، فتكمن في الحركات الجماعية التعاونية التي هي فعل واعد خالد ناجح، وعلى حد عبارة اسبينوزا: "فيها تجربون أنكم خالدون". وتلك كلمة الفيلسوف الختامية.وبها يلتبس الأمر على القارئ: أهو، يا ترى، مديح للسياسة أم هو مديح للفكرة الشيوعية؟ لكن هل تسوغ هذه التسوية؟ وهل يجوز القول: كما أنه لا يوجد في القنافذ أملس، فكذلك لا يمكن أن يكون ثمة بشر أميز؟ وما مستقبل التعددية السياسية في ظل هذه الفكرة التي يدعو إليها المؤلف؟ تلك هي القضية، لكنها قضية عندنا وليست قضية عنده.
-------------------------------------
التفاصيل :
عنوان الكتاب :مديح السياسة
المؤلف : ألان باديو بالاشتراك مع أود لانسولان
السلسلة : Café Voltaire
دار النشر : Flammarion
سنة النشر : 2017
لغة النشر: الفرنسية