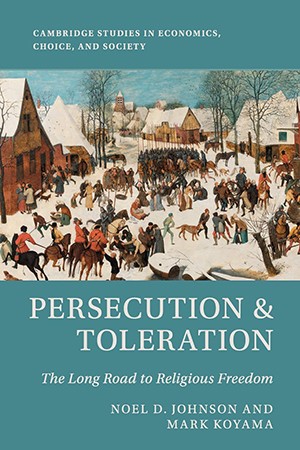تأليف: نويل. د. جونسون ومارك كوياما
عرض : محمد الشيخ
أَنْ يكتب فيلسوفان سياسيان في تاريخ مفهوم "الحرية الدينية"، فذاك أمر مألوف معهود. وأَنْ يكتب عالما سياسة في الموضوع ذاته؛ فذاك أيضا أمر مشهود مأنوس. لكن، أن يكتب فيه باحثان اقتصاديان، بل ومؤرخان للاقتصاد؛ فذاك أمرٌ ما يعهد من قبل ولا جرى ذكره. يقول صاحب يوهوي حاورني: "وما شأن علماء الاقتصاد بالدين وبالحرية الدينية؟"، فأقولله: مَهْ، ياعزيزي، فإن بعض أهم الكتب في "الدين" أمسى يؤلفها علماء اقتصاد. وما عنوا هم بالاقتصاد في الاعتقاد فقط، وإنما صاروا إلى العناية أيضا بالاعتقاد في الاقتصاد.
وبعد، هذا كتاب غير معهود في تاريخ "الحرية الدينية"،لا من حيث "الرؤية" ولا من حيث "المنهج". إذ ما كانت الرؤية المعتمدة فيه بالرؤية الدينية، فضلا عن الفلسفية، وإنما كانت رؤية اقتصادية بالأولى وسياسية بالألحق. وما كان المنهج المتبع فيه منهجا تأمليا، وإنما كان منهجا وضعيا استند صاحباه إلى إحصاءات وبيانات وخرائط ورسومات، بما لم يعهد بمثله من تأمل حال كتب مؤلفة في هذا الغرض. وإنه لكتاب أقرب إلى تاريخ الوقائع الاقتصادية والاجتماعية منه إلى تاريخ النظريات الفكرية.
يفتتح الكتاب بالإشارة إلى ماسمَّاه الباحثان الهزات التي أضحت تعاني منها "القيم الليبرالية" بتأثير عوامل متباينة: الضغط الاقتصادي الجامح والشعبوية الصاعدة والهجرة المتسعة. ويشيرالمؤلفان إلى أن "الحرية الدينية" مكون "جوهري" من مكونات الليبرالية. وها هي أمست تثير الكثيرمن الجدل. وفي بيئة كهذه، يرى الباحثان أنه لابد من العودة إلى "أصول" وإلى "تطور" القيم الليبرالية شأن قيمة "الحرية الدينية". ويعلنان أن هذا هوالغرض الذي يتغياه كتابهما. فهو كتاب يسعى إلى فهم كيف بزغت "الحرية الدينية" في أوروبا الغربية من العصور الوسطى [عهد "التسامح المشروط"] إلى العصر الحديث [عهد "الحرية الدينية"].
والذي عند المؤلفين أن "الحرية الدينية" ماكانت توجد في العالم ما قبل الحديث. وبسبب من الدور الذي كان يلعبه الدين في دعم النظام السياسي- إذ كان يضفي الشرعية على الحكام- فإن النخب السياسية سعت دوما لممارسة الرقابة على الممارسة الدينية. وفي غياب حرية دينية حقة، ما كان يوجد، في أفضل الأحوال، سوى ما يسميه المؤلفان "التسامح المشروط" الذي عملت "الحريةالدينية" على تجاوزه في العصرالحديث. تلك هي المسألة الجوهرية في الكتاب: دواعي بزوغ "الحرية الدينية" وقد تجاوزت "التسامح المشروط"، وحيث يأتي هذا البزوغ. ولايهتم الكتاب بمضمون الدين أو الاعتقاد؛ وبالتالي ما كان كتابا في اللاهوت، وإنما هو كتاب في التاريخ الاجتماعي، ولاسيما منه في شقه الاقتصادي؛ حيث يهتم، أولا وقبل كل شيء، بتطور "المؤسسات السياسية والاقتصادية" التي سمحت ببزوغ هذه الحرية.
دعاوى الكتاب الثلاث
من أين تسللت مفاهيمنا الحديثة عن "الحرية الدينية"؟ يقتضي الجواب فهم السيرورة التي تحكمت في بزوغ هذا المفهوم. وهذا أمر لا يتطلب المعرفة بالتاريخ وفهمه فحسب، وإنما يقتضي إدرك التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الدول ما قبل الحديثة. ولفعل ذلك، لابد من مواجهة "ثلاث أساطير" شعبية تكونت حول موضوع "التسامح الديني"
تقول الأسطورة الأولى إنَّ العنف الديني كان شديد الحضور في أوروبا الوسطى والحديثة المبكرة. ولاكما تقول، إذ الحال أن الاضطهادات الدينية ماكانت ثمرة اعتقادات متعصبة أو غير عقلانية، وإنما كانت انعكاسا للاقتصاد السياسي لعالم ماقبل الحديث؛ حيث كان الحكام يخضعون للمرجعيات الدينية بغاية إثبات شرعية حكمهم. وإذا صح أنه ماكانت ثمة "حرية دينية"، صح أيضا أنه ما كان هناك "اضطهاد ديني" مستشر. كان ثمة "تسامح مشروط" يقسم الجماعات الدينية إلى دوائرمعزولة. وكان الثمن الاقتصادي المؤدى عن سياسة العزل هذه مكلفا.
وتقول الأسطورة الثانية إن بزوغ "الحرية الدينية" إنما يعزى لتغير المناخ الفكري، وإلى الدعاوى التي تقدم بها مفكرون من أمثال جون لوك وباروخ اسبينوزا وبييربايل للدفاع عن "التسامح الديني". لكن إن صح أن هؤلاء المفكرين هم الذين دعوا إلى الحرية الدينية، فلماذا دعوا إليها بالذات في القرن السابع عشر؟ ولماذا نسيت دعاوى الذين تقدموهم بالزمن وهم كثر؟ "الأفكار" وحدها لاتكفي، بل حتى "التجارة الوديعة"، وإنما المفتاح يكمن في "المؤسسات السياسية". والحال أن التحولات التي شهدتها الاقتصادات الحديثة المبكرة، وكذا تلك التي شهدت عليها الدول، هي التي قادت، قبل غيرها من العوامل، إلى اعتراف تدريجي بأهمية "الحرية الدينية".
وتقول الأسطورة الثالثة إنَّ مصدر العنف الديني الأساسي هو الدولة. وذلك بحكم ما تم افتراضه من أن الدولة كانت مفترسة فنزعت إلى التسلط المطلق؛ وبالتالي أشاعت الاضطهاد وغلَّبت النخبة على مجموع المجتمع. بيد أن ما ننساه أن هذا الرأي الشائع يسقط مفهوم "الدولة الحديثة" على زمن كانت فيه الدولة شبه غائبة في تجارب الناس العادية من قبل. والحق أن السلطات المحلية والأهلية هي التي أشاعت الاضطهاد على نحو ما هو بيّن في حملة "مطاردة الساحرات" وليست النخب المركزية ممثلة الدولة، والتي كانت في أغلبها دنيوية الهوى وليبرالية الرأي.
إذن، يستبعد المؤلفان "مرويات" نشأة "الحرية الدينية" السائدة، ويعرضان "مروية أخرى" عن بزوغ "الحرية الدينية". ويفعلان ذلك لا بالتركيز على "الأفكار" و"المعتقدات"، وإنما على "المؤسسات" التي حكمت العالم ما قبل الحديث و ماطرأ عليها من تطور.
وبدورها، تنبنِي الأطروحة التي يقدمها المؤلفان في كتابهما على ثلاث دعاوى:
- الدعوى الأولى: عبر التاريخ توسَّل الحكام الدين لتسويغ حكمهم وإضفاء الشرعية على سلطتهم. وكم كان قديما التعالق بين الدين والسلطة السياسية. إذ منذ أقدم عصور التاريخ قام توازن بين الدين والدولة. لكنه انكسر لأول مرة في أوروبا الغربية. ويدرس الكتاب كيف تم الانتقال من عالم كان فيه الدين والسياسة ممتزجين إلى عالم صارت فيه "الحرية الدينية" تحظى بالاحترام وتستحق الرعاية. وكان من نتائج التعالق الذي حدث عبر التاريخ أن توسلت السياسة بالدين، فلجأت إلى الحد من الحريات الدينية وإلى إنزال الاضطهاد بالذين يخالفون السنة. ولئن حدث التسامح الديني، فإنه كان تسامحا مشروطا، وما كان بالحرية الدينية الحقة. وغالبا ما كان يتم التسامح مع المنشقين عن السنة في المجتمعات ما قبل الحديثة، ما لم يهددوا سلطة الحاكمين.
كيف حدث الانتقال من "التسامح المشروط" إلى "الحرية الدينية"؟ ثمة "آليات" قادت أوروبا من توازن اجتماعي- سياسي إلى آخر؛ أي إلى مجتمعات ليبرالية مفتوحة قائمةعلى قواعد حكم عامة.
وقد بسط المؤلفان هذه الدعوى في الفصول الستة الأولى من كتابهما. إذ أقام الفصل الأول في صلالت فرقة بين "التسامح المشروط" و"الحرية الدينية" مميزا بين طريقتين في تنظيم المجتمع: تتمثل الطريقة الأولى في شكل التنظيم الاجتماعي الذي ورثناه عن الإقامة الأولى للمجتمعاتا لزراعية، وبقي حاضرا في كل أنحاء العالم إلى قرون قليلة. وقام على "قواعد هوية". وهي قواعد حكم وسلوك تعامل الأفراد معاملة تختلف بالقياس إلى هويتهم الاجتماعية. وتنهض الطريقة الثانية لتنظيم المجتمع على استعمال القواعد عامة لحكم المجتمع وإدارة سلوك الأفراد. وهي تعامل كل أفراد المجتمع على قدم المساواة. ولقد كانت قواعد الهوية مديدة الحضور في العالم برمته؛ لأنها كانت تؤهل الحكام إلى ضمان امتيازات خاصة لجماعات اجتماعية مخصوصة. وكان من ثمرات ذلك الحفاظ على النظام. فكانت أرخص السبل إلى تحقيق ذلك. لكن كان لها ثمن باهظ سواء على مستوى التضحية بالحرية الشخصية أوعلى مستوى تباطيء النموالاقتصادي. وبالضد، كانت قواعد الحكم التي لاتستند إلى الهوية- القواعد الحديثة لحكم وإدارة الأفراد والمجتمعات- "باهظة التكلفة"؛ إذ كانت تتضمن الاستثمار في مؤسسات قادرة على تقوية المساواة أمام القانون بين كل أعضاء المجتمع؛ بما كان يقضي بتنصيب محاكم وإقامة محاكمات وتعزيز شرطة الدولة. لكن مقاب لذلك، كان ذلك الخيار يضمن النمو الاقتصادي والتجديد. فكان لابد مما ليس منه بد. ويقدم الفصل الثاني إطارا لفهم العلاقة بين الكنيسة والدولة على النحو التالي: كان الدور التأثيري للدين في المجتمع يمنح للمرجعيات [السلطات] الدينية أهمية بالغة، اجتماعيا وسياسيا؛ إذ تستعمل ذاك التأثير للشراكة مع السلطات الدنيوية مانحة إياها الشرعية السياسية مقابل تقوية الدولة القوية السنية الدينية. ويركز الفصل الثالث على المؤسسات التي قام عليها "التسامح المشروط". وقد فحص كيف شكلت الدواعي السياسية والاقتصادية مواقف منا لخروج عن الملة. وهذا يفسر ترافق بروز تنظيمات سياسية أكثر انسجاما بحركة اضطهاد. وكانت النتيجة الوجه المظلم للتسامح المشروط: الاضطهاد الديني الذي عانت منه الحركات الهرطقية. ويتناول الفصل الرابع الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي حكمت إقامة اليهود بأوروبا الغربية. وقد قام توازن "التسامح المشروط" على الموارد الاقتصادية التي ولّدها قرض المال على الطريقة اليهودية. وكان توازنا هشا للغاية سرعان ما انكسر خلال سنوات الضنك الاقتصادي التي عرفتها أوروبا.
ويدرس الفصل الخامس الصلة بين الظروف المناخية القشفة [الجفاف والمجاعة] واضطهاد اليهود. كما يبين الفصل السادس كيف أن اليهود كانوا يمسون من ذوي الوضع الهش ما أَنْ كان يحدث التشكيك في مشروعية الحكام.
الدعوى الثانية: يذهب الباحثان إلى التمهيد لهذه الدعوى بملاحظة أن الكنيسة الوسيطة أفلحت في هزيمة ما لايكاد يحصى من الهرطقات، لكنها أخفقت في هزيمة حركة "الإصلاح الديني". ومفاد الدعوى أن الحكام الأوروبيين سعوا إلى رفع الضرائب أكثر لتحصيل مداخيل أكبر. وقد ترتب عن هذا قيام أشكال من التوتر بين قواعد الهوية المستندة إلى الدين وسلطان الدولة في الحكم. فكان أن نشأت حركة الإصلاح. وكان من شأن الإصلاح- ويا للمفارقة- أن أدى إلى ازدياد حركة الاضطهاد. وقد بسط المؤلفان هذه الدعوى في الفصول الثلاثة اللاحقة؛ وذلك بحيث درس الفصل السابع تأثير حركة الإصلاح. وقد بدا الإصلاح، بالنسبة إلى المؤلفين، بمثابة صدمة وجهت إلى التفضيلات الدينية؛ بحيث كسرت ادعاءات الحكام الشرعية السياسية. وأدى هذا بدوره إلى اضطهاد ديني قصير الأمد متفاوت الأثر لكنه شديد البأس، لاسيما في إنجلترا وفرنسا والأراضي المنخفضة. وحدث الانكسار الأعظم عندما سار بناء الدولة بخطى حثيثة نحو الأمام سيره الأسرع. وحيث ماكان سلطان الدولةأعلى والاضطهادات أشد، بزغت المؤسسات الجديدة. وقد بدا أن هذه المؤسسات لاتتوافق مع توازن التسامح المشروط. وهكذا، ما عاد حكام إنجلترا وفرنسا وهولندا، بعد عام 1600، يخضعون إلى الدين. أكثر من هذا، مع النمو الاقتصادي، بدا ثمن اضطهاد الأقليات النشيطة باهظا، فكان لابد من بروز الدولة الليبرالية. ويفسر الفصل الثامن حالة شبه الجزيرة الإيبيرية التي لجأت إلى محاكم التفتيش لتنميط الناس، وماكان من أثر لذلك على أفول سلطان إسبانيا الاقتصادي والسياسي بعد عام 1600. ويتتبع الفصل التاسع التطورات التي حدثت في فرنسا وإنجلترا بعد عام 1600. ويرى أن الحكام سعوا إلى العودة إلى توازن التسامح المشروط، في فرنسا، على أساس من الكاثوليكية، وفي إنجلترا، على قاعدة من الأنجليكانية، لكن النجاح كان محدودا، وأدى إلى اقتصاديات دينية مشتتة. وقد حاول لويس الرابع عشر طرد طائفة الهوغنوت من بلده، لكنه أخفق في تصيير فرنسا بأكملها كاثوليكية، وأدى ثمنا اقتصاديا غاليا على فعلته تلك. واضطهدت إنجلترا بدورها البروتستانت غير السنيين في القرن السابع عشر قبل أن تتخلى عن محاولاتها إنجاز التسنن التام بعد عام 1689. لكن القرن الثامن عشر البريطاني سار نحو توازن جديد مع دور للدين أقل.
الدعوى الثالثة: إذ عجز العديد من صناع السياسة عن إعادة ترميم الشراكة القديمة بين الدين والدولة، فضلوا إحلال توتر بين قواعد حكم الهوية الدينية وسلطان الدولة بالتخلي عن قواعد الهوية. وبالبدل من ذلك، طوروا أنظمة حكم تغافلت عن الفوارق الفردية وأخضعت الجميع إلى جملة قوانين وتنظيمات مشتركة. وهذا ما فصل فيه القول الفصلان العاشر والحادي عشر. إذ استقصى الأول ماسماه المؤلفان "أفول العنف ضد السامية" بعد عام 1600. وقد رأيا أن هذا الأفول ما كان بأثر مباشر من الإصلاح أو التنوير، بقدر ما كان بأثر تنامي سلطان الدولة الذي حرر الدول الأوروبية من الاستتباع إلى نظام القرض اليهودي وف ينفس الوقت أظهر أنه ما كان لها أن تستجيب إلى هذه النزاعات الطائفية. ويقر المؤلفان بأنه في فرنسا لعبت مفاهيم الأنوار عن المساواة بين بني البشر دورا حاسما في رفع الحواجز التمييزية، لكن في بلدان أخرى كانت الاعتبارات البرجماتية المتعلقة بضريبة الدخل والاقتصاد هي الأهم. وقد عمد الباحثان – في الفصل الحادي عشر- إلى دراسة الصلة بين سلطان الدولة والعنف الديني من منظور آخر: منظور محاكمة الساحرات. وهنا نجد المركزية القانونية – سلطان الدولة – وقد صارت تستند إلى القانون العام قد عملت على الحد من مقدرة المؤسسات الشرعية المحلية على الاستجابة إلى المخاوف الشعبية من الساحرات، وحدت من الاستعمال الاعتباطي للتعذيب. وهكذا يبدي هذا المثال كيف أن منطق الدولة انتصر على منطق الجماعة.
ما هي النتائج الاقتصادية للحرية الدينية؟
يُبرِز الفصل الثاني عشر أنَّ المدن التي كانت متسامحة مع اليهود نمت بسرعة أكبر. ويفحص الفصل الثالث عشر القومية بحسبانها المصدر البديل الذي أمست تتكئ عليه الشرعية السياسية. ذلك أن القومية (المدنية وليس العرقية) توافقت مع الحكم القائم علىا لقواعد العامة. ويدعي المؤلفان أن بروز القوميات المدنية ساعد الدول الأوروبية على استبدال القواعد الهوياتية بالقواعد العامة. وفي الفصل الموالي يخرج المؤلفان عن أوروب البيان أن إطارهما التفسيري يصلح للتطبيق على بلدان أخرى. في الشرق الأوسط، مثلا، كان الدين حاسما في الشرعية السياسية، وكان التسامح المشروط مع النصارى واليهود متوافقا مع الداعي البرجماتي للحكام العرب. لكن هذا التسامح كان قائما على أعراف هُوياتية. وقد عاقت التبعية إلى هذه الأعراف النمو الاقتصادي. وأدى الفشل في الاستثمار في تعزيز سلطان الدولة إلى بقاء توازن التسامح المشروط قائما حتى أدركته الأزمنة الحديثة. ويبرز الفصل الأخير الوجه المظلم للدولة الحديثة الذي أبدت عنه ألمانيا النازية وروسيا الشيوعية؛ إذ كلاهما قمع الدين. وقد أظهرت االمرجعيات الدينية بحسبانها مصادر منافسة للسلطة السياسية، وكم ضحايا بأقليات دينية.
-------------------------
التفاصيل :
- الكتاب: "الاضطهاد والتسامح: الطريق الطويل إلى الحرية الدينية".
- المؤلف: نويل. د. جونسونومارككوياما.
- الناشر:جامعةكامبريدج،2019.
- عددالصفحات: 368 صفحة.