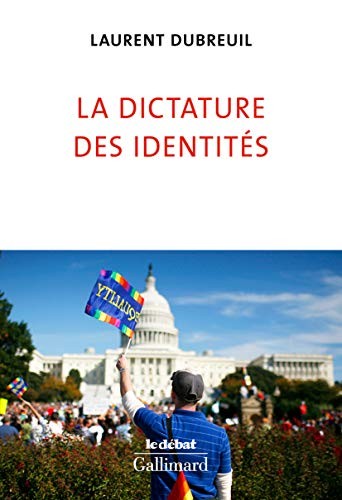تأليف: لوران ديبروي
عرض: محمد الشيخ
لَئِنْ دأب الفكر والفلسفة السياسيان القديمان على تناول قضايا شأن "المدينة" و"الفضيلة" و"نظام الحكم الأمثل" و"الحياة الطيبة"، ودأب الفكر والفلسفة الحديثان على مناقشة مواضيع شأن "الدولة القومية" و"التعاقد الاجتماعي" و"السيادة" و"المجتمع المدني"، فإنَّ هذين المبحثين أمسيا يدوران -في الفترة الراهنة- على موضوعات جديدة شأن "التعدد" و"الاعتراف" و"الهوية".. وما كان كتاب الفيلسوف والناقد الفرنسي لوران ديبروي الأستاذ بجامعة كورنيل الأمريكية - صاحب كتاب: "رفض السياسة" (2012)- بدعا من ذلك.إذ يتناول في كتابه الجديد هذا -"دكتاتورية الهويات" (2019)- مسألة "الهويات" والسياسة المستندة إليها -"سياسة الهوية"- تناولا نقديا، مع التركيز على النموذج الأمريكي.
يفتتح الفيلسوف الشاب كتابه بمقدمة تعلن، بدءا، عن نبرة الكتاب النقدية السجالية: "ضد الهويات". ويصرخ لمن يريد أن يسمعه: "أَلا كم كنا ـ معشر الناس ـ مخدوعين! وما اكتشفتُ الخدعة إلا بالأمس القريب!" ويواصل الحديث: إلى حد الآن، كنا نحسب أن موضوع "السياسة" هو "الخير المشترك" ـ المصلحة العامة ـ و"الحرية الفردية أو الجماعية"، و"مزاولة السلطة"، و"صون المجتمع"، و"أشكال المواطنة"، و"تأطير الاستغلال"، و"الحماية من الهمجية"، و"رعاية المؤسسات"، و"القيام بالثورات"... وكنا نناقش هذه الأمور منذ آلاف السنين، وأحيانا بفورة وسورة. وكم قادت هذه النزاعات الشديدة إلى تمردات وانتفاضات واحترابات. والحال أنه يبدو أننا كنا على خطأ. ذلك أنه يتبدى أن مسألة "السياسة" ـ في نهاية المطاف ـ قد تكون هي "الهوية"، التي إذ ترسخت في حياتنا كل الترسخ، فإنها أضحت تحكم خطاباتنا واستيهاماتنا وقوانيننا وحكوماتنا. أجل، ثمة "هويات"، وهي "هويات" تحكم عبرنا ومن خلالنا. وإهمالها ونكرانها والتنسيب منها أو التجاوز عنها من شأنه أن يبين عن دناءة هذه الهوية (الأغلبية بلا شك) التي تسعى لإسكات أولئك الذين تم إخضاعهم واستتباعهم.
وهكذا، صِير إلى ادعاء أن "سياسة الهوية" هي الكمال الحق لكل السياسات، فهي تنظم مختلف طبقات الشأن العمومي والخصوصي معا. ويفضي إلينا المؤلف بأن الهويات أمست تحكم كل أمر: الهوية الذكورية ضد الهوية الأنثوية، والهوية البيضاء ضد الهوية الملونة... ولسوف تعمل "سياسة الهوية" -على حسب ما يزعمون- على حل هذه المعضلة، وذلك لا بصهر الهويات، وإنما بالضد من ذلك بتعزيزها: أَلا وقد صار المطلوب من كل هوية أن تتقدم وأن تكشف عن وجهها وأن تعلن عن نفسها وأن تبدي مظلمتها وأن تعرب عن مطلبها... وبهذا تحولت هذه السياسة -المبنية على الهويات- إلى سياسة صبيانية تبعث على السخرية... وقد مثَّل لها المؤلف في هذا الكتاب بعشرات من الأمثلة مجملها مستمد من بعض القضايا الهوياتية الغريبة التي طرحت في المجتمع الأمريكي،حيث صارت، مثلا، في الأوساط الجامعية كل جماعة من الطلاب تطالب بالطعام الذي يحترم هويتها الخصوصية... وتنتفض ضد كل طعام مخالف لهويتها الخاصة! لكن المشكلة، في رأي المؤلف، أن هذا الأمر المثير للضحك قد تحول إلى برنامج سياسي.
ويرصد المؤلف هذه الحركة -من مطلب الهوية إلى سياسة الهوية- منذ بدايتها عام 1977 إلى اليوم. والجديد اليوم عنده، بالقياس إلى الأمس، أن وسائل الاتصال الجماهيرية -وهي التي لطالما كان يُظن أنها وسائل العولمة بامتياز- أمست، على الضد، تعزز سياسة الهويات هذه وتمدها بدفعة قوية بدلا من أن تحد منها، وأن تجعل الناس يتعارفون فيما بينهم البين ويرعوون عن غلواء هوياتهم الضيقة. ذلك أنه بداية من أعوام 1990 بدأت الموجة الثانية من هذه النزعة تتنامى بعد أن كانت قد تراجعت في النقاش العمومي التقليدي. وها هي عادت في سنوات 2000 لتستقر في الإنترنت ولتتحين ولتتجدد على نحو أشد فظاظة وخبثا.
ينقسمُ الكتاب إلى أربعة فصول يخصصها المؤلف إلى نقد "سياسة الهوية" على اعتبار أن هذه السياسة استبدادية وجبية المنزع، ثم يفضح منطق الضحية -جراح الهوية وندوبها- الذي تختفي وراءه خطابة الهويات، كما يفضح الوسائل التي تتوسلها الهويات لكي تمارس رقابتها المقيتة.
والمؤلف على وعي تام بأنه يجازف بقوله هذا ضد الهويات مجازفة صعبة، كما أنه يعلم مسبقا بأنه يمكن الكشط على تحليلاته بجرة قلم، وذلك من منطلق مقاومة الهويات لكل نقد باسم "قداسة النزعة الهوياتية". وجوابه عن هذين التحديين: أجل، ينبغي أن نرفع أصواتنا صادعة قوية ضد "عوي جماعات الهوية المستذئبة".
استبدادات
يقول لسان حال "سياسة الهوية": "أنت على شاكلتك، وأنا على شاكلتي، وأنت تفكر على هذا النحو، وأنا أفكر على غيره [لا شيء يجمعنا، كنا طرائق قددا]". وبهذا تعزز "سياسة الهوية" بروز نزعة "استبدادية ديمقراطية"؛ حيث لا تعود السلطة التسلطية مرتكزة بين يدي الطاغية وحده، ولا الحزب الوحيد، ولا الدولة المستأسدة، وإنما تمسي في متناول أفراد خضعوا إلى عملية تألية وتصنيع وتوجيه، بحيث أمست تعبرهم رغبات هيمنة شمولية توتاليتارية. وهكذا، يمسي الجميع رقيبا على الجميع [لي هويتي ولك هويتك، فلا تمسس هويتي]؛ بحيث لا تصير الدولة هي من يُعمل آلية الرقابة، وإنما الأفراد أنفسهم يعرضون فيديوهاتهم وتعاليقهم وصورهم ورسائلهم المتبادلة، مفتخرين يمشون في الأرض مرحا مستعرضين لهوياتهم: "هذه هويتنا".وهذا يظهر أن الأمر ما كان حادثة عرضت لنا في المسار، ولا كان مجرد مرحلة انتقالية، ولا حتى مرحلة جديدة بجدة جذرية، وإنما هو بالأولى تجربة مفاجئة وإرادية تجد مقدماتها في نزوع هوياتي تسلطي بدأت ملامحه تتبلور منذ سنين خلت.
حتميات
تتقدَّم "سياسة الهوية" وهي مزدهية بما تعده مزايا ثلاث تتوافر فيها: تقوم على "الأصالة"، وتعبر عن "المحافظة على الأصول"، وتمثل "مصير" الجماعة الهوياتية. وهكذا، ينتشر، مثلا، ضرب من الخطاب المعادي للعنصرية، وهو واهي الحجة، لكنه سريع الانتشار، يشدد على استحالة أن يختار الأفراد "عِرقهم". وقد يتبعه في ذلك ضرب رائج من الخطاب حول "النوع". ويجتمعان معا على أن "الهوية" إنما تتحدد بالجبرية ولا تُختار بالطواعية. وهما يذهبان إلى أن انجذابات الشخص إلى الهوية وانفعالاته إنما تعود إلى صبغياته وبيان هرموناته وعقدة أوديب والظروف الاجتماعية-التاريخية التي تحكمت في طفولته، أو حتى تعود إلى إرادة الرب: "هكذا خُلِقْتُ!" وفي هذا التصور الرائج خليط عجيب من "الحتميات" قد تكون أحيانا بمباركة من علم شبيهي لا حقيقي دائر على هوية جامدة غير سيالة. ويضحى الوجود هنا قضية توجيه وتحكم. ويمسي المطلوب من المرء أن يتبع "هويته الحقة" التي رسمت له سلفا. وفي هذا تحالف غريب مريب بين اللاهوت والعلم المبسط والعلاج النفسي والحتمية الاجتماعية والتاريخية يفضي إلى الإيمان بخرافة "الهوية الحقة".
ويعارض المؤلف هذه الفكرة باستحضار نماذج وأمثلة عن هويات مبدلّة. إذ كم من واحد اكتشف أن هويته الحقة المزعومة إنما كانت هي هوية زائفة، على نحو ما يحدث في عمليات تبديل الدين والجنس والعوائد والمذاهب والمعتقدات... ومما طم الوادي على القرى أنه تم تسييس هذا المنطق الهوياتي الأعرج بما أمسى يسمى "سياسة الهوية". وجواب المؤلف عن هذا التحدي: كلا؛ ما كنا كيانات -معشر البشر- سياسية تحددنا هويات. هذه تقسيمات جبرية استبدادية توتاليتارية لا يمكن أن ندعها تحدد لنا ما نحن وكيف نكون، وأن تحتوينا فيها كل الاحتواء، فلا تترك لنا مما نريد أن نكونه شيئا.
جراحات
في سياسة الهُوية، التي تنزع إلى إلغاء الخيار الحر، تعد المعاناة هي الأولى، وتعتبر أمرا لا ينمحي. ومن هنا ارتباط الهوية بالجرح: الهوية المنجرحة هي التي أمست تحدد من أنا ومن أكون. والنتيجة هي تحول الأنا الهوياتي إلى جلاد جديد يجلد الجلادين القدامى. أكثر من هذا، تسعى الهوية الجديدة، وقد حملت ندوب جراح الماضي، إلى حشر الآخرين في هويات مصطنعة وتسعى للتسلط عليها كل التسلط: هو ذا الضحية الذي يستحيل جلادا. والمفارقة هنا أنه إذا ما هو التأم الجرح ضعفت الهوية، فلا بد إذن من نكء الجرح من جديد حتى تبقى الهوية موشومة في الذاكرة العميقة. فلا سبيل إلى الحفاظ على الهوية اللهم إلا باستدامة ذكرى الجرح: العصاب والأسى. والحال أن من شأن امرئ يحدد نفسه بالألم وبالجرح أن يقيم دوما في مقام "الضحية"؛ حيث كل "مس" بالشخص، واقع أو محتمل، يُتصور على أنه نفي للشخص وقهر من شأنه أن يُعلِم عن رغبة في الاجتثاث ونزعة إلى الإبادة. هو ذا ما يشكل هوية الضحية. ولئن كانت تجارب أمريكية قد لجأت إلى خلق ما يسمى "فضاءات آمنة" لا يشعر فيها المرء بأي جرح في هويته، فإن المؤلف يرى أنه كلما زاد "الأمن الجماعاتي" على الهوية ضاع الفرد، وأنه بدل أن تحمي هذه الفضاءات الآمنة الأفراد من العدوان، فإنها تجعل العقول تجف، وتلغي الأرواح، وتهدد الأجساد. وذاك هو ما يسميه المؤلف باسم "استبدادية الديمقراطية" التي تنشر الانقسامات الهوياتية والعداء المتبادل باعتبارها هي الحكامة الجيدة.
رقابات
قد يذهب البعض إلى أن الفضاء المؤمَّن الوحيد للتعبير عن الهويات السياسية هو ممارسة الرقابة على كل ما من شأنه أن يهدد الهوية. ودعاة الرقابة هؤلاء يدعون أنهم يتكلمون باسم الآخرين، مهما أنكروا هم ذلك، معتبرين أن الآخرين من "أمثالهم"، وذلك من دون أن يملكوا حجة على ذلك ولا داع إليه. وعلى هذا النحو يتم ادعاء السيادة على كلام جماعي وقد تم الاستحواذ عليه والاستئثار به: يقررون ما الذي ينبغي أن يُتحدث عنه، وحول ماذا، وكيف، ولماذا، ومتى... ومن ينبغي له أن يتكلم، ومن ينبغي له أن يسكت. وهكذا تنكشف آلة الرقابة السياسية، فلا يتم فقط الحفاظ على النظام السياسي السائد بدعواته إلى الإحراق والإتلاف والحظر والمنع، وإنمايتم تعزيز الهويات المنجرحة التي من مصلحتها ألا تضع حدا لما يؤسسها.
على سبيل الختم
يختم المؤلف كتابه بما يشبه الإفضاء والإسرار: أنا لا أتحدث باسم أي كان، بل لا أتحدث حتى باسمي. ذلك أن حياتي ما كانت على نمط واحد -هوية متجانسة لا سوية فيها- وإنما انصبغت حياتي بلقاءات وأحداث وأوضاع وظروف، وأنا لست أعد حياتي هذه أبدا، وعلى خلاف أصحاب منطق الهوية، "مصيرا" أو "ثمرة". لا توجد ههنا هوية ثابتة جامدة نهائية، كل هوية تكون سيالة بدالة ذائبة. ذلك أنه لو أن أمرا أصاب أعصابنا ومس بها، لحول شخصيتنا من "هوية" إلى "هوية" أخرى. إذ يمكن للإنسان أن يتطور في حياته أطوارا.
والحال أنَّ الخوف من التطور بأطوار هو بالذات الذي يؤدي إلى الانكفاء على ماضي معطى سلفا، وإلى القول بإصرار: "هكذا أنا!" أو "هكذا خلقت!" و"هكذا هي أسرتي!" و"نحن لا نتصرف على هذا النحو!" و"هذه طرقنا في الفعل!" و"حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا!" ـ هو ذا منطق الهوية القبلية. وجواب المؤلف على هذه المنطق: كلا؛ ما كان "الماضي" و"المعطى" و"المسبق" ضمانة لي، وهم لا يتحكمون في. ولا ينبغي أن نترك أهل السياسة يلعبون على هذه الحبال. وصلتي بالسياسة سوف تنجلي دوما على ضوء ما أريد أن أفعله بنفسي. ولا بد من كسر الأسوار، والدفاع عن مبادئ أقل خضوعا إلى الرقابة وأقل ميلا إلى التحكم.
أكثر من هذا، كل عمليات صنع الهوية -التماهي أو التهاوي- تبقى جزئية وغير تامة ومتعددة وقابلة للمراجعة، وهي غير محددة للمرء التحديد النهائي ولا ذات مرجعية ثابتة. هذا هو التصور الذي لا يتحقق عنه الضرر، وهو تصور ضد الهويات الشاملة الكلية. على أن هذا لا يمنع المؤلف من إعلان تحفظه على منطق التنويع والتهجين العابر للعرقيات الذي بدأت تسلكه بعض الدول الغربية؛ وذلك لأنه لا يفلح دائما في تبديد مخاطر سياسة الهوية، بحكم أنه غالبا ما لا يقدر على مقاومة هيمنة المنطق الهوياتي الذي له سلطان قوي وملك عضد عظيم؛ وبالتالي فإنه بالضد يعمل -وقد امتزج مع انتشار التقنيات الوسائطية- على تعزيز الهوية أكثر مما يعمل على إضعاف حدتها. ولهذه الحيثية، لا بد من التخفيف من سورة التسييس، بل لا بد من الخروج عن أسوار المدينة المغلقة.
وينهي المؤلف معركته ضد "سياسة الهوية" بالحديث عن أهمية الفن بوصفه مفككا للهويات الصلبة؛ ذلك أنه عوض أن تعيدنا الأعمال الفنية إلى الماضي، وأن تجعلنا ننغلق في الهوية، فإنها تقترح علينا تجريب طرق تفكير وإحساس من شأنها أن تكون عابرة للهويات، ومقوضة للتصلبات، ومذكرة بهشاشة كل هوية قشفة... ومتمردة على كل رقابة ضيقة العطن.
-----------------------
تفاصيل الكتاب :
- العنوان: "دكتاتورية الهويات".
- المؤلف: لوران ديبروي.
- الناشر: جاليمار، بالفرنسية، 2019م.