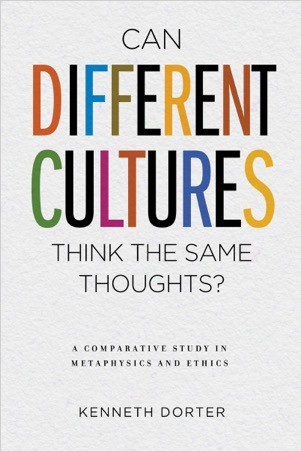تأليف كنيث دورتر
عرض: محمد الشيخ
دراسة مقارنة في الميتافيزيقا والأخلاق
كان الفيلسوف الألماني شوبنهاور قد نَظَر في أمر الصلة بين بني البشر، من حيث حفظ المسافة المثالية بينهم بين التقارب المفرِط والتباعد المفرّط؛ فما كان منه إلا شبههم بحيوانات الشيهم ـ تلك التي ذات صبيحة باردة، إذ تضامت إلى بعضها البعض طلبا للدفء أدمت بعضها البعض بمشاوكها، ثم ما لبثت أن ابتعدت عن بعضها، إلا أنه سرعان ما عاودها الإحساس بالبرد إياه، فكان أن آثرت الالتصاق من جديد، وكان أن عاودها الألم عينه. وهكذا ظلت على هذه الحال من القرب المفرط والبعد المفرط إلى أن عثرت على المسافة الوسط، فكان أن لزمتها.
وكان قد تدبَّر الحكيم الإباضي أبو عبد الله بن بكر في شأن تآلف الناس في زمانه وتخالفهم، وتقاربهم وتباعدهم، فقال: "الناس أشبه شيء بالتيوس: إِنْ اجتمعوا تناطحوا، وإِنْ افترقوا تصايحوا".
وهكذا نجد الفكرة هي هي، وإن اختلفت العبارة والاستعارة، رغم أن الثقافة التي استُلت منها الأمثولة الأولى بوذية، والثقافة التي استفيدت منها الأمثولة الأخرى أمازيغية إسلامية. وتسمى هذه الظاهرة باسم "توارد الأفكار". لكن كيف تتوارد الأفكار في الثقافات المختلفة؟ هو ذا ما يحاول هذا الكتاب أن ينظر فيه.
منذ البدء، يعلن المؤلف أن مطلب الكتاب يتمثل في أمرين:
أولا؛ استكشاف مسائل في الميتافيزيقيات [الماورائيات] والإتيقيات [الأخلاقيات]، بما في ذلك مسألة كيف يمكن للماورائيات أن تؤسس للأخلاقيات، من خلال أعمال بعض عظماء المفكرين الذين ينحدرون من تقاليد فلسفية عتيدة ومختلفة ـ الهند والصين والغرب ـ وبالمقارنة بين كل فيلسوفين فيلسوفين من تقليدين ثقافيين مختلفين في كل فصل (نصوص زهوانغزي الحكيم الصيني صاحب مذهب الطاوية ونصوص الأوبانيشاد الهندوسية القديمة [الفصل الأول: المرئي واللامرئي]، وفكر بارمنيدس الفيلسوف الإغريقي القديم وشانكارا الحكيم الهندوسي،فضلا عن اسبينوزا الفيلسوف الهولنديالمحدث [الفصل الثاني: الظاهر والباطن]، والحكيم البوذي كزهو كسي وفلاسفة الإغريق أفلاطون وأرسطو وأفلوطين [الفصل الثالث: الميتافيزيقات والأخلاقيات]، والحكيم الطاوي الصيني لاو تسو والحكيم الإغريقي هرقليطس [الفصل الرابع: عدم التعين والفعل الخلقي]، والحكيم اليوناني سقراط والفيلسوف الصيني وانغ يانغمينغ [الفصل الخامس: الفضيلة هي المعرفة]، والحكيم كونفشيوس وأفلاطون [الفصل السادس: الوسط العدل]، وكتاب الأناشيد الهندوسية البهاغافاد جيتا والحكيم الرواقي الروماني مارقوس أورليوس [الفصل السابع: الحرب والعنف]). ويرى المؤلف أن من شأن هذه المقاربة الموضوعاتية في استكشاف موضوع ميتافيزيقي أو أخلاقي (الظاهر والباطن والفعل والفضيلة والحرب والعنف ...)، من توجهات مختلفة، أن تُقدرنا على التعرف على الحدود ـ المواصل والفواصل ـ التي لا تظهر في مقاربات أخرى.
ثانيا؛ من أمر المقاربة العابرة للثقافات أن توفر لنا إبانة إلى أي حد يمكن المضي في المقارنة بين وجهات نظر تنتسب إلى ثقافات متباينة. والحال أنه منذ أن كان رأى الفيلسوف الألماني هيجل أن ما من ثقافة إلا والشأن فيها أن تكون متفردة بالكينونة متميزة بالبينونة؛ وبالتالي لا يكون التشابه البادي بين الثقافات إلا ظاهرا، أما الاختلاف فهو الحاسم، سادت هذه النظرة سيادة تكاد تكون مطلقة. أما المؤلف فيرى، بالضد، أن التشابهات بين الثقافات عميقة، وأن التماثلات بدية؛ لكنه، تلقاء ذلك، لا يرى أن ثمة "فلسفة كونية" واحدة عابرة للثقافات، وإنما ثمة "فلسفات خاصة" لكنها عابرة للحدود الثقافية، كما لا ينكر أن ثمة خلافات جوهرية بين الفلاسفة. على أنه يؤكد على المشترك العابر للثقافات المتباينة.
المطلب الأول للكتاب
في ما يتعلق بالمطلب الأول ـ وهو استكشاف المسائل الجوهرية في الماورائيات والأخلاقيات وبيان أوجه التعالق بين المبحثين ـينتهي المؤلف ـ في الفصل الأول من الكتاب ـ إلى أنه من بين المسائل المطروحة ينهض السؤال: كيف يمكن للميتافيزيقا أن تنبع من التفكير العادي؟ وللإجابة عن هذا السؤال المشترك، يرى أن معظم فلاسفة الغرب استعملوا الحجة العقلية، والأمر نفسه حق على الفلاسفة الآسيويين. لكن وعلى خلاف أولئك، فإن هؤلاء مالوا أكثر إلى استعمال أساليب غير استدلالية. ذلك أن المفارقات ـ التي تكمن في صلب الحياة اليومية ـ تقود تفكيرنا المنطقي إلى مأزق، وتدفعنا إلى النظر في ما وراء بسيط المنطق العادي إلى شيء أكثر عمقا غير مدرك للحس العادي. والحق أن من شأن التهكم من الأوضاع المفارقة التي نجد أنفسنا فيها أن يدفعنا إلى رؤية الأمور على نحو مخالف. وهنا قد تلجأ معظم الفلسفات الغربية إلى آلية "التدليل"، بينما تلجأ العديد من الفلسفات الشرقية إلى آلية "التمثيل" (القصص والأمثال). البغية واحدة والعبارة متعددة.
ويدور الفصل الثاني على ما يعتبر عادة المسألة الرئيس في الميتافيزيقا ـ وهي مسألة الفارق بين العالم كما يبدو للحواس ـ الظاهر ـ والعالم كما يتجلى للفكر ـ الباطن ـ أي الفرق بين المظهر والمخبر. ذلك أن أصول الفلسفة الغربية تُظهر أن إدراكنا للعالم بحسبانه تعدد أفراد إنما هو إدراك خاطئ لما يقوم في الحقيقة ـ الواقع الحق ـ واحدا أحدا. وقد استعار القدماء لوصف هذه الوحدة المختفية خلف الكثرة استعارات عدة؛ كالماء (طاليس) أو الهواء (أنكسمنس)، كما عُبِّر عنه من غير استعارة باسم "اللامحدد" (أنكسمندريس) أو بتعبير "الهذية" (هذا الشيء الماثل) (بارمنيدس). وبالمثل، في أصل الفلسفة الهندية تُصوِّر الواقع الحق على أنه "الأتمان" (الشيء عينه أو العينية)الذي تخفيعنا قوة الخلق التكوثرية التوهيمية (مايا) وحدته، كما أنه اهتُدي عند الفيلسوفين الصينيين لاوتسي وزهوانغزي إلى الوحدة الأصلية التي تخطئ الحواس إدراكها فتجعل من الوحدة الكامنة كثرة متبدية. وبفحص هذا الأنموذج ـ الكاشف للوحدة خلف الكثرة ـ يتبين كيف يقود النظر في الماورائيات إلى اعتبار الأخلاقيات، وذلك من خلال ثلاثة فلاسفة ساووا بين الوحدة والخيرية. وهكذا، فإنه بالنسبة إلى اسبينوزا، تقود الميتافيزيقا (وحدة الوجود) بالضرورة إلى مسلك في الحياة إتيقي؛ بحيث تمسي غاية الحياة العيش بوفق العقل، ويمكن لهذا المسلك الخلقي أن يتحقق التحقق الأفضل إن عاش الآخرون أيضا بهداية من العقل. ذاك هو المعنى العميق للإتيقا، ولا معنى آخر سواه للحياة الأخلاقية، وإلا كانت هي حياة جهالة. وبالنسبة إلى شانكارا أيضا، فإن الجهالة ـ التي تمثلها "أنا" و"عندي" و"لي" [الذات الزائفة] ـ من شأنها أن تبدد ظلمتها المعرفة التي وحدها تحقق الذات الحقة. ذلك أن من شأننا أننا عندما نتوقف عن التنافس مع الأغيار، لا يعود يوجد داع لنا كي نتصرف التصرف غير الأخلاقي. وبهذا يتضح أنه سواء لدى الغربيين أو لدى الشرقيين، تنتهي الميتافيزيقا إلى أن تهدينا بالطبع إلى الخلق.
ويفحص الفصل الثالث فحصا أوضح الصلة بين الميتافيزيقا والأخلاق التي ظلت مسألة ظلية في الفصلين السابقين. ويذهب صاحب الكتاب إلى أن فلاسفة كزهو كسي وأفلاطون وأرسطو وأفلوطين نظروا إلى الميتافيزيقا لا بحسبانها فقط أداة قوية باعثة على الأخلاق، وإنما باعتبارها أيضا الطريق الوحيد الذي يمكن بواسطته تقدير الصلة بين الوجود والخير. فمن خلال التفكير الميتافيزيقي نقتدر على الوعي بالعقلانية الخالصة التي توجد داخل العالم المادي وجودا غير مكتمل؛ وهو الأمر الذي يمنح هذا العالم معناه، كما نصير، بالتّبَع، واعينبأن حياتنا تمسي ذات معنى أكبر وذات خلق أنبل عن طريق التفكير العاقل والسلوك المتعقل. ويظهر التفكير الميتافيزيقي كيف أنه لا يوجد تواؤم بين الواقع الجسماني والواقع العقلاني، وبمحاربة فكرة أن السعادة تكمن في المتعة الحسية والجاه والسلطان، فإن التفكير الميتافيزيقي ينسف جواذب أن نحيا على غير وفق الأخلاق.
ويتعلق الأمر في الفصل الرابع أيضا بالمقارنة بين آراء فيلسوفين ميتافيزيقيين (لاو تسي وهرقليطس)، لكن لا على طريقة السابقين الذين كانوا فلاسفة نسقيين. وههنا يُظهر المؤلف أيضا كيف أن التفكير الميتافيزيقي تترتب عنه مبادئ أخلاقية، ولا سيما مبدأ عدم التحيز، وإِنْ كان ذلك على نحو أشد رخاوة من النماذج السالفة. فحسب هذين الفيلسوفين، ما من إنسان إلا وهو خيِّر بالطبع، وذلك باعتبار مساهمته في خيرية العالم الشاملة. لكن لكي يكون المرء خيِّرا بالخلق وليس بالطبع، وبالكسب وليس بالوهب، عليه أن يعي هويته مع مبدأ"الكل" أكثر منه سويته مع مبدأ "الجزء" الذي هو الجسد. هو ذا معنى عدم التحيز الذي دندن حوله العديد من الفلاسفة.
ويبرهن الفصل الخامس على أنه ليس النظر الميتافيزيقي وحده يقودنا إلى الفضيلة، بل ويكون متطابقا معها التطابق، وإنما يمكن للتفكير العادي أن يفعل ذلك. وهكذا، نجد في التقليدين السقراطي والكونفشيوسي معا أن المعرفة ـ التي هي عندهما متطابقة مع الفضيلة، بينما يتطابق الجهل مع الرذيلة ـ تؤهلنا إلى أن نميز في كل وضع بين ما ينبغي أن نفعله ونمضي فيه قدما وبين ما لا (سقراط، وانغ يانغيمنغ).
ويعمق الفصل السادس ما ورد في سابقه، ويركز على نظرية الوسط العدل (الفضيلة وسط بين رذيلتين). وإذ لا يمكن أن نحسب الوسط بدقة متناهية، فإنه بمكن أن نقدره التقدير؛ فنلفي الفضيلة وسطا عدلا بين رذيلتين كلاهما شطط. ويشكل هذا التقدير ضربا من المعرفة لا نجد لها اسما عند أفلاطون وكونفشيوس، لكن أرسطو يسميها "الروية" التي عادة ما تترجم إلى "الحكمة العملية" و"التبصر"؛ أي ضرب من البصيرة التي تنظر في عواقب الفعل في كل وضع، والتي يمكن أن نمرن أنفسنا عليها بمحاولة تصور ما الذي على شخص خيِّر أن يختاره في ظل ظروفه.
ويركز الفصل السابع على مسألة خاصة من مسائل الأخلاقيات هي مسألة اللاعنف. ذلك أن المشترك بين الثقافات الثلاث (الغربية والهندية والصينية) أن علينا أن نحب قريبنا مثلما نحب أنفسنا؛ بما يتضمن ألا نحدث الضرر ـ العنف ـ بالأغيار. وعند بعض المذاهب، شأن الجاينية والثامرية، ما كان اللاعنف وسطا عدلا وإنما هو أمر مطلق [واجب: يا هذا،إياك أن تعنف سواك!]، وبالضد عند خصومهم، كما عند الأزتيك والنازيين والإرهابيين من كل الانتماءات، لا يعد اللاعنف فضيلة. وبالنسبة إلى أولئك الذين ينشدون اللاعنف، ويرون أن ثمة مواقف تقتضي اللجوء إلى أفعال استقواء، فإن المسألة تكمن في معرفة الوسط بين العنف والسلبية: متى يعد العنف عدم عنف؟ والجواب المباشر: عندما يمسي ضروريا. لكن متى يصير العنف ضروريا؟ هذا أمريخضع إلى الكثير من التقديرات الذاتية. وإذ يرى البعض أنه تحدث ضرورة العنف عندما يرى التفكير العقلاني الهادئ، الذي لا تثيره الأهواء، أن من الواجب الضرب بقوة، فإننا نجد العديد من الفلاسفة، من نيتشه إلى فوكو، قد ناقشوا هذا الأمر، وطرحوا مسألة التحيز وعدم التحيز: من السهل أن يقنع المرء نفسه أن واجبه يوجد حيثما تقوم مصلحته، ولا وجود لوسيلة تردعنا عن هذا الاقتناع الذاتي.
المطلب الثاني للكتاب
كانت بغية الكتاب الثانية تقرير إلى أي مدى يمكن اعتبار أن فلاسفة من ثقافات مختلفة قد قالوا بأفكار قابلة للمقاربة. والذي يقرره أن لا أحد يشك في وجود تآلفات بين الفلاسفة من مختلف التقاليد وتخالفات، على الرغم من تأكيد هيجل على أن التآلفات ظواهر ومظاهر والتخالفات بواطن وسرائر. ويظهر الكتاب أن أقرب الفلاسفة إلى بعضهم البعض في المطابقة بين الفضيلة والمعرفة كانا هما الفيلسوف اليوناني سقراط والحكيم الصيني وانغ يانغمينغ. أما باقي الفصول، فقد ظهر فيها التأثير الواضح لتباين الثقافات، لا سيما حين تعلق الأمر بالفلسفة الهندية بالقياس إلى باقي فلسفات العالم. وهكذا وجد في الأبانيشاد ولدى شانكارا وفي البهاغافاد جيتا استعمال شديد للغة الدينية أكثر مما وجد عند زوانغزي وغيره من حكماء الصين والغرب على حد السواء. وكذلك لم يعرف الفلاسفة الغربيون ـ بارمنيدس واسبينوزا ـ فكرة تناسخ الأرواح الهندية، ولا فكرة أن بعض البشر قد يستحيل إلها. وهو ما لا يقبله الفيلسوف الرواقي الذي يرى أن الحكيم وإن تشبه بالإله فإنه لا يتأله.
وهكذا، تنجلي أطروحة الكتاب برمته في أن المؤلف لا يدعي أن مفكرين من ثقافات متباينة يفكرون في أفكار متطابقة، وإنما يرى أنهم يفكرون في أفكار متقاربة ومتقارنة ومتلائمة. وكيف للتطابق في الأفكار أن يتحقق ملأه حتى في مفكري ثقافة واحدة؟ بهذا يرى المؤلف أن استراتيجيتي زوانغزي والأوبانيشاد لإخراجنا من رؤيتنا العادية للواقع إلى رؤية غير عادية تتشابه على الرغم من اختلاف التعبير الثقافي، كما أن بارمنيدس وشانكارا واسبينوزا كلهم يرون أن تعدد العالم في التجربة العادية مرتهن بعدم ملاءمة قوانا الإدراكية، هذا بينما الواقع يشهد على الوحدة لا الكثرة. والأمر نفسه يقال عن هرقليطس ولاوتسي. فعلى الرغم من اختلاف الثقافة والأسلوب، يبقى تميز الفيلسوفين عن أسويائهما وتشابه رؤيتهما أمرا مؤكدا. ويظل التباين الأكبر قائما بين كزهو كسي وأفلاطون وأرسطو، لكنه ما كان تباينا ثقافيا، وإلا ما كان ثمة تباين بين أفلاطون وأرسطو وأفلوطين لانتمائهما إلى الثقافة نفسها! أكثر من هذا، تشبه آراء أفلوطين لا آراء أفلاطون وأرسطو من بني جلدته، وإنما آراء فيلسوف من ثقافة مختلفة: كزهو كسي الحكيم الصيني. ومهما تعددت الاختلافات، فإن الائتلافات حاصلة؛ بما جعل المؤلف يستنتج أنه مهما أقامت الثقافات تباينا واضحا في بعض اعتقاداتنا، ومهما وفرت هي الإطار المفاهيمي الذي ينبغي أن نعبر فيه عن معتقداتنا، فإنها لا تمنعنا من أن تكون لنا تجارب متقاسَمة. إذ يختلف الفلاسفة عن بني جلدتهم بطرق قدد، لكنهم يشتركون مع مفكرين من ثقافة مختلفة لربما أحيانا أكثر مما يتفقون مع ذويهم.
أخيرا، من المأسوف عليه أننا لا نجد نماذج فلسفية إسلامية في الكتاب. وهكذا، بعد أن كُتب تاريخ الفلسفة الغربية عن العرب بمعزل، ها هو تاريخ الفلسفة الشرقية يكتب أيضا عنا بمنأى، بل ها الحوار بين الفلسفتين ـ الغربية والشرقية ـ يتم عنا بمبعد. وما كان العيب في هؤلاء ولا في أولئك، وإنما العيب كامن فينا نحن الذين لم نبادر إلى أن نُظهر ما يحتويه تراثنا من درر ثمينة. ففي كل موضوع تطرق إليه المؤلف ثمة مكان لمساهمة عربية إسلامية، لكنها تنتظر أن تقدم إلى العالم التقديم الأمثل. أقطع في هذا ولا أستثني.
---------------------------------------------------------------------------------
تفاصيل الكتاب
عنوان الكتاب : هل يمكن لثقافات مختلفة أن تفكر في نفس الأفكار؟
المؤلف : كنيث دوتر
لغة الكتاب :الإنجليزية
دار النشر : مطابع جامعة نوتردام (إنديانا)
سنة النشر : 2018
عدد الصفحات : 276