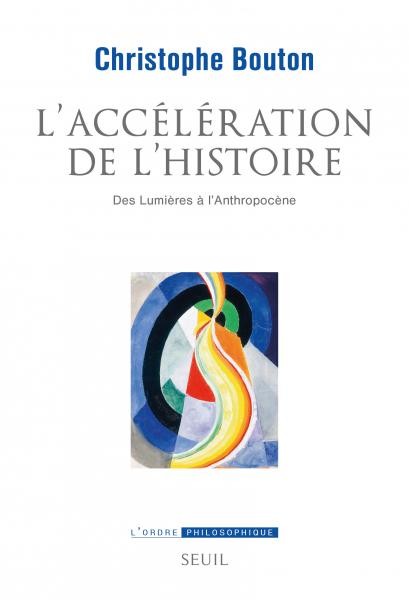كريستوف بوتون
سعيد بوكرامي
يهدف كتاب أستاذ الفلسفة كريستوف بوتون، إلى توضيح معاني التصنيف التاريخي للتسارع من خلال تمييز أبعاده السياسية والتكنولوجية والتاريخية، لهذا يضع مفاهيم التسريع والتحديث الناتجة عن الابتكار والتقدم موضع الشك متسائلا: هل هي مناسبة لوصف حداثتنا، وهل التسارع ظاهرة تاريخية حقيقية أم تعبير عن "هلوسة جماعية"؟
يتمحور الكتاب حول ثلاثة جوانب: تعريف الحداثة من خلال تسريع التاريخ لصالح الثورتين السياسية والصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ووصف هذا التسارع بأنَّه قطيعة مع الماضي وانخراط في المستقبل وأخيرًا الجمود الذي ينطوي عليه هذا التسارع الذي يكرس ديكتاتورية الحاضر. بعبارة أخرى، كلما ذهبنا بشكل أسرع، قل الوقت المتاح لدينا لتقييم موارد الماضي والنظر في المستقبل على ضوء الحاضر.
وبعيدًا عن كونها نقدًا للتسارع بشكل عام، تستند الدراسة إلى منهج سياقي يميز أنواع التسارع المختلفة بناءً على علم الاجتماع الذي تمثله الباحث (هارتموت روزا) والتحليل الفلسفي والتاريخي مع (ماركس، كوسليك، هارتوغ)، ثم ينتهي هذا التحليل المفاهيمي بمنعطف أكثر ذاتية؛ إذ يتساءل المؤلف عما إذا كانت نهاية اليوتوبيا و"التسارع الكبير" الذي يقودنا إلى عصر جديد حيث يميل الإنسان إلى إعادة العيش في الأرض التي شوهها بتأثير نشاطه على البيئة، أو "الأنثروبوسين"، تعتبر المقاربات الوحيدة الممكنة لتجربتنا مع الزمن. عندها سيكون هناك قلق جديد من الماضي وشكل جديد من اليوتوبيا التي ستكون اجتماعية وديمقراطية وجماعية بشكل ملموس.
يشبه الكاتب التسارع بقاطرة انطلقت بأقصى سرعة لكنها فقدت سائقها. يتميز تاريخ المجتمعات الغربية، منذ منتصف القرن الثامن عشر، بالتسارع المطرد الذي أصبح خارج نطاق السيطرة. وقد عالج هذه الرؤية للحداثة هارتموت روزا الذي يعتبر الممثل الأكثر شهرة لها، واليوم يتداول بقية المفكرين نظريته وعلى نطاق واسع. في العقود الأخيرة، زادت الآثار المدمرة للنشاط البشري على الكوكب بمعدل مذهل. وبذلك ظهر نوع من القلب للنظام؛ لأن الطبيعة، التي كان يُنظر إليها ذات مرة على أنها مكان للتكاثر والتكرار، أصبحت ذات طابع تاريخي، تنساق بسرعة نحو النهاية، في حين أن التاريخ، باعتباره مكان التغيير ذاته، يبدو بغرابة بطيء الحركة وأحيانا راكدًا تماما.
من خلال الربط الوثيق بين تاريخ المفاهيم والتفكير في الحداثة، يدعو كريستوف بوتون إلى إجراء تقييم نقدي لهذا "التسريع التاريخي". متسائلا عن المدافعين عنه والدلالات التي يأخذها في مختلف الاستخدامات النظرية والعملية والسياسية وهل نعيش حقًا في عصر التسارع المعمم؟ ثم أخيرا ألا ينبغي علينا بالأحرى تغيير وجهات النظر من خلال الانتباه إلى تجارب أخرى مستقاة من الزمن التاريخي، مثل الاهتمام بالماضي أو بالفكر الطوباوي، الذي يقاوم في العمق هذا الاتجاه الأساسي؟
وفي خضم أجوبته ينتقل بنا الكاتب من الثورات التي يعتبرها قاطرات للتاريخ مع (ماركس) على الخصوص إلى تلك التي تصورها (بنيامين) على أنها مكابح للطوارئ، مرورا بتصور "الطبقات الزمنية" مع (راينهارت كوسليك)، الذي يزخر بالصور المستخدمة للتفكير في تسارع التاريخ. إنها كلها أدوات مساعدة على الكشف ومن ضمنها مفهوم "تسريع التاريخ". الذي يتخذه الكاتب، موضوعا للتفكيك النقدي، يعالج من خلاله كريستوف بوتون المتخصص في فلسفة هيغل ونظريات التاريخ، وأستاذ الفلسفة في جامعة بوردو ثلاث مجموعات من الأسئلة.
أولاً، الأسئلة الدلالية: ما معنى وما هي الاستخدامات التي نعطيها لهذه الفكرة؟ ثانيًا، الأسئلة التجريبية: ما حقيقة تسارع التاريخ وما مدى وعينا به؟ ثالثًا، الأسئلة المعيارية: وفقًا لأي معايير ينتقد تسارع التاريخ وتتم إدانته، ووفقًا لأي معايير يروج له وينظر إليه على أنه حقيقة إيجابية؟ المشكلة التي تعرض عبر الفصول السبعة من الكتاب تتمحور كليا حول"نظرية التسارع".
وحسب كريستوف بوتون، هناك ثلاث افتراضات تشكل هذه النظرية: 1) الحداثة تعني تسريع التاريخ. 2) هذا الأخير بدوره يعني قطيعة مع الماضي والمستقبل 3) الحداثة تؤدي إلى "دكتاتورية الحاضر".
يعتمد كريستوف بوتون منهجا سياقيا لتحليل "النظرية النقدية للتاريخ" (ص 23). يتكون هذا المنهج من تحليل الدلالات التاريخية، ثم وضعها في سياقها التاريخي، مع شرح المعايير التي تكمن وراءها. في هذا المشروع الهام، يستعين الكاتب بنوعين من المصادر. أولاً، نصوص الفلاسفة (ماركس، نيتشه، بنيامين، هيغل)، كتاب مقالات مثل (هنري آدمز)، المؤرخ (ميشليه) والكيميائي وعالم المناخ (بول كروتزن) هؤلاء جميعهم يدعمون طريقة تفكيره في نظرية تسريع التاريخ. ثانيًا، يستعين الكاتب بمجموعة من النصوص النظرية النابعة أساسًا من الفلسفة والعلوم الاجتماعية التي تحاول أن تضع تصورا لتسارع التاريخ. يجد القارئ في هذه المجموعة الثانية أطروحات راينهارت كوسليك، هارتموت روزا، فرانسوا هارتوغ، كاثرين لاريير، بيير نورا، إرنست بلوخ، ديبيش تشاكرابارتي، على سبيل المثال لا الحصر ويعتبرون المؤلفين الرئيسيين الذين ناقش الكاتب أفكارهم.
الكتاب منظم في ثلاث فترات زمنية مميزة. يبحث الفصلان الأول والثاني في كيفية ترسيخ تسارع التاريخ في صميم الحداثة. بعد ذلك، ينتقل الفصل الثالث إلى فحص نقدي لـ "ديكتاتورية الحاضر". وأخيرًا، تحلل الفصول من الرابع إلى السابع ثلاثة أنظمة تاريخية تتعايش مع النظام الحالي للتاريخانية التي تهيمن على عصرنا، ويمكن تلخيص مبادئها من خلال التركيز على المدى القصير. وبالتالي، فإن هذه الأنظمة الثلاثة للتاريخانية هي طرق بديلة للاستقرار في الزمن التاريخي، مما يبطل أي اختزالية لنظام واحد للتاريخية، مهما كان مهيمناً. هذه الأنظمة الثلاثة للتاريخانية هي الانشغال بالماضي، وطوباوية الوقت الحر والأنثروبوسين.
في نهاية تحليله النقدي، يتوصل كريستوف بوتون إلى اقتراح نظري مبتكر، محدثا قطيعة مع "الوجود الكلي في الحاضر" لفرانسوا هارتوغ و"دوامة التسارع" عند هارتموت روزا. وقبل كل شيء، يؤكد على "تعدد أشكال" الحداثة، "بمعنى تعددية الفترات الزمنية مع إيقاعات سريعة مختلفة إلى حد ما، ومقاييس زمنية مختلفة، ومنعطفات مختلفة بين الماضي والحاضر والمستقبل" (ص 365) . كريستوف بوتون يستوحي فكرته هنا من برناديت بنسوود-فانسنت، ولكن أيضًا من "الطبقات الزمنية" لرينهارت كوسليك، وكذلك من نموذجه "التزامن غير المعاصر". يسمح الاقتراح النظري لكريستوف بوتون أيضًا بالقطع مع المعادلة بين التسارع ونهاية السياسة، من خلال إعادة فتح الفضاء الزمني للعديد من المحددات الزمانية، وبذلك يقتحم مجال السياسة.
إذا عدنا إلى الفصل الأول، فسنجده يقوم بحفريات عن "تسريع التاريخ" الذي تميز بثلاث مراحل مختلفة. الأول سياسي ويركز على الفترة المحورية التي يسميها راينهارت كوسليك "ساتيلزيت"، وتبدأ من خمسينيات القرن الثامن عشر إلى خمسينيات القرن التاسع عشر، والتي تتمحور حول الثورة الفرنسية. أما المرحلة الثانية فهي تقنية وتشير إلى الثورة الصناعية والتغييرات التي أحدثتها. أخيرًا، المرحلة الثالثة التي سلط عليها الضوء ويطلق عليها بمرحلة الأخرويات، وقد روجت مفهوم التسارع التاريخي كتوقع لنهاية الزمان ووسيلة لتحقيق الخلاص.
يفحص الفصل الثاني المعايير المعيارية المستخدمة في القرنين التاسع عشر والعشرين لانتقاد تسارع التاريخ. في القرن التاسع عشر، تبلورت هذه الفئة واندمجت مع فئة التقدم لدرجة أن الاثنين أصبحا لا ينفصلان عن بعضهما. يرسم كريستوف بوتون صورة للانتقادات الموجهة ضد تسارع التاريخ ومنها: فقدان الثقافة، وفقدان السيطرة، وفقدان المعنى، والمخاطر المتزايدة والقصور الذاتي في الحركة الظاهرة، وبذلك يحدد النقاط البارزة في هذه الانتقادات. كما ينتقد المؤلف أطروحة "التسارع الشامل للتغيير الاجتماعي" التي دافع عنها هارتموت روزا. إن الحديث عن تسارع التاريخ يجانب الصواب؛ لأنه تصنيف يجعل من الممكن وصف ديناميكيات معينة للحداثة دون أن تكون عاملاً مستقلاً وفعّالاً، ومقابل هذا التجريد، يقترح بوتون اتباع "المنهج السياقي" لفهم تعددية الأزمنة غير الخطية والمتشابكة للفاعلين التاريخيين والاجتماعيين (ص 111).
يُعبر كريستوف بوتون في الفصل الثالث عن الانشغال نفسه، عندما يفحص نظام تاريخانية الحاضر لفرانسوا هارتوغ منتقدا تصوره للتاريخانية، باعتبارها فئة شاملة تضم العديد من الظواهر المتنوعة والمتناقضة بحيث لا يمكن مقاربتها كليا. لذلك يقترح المؤلف إبراز الفروق الدقيقة لراهنية عصرنا من أجل الأخذ بعين الاعتبار تجارب الأزمنة الأخرى. في هذا السياق يتتبع الكاتب نموذج راينهارت كوسيليك لـ "الطبقات الزمنية" و"التزامن غير المعاصر".
وعلى الرغم من أن تزامنية الحقائق التاريخية والاجتماعية، إلا أنها تتعلق بمواعيد زمنية مختلفة وليس لها أصول معاصرة، مما يؤدي إلى ظهور اختلافات في الخبرة بين الأجيال، وهذا يؤلف عالمًا مكونًا من عدة طبقات من الزمن. في الفصل الرابع، يحاول كريستوف بوتون تحديدًا إظهار "تعدد الصيغ الزمنية للتاريخ" والحديث هنا عن الاهتمام بالماضي الموجود دائمًا في نظام التاريخ الحديث. ولتوضيح ذلك يستند الكاتب إلى ثلاثة مؤلفين: نيتشه وماركس وبنيامين. وفقًا لأساليبهم المختلفة، بالنسبة لهؤلاء المفكرين الثلاثة الرئيسيين، يظل التاريخ هو معلم الحياة والفعل ولذلك، وحسب رأي كريستوف بوتون فإن أطروحة الانحلال الحديث للتاريخ التي دافع عنها راينهارت كوسليك تستحق أن توضح بقوة.
يكرس المؤلف في الفصول الخامس والسادس والسابع معارِفَ وأفكارًا لفهم الأنظمة التاريخانية التي تتعايش مع الحاضر في عصرنا الحالي. في الفصل الخامس، يحاول كريستوف بوتون أن يُبرز، بناءً على معطى وقت الفراغ، أن "الاهتمام بالمستقبل مكن من مقاومة استبداد الحاضر" (ص 205). في هذا السياق ينتقد أطروحة "كسوف اليوتوبيا" لدى (إنزو ترافيرسو) التي يتشاطرها معه هارتموت روزا وأكسل هونيث: كان من الممكن أن يؤدي تسارع التاريخ إلى تفكك واستنفاد "الطاقات الطوباوية" (ص. 205). يطور كريستوف بوتون فكرة يوتوبيا وقت الفراغ معتبرا أنها تمثل "شكلاً منشقًّا عن النظام التاريخي للتاريخانية الحديثة: لأن مستقبلا آخر لا يلتزم بالعقيدة الحداثية للتقدم والسرعة" (ص 245)، بل يعتبر رد فعل للتسارع التكنولوجي.
أما الفصلان الأخيران من الكتاب فقد خصصهما الكاتب لتأثيرات الأنثروبوسين في مجال الأنظمة التاريخانية. وتتمثل حداثتها الرئيسية، حسب أطروحة ديبيش تشاكرابارتي، في أنها جعلت الانقسام بين تاريخ البشرية وتاريخ الطبيعة يتلاشى ويختفي. ويكمن أيضًا في نظريات القيامة ونهاية العالم التي يسميها "الأخرويات المعكوسة" (ص 301) حيث يُخشى التسارع، ولا سيما "التسارع الكبير" منذ عام 1945 والذي يتمثل في عدد كبير من المنحنيات المتزايدة، على عكس الخلاص المأمول في نهاية العالم العقائدي، ونهاية العالم البيئي التي تقدم تصورات كمرادف للكشف والخلاص ولكنها مرفوقة بالانهيار والمعاناة والكارثة. أخيرًا، يعدل الأنثروبوسين علاقتنا بالمستقبل. إنه بهذا المعنى درس في التواضع من خلال تذكيرنا بأن مائتي ألف عام من تاريخ الإنسان العاقل هي في غاية الضآلة مقارنة بـ 4.5 مليار سنة من تاريخ الأرض. على العكس من ذلك، فإن الأنثروبوسين يوسع "فئة الجدوى من تاريخ الطبيعة"، أي أن الفعل البشري الواعي أصبح حاسمًا من أجل مستقبل الطبيعة. ويتضح جليا من خلال وجهات نظر الهندسة الجيولوجية، التي جسدها على سبيل المثال بول كروتزن وانتقدها المؤلف أيضا.
باختصار، لا يمكن إنكار مميزات الكتاب: الوضوح الديداكتيكي، ودقة التحليل المفاهيمي الذي يوضح تصورات معرفية ومعيارية تبدو في غاية الأهمية، كما يبرع الكاتب في الربط بين أعمال ونصوص ومفاهيم منفصلة لمفكرين سابقين، ليصوغها في مزيج دقيق من المقترحات النظرية القوية دون أن ينسى سبره للفروق الدقيقة وانفتاحه على الأعمال المستقبلية الواعدة، كما يأخذ بعين الاعتبار القضايا السياسية الساخنة الراهنة . يمكن القول إن كتاب " تسريع التاريخ من التنوير إلى الأنثروبوسين" يتوفر على الكثير من الأسباب التي تجعل منه علامة فارقة في معالجة قضية التاريخانية خصوصا في مجال العلوم الاجتماعية.
تفاصيل الكتاب:
الكتاب: تسريع التاريخ من التنوير إلى الأنثروبوسين
المؤلف: كريستوف بوتون
الناشر: دار سويْ. باريس. فرنسا.
سنة النشر: 2022
عدد الصفحات: 416 ص
اللغة: الفرنسية