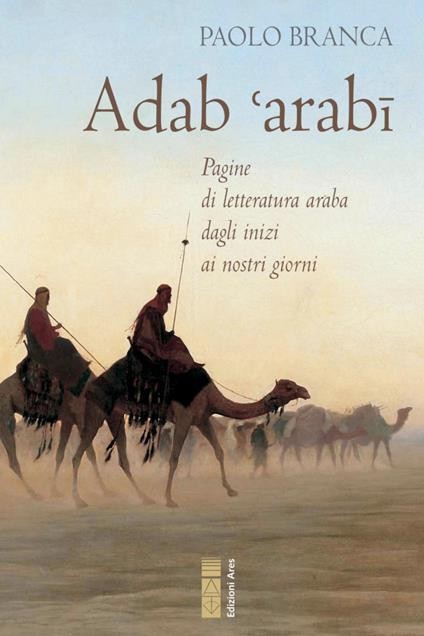باولو برانْكا
عزالدين عناية
أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا
الكتاب هو محاولة تأريخ للفكر العربي من العصور الأولى إلى التاريخ الراهن. وهو مسعى لإعطاء بسطة عامة عن فحوى الفكر العربي في هذا الحيِّز الزمني اللغوي المترامي للدارس الإيطالي المعني بدراسة الإنتاجات العربية. ولعلّ أهمية الكتاب تكمن في التطلّع إلى سدّ ثغرة أمام قلّة الأبحاث والدراسات التي تقدّم بسطة بانورامية عن الفكر العربي في اللسان الإيطالي. الكتاب منجَز من قِبل مؤلف إيطالي يشتغل في مجال التدريس الجامعي، وعلى دراية موسعة بالثقافة العربية، وهو على صلة قريبة بحاجة الساحة الأكاديمية الإيطالية، تأتّت بفعل اشتغاله على مدى عقود في مجال التدريس والبحث.
صحيح هناك أعمال إبداعية عربية في الفلسفة والدين والتصوف والشعر والرواية والمسرح مترجمة إلى الإيطالية، ولكنها لا تفي بالغرض في إعطاء نظرة عامة عن الفكر العربي سواء من زاوية تاريخية أو تحليلية أو نقدية. فجلّ الأعمال الأكاديمية أو غير الأكاديمية المنشورة هي غالبا ما تغطّي مواضيع حصرية خاصة بكتاب أو بمجالات بحثية محدّدة. في هذا المؤلَّف وزّع الكاتب عمله على عشرة محاور غطّت انشغالات الكتاب، وجاءت معنونة على النحو الآتي: الفترة القديمة؛ ظهور الإسلام وعصور الازدهار؛ الفترة العباسية في بغداد؛ حقبة الانحطاط؛ الفترة الحديثة والمعاصرة؛ الفكر الحديث والمعاصر؛ بلد كبير وكاتب كبير؛ أدبيات الإسلام السياسي؛ الفكر العربي المعاصر؛ خاتمة.
في مطلع الكتاب، يشير المؤلف إلى إشكالية الكتابة عن الفكر العربي، بفعل الامتداد الهائل على مستوى تاريخي وعلى مستوى جغرافي؛ لكن ذلك يمكن تخطيه بحسب رأي الكاتب من خلال التركيز على الجوانب المشتركة بين الجهات والمرجعية الكبرى لهذا الفكر. حاول المؤلف الانطلاق من التشكلات البدائية للفكر العربي مع الفترة الجاهلية، سواء الواردة منها في الشعر أو النثر، وقد خصص لذلك فصلاً على حدة بعنوان "الفترة القديمة". استعرض من خلاله قصائد بعض شعراء الجاهلية مثل امرئ القيس، وعمر بن كلثوم، وعنترة بن شداد، بتحليل مجموعة من القصائد المترجَمة إلى الإيطالية. لكن الملاحظ ارتهان الكاتب في دراسة الفكر العربي في هذه الفترة إلى النصوص المقدسة الكتابية الثلاثة (التوراة والإنجيل والقرآن) من حيث تفهّم المواضيع والقضايا التي تطرق إليها العرب الأوائل في أشعارهم. وهو لا يخصّص لكل مساهم دراسة على حدة؛ بل يحاول التطرق إلى ملامح الموضوع الواحد مثل "الموت"، أو "الحياة"، أو "الغزل"، أو "الثأر"، عبر ما يصوره أدباء الجاهلية وشعراؤهم، والنظر في أبعاد ذلك من خلال النصوص المُقدّسة التي شكلت لديه مرجعية عليا لمخيال الجاهلي.
يتغير هذا المنهج نوعًا ما عندما يعالج باولو برانكا الفترة الكلاسيكية للفكر العربي، سيما إبّان الحقبتين الأموية والعباسية، ليغدو مخيال الأديب أو الشاعر أو الفيلسوف العربي مسكوناً بالقيم المستوحاة من الدين الجديد، الإسلام. في الأثناء يسعى الكاتب إلى استعراض جملة من نصوص مشاهير تلك الفترة، ويحاول القيام بتحليلها واستنطاق مضامينها. فيستخلص برانكا الجانب الفكري في مقول الكاتب العربي في تلك الفترة مبرزا هويته المعرفية المستقلة عن هويته الدينية.
ينطلق المؤلّف من تحديد المشاغل الجوهرية للكاتب العربي في تلك الفترة الكلاسيكية من خلال التطرق بالخصوص إلى موضوعيْ الحياة والموت، ثم ينزاح باتجاه معالجة موضوع "الأدب الصوفي"، الشعري والنثري، بوصفه مكوِّنا أساسياً من مكونات الفكر العربي الكلاسيكي وفق منظوره. يأتي على ذكر ثلّة من المتصوفة وتحليل مجموعة من أعمالهم مبرزاً عمقها الروحي وانفتاحها على "ثيمة" الإيمان المنفتحة على التجارب الروحية الكتابية وغير الكتابية. يُعرّج صاحب الكتاب عقب ذلك على ما يطلق عليه "حقبة الانحطاط" التي سبقت وأعقبت لديه الفترة الأندلسية، التي طبعت الفكر العربي بتغيّر جذري. وفي الأثناء يولي الكاتب كتاب "ألف ليلة وليلة" عناية بوصفه تراثاً مغايرا يُعرب عن تراجع المواضيع "المطلَقة" أو "المفارقة"، كما يسميها، في الفكر العربي، لتفسح المجال إلى المواضيع المغرَقة في "الدنيوية". والواقع أنَّ هذا المبحث قد أتى مفرَطاً في الإيجاز ولم يتناول الأعمال الفكرية بما يكفي، سواء منها في الفترة الأندلسية أو التي سبقتها أو تلتها، واقتصر المؤلف على نماذج سريعة لم تستوفِ ما يطلق عليه "حقبة الانحطاط".
في الفصول الثلاثة: الخامس والسادس والسابع، تناول الفكر العربي الحديث والمعاصر، واستعرض كيفية تشكل هوية الفكر العربي الحديث بالتواصل مع الغرب، ومحاولات إدخال روح جديدة على الكتابات العربية من خلال التطرق إلى لحظات ميلاد الفكر الحديث والنقد، والجدل الذي ثار في الثقافة العربية الحديثة بين تياريْ المحافظة والتجديد، حتى اتخذت الثقافة العربية هويتها الحالية. وأما الفصل الثامن، فهو لم يتجاوز 12 صفحة، فقد أعدّه كاتب آخر باولو غونزاغا، وقد تعلّق أساسا بالأدبيات الإسلاموية. بدا الفصل كأنه مقحَم. وفي الفصل التاسع والأخير من الكتاب، المعنون بـ "الفكر العربي المعاصر"، يستعين الكاتب بمجموعة من الدارسين المتخصصين في آداب البلدان العربية، كل بحسب مجاله واهتمامه، غطّت إسهاماتهم الجزائر والأردن والعراق ولبنان وليبيا والمغرب والسودان وتونس، واختار من جانبه إتمام الصفحات المخصّصة لفلسطين وسوريا والمملكة العربية السعودية واليمن، ليقدّم كلّ كاتب مدخلا عاما عن تطور الكتابة الفكرية وتحولاتها مع التعريج على أهم الأسماء وانشغالاتها.
وفي مجال العرض البانورامي للفكر العربي، تبدو الأعمال الإيطالية الصادرة في الموضوع قليلة، ولذلك تأتي مجمل الكتب المعتمَدة في إيطاليا في عرض الفكر العربي القديم منه والحديث متأتية من لغات أجنبية أو مترجَمة، مثل كتب محمد مصطفى بدوي، أو كذلك كتابات أندريه ميكيل وروجر آلين وآخرين. ومن هذا الجانب يمثّل كتاب باولو برانكا إضافة مُهمّة نظرًا للنقص الفادح الموجود في الساحة الثقافية. والمُلاحظ بشكل عام أنّ أغلب الدارسين، سواءٌ منهم المبتدؤون أو المتقدّمون، يعوّلون كثيرا في الاطلاع على الأعمال الفكرية العربية على ما يصدر باللسان الإيطالي. ومن هذا الباب لا تفوز الكتابات العربية المؤلفة باللسان العربي بحضور في أوساط الدارسين بشكل عام، بفعل وهن عسر التواصل المباشر مع تلك المراجِع على كثير من الدارسين.
فممّا لا يخفى على الدارس المتابع، أنّ انتشار تدريس اللغة العربية والدراسات العربية يسير بشكل متطور في كثير من الجامعات الإيطالية للعلوم الإنسانية، ولا يوازيه توفر قدرة لدى المدرّسين الجامعيين أو الدارسين الطلاب، بما يسمح للغوص المباشر في الأعمال العربية، وهو ما يجعل التعويل على الأعمال المؤلفة باللغة الإيطالية حاسما في المجال. فما نجده بشكل عام هو دراسات وأبحاث مخصَّصة لكتّاب أو كاتبات عرب، في حين ما تفتقر له الساحة بحقّ هو الدراسات الشاملة والعامة التي تستهدف تقديم عروض موسعة للفكر العربي. ومن هذا الجانب تبدو هذه المبادرة الجامعة لباولو برانكا ذات نفع وجدوى، خصوصًا وأن الكِتاب لا ينحصر بمنطقة مُعّينة أو بفترة محدّدة، وإنما يسعى إلى عرض شامل في المجال يوفر نظرة بانورامية.
كان المنهج المعتمد باستحضار نصوص معرفية تعود إلى فترات محدّدة، وإرفاقها بتحليل ونقد موفّقًا إلى حدّ ما في إلقاء الضوء على شخصيات وأساليب كتابية راجت في الثقافة العربية. وإن جاء الجانب التحليلي مختصرا أحيانا ولا يفي بالغرض، فقد استطاع المؤلف تقديم إشارات وتنبيهات على قضايا متنوعة.
يُعتبر باولو برانكا (من مواليد 1957 بمدينة ميلانو) من الوجوه الثقافية البارزة في إيطاليا، من حيث الاشتغال على الثقافة العربية واللغة العربية؛ فمنذ انضمامه كباحث في الدراسات العربية إلى الجامعة الكاثوليكية "القلب المقدس" في ميلانو، وإلى حين ترقّيه في المنصب حتى غدا رئيس قسم الدراسات العربية في الجامعة، انشغل باولو برانكو بحقلين أساسيين: الدراسات الإسلامية والدراسات الفكرية. وهو في الوقت الحالي أستاذ اللغة العربية والإسلاميات في الجامعة المذكورة. بات الرجل مرجِعًا في الشأن في الأوساط الأكاديمية والإعلامية في إيطاليا، لا سيما فيما يتعلق بالإسلام في إيطاليا وبقضايا المهاجرين المسلمين، ناهيك عن متابعته موضوع الحوار بوجهيه الديني والحضاري مع العالم الإسلامي. في البدايات الأولى، تمحور اهتمام برانكا حول الدراسات الدينية ذات الطابع السياسي، ثم انعطف في مرحلة لاحقة نحو الدراسات الأدبية، وقد أنجز في الشأن جملة من الأبحاث والمؤلفات المرجعية في الثقافة الإيطالية، ونظراً لقرب الرجل من الأوساط الكَنَسية الكاثوليكية في إيطاليا، بات مرجعًا في المجال. غدا الرجل مستشارا لدى عديد من المؤسسات الرسمية والدينية في مسألة التقارب مع العالم الإسلامي وحوار الحضارات والأديان والتعامل مع المهاجرين المسلمين.
منذ سنوات تدور انشغالات باولو برانكا البحثية والكتابية بالأساس حول تحليل الظاهرة الإسلامية في الغرب، من زوايا ثقافية ودينية واتصالها بموضوع الهجرة. وهو لا يخفي توجهاته اليمينية والكَنَسية الواضحة في النظر إلى "الإسلام المهاجر"، إذ غالباً ما تَميزَ الرجل برؤية نقدية واضحة في تدخلاته الإعلامية.
تتعدّد الأعمال المنشورة التي ألّفها باولو برانكا، وآخرها عمل " الفكر العربي.. من البدايات إلى اليوم". فقد أنجز سلسلة من الأعمال ناهزت العشرين عملا، نأتي على ذكر عناوين منها: "البابا فرنسيس والحوار المسيحي الإسلامي" (2021)؛ "القرآن" (منشورات إيل مولينو، 2021)؛ "المسلمون" (منشورات إيل مولينو، 2000)؛ "مقدمة في الإسلام" (منشورات سان باولو، 1995)؛ "نحن والإسلام.. من الضيافة إلى الحوار" (منشورات إي. آم. بي، 2010). وصدر له كتاب حول الأمثال العربية بالاشتراك مع أنجيلو فيلا بعنوان: "الحياة مثل الخيار.. رحلة في الفكاهة العربية" (منشورات إي بيس، 2020).
الرجل ملمّ بالعربية بشكل تعليميّ (النحو العربي الذي يدرّسه في الدرس الجامعي يعتمد في تدريسه على الإيطالية كسائر الجامعيين الإيطاليين الآخرين)، فعلاوة على دراسته الأكاديمية التي تلقاها في إيطاليا، سبق له أن أقام طويلا في البلاد العربية خصوصا في لبنان، وهو ما يَسّر له الإلمام المقبول بالعربية والثقافة العربية، غير أن عربيته في المحادثة تبقى متأثرة بالدارجة، وهو غير مقتدر على إلقاء محاضرة أو كتابة نص بالعربية.
في كتابه الذي نعرضه لم يعتمد الكاتب بما فيه الكفاية المراجع والمصادر العربية، واقتصر على ما هو مدوَّن بالإيطالية وعلى ما هو مترجم إلى اللسان الإيطالي؛ فقد جاءت المؤلفات العربية قليلة في كتابه لا تتجاوز الخمسة أعمال، في بيبليوغرافيا لم تتجاوز الستين مرجعا. صحيح أورد الكاتب العديد من النصوص، ولكنها وردت مترجَمة ومستمَدّة من نصوص كتّاب ومترجمين آخرين. مع هذا، الكاتب على إلمام موسَّع بالثقافة العربية، وعلى دراية بالأبعاد التاريخية والسوسيولوجية للمجتمعات العربية، لكن ما يميّزه المنحى اليميني في النظر للظواهر وفي معالجة الوقائع. وهو ما جعله في كثير من الأحيان يصطفّ في منحى الدراسات المغالية، التي لا تشجّع على التقارب، ولا تنحاز إلى الحوار الحضاري؛ إذ يلمس المطّلع على مؤلفات الكاتب، لا سيما التي عالجت القضايا الدينية مركزية مفرطة.
وقد أبان المنهج التاريخي الذي اعتمده المؤلف في التأريخ للفكر العربي عن ثغرات هائلة من حيث التعجل في دراسة بعض المراحل، وعدم التعمق في خصوصيات بعض القضايا الفكرية. وبالإضافة إلى ذلك، جاء التناول للقضايا المعالَجة مصبوغا في كثير من الأحيان بهاجس السياسة والدين، وهو ما أثّر على فحوى الكتاب. لا نقدّر أن الكاتب كان موفقًا في العديد من الفصول في تناول أطوار الفكر العربي؛ فقد جاء بعضها أقرب إلى التحليل الذاتي المفتقد إلى سندات ودعائم، وهو ما أفقد الكتاب المتانة العلمية اللازمة.
للوهلة الأولى يغري الكتاب بالقراءة من حيث سلاسة العبارة ودقتها؛ إذ يميز المؤلف أسلوب كلاسيكي في الكتابة بالإيطالية. فهو بارع في استدراج القارئ من موضوع كلاسيكي إلى موضوع معاصر، مع قدرته على ربط ما هو أدبي بما هو ديني وسياسي. لكن لا يمكن القول إن الكتاب من ناحية منهجية قد التزم بالموضوع المحدّد الذي ارتأى معالجته، في القديم والحديث؛ فقد اعترت الكتاب هنات، وطغى عليه الهاجس الديني بشكل واضح في معالجة جملة من القضايا، ناهيك عن إقحام مواضيع لا نُقدّر أنها على صلة بموضوع الكتاب سوى من باب إغواء القارئ غير المختص، الباحث عن فهم متسرّع للعالم العربي والثقافة العربية بشكل عام.
من جانب آخر، جاءت الفهارس في الكتاب شحيحة جدّا، واقتصرت على جرد البيبليوغرافيا وفهرس المواد. لم يدرج الكاتب غيرها، وهي نقيصة لافتة في الكتاب. ويعلّل مؤلف الكتاب عدم توسعه في عمله بسبب رحابة الموضوع، وهو ما جعله يختصر المحاور. مع هذا لا يمكن نكران الجهد المبذول في العمل، ولا يمكن إغفال النوايا التي أرادها المؤلف من أجل تقديم نصّ ميسَّر في عرض الفكر العربي؛ بَيْد أن المنجَز لا يرتقي حسب تقديرنا ليكون مرجِعا، نظرا للثغرات التي تخللت النص.
تفاصيل الكتاب:
الكتاب: الفكر العربي: من البدايات إلى اليوم
تأليف: باولو برانْكا.
الناشر: منشورات "آريس" (ميلانو) 'باللغة الإيطالية'.
سنة النشر: 2022.
عدد الصفحات: 285 ص.