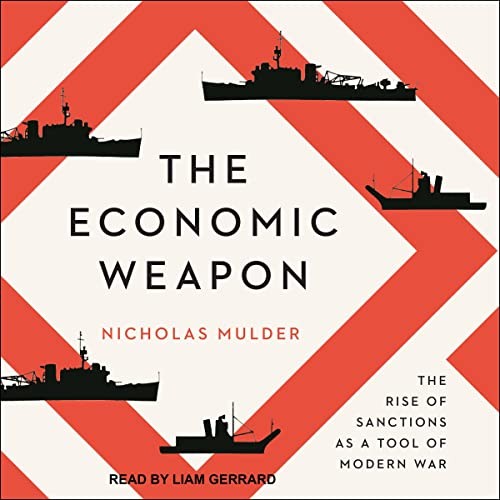نيكولاس مولادر
فينان نبيل
كاتبة وباحثة مصرية
كان صعود" العقوبات الاقتصادية" كأداة للحرب الحديثة بمثابة إشارة إلى صعود نهج "ليبرالي"مميز في الصراع العالمي. غيرت "العقوبات" الحدود بين الحرب والسلام، وأنتجت طرقا جديدة لرسم خريطة الاقتصاد العالمي والتلاعب به، وغيرت تصور الليبرالية لسياسة إجبار الدول، وغيرت مسار القانون الدولي. دار جدل شديد الخطورة منذ عام 1914 إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945، حول ما إذا كان يمكن للعقوبات الاقتصادية أن تجعل العالم آمنا. تصاعد استخدام العقوبات منذ نهاية الحرب الباردة، وتستخدم اليوم بقوة أكبر، ويكشف السلاح الاقتصادي عن نفسه كواحد من أكثر ابتكارات الليبرالية العالمية ديمومة في القرن العشرين، وأنه مفتاح لفهم التناقض والمقاربة بين الحرب والسلام. لم تكن"العقوبات الاقتصادية " تستخدم إلا في زمن الحرب من أجل عزل المجتمعات عن التبادل مع العالم الأوسع، وأصبحت الآن ممكنة الاستخدام في حالات أكثر، ويمكن تصور أنه تم وضع سياسة الحصار التجاري والمالي كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية كوقاية ضد الحرب التقليدية.
يقدم الكتاب أصل وتاريخ "العقوبات "؛ فيرجعه إلى عام 1919 لكل من المندوب البريطاني، اللورد "روبرت سيسل "، ونظيره الفرنسي، ليون بورجوا". وعلى الرغم من الخلفية المختلفة لكل منهما، اتفق كلاهما على أن "عصبة الأمم" يجب أن تزوَّد بأداة إنفاذ قوية، فقرروا نشر نفس تقنيات الضغط الاقتصادي التي استخدمتها دول المحور ضد منافسي نظام "فرساي" والدول التي سيتم تصنيفها على أنها "معتدية" مستقبلا.
ساهم الانهيار السياسي، والاقتصادي العالمي التام في الثلاثينيات، واندلاع الحرب العالمية الثانية في اعتبار العصبة "منظمة طوباية"، واستنتج الكثير آنذاك، ومنذ ذلك الحين أن معاهدات السلام كانت معيبة بشكل قاتل، وأن المنظمة الجديدة كانت أضعف من أن تحافظ على الاستقرار، وأنها تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بإخضاع مقلقي السلام؛ فكان لابد من استخدام شكل من أشكال القوة لا يمكن مقاومته ويخضع له الجميع، فتم تزويدها بنوع جديد، وقوي من الأدوات القسرية للعالم الحديث، كانت تلك الأداة هي " العزلة الاقتصادية المطلقة" للدول التي تهدد السلام.
وصف الرئيس الأمريكي "وودر ويلسون" 1919 "العزلة " بأنها شيء أروع من الحرب وأنها تعيد الدولة إلى رشدها، كما يزيل الحصار عن الأفراد كل الميول إلى القتال، ولا تكون هناك حاجة إلى استخدام القوة آنذاك، كما دعا لتطبيق هذا العلاج القاتل الصامت. إنه علاج رهيب، يفرض ضغوطا على الدولة التي يتم مقاطعتها دون الوصول إليها، ولا يمكن لأي دولة حديثة أن تقاومه. رأى ويلسون أن المقاطعة يمكن أن تشل معيشة أي أمة تجارية حديثة، والأمر لا يكمن فقط في العقوبات، ولكن في العجز عن الحصول على المواد الخام، ومنع المصانع من الإنتاج، والعجز عن الحصول على الائتمان، وعدم جدوى الأصول ونفعها. تكمن خطورة فرض العقوبات في
ضغط أكبر وهو شعور الدولة المُحاصرة بالتذبذب، والاحتقار، وإضعاف الروح المعنوية يكون أكثر حدة من العقوبات المادية؛ فقد أكد ويلسون أنه "إذا كان العقلاء يرون أن الحرب بربرية، فإن المقاطعة غير المحدودة واحدة من أكثر أدوات الحرب فظاعة".
أدرج المنتصرون في الحرب العالمية الأولى "السلاح الاقتصادي" في المادة السادسة عشر من ميثاق "عصبة الأمم"، وقاموا بتحويله من سلاح في وقت الحرب، إلى آلية تُستخدم وقت السلم، مثل الآليات المبتكرة الأخرى لعمل عصبة الأمم في مجالات الحوكمة الاقتصادية العالمية، والصحة العالمية، والعدل الدولية . يشار إلى السلاح الاقتصادي أيضا باسم "الحصار"، وقد استخدمه الحلفاء، والقوى المرتبطة بهم بقيادة إنجلترا، وفرنسا ضد الامبراطوريات الألمانية، والنمساوية، والمجرية والعثمانية، وأقاموا وزارات وطنية للحصار، ولجانا دولية لضبط تدفق السلع، والطاقة، والغذاء، والمعلومات إلى أعدائهم، وكان التأثير شديدا على أوربا الوسطى، والشرق الأوسط، وكانت حربا اقتصادية غير مسبوقة؛ حيث نتج عن الحصار موت مئات الآلاف من الجوع، والمرض، وتشريد المدنيين بشكل خطير، مما جعل "الحصار الاقتصادي" يبدو سلاحا قويا.
يزعم الكاتب أن استخدام سلاح العقوبات كان سببا في تشكيل العالم ما بين الحربين، وصياغة بنية النظام السياسي، والاقتصادي الذي نعيشه اليوم، ومؤشرا للظهور الدولي لشكل جديد من أشكال الليبرالية، ذلك الشكل الذي عمل من خلال جهاز فني، وإداري يتألف من المحامين، والدبلوماسيين، والخبراء العسكريين، وخبراء الاقتصاد. عمل هؤلاء المسؤولون في وقت الحرب، وبعدها؛ ففي الفترة التي منحت فيها الحكومات الأوروبية مواطنيها حق الاقتراع، وطالبت لهم بالرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، نظرت إلى السكان الآخرين باعتبارهم أهدافا مناسبة للضغوط القسرية، والعقوبات الاقتصادية، وتآكلت التقاليد القديمة مثل حماية المدنيين غير المقاتلين، والملكية الخاصة، والإمدادات الغذائية، وكان ذلك بمثابة تحول كبير ومعقد في النظام الدولي . يتم النظر إلى العقوبات الاقتصادية بشكل عام على أنها بديل للحرب، ولكنها في الحقيقة كانت جزءا من جوهر الحرب الشاملة بين الحربين العالميتيين.
كان الهدف الأولي من إنشاء السلاح الاقتصادي بين الحربين العالميتين، هو عدم استخدامه، وكان منشؤوه يأملون أن يكون محض تهديد للدول التي تفكر في تحدي "نظام فرساي" استنادا لاعتقاد أن الخوف من الحصار قد يمنعهم، ويكون من شأن هذا الحفاظ على السلام. لكن ماحدث في الواقع أنه تم صقل أساليب للحرب الاقتصادية، وإعادة توجيهها لتستخدم في وقت الحرب والسلام، بل وتم تطوير حصار المجتمعات البشرية ماليا وتجاريا، كأحد أشكال الحرب، بينما كان المفترض أن تكون وسيلة وقائية ضد الحرب. لاحظ معارضو فرض العقوبات الآثار المدمرة الناتجة عن الضغط على المدنيين، ولكنهم قبلوها أحيانا كبديل أفضل من الحرب.
تظهر خطورة" السلاح الاقتصادي" عندما تتم مقارنته بالأسلحة الثلاثة الرئيسة التي تم استخدامها ضد المدنيين في فترة ما بين الحربيين العالميتين، القوة الجوية، وحرب الغاز، والحصار الاقتصادي؛ فقد اتضح أن الحصار الاقتصادي كان الأشد فتكا على الاطلاق في الحرب العالمية الأولى، فقد تسبب الحصار في قتل مئات الآلاف من وفيات المدنيين، بسبب ما نتج عن العزلة الاقتصادية من جوع، ومرض في أوروبا الوسطى، ومزيد من الوفيات في المقاطعات العثمانية في الشرق الأوسط متأثرة بالحصار الانجلو – فرنسي قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لم يكن من السهل تسليط الضوء على أدلة الإدانة، لإبراز الآثار القاتلة للحصار، حتى بالنسبة لمستخدميها المباشرين، أعرب "أرنولد فورستر"، عن قلقه من أن "السلاح الاقتصادي هو السلاح الذي يسهل استخدامه بدرجة كبيرة؛ فهو يبدو أنظف أدوات الحرب، ويمكن التعامل معه من قبل الهواة بمجهود أقل بكثير، وإدراك أقل للعواقب. كانت العقوبات الاقتصادية جذابة ليس فقط بسبب قوتها المحتملة، ولكن أيضا لأنها كانت سهلة الاستخدام لمن يتعاملون معها، ولم تكن سلطتهم القسرية تدار من قمرة قيادة قاذفة قنابل، أو من مؤخرة مدفع بل من وراء مكتب من "خشب الماهوجني" .
طارد شبح العقوبات أوربا في فترة ما بين الحربين، وأدى التهديد بفرض عقوبات ضد الدول الصغيرة إلى نتائج عكسية تجاه الدول القوية بما يكفي لاعتباره تحديا للعصبة، فقد خاطرت إيطاليا الفاشية بغزو إثيوبيا عام 1935، وقطع ثلاثة أرباع دول العالم معظم علاقاته التجارية مع إيطاليا، لكن فشلت العقوبات في إلحاق الضرر بنظام"موسوليني" بالسرعة الكافية لإنقاذ أثيوبيا من الغزو والاحتلال، وكانت إيطاليا على استعداد لتحمل النقص، ورغم ذلك فقد اضطر موسوليني إلى إطلاق حملة من أجل الاكتفاء الذاتي الشامل في مواجهة العقوبات لتجاوز النقص المالي.
تركت تجربة العزلة الاقتصادية بصماتها على المجتمعات لعقود، وانتقلت آثار الجوع، والتدهور الصحي، وسوء التغذية على المجتمعات للأجيال التي لم تولد بعد؛ فقد أنجبت الأمهات الضعيفات أطفالًا متخلفين، ومتوقفين عن النمو، فضلا عما يؤدي إليه الحصار الشامل من انهيار اجتماعي. وهكذا يلقي السلاح الاقتصادي بظلال اجتماعية، واقتصادية، وبيولوجية طويلة الأمد على المجتمعات المستهدفة، لا تختلف عن التداعيات الإشعاعية.
أدرك السياسيون، والعلماء، والنسويون على وجه الخصوص ذلك خلال الحرب العظمى نفسها، وقام العديد منهم بحملات نشطة ضد استهداف المدنيين بالسلاح الاقتصادي. لعبت الحركة النسائية دورًا نشطًا في التاريخ الدولي في معارضة للعقوبات ومحاولة تخفيف قوتها إلى حد كبير. وتم وضع خطة اقتصادية ترمي إلى مساعدة الضحايا المتضررين لوجيستيا، ولكنها كانت مبادرة هشة وغير مستقرة نتيجة إعطائها الأولوية للانضباط والعقاب، وإهمال التضامن مع المتضررين، ولكن ظلت فكرة التضامن مع الدول المتضررة ذات أهمية فكان البرنامج العالمي للإقراض عام 1941 .
بذلت الأنظمة جهودا متواصلة لجعل الضغط الاقتصادي ضد المدنيين مشروعا من الناحيتين التقنية، والسياسية، وظل القانون الدولي يحاول وضع حدود اللوائح المنظمة لاستخدام القوة، والإكراه الاقتصادي، فقد استلزم السيطرة على دولة ما، التحكم فيما يقوم به مواطنوها في كل مكان في العالم. بدأ أنصار "العقوبات" في إعادة تعريف القانون الدولي لتقييد حرية الملاحة، وكذلك الحقوق التجارية المحايدة. وكان على كل دولة، وشركة، وأفراد أن يشاركوا في عزل المعتدي، فأدى ذلك إلى تغيير وضع التجارة الخاصة والاستثمار الأجنبي، وتدفقات رأس المال في الاقتصاد العالمي، وأصبحت الشركات الدولية، والتجار، والمصرفيون، والمستثمرون قلقين من العقوبات في وقت السلم، بينما كانوا يناضلون لإعادة بناء وحماية شبكاتهم العالمية في أعقاب الحرب؛ فقد رغبوا في نظام اقتصادي وقانوني خال من التدخل السياسي، وحماية أعمالهم وأصولهم من خطر المقاطعة، أو خفض قيمة العملة أو المصادرة، كما طور منشئو العقوبات في فترة ما بين الحربين آليات التحكم في الطاقة، والإدراج في القائمة السوداء، وتقنين الاستيراد والتصدير، ومصادر الممتلكات، وتجميد الأصول، وحظر التجارة، ومنع الشراء، فضلا عن الحصار المالي.
تعتمد الحرب الاقتصادية على جمع المعلومات وإنتاج المعرفة، ففي سبيل عزل بلد بأكمله عن التبادل العالمي، كان لابد من رسم خريطة للنسيج الاقتصادي الذي يربطه ببقية العالم، مما استلزم إحصاءات دقيقة، وتطوير المعرفة، وهو ما يسمى "بالسياسة البيولوجية"، أي إدارة الدولة لحياة البشر، وممتلكاتهم في ظل ظروف العولمة.
بدت العقوبات كأنها ممارسة جيدة لحفظ السلام مقارنة بالآليات التأديبية الأخرى التي فرضتها الإمبراطورية الغربية، بينما كان الحماس لها في باقي العالم محدودا، وبدأ يتسبب في مشكلات، أصبح نظام الأمن الجماعي القائم على التبادل بين العقوبات، والمعونات معروفا، كان تبرير إلحاق الأذى بالدول عن بعد للنخب الأوروبية التي اعتادت على إدارة الإمبراطوريات الاستعمارية أسهل بكثير من تبرير الحرب.
أثارت العقوبات تساؤلات عظيمة حول علاقة أوروبا بالعالم الأرحب، وعلى الرغم من كل الأحاديث النبيلة عن إنهاء الحرب بين القوى العظمى، فقد بات من الواضح في أوقات الأزمات الدبلوماسية أنها كانت تستهدف غالبا الدول الأصغر حجما.
كان لانهيار نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى أسباب عدة منها تراجع الحماس للديموقراطية، وزيادة الشيوعية الثورية، وصعود الفاشية، وصدمة الكساد الأعظم، وفشل جهود نزع السلاح. ونتيجة لعدم الاستقرار كان طبيعيا أن ينزلق العالم نحو صراع عالمي جديد.
عملت العقوبات على تسييس الاقتصاد العالمي، وتفاعل العديد من البلدان مع البيئة الاقتصادية المتدهورة من خلال إطلاق برامج التعزيز الداخلي، والاكتفاء الذاتي، وبدلا من وقف المد القومي وما يترتب عليه من خطر الحرب، عملت العقوبات على تعزيزه، فضلاً عن ديناميكيات المنافسة، والتفاوت في النمو الاقتصادي، والتقدم الصناعي من جهة، والتنافس العسكري والصراع الأيديولوجي من جهة أخرى.
لم يحتكر الإمبرياليون الأوربيون استخدام الضغط الاقتصادي، فقد كان تقليد الحظر الذي يتمحور حول الدولة والذي قد تنشأ عنه العقوبات كان له نظير من المجتمع المدني، وهو تنظيم من عدم التفاعل الاقتصادي من قبل الحركات السياسية والاجتماعية ضد الطغاة الأجانب، أو الظلم الأخلاقي. استخدم المستعمرون الأمريكيون والكويكرز البريطانيون مثل هذه التكتيكات في القرن الثامن عشر. كان عدم التفاعل المنظم كظاهرة عالمية موجودا قبل الحرب، وعرف باسم "البويكوت" ونشأ هذا المصطلح في حالة شهيرة عام 1880 حيث قامت رابطة الأراضي الأيرلندية، التي حاربت من أجل حقوق الفلاحين الذين لا يملكون أرضا، باستخدام سياسة عدم التفاعل للضغط على "تشارلز بوي كوت"، الوكيل المستبد لصاحب الأراضي الغائب، لتقديم تنازلات للمستأجرين الريفيين، وسرعان ما استخدم اسمه على نطاق واسع كاسم، وفعل، ودخل إلى اللغة الفرنسية، وبعد عام واحد كان يستخدم في الإسبانية، والإيطالية، والبرتغالية، والسويدية، والألمانية، والهولندية، بل حتى عدة لغات آسيوية. يدل الانتشار السريع للمصطلح على أن المقاطعة كانت مرتبطة بشكل مباشر بعولمة التجارة والمعلومات في أواخر القرن التاسع عشر.
أثبتت التجربة، استخدام العقوبات الاقتصادية كبديل للحروب مجرد أمل بعيد المنال، وواحدة من المخططات اليوتوبية العديدة التي تسكن الصحف، وقاعات المحاضرات .إن تاريخ العقوبات في فترة ما بين الحربين ينير الطريق لعالمنا في القرن الحادي والعشرين؛ فاليوم يترنح الاقتصاد العالمي بين الأزمات المالية، والنزعة القومية، والحروب التجارية. تعمل العقوبات على تفاقم التوترات القائمة في إطار العولمة، ومن المؤسف أن المقصود من العقوبات تعزيز الاستقرار الدولي، إلا أن العواقب السلبية غير المقصودة قد تكون مدمرة بقدر الضرر المتعمد.
تفاصيل الكتاب:
عنوان الكتاب: السلاح الاقتصادي: صعود العقوبات كأداة للحرب الحديثة
المؤلف: نيكولاس مولادر
الناشر: يالا- لندن -2022.
لغة الكتاب: الإنجليزية