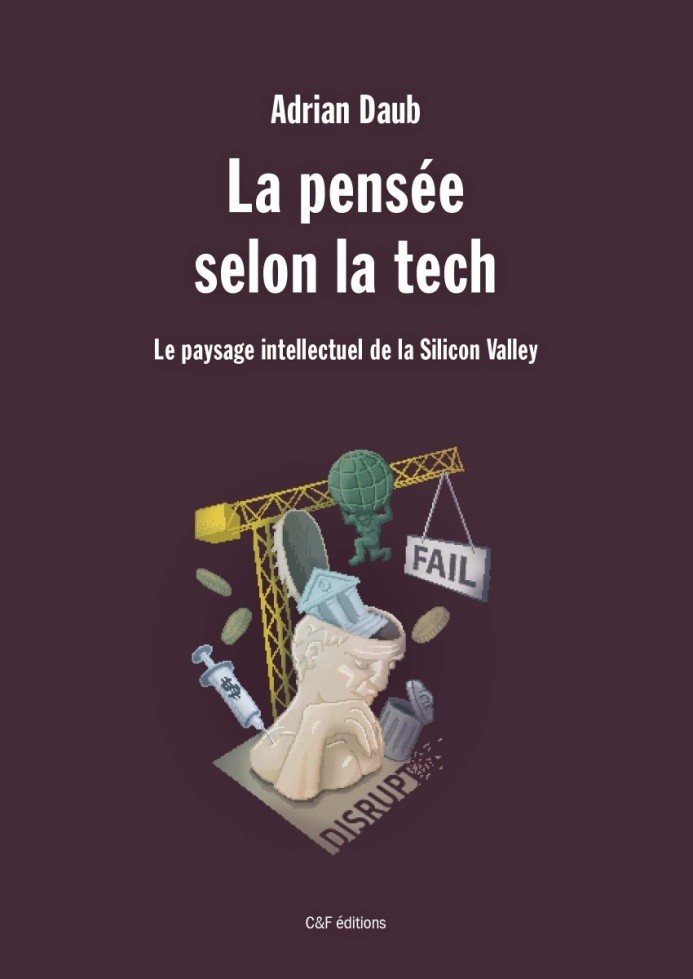أدريان دوب
سعيد بوكرامي
كيف صنع ستيف جوبز أو إيلون ماسك أو جاك دورسي أو بيتر ثيل عبقريتهم الخلاقة؟ ولماذا هيمنت أفكارهم التكنولوجية على عالم الابتكارات؟ ماذا يحدث بالضبط في وادي السيليكون؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة التي تبدو بسيطة تحتاج إلى فهم عناصر اللغة والأماكن المشتركة وشخصيات الوصاية والأفكار التي تحملها شركات التكنولوجيا أي كل ما يشكل إيديولوجيتهم المهيمنة على الحاضر والمؤثّرة على المستقبل.
يقوم المؤلف أدريان دوب باستعادة الأفكار الإبداعية والمبتكرة للتكنولوجيا، ثم يرسم لنا بانوراما عن التفكير الألمعيّ لصانعي وادي السيليكون منقباً عن جذور أفكارهم المتطورة باستمرار. يستند صاحب الكتاب إلى مقولة شهيرة ذكرها باراك أوباما في قلب وادي السيليكون، في جامعة ستانفورد، شهر أبريل 2022. قال فيها: "الآلات لا تتحكم فينا. لأنه يمكننا السيطرة عليها وإعادة بنائها". من خلال الدعوة إلى تنظيم المنصات الرقمية، التي يُنظر إليها على أنها تهديدات للديمقراطية، يتحدى الرئيس السابق للولايات المتحدة واحدًا من الأساطير الشائعة حول التقنيات الجديدة. وهذا أيضًا ما يقترحه أدريان دوب في هذا الكتاب المهم. إذ يعرض موجزا للأفكار المشتركة في عالم التكنولوجيا، ومصادر إلهامها وقبل كل شيء أوجه تناقضاتها.
يهتم الكتاب بكل ما يتصل بعالم التكنولوجيا وشركاتها ووسائل الإعلام التي تتابع وتحلل التطورات في هذا القطاع الاقتصادي الحيويّ. ولرسم صورة فكرية عن وادي السيليكون، يعتمد أدريان دوب على العديد من المصادر، في مقدمتها أعمال المؤلفين الذين أثّروا في الفاعلين التكنولوجيين، وكذلك المقالات التي نشرتها صحافة الرأي الأمريكية بالإضافة إلى العديد من الوثائق، على سبيل المثال، مواد الدورة التي درسها مارك زوكربيرغ في جامعة هارفارد وكذلك المقابلات التي أجراها المؤلف مع بعض الفاعلين. كما يقوم أدريان دوب بتحليل المؤتمرات والمقابلات مع الأشخاص المؤثرين مثل ستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة آبل ومارك زوكربيرغ مؤسس ومدير فيسبوك وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وجاك دورسي المؤسس المشارك لتويتر وبيثر تيل المؤسس المشارك لباي بال.
يقسم المؤلف كتابه إلى سبعة فصول. يتناول كل فصل أسطورة ساهمت في تأسيس التفكير التكنولوجي مثل تراجع الجامعة، وانتشار الشكل على حساب محتوى المنصات الرقمية، وجماليات عبقرية القادة الاقتصاديين، والاتصالات الشخصية على المنصات الرقمية، ورغبة المستخدمين، ثم التعميم كمبرر لكل ابتكار وأخيرا الاحتفاء بالفشل.
ترتبط الأسطورة الأولى بالسيرة الذاتية لمبدعي شركات التكنولوجيا، الذين كانت لديهم خلفية غير نمطية في الدراسة إذ يعتبرون من الطلاب"المتسربين" أو " المنقطعين عن المسار الدراسي عدة مرات، بدعوى أنهم لا يتوافقون مع قوالب الدراسات الجامعية. حتى لو كان عدد المتسربين من الجامعات محدودًا، فإنهم يساهمون في خلق الصورة التي تعرضها التكنولوجيا كما يظهرون كيف يتصرفون تجاه قطاعات المجتمع الأخرى. في الواقع، يصف المتسربون علاقتهم بالتعليم العالي والبحث كعلاقة مع الزبائن ويعتبرون أن المؤسسة المدرسية تعتبر منتوجا غير مرض ولا يشفي غليل الطموحين. كما قال مارك زوكربيرغ: "ربما تعلمت برمجة المشاريع التي نفذتها بالتوازي أكثر مما تعلمت من الدروس التي تلقيتها في الجامعة" ص 35. هذا النوع من الخطاب حول القطيعة الدراسية التي يروج له بعض قادة القطاعات التكنولوجية يبني سيرة ذاتية متماسكة تطوب الاستقلالية الفكرية والذاتية. ومع ذلك، وكما يشير المؤلف، فإن المسارات الدراسية المتقطعة ليست في الواقع شيئًا أصليًا، ولأنها غالبًا ما تنتهي بالرسوب والفشل الدراسي التام.
إن أسطورة التلميذ الفائق الموهبة الذي لا يتناسب تفكيره مع تعليم مرموق أُنشأ حول التسرب مبالغ فيها وغالبا ما يكون هذا "الأكثر تفاهة في السيرة الذاتية لشاب أبيض ثريّ" (ص 42). بالنسبة للشباب، فإن التخلي عن الدراسة، الذي يتبعه في الغالب استئناف لها، هو نفس تجربة التعليم عن طريق الدراسة النصف السنوية المعتمد في كثير من الجامعات. وبالنسبة للجامعة فهي لا تعتبره قطيعة أو تخليا وإنما مجرد استراحة. لاحظ المؤلف وجود تشابه معين بين نماذج الأعمال التي طورتها التكنولوجيا والجوانب المشتركة لتجربة الجامعة. على سبيل المثال، تدعي شركة ليفت أن إعادة اختراع النقل من خلال استبدال السيارة بخدمة شاحنات صغيرة تتبع طرقًا محددة مسبقًا ... بمعنى آخر،استبدال السيارات بالحافلات! لكن يجب أن تكون هذه الحافلات مخصصة فقط للأشخاص الذين يملكون هواتف ذكية ومهارات استخدام ويعرفون كيفية تهيئة التطبيق المخصص. لقد طورت مشاريع عدة بواسطة طلبة جامعيين سابقين أصبحوا مديري شركات التكنولوجيا، وهذا يعني اقتراحًا للخدمات الموجهة نحو المستخدمين الذين لديهم خصائص ورغبات محددة، مثل امتلاك هاتف ذكي، على سبيل المثال.
ثم يعود أدريان دوب إلى كتابات مارشال ماكلوهان وتداعيات تلقيها. بالنسبة لممثلي وادي السيليكون الذين لا يثقون بمؤسسات الدولة والجهات الفاعلة، فقد كان مفهوم ماكلوهان للإعلام مفتاحًا مهمًا لاستيعاب إنجازاتهم؛ لأن هذا الأخير يوضح أن التطورات التكنولوجية الحالية لا توجد في الكائن، ولا في محتوى المنصات الرقمية، ولكن في الوسائط نفسها، وفي قوالب هذه المنصات. وبالتالي، عندما يبحث رائد أعمال تقني عن نموذج اقتصادي لشركته، فإن ما يهمه هو الطريقة التي يجب أن يهيكل بها منصته وليس التطبيق الذي سيعالج به بيانات الخدمة التي يريد تطويرها، سواء كان الأمر - يتعلق بالرحلات أو بالسيارات أو توصيل الوجبات أو مشاركة وصفات الطهي عبر الإنترنت إلخ.
حقيقة، ما يبني واقع المستخدمين هي المنصات ومن يصنعها، وليس محتواها ومن ينتجها. لا تُبدي الشركات التكنولوجية أي اهتمام بالمجتمعات التي تتكون حول منصاتها (عمال التوصيل، والعملاء الذين ينشرون مراجعات المطاعم، وهواة الموسيقى، والمدونون، وغيرهم) ولا يتعرفون على المحتوى الذي ينتجونه على المنصة باعتباره ثمرة عمل دؤوب. كما أن قادة المنصات يبتعدون عن المحتوى لإعلان حيادهم الظرفي. إذا كانت إدارة تويتر لا تتردد في التأكيد على الدور الذي لعبته المنصة خلال الربيع العربي، فإنها ترفض كل المسؤولية عن التصريحات المؤيدة للنازية التي تتداول بانتظام على منصتها.
السمة الثالثة للتفكير حسب نظام التكنولوجيا تتعلق بعبقرية قادتها، الذين ينبع نجاحهم من إبداعهم وأصالتهم. ومن أجل استكشاف أسس هذا الفكر، يعتمد المؤلف على كتابات الفيلسوف آين راند وعلى بحث معمق في سير هؤلاء القادة، ولا سيما بيتر ثيل، وسام ألتمان أو ترافيس كالانيك (مؤسس أوبر) أو ستيف جوبز (المؤسس المشارك لشركة آبل) أو إيلون ماسك ( مؤسس تيسلا وسبيس إكس). يؤكد آين راند أن قادة التكنولوجيا يجسدون دور البطولة الفردية و"جماليات العبقرية" وهذه الجمالية تنطوي على العمل وعلى فكرة أن الشركة هي التعبير الحر عن الذات. لكن جمالية العبقرية هذه قد تنتج خيبة أمل عند مواجهة واقع التبادلات بين مستخدمي المنصات الرقمية. استنادًا إلى تأمل لمواجهة بين الثقافة المضادة وفكر وادي السيليكون. يوضح المؤلف أن قادة التكنولوجيا يتشاركون فكرة واحدة تفيد أن هناك اتصالا شفافا وحرا وفاعلا بين مستخدمي منصاتهم.
في الواقع، أدى التقدم التكنولوجي المذهل إلى الاعتقاد بأنه من الممكن تصميم أدوات جديدة لتحسين التواصل بين البشر. ومع ذلك، يبدو أن المنصات الرقمية ليست الأماكن المثالية للحوار والنقاش المأمول، كما يتضح بالفعل، من خلال المضايقات عبر الإنترنت أو مشاركة الصور المستهجنة. ولكن، بشكل أكثر مكرًا، وعلى عكس ما يدعي الفاعلون التكنولوجيون، تقوم المنصات بتحديد المحتوى المتاح وتشكيله، فهم يسهلون أشكالًا معينة من الاتصال مثل ردود الفعل القصيرة أو الآراء الخلافية. إن صانع المنصة "يجب أن يخفي مقاصده ليؤكد أن نموذجًا أفلاطونيًا معينًا للتواصل يحرك المنصة، بينما يقف بسعادة وهدوء خلف مقاطع الفيديو التي تعرض الأرض على أنها مسطحة وأمام الأفكار المعادية للسامية" (ص 112).
تفترض نظرية المحاكاة، التي صاغها رونيه جيرار، أن كل رغبة بشرية هي محاكاة . في الأصل، تشير نظرية المحاكاة إلى وجود صراعات متأصلة في طبيعة الرغبة نفسها. ولكن من خلال تبني هذه النظرية، فإن الفاعلين الحقيقيين هم التكنولوجيون - ولا سيما بيتر تيل من خلال مؤسسته، التي أنشأها في عام 2006 – ومنحها قيمة رمزية متفوقة. وهذا ما يسمح لهم بالتأكيد بالهيمنة على الناس وتحويلهم إلى "قطيع" وأن المنافسة بين الشركات هي قبل كل شيء صراعات شخصية بين العباقرة الذين يريدون الشيء ذاته.
بالنسبة لأدريان دوب، "التشويش" هو المفهوم الذي يميز التفكير التقني على أفضل وجه، ويجد مصدره في إعادة تفسير التأملات الكلاسيكية حول "التدمير الإبداعي" التي طورها كارل ماركس ثم جوزيف شومبيتر. ولكن، على عكس هذين المؤلفين، لم يعد مفهوم التشويش يهدف إلى فهم تطور الرأسمالية بين الاستمرارية والانقطاع؛ فبعد إعادة تفسيره وتجريده من سياقه التاريخي، فإنه يسمح لممثلي وادي السيليكون بالاحتفال بتدمير أي استمرارية أو أي ركود. هذا الفكر، الذي يلخصه بوضوح شعار الفيسبوك "تحرك سريعًا وحطم الأشياء"، الذي ينطبق على العديد من القطاعات التي غالبًا ما تُعتبر أخطأ احتكارية. وبذلك يقدم التشويش نفسه كمبرر لابتكار ريادي من واجبه محاربة النظام المتحفظ. لكن هل عطلت أوبر "آلاف سيارات الأجرة الفردية التي كانت بالكاد تكسب لقمة عيشها"؟ هل عطل موقع يِلْبْ احتكار القلة للرأي؟ يسأل المؤلف (ص 155). وراء هذا الخطاب، يكشف المؤلف عن "ارتياب عميق إزاء أي تراكم لقوى التقدم" (ص 155).
يختم الكتاب بالأسطورة الأخيرة التي يفاخر التفكير التكنولوجي بإعادة سردها، تلك التي تحتفل بالفشل كفرصة للقفز نحو التقدم، ونتيجة التعلم منه، تتحسن المبادرات الأخرى وتحقق النجاح. والدليل على ذلك أن العبارة المفضلة لنخبة وادي السيليكون هي "نعم للفشل لكن نحو الأفضل" وهي مأخوذة من مقولة لصمويل بيكيت حول "العجز عن الفهم والفشل والاستسلام" (ص 162).
إن الاحتفال بالفشل، الذي يعتبر تعويذة مستخرجة من سياقها التاريخي والأدبي، يسمح لأصحاب المشاريع التكنولوجية بأن يقولوا إن كبوات عديدة قد اعترضتهم و"سقطوا باستمرار في أوقات عصيبة" (ص 165). قد لا تكون الجملة تأملا لحالة مشتركة، ولكنها "حث على التطور وهو موجه إلى إنسان فريد من نوعه" يركز على "الذات الإبداعية" (ص 166-167). غالبًا ما تحجب هذه التعويذات التي نجدها خلال المؤتمرات والمقابلات مع القادة المزايا الاجتماعية أو العرقية أو الطبقية أو العمرية التي تسمح للبعض بالفشل "بشكل أفضل"، على عكس أولئك الذين تكون خصائصهم الاجتماعية أقل حظا والذين لا يملكون الموارد اللازمة ل "للنهوض" والنجاح بعد الفشل.
في النهاية، يصور الكتاب بمهارة أبطال وادي السيليكون محددا أسباب نجاح قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصعود وانتشار ابتكارات هذه الشركات وازدياد ثرواتهم المهولة. ولتفادي إنتاج عموميات شاملة وغير دقيقة حول قطاع يتضمن مجموعات مهنية متنوعة (مديرين، موظفين، صحفيين، إلخ)، يبين المؤلف بوضوح كيف تستمد التكنولوجيا الموارد الخطابية من الأدبيات العامة والأكاديمية. لذلك تفسر هذه الموارد، غالبًا بشكل خاطئ، لتتحدث عن أيديولوجية مشتركة نسبيًا تعمل على دعم الدفاع عن قطاع ينظر إليه بريبة وانتقاد. في حين يستمر وادي السليكون في إنتاج أفكاره المبتكرة والمذهلة نتيجة قدراته الذكية على الهروب من قواعد صارمة، وقوالب نمطية، ليفسح لحرية الإبداع والابتكار والمراهنة على المستقبل؛ لأن من يملك الأفكار المتجددة لا يفشل.
تفاصيل الكتاب:
الكتاب: التفكير التكنولوجي: المشهد الفكري لوادي السيليكون
المؤلف: أدريان دوب
الناشر: Caen, C&F Editions. فرنسا
سنة النشر: 2022
عدد الصفحات: 184ص
اللغة الفرنسية