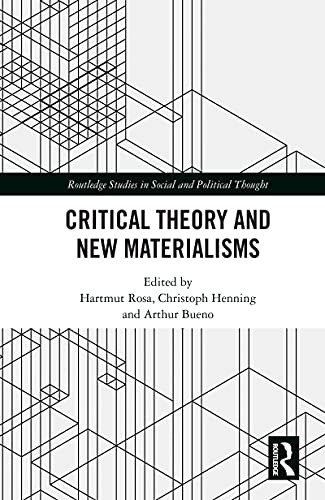تأليف جماعي
علي الرواحي
يجمع هذا الكتاب بين كُتّاب من تقاليد فكرية تطورت بشكل عام حتى الآن، بشكل مستقل عن بعضها البعض: النظرية النقدية والمادية الجديدة، كما يتناول الاختلافات الأساسية والصلات المحتملة الموجودة بين هاتين المدرستين، مع التركيز على بعض الأسئلة الأكثر إلحاحا في الفلسفة المعاصرة والنظرية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص، تلك المتعلقة بحالة الفصل طويل الأمد والمتنازع عليه بين المادة والحياة: البيولوجي والرمزي، السلبية والفاعلية، والعاطفة والعقلانية؛ حيث يوضح أن التطورات الأخيرة في كلا التقليدين تشير إلى تقاربات مهمة بينهما؛ وبالتالي تمهد الطريق لمزيد من المواجهة المباشرة والتلاقح المتبادل؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار بين النظرية النقدية والمادية الجديدة. كما تستكشف هذه المجموعة من المقالات الآثار المترتبة على المناقشات المعاصرة حول البيئة والجنس والسياسة الحيوية وما بعد الإنسانية والاقتصاد وعلم الجمال.
وينقسمُ العمل لثلاثة فصول مترابطة ومختلفة في نفس الوقت؛ ففي الفصل الأول يناقش طبيعة النظرية النقدية، في حين أن الفصل الثاني يتحدث عن قوى المادة والحياة وتأثيرها، كما يتطرق الفصل الثالث لنقد المادية الجديدة.
وفي مقدمة لثلاثة باحثين من ضمنهم وربما أهمهم الفيلسوف الألماني هارتموت روزا Hartmut Rosa ممثل الجيل الرابع للنظرية النقدية، يرون بأن النظرية النقدية ولدت من روح المادية التاريخية "القديمة"، حيث كان يُنظر إليها في كثير من الأحيان، وبشكل متناقض تماما، على أنها تتخذ مسافة مفرطة تجاه المادية والبيولوجيا للعالم؛ وذلك من خلال فهم نفسها على أنها استمرار للمشروع ما بعد الميتافيزيقي "غير المكتمل" للتنوير الكانطي، فقد رسخت مؤخرا أفقها السياسي في ممارسات الاتصال العقلاني بين الذوات (يورغن هابرماس)، والاعتراف (أكسل هونيث) والتبرير أو التسويغ (راينر فورست). على الرغم من اختلافاتهم، فقد تم انتقاد هذه المقاربات لأنها تحمل مفاهيم بشرية عن الطبيعة والأفكار العقلانية للمجتمع، والتي تنبع في النهاية من اعتمادها على التقليد الفلسفي للمثالية الألمانية. ونتيجة لذلك، يجادل النقاد بأن الجوانب المادية والحيوية والعاطفية لعالمنا قد تم تجاهلها أو إخضاعها لعمليات تذاوتية للتفكير المعياري. كما سعت الأعمال الحديثة ضمن النظرية النقدية إلى التغلب على هذه القيود من خلال اللجوء إلى التقاليد الفكرية الأخرى، وعلى الأخص من خلال إعادة فتح النقاش حول ما يمكن تسميته "المشروع غير المكتمل" للرومانسية. طرح مفهوم التصادي -يُفهم على أنه علاقة تجاوب ثنائية الاتجاه تتمثل في التأثر بشيء خارجي، إضافة للقدرة على الوصول إلى شخص ما أو شيء ما ونقله "إلى الخارج"- عن طريق هارتموت روزا (2019) أنشطة وعلاقات جسدية للعودة إلى الطبيعة بقوة أكبر في النظرية النقدية، مما يؤسس اتصالاً محتملاً بخطوط الفكر التي طورها الرومانسيون.
أدَّت هذه التطورات إلى توترات داخلية وسلسلة من المناقشات الجديدة داخل النظرية النقدية. وفي الواقع، شعر العديد من المدافعين عن "المشروع غير المكتمل" لحركة التنوير بالقلق من أنه قد يكون هناك شيء محافظ في جوهره حول مثل هذا الابتعاد عن الديناميكيات الذاتية للتواصل العقلاني والاعتراف والتبرير. ومن وجهة نظرهم، فإن التركيز المتزايد على المادي والحيوي والعاطفي يخاطر بحرمان النظرية النقدية من الأسس العقلانية التي أنشأتها للنقد الاجتماعي. ومن هذا المنظور، فإن الميول الجديدة في هذا المجال تشبه نظريات ما بعد البنيوية التي انتقدها هابرماس في الخطاب الفلسفي للحداثة (1990م). وتتمثل إحدى المصالح الرئيسية في هذا النقاش فيما إذا كان مثل هذا التوجه الذي يتجاوز العقلانية يؤدي إلى اتجاه محافظ لا مفر منه أو ما إذا كان سيؤدي إلى رؤية ونقد أكثر راديكالية للحياة الحديثة.
وفي هذا الصدد، قد لا يكون التشابه المؤذي بين المنعطف "الرومانسي الجديد" في النظرية النقدية ونظريات ما بعد البنيوية غير متسق، بل قد يثبت أنه منتج مثمر للمقاربات النقدية.
وفي مقابل ذلك، حدث تحول مماثل نحو الطبيعة والحياة والتأثير في نقاشات ما بعد البنيوية والنسوية والعلوم والتكنولوجيا في النصف الثاني من التسعينيات، والتي تضمنت عددًا من النظريات التي كان روزي بريدوتي (1994) ومانويل ديلاندا (1996) أولهما للإشارة إلى "المادية الجديدة" أو "المادية الجديدة"؛ حيث تميزت هذه المساعي بمحاولة واضحة -بالتوازي مع جهود المنظرين النقديين المعاصرين فيما يتعلق بمجالهم- للتحرك أبعد من حدود "المنعطف اللغوي". فالسمة المميزة لهذه الأعمال هي، قبل كل شيء، إشكالية الثنائيات التي تطورت تماشيا مع خيوط الفكر الحديث، خاصة تلك التي تم تحديدها مع التنوير، في مصطلحات مقيدة وهرمية إلى حد ما: المادة مقابل الحياة، الحياة البيولوجية مقابل: الحياة الرمزية، السلبية مقابل الفاعلية، والعاطفة مقابل العقلانية.
وفي مواجهة هذه المفاهيم المزدوجة، شرعت كارين باراد (2007م) في إعادة تأطير العلاقات بين البشر وغير البشر على أنها "علاقات داخلية، في حين شككت جين بينيت (2010م) في التمييز الأساسي بين المادة والحياة؛ من خلال اقتراح منظور حيوي نقدي"، كما شككت إليزابيث غروز (Elizabeth Grosz) في الحدود بين الحياة البيولوجية والرمزية. والنتيجة الأخرى لهذا التداخل بين المجالات التي تعتبر منفصلة بشكل عام هي أن إمكانات ما بعد الإنسانية التي أثارتها التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن اعتبارها -في كل من آثارها السلبية والإيجابية- في استمرارية مع المادة والحياة والتأثير وليس ببساطة في مقابل لها.
وتُشير التطورات الأخيرة في النظرية النقدية والمادية الجديدة إلى تقارب محتمل بين هذين التيارين الفكريين. على الرغم من أصولهما المختلفة، فقد حاول كلاهما التشكيك والتغلب على قيود العقلانية المتمركزة حول الإنسان. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات مهمة في طريقة تقدم كل هذه التيارات في هذا الصدد. في حين أن المنظرين النقديين المعاصرين يفهمون في الغالب مهمتهم على أنها مهمة تكملة أو توسيع حدود فكر التنوير من خلال اللجوء إلى التقاليد الأخرى، يسعى الماديون الجدد إلى تطوير استجواب أكثر جذرية للفكر الحديث ومشاركة مباشرة أكثر مع الطبيعة المتشابكة للمادة، الحياة والتأثير والتكنولوجيا. ونتيجة لذلك، غالباً ما يظهر أولئك الذين يعملون في مجال النظرية النقدية لمناصري المادية الجديدة على أنهم محاصرون كثيراً في منظور يركز على الإنسان واللغة، في حين أن الأخير كثيراً ما ينظر إليه الأول على أنه يتخلى بسهولة عن الفروق المهمة بين الإنسان والطبيعة غير البشرية، والوجود والمظهر، ونظرية المعرفة والأنطولوجيا. ومن ثم، فإنَّ حقيقة أن هذين المجالين الفكريين يشتركان في التزام أساسي لتجاوز العقلانية المتمركزة حول الإنسان، ولكن تنفيذ مثل هذا المشروع باستراتيجيات فكرية متميزة للغاية، يوفر أسساً لمناقشات بالغة الأهمية في الفلسفة المعاصرة والنظرية الاجتماعية.
ومع ذلك، فمن المدهش أنه حتى الآن لم تكن هناك محاولة جادة للانخراط في مثل هذا النقاش. يكمُن جزء من السبب في ذلك تحديداً في الاستراتيجيات المختلفة التي يستخدمها هذان التياران الفكريان في جهدهما المشترك لتجاوز حدود مشروع الحداثة المستنيرة. على الرغم من اتفاقهما في الهدف، إلا أن المسارات التي اعتمدها كل منهما تختلف اختلافاً جوهرياً. في حين أنه من الصحيح أن كلاً من النظرية النقدية والمادية الجديدة يتميزان بخلافات داخلية، فإن أساس كل منهما يكمن في مجموعة مميزة من الافتراضات المعرفية والأنطولوجية والعملية.هذه، في الواقع، بعض الأبعاد التي يمكن أن يُنظر فيها إلى النظرية النقدية والمادية الجديدة على أنها تتبنى مواقف متباينة أو حتى متعارضة تماماً؛ وبالتالي تشكل المناقشات المعروضة في هذا الكتاب، وتحدد جوهر خلافاتهم في هذه المجالات، وكذلك موضع التقارب المحتمل بينهم، في مفاهيمهم المختلفة عن الطبيعة.
وبالنسبة للنظرية النقدية، فإن "الطبيعة" هي جوهر المشكلة. فلفترة طويلة في التاريخ، بدا أن اضطهاد واستغلال الفقراء والنساء والعمال والأقليات، وكذلك الاشتباكات بين القوى السياسية التي جلبت الدمار والبؤس للكثيرين، كانت حقائق طبيعية؛ حيث تم تناول هذه الظواهر من قبل الاقتصاد السياسي -من هوبز إلى مالتوس وما بعده- باعتبارها قابلة للتفسير عن طريق "القوانين الطبيعية". كان النظام الاقتصادي الذي يُلقي باللوم على المجتمع الطبقي يتطور بضرورة حديدية لا ترحم، كما لو كان يُنفذ من قبل قوارض بشرية تتحكم فيها الغرائز الطبيعية، بحيث ظهر أيضاً كجزء من الطبيعة (ولا يمكن أن يأتي الخلاص إلا من فوق، من خلال التدخل المسيحاني، الذي تصورته الاشتراكية المبكرة وكذلك العلماء اللاحقون مثل والتر بنيامين من منظور ديني).
ووفقاً لذلك، اعتبرت العلوم التي تتعامل مع هذه العمليات "الطبيعية" من العلوم الطبيعية: إما صياغة قوانين غير قابلة للإلغاء (كما فعل الاقتصاد السياسي) أو جمع الظواهر الاجتماعية كما لو كانت أشياء (كما هي الحال في العلوم الاجتماعية الوضعية). ومع ذلك، كانت المفاهيم الاجتماعية الداروينية التي طُرحت ضد الليبرالية منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعداً أكثر ضرراً على الشرائح الضعيفة من السكان من القهر الليبرالي للدولة الحديثة وللمجتمع وللاقتصاد. واعتمدت هذه على أفكار الطبيعة التي بدت أكثر قسوة وصعوبة من الأفكار الليبرالية (على الرغم من أن هناك الكثير ممن تناولوا استمراريتها لاحقاً). وقد تم تفسير الانتقاء الطبيعي في نهاية المطاف على أنه "صراع عنصري"، بحيث يمكن أن يظهر الفصل حسب اللون و"العرق" أو حتى الإبادة الجماعية كظواهر طبيعية. في مثل هذا السياق، كان يُنظر إلى مهمة "النظرية النقدية" على أنها تتمثل في التراجع عن الثبات "الطبيعي" للمعتقدات الراسخة والعادات الاستبدادية والمعايير الجنسية والعرقية وما إلى ذلك.
وفي ظل هذه الظروف، غالباً ما افترض التفكير التقدمي أنه من أجل إفساح المجال للحرية والتحرر، يجب تقليص عالم الطبيعة. بينما أدى ذلك في الممارسة العملية إلى هيمنتها من خلال التكنولوجيا التي يحركها العلم واستغلال "الموارد" الطبيعية ومصادرتها، وهذا يعني من الناحية النظرية نزع التحييد عن القوى الدافعة لمثل هذه العمليات، أي إزالة الغموض عنها والكشف عن "طبيعتها" الحقيقية - التي لم تعد طبيعية. بالنسبة للنظريات النقدية، كان وراء تلك الديناميكيات غالباً محفزات غير طبيعة، أشياء أكثر إنسانية واجتماعية، أكثر مرونة وقابلية للتغيير: العقل، في حالة كانط، أو الروح في البديل الهيغلي، أو حتى -تغيير بسيط فقط من هذا المنظور- الثقافة والمجتمع.
ويُمكن رؤية كيفية "إضفاء الروحانية" على هذه الرؤية المناهضة للطبيعة للمجتمع عن طريق التركيز القوي على المعيارية والعقل في المناقشات الأخيرة داخل النظرية النقدية. باختصار، بالنسبة للجزء الأكبر من القرن العشرين، فإن الانتقاد يعني إلغاء البُعد الطبيعاني، وأن يكون معنى التفكير النقدي أن تكون غير طبيعي.
وما يربط بين هذه الأساليب المختلفة تجاه طبيعة أخرى (كالعقل، أو الروح، الثقافة أو المجتمع) هو أنه في الأخير فقط يُمكن تأسيس "عالم الحرية". ففي معظم التوجهات الراديكالية من هذه الفلسفات، امتد مجال الحرية ليشمل الطبيعة أيضاً. ومع ذلك، طالما أن هذا الشكل الروحي للحرية لم يتحقق بالكامل، فإننا ننتهي (على الأقل) بكيانين: الطبيعة والمجتمع، أو الطبيعة الأولى والثانية. وفي الواقع، كما أدرك برونو لاتور (2004) بحق بروح الدعابة السوداء، يمكن تفسير النظرية النقدية في القرن العشرين جزئياً على أنها لعبة "تنقية": كل الجوانب المتجسدة في المجتمع (الدولة والاقتصاد والطبقات والقوالب النمطية العرقية، أدوار الجنسين والأعراف السلوكية) يجب نزعها عن طبيعتها وتجريدها من الواقع من أجل "تحريرها" من لعنة الحتمية والقمع. يبدو الدافع واضحًا: ضد الطبيعة، حيث تتجلى هذه العقلية من هيغل إلى ماركس، ومن لوكاش إلى أدورنو ومن فوكو إلى جوديث بتلر، وقد أصبحت مهيمنة في العديد من النظريات الاجتماعية في العقود الماضية وحتى اليوم. نتيجة لذلك، أصبح عالم الطبيعة غير ذي صلة من الناحية النظرية -تقريباً كصورة معكوسة للعملية المستمرة للحاويات الرأسمالية والتدمير البيئي في "الأماكن الخارجية العظيمة". أحد الآثار الجوهرية لهذه العملية هو أن الخيوط الناتجة عن النظرية النقدية لم يكن لديها الكثير لتقوله عن الأزمة البيئية، ما لم يتمكنوا من إظهار أن مثل هذه الأزمة ليست "طبيعية"، بل بالأحرى "معيارية". الأمر الذي أثار اهتمام هابرماس بالحركة الخضراء -على سبيل المثال- هو الحركة وليس التفكير "الأخضر" الذي نشأ.
وفي مقابل ذلك، تطوَّرت المادية الجديدة في الكتابات بشكل رئيسي من النسوية ما بعد البنيوية، لكنها أيضاً مستوحاة من مناهج في مجال دراسات العلوم والتكنولوجيا؛ حيث كان الهدف ترك التقاليد الفكرية المحدودة بما يبدو على أنه "ثنائيات" بين نظرية المعرفة والأنطولوجيا، وكذلك بين مجالات مختلفة من الوجود مثل الطبيعة والثقافة، والعقل والمادة، أو الحياة والتكنولوجيا؛ فهي تطمح لرؤية عالمية جديدة لا مركزية لم تعد بشرية، وهرمية ومنفصلة ولكنها "أحادية" ومنفتحة على العديد من العلاقات والتغييرات في العالم الذي نحن جزء منه. تُعزى الأزمة البيئية، وإخضاع النساء، والاغتراب الواسع النطاق إلى التفكير الذي حط من قيمة الأمور غير البشرية بشكل خاطئ كأشياء ميتة أو عمليات لا معنى لها؛ نظرًا لأن خصومها الأساسيين هم نظرية المعرفة (على وجه الخصوص كانط)، والمادية "القديمة" (هوبز، ونيوتن، أوماركس وإنجلز) والأنطولوجيا الثنائية (المنسوبة إلى ديكارت أو، مع لاتور، أو إلى "الحداثة" ككل)، في بعض الأحيان يبدو كما لو أن المادية الجديدة ترغب في التغلب على العقلية النقدية الحديثة أيضاً. كما نجد أنَّ هناك بعض التحفظات الصريحة بالفعل، على الأقل ضد النقد الذي يقارن بين المعايير العقلانية "الجيدة" والواقع التجريبي "السيئ"، أو الإنسانية "الجيدة" والتكنولوجيا "السيئة".
وتتفاعل المادية الجديدة ومشكلة الطبيعة مع المادية الجديدة كنهج علمي اجتماعي. فهي لا تهتم بالطبيعة المهددة، كما هي الحال في النظرية النقدية، ولكن بالأحرى مع أزمة الطبيعة في الممارسة وتجاهل القضايا البيئية في النظرية الاجتماعية. في كلا الأمرين، يبدأ المؤلفون الماديون الجدد بالتشكيك في تبعية الطبيعة. الدافع الأساسي هو التشكيك في الثنائيات التي تميز الفكر والممارسة الحديثين. حيث يُنظر إلى الحداثة على أنها مبنية على أساس معارضة مفاهيمية مركزية: تلك بين المادة والروح، حيث يظهر الأول ليس فقط على أنه متميز ولكن أيضاً تابع للأخير. فالروح تعني النشاط والقيمة والتعالي؛ فالمادة سلبية ولا معنى لها. بالنسبة للماديين الجدد، تشرح هذه الثنائية كلاً من حدود الفكر الحديث ومشكلاته العملية في القضايا البيئية والعرقية والجنسانية، من بين أمور أخرى. ولهذا السبب من الضروري مساءلته أو تجاوزه على النقيض من الفكر الإنساني الثنائي أو حتى المتعالي السائد في الحداثة، حيث تقترح المادية الجديدة فلسفة أحادية جوهرية تركز على المادة وتمتنع عن تصور الأخيرة على أنها شيء خامل ومقدر أن تصوغه الروح.
النقطة هنا ليست مجرد التأكيد على أحد القطبين (المادة) على حساب الآخر (الروح)، بل بالأحرى تجاوز الازدواجية ذاتها التي تؤسسها كأقطاب. لا ينبغي أن يكون هناك "ترتيب للأولويات"، ولا أساس: إنها ليست مسألة طرح مسألة ضد الروح (أو العكس) ولكن التفكير فيها في تأكيد متبادل أو تكوين مشترك وهكذا، بدلاً من ثنائية الطبيعة / الروح، ما يظهر هنا هو "الثقافة الطبيعية" أو "الخطاب المادي" أو "السيميائية المادية". بدلاً من التفاعل بين العناصر المحددة بدقة والمتناقضة، هناك "تفاعل داخلي" مستمر للقوى والأمور في مختلف الحالات ودرجات التماسك.
تفاصيل الكتاب:
- الكتاب: النظرية النقدية والمادية الجديدة
- المؤلف: تأليف جماعي
- الناشر: Routledge - 2021
عدد الصفحات: 216 صفحة