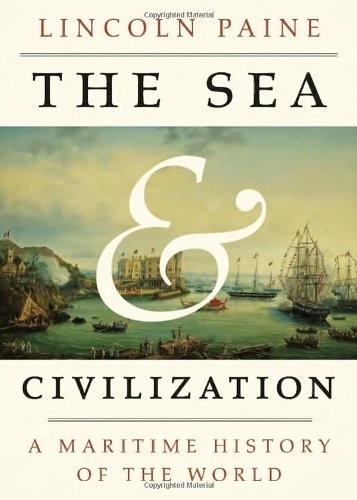لينكولن بين
محمد الشيخ
كُتب الكثير عن البحر -ملاحة وتجارة وجغرافية، ورصدا وصيدا وحربا- لكنَّ القليل كُتب عن البحر والحضارة. وهذا الكتاب أحد أهم تلك المكتوبات، هذا إِنْ لم يكن الأهم. وهو ملحمة -هوميرية الرؤية شاعرية النَّفَس- للإنسان والبحر كُتبت بلغة العصريين تنتهي إلى القول بأنه لا البحر ينبغي له أن يقضي على الإنسان ولا الإنسان ينبغي له أن يقضي على البحر، وإنما هما كائنان هَشَّان، والأمانة التي حُمِّلها إنسان اليوم إنما تتمثل في أن يَتَعَهَّدَ هو البحر التعهد أحسنه؛ لأن في ذلك تعهدا لنفسه.
وقلما يُفتتح كتاب غربي باستشهاد لمفكر عربي. وهذا الكتاب استثناء؛ إذ يفتتح بقول للمقدسي -صاحب كتاب "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم": "بينا أنا يوما جالس مع أبى علي بن حازم أنظر في البحر ونحن بساحل عدن؛ إذ قال لي: ما لي أراك متفكّرا؟ قلت: أيّد الله الشيخ، قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة الاختلاف فيه، والشيخ اليوم من أعلم الناس به لأنه إمام التجار ومراكبه أبدا تسافر إلى أقاصيه؛ فإن رأى أن يصفه لي صفة اعتمد عليها وأرجع من الشّك إليها فعل؛ فقال: على الخبير بها سقطت، ثم مسح الرمل بكفّه ورسم البحر عليه".
كتاب ضخم مكوَّن من عشرين فصلا، يبدأ بفصل عن إقبال الإنسان على الماء، حلوه ومالحه، عوما وإبحارا؛ وينتهي بفصل عن العالم البحري منذ الخمسينات من القرن الماضي إلى اليوم؛ فضلا عن تقديم وتهميش كثير وببليوغرافيا ثرة وكشاف مفيد. ومؤلفه باحث في تاريخ البحر -وما أقل أهل هذا التخصص!ـ صاحب خمسة كتب مدارها على البحر -فضلا عن أزيد من خمسين مقالة ومحاضرة- أهمها الكتاب الذي بين أيدينا، وكتاب "سفن العالم: موسوعة تاريخية" (1998). وقد نشأت فكرة كتابه لما كان مكبا على تأليف موسوعته هذه -وهي جماع سِيَر بواخر اشتهرت إيجابا- المجد -أو سلبا- العار؛ إذ عَنَّت له فكرة وضع هذه "السِّيَر" في سياق تاريخي أوسع. على أن الكتاب، وعلى خلاف الموسوعة، لا يدور على السفن نفسها بقدر ما يدور على ما كانت تُقِلُّه -من بشر وثقافتهم وثمرات صنائعهم ومحاصيلهم وقطعانهم وصراعاتهم وآرائهم المسبقة وانتظاراتهم للمستقبل وذكرياتهم عن الماضي.
وينطلق صاحب الكتاب من مفارقة صارخة: نحن نحيا في عصر أثرت فيه تأثيرا عميقا مبادرة الإنسان البحرية، لكن أهمية هذا التأثير تغيرت تغيرا جذريا فحسب خلال جيلين أو ثلاثة بعد أن شهد البر ثورة تقنية أتت بالنسيان على علاقة الإنسان بالبحر. كما بتنا نرى اليوم المتعة في الإبحار حيث كان أسلافنا يرون الخطر، وصرنا نلتذ بثمار التجارة البحرية دون أن نعي بوجودها؛ وذلك حتى حين نكون ترعرعنا في مدن شكّل البحر مصدر غناها. ضد هذا النسيان الجَحود، ينعش المؤلف ذاكرتنا بمروية باذخة حول التاريخ البحري. وما كان هذا الكتاب تاريخا للبحر، بقدر ما هو تاريخ لصلة الإنسان بالبحر. وما كان تاريخ أي إنسان، وإنما هو بالأولى تاريخ الإنسان البحري؛ أي الإنسان من حيث هو كائن ثَقِفَ البحر.
ويفتتح المؤلف كتابه بعبارة تخاطب القارئ: "أود أن أُغير الطريقة التي تنظر بها إلى البحر؛ خاصة الطريقة التي تنظر بها إلى خريطة العالم؛ وذلك بجعلك تركز نظرك على الأزرق الذي يشكل 70% من الصورة الواقعة أمامك، وأن تترك نبرات البر تتلاشى". يريد إذن تطرية عين القارئ بذكرى: قبل تطور السكك الحديدية في القرن 19 كانت الثقافة والتجارة والوباء والنزاع بعامة تسافر عن طريق البحر أكثر منه عن طريق البر. ويؤطر الكاتب كتابه ضمن "التاريخ البحري". وهو تاريخ ينضوي على البحث التوليفي في التفاعلات بين أقوام ذوي خلفيات ونزوعات متباينة. وبذلك يتجاوز تركيز المؤرخين التقليدي على الجماعات المختلفة من جانبها السياسي والديني والثقافي وقد نُظر إليها، بالأولى، على المستوى المحلي أو القومي أو الجهوي. ومن مزايا التاريخ البحري أنه ملتقى مباحث ومؤتلف مناطق، وهو قسم من التاريخ العالمي يتناول مواضيع شأن بناء السفن والتجارة البحرية واكتشاف المحيطات والهجرة البشرية والتاريخ الملاحي. ويقوم على مقدمة مفادها أن دراسة الأحداث التي تقع في صلة بالماء من شأنها أن تمدنا باستبصارات في شأن شؤون البشر.
ومن ثمَّ تناول المؤرخ البحري لمباحث نظير الفنون والدين واللغة والقانون والاقتصاد السياسي. ويرى المؤلف أن من شأن هذه النظرة أن تخرج الأوربيين من ضيقة النظر إلى فسحته؛ أي مما يسميه المؤلف "رؤية العالم المتمركزة على أوربا" القائمة على النظرة العرقية القائلة بوجود "شعوب بحر حصرية"، كما الأغريق والبريطانيون، و"شعوب غير بحرية"، كما الصينيون. ولا تصحيح عنده اللهم إلا بالأوبة إلى المظان. وهو ما تشهد عليه المصادر المتنوعة التي يُشهِدها. واللهم إلا بنزع الطابع السياسي عن التاريخ البحري؛ أي بما يسميه "تمرينا متنورا" يؤهلنا للنظر في التفاعلات الثقافية بين الأمم والصلات العابرة للأمم من دون العودة الدائمة إلى "وهم الحدود السياسية".
وهذا الكتاب، كما يقدمه صاحبه، سعي إلى فحص كيف نسجت أقوام الصلة بالبحر والنهر، وكيف نشرت ثمار محاصيلها وصنائعها وأنظمتها الاجتماعية ـ من اللغة إلى الاقتصاد فالدين. وهو يركز على قضايا أساسية:
1- كيف وسّعت المبادرة البحرية من عوالم التجارة التي تتشاطر ضروبا من الدراية بالأسواق والممارسات التجارية والملاحة وبناء السفن؟
2- كيف يَسّرت أعالي البحار نشر اللغة والدين والقانون بين الأمم؟
3- كيف استثمر الحكام في المبادرة الملاحية عبر سن المكوس وحماية التجارة ووظفوا آليات لدعم سلطانهم؟
ومن مزايا هذا الكتاب تلك التوليفة العجيبة بين "المعلومة" و"المروية"؛ بحيث صاغ المعلومات -وما أثراها!- في شكل مرويات كل مروية تتعلق بمنطقة: من أمريكا ما قبل التاريخ إلى قريتنا العالمية اليوم -ووسع من الأفق؛ بحيث ما تناول فحسب "المياه المالحة"- البحر ـ وإنما الملاحة الداخلية (المياه العذبة: الأنهار، القنوات)، متصديا لبعض أوهام الغربيين؛ شأن انطباعهم الخاطئ عن الإسلام بكونه ديانة رُحَّلِ قفار، بينما يحيا الكثير من المسلمين في أرخبيلات، ومثل ما أشيع عن الهندوس أنهم يحرّمون الولوج إلى البحر، بينما الكثير منهم يعيشون على جزر. وما ينتهي إليه المؤلف أن هذه "الأمارات" تدل على أن تكيف بني البشر التقني والاجتماعي مع الماء -سواء للتجارة أو للحرب أو للاستكشاف أو للهجرة- كان قوة هادية في تاريخ بني البشر. ذلك أن الحركة الملاحية كانت مركزية في نشر العديد من التقنيات والأفكار والحيوانات؛ وهذا ما لم ينتبه إليه بعض مؤرخي البشرية.
والمؤلف راوية مِفَنٌّ متمكن من فنه. يأخذ بنا عبر أسلوب حكائي من بدء مغامرة الإنسان في الماء (الفصل الأول) إلى زمننا هذا (الفصل العشرون). إذ يروي في الفصل الأول قصة مغامرة الإنسان الأولى بالإبحار، وهي مغامرة لا نعرف بدايتها على وجه الدقة، ولكن ما نعرفه أنه ما أن ألقى الإنسان بنفسه في اليم حتى استعذب الرحلة، وما فكر أبدا في أن يعود إلى ما قبل ذلك. وكان أن بدأ الأمر بأشد الزوارق بدائية، في أوقيانوس والأمريكيتين، لكن توغلهما الأول في البحر وجد له أصداء في ثقافات أخرى. وفي الفصل الثاني يستدرك المؤلف بأن يرى أن أعظم الأمارات الأثرية والفنية الدالة على تطور المبادرة الملاحية في العالم القديم إنما أتتنا من مصر -وهي لِلْمفارقة البلد الذي ارتبط أكثر بالبر- لكنَّ شعب مصر طوّر صناعة الزوارق والسفن تطويرا عظيما أثر في كل مناحي حياة المصريين. ولا ينبغي لحرارة طقس البلد أن تحجب عنا عمق تعلق أهله بتجارة النهر والبحر وأثر ذلك في استقرارهم السياسي وسكينة البلد وتبادلهم مع شعوب نائية عبر البحر الأبيض المتوسط العاجِّ بالسفن السيّارة الناقلة للبشر وللبضائع؛ بما في ذلك أطنان الحجارة المنقولة بغاية بناء الأهرامات. وفي حوالي 2600 قبل الميلاد، كان المصريون يروحون إلى مشرق الشمس لحمل شحنات ضخمة من الأرز، وإلى البحر الأحمر بحثا عن البخور والأحجار الكريمة والحيوانات العجيبة، وإلى إرثيريا لحمل العجائب.
وينتقل بنا المؤلف في الفصل الثالث إلى جنوب غرب آسيا، التي شكلت ملتقى للتبادل الثقافي والتجاري في العالم؛ حيث كانت تأتي السفن من أناطولية والقوقاز ومن وسط وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين، ملتقية برأس خليج فارس، رابطة بين بلاد الرافدين والبراري التي تحيط بالمحيط الهندي وبحاره، فإلى أرخبيل البنغال. وقد طور شعب بلاد الرافدين بدائع الحضارة؛ شأن الكتابة واستيطان المدن نهاية 3000 ق.م. وكان رائدا في الملاحة والقانون التجاري وفي الأدب على نحو ما تشهد به ملحمة جلجامش التي وجدت صدى لها في الأسطورة الإغريقية وفي أساطير الأولين اليهودية والمسيحية والإسلامية. وكانت القصص تسافر من الفرات إلى الشام فإلى باقي البحر الأبيض المتوسط، وكانت أقدم هي الصلات البحرية بالشرق، عبر الخليج الفارسي إلى أراضي البحرين وعمان وجنوب فارس إلى الحدود البحرية لنهر الهندوس.
وفي الفصل الرابع، يقيمنا المؤلف في الشرق، في القرن التاسع قبل الميلاد، فإلى المدن/الدول في اليونان حيث تنهض التجارة بدءا من موانئ صغرى مستقلة؛ فيجوب التجار البحر الأبيض المتوسط ناقلين البضائع والبشر والثقافات. وكان الفينيقيون واليونان الأوائل الذين أسسوا إمبراطورية مستوطنات يجوبون شواطئ صور وصيدا وقادس وقرطاجنة وبيزنطة ومرسيليا... وكانوا أوائل من بنوا السفن؛ لا سيما الحربية منها، وطوروا استراتيجيات لاستعمالها، وأقاموا موانئ منذورة لتيسير التجارة واستكشاف البحار. لذلك ديننا للفينيقيين عظيم: اختراع الأبجدية التي استند إليها اليونان والرومان، لكن أولئك ما تركوا مكتوبات، بينما اليونانيون تميزوا بمكتوباتهم. وفي الفصل الخامس ينقلنا المؤلف إلى قرطاج وروما والبحر الأبيض المتوسط (القرن الثالث قبل الميلاد) حيث تتآكل المدن الإغريقية من إدمان الحروب، وتنمو روما نموها، وتسيطر على الخطوط الملاحية في البحر الأبيض. وما كان لها أن تزدهر لولا إرادة مواطنيها في استعمال البحر للحرب والتجارة، ثم تسيدت وتمددت وغذّت جيوشها بمخازن الحبوب في صقلية وإفريقيا، حتى سمى الرومان ذاك البحر "بحرنا".
وفي الفصل السادس يدير المؤلف دفة سفينته/كتابه هذه المرة نحو التاريخ البحري للمحيط الهندي المنفتح الذي اختلف عن تاريخ البحر الأبيض المنغلق، وكانت السعة هنا رحمة، وما نشبت المنافسات التي حدثت بين شعوب البحر الأبيض، وكان أن انتقلت الخيرات والأفكار انتقالا أيسر. وكان أن دارت التجارة البحرية بين محيط (المحيط الهندي) وبحرين (البحر الأحمر والبحر الأبيض) عبر خليج البنغال والخليج الفارسي، معدة بذلك تجارة ذات نَفَس طويل بدءا من ميلاد الإسلام إلى وصول التجار الأوروبيين في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. ويخصص الفصل السابع للحديث عن الصين والبحر. وقد قارب الصينيون البحر على احتشام. ذلك أنهم آنسوا، أولا، أنهارهم، ثم استألفوا البحار ووسعوا تجارتهم، حتى باتت الصين، على الرغم من ظاهر تحركات الأقوام الأخرى، "المحرك الذي لا يتحرك" للتجارة البحرية ولنشر البوذية.
ويفرد الفصل الثامن للحديث عما يسميه: "البحر الأبيض المتوسط المسيحي والمسلم"؛ حيث يلاحظ بزوغ الأدلوجة الدينية في النزاع السياسي، وعجز الإمبراطورية البيزنطية عن مدافعة انتشار الإسلام، وإحياء المسلمين تجارة الموانئ، وتجديد تقنيات بناء السفن بالاقتصاد في المواد والجهد والمهارة والوقت؛ مما ساهم في انتشارها. على أن الصراع بين الملل أقام حواجز أمام التجارة وأدى إلى أطول الحروب البحرية في المتوسط. ورغم ذلك سعى التجار إلى المصالحة بين مختلف الملل بما خلق أنواع جديدة من تمويل التجارة وانتشار الممارسات القانونية المنذورة إلى حماية شحنات التجار واستثماراتهم. وفي الفصل التاسع يتحدث المؤلف عن أوروبا الغربية في عصر الفايكنج وعن تجارة هولندا والسويد وروسيا وطموح الحكام إلى الاستفادة من عائدات التجارة البحرية الجمركية، منبها إلى أن الفايكنج وإن اشتهروا بفظاظتهم، فإنها ما كانوا أشد عنفا من معاصريهم.
وفي الفصل الموالي، يأخذنا المؤلف إلى ما يسميه "طريق حرير البحار" في عهد هيمنة "دار الإسلام" وتوحد الصين واجتراحها طريق الحرير من بر آسيا الوسطى إلى طريق الحرير عبر البحر. وإذ نشطت الأسواق البحرية عبر طريق التجارة هذا، فقد جذب ذلك التجار حول بحار الرياح الموسمية وساعد في كسب إمبراطورياتهم بعدا كونيا؛ حيث نشأت دائرة من البضائع والثقافات. ويستأنف المؤلف الحديث عن الصين وبالذات إمبراطورية تانغ (618 م- 907 م) التي بشرت بالعصر الذهبي للحضارة الصينية حيث اتسعت الرؤية وازدهرت الفنون وانتعشت الأديان ونمت الفلسفات، وتمازجت بفضل هذه الحضارة العناصر الصينية والعربية والفارسية والهندوسية كل التمازج... ويخصص المؤلف الفصول اللاحقة لمروية صعود الغربيين إلى مسرح العالم بعد ازدهار مدن إيطاليا الكاثوليكية المنقسمة، وازدياد نفوذ التجار الغربيين وتطلعهم إلى السيطرة على الطرق البحرية، وحدوث تسويات رغم اختلاف الملل؛ بما وشى عن بداية ميلاد القانون الدولي الذي عزز الانتشار في ما وراء البحر الأبيض. ثم يأتي العصر الذهبي لآسيا البحرية حيث انتسجت أواصر تجارة مزدهرة ربطت بين غرب وشرق أورو-آسيا القصيين عبر البحر والبر، وشيئا فشيئا بدأ تحول مركز التجارة من البحر الأبيض إلى المحيط الهندي، وتزايدت شهوة الغربيين إلى عطور الشرق ومواد رفاهيته؛ وفي الوقت نفسه دخلت تجارة أقاصي البحار مرحلة نضجها.
وها هو كولومبوس يعبر الأطلسي وجاما يجترح طريقا جديدا بين أوروبا والمحيط الهندي وماجلان يدور حول الكوكب من الشرق إلى الغرب وأوردانيتا من الغرب إلى الشرق عابرين المحيط الهادئ. هي ذي الانتصارات الملاحية لهذا العصر، بل ولكل العصور. وهي الذي مكنت من اجتراح روابط جديدة بين ما لم يكن يتواصل من أقسام العالم، وقادت إلى الصعود الأوروبي على خشبة العالم. وكان لهذه العزيمة ثمن أداه أهل البحر. وبهذا دشن "عصر التوسع" الذي لم يسبق له مثيل، لا بسبب السيولة الخارقة للناس وللأفكار وللثروات المادية، كما للنباتات والحيوانات والأدواء، والتي انتشرت انتشارها عبر العالم، ولكن أيضا لأن الأوربيين باتوا لأول مرة في طليعة العالم؛ فكان أن أنشؤوا شركات بحرية مالكة لسفن ضخمة متنافسين فيما بينهم بل ومتحاربين ومتصدين للقرصنة (القرن 17).
أعقب ذلك تطوير ترسانة البحار التقنية والحربية، وزيادة استكشافات البحار (علم الحيوانات، علم النباتات، على الشعوب) (القرن 18)، وكان من آثار التطوير "إلغاء المكان والزمان" كناية عن تقليص زمن الأسفار البحرية بفضل تسريع حركة السفن واختراع محركات جديدة وتطوير صناعة السفن بحيث ما عادت هي "أسوارا من خشب" (ثيموستوكلس) وإنما باتت "قلاعا من حديد" (تشرشل)، وما صاحبه من فتح القارات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع والبشر؛ مما أثر على إيقاع الحياة في العالم بأسره وبُدُوِّ عصر العولمة، بل والعصر النووي البحري.
وفي الختام، يعتقد البعض أن التغيرات التي شهدت عليها صنعة البحر وصلاتنا به نزعت عن البحر قصته الرومانسية ووعوده، لكن بالنسبة إلى الكثير ما حدث أن شكّل البحر أبدا حلما رومانسيا ببلاد جديدة أو بشارة بربح تجارة؛ وذلك بالنسبة إلى العبيد والخدم والمحرومين، بقدر ما شكل رمز أناس أجانب وأفكار غريبة وأوبئة قاتلة وأعداء أفظاظ وراء البحر. لكن في الوقت ذاته انتهينا إلى إدراك أنه بينما يظهر لنا البحر متقلبا لا يشفق، يبدو أيضا بيئة هشة قابلة أن يفسدها الإنسان، إلى درجة لم يتصورها أجدادنا، بفعل تقنياتنا.
تفاصيل الكتاب:
الكتاب: البحر والحضارة (تاريخ بحري للعالم)
الكاتب: لينكولن بين
الناشر: كنوبف