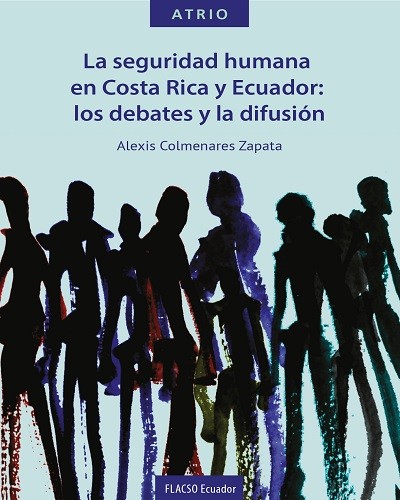أليكسياس كولميناريس ثاباطا
* كلثوم بوطالب
أصبح عالمنا اليوم عالما غير آمن ومحفوفا بالمخاطر، وهي مخاطر محدقة بنا من العديد من الجهات: الأزمات طويلة الأمد والكوارث الطبيعية والأوبئة وفترات الركود الاقتصادي. كلُّ هذه المشكلات وغيرها من الأزمات تتسبب في زعزعة الاستقرار والسلام.
وفي هذا السياق، نشر الكاتب أليكسياس كولميناريس زاباتا أستاذ باحث في معهد الدراسات الوطنية العليا (IAEN) -وهي أول جامعة للدراسات العليا في الإكوادور- كتابه الذي يقدم فيه مفهوم الأمن البشري كمنهج واعد يحتذى به في الإكوادور وكوستاريكا. وكوستاريكا هي عضو نشط في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية وعضو في العديد من المنظمات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. أما الإكوادور، فقد ركزت على النهج المتعدد الأطراف في القضايا الدولية، وهي عضو في الأمم المتحدة وعضو في العديد من المجموعات الإقليمية، بما في ذلك مجموعة ريو، والنظام الاقتصادي لأمريكا اللاتينية، ومنظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية ومنظمات حقوقية عديدة.
ويقدِّم الكاتب مصطلح "الأمن البشري" بوصفه مصطلحا مثيراً للجدل، حيث يتضمن استبدال الرؤية الكلاسيكية لأمن الدولة بنهج يتمركز حول الإنسان. فمنذ أن تم اقتراحه منذ أكثر من عشرين عامًا، أثار نقاشا مستمرا حول نطاقه ومحتواه. وعلى الرغم من ذلك، طبَّقت عدة بلدان في أمريكا اللاتينية هذا المفهوم في العديد من المبادرات المحلية وحتى الإقليمية. وربما يكون من المفيد ملاحظة أن التقارب في الأفكار حول الأمن البشري هو نتاج موجة من الانتشار الإقليمي؛ حيث وصل الأمن البشري إلى هذين البلدين وإلى الجهات الفاعلة ذات الصلة بفعل انتشاره. وناقش مجموعة من المفكرين مختلف التغيرات في النظام الدولي في القرن العشرين، وهي تحولات أدت إلى تغيير وجودي ومعرفي في أفكار الأمن وفي رؤية العالم؛ ومن بين هذه الأفكار كان اقتراح استبدال الرؤية الكلاسيكية لأمن الدولة بالنهج الشامل للأمن البشري الذي يحلّ محل الدولة بوصفه مرجعاً للأمن.
ويؤكد الكاتب على أنّ مفهوم الأمن البشري ليس جديدا في المنطقة، ولكن استخدامه ليس بعيدا في الزمن كما قد يتصور المرء. وقبل عقدين تقريبا، بدأ استخدام هذا المصطلح في أمريكا اللاتينية، ليحل محل المفهوم الذي توفره الدولة للأمن. ولم يكن من قبيل الصدفة نشر المفهوم على نطاق واسع بين مختلف بلدان المنطقة التي اعتمدته من أجل وضع سياسات عامة تتصل بالأمن. ومع ذلك، لم يتم إجراء تحقيق حتى الآن لمعرفة الدوافع الحقيقية التي أدت إلى ترسيخ هذا المصطلح.
وهكذا، وفي سياق العولمة، يتيح تبادل الأفكار والمعارف والخبرات وما إلى ذلك بين مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات العامة والخاصة زيادة الصلة والتقارب بين مختلف أساليب الحكم وآليات تصميم وتنفيذ السياسات العامة. إنّ الهدف الرئيسي من هذا العمل هو الغوص في الكليات النظرية المرتبطة بطرق النقل والانتشار، حيث ينظر الإطار النظري لهذه المسألة إلى انتشار المفاهيم على أنه العملية التي تنقل من خلالها الأفكار والتصورات والمصطلحات القانونية ونماذج السياسات العامة والأطر المؤسسية بين الجهات الفاعلة في وقت معين ومسافة محددة.
ويضيف الكاتب في نفس السياق أن مفاهيمَ نجحت في بلدان أخرى -مثل: القوى السياسية بصفة خاصة، وإصلاح الجهاز البيروقراطي، والإدارة العامة الجديدة، وتصميم نظم المعاشات التقاعدية والصحة العامة- دون تجاهل أمثلة أخرى مثل: زيادة المساواة ومشاركة المرأة في الحياة العامة، على سبيل المثال لا الحصر. ويؤكد أنه مع ذلك، فإن مفهوم الأمن البشري لم يحظ بتغطية كافية في البث الإذاعي خاصة على قنوات البث الدولية وتفاعلها، وهنا تبرز أهمية المفاهيم المنقولة والدور الذي تؤديه المجموعات المولّدة للمعرفة، أو ببساطة المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص في الآراء. وينتهي الكاتب إلى أن الفرضية هنا هي أن هذه المجتمعات التي تولّد المعرفة قد لعبت دورا رائدا في تصور مفهوم الأمن البشري، ولكن لم يتم شرح كيفية انتشاره بشكل كامل. وهذا هو الإسهام الذي يقدمه الكاتب في هذا العمل؛ وهو إظهار الدور الرئيسي لكيفية انعكاس استخدام البيانات والمعارف في المجتمعات المحلية في الأفكار التي تنشر بدورها من خلال وسائل إعلامية مختلفة من أجل التحرك نحو تغيير في مفهوم جوهره الإنسان؛ أي: "الأمن البشري".
ويؤكد الكاتب على أن العولمة أدت لمزيد من الترابط بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وأسهمت في واقع جديد لصنع السياسات، وقد أدّى ذلك إلى زيادة مستوى وسرعة تقارب السياسات بين الدول. وفي هذا السياق، وعلى هذا النحو، يتم نقل الأفكار عبر مختلف القنوات وبمشاركة مختلف المواضيع.
ومن بين التأملات التي يقدمها المؤلف في كتابه الإشارة إلى أنَّه في نهاية القرن العشرين إلى جانب العولمة، بدأ الجدل عميقاً في مجال العلاقات الدولية حول منهج الأمن البشري ومواجهة الرؤية الكلاسيكية التي تركز على حماية الدولة، وظهر منهج جديد يعتبر الإنسان محور العمل والتفكير. وتنشط كلّ من كوستاريكا والإكوادور في الشبكات الدولية المعنية بأمن الإنسان، وأدرجت هذا المفهوم في إطارها القانوني. هذه الوضعية نتج عنها جلب الكثير من المشاريع خاصة بهذا الشأن إلى الإقليم. ولم تكن كولومبيا استثناء أيضا، بما في ذلك هذا النهج الذي اتبع في أعقاب تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويستعرض الكاتب في الفصل الأول النظريات والمفاهيم المتعلقة بتحليل نشر سياسات الأمن البشري في كوستاريكا والإكوادور، انطلاقا من زاوية نظرية تعددية حيث تجتمع عناصر العقلانية (الحوافز والجزاءات والتكاليف والفوائد)، وعناصر البنائية (الضغط المعياري وتغيير المعتقدات والاعتبارات الرمزية). وخصص الكاتب هذا الفصل لافتحاص السمات الرئيسية والافتراضات والنقاشات حول مصطلح "الأمن البشري".
ويُؤكد الكاتب أن مفهوم "الأمن البشري" مفهوم متكامل ومتعدد الأبعاد يركز على الأشخاص بوصفهم مرجعاً أساسياً للأمن؛ ووفقا لذلك يعيش الإنسان حرًّا متحررا من العوز والخوف. ويضيف الكاتب أن أهمية الأمن البشري في نظام الدراسات الدولية يكمن في مساهماته من خلال الآراء الليبيرالية والمناهج النقدية. يهدف الأمن البشري للحماية من التهديدات المحتملة والمتمثلة في سبعة مجالات: الاقتصادية والغذائية والصحية والبيئية والشخصية والمجتمعية والسياسية. وهذه الخصائص تجعل الأمن البشري يتطور بوصفه مفهوما شموليا ومتمركزا حول الإنسان على عكس بعض المفاهيم الأخرى. تشمل مفاهيم الأمن البشري التصدي لمجموعة من التهديدات مثل الفقر وسوء التغذية والمخاطر البيئية والبطالة والجريمة والعنف الأسري.
ولأنَّه من الصعب تحديد مفهوم الأمن البشري، يقدِّم الكاتب في الفصل الثاني نظرة عامة حول هذا المفهوم كما تم تداوله في كوستاريكا والإكوادور؛ من خلال منهجية الخرائط المفاهيمية حتى يتسنى للفاعلين فهم منهج الأمن البشري في جميع أبعاده بناء على الفكرة والتصنيف والتوصيف والتمايز والتقسيم الفرعي وتمثيل المصطلح وتحديد الاختلافات الموجودة بين البلدين.
ومن بين الخلاصات التي توصَّل إليها الكاتب في دراسته أنَّ كوستاريكا بلد له جدول أعمال نشط في تعزيز حقوق الإنسان والأمن البشري، وعلى العكس من ذلك في الإكوادور منهج الأمن البشري له صدى أقل، ذلك أنّ الأعراف والعادات والتقاليد وهوية الدولة يؤثران على كيفية تلقي مفهوم "الأمن البشري" وتداوله وتثبيته وممارسته.
ويناقش الكاتب في الفصل الثالث تطور المجتمع البشري في شأن الأمن البشري من خلال دراسة الحالتين (الإكوادور وكوستاريكا) استنادا إلى المكونات الأربعة (القناعات المعيارية، المعتقدات المشتركة، النتيجة-السبب، مفاهيم مشتركة حول الصلاحية وبدائل السياسة)، كما يناقش كذلك أفكار المجتمعات المعرفية المتعلقة بالأمن البشري كحقوق الإنسان والتنمية البشرية، فضلا عن الأمن المقيد والموجه نحو أمن الدولة، ويؤكد الكاتب أنه من الضروري الانتباه إلى الديناميكيات الداخلية التي تعزز نهج الأمن البشري؛ بحيث لا يكفي تحليل مستوى تطور المجتمع المعرفي بقدر ما هو ضروري فهم درجة تأثيره لإدراك دوره في عملية الانتشار.
ويحاول الكاتب خلال الفصل الرابع دراسة كيفية نشر الأفكار ومعايير وسياسات الأمن البشري في كوستا ريكا والإكوادور عن طريق تحديد طبيعة آليات الانتشار العقلانية والفكرية، ويقصد الكاتب بطرق النشر الطرق التي يمكن أن تؤثر بها الجهات الفاعلة في قرارات جهات أخرى بواسطة آليات الإكراه والمنافسة والمحاكاة والتعلم وصلته بالمجتمعات المعرفية، إضافة إلى وسائل الإعلام وأدوات التبليغ والصحافة والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وبهذا يمكن فهم انتشار مفاهيم الأمن البشري وتحديد العملية التي من خلالها بلورة فكرة ما أو سياسة ما في هذا السياق.
ويقوم الكاتب بدراسة السياق الذي نشرت فيه المفاهيم الخاصة لنهج الأمن البشري في البلدين أخذا بعين الاعتبار دور المنظمات الدولية والقوات المسلحة والأكاديميين والحكومة. وفي المقابل، يحلل رفض ومقاومة أفكار الأمن البشري عند بعض الجهات المؤسسية الفاعلة (الوطنية والدولية) وتحفظها.
ويضيف الكاتب أن نشر أفكار الأمن البشري في كل من نطاقه الواسع أو المقيد يظل مشروطا من قبل بعض الجهات الفاعلة التي تولدت لديها معرفة بهذا النهج أو -على العكس من ذلك- الجهات التي أثارت مقاومة ضد هذا المفهوم؛ على سبيل المثال في كوستاريكا: تنتمي هذه الجهات إلى مجتمع حقوق الإنسان وبدرجة أقل من مجال التنمية البشرية. وينتهي الكاتب إلى أنَّ آليات النشر في كوستاريكا والإكوادور مرتبطة بالمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والحكومية ووجود أو عدم وجود القوات المسلحة. وهذا يعني ضمنا أن الجهات المعرفية تلعب دورا مهما في تقبل أو رفض نشر أفكار وسياسات الأمن البشري.
كما يعرضُ الكاتب الآليات ومجموعة من الأفكار التي تم تفعيلها في كلا البلدين، ويوضح كيف تم تحويل تبني منهج الأمن البشري من قبل الجهات الفاعلة الاجتماعية كمؤسسات التعاون الدولي والأوساط الأكاديمية أو القوات المسلحة كما هي الحال في الإكوادور. عمد الكاتب في هذا العمل إلى استخدام جميع عناصر الخرائط المفاهيمية لتحليل الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالأمن البشري.
وتكمُن أهمية هذه الدراسة في تحليل الدور المعرفي للمجتمع في حقوق الانسان في كوستاريكا والإكوادور في نهج الأمن البشري. ويشير الكاتب في دراسته إلى أن أوساط حقوق الإنسان اضطلعت بدور غامض في نشر نهج الأمن البشري في كوستاريكا الذي يتقوقع بين القبول والرفض، فآليات الإكراه والمنافسة والتنشئة الاجتماعية يمكن أن توثر على الجهات الفاعلة بخلاف الدولة أو الحكومة مثل المنظمات الدولية. فقد غيّر مفهوم " الأمن البشري" نظرة العالم والجهات الفاعلة الدولية من خلال التشكيك في المنظور السائد والقائم على أمن الدولة ومن خلال التركيز على حماية الأفراد (الحماية ضد العنف وتأمين الاحتياجات الأساسية).
ويعدُّ هذا الكتاب إسهاما جيدا في ميدان العلوم السياسية ومجال العلاقات الدولية؛ حيث يعزز النقاش المستمر حول التركيز على التفكير في السياسات العامة لهذا المجال، وذلك بالتأكيد على مفهوم جديد في التطور المستمر والمؤثر أثناء تصميم السياسات العامة على الأمن في المنطقة، ويكتسي هدا التحول أهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا اللاتينية، حيث تتعرض الحياة باستمرار للتهديد من قبل مختلف أنواع العنف.
كما يُجيب هذا الكتاب المهم عن كثير من الأسئلة المرتبطة بمفهوم الأمن البشري الذي أضحى منهجاً مطروحا بقوة، ومنه فإن المسألة البحثية الواردة في هذا الكتاب تدور حول كيفية انتشار مفهوم الأمن البشري في كوستاريكا والإكوادور بين عامي 2001 و2016. وتنشأ، بدورها، بعض المتغيرات مثل الآليات التي تؤدي دورا رائدا في نشر المفهوم، أي من خلال طرح السؤال المتعلق بكيفية نشر بعض المفاهيم أو الإجراءات وسبب نشرها أو من فاعل إلى آخر، وهي إشكالية ظلت موضوعاً للعلوم الاجتماعية. ومنه فإن نقطة انطلاق هذا العمل هي المشكلات النظرية المتعلقة بعمليات النشر أو التبليغ، وبشكل عام؛ يمكن فهم النشر على أنه العملية التي تنتشر من خلالها الأفكار أو المعايير أو السياسات أو المؤسسات.
وتُعتبر قضية الأمن البشري في البلدان العربية قضية مهمة والتي تعتبر أساسا قضية إنسانية واجتماعي وسياسية، لا يمكن الفصل بينها وبين مختلف قضايا الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان والديموقراطية. ويبدو لي أنه من المهم جدا توسيع مفهوم الأمن البشري -في بلداننا العربية وفي العالم أجمع- ليخرج من دائرته والتي تعد ضيقة والتي لا تتعدى حماية الإنسان من العوز والخوف، ليطال مجال الحروب والمواجهات العسكرية؛ وبالتالي خلق رؤية فكرية جديدة للحدّ من أي عدوان يهدد سلامة واستقرار البشرية. كما أنه قد يكون مفيدا للمكتبات العربية إذا اهتمت بمثل هذه الدراسات الأساسية والتأسيسية في مجالها وترجمتها عن اللغات الأجنبية لتغني رفوفها وتكون مرجعاً أساسيا للباحثين في قضايا الأمن البشري وأدب الأزمات، خاصة في مثل هذه الظروف التي يعرفها العالم من أزمات صحية وكوارث طبيعية وحروب. ومن بينها هذا الكتاب الذي يستحق أن يطلع عليه القراء، ليتعرفوا على وجهات نظر باحثين ينتمون على مناطق بعيدة عن المركزية الأوروبية وعانت ما عانته بلداننا من وسمها بدول الهامش، أو الدول المُستَعمرة، كما أن الكاتب يكتب بلغة سيرفانتيس، وهي لغة قدمت للمكتبات الكثير من الدراسات المهمة في شتى المجالات. وربما يكون الاطلاع على مثل هذه الدراسات وسيلة لاستنبات مفهوم الأمن البشري وتداوله في المجال الثقافي العربي.
تفاصيل الكتاب:
الكتاب: الأمن البشري في الإكوادور وكوستا ريكا.. جدل وانتشار
الكاتب: أليكسياس كولميناريس ثاباطا
الناشر وسنة النشر: يناير 2021 - Editorial FLAKSO Ecuador
عدد الصفحات: 176 صفحة
لغة الكتاب: الإسبانية
* باحثة في جامعة محمد الخامس-الرباط