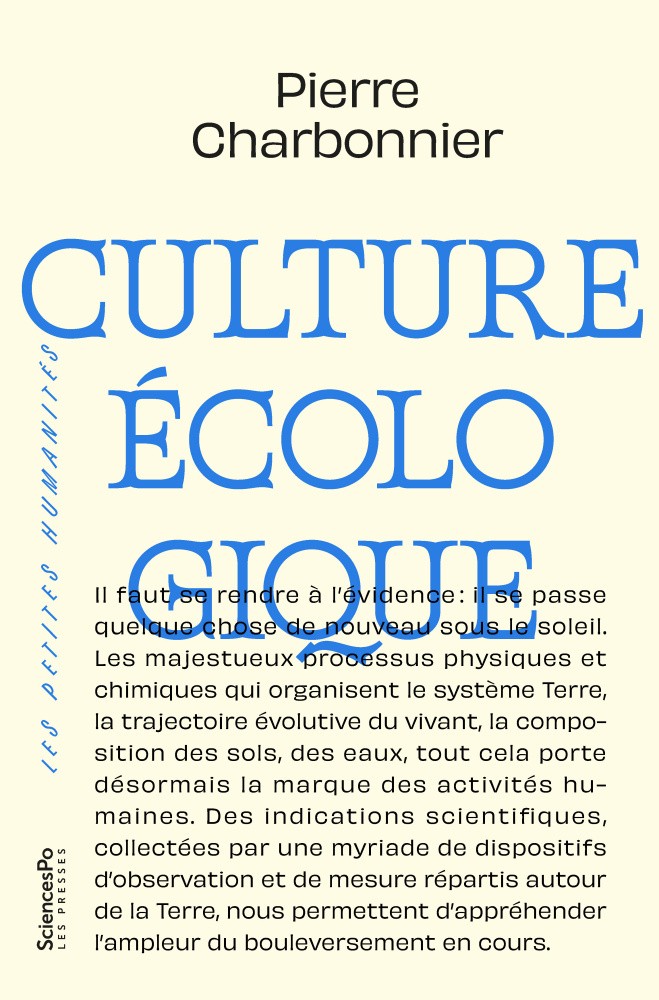بيير شاربونييه
سعيد بوكرامي
هناك أمور جسيمة وجديدة تحدث تحت سمائنا، منها العمليات الفيزيائية والكيميائية المثيرة للقلق التي تتحكم في النظام البيئي للأرض، والمسار التطوري للكائنات الحية، وتكوين التربة والمياه، كل هذه الظواهر البيئية تدل الآن على أنَّ الأنشطة البشرية تغير الطبيعة وتسير بها نحو أزمة حقيقية ووضع دراماتيكي.
تأتي الاهتمامات البيئية لتفتح ثغرات في المفاهيم السائدة للتقدم والتنمية والثروة، وبشكل أوسع، في الفكرة نفسها التي تصورناها عن التعايش الاجتماعي. تهدف الثقافة البيئية إلى لفت انتباه أكبر عدد ممكن من الناس إلى المناقشات التي تنظم المسألة البيئية اليوم. تجمع هذه المناقشات بين علوم الأرض والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد، فضلاً عن الفلسفة. وهي تدعو جميعها إلى مساءلة تنظيم المعرفة والأعراف السياسية والإطار التقني للطبيعة.
اشتهر بيير شاربونييه من خلال كتابه: " الوفرة والحرية" ذي الطابع الأكاديمي الصادر عام 2020 الذي واكبته تغطية إعلامية واسعة، أما في كتابه الجديد "الثقافة البيئية" فيقترح دليلًا إجرائيا موضحًا بالصور والبيانات والمراجع. قد يكون الكتاب موجها للطلبة أو أي مهتم يرغب في أن يطلع على تنوع القضايا الرئيسية والمراجع الأساسية التي أثارتها بداية "الأزمة البيئية"، لذلك يقدم هذا الدليل نظرة عامة فعَّالة للسماح أيضا لغير المهتمين والمبتدئين كي يجدوا اتجاهاتهم، والحصول على الوسائل لتعميق النقاط البيئية التي تبدو لهم أكثر حسماً. ومع ذلك لا يتوقع القارئ تفاصيل عميقة ومتخصصة، لكنه بالمقابل سيجد في نهاية كل فصل من الفصول الثمانية، إشارات ببليوغرافية مفيدة للغاية تجمع بين المراجع الأكاديمية الأكثر صرامة (المنفتحة على اللغة الإنجليزية)، وعناصر من الثقافة الشعبية (من الأفلام إلى الرسوم المتحركة)، وخاصة تلك المقالات ومقاطع الفيديو المتاحة على الإنترنت.
يبدأ الفصل الأول من أصول البشرية ثم يعالج بعض الحقائق الرئيسية للحياة وعلوم الأرض ("الأكسدة الكبيرة"، "المنطقة الحرجة" أو "فرضية غايا"). ومن عصور ما قبل التاريخ البشري، يستخلص المؤلف هذا الدرس المقنع: "التكنولوجيا هي بُعد جوهري للواقع البشري. بعبارة أخرى، لا يعرف الإنسان العاقل علاقة أخرى بالعالم غير تلك التي خبرها بواسطة الأدوات"(ص 33). من ناحية أخرى، فإن الملاحظة التي تفيد بأنه "حتى فترة قريبة، من القرن التاسع عشر، كان تاريخ الأرض يقدم أساسا من خلال الروايات اللاهوتية" (ص 36) لكن تبدو هذه الملاحظة مبالغا فيها: وهذا يعني أننا نسينا بسرعة التقليد الفيزيائي بأكمله، الذي اقترب بالفعل من الظواهر الجيولوجية والبيولوجية دون ربطها بأغراض الوجود البشري. كما ترسخ الحداثة، هذا التناقض في صميم علاقاتنا مع البيئة: "لا يمكننا حماية الطبيعة إلا إذا افترضنا مستوى معينًا من الهيمنة على العمليات التي تنشطها" (ص 50). وينتهي القسم بالحاجة إلى إعادة التنمية الاقتصادية كلها إلى قاعدتها "الأيضية" أو "الطاقيّة"، حيث يلعب البعد الاستعماري دورًا رئيسيًا.
أما الفصل الثاني، وهو من أكثر الفصول إثارة، فيتناول "ثورة العصر الحجري الحديث" بحيث يبرز الكاتب كيف أن تفسيرها يقع في قلب تمثيلاتنا السياسية والدينية. في الواقع، ترتبط "الأساطير السياسية الحديثة" بأكملها (ص 89) بشكل وثيق بالتطور الذي أتاحه هذا التعميم للزراعة والثروة الحيوانية بالمؤسسات السياسية المركزية (الدولة) والنظام الاجتماعي غير المتكافئ. ومع ذلك، وبعد تطرقه إلى أعمال ديفيد غريبر وريمي حداد، يؤكد المؤلف أن نمط الإنتاج الزراعي يمكن أن يتعايش مع أنظمة اجتماعية مختلفة تمامًا، بدون إدراجه في "ثورة العصر الحجري الحديث"، كان التطور الاقتصادي والتقني والاجتماعي الذي عشناه مجرد إمكانية يتيمة من بين أمور أخرى كافية "لإعادة فتح احتمالات سياسية شتّى" (ص 90).
يبدو الفصل الثالث من أكثر الفصول إثارة للتساؤل من وجهة نظر فلسفية. فهو يفحص موضوع "الحداثة التي نشأت منذ القرن السابع عشر في أوروبا الغربية" (ص 97)، بناءً على مفاهيم العلم والتقدم والغزو الإقليمي. لكن المؤلف نفسه يستسلم لرواية غائية تبسيطية: تقول بأن "الفيزياء اليونانية طبعت بالميتافيزيقيا حتما" (ص 99)، والتي ينسبها العلم الحديث منذ غاليليو إلى المنطق الديكارتي أو صيغة "الرياضيات العالمية" (ص 99). لا شيء أبعد عن الحقيقة: في الواقع، لم تختف الشحنة الميتافيزيقية للعلم مع الحداثة، بل على العكس تمامًا، ومن حسن الحظ أن النهج التجريبي أو الوصفي كان يمارس قبل القرن السابع عشر. تمتد هذه المقولات المجانبة للصواب عندما ينسب المؤلف إلى ديكارت استقراءً لنجاحات المنهج التجريبي "مثل القدرة المطلقة للعقل البشري على مواجهة الطبيعة" (ص 100). عموما، يعتبر هذا الاستحضار للعلم الحديث الجزء الأكثر هشاشة في الكتاب، وخير مثال على ذلك التسلسل الزمني غير المؤكد للعلماء الوارد ذكرهم مثل: "كوبرنيك، وغاليليو، ونيوتن، ثم لايبنيز و كارل لينيوس " (ص 102). من خلال نقل هذه الرؤية المتجانسة لظهور العلم الحديث، يقلل المؤلف من كل إمكاناته. إنه يمنع بالضبط ما ينوي الترويج له، من إعادة القراءة البيئية للحداثة - "إعادة كتابة معرفتنا بالماضي في ضوء المشكلة البيئية" (ص 327) مما يعني إعادة اليوم فتح إمكانات الفكر الحديث، وعدم إغلاقها جميعًا على عقلانية باردة ومدمرة.
يركز الفصل الرابع على "التناقضات المادية" (ص 137) للرأسمالية، ويقدم، بواسطة صياغة التاريخ والفلسفة والاقتصاد، نظرةً ثاقبة وعامة: بدءا بمفهوم الاشتراكية عند بيير ليرو (ص 143) إلى مفهوم "المشاعات"، مروراً بـ "منحنى كوزنتس البيئي" (ص 146)، دون أن ننسى مدينة الحدائق لدى إبينيزر هوارد (ص 150). يقترح المؤلف بطريقة مثيرة للاهتمام أن "توصيف البرية كمصدر للخطر يلعب دورًا مركزيًا في إضفاء الشرعية على الافتراس البيئي" (ص. 144)، ثم يستدعي بعد ذلك العلاقة الوثيقة "بين الحرب والافتراس البيئي" ( ص 163) ويستدل عليه بمفهوم "الإبادة البيئية" الذي ظهر على وجه التحديد في سياق الحرب في فيتنام.
أما الفصل الخامس، فيوجه "انتقادات مختلفة للتقدم"، مستحضرا عدة شخصيات منها البريطاني توماس كارلايل (الذي ندين له بإدخال مصطلح "البيئة"، ص 175)، وما كتبه جون روسكين وويليام موريس. وعند ذكره "للنقد التبعي"، فإن المؤلف يستحضر بروعة أفكار غاندي وفلسفته البيئية، الذي "يُخضع التوقعات المادية من أجل الحفاظ على الروح" (ص 189). إن استنتاج هذا القسم بسيط ولكنه مهم: فهو يشير إلى "التناقض الأيديولوجي" في علاقته بالطبيعة (ص. 182) مثيرا السؤال الذي لا يزال مطروحا وبإلحاح "عن الطبيعة التقدمية أو المضادة للتقدم للبيئي" (ص 197) ).
بينما يناقش الفصل السادس التيارات الرئيسية الثلاثة للحركة الاجتماعية البيئية، فيهتم أولاً بـ "البيئة العالمية"، التي روجت لها المؤسسات الدولية منذ منتصف القرن العشرين، حول الشخصية المربكة لجوليان هكسلي (مؤسس الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) والصندوق العالمي للحياة البرية، والرائد في تحسين النسل). ثم يدرج الكتاب، مبادرات الستينيات، مع حملة "حماية البيئة في الشمال والجنوب"، بدءا بمساهمة راشيل كارسون وصولا إلى جوان مارتينيز أليي. ويعتبر هذا الفصل من أعظم نقاط قوة هذا الكتاب؛ لأنه يأخذ في الحسبان تمامًا الأدب القادم من الجنوب. وأخيرًا، يناقش المؤلف "البيئة الحزبية" منذ سبعينيات القرن الماضي، عند أندريه غورز، وإيفان إليش، ورودولف باهرو، وخصوصا مع ظهور "الأحزاب الخضراء" في أوروبا. وهنا، ينتهي بيير شاربونييه إلى الموافقة على فلسفتها البيئية، دون التعمق كثيرا (لأن الصيغة لها نبرة نيوليبرالية خطيرة)، خصوصا ما يروج له عن فكرة "أزمة دولة الرفاهية" (ص 237)، ولا يطرح بما فيه الكفاية صيغا متناقضة بشكل واضح عن الائتلاف البيئي الذي "يجمع جزءًا كبيرًا من الفئات الاجتماعية الأكثر تعليماً" (ص 237) بينما "تظل الطبقات الشعبية والعاملة منكفئة تعتمد هيكليًا على المصفوفة الإنتاجية" (ص 236). أليست هذه علامة على تعثر في التفكير؟ ويدل على ذلك "النزعة البيئية لدى الفقراء" في أوروبا، التي يجب أن تدمج بشكل أفضل في مصير وقيم الطبقات الاجتماعية الأقل حظًا؟ لا ينحاز المؤلف إلى هذه المشكلة الأساسية للإيكولوجيا السياسية، بل يقتصر على ملاحظة أن "ولادة الأحزاب الخضراء تعكس الانقسام داخل الحركة اليسارية" (ص 238).
يفحص الفصل السابع "اقتصاديات تغير المناخ" من جوانبها الثلاثة. يدرس بداية "الرأسمالية الخضراء" وإجراءاتها غير الفعالة، بناءً على المفاهيم الاقتصادية الرئيسية "القيمة الخارجية" و"رأس المال الطبيعي": يرى المؤلف أن ثمة "مصادرة للمستقبل من قبل المصالح قصيرة الأمد" (ص. 260-261). إنها "الصفقة الخضراء الجديدة" الأكثر إقناعًا من حيث "إعادة بناء حل وسط اجتماعي. قادر على دمج حدود الكوكب" (ص 269). في مواجهة هذا السؤال الجوهري، حول "إشكالية محرك الخوف في السياسة الحديثة" (ص 264)، من الواضح أن استقلالية السوق لم تعد قادرة على الطمأنة: على العكس من ذلك، فقد صارت "عامل مخاطرة "مقابل إجماع حول التقارب بين ما هو اجتماعي وإيكولوجي "(ص 267). نحن نشترك عن طيب خاطر في مشروع"الصفقة الخضراء الجديدة"، حتى لو لم تحدد المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية (العزل الحراري بدلاً من السيارات الكهربائية؟) ولا مسألة التمويل (مسألة عدم المساواة، مع تحديد مستوى الثروة وإخضاعه للضريبة). ثم يناقش المؤلف بعد ذلك تيارات "تراجع النمو، النسوية البيئية وما بعد الاستعمار" من الواضح أن "تراجع النمو" ليس نعمة، لأنَّ المؤلف لا يرى فيه سوى مشروع نظري، "يترك إمكانية التعبئة الاجتماعية الملموسة غير واقعية"، ويشكل " نداء سلبياً لا يعطي المضمون السياسي للمشروع البديل المزمع بناؤه خصوصيته المطلوبة "(ص 279). ويبقى السؤال المثير للاهتمام، حول ما عملت عليه النسوية الإيكولوجية طوال سنوات نضالها بحيث اقترحت "إعادة اختراع الإنتاجية" التي من شأنها أن تتجاوز الهوس الإنتاجي من خلال إعطاء قيمة أكبر لعمل "إعادة الإنتاج" (ص 284)، وهو ما يضمن المحافظة على الموارد وتوفير وظائف للمجموعة الاجتماعية الأساسية.
يتناول الفصل الثامن العلاقة بين البشر والبيئة عامة ملحا على الحاجة إلى "تنمية الروابط التي توحدنا"، (ص 321)، إلى أي مدى تتطلب المشكلة البيئية "ثقافة" مناسبة لفهمها، بناءً على مجموعة كاملة من المعرفة. تلك على وجه الخصوص لا تنشأ إلا من الاهتمام الموجه لعلاقاتنا مع الحيوانات، والتي يمكن أن تنشأ عنها معايير أخلاقية جديدة: وبالتالي، فإن "مرافقة الأطفال للحيوانات البرية أو الداجنة ومعرفة الترابط البيئي الأولي، يمكن اعتباره شرطًا من شروط التماسك الاجتماعي "(ص 300). يستحضر المؤلف بعد ذلك "الإيكولوجيا الزراعية"، لكنه يخلط بين "اليوتوبيا الملموسة" و "اليوتوبيا الحقيقية" فيما يتعلق بما كتبه إريك أولين رايت (ص 306) ما هو نوع المجتمع الذي يمكن أن ينشأ من استيعاب القيود المناخية؟ وهنا يطرح الكتاب سؤالا ذكيا. وفي السياق ذاته يذكر الكتاب إجراءا ملموسا مهما، ونقصد به "الأسبوع المؤلف من أربعة أيام" (ص 309) للحد من استخدام وسائل النقل الملوثة. كما يستنتج المؤلف أن "دمج العدالة الاجتماعية لإعادة تنظيم المجتمع لم يعد مسألة بديهية" (ص 313): "هل الاهتمام البيئي يتحدد بالكامل من خلال الانتماء الطبقي إلى فئة ميسورة أو يمكن دعمه بواسطة كتلة من السكان بما في ذلك الطبقات العاملة المنتقدة والواعية؟ (ص 312). وهذه معضلة أخرى تتمحور حول ما نسميه بالنطاق الديمقراطي الكامل للقضية البيئية، التي لا تزال دون حل.
وفي الأخير تدعونا خاتمة الكتاب إلى فرض منهاج تعليمي ل"الثقافة البيئية" في المدارس، يشمل معرفة بالآلات والبنى التحتية الأولية ("محطات الطاقة، وتنقية المياه، والتخلص من النفايات" ( ص 329). ليصبح المواطن مطلعًا على هذه القضايا الأساسية، يجب التمسك بفكرة "محو الأمية البيئية للمجتمع" (ص 325) لأن معلمي التكنولوجيا في المدرسة الإعدادية، ومدرسي علوم الحياة والأرض في المدرسة الإعدادية والثانوية، يواجهون هذا التحدي بالفعل. علاوة على ذلك، لم يكن "التعليم والتدريب على الثقافة البيئية" يهدف إلى خوض حراك بيئي من أجل محاربة توحش وتوغل الليبرالية الجديدة، وإنما هدفه غرس المبادئ الأولية البسيطة للحفاظ على البيئة التي تبيَّن أنها غير كافية وليست فعالة أمام الأزمة البيئية الخطيرة القادمة مع المنتصف الثاني من القرن الواحد والعشرين.
تفاصيل الكتاب:
الكتاب: الثقافة البيئية
المؤلف: بيير شاربونييه
دار النشر: باريس منشورات Sciences Po
سنة النشر:2022
عدد الصفحات: 333 ص
اللغة: الفرنسية.