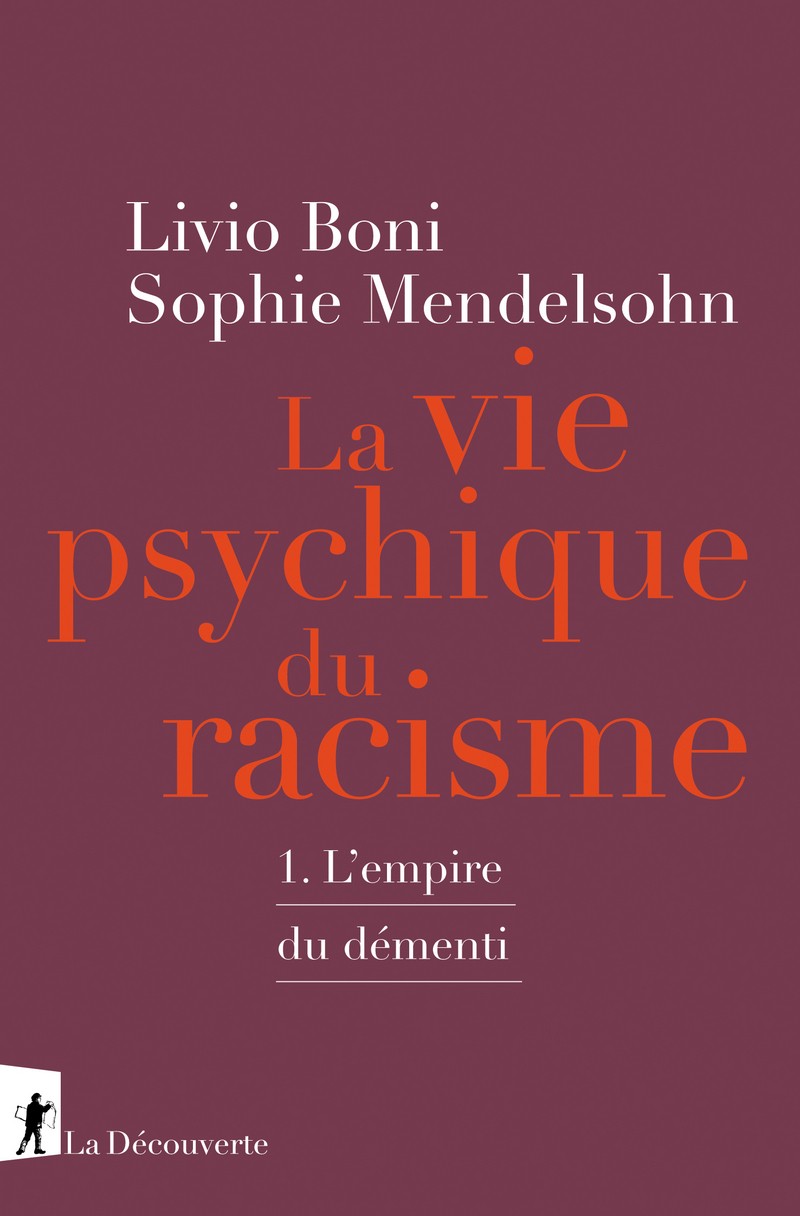ليفيو بوني وصوفي مندلسون
سعيد بوكرامي
اليوم، من غير المُمكن تصديق مبررات علم الأحياء أو الأنثروبولوجيا حول أسباب العنصرية وتمثلاتها، كما كان الحال عليه في ذروة الفترات الاستعمارية السوداء، على الرغم من أنَّ قضية العنصرية لم تختف بعد، لأنَّ استمرارها الغامض والمُستفز يستمد حيله وأسبابه من اللاوعي وتأثيرات الأفكار المترسّخة منذ الطفولة وما ينتج عنها من تمثلات وتأويلات ومظاهر اجتماعية.
ينطلق هذا الكتاب الهام للبحث عن آثار العنصرية في الحياة النفسية والاجتماعية الموروثة من تاريخ يعتمد إلى حد كبير على الانقسامات الاستعمارية الكبرى، والذي أصبح تدريجيا مطموسا في عصر ما بعد الاستعمار. وللتنقل الموجه بين هذه المسارات الملتوية والمؤلمة التي طواها بعض النسيان، كان من الضروري الاعتماد على مساهمة أوكتاف مانوني عالم الإثنولوجيا والفلسفة وعلم النفس التي لم تحظ بكثير من الاهتمام. هذا الفيلسوف الذي جاء متأخرًا إلى التحليل النفسي، كان قد ترعرع طيلة ربع قرن في المستعمرات قبل أن يبدأ عملية "إنهاء الاستعمار الذاتي" بالتزامن مع محاولة وصف الجانب اللاواعي للمشهد الاستعماري والمتمثل في قسوته ووحشيته ولكن أيضًا في هشاشته الحميمة، والذي طال امتداده إلى الآثار طويلة الأمد لدى كل من المستعمِرين والمستعمَرين السابقين.
من خلال تحليل هذه الرحلة بأصدائها وانتقاداتها وتكرارها، يستكشف مؤلفا كتاب (الحياة النفسية للعنصرية: إمبراطورية الإنكار ليفيو بوني وصوفي مندلسون) الينابيع اللاواعية للعنصرية انطلاقاً من آليات الإنكار، وبذلك يستجليان تاريخا ثانويا من التحليل النفسي الفرنسي، والذي كانت له علاقة بالمسألة العرقية حتى قبل أن يبرزه فرانز فانون علنًا ويعلنه جاك لاكان قائلا إنه بمجرد انتهاء دورة الاستعمار فإن "العنصرية سيكون لها مستقبل واعد".
وبينما ساد في السنوات الأخيرة تشكيك متواصل في الفعالية السريرية والملاءمة لنظرية التحليل النفسي فإنَّ عمل ليفيو بوني وصوفي ميندلسون يقدم تأملاً ذا قيمة تتساوق مع ما يتطلبه التحليل النفسي في مواجهته للموروثات الاستعمارية. لهذا قام المحللان النفسيان المعروفان، بتطوير تحليل يجمع بين التحليل النفسي والتاريخ والأنثروبولوجيا من أجل مساءلة الفكر العرقي في المجتمعات المعاصرة. وبهذا ينضم المؤلفان إلى الأعمال الحديثة التي، من وجهة نظر التاريخ والفلسفة، لا تشكك فقط في تاريخ العنصرية ولكن ببصمة النموذج العنصري في بناء المجتمعات الحديثة والتأثير على تكوينها النفسي والثقافي وبذلك، فإن القيمة العظيمة لهذا العمل ترجع إلى براعة المعالجة النظرية، التي تعتمد أكثر على الأعمال المبكرة للمحلل النفسي أوكتاف مانوني، وبقدر أقل على قدرته على مساءلة الحقائق السياسية المعاصرة.
في حين يعتبر أوكتاف مانوني اليوم أحد أكثر المحللين النفسيين احترامًا في جيله، فإنَّ كتاباته المبكرة المرتبطة مباشرة بتجربته الاستعمارية، لا تزال مهملة إلى حد كبير في فرنسا. ولد مانوني في لاموت بيوفرون عام 1899، ودرس الفلسفة ثم درّسها لبضع سنوات في فرنسا، قبل أن يرحل إلى المارتينيك عام 1925، ثم جزيرة لاريونيون عام 1929 وأخيراً مدغشقر عام 1931، حيث مكث إلى غاية عام 1947. بينما كان في عام 1945 قد شرع في إنجاز أعماله رفقة جاك لاكان، وكانت تجربته الاستعمارية هي الدافع وراء تأملاته التحليلية الأولى. بعد عدة مقالات، نشر أول عمل له في عام 1950 بعنوان: "سيكولوجيا الاستعمار"، والذي استكشف فيه الينابيع النفسية لـ "الوضع الاستعماري"، وهي الفكرة التي كان أول من صاغها ثم تناولها بعده آخرون وعلى نطاق واسع. بداية مع عالم الاجتماع جورج بالاندية من خلال ربطه الديالكتيك الهيغلي المكرس لفهوم السيد والعبد، بالفينومينولوجيا الذاتية والوجودية السارترية. يتصور مانوني الوضع الاستعماري على أنَّه التقاء بين "عقدة النقص" الخاصة بالمستعمر الفرنسي و"عقدة التبعية" الخاصة بالمستعمَرين الملغاشيين. وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ عقدة النقص عند المستعمِر لا تشير بأيِّ حال من الأحوال إلى شعور بالنقص، ولكنها تختم الحاجة المنهجية لدرء خطر الدونية عن طريق الاستيلاء على الآخر. أما عقدة التبعية فهي تشير من جانبها إلى "تثبيت العلاقة بالسلف، كنوع من الرابطة الروحية مع الأب الميت، يستحيل معها أي صراع حقيقي" (ص 50)، مما يضع الملغاشيين في حاجة إلى الهيمنة، معتمدا في تحليله على مصطلح " فزارا" كمثال، الذي يشير في الثقافة الملغاشية إلى كل من الجد والأجنبي على حد سواء. يُثْبِتُ مانوني أن قدوم المستعمر قد فاقم من عقدة التبعية هذه. وهكذا، سيحل الفرنسي تدريجياً محل السلف/ والأب الروحي، ليصبح الموضوع المُميز لعقدة التبعية الذي تشكل كردة فعل تجاه القلق من الإخصاء. بالنسبة إلى مانوني، فإن الوضع الاستعماري قائم على التكامل النفسي، حيث يخفي إشباع المصالح السياسية والاقتصادية إشباعًا غريزيًا فقط، والأبعاد الليبيدية للهيمنة تجد نفسها محجوبة بواسطة الهيمنة الموضوعية (الاقتصادية، والطبية، والعسكرية، وغيرها).
قوبل تفكيك مانوني للجدل النفسي الاستعماري بريبة كبيرة من طرف معاصريه، لأنه في نظرهم يسيئ للملغاشيين بوسمهم بعقدة التبعية، لهذا يوجه الكاتب إيمي سيزار اتهاما لاذعا لمانوني بأنه يعيد النظر في أكثر الكليشيهات العنصرية المبتذلة تحت ستار التنظير الفكري. وعلى نفس المنوال، احتج عليون ديوب أيضاً على كتابات مانوني التي يشير فيها إلى أنه إذا كانت مدغشقر مستعمَرة، فهذا خطؤها في النهاية. ثم جاء نقد الطبيب النفسي فرانز فانون ليكمل هذا التلقي الغاضب. في عام 1952، وبمناسبة نشر كتاب "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء"، خصص فانون فصلًا لـ"عقدة تبعية المستعمِر المزعومة" واتهم مانوني بجعله عقدة النقص حقيقة موجودة مسبقًا ودافعاً ملحاً للاستعمار. كان سوء الفهم بينهما كبير. يشدد بوني ومندلسون، مع ذلك، على أنه لا ضرورة لاختزال هذه المناقشات إلى تكريس فكري كاريكاتوري. إن عدم إدراك فرضيات مانوني هو في الواقع إغفال لبعض ما بلوره فانون من أفكار تعتمد وتعترف، علاوة على ذلك بـأهمية المنهج المانوني. وأخيرًا، "يبدو الأمر كما لو أنه لم يكن من الممكن تحديد سوء الفهم الكامن وراء الوضع الاستعماري دون أن تتهم نفسك بكونك صاحب سوء الفهم المذكور، والسعي للترويج له "(ص. 63). كان مانوني يشعر بحساسية وجرح إزاء مواجهة سوء الفهم الذي لحق دراساته، لذلك التزم مانوني الصامت طويلا. وانتظر حتى عام 1966، حيث نقرأ في خاتمة ملحقة بإعادة إصدار كتابه باللغة الإنجليزية، أنه أعلن إدراكه المتأخر للطبيعة المؤسفة لمفهوم التبعية وشكك في البصمة الإثنوغرافية الكامنة وراء عرضه وبرهنته.
إذا أثار التصنيف الإثنوغرافي الذي اقترحه مانوني أسئلة كثيرة، فإن بوني ومندلسون يُبرزان أنه من خلال التشكيك في الواقع النفسي للمشروع الاستعماري، فإن مانوني هو من أوائل المفكرين الذين اكتشفوا أنه لا يكفي تحطيم العلاقات الموضوعية للهيمنة كي يتبدد التقسيم والميز العنصري الاستعماري. ومن أجل فهم أهمية هذه التخصيصات النفسية المشتركة، قام المؤلفان بدمج كتابات مانوني مع "فكرة ثانوية عن الفرويدية، وهي فكرة Verleugnung" (ص 20)، والتي يمكن ترجمتها بمفهوم "الإنكار"، لأن الإنكار يشكل أنظمة وجودنا ويجعل من الممكن إدامة البصمة الذاتية للعرق فوق معرفة تستمد وجودها الذاتي منذ أكثر من نصف قرن. فلماذا إذن لا نتمسك بمفهوم الإنكار الوحيد، هل يمكن للمرء أن يعترض عليه؟ إنهما يبرهنان على أنه بعيدا عن كونه قابلاً للاختزال في منطق الكبت الذي يشكل جوهر الإنكار، فإن فكرة الإنكار تسمح لنا بالإصرار على تحديد اللاوعي الذي يجمع المعرفة والاعتقاد، ويمكن بالتالي أن نجد لدى الفرد نفسه عدم معرفة بالوجود البيولوجي والجيني والأنساب للعرق لكن دون الإضرار بسلسله من الحدود العرقية الذاتية التي تغذي تصدعات الفضاء الاجتماعي. باختصار، يوضح بوني ومندلسون أن الإنكار هو استجابة جماعية، يمكن تحديدها تاريخيًا، والهدف من عملهما هو تقديم أول خارطة نفسية لعملية تصفية الاستعمار التي لا تزال سائرة المفعول.
ما الفائدة من هذا الإنكار؟ يجعل مانوني من هذا المفهوم آلية ليس للدفاع ولكن للحماية من التمثيل غير المرغوب فيه الذي من شأنه أن يهدد نزاهة الذات. إذا كانت هذه الغرابة المقلقة لهذا الغموض المفيد المتمثل في العرق قادرًا على الحفاظ عليه، فلأن هذا الإنكار يجعل من الممكن عدم مواجهة شخصية الآخر الذي يهدد سلامة الأنا. يساهم الإنكار في الحفاظ على التمتع بالذات ؛ الأمر الذي دفع بوني ومندلسون ليقولا، بدءًا من مقولة لاكان، أن "العنصرية سيكون لها مستقبل واعد" (ص 205). إذا كان هناك مستقبل، فإن إمكانية وجود الذات للمصالحة يتعارض مع أقلمة أساليب التمتع. إذا سمح الاستعمار بترسيخ هذا التمتع لبعض الوقت، فإن لحظة الاستقلال أغرقت هذا التمتع في حالة من عدم الاستقرار لم يسع إلى إصلاحه مرة أخرى. وبذلك يتم تحديث الإنكار العنصري باستمرار، لدرجة صار من الضروري البحث عن جذور العنصرية في مكان آخر غير ما هو معتاد، أي في مفهوم وأسباب كراهية الآخر. و إذا كانت الإيديولوجية العنصرية تسمح باستمرار العنصرية، يبقى الانتماء العرقي قبل كل شيء نتاج عدم القدرة على تصور متعة الآخر كنوع من الاختلاف. وإذا كان الأمر يتعلق بالفعل بالكراهية، فهي كراهية للمتعة،التي يظهر عدم استقرارها في كل مرة يصيبها نمط آخر من المتعة (ص 220). وبالتالي، تصبح قضية نزع الهوية فكرة مركزية: وحده الفكر الذي يسبق مسألة العلاقة مع الكينونة سيسمح بإغلاق هذا التقسيم العرقي. في هذا المقام، ينضم المؤلفان إلى فكر إدوارد غليسان والحاجة إلى التخلي عن المرجع الوحيد لصالح التعددية. الطريقة الوحيدة لرفع سلطة الإنكار تكمن في شاعرية العلاقة التي هي في طور التكوين دائمًا. لم يعد الأمر يتعلق بالسعي إلى تراكب وجهات النظر، بل بالموافقة على أفق أوسع، حيث يتشابك وجود أحدهما بالآخر، ويقبل كل طرف أن كل وجود معني بهذه التخصيصات المختلفة والممَيزة و البينية.
في الختام، سنحتفظ باقتراحين رئيسيين من هذا المجلد الأول، أحدهما يوضح التحليل النفسي والفلسفة السياسية، والثاني يتعلق بالقضايا الأخرى المرتبطة بالنوع الاجتماعي. كما لا بد من الإشارة إلى أن قيمة وتفرد الدراسة التشريحية الأولى التي أنجزها مانوني ما تزال مهملة إلى حد كبير في فرنسا.
إن وضع هذه الكتابات الأولى في سياقها العام، وإزاء المثقفين في عصره (فانون،وإيمي سيزير، وديوب، وميمي، وكامو ...)، ولكن بشكل خاص إزاء نفسه، في هذا العالم الاستعماري الذي تطور لما يقرب من ربع قرن، كفيل بأن يبين لنا كل ما يتسم به موقفه الفكري من تعقيد وأصالة؛ إذ نكتشف بعد قراءة متأنية لأطروحاته قوة أفكاره، وجرأتها الكبيرة، لكن بمجرد التخلص من ورنيشها الإثنوغرافي الذي استعصى عليه التخلص منه، في إبانها. يتبنى بوني ومندلسون، المدركان لهذه الصعوبات، موقفًا دقيقًا يسمح لنا بإلقاء نظرة عميقة على هشاشة تحليلاته وعيوبها ومواضيعها وقابليتها للمعالجة المعاصرة بعيدا عن الأفكار المقولبة والإيديولوجيا العمياء. كما يضرب لنا المؤلفان موعدا قريبا مع المجلد الثاني من " الحياة النفسية للاستعمار" لما يكتسبه الموضوع من أهمية كبيرة تاريخية وفكرية قد تضيء عتمة تاريخ وحشي وتنير لحاضر من التعايش والتسامح والأمل أصبح الإنسان المعاصر اليوم ومستقبلا في أمس الحاجة إليه.
الكتاب: الحياة النفسية للعنصرية:إمبراطورية الإنكار: الجزء الأول
المؤلف: ليفيو بوني وصوفي مندلسون
الناشر: دار لاديكوفيرت. باريس
تاريخ النشر: 2021
عدد الصفحات: ص 270
اللغة الفرنسية