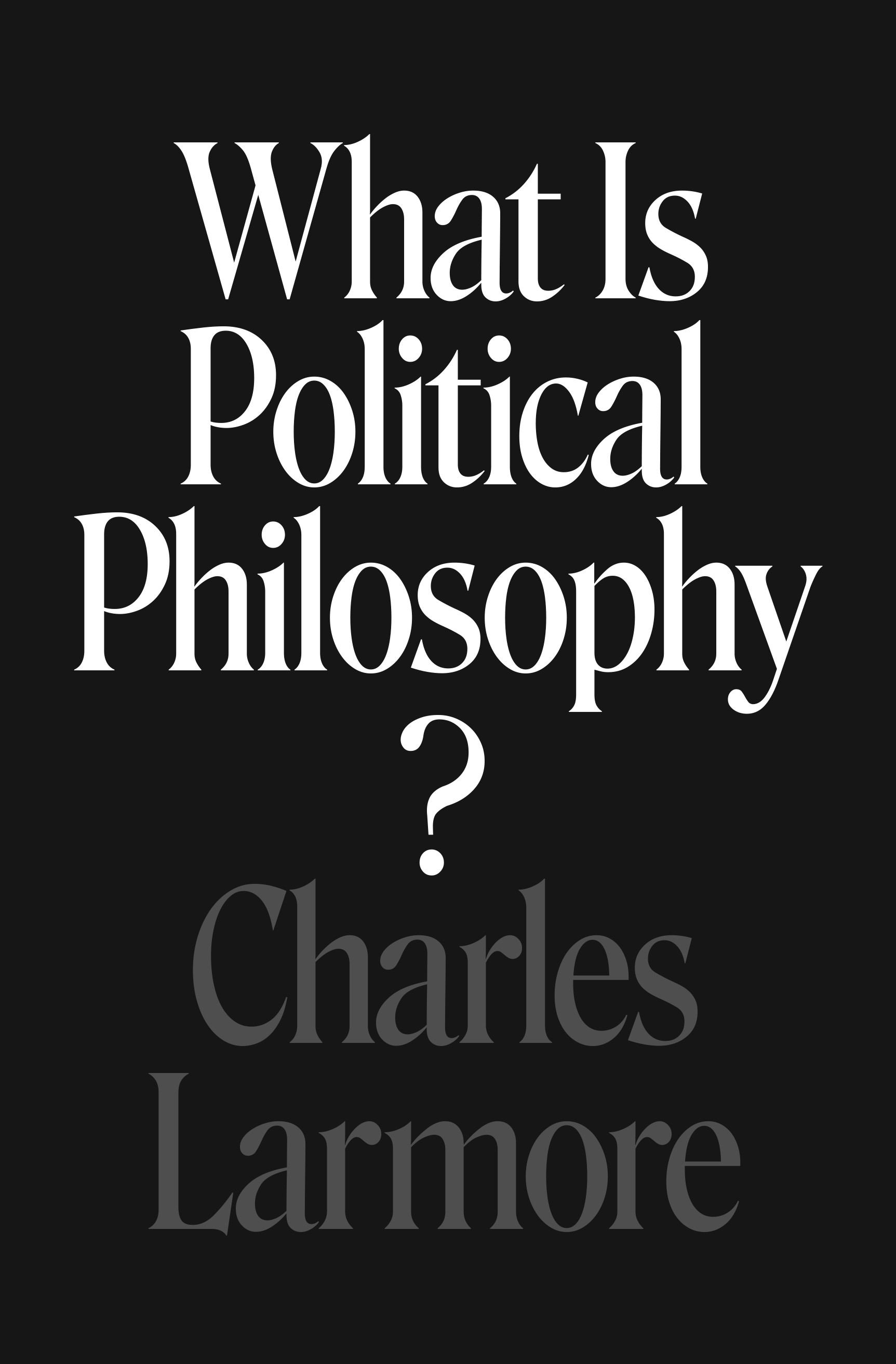تشارلز لارمور
محمد الشيخ
منذ حوالي أزيد من نصف قرن من الزمان ونيف كتب الفيلسوف السياسي اليهودي الألماني ليو شتراوس (1899-1973) كتابه: "ما الفلسفة السياسية؟" (1959)، وفي عام 2014 طلع علينا الفيلسوف الكندي رونالد باينر ـ صاحب كتاب: "عقول خطيرة: نيتشه وهايدجر وعودة اليمين المتطرف" (2018) ـ بكتابه: "الفلسفة السياسية: ما هي ولماذا هي مهمة؟" وها هو اليوم يعيد الكرة الفيلسوف السياسي الأمريكي تشارلز لارمور (1950- ) في كتابه الجديد: "ما الفلسفة السياسية؟" (2020). والحال أنه إِنْ دل هذا على شيء، فإنه يدل على حيوية مبحث "الفلسفة السياسية" وتجدد النظر فيه بالنظر الموصول.
نأتي، في بداية هذا التقديم، إلى جواب الفيلسوف لارمور الجواب المباشر عن سؤال: "ما الفلسفة السياسية"؟ فنقول: الذي عند الرجل ـ والذي عُرِف عنه نقده العميق لفكر الفيلسوف السياسي الأمريكي الشهير جون راولز (1921-2002)، وإقرار هذا بمدى وجاهة ذاك النقد ـ أنه في زماننا هذا وتحت تأثير جون راولز ذاك باتت تُسَوّى الفلسفة السياسية ونظرية العدالة الاجتماعية كل التسوية؛ وذلك حتى أمكن الجزم: ما الفلسفة السياسية سوى النظر في العدالة ليس إلا. وهذا ما يرفضه ناقد جون راولز هذا جملة. فما تنساه هذه النزعة الفلسفية السياسية ـ الدائرة في نهاية المطاف على "الأخلاق"، بما أن "العدل" خُلُق في النهاية ـ إنما هو واقعة أن النزاعات الاجتماعية، التي يتوجب على الفلسفة السياسية أن تستكشف طرق حلها، يمكن أن تتأتى حقيقة، في قسم كبير منها، عن نزاعات ذات طبيعة "أخلاقية" ـ متعلقة بمسألتي "العدل" و"الحق" ـ مدارها على كيف ينبغي تنظيم المجتمع التنظيم الأفضل والأجود. لكن المسألة الجوهرية في السياسة، تماما مثلما هي المسألة الأساسية في الفلسفة السياسية، إنما هي الشروط التي وفقها تصير إقامة القواعد الإكراهية الهادفة إلى تدبير النزاعات الاجتماعية أمرا مسوّغا ومبرّرا ومقبولا من لدن المحكومين. ولهذه الحيثية، يمكن القول: كلا؛ ما كانت "العدالة" هي مدار الاهتمام الجوهري للفلسفة السياسية، ولا ينبغي لها أن تكون، وإنما "المشروعية" هي المدار.
ولكي يقرر تشارلز لارمور هذا الجواب، يأخذنا في كتابه هذا إلى رحلة فكرية شيقة وشاقة يقطع بنا فيها مفازات. وهو في كل ذلك يدافع عما يسميه "المقاربة الواقعية للفلسفة السياسية". ومقتضاها أنه يتعين على الفلسفة السياسية أن تفهم مجالها باعتباره مجالا تبدو فيه الأمور على نحو أقل مثالية مما نعتقد عادة؛ حيث يكون النجاح دائما نسبيا، ويبيت أبدا غير تام، وترافق دواعي التشجيع منه أمارات الاضطراب.
أولا؛ سياق طرح سؤال: ما الفلسفة السياسية اليوم؟
يحدد المؤلف سياق الكتاب في ما يعتبره هجمة من يسميهم "الديماغوجيين الشعبويين" على الديمقراطية الليبرالية، وقد ادّعوا أنهم وحدهم من يمثل الإرادة الواحدة لمن يطلقون عليهم اسم "المواطنين الحقيقيين"، وأعلنوا أن النخب والأقليات العرقية هم "أعداء الشعب" على الحقيقة. وهم في ما ذهبوا إليه قد شهدوا على أنه ما ينقضي يوم إلا ويشي بتفسخ النظام السياسي الأمريكي: إذ لا يوجد استثناء أمريكي بهذا الخصوص. ففي نهاية الأمر، ما من شيء إلا وهو سائر، لا مرية، إلى خاتمة، وصائر، لا محالة، إلى بيدودة ـ وما كان الأفراد وحدهم من ينطبق عليهم ناموس الفناء هذا، وإنما على الجمهوريات ينطبق أيضا.
ثانيا؛ ما الفلسفة السياسية؟
ثمة سمة بارزة تميز الفلسفة، بعامة، عن غيرها من سائر المعارف؛ وهي سمة "التَّفَكُّر": ذلك أن من شأن الفلسفة أن تُفَكِّرَ في شتى الموضوعات، ومن أمرها أيضا أن تفكر في ذاتها؛ أي أن تَتَفَكَّرَ في نفسها؛ وذلك مثلما هي اليد تغسل سائر أعضاء الجسم وتغسل نفسها بنفسها. وتلك هي سمة "الانعكاسية" أو "التفكرية". وما كانت "الفلسفة السياسية" ببدع من هذا: فهي أيضا من شأنها أن تفكر في شتى المواضيع السياسية، ومن ديدنها أن تؤوب إلى نفسها مفكرة في ذاتها متدبرة في أمرها: تُرى ما الذي تَكُونه الفلسفة السياسية؟
ينطلق المؤلف من الفلسفة السياسية كما تمارس بالفعل، ثم يفحص المهام الرئيسية التي يتعين عليها القيام بها. وقد قاده ذلك إلى النظر في سمات الوجود السياسي عينه ـ ما يسميه "حيثيات السياسة". وهي تكمن، عنده، في تفشي نزاع المصالح والمثل في كل مكان، نزاع ما كان شأنه أن يتغذى بالهوى فقط أو بالجهل فحسب، وإنما بممارسة العقل لوظيفته في التفكير أيضا. والحال أن هذه النزاعات تعمل على كبح فرص التعاون الاجتماعي بين أفراد الشعب الواحد، أو على إخماد جذواها؛ اللهم إلا إذا ما هي تمت إقامة قواعد أو قوانين مرجعية ذات سلطان يقبل بها الجميع. ويلزم عن هذا الأمر أن الاهتمام الجوهري للحياة السياسية وللفلسفة السياسية معا إنما ينبغي أن يكمن في مسألة المشروعية؛ أي في مسألة من هو المؤهل لإقامة هذه القواعد، وما المدى الذي ينبغي أن تبلغه، وعلى من ينبغي أن تُجرى. وإذا ما صح أن ثمة، لا محالة، مكان في الفلسفة السياسية لنظريات المجتمع الجيد التنظيم والإيالة والتدبير، فإنه يصح أيضا أنه قبل النظر في طبيعة هذا المجتمع، من حيث إقامة العدل فيه، ينبغي النظر، أولا وقبل كل شي، في مسألة مشروعية من يدبر هذا المجتمع وشرعية من يديره.
وعملا بمبدأ بأضدادها تميز الأشياء، يعمد المؤلف إلى المقارنة بين الفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية. ثمة، أولا، أولئك الذين لا يرون في الفلسفة السياسية اللهم إلا فلسفة أخلاقية مطَبَّقَة؛ وذلك على اعتبار أن شأن الفلسفة الأخلاقية أن تنظر في ما هو "العدل" وفي ما هو "الحق" في ذاتهما ولدى الأفراد، وأمر الفلسفة السياسية أن تطبق هذين المبدأين على الجماعات. هذا ما يستشف من كتاب راولز "نظرية العدالة" (1971). لكن في العقدين الأخيرين بدأت الشكوك تساور الفلاسفة السياسيين والاجتماعيين في أمر ما إذا كانت الفلسفة السياسية فلسفة أخلاقية مطبَّقَة ليس إلا.
ولكي يواجه المؤلف أطروحة راولز وأنصاره، يتساءل أولا: أليس "العدل" و"الحق" يشكلان موضع خلاف بين الأفراد والجماعات؟ وجوابه: بلى. وهو يرى أن الخلافات من هذا النوع ما كانت هي مجرد خلافات في وجهات النظر، بل هي خلافات أعمق من ذلك بكثير. هي خلافات تستوطن في تضاعيف العقل نفسه وفي ثنايا ذاته. ولَئِن طالما اعتقد الأقدمون أن الخلاف بين"أهل الحق" و"أغيارهم" إنما ينجم عن سوء استخدام هؤلاء لعقولهم، وأنه يكفي لذلك أن يُحسنوا استخدامها حتى ينتهوا إلى الحق الذي هو واحد، فإن درس الأزمنة الحديثة أظهر أن الخلاف كامن في العقل نفسه وليس طارئا عليه حين استخدامه. إذ يمكن، بل يتوجب بالفعل، أن ينجم الخلاف بين أناس متعقلين ـ أناس يحاجون عن حسن نية، ويبذلون أفضل مهاراتهم في المحاجة حول معنى الحياة الطيبة والمجتمع الجيد.
ثالثا؛ ما صلة سؤال ما الفلسفة السياسية بالليبرالية السياسية؟
هنا يقدم المؤلف أطروحتين رئيسيتين في الكتاب:
أولا؛ الخلاف لا الوفاق هو الأصل. ذلك أنه لما كان الأمر يتعلق بقضايا تدور على "الخير البشري" وعلى "العدالة الاجتماعية"، فإن من شأن الناس المتعقِّلين أن ينزعوا نزوعا طبيعيا إلى بلوغ وجهات نظر متباينة، بل وحتى متعارضة. وهذا أمر لم يكن التقليد الفلسفي يستوعبه. إذ كان التقليد على المذهب الذاهب إلى أن دور العقل يكمن في تجاوز الخلاف، بينما بات دوره اليوم يتمثل في تدبير الخلاف المتأصل في العقل البشري وليس الطارئ عليه لخطل مفترض في استدلالاته. والحال أنه حين نلفي أنفسنا وقد اختلفنا في مسائل خلقية ـ ما "الحق"؟ وما "العدل"؟ ـ فإننا ما عدنا، شأن القدماء، نسعى إلى تبين من يوجد الحق إلى جانبه، وإنما بتنا نسعى إلى تدبير خلافنا بالروية. وقد أضحينا على قناعة بأن الخلاف، وليس الوفاق، هو الأصل. وذلك لأن المحاجة إنما تنهض على خلفية من المعتقدات والمعايير والمنافع الموروثة والراسخة، وهي أمور مُشْكَلة ومختلف حولها بالطبع. وما كانت المشكِلة تكمن في الخلاف في ذاته؛ إذ الخلاف الأخلاقي أمر متوقع على وجه الدوام، وإنما تكمن هي في آثار الخلاف الاجتماعية. ذلك أن الخلاف المتعقل يشكل مشكلة سياسية عجيبة، من حيث أنه يكوّن رافدا أساسيا للنزاع الذي يهدد إمكان النظام السياسي وفرصة الوئام الاجتماعي. وما من نظام حكم سياسي، أنى كان شأنه، إلا وهو مطالب بأن يبادر، قبل كل شيء، إلى تصور وفرض قواعد سياسية لتدبير أهم النزاعات في مجتمعه؛ بما في ذلك، أساسا، تلك النزاعات التي تنجم عن الخلاف المتعقل حول "الخير" وحول "الحق". وهذا يُظهر أن أولوية أي نظام سياسي ـ وبالتبع أي فلسفة سياسية ـ ما كان هو العدالة الاجتماعية، وإنما هو المشروعية السياسية.
ولَئِنْ حق أن ثمرات وأعباء التعاون الاجتماعي ينبغي أن يتم توزيعها بين أفراد المجتمع توزيعا عادلا ومتساويا ـ وهو الأمر الذي لطالما شكل موضوع جدل بين المفكرين الاجتماعيين والفلاسفة السياسيين؛ ومن ثمة كوّن منبعا رئيسيا للتنازع الاجتماعي ـ إلا أنه قبل طرح قضية العدالة التوزيعية هذه، يتعين، أولا، ضمان إمكان التعاون الاجتماعي ـ اللحمة الاجتماعية ـ نفسه. ومن هنا كانت المسألة الأساس هي "مسألة المشروعية" ـ مشروعية نظام الحكم ـ وليس "مسألة العدالة" ـ العدالة التوزيعية. ذلك أنه يتوجب في القواعد والقوانين التي تفرضها دولة معينة أن تكون ذات برهان وصاحبة سلطان، فلا تفرض نفسها قهرا بلا مسوِّغ يسوغها. إذ بناء عليه فقط يتم ضمان التعاون الاجتماعي. وهو الأمر الذي لا يحدث اللهم إلا إذا شعر الناس في المجتمع بأن هذه القواعد والقوانين مشروعة إلى حد مقبول؛ أي مفروضة بما من شأنه أن يبرّرها وأن يجعلها متبناة لدى السواد الأعظم. فما من دولة إلا والشأن فيها أن تسعى السعي إلى إضفاء المشروعية على ممارستها للسلطة في أنظار أولئك الذين تسوسهم، هذا إِنْ هي رامت أن تحقق تحقيقا ناجحا مهمتها الأساسية التي تتمثل في جعل النزاعات الاجتماعية تقع ضمن نطاق سيطرتها.
والذي يزعمه المؤلف بهذا الصدد، أن الليبرالية السياسية هي القمينة بالنهوض بمهمة الشرعنة هذه. ذلك أنَّ الليبرالية تقوم على فكرة "احترام الأشخاص". ويمكن صوغ هذه الفكرة على النحو التالي: بما أن المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها الحياة السياسية قهرية بطبيعتها، فإنه يتعين عليها أن تقوم بحيث يكون أولئك الذين يخضعون إليها قادرين، من وجهة نظرهم، على أن يتبينوا دواعي تبني هذه المبادئ وعلى أن يتفهموها التفهم، وبحيث يلتزموا بإقامة الاجتماع السياسي على مبادئ يمكن أن تلاقي الوفاق المتعقِّل من لدن الجميع. ولماذا الليبرالية يا ترى وليس أية أدلوجة أخرى؟ يجيبنا المؤلف: لأن الليبرالية هي القادم الأخير الذي تعلّم الدرس من صنوف فشل الجهود المبكرة لتنظيم الحياة السياسية بوسمها حياة طيبة.
ثانيا؛ النزاع دائم. لا ترتهن تصورات المشروعية السياسية إلى اعتقادات فعلية متنوعة فحسب، وإنما تركن أيضا إلى مبادئ أخلاقية؛ لا سيما مبادئ ذات صلة بالممارسة المسوِّغة للسلطة القهرية. على أنه ما من تصور للمشروعية السياسية، مهما اتسع هو وعمَّ وشمل، إلا أنه يكون لطبع متأصل فيه ضيقا وإقصائيا واستبعاديا. وما كانت الليبرالية لتعد بدعا من هذا كله. ذلك أن من شأن الأناسي المتدينين، مثلا، أن يربطوا المشروعية بإقامة إرادة الرب، وهذا ما لا تؤمن به الليبرالية؛ مما من أمره أن يُشعرهم بأنهم منبوذون بالنظر إلى ما تنص عليه القواعد التي يبني عليها المجتمع الليبرالي. وههنا يحدث الصدع الذي لا يمكن رأبه بين الحرية الفردية والسلطة السياسية. ومن تم تبقى جاذبية الليبرالية رهينة، في آخر المطاف، بقيمة المبادئ التي بواسطتها تمارس الإدماج والإقصاء معا. والحال أن المؤلف يعرض الليبرالية السياسية ـ وهو واع تمام الوعي بمثالبها ـ بوصفها حلا ـ ضمن حلول أخرى ممكنة ـ لمسألة المشروعية السياسية، كما أنه لم يخف البتة قلقه حول مستقبلها.
وبالجملة، ما يريد أن يظهره الكتاب إنما هو وجود تعالق حميمي بين طبيعة الفلسفة السياسية، وقد فُهمت الفهم الأحق، وهواجس الفكر الليبرالي. لقد لعبت الليبرالية دورا مهما في جلب الانتباه إلى الطريقة التي يمكن بسهولة للقناعات الأخلاقية، مهما بدت هي لمعتنقيها راسخة التبرير متينة البنيان، أن تختلف وتتباين؛ فتقود إلى نزاع اجتماعي وتنازع.
وفي الختام، لقد رسم المُؤلف ـ وهو مُقِرٌّ بذلك غير ناكر له ـ صورة قاتمة للصعوبات التي تواجه الديمقراطية الليبرالية؛ لاسيما وأن الكثيرين يقرنون مصيرها بالرأسمالية. وهو يعتبر أن تعطش الرأسمالية الدائم إلى النمو الاقتصادي ـ وبالتالي إلى الربح ـ قد يشكل خطراً قاتلاً يودي باشتغال مبادئ الليبرالية، إن لم يود بمستقبل البشرية نفسها جمعاء.
|
عنوان الكتاب |
ما الفلسفة السياسية؟ |
|
مؤلف الكتاب |
تشارلز لارمور |
|
دار النشر
|
مطابع جامعة برينستون برينستون وأكسفورد |
|
سنة النشر |
2020 |