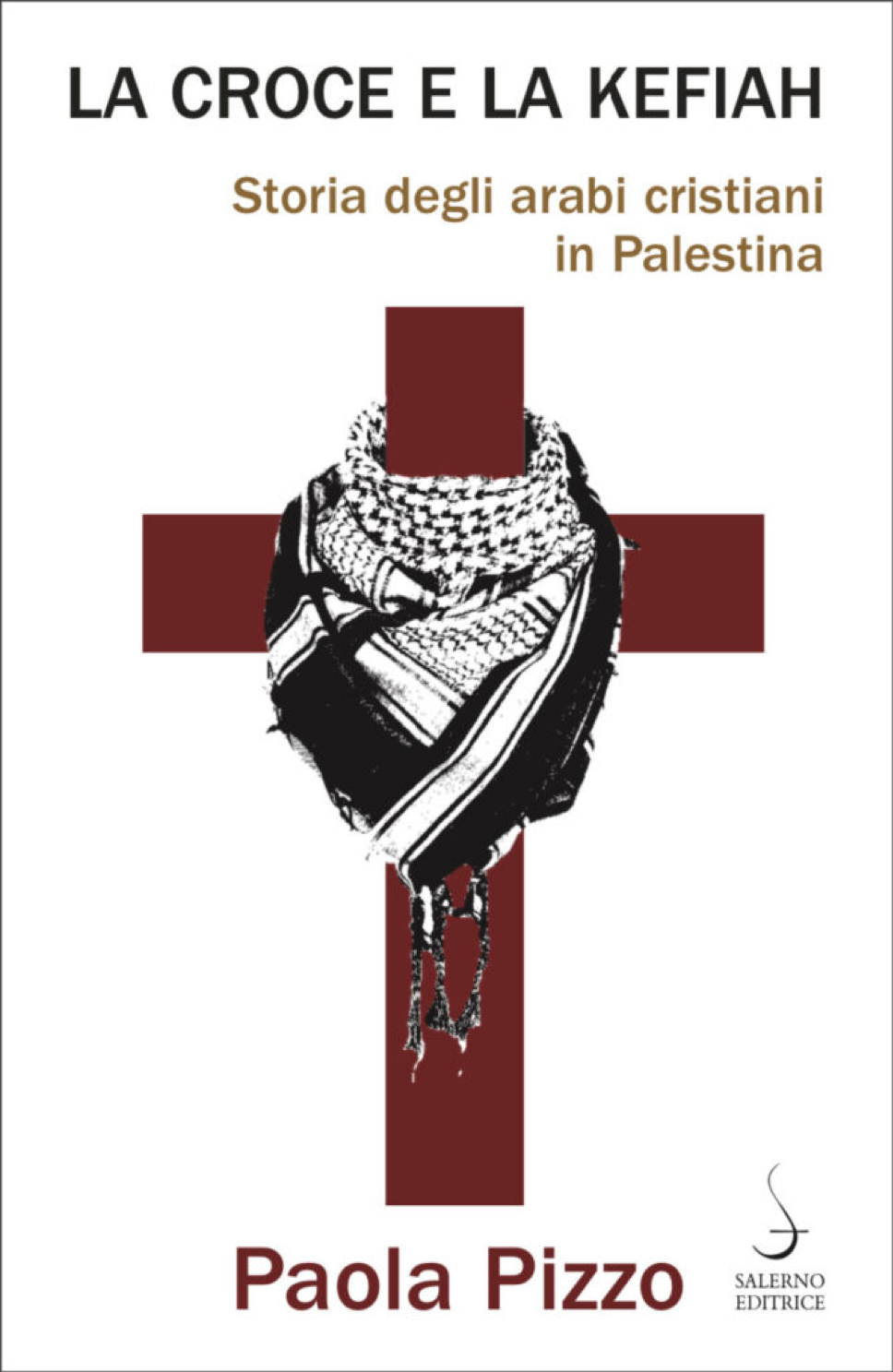باولا بيزو
عزالدين عناية*
ثمّة قطاع واسع في الدراسات الدينية لازال التعامل معه في الثقافة العربية ضمن أدوات المفاضَلة والمناكَفة والبكائيات وما شابهها، وهي أدوات مضلِّلة ومشوِّهة لا تمتّ بصلة للدراسات العلمية للأديان. فهي عائدة إلى ضعف التكوين في حقل معرفي يقوم أساسا على فصل ما هو ذاتي عمّا هو موضوعي، وما هو لاهوتي عمّا هو علمي. حتى أنّ كتاباتنا حول اليهودية والمسيحية، على سبيل المثال، لا يُعتدّ بها في المدوَّنة العالمية ولا تلقى حظوة لضعف بنيتها المعرفية وترهّل منهجها. ما يجعلنا في هذه المساحة المتاحة لنا من عرض المؤلفات الغربية نشير إلى الإنجازات المقدَّرة في مجالات الدراسات العلمية للأديان في اللسان الإيطالي. وقد آثرنا في هذا العرض تناول كتاب على صلة بتاريخ المسيحية الفلسطينية تحديدا.
فبهذه الكلمات تستهلّ الباحثة الإيطالية باولا بيزّو كتابها "الصليب والكوفيّة.. تاريخ المسيحيّين العرب في فلسطين" "يبدو الصليب والكوفية رمزين متنافرين، أو لنقل الواحد على نقيض الآخر، في المخيال الغربي، في حين يفصح التاريخ عن تلاحم وثيق وحيّ، بين أرض فلسطين والإيمان المسيحي". فقد سكن المسيحيون العرب فلسطين ومنطقة الهلال الخصيب، منذ عهود المسيحية الأولى بدون انقطاع وإلى اليوم. في هذا المؤلّف تتتبّع الباحثة باولا بيزّو تاريخ أتباع المسيح (ع) في أرض فلسطين من البدايات إلى وقائع التاريخ المعاصر، في مسعى لصياغة خلاصة جامعة.
توزّعَ البحث على ستّة محاور أساسية، غطّت مختلف أطوار التاريخ الفلسطيني وجاءت معنونَة على النحو الآتي: "بدايات التاريخ الأولى"، وذلك منذ ظهور المسيح (ع) إلى احتضان الإسلام هذا الدين وانضمام المسيحيين إلى مكوَّن حضاري جامع؛ "المسيحيون والنهضة العربية"، تناول أبرز إسهامات الكتّاب والمفكرين الفلسطينيين في بلورة مشروع النهضة العربية؛ "الهوية الفلسطينية بين الدين والقومية"، وقد تركّز فيه الحديث على الطابع التعدديّ للهوية الفلسطينية وعلى دور المسيحيين إبان الانتداب البريطاني، فضلا عن مظاهر مقاومة المدّ الصهيوني في صفوف المسيحيين؛ "تأجّج أوضاع فلسطين"، تناول أحداث الثلاثينيات من القرن الماضي التي عصفت بفلسطين، حيث تعرّض للنشاط التبشيري الهائل وللهجمة الصهيونية الغاشمة ومواقف مسيحيّي فلسطين وتجذّرهم في حركة المقاومة؛ "1948.. المسيحيون والنكبة"، ركّز بالأساس على أوضاع المسيحيين قبل النكبة وأثنائها، وأبرز ما حاق بهم من اجتثاث وما لحق بالباقين منهم من تضييق وتنكيل؛ "تحديات المستقبل"، انشغل هذا المحور بما هزّ أوضاع المسيحيين من تحوّلات في الحقبة الراهنة، فضلا عن تعرّضه للنزيف المسيحي في ظلّ أوضاع الاحتلال، ثم عرّج البحث على علاقة المسيحيين بالكيان الإسرائيلي وبالسلطة الفلسطينية.
نشير إلى أنّ باولا بيزّو مؤلّفة الكتاب، هي مستعرِبة إيطالية ومؤرّخة تدرّس التاريخ المعاصر للبلدان الإسلامية في جامعة كييتي بِسْكارا في إيطاليا. وتدور مجمل أبحاثها حول العلاقات المسيحية الإسلامية في الشرق الأوسط. نذكر من بين أعمالها المنشورة "المسيحيون والمسلمون في مصر إزاء الطروحات القومية: 1882-1936" (2003) و "الإسلام في المتوسط.. اللقاء مع أوروبا وتحديات الحداثة" (2010).
تَركّز الاهتمامُ في المحور الأول على إبراز الترابط المتين بين المسيحيّ الفلسطيني وأرضه، حيث حاولت الباحثة بيان عمق الصلة بين المسيحي ومعلّمه. فقد وصفَ المسيحُ (ع) صحبَه الأوائل من سكنة فلسطين وما جاورها، أو لنقل بعبارة جغرافية قديمة من أهالي سوريا الكبرى، بقوله: "أنتم ملح الأرض... ونور العالم" (متّى5: 13-14). فقد خلعَ المسيح على شيعته ذلك الوصف قبل أن تتعبّأ الديانات داخل قوميات، وقبل أن تغدو عناوين جامدة وثابتة لشعوب وأقوام وأجناس وأعراق. ولعلّ ذلك هو المعنى الجوهري لرسالة الدين والتديّن المتخفِّف من تلك الحمولة القومية المفرَطة، والوارد في قوله تعالى: "ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا" (آل عمران، 67). لنتابع مع الباحثة باولا بيزّو رحلة البحث عمّا تبقى من ذلك الملح في كتاب "الصليب والكوفية" رغم سائر المحن التي ألمّت بأتباع الناصريّ. فالكتاب هو من الكتب الجادة والرصينة في دراسة واقع مسيحيّي فلسطين وتاريخ المنطقة بعيدا عن النبرة البكائية الطاغية على مجمل كتابات العرب المعاصرين، كلّما تطرّقوا إلى موضوع المسيحيين الراهن. والتي سبق أن حذّرنا من تداعياتها السلبية على فهم واقع المسيحية العربية وتلمّس حلولها في كتابنا "نحن والمسيحية في العالم العربي وفي العالم" (الدار البيضاء، 2010)، لحرصنا على جعل حقل المسيحية العربية مبحثا دراسيا علميا بعيدا عن البكائيات التي تحاصر كثيرا من الدراسات.
استطاعت الباحثة الإيطالية أن تقدّم خلاصة موثَّقة رصينة عن واقع تجمّع ديني بات يتهدّده الذوبان في ظلّ التحوّلات القاهرة. وترتئي أنّ حشر المسيحية والإسلام ضمن منظور قومي لائكي قد استنفد طاقته، وأن البراغماتية تستوجب البحث عن رابطة مواطَنية تقوم على المساواة والكرامة وتستند إلى خطة ديمقراطية للكيانات الهشّة، ودون الوقوع رهن ثنائية الأغلبية والأقلية. إذ أنّ تناول الحديث عن الفلسطينيين المسيحيين بمنطق الأقلية هو أمرٌ غير مقبول وفاقد للصلاحية، من قِبل عموم الفاعلين الفلسطينيين، لِما في ذلك من تهوين وتحقير للدور المسيحيّ. فمنذ فترة العشرينيات من القرن الماضي، حين بدأ العرب يتلمّسون طريق التحرر والاستقلال، ظهرت قيادات مسيحية في فلسطين ودول الجوار، تحمّلت الدور التفاوضي والتواصلي مع الغرب.
ومنذ السنوات الأولى للانتداب البريطاني كانت الحركة الوطنية الفلسطينية منتظمة في جبهة موحَّدة، تخلو من الطابع الديني، وذلك ضمن وفاق إسلامي مسيحي نادى بعروبة فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني. بدا ذلك التلاحم جليّا، حتى أنّ عائلة الغوري المقدسية المسيحية، كانت تعقد الاجتماعات لوجهاء المسيحيين في بيت الأسرة لصياغة النداءات الموجَّهة للمندوب البريطاني التي أعربت فيها عن أنّ الجالية المسيحية لا تعترف برجل يتولّى منصب الإفتاء لفلسطين سوى للمرشَّح الحاج أمين الحسيني وذلك أثناء حملة تنصيبه مفتيا (1921). وتشير الباحثة إلى أنّ عائلة الغوري قد توزّعت نضالاتها الوطنية المبكّرة على عدّة جبهات. فقد وقف إميل الغوري (1907-1984) في وجه عمليات غَرْبنة المسيحية الشرقية من قِبل المبشّرين الأجانب، حتى وإن قَبل الأهالي، على مضض، بالخدمات المتاحة في المجال التعليمي والثقافي والاجتماعي.
وتبرز الباحثة باولا بيزّو أنّ تنبّه الشوام، بمسلميهم ومسيحييهم، لحملات التبشير الأولى كان حازما. فخلال العقود الأخيرة من الوجود العثماني في المنطقة الشامية بات الأهالي يسعون للتعويل على أنفسهم أمام تفاقم الأنشطة التبشيرية. وأُقيم للغرض العديد من المبادرات في أوساط المسلمين والمسيحيين لمواجهة تلك الحملات. ففي بيروت أنشأَ بطرس البستاني "المدرسة الوطنية" (1868)، وبعد عشر سنوات أنشأت "جمعية المقاصد الخيرية" مدارسها. وتمّ في طرابلس فتح "المدرسة الحميدية" (1895)، وفي حيفا أُنشئت "المدرسة الإسلامية" حيث درّس الشهيد عزالدين القسّام، وفي القدس بعثت بطرياركية الإغريق الأرثوذكس المدرسة الثانوية مار متري.
وعلى ما ترصد الباحثة، كانت النظرة لمرامي المبشِّرين الأجانب في بداية القرن، سواء من قِبل المسيحيين أو المسلمين الفلسطينيين، بمثابة الانتهاك لثقافتهم الوطنية والتهديد لهويتهم المشتركَة. وكانت التكتّلات المسيحية في لبنان وفلسطين، وكما هو الحال مع أقباط مصر، تحسّ أنها أقرب إلى شركائها المسلمين في الوطن منه إلى المبشّرين الأجانب الذين يشاركونهم الإيمان بالمسيح.
لقد مرّ المسيحيون في فلسطين بأطوار ديمغرافية عدّة، تقلّبوا فيها من أوضاع الجماعة الفاعلة إلى أوضاع الأقلية المهجَّرة، لكن ما ميّز الفلسطينيين المسيحيين منذ مطلع القرن الفائت أنهم جالية حضرية سكنت المدن، مثل يافا وحيفا والقدس، وشكّلت الغالبية في رام الله وبيت لحم والناصرة. فقد كان 18 بالمئة فقط منهم من المزارعين بحسب إحصاء يعود إلى العام 1931.
في محور آخر تتبّعُ الباحثة آثار النكبة على المسيحيين الفلسطينيين. وتعود بالمصطلح إلى المؤرِّخ السوري المسيحيّ قسطنطين زريق الذي استوحاه لأوّل مرة، وذلك قبيل أحداث 1948. فعلى إثر حصول تلك الملَمّة وجدَ الفلسطينيون المتبقّون أنفسهم فجأة، بعد عمليات التهجير، بدون نخبة ثقافية، وبدون قيادة سياسية، وبدون وطن. هزّ التهجير الشرائح المدينية الوسطى والميسورة من المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء. وبحسب ما تورد الباحثة ترك فلسطين بين 700.000 و 800.000 نفر، ولم يبق في ظلّ السيطرة الإسرائيلية سوى 160.000، مجملهم من الأوساط الريفية والبدو. وبشأن ما حاق بالمسيحيين، تروي الباحثة أنّ بن غوريون اتّخذ قرارات خاصة وحازمة لحماية معالم مدينة الناصرة، خشية ردّة فعل العالم المسيحي، وقال كلمته المحذرة "العالم يراقب أفعالنا!"، في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي، بقيادة موشي كرميل، يحاصر الناصرة ويتأهّب لاقتحام المدينة وطرد 16.000 ساكن من ضمنهم 10.000 مسيحيّ.
وما إن هدأت عمليات التهجير حتى شهدت الناصرة تضاعف عدد سكانها بشكل متسارع بين 1948 و1949، وتحوّلت إلى شبه ملجأ لعرب الداخل. فمع أواخر الانتداب كانت المدينة تَعدّ 18.000 ساكن ومع أول إحصاء إسرائيلي سنة 1949 بلغ العدد 30.000. وتشير بعض الدراسات التي أجريت خلال أواخر القرن الماضي أنّ عدد سكان المدينة ستون ألفًا، 70 بالمئة منهم مسلمون. وتشير الباحثة إلى أنّ عدد المسيحيين، مع نهاية الحرب العالمية الثانية، قد ناهز 135.000 على عدد جملي 1.750.000 ساكن، ما يساوي 8.8 بالمئة من المجموع العام. كما تشير الباحثة إلى أنّ 7 بالمئة من لاجئيّ 48 كانوا من المسيحيين. وأنّ قرابة 140.000 من المسيحيين، كانوا يقيمون في فلسطين خلال العام 1948، أُجبر 50.000 منهم على الرحيل القسري، ما يعني الثلث تقريبا. وهو ما جعل عدد المسيحيين بعد النكبة يتراجع من 8 بالمئة إلى 2.8 بالمئة.
وتذهب بعض الدراسات التقديرية التي أجريت خلال الفترة الأخيرة إلى أنّ أعداد المسيحيين كانت مرشّحة أن تبلغ 600.000، لو لم تكن النكبة، في مقابل ما هو موجود في الوقت الحالي 170.000. فهذا العدد يمثّل 28 بالمئة من المجموع العام للمسيحيين، أي من قرابة 600.000 من مسيحيي الشتات الموزَّعّين في شتى أرجاء العالم.
من جانب آخر تشير الإحصائيات الإسرائيلية العائدة إلى العام 2019 إلى أنّ عدد عرب فلسطين 1.916.000، ويمثّلون 21 بالمئة من المجموع العام. ويبلغ عدد المسيحيين بين هؤلاء 177.000، أي بما يعادل 2 بالمئة من التعداد العام، وبما يساوي 7.2 بالمئة من تلك العربية مع استثناء الأجانب. هذا وقد سجّلت الكتلة المسيحية تزايدًا بـ 1.5 مقارنة بالعربية 1.7 بالمئة واليهودية 2.2 بالمئة. من جانب آخر وبحسب الإحصاء الذي أُجري في أراضي السلطة الفلسطينية، خلال العام 2017، بلغ عدد المسيحيين 46.850 أغلبهم من الكاثوليك. ويقيم السواد الأعظم منهم في الضفة الغربية، وتحوز بيت لحم 23.165، ورام الله 10.255، والقدس 8558، وقطاع غزة ما يزيد عن الألف. نشير إلى أنّ 40 بالمئة من المسيحيين المقيمين في القطاع قد غادروا غزة، منذ العام 2008 وإلى غاية العام 2016.
وبشأن أوضاع كنائس الداخل، تورد الباحثة أن إسرائيل تعترف لبعض الجماعات المسيحية التي لها وجود يعود إلى الفترة العثمانية ببعض الحقوق، على غرار الأحكام الخاصة المتعلّقة بالأحوال الشخصية في تسوية أمور الزواج والطلاق والميراث. كما تتمتّع الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية، والكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والكنيسة المارونية، والكنيسة الإغريقية الكاثوليكية (الملكانية)، والكنيسة السريانية الكاثوليكية، والكنيسة الأرمينية الكاثوليكية، والكنيسة الكلدانية، والكنيسة الأنغليكانية، ببعض الحقوق. وقد حرصت الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية على الحفاظ على الوضع القائم بما يضمن لها أفضلية على الكنائس الأخرى. لذلك حرصت هذه الكنيسة على التعاون الجيد مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما تواصل إلى أواسط الثمانينيات. وتشير الباحثة إلى إلحاح أتباع هذه الكنيسة داخل فلسطين والأردن على مراجعة أوضاع التسيير في هذه الكنيسة على أساس الانتخابات. كما تبقى الكنيسة الأرمينية المالك العقاري الأهمّ في المدينة القديمة.
تبرز الباحثة أنّ تراجع أعداد المسيحيين الفلسطينيين لا يمثّل تحدّيا للدول العربية وحدها، بل لسياسة التعايش الإسرائيلية أيضاً. والمشكلة أن الجماعات اليهودية المتطرّفة، ليس المسيحيون فحسب من لا يجدون ترحيبا لديهم، بوصفهم "ضالين"، بل حتى المسلمين "الموحِّدين". وكما تُقدِّر الباحثة أن حلّ المسألة لا يقتصر على الاعتراف بحقوق المسيحي العربي، بل في خلق وفاق اجتماعي ثقافي من شأنه أن يغذّي الرغبة الجماعية في العيش معًا.
الكتاب: الصليب والكوفيّة.. تاريخ المسيحيّين العرب في فلسطين.
تأليف: باولا بيزّو.
الناشر: منشورات ساليرنو (روما) 'باللغة الإيطالية'.
سنة النشر: 2020.
عدد الصفحات: 167 ص.
* أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا