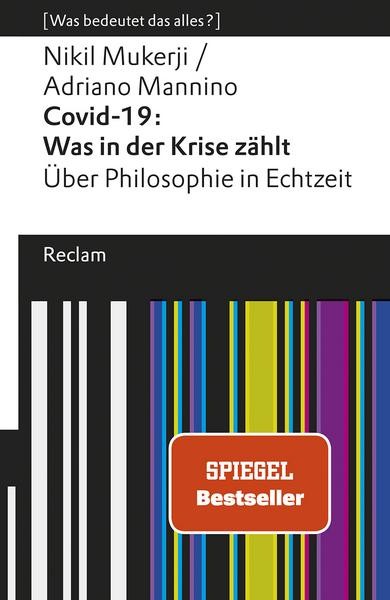نيكيل موكريي وأدرياو مانينو
رضوان ضاوي *
صَدَر كتاب جديد بعنوان "ما يهمّ في أزمة كوفيد 19: عن الفلسفة في الزمن الحقيقي" للفيلسوفين نيكيل موكرجي وأدريانو مانينو، الخبيرين الاقتصاديين، وهما عضوان في مجموعة بحثية متعددة التخصصات تعمل على تطوير إستراتيجيات للتعامل مع وباء كوفيد 19 ومخاطر الكوارث الأخرى، إلا أنهما ليسا من علماء الفيروسات أو علماء الأوبئة. فما الذي يمكن أن تسهم به الفلسفة في حلّ مشاكل الأوبئة والجوائح والأمراض؟ وكيف يكون العمل العقلاني ممكنًا في أزمة كورونا المستجدة؟ يتكون الكتاب من أربعة فصول وقاموس للمصطلحات المتعلّقة بالمجال المعجمي لكوفيد 19، إضافة إلى بيبليوغرافيا مهمة ينصح المؤلفان القرّاء بمطالعتها.
يؤكد المؤلِّفان على أنه خلال أزمة كوفيد، سرعان ما أصبح واضحًا أن علم الفيروسات وعلم الأوبئة ليسا التخصصين الوحيدين في مواجهة هذا الوباء؛ فموضوع خطير مثل هذا يتطلب مناقشة متعددة التخصصات تضيء جميع الجوانب ذات الصلة من وجهات نظر مختلفة للاقتصاديين والتشريعيين وعلماء الاجتماع.
ومن خلال الكتاب، يظهر جليّاً للقارئ أهمية الفلسفة في تقديم إجابات على سؤال القرار العقلاني والمبرّر أخلاقياً في ظل ظروف عدم اليقين والجهل. ذلك أن التخصصات الفلسفية تقدم هذا الموضوع من خلال نظرية المعرفة ونظرية العلوم ونظرية القرار وأخلاقيات المخاطرة وفلسفة الكوارث أو ما يمكن أن نسميه بيداغوجيا الكوارث.
يتحدث الكتاب عن الأهمية القصوى التي باتت "فلسفة في الوقت الحقيقي" تكتسيها في أزمة كورونا. فنظرًا لإلحاح المخاطر، هناك ضرورة حاليًا إلى اتخاذ قرارات ولا يمكن تحمل ترف الانتظار حتى يتم اثبات المعرفة بهذه المشاكل، لذا يتعين على الفلاسفة معالجة البيانات والحجج تحت ضغط الزمن، لأنه يجب اتخاذ القرارات بشأن الإجراء قبل نقطة زمنية معينة. ونظرا لأن هناك أولوية للممارسة، يتعين العمل بأفضل المعلومات المتاحة حتى لو كانت أقل موثوقية مما يتم قبوله في العادة، فوضع البحث يتغير بوتيرة سريعة، مما يتطلب تكييف تفكيرنا وتصرفنا.
الخبراء.. الثقة النسبية أو التشاؤم
ركَّز هذا الكتاب على ما سيراهن عليه الإنسان إذا لم يكن من الممكن استبعاد سيناريوهات أسوأ حالة كارثية، ليتجاوز المؤلفان القاعدة العامة التي تدعو إلى اتباع غالبية مجتمع الخبراء الذين يصدرون أحكامًا أكثر موثوقية من الناحية الإحصائية. فلا ينبغي أن تكون ثقة الناس مطلقة في رأي الأغلبية من الخبراء، بل يتوجب عليها أن تمثل حكمًا احتماليًا. تساعد نظرية القرار وأخلاقيات المخاطر على التخفيف من وطئة التساؤل عن المدى الذي سيكون فيه الأمر سيئًا إذا أخطأت مجموعة من الخبراء، فيكون الجواب عنه بالتفكير في الإجابة عن مثل هذا السيناريو. ففي حالة الموضوعات المثيرة للجدل، قد يكون من المعقول جدًا تصديق غالبية الخبراء، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون الناس آمنين ويتبعون أقلية من الخبراء المتشائمين في العمل التطبيقي، وتعني كلمة "متشائم" هنا أن الخبراء المعنيين يتوقعون سيناريو كارثة يجب التفكير في مواجهتها. يوضح المؤلفان أنه ربما أمكن تجنب الإغلاق إذا ما اتبع المسؤولون هذا المبدأ:"اتبع أقلية من الخبراء إذا كانوا متشائمين".
ومن هنا، يفحص هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة غير المريحة على نحو منهجي، فعندما ننظر إلى الوراء في بداية الوباء، نجد أنّ تطويق مقاطعة هوبي الصينية عسكريا، معطى قوي وواضح على أن حالة الخطر ربما تكون حقيقية للأوروبيين أيضاً، ودراسة الحالة المأساوية لشمال إيطاليا التي أيقظت أوروبا في النهاية لم تكن ضرورية. فقد كان ينبغي للصين أن تكفي؛ لأن العالم أصبح العالم أكثر عولمة وتشبيكًا، والفيروس يمكن أن ينتقل حول العالم في غضون ساعات قليلة فيتم إيقاف الحركة الجوية من الصين. كان ينبغي توقع ما سيحدث في سوق الأقنعة أثناء الجائحة، كمنتج ببنسٍ واحد أصبح "باهظ الثمن فجأة". وكان من المنطقي تطوير تطبيقات التتبع وتحديد إستراتيجيات لزيادة قدرات الاختبار، والتوقف عن مواصلة الدول الغربية التقليل من أهمية هذه الحزمة الفعالة والرخيصة نسبيًا من التدابير التي تم تنفيذها منذ فترة طويلة في كوريا الجنوبية وتايوان. كما توجَّب إنشاء أقسام للأمن الصحي في وزارة الصحة. ويستدرك الفيلسوفان أن الشروع في إجراءات صارمة، لا تتخذ من منطلق الثقة التامة فيها، ولكن من منطلق وجوب طرح هذه الإجراءات للتطبيق في ظل عدم اليقين، فيتوجب تبرير ضرورة الإغلاق على وجه اليقين، والتفكير في البديل الاجتماعي والاقتصادي للناس، رغم ذلك يؤمن الفيلسوفان بالمثل القائل: من الأفضل أن تبقى آمنا لا أن تبقى آسفاً، من خلال التفكير في تقليل المخاطر قدر الإمكان.
ينتقد الفيلسوفان بشدة عدم تبليغ الخبراء العلميين والسياسيين مثل هذا التبرير الذي ينطلق من موقف نقدي عقلاني: إذا لم تقم بإبطاء انتشار الفيروس بالسرعة الكافية، فإنك تخاطر بإصابة نفسك بالعدوى بشكل لا رجعة فيه، بينما يمكن تخفيف ورفع الإغلاق، فمن حيث المخاطر الأخلاقية، يعتبر الإغلاق أفضل كاستراتيجية قابلة للتحكم العكسي، مما يسمح بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت وتكييف أفعالنا مع الحالة الجديدة للمعرفة من خلال الموقف النقدي العقلاني. ويعطي الباحثان نموذج السويد التي خافت من التأثير الاقتصادي للإغلاق، ووثقت في العديد من الأشخاص الذين يلتزمون طوعًا بإجراءات الحجر، لكنها أغفلت أو تجاهلت مدى ضرر العدوى اقتصاديًا؛ لذا فقد عانت البلاد من عدد كبير من القتلى بلا داع وخاطرت مخاطرة كبيرة يصعب تبريرها.
بين العامّة والخبراء: افتقار إلى المعرفة بالأوبئة وضعف التواصل بين جماهير الاتحاد الأوروبي
في البداية تساوى العامّة والخبراء في مسألة عدم الأخذ بجدية الوباء. يفتقر العامّة إلى المعرفة الأساسية حول تاريخ الأوبئة والجوائح، ولم يسمعوا ربما من قبل بالأنفلونزا الإسبانية التي قتلت ما يصل إلى مئة مليون شخص بين عامي 1918 و1920، وهو عدد يقول المؤلفان إنه يفوق عدد الضحايا العسكريين في الحرب العالمية الأولى بأربع إلى خمس مرات. ومع ذلك، فإن هذه الكارثة لم تخترق ذاكرة الإنسان حقًا. لذلك؛ يُمكن أن يؤدي الوعي والتعليم التاريخي بالأوبئة إلى التقليل من حالات التهديد الحالية، ومعالجة عجز "المعرفة بالكوارث". أما العلماء والمتخصصون في الفيروسات فهم على دراية جيدة بمخاطر الفيروسات والأوبئة. ومع ذلك، كان بعضهم مخطئًا بشكل كبير في البداية. فقد قال عالم الفيروسات في بون، هندريك شتريك، في نهاية شهر يناير إن فيروس كورونا الجديد "ليس أكثر خطورة من الإنفلونزا"، كما أخطأ عالم الفيروسات كريستيان دروستن وعالم الأوبئة السويسري مارسيل سالاتي تقدير الخطر، وإن كان بشكل أقل وضوحًا، حيث أشارا إلى إمكانية السفر إلى إيطاليا دون التعرض للخطر المستجد. ثم كان شمال إيطاليا في حالة طوارئ، وأفاد أطباء العناية المركزة أنه يجب فرزها "كما هي الحال في الحرب".
يرجع المؤلفان حدوث مثل هذه الأحكام الخاطئة إلى حقيقة أن التقييمات ذات الصلة بالعمل مثل "الرحلات إلى إيطاليا غير إشكالية"، لا تلعب دورا في قضايا المخاطر الوبائية فحسب، بل أيضًا دورًا أخلاقيًّا. يمكن للمرء أن يلجأ إلى علم النفس لشرح التشوهات المعرفية النموذجية التي يتعرض لها حتى الخبراء الذين بالتأكيد لا يفتقرون إلى الخبرة الفنية، لكنهم يفتقدون إلى فهم هذه المعرفة بشكل حدسي وعاطفي بشكل صحيح وترجمتها إلى إجراءات مناسبة. أظهر علم النفس المعرفي أن الخبراء غالبًا ما يقعون في نفس المغالطات البديهية هنا مثل الأشخاص العاديين وغالبًا ما يجهلونها. ويضيف المؤلفان أن إدانة الخبراء والعلماء والاقتصاديين لكل شعور بالخوف على أنه غير عقلاني، لا يساعد في التقييم الموضوعي لموقف خطير. فرغم أن الناس وجدوا صعوبة في تقييم المخاطر بشكل مناسب ولا يعرفون أي شيء عن الخطر الفعلي الموجود في الجائحة الحالية، برع العديد من علماء النفس وعلماء المخاطر والاقتصاديين وعلماء السلوك البارزين في شهري فبراير ومارس من هذا العام، في الترويج للأطروحة القائلة بأن الناس أصيبوا بذعر لا أساس له من الصحة من فيروس إنفلونزا جديد.
وتفتقر المجتمعات الغربية على وجه الخصوص إلى المعرفة القائمة على الخبرة ذات الصلة والرغبة في التعلم من المجتمعات الأخرى. حتى وقت قريب، لم تكن الأوبئة الخطيرة ببساطة جزءًا من بيئتنا المعيشية. قال لوثار ويلر، رئيس معهد روبرت كوخ، في مؤتمر صحفي في نهاية شهر مارس: "نحن جميعًا في أزمة من الحجم الذي لم أكن أتخيلها أبدًا". ربما تلعب غطرسة ثقافية معينة دورًا في هذا الصدد، وربما كان الحذر من متمردي كورونا ممن يشكلون خليطا من الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة ومتطرفي اليمين ولكن أيضا من الألمان القلقين حيال الأمر، الذين ينشرون الادعاءات، وفقًا للشعار: "ما الذي يمكن أن يحدث لنا في الدولة الأكثر أمانًا والأكثر قوة اقتصاديًا في أوروبا؟" حتى عندما وقعت الكارثة في إيطاليا، تم في البداية نفي خطورة الوضع في ألمانيا وسويسرا. استغرق الأمر عدة أيام حتى يلاحظ الجمهور الألماني تقارير الفرز المروعة لأطباء العناية المركزة الإيطاليين، واجتهاد التنفيذيين والصحفيين الإيطاليين في محاولة بلا جدوى لعدة أيام لإيقاظ الجمهور الألماني، وهو راجع بالأساس إلى ضعف التواصل بين الجماهير في أوروبا الموحدة، وهذا يؤدي في وقت لاحق إلى زعزعة الثقة في المؤسسات العامة، وهي مسألة مهمة من منظور أخلاقي للمخاطر. لكن يجب توضيح أنه لا يوجد سبب لسحب الثقة في المؤسسات العامة أو في العلوم، حتى لو ثبت أن التدابير الوقائية غير ضرورية في حالة معينة، ففي حالة كوفيد- 19، تشير البيانات الحالية إلى أن التدابير الوقائية كانت مهمة وكان ينبغي اتخاذها قبل ذلك بكثير.
يذكُر المؤلفان ثلاث طرق مبررة أخلاقيا للخروج من الحجر: تأخير تسطيح منحنى العدوى على مدى فترة زمنية طويلة جدًا حتى لا يتم تحميل النظام الصحي فوق طاقته، وفرض سياسة الاحتواء، بهدف استخدام التدابير المناسبة لتقليل رقم التكاثر الفعال للفيروس ثم إيقافه تمامًا. وأخيرا استراتيجية الشرنقة، التي تمكن من حماية المجموعات المعرضة للخطر من خطر الإصابة على أفضل وجه ممكن، بينما يؤدي المجتمع بشكل طبيعي وظائفه. يميل المؤلفان إلى استراتيجية الشرنقة المبرّرة في ظل الخلفية التالية: يجب منح كبار السن والمرضى سابقًا حماية خاصة دون إهمال إجراءات الاحتواء مثل الاختبارات وتطبيقات التتبع وارتداء الأقنعة. يجب أيضًا أخذ التطعيم الإجباري في الاعتبار بمجرد توفر المستحضر المناسب. إن الإصابة البطيئة والتأخر في بناء مناعة القطيع، تنطوي على مخاطر صحية كبيرة وتكاليف اقتصادية هائلة وتحدُّ من حقوق الناس الأساسية لفترة طويلة بشكل غير مقبول. إذا لم تحم الناس نفسها فإنها تزيد العبء على المستشفيات في حالة المرض فيعرضون الآخرين إلى الخطر، وينعدم العلاج. وأسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تزدهر عدم بناء مناعة القطيع بشكل كاف، لأن العدوى، مثل الأنفلونزا الإسبانية، توجد منها موجة ثانية منها، وهي أكثر فتكًا بسبب طفرة في الفيروس؛ وأنه في غضون عامين لن يكون هناك لقاح؛ أو أن نسبة كبيرة من مرضى كوفيد 19 يعانون من أعراض خطيرة.
يُسائل موكرجي ومانيينو الخطاب السياسي الحالي عن شروط اتخاذ القرار العقلاني تحت ضغط الوقت وعلى أساس انعدام المعلومات الكافية علميا. ويشير هذا الفريق إلى أن الأزمات تتطلب تصور مبادئ القرار، وأن الحكمة السياسية تفعل ذلك بشكل مثالي قبل حدوث الأزمات. ولا يُظهر تركيز الكتاب على نظرية المعرفة بالمخاطر بأي حال من الأحوال حدودًا، بل يُظهر الثقة بالنفس للفلسفة كعلم أساسي، يتمثل اختصاصها في العمل "كمراقب لمدى ملاءمة جميع الاعتبارات الأخرى". وقد طرح المؤلفان نموذجا صارما لترتيب الأسئلة الفلسفية زمنيا، ويمكن تليخص أهم محتويات الكتاب على النحو التالي:
- كان الوباء متوقعاً. تحيل أزمة كوفيد الإنسان بشكل مباشر على أزمة البيئة الناتجة عن استهلاك اللحوم وإزالة الغابات وتغير المناخ بوصفها عوامل خلفية لفيروس سارس 2 ولتفشي الأمراض المعدية الناشئة، بسبب تدمير النظم البيئية، وإظهار العدوى على أنها عادةً كارثة طبيعية بمعنى حدث طارئ مصيري، هي النظرة المنعزلة للوباء التي تهدد بمنع الدروس المستفادة منها، ومن بينها يرى المؤلِّفان قبل كل شيء تحولًا بيئيًا، لا سيما في إنتاج اللحوم واستهلاكها.
- يحيل الفيلسوفان على هجمات وسائل الإعلام الشعبوية لصحيفة مثل صحيفة دير بلد على ممارسة البحث والنشر الفيروسي. هذا التبخيس في قيمة المعلومة هو الجانب السلبي للافتراض غير النقدي بأن علماء الفيروسات يمكنهم أيضًا اتخاذ قرارات صحيحة بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية. لذلك يوازن موكرجي ومانينو بين خبرتهما العلمية ولحظة الشك، والتي يمكن للجميع الوصول إليها: ماذا لو كنت مخطئًا؟ توجد الرغبة في أن يتمكن العلماء من "اكتساب وجهات نظر عقلانية وإيصالها إلى الجمهور دون تشويه"، وهذه المعالجة تصدّ التشويه الناجم عن عدم الفهم.
- من المهم جدا انتقاد القومية، التي أدت إلى تأخر الاستجابة السياسية والحزم في صنع القرار السياسي والنقاشات العامة أثناء الوباء، وبالتالي جعل الانتشار العالمي للفيروس ممكناً. يناقش الكتاب كيف يمكن اتخاذ القرارات بطريقة عقلانية ومبررة أخلاقياً في أزمة نشأت؛ كيف يجب، قبل كل شيء، تنسيق المعرفة المتخصصة واتخاذ القرار السياسي والخطاب الاجتماعي، وإجراء مناقشة أساسية حول وضع الخبير. فقد كان من الممكن اتخاذ الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء الصيني كمؤشرات على مدى التهديد على محمل الجد. ولكن على ما يبدو، فإن توطين مسببات الأمراض في مسافة يُفترض أنها غريبة يعيد إنتاج الأنماط الاستعمارية لسياسات الأوبئة في القرن التاسع عشر. ففي جغرافيا إلقاء اللوم على الآخر، تقوم الغرائبية بتوطين مسببات الأمراض على أطراف الحضارة، فغالبا ما تتناقض إجراءات الحجر الصحّي الصارمة مع مبادئ الحضارة الغربية.
- إلى جانب النظر إلى الأوبئة على أنها مجرد أحداث مصيرية أكثر من اعتبارها أحداثًا من صنع الإنسان جزئيًا ، يكون من السهولة بمكان تحديد المسؤولية البشرية عن أصل الفيروس. ويرى موكرجي ومانينو أن العوامل النفسية وراء الاستجابة المترددة للتهديد الوبائي الناتجة عن نقص الخبرة الشخصية والثقافة الشعبية وسرديات تفشي المرض والتهديدات القاتلة من العدوى العالمية، وبالتالي عدم القدرة على التخيل.
الفلسفة في أزمة: "يجب أن نفكر مسبقا"
ولكن لماذا يجب أن يتعامل علم نظري مثل الفلسفة مع أزمة كورونا؟ ما الذي يستطيع الفلاسفة رؤيته ولا يستطيع علماء الفيروسات رؤيته؟ يؤكد مؤلّفا هذا الكتاب أن الأمر "يتطلب مناقشة متعددة التخصصات تضيء جميع الجوانب من وجهات نظر مختلفة". تتمثل مهمة الفلسفة في الحصول على لمحة عامة عن كل شيء واستخلاص النتائج منه. ويأمل الفيلسوفان في "توفير قوة دفع فلسفية للنقاش مع هذا الكتاب". ورغم أن هناك من يشكك "في العمل الفلسفي الراسخ حول أزمة فيروس كوفيد 19 في مثل هذه المرحلة المبكرة"، إلا أن الجدل السياسي والاجتماعي أظهر "أن المعالجة المناسبة للكارثة الوبائية لا يمكن تركها لعلماء الفيروسات وعلماء الأوبئة وحدهم". ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه على الرغم من إتقانهم لمجال تخصصهم، إلا أنهم لا يستطيعون بالضرورة تقييم العواقب الاجتماعية الناتجة عن هذا الوباء: "تستطيع الفلسفة بالفعل أن تقدم مساهمة كبيرة في حل مشكلات صنع القرار المعقدة فيما يتعلق بالوباء، لكن الفلاسفة لا يستطيعون تحمل ترف انتظار جميع البيانات ذات الصلة". وهذا هو الخيط المشترك الذي يمرره الكتاب بأكمله: توقع الأسوأ، وعدم انتظار بيانات موثوقة، رغم أن هذا الكتاب يظهر أن الفلسفة تدعو إلى ضرورة التفكير في العواقب حتى في ظل عدم اليقين. ففي رأي المؤلفين، هذا هو بالضبط المكان الذي تدخل فيه الاعتبارات الفلسفية. ويقصد المؤلفان بـ"العلم في الوقت الحقيقي" أن أفضل المعلومات المتاحة حاليًا تأتي من العلم، لكن لا توجد معرفة علمية مضمونة بالكامل وأن غالبًا ما يكون هناك عدم يقين، وتصريحات متناقضة من قبل كبار علماء الفيروسات على أساس يومي. لكن هذا ليس سببًا للشك في العلم. على العكس من ذلك، هذا هو بالضبط ما يمكن أن يتوقعه المرء من العلم القائم على الأدلة: أن الأخطاء يتم مراجعتها بسرعة واستبدالها بنتائج علمية جديدة.
ويُختتم الكتاب بنظرة عامة حول ما يمكن أن نتعلمه من هذه الحالة لمستقبلنا؛ على سبيل المثال للمناقشات حول مخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ والذكاء الاصطناعي. هذا الكتاب يوضِّح كيفية الحفاظ على صفاء الذهن في ظل ظروف الكوارث من خلال تقييم عملية "الفرز"، والدعوة إلى "أخلاقيات الكارثة" وكيفية تجنب أخطاء الحكم في أزمة كورونا، ووجوب حظر "الأخبار الكاذبة والأكاذيب المتعمدة". ويحذِّر من أننا سنستيقظ مرة أخرى - من الكارثة الصغيرة إلى الكارثة الكبرى والأسوأ بكثير لتغير المناخ الذي سيستمر لعدة عقود مقبلة. ويُؤكد الفيلسوفان في كتابهما أن ما نحتاجه هو فلسفة أخلاقيات عقلانية قائمة على الأدلة ويأملان أن يكون هذا الكتاب "دافعًا فلسفيًا للنقاش". إنه كتاب موجه للمعلمين وللفضوليين، وللقراء المتخصصين، وهو مثال رئيسي للتواصل العلمي المفهوم وأحد أهم الكتب حول أزمة كورونا.
----------------------
- الكتاب: "كوفيد 19.. ما يهمُّ عن الفلسفة في الزمن الفعلي".
-المؤلفان: نيكيل مكريي وأدريانو مانينو.
- الناشر: ركلام، 2020، بالألمانية.
- عدد الصفحات: 120 صفحة.
* باحث في الدراسات المقارنة - الرباط/المغرب