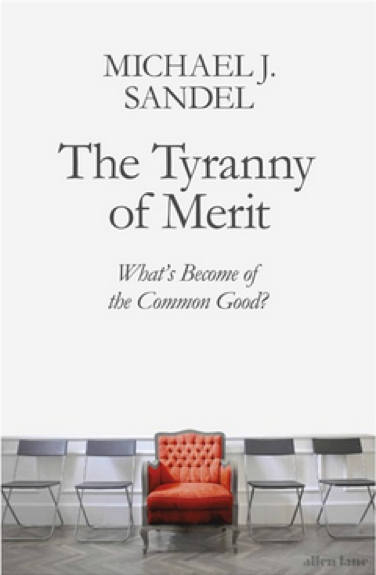ميخائيل صاندل
محمد الشيخ
لا مبدأ يبدو لنا أشد بداهة من مبدأ الاستحقاق ـ كل حسب ما يستحق ـ حتى أضحى هذا المبدأ من فرط بديهيته لا يناقش. لكن ثمة من فلاسفة اليوم من بدأ يجد في هذا المبدأ أنه مبدأ شديد الاشتكال. ومثلما جرت عادة الفلاسفة على استشكال المبادئ الكبرى ـ من "العقل" إلى "الكرامة"، ومن "الحق" إلى "العدالة" ـ يبدو أن الدور قد أتى، مؤخرا، على مبدأ الاستحقاق نفسه؛ وذلك لا بمعنى إنكاره كل الإنكار، وإنما بمعنى الوقوف على حدوده. فلا شيء "مقدس" في الخطاب الفلسفي المعاصر الذي بات يستشكل كل المبادئ التي بني عليها الفكر البشري استشكالا عميقا، لا إنكارا لها وإنما توسعا فيها؛ بحيث بات باسم العقل نفسه يتم الوقوف عند تخومه، وباسم العدالة ذاتها يتم تبيان حدودها، وباسم الكرامة عينها يتم إظهار اشتكالها.
مفتتح الكتاب:
جائحة كورونا وهشاشة الوضع البشري
في مفتتح كتابه هذا ـ طغيان الاستحقاق. ما الذي آل إليه الصالح العام (2020) ـ ينطلق الفيلسوف الأمريكي ميخائيل صاندل (1953- ) ـ الذي كان قد اشتهر بمناقشته لأطروحة جون راولز في العدالة (الليبرالية وحدود العدالة (1982)، وتأليفيه في مبحث "الفلسفة العمومية" (الشقاق الأمريكي (1998)، الفلسفة العمومية (2005)، وفي الأخلاقيات في زمن الهندسة الوراثية (2007)، وفي فلسفة المال في الحياة المعاصرة (ما الذي يمكن أن يشتريه المال: أخلاق حدود السوق (2012))، وانفتاحه على الفلسفة الشرقية (اللقاء بالصين (2018)) ـ ينطلق من جائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أنه لم يتم الإعداد لها. ويفحص عن أسباب عدم الاستعداد هذا في القرار السياسي (استهانة ترامب بالمرض) وفي القرار الوجستيكي (تباطؤ مراكز مراقبة الداء والوقاية منه في توزيع المعدات الطبية). لكنه يضيف أيضاً أنَّ البلد لم يكن مستعدًا من الناحية الخلقية (الانقسامات الاقتصادية والثقافية والسياسية العميقة). وهي الحصاد المر لعقود من التفاوتات الاجتماعية ومن ردود الفعل عليها وقد تجلت في الأحقاد الدفينة التي جاءت بترامب إلى سدة الحكم. والحال أنَّ أزمة الجائحة هي ثاني أفدح أزمة تصيب أمريكا بعد 11 سبتمبر، وقد قادت إلى: التباعد الاجتماعي، التخلي عن الشغل والمكوث بالبيت، التهديد المحدق بكبار السن وبمحيطهم ..
ويستنتج صاندل النتائج: أخلاقيا ذكرتنا الجائحة بهشاشتنا، وبتعالقنا إزاء بعضنا البعض؛ مما أدى إلى تكثيف الدعوة إلى التضامن. لكن، يتساءل الفيلسوف، أي تضامن في زمن الفرقة؟ وجوابه: تضامن الخوف من العدوى الذي بات يتضمن التباعد الاجتماعي والانعزال الذاتي.
ويقف الفيلسوف على مفارقات هذا الوضع: التضامن بالتعازل. ثمَّة ضرب من الفراغ يعتور الشعار: "كلنا نركب في نفس المركب". إذ لا يتعلق بضرب من الجماعة المجسّدة في ممارسة قائمة على إلزام متبادل وتضحية مشتركة، بل طفح على المشهد في وقت ازدادت فيه الفوارق الاقتصادية والأحقاد الاجتماعية. ذلك أنه في وقت دخول الولايات المتحدة الأمريكية عهد الاقتصاد المعولم، مع ما جلبه من اغتناء النخبة وافتقار العِدة، وجد البلد نفسه في حاجة إلى أن يستورد الكمامات الطبية والأدوية. وبهذا صار "الرابحون" من العولمة هم نفسهم دعاة حفظ المسافة عن "الخاسرين"، مؤكدين أنهم يستحقون نجاحاتهم. وبات الكل أمام العولمة سواء: الرابحون يستحقون ربحهم، والخاسرون يستحقون خسارتهم. والحال أن هذا النمط من التفكير ـ المبني على فكرة الاستحقاق: كل حسب استحقاقه ـ يجعل من العسير الاعتقاد بأننا كلنا في نفس المركب. كيف لا وهو يدعو الرابحين إلى اعتبار أن ربحهم ثمرة جهدهم، ويدفع الخاسرين إلى الشعور بأن أولئك الأعلون ينظرون إليهم بامتهان وحتى بشماتة؟ كما أنه يفسر لماذا أولئك الذين تركوا نهباً للعولمة باتوا غاضبين وحانقين، ولماذا انقادوا إلى الشعبويين السلطويين الذين تمردوا ضد النخب ووعدوا بإعادة إرساء الحدود القومية انتقاماً "للشعب الحقيقي"!
الحال أن أمر الجائحة لا يدعو فحسب إلى تجنيد الخبرة الطبية والعلمية، وإنما يحث أيضاً على تجديد النظر الأخلاقي والسياسي. فالامتزاج السام بين العُجْب والحَنَق الذي جاء بترامب إلى السلطة لا يُمكن أن يكون مصدر التضامن الذي نحتاج إليه اليوم. ذلك أنَّ أي أمل في تجديد الحياة الخلقية والمدنية رهين بفهم الروابط الاجتماعية ومآل احترام البعض للبعض.
مناسبة الكتاب وغايته
الغاية من هذا الكتاب مُحاولة تفسير لماذا حدث هذا الذي حدث واعتبار كيف يمكن أن نجد السبيل إلى ما يسميه المؤلف "سياسة الصالح العام". ذلك أنَّه في زمن قاد فيه الحنق ضد النخب الديمقراطية إلى الهاوية، فإن التساؤل حول الاستحقاق أضحى أمرا مستعجلا على وجه الخصوص. وقد بتنا بحاجة إلى التساؤل عما إذا كان الحل لانشقاقاتنا السياسية هو العيش عيشاً على نحو أصدق وفق مبدأ الاستحقاق، أم السعي إلى الصالح العام في ما وراء الانتقاء والاصطفاء والجهد والاستعداد والاستحقاق.
دعوى الكتاب:
استشكال أمر الاستحقاق
على طريقة الفلاسفة الذين يتفلسفون وفق التقليد الأنجلوسكسوني، ينطلق المؤلف من "كائنة" حدثت في مارس 2019. وكما أسس عالم الرياضيات والفيلسوف الإنجليزي وليام كليفورد مبحث "أخلاقيات الاعتقاد" (1877) انطلاقاً من كائنة جنوح سفينة إيرلندية في عهده كانت رائحة إلى الولايات المُتحدة الأمريكية واعتقد صاحبها اعتقادًا جازمًا بأنها سوف تنتهي إلى شط النجاة مع حملها حمولة أكثر مما تقتدر عليه، كذلك سعى المؤلف إلى تأسيس مبحث "الفلسفة العمومية" انطلاقاً من هذه "الحادثة" التي تورطت فيها شخصيات أمريكية بارزة وهي تسعى لضمان الامتياز لأبنائها في التعليم تحت غطاء الاستحقاق. كانت فضيحة مدوية حول من يستحق أن يكون في الصفوف الأمامية، ولماذا يا ترى؟ أي مسألة: من يستحق ماذا؟ وقد طرحت هذه الفضيحة مسألة أخلاقيات القبول في الجامعات النخبوية الأمريكية بناءً على المال تبرعاً وهدية وإرشاء. ولئن كان الأصل في الاستحقاق أن يتطلب الولوج من الباب الأمامي، وليس من "الباب الخلفي" ـ وهو ما يعتبره أغلب الناس أمرًا منصفاً؛ إذ يرون أنه على المقبولين أن يُقبَلوا بناءً على استحقاقهم الخاص وليس على أساس ثروة آبائهم ـ فإن الأمر في واقع الحال أعقد من هذا بكثير. فالمال ـ تبرعاً ـ من شأنه أن يولج من الباب الأمامي كما من الباب الخلفي. ومن الصعب فصل المقال في ما يوجد بين معايير الاستحقاق والمزايا الاقتصادية من اتصال. والمشكلة يطرحها الفيلسوف على نحو جذري: أليس توجد شروط مسبقة تشرط الاستحقاق نفسه؛ فتجعله بلا استحقاق؟ خذ مثلا الواقع التالي: لا ينشأ الناس متساوين قبل تباري الاستحقاق وأثنائه؛ إذ ثمة من جادت عليهم الظروف بتربية ثرة وبتعليم موسيقي مُبكر وبممارسة للقدرات الرياضية مساعدة؛ بما جعل استحقاقهم ضربا من الإعداد المسبق؛ وبالتالي منحهم الامتياز، وأكسبهم التفوق. ثم تأتي بعد ذلك استحقاقات الدراسة التي لا يقدر على تأديتها اللهم إلا الأثرياء...
ههنا مكمن المفارقة: يدعو التعليم العالي إلى تبني مبدأ الاستحقاق، لكنه لا يحقق عملياً سوى مبدأ الامتياز. وقد صار الاستحقاق أكثر حتى من مجرد مسألة اقتصادية (أداء مقابل التعليم)؛ إذ بات أولياء الطلبة يشترون الاستحقاق نفسه. ففي مجتمع التفاوت، يعتقد أهل المقامات المكينة أن نجاحهم مُسَوّغ أخلاقيا. وفي مجتمع الاستحقاق يعني هذا أن على الرابحين الاعتقاد بأنهم إنما فازوا بسبب موهبتهم الشخصية وكدهم الشديد. لكن الحقيقة أن هذا الاستحقاق، إن هو فُتش أمره، وُجِد أنه هبة غش ومنة إرشاء من أوليائهم. ولو كان الآباء يراعون فعلاً تأهيل أبنائهم للعيش في ثراء، لاكتفوا بوهبهم ثرواتهم، لكنهم يرغبون في شيء تكميلي ـ هو بالذات الطابع الاستحقاقي الذي تمنحه الكليات النخبوية. وهنا يبدو التعارض مع القبول المبني على الاستحقاق أمرا بديهيا: يفتخر المقبولون قبولا مشروعا بما أنجزوه فعلا. لكن هذا الأمر غير صحيح بالتمام. فالاستحقاق هنا احتاج إلى أمر آخر غير كدهم: الامتياز القبلي. ألم يفيدوا من آباء وأساتذة سخروا أنفسهم في مسارهم؟ وما القول في المواهب والهدايا التي ما كانت كلها من صنع أيديهم؟ وما القول في الحظ السعيد الذي حالفهم بأن ازدادوا في مجتمع ينمي المواهب ويكافئها؟ الحال أن أولئك الذين يفخرون بالتفوق في منافسة استحقاقية مدينون إلى منافسة تُغمض الأمر ولا توضحه. وبقدر ما يشتد الاستحقاق يستغرقنا الجهد المبذول حد الذهول عن الدَّيْن المستحق. وفق هذا الاعتبار، حتى نظام استحقاق منصف، نظام من غير غش أو إرشاء أو غدق امتياز على أهل الثروات، من شأنه أن يؤدي لا محالة إلى انطباع مغلوط ـ انطباع أننا نحصل على ما حصلنا عليه بفضل جهدنا؛ وذلك حتى بات من اليسير أن نحسب أننا صنيعة أنفسنا وأننا كفاية ذواتنا، وأمسى من العسير أن نتعلم شيئا من التواضع والامتنان. والحال أنه من دون هذين الإحساسين، من الصعب العناية بالصالح العام. كانت كائنة مارس 2019 مجرد مناسبة لطرح الحجج حول مبدأ الاستحقاق واستشكالها. والحال أن النقاشات حول من يستحق تعج بها السياسة الحديثة. وظاهر هذه النقاشات أنها نقاشات تدور على مبدأ الإنصاف: هل يحظى كل شخص حقا بالفرصة عينها للتنافس حول خيرات وأوضاع اجتماعية مطلوبة؟ لكن اختلافاتنا حول الاستحقاق ما كانت فحسب اختلافات حول الإنصاف، وإنما هي أيضاً اختلافات حول ما الذي يحدد النجاح والإخفاق، وحول المواقف التي ينبغي للفائزين أن يتبنوها نحو أولئك الذين كانوا أقل نجاحا منهم.
ولهذه الحيثية تتناول فصول هذا الكتاب القضيتين الرئيسيتين التاليتين:
أ ـ كيف تم استحضار معنى الاستحقاق في العقود الأخيرة على نحو أهدر كرامة الشغل وجعل أشخاصا يشعرون أن النخب باتت تنظر إليهم نظرة استعلاء؟
ب ـ وهل الرابحون من العولمة مسوَّغون في اعتقادهم أنهم فازوا؛ وبالتالي يستحقون فوزهم، أم أن هذا الاستحقاق مجرد مَخِيلة منهم؟
من نتائج الدعوى:
أ ـ مبدأ الاستحقاق والصالح العام:
كثيرا ما تم حسبان أن المجتمع العادل إنما هو مجتمع الاستحقاق الذي يكون فيه لكل فرد حظ متكافئ لتطوير أقصى ما يمكن أن تقود إليه الموهبة والكد. لكن المؤلف يرى أن هذا التصور باطل: المساواة في الحظوظ أخلاقيا ضرورية للإنصاف من إجحاف، لكنها مبدأ تقويمي وليس مثالا مناسبا للمجتمع الجيد. ذلك أننا إذ نفيد من نجاح البعض، فإننا نتساءل كيف للآخرين أن يُؤهَّلوا للانفلات من ظروف تشدهم إلى الأدنى بالعوز والإجحاف. لكن المجتمع الجيد لا يمكن أن ينهض فحسب على وعد بالانفلات من الانحدار. ما أحوجنا إلى بديل عن المساواة في الفرص ـ مبدأ الاستحقاق ـ بمساواة واسعة في الوضع الذي يؤهل أولئك الذين لم يحققوا ثروة أو يكسبوا موقعا للعيش بكرامة؛ بحيث يُمَكَّنوا من تطوير مهاراتهم وممارستها في الشغل الذي من شأنه أن يكسبهم التقدير الاجتماعي، وبحيث يتقاسمون ثقافة تعليم منتشرة انتشارا واسعا، ويتداولون مع مواطنيهم في الشأن العام.
ب ـ الديمقراطية والتواضع:
أدى عقدان من العولمة إلى حدوث تفاوتات في المدخول والثروة هائلة إلى حد أنه تمخض عنها نمطا عيش متباينان بأشد تباين يكون: نمط عيش النبلاء ونمط عيش الوضعاء اللذان باتا نادرا ما يلتقيان في ما بينهما البين في تزجية سحابة يومهما. وقد باتا يعيشان ويشتغلان ويتبضعان ويلهيان في مكانين مختلفين على حالين متباينين، وصار أبناء كل واحد منهما يروحون إلى مدرستين مختلفتين. وإذ فعلت آلة الحظ الاستحقاقية فعلها، بات يستحيل على أولئك الذين يوجدون في الذروة أن يقاوموا الفكرة القائلة بأنهم يستحقون نجاحهم، وأولئك الذين يوجدون في الحضيض يستحقون ما لحق بهم ... وكان أن فقد المجتمع مهارة التداول في الشؤون العامة أو حتى الإصغاء إلى بعضه البعض.
شيء من تاريخ مفهوم الاستحقاق وتصور الصالح العام
أصل الاستحقاق مبدأ ديني: بدأ الاستحقاق مساره بتعزيز فكرة أنه يمكننا، عن طريق الكدح والعبادة، أن نجعل فضل الرب يميل إلى جانبنا لكي يشملنا بإنعامه. ثم سرعان ما تَدَنْوَنَتْ هذه الفكرة؛ بحيث بات إيماننا طوع أيدينا: بذل الجهد. وصرنا أمام تصورين للصالح العام: التصور الاستهلاكي والتصور المدني. لئن كان الصالح العام يكمن فقط في مضاعفة رفاهية المستهلكين، فإن تحقيق المساواة في الوضع بات لا يهم في نهاية المطاف. ولئن كانت الديمقراطية مجرد ممارسة للاقتصاد بسبل أخرى، سبل فيها مزيد من تحقيق مصالحنا الشخصية وتفضيلاتنا، فإن مصيرها لا يمسي آنها مرتهنا إلى الروابط الأخلاقية بين المواطنين. لكن، لَئِنْ كان لا يمكن حدوث الصالح العام اللهم إلا بالتداول بين المواطنين حول الأغراض والغايات المهمة في حياتنا المشتركة، فإن هذا الأمر لا يتطلب بالضرورة مساواة تامة، ولكنه يقتضي أن يلاقي المواطنون من مختلف سبل العيش بعضهم البعض في أماكن مشتركة وحول قضايا متبادلة. هُوَ ذا طريق العناية بالصالح العام. إن القناعة الاستحقاقية بأن الناس يستحقون كل الغنى التي يمنحها السوق إلى مواهبهم يجعل مشروع التضامن مشروعا مستحيلا. علينا الإقرار بأنه، في ما يخص مجهودنا بما يلي: كلا؛ ما كنا صناع أنفسنا ولا كنا مكتفين بذواتنا، وإنما شأننا أننا نجد أنفسنا في مجتمع يقدر المواهب، وذلك كان حظا سعيدا أصبنا منه وما كان استحقاقا لنا. ومن شأن هذا الأمر أن يلهمنا شيئا من التواضع: علينا ألا ننسى أن ما تحقق لنا كان إما بفضل الرب أو بصدفة الميلاد أو حتى بسر القدر ... ومن شأن هذا التواضع أن يكون بداية طريق العدول عن أخلاق النجاح المتصلبة التي تقودنا إلى العزلة. وهو تواضع أمره أن يقودنا إلى ما وراء طغيان الاستحقاق نحو حياة عمومية جماعية أقل سخما وأكثر سخاء.
---------------------------------------------------------------------------------
عنوان الكتاب :طغيان الاستحقاق ما الذي آل إليه الصالح العام؟
اسم المؤلف : ميخائيل صاندل
دار النشر : بينكوين
بلد النشر : إنجلترا
سنة النشر: 2020