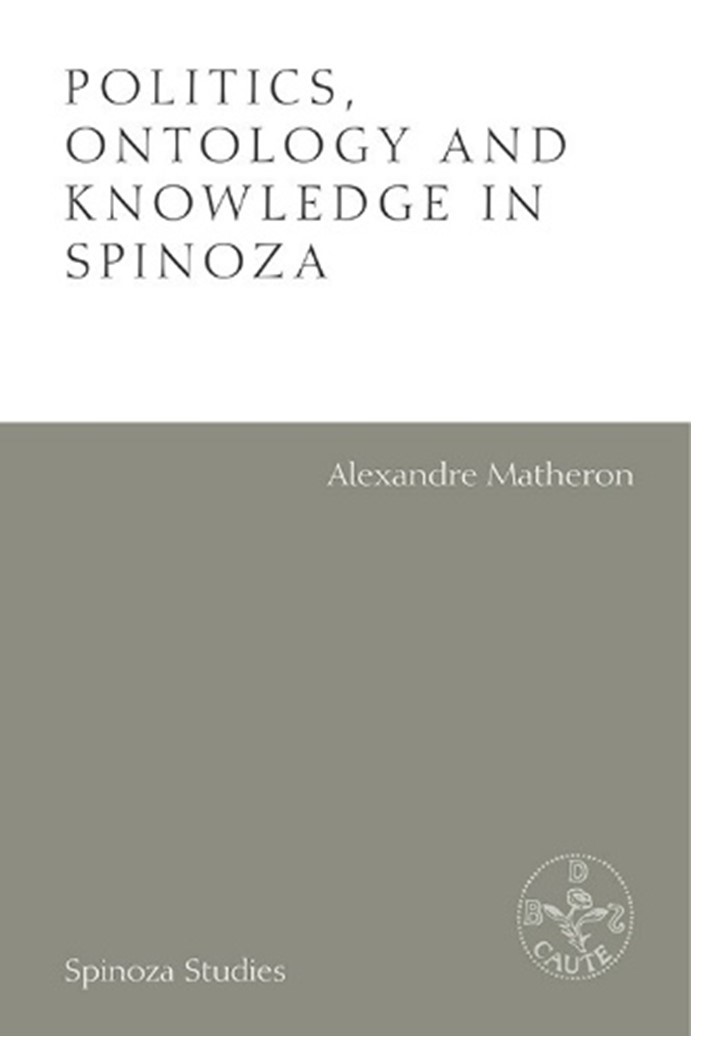ألكسندر ماثرون
وليد العبري
هذه فرصة لمن يعشقون الفكر الفلسفي الفرنسي، ويعوزهم إيجاد مدخل سهل المتناول إليه بلسانه الأصلي.. هو كتاب أحد أهم الدارسين لفكر الفيلسوف الهولندي إسبينوزا -أحد الفلاسفة الذين لا يبلى فكرهم، والذين يعاد إليهم باستمرار- وهو الدارس الذي كان قد لفت الانتباه إليه منذ كتابه الأول عن هذا الفيلسوف: "الفرد والجماعة عند إسبينوزا" 1969م. يجمع الكتاب بين دفتيه عشرين مقالًا لهذا الباحث مدارها على علم الوجود عند إسبينوزا، وعلى نظرية المعرفة، ونظرية السياسة، والنظرية الإتيقية (فلسفة أسلوب العيش)، وذلك بعقد مقارنات مهمة بين جديد إسبينوزا بالقياس إلى أسلافه والنظر إلى حواره مع مجانينه.
إنَّه المصير الغريب للفلاسفة الذين كانوا غزيري الإنتاج كماركس وهيجل وسبينوزا قبله، يعاملون كما ذكر ألكسندر ماتيرون في كتابه، مثل "كلب ميت". في الواقع، من الغريب، ولكن ربما ليس من المستغرب، أن الشخصيات الرئيسة فيما كان يسمى "ثورة"، أو على الأقل "نهضة"، في منحة إسبينوزا الأخيرة بالكاد معروفة خارج الدوائر المفتوحة في بلدانهم الأصلية. بتصفح الببليوغرافيا لأي عمل رئيسي عن إسبينوزا بأي لغة من السنوات الخمسين الماضية، سيجد المرء دائما اسم ألكسندر ماثرون، على الرغم من أن أعماله لم تُترجم تقريبا، وتقديرا واسعا لعمله، والمشاركة فيه ما زالت سلسلة "Spinoza Studies" الجديدة في مطبعة جامعة أدنبره، تهدف إلى معالجة مثل هذه الغيابات الواضحة، مما يجعل عمل علماء إسبينوزا المهمين متاحا حديثا لجمهور عريض.
مع نشر هذا المجلد، يسعدنا أن نقدم مجموعة كبيرة من الكتابات من قبل عالم إسبينوزا البارز ومؤرخ الفلسفة، ألكسندر ماثرون، لقراء اللغة الإنجليزية لأول مرة. لا يمكن أن يكون هناك شك في أن ماثرون قام بمفرده بأهم وأعمق المساهمات في منحة إسبينوزا على مدى المائة عام الماضية. كما يكتب لوران بوف، "الفلاسفة ومؤرخو الفلسفة معروفون بألكسندر ماثرون؛ باعتباره واحدا من أعظم المعلقين، إن لم يكن أعظمهم، على فلسفة إسبينوزا".
عند قراءة المقالات التي تمَّ جمعها في هذا الكتاب، لا يسع المرء إلا أن يتعاطف مع إحباط باليبار: نهج ألكسندر ماثرون كثيرا ما يستمر من خلال تحديد التناقض الواضح أو، وبدلا من البحث في مكان ما وراء النص، كما كان، من أجل حله، أو حتى في نوع من الحركة التفكيكية، التي تعلن وجودها حالة من الاحتمالية أو استحالة لتماسكها المنهجي، تسعى بدلا من ذلك إلى تحديد وتعبئة الموارد الفلسفية الداخلية للعقيدة نفسها؛ التي تحيد التناقض وتبعده. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن أولئك الذين يرون الصراعات والتناقضات في نصوص إسبينوزا ببساطة مخطئون أو قصيرو النظر، ولكن بالأحرى فإن المشاكل الحقيقية لا تنشأ إلا بعد إعادة صياغة هذه التناقضات الواضحة على أساس إشكالية سبينوزية حقيقية. ولكن كما يقول ماثرون نفسه في مراجعة للمجلد الأول من دراسات جيولوريت عام 1972م، حول "كيف يمكننا إعادة تشكيل المشاكل إن لم يكن على أساس المعرفة الدقيقة للأنظمة؟" التوجه نحو الإشكاليات التي اتسمت بها العقلانية الفرنسية من باشلارد إلى ديلوز. ومع ذلك، فإن ماثرون معني بنفس القدر بمدى أهمية إسبينوزا للفلسفة السياسية، وشروط إمكانية الظهور التاريخي للسبينوزية، وقضايا التفسير وفلسفة اللغة.
وفي الحد الأقصى، تشير قراءات ماثرون إلى أنه ببساطة لا توجد تناقضات في عقيدة إسبينوزا. وهذا لا يعني أن عقيدة إسبينوزا كاملة ومتسقة بشكل غير مشكوك فيه، الحلم المحقق للمثالية المطلقة، ولكن بدلا من ذلك تكشف أن ماثرون كشف أن ثغراتها وتناقضها ليست تناقضات غير قابلة للذوبان أو مجرد إشراف. ويبدأ ماثرون دائما في ظل هذه التوترات، في صميم هذه المشاكل السبينوزية، كما لو كان ينجذب إلى ضرورتها المعقدة بنفس الطريقة التي يرى إسبينوزا نفسه. وكما يقول فيليب دي لوشيز: "من النادر أن تلتقي بمعلق يعرف بعمق العقيدة التي يدرسها"، وهذا ينطبق بالضبط على ألكسندر ماثرون.
كان كتاب ماثرون الأول هو "Individu et communauté chez Spinoza" (1969)، وهي دراسة ضخمة للأخلاقيات التي تم نشرها في سلسلة بيير بورديو المؤثرة، والتي وصفها أنطونيو نيغري ذات مرة بأنها الأكثر مغامرة بين جميع محاولات التحليل الهيكلي للنص. كان هذا الكتاب من بين القراءات الأولى، المستمرة على الإطلاق للإصرار على مركزية الأسئلة السياسية لمشروع إسبينوزا الفلسفي، وللتجادل حول حداثة الفكر السياسي لسبينوزا، والذي كان يُنظر إليه غالبا إما على أنه تعاقد ليبرالي، أو متغير ضال من المطلقة هوبسيان. في الواقع، من بين الدراسات الفرنسية العظيمة الثلاث حول إسبينوزا التي ظهرت في نهاية الستينيات، كانت الماركسية ماثرون هي الأكثر سياسية وذهنية.
وعلى الرغم من أن تعبير جيل ديلوز في الفلسفة كان حاسما، لكيفية تعامل الفلاسفة الفرنسيين بعد الحرب مع السياسة من خلال إسبينوزا، فإنه في حد ذاته لم يكن نصا سياسيا، ودراسة جيولوريت المكونة من مجلدين حول الفيلسوف تقريبا غير سياسية. ويمكن للمرء أن يقارن كتاب ماثرون الأول بنقد الكاتب جين باولو سارتوري وهو نقد العقل الجدلي، ولكن يعاد كتابته على أسس سبينوزية بالكامل: فهو يشرح منطقا اصطناعيا صارما للتكوين التدريجي والتنظيم، بدءا من البساطة الجسدية للمادة الممتدة، وينتهي في الحياة الأبدية عبر الفرد من المجتمع المذهل من الحكماء، يمر عبر الاغتراب المستوطن في المجتمع السياسي لأنه ينشأ بشكل طبيعي بين البشر الخاضعين للعواطف، والتطور التدريجي لقوى العقل من داخل تلك الأشكال الاجتماعية.
ما وراء الدولة "الليبرالية"، "البرجوازية "، والمرحلة الانتقالية للحياة المعقولة بين البشر، يعلن ماثرون أن ما يريده الحكيم السبيني هو "تأسيس شيوعية من العقول: لجعل الإنسانية كلها موجودة كإجمالي واعٍ لذاته، عالم مصغر من الفهم اللامتناهي، حيث ستصبح كل نفس، في نفس الوقت، نفسها في نفس الوقت كل الآخرين.
ويصف بيير فرانسوا مورو النص بأنه يحتوي على مهمة مزدوجة، والتي قد نسميها "جدلية" من ناحية فك رموز العواطف؛ التي تدفع السلوك البشري في الرسائل السياسية على أنها تلك التي تم تحليل تكوينها في الأخلاق. ومن ناحية أخرى، فإن إظهار مفتاح فهم هذه العواطف يكمن في التكوينات الاجتماعية والمؤسسات السياسية التي يتم تحليل طبيعتها في الرسائل.
وبعد ذلك بعامين، نشر ماثرون كتابا آخر "المسيح وإنقاذ الجهل في إسبينوزا" (1971)، لطالما نفدت الطباعة ويكاد يكون من المستحيل العثور عليها اليوم. هذا الكتاب مكرس للكشف عن بعض من أصعب التوترات في كتابات إسبينوزا اللاهوتية السياسية، والتي تقع بالضبط في نقطة الربط بين السياسة واللاهوت. السؤال الأولي الذي يحرك النص يعطيه أيضا عنوانه: كيف يمكن لسبينوزا أن يحمل باستمرار في المسائل الخاصة، أنَّ الجهل يمكن أن يحقق الخلاص بمجرد الطاعة، وأيضا أن الخلاص هو مسألة معرفة وحرية؟ أو مرة أخرى: كيف يمكننا التوفيق بين عقلانية إسبينوزا المطلقة، والتي تظهر بوضوح في نقده القاسي لأي معرفة محتملة لله من خلال المعجزات، مع إصراره على أن حقيقة الخلاص عن طريق الطاعة لا يمكن الوصول إليها عن طريق العقل، ولكن فقط من خلال الوحي؟ في الواقع، وبالنسبة لإسبينوزا، كان معنى المسيح، ذلك النبي الأعزل المدمر الذي سُيد بامتياز في مسائل النوع الثالث من المعرفة، كان، من بين أنماط محدودة، الشخص الذي ظهرت من خلاله فكرة الله لأعلى درجة حصلت عليها حتى الآن؟ يرفض ماثرون تماما كل حل سهل لهذه المعضلات، ويصر على اتساق فكر إسبينوزا والضرورة المفاهيمية والتاريخية لهذه المشاكل نفسها.
والنتيجة هي عمل مذهل للإنتاجية الفلسفية، والذي يوضح المفاهيم التي يمتد معناها إلى ما هو أبعد من النطاق الباطني لتركيزه الواضح؛ إنه نص حول الاحتمالية والضرورة التاريخية، حول المنطق الملموس للانتشار الإيديولوجي والانتكاس، حول قوة الخيال وتفاعل الديناميكيات الاجتماعية المعقدة في الدستور التاريخي لحقيقة تتطلع إلى العالمية الراديكالية. كما يوضح نيغري، يوضح لنا ماثرون في هذا العمل كيف بالنسبة لإسبينوزا، "يتم إعادة تفسير إشكالية الخلاص الدينية بالكامل في ضوء هذا المنظور العلماني والمادي للتحرير".
لقد اخترنا تنظيم الفصول في هذا المجلد حسب الموضوع.. تم تجميع المجموعة الأولى من المقالات تحت عنوان (Spinoza on Ontology and Knowledge).. إنها تتعلق بما قد يبدو مشاكل تقليدية نسبيا للميتافيزيقيا والمعرفية: الطبيعة الانعكاسية المتأصلة للأفكار في إسبينوزا من أقرب أعماله، إلى أعماله الأكثر نضجا؛ التطور التدريجي للميتافيزيقيا للسلطة في إسبينوزا وعلاقتها بالفيزياء (الفصول من 2-4)، والمفاهيم الصعبة المعروفة للحياة الأبدية والمحبة الفكرية لله في الجزء الخامس من الأخلاق (الفصلان 5 و6). حتى على هذا المستوى الميتافيزيقي المجرد ظاهريا، فإن قراءة ماثرون لسبينوزا لها إيحاءات سياسية مهمة؛ كما يلاحظ ماثرون نفسه في المقابلة الملحقة بهذا المجلد، كان يعتقد أن "الخلود" حياة المجاهد، والذي بدا لي أنه أفضل مثال على كفاية وجودنا لجوهرنا".
المجموعة الثانية أكبر بكثير من المقالات التي تم تجميعها تحت عنوان "إسبينوزا حول السياسة والأخلاق". هناك تداخل مواضيعي كبير عبر جميع هذه الفصول تقريبا، ولكن يمكن تقسيمها مؤقتا إلى مجموعات أصغر تشترك في تركيز معين. تتضمن الفصول من 7 إلى 11 قراءة ماثرون لأمر إسبينوزا، في الفصل الأول من الرسالة السياسية، بأنه يجب علينا "البحث عن الأسباب والأسس الطبيعية للدولة، ليس من تعاليم العقل، ولكن من الطبيعة أو الحالة المشتركة، من الرجال، كما يؤكد ماثرون مرارا وتكرارا، وهذا يعني: على أساس التأثيرات السلبية.
وفي الواقع، نجد في هذه الفصول واحدة من أكثر مساهمات ماثرون الأصلية، وهو ما يشير إليه أحيانا باسم "التأثيرات الأساسية الأربعة": الشفقة والحسد وطموح المجد وطموح الهيمنة. كما يوضح، كل هذا يتبع تقليد التأثيرات، حتى في حالة الطبيعة الافتراضية، والقطع الزائد، وينتج كل منهما الآخر في دورة لا نهاية لها مدفوعة بالسخط؛ وهذا، كما يجادل، كافٍ في حد ذاته لمراعاة الإنشاء الواقعي لإمبريالية ديمقراطية وتشكيل المجتمع السياسي. تسمح هذه القراءة المبتكرة لماثرون بالحفاظ على أن إسبينوزا يطور حسابا غير متعاقد بشكل جذري حول نشأة الدولة المدنية، وحتى دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي حساب نفعي من جانب أي فرد. لكن الدور الحاسم الذي يلعبه السخط في هذه القصة أيضا، كما يحرص على التأكيد، يستلزم وجود شيء لا يمكن إصلاحه (بالمعنى التقني لمصطلح إسبينوزا) على أساس جميع المجتمعات السياسية، وهي آلية فعالة للقمع وأساس اجتماعي للكراهية غير القابلة للاختزال، باتباع مكيافيللي، وربما توقع بعض رؤى نيتشه وفرويد. بهذه الطريقة، يمكن أن تكون تحليلات ماثرون الرصينة بمثابة تصحيح مفيد لأولئك الذين يرون في إسبينوزا سياسة إيجابية بحتة وسعيدة، دون تلوث بأي سلبية.
يستمر تحليل ماثرون لطبيعة السياسة إسبينوزا في الفصول القليلة التالية، التي تتعامل مع الوضع الأنطولوجي لشيئين محددين ومدهشين: الدولة نفسها (الفصل 12)، والكتاب المقدس (الفصل 13). كلاهما، كما يجادل ماثرون بشكل مقنع، مؤهلان كأفراد، بالمعنى الدقيق للفرد لدى إسبينوزا، على افتراض أن بعض الشروط الخارجية المهمة قد استوفيت. وبتأكيد الفردية الوجودية للدولة والكتاب المقدس، يلخص ماثرون بعض الموضوعات المهمة من دراساته السابقة: يجب أن يفهم كل منهم على أنه يمتلك جهازه المناسب، ويفتح تحليله على الأسئلة المتعلقة بالاستقلالية النسبية للإنتاج الاجتماعي والأيديولوجي، وتصور الاستنساخ كعمليات تاريخية ملموسة. بعد ذلك، يلخص (الفصل 14)، الذي تمت كتابته في الأصل لمجلة الحزب الشيوعي الفرنسي، كل هذه الانعكاسات السياسية في رواية مضاربة شاملة تلعب دورا جوهريا في تكوين المجتمع السياسي، والاغتراب المصاحب له، واحتمال تجاوز الآفاق القاتمة لشكل الدولة الحديثة من خلال قوى العقل، كل ذلك من منظور نظرية إسبينوزا للسلطة.
تتناول الفصول القليلة التالية "مشاكل" محددة في الانعكاسات السياسية والأنثروبولوجية لسبينوزا. في هذه المقالات، تناول ماثرون علاقة إسبينوزا بنظرية الملكية في القرن السابع عشر (الفصل 15)، ومسألة الجنس في فلسفته المنهجية (الفصل 16)، واستبعاده النساء والخادمات من المشاركة في الدولة الديمقراطية التي يتوخى (الفصل 17). يحذرنا ماثرون من عدم التحرك بسرعة كبيرة في إدانة إسبينوزا في هذه الأمور من موقفنا التاريخي الخاص، والذي قد يبدو عليه من الواضح أنه تراجع ولا يمكن الدفاع عنه، ولكنه يرفض أيضا تبرير مواقفه على أنها مجرد "منتجات وقتهم". وبدلا من ذلك، تسعى تحليلاته إلى شرح كيف ولماذا رأى إسبينوزا هذه المواقف على أنها نتائج متناسقة حقا، إذا كانت مزعجة، من نهجه الفلسفي في الحياة السياسية والأخلاقية في ظل ظروف لا يكون فيها للعقل اليد العليا بشكل واضح على العواطف، التي تحدد بقوة رغبات وسلوك الغالبية العظمى من البشر.
ويُمكن وصف الفصول المتبقية بأنها دراسات مقارنة. نجد فيها ماثرون يتناقض مع إسبينوزا وهوبز حول موضوع العلاقة بين السلطة والحق، حيث يجادل بأن نقد روسو الشهير لـ"حق الأقوى '' يخطئ العلامة في كلتا الحالتين ولكن لأسباب معاكسة (الفصل 18). ويقارنهم أيضا بموضوع الديمقراطية، بحجة أن شرح هوبز لمفهوم التفويض في حسابه للعقد الاجتماعي، بين دي سيفي وليفاثان، تم تصميمه لتحل محل الأسبقية النظرية التي منحها عمله السابق دون قصد إلى السيادة الديمقراطية، أولوية يؤكد عليها إسبينوزا بشكل لا لبس فيه (الفصل 19). الفصل الأخير (الفصل 20) يشكل حجة طويلة ومعقدة لنظرية الفلسفة السياسية السبينوزية، والتي، كما يدعي ماثرون، هو أول الهاربين من الرابط المزدوج للوضعية الوهمية والمثالية غير المجدية. لكن هذا الحساب له تطور تاريخي مادي: إذا كان إسبينوزا، وفقا لماثرون، قادرا على التحايل على هذا المأزق نظريا، فذلك فقط لأن الممارسات السياسية الفعلية للمكيافيلليين (وليس، أي أعمال مكيافيللي نفسه) قد صنعها لأول مرة من الممكن فهم الطبيعة الحقيقية لهذه المشكلة.
----------------------
- الكتاب: "السياسة والأنطولوجيا والمعرفة عند إسبينوزا".
- المؤلف: ألكسندر ماثرون.
- الناشر: جامعة إدنبره، 2020م.