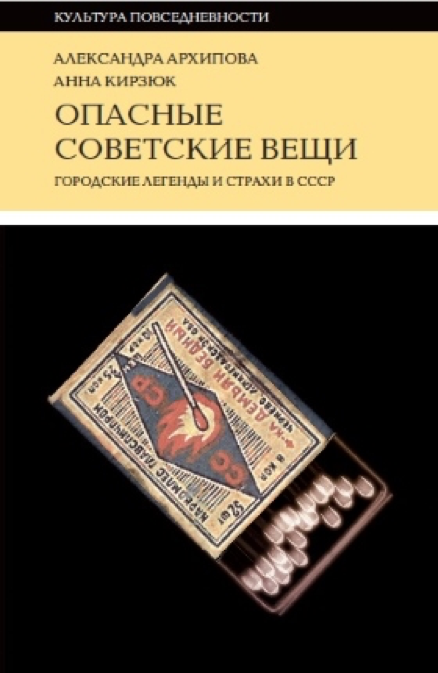الأساطير الحضرية والمخاوف الشعبية في الاتحاد السوفيتي...
أليكساندر أرخيبوفا وآنا كيرزيوك
فيكتوريا زاريتوفسكايا*
يعد الكتاب "أشياء سوفيتية خطرة" للباحثتين الروسيتين أليكسندرا أرخيبوفا وأنا كيرزيوك أول دراسة أنثروبولوجية فلكلورية مُكرسة للمخاوف الخفية للشعب السوفيتي، حيث نتعرف فيه على نشأة مثل هذه الهواجس وكيفية تحولها إلى شائعات واسعة النطاق وتأثيرها على سلوك الشعب السوفيتي؛ سراويل الجينز الموبوءة بالقمل، واليرقات المنضوية في جلد الضيوف الأفارقة، وصورة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ تظهر ليلاً منسوجة في سجادة صينية، والصلبان المعقوفة المدسوسة في هندسة المنازل، والعلكة الممزوجة بالزجاج المسحوق - كل هذا وغيرها من الأساطير الحضرية السوفيتية حول الأشياء الخطرة.
لم تقتصر المؤلفتان على تقديم لمحة تاريخية موجزة لموضوع بحثهما، فجمعتا فصلاً حول مقاربات ومحاولات علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع في تفسير سبب وجود الأساطير الحضرية، بدءًا من اعتبارها قصصاً غامضة نرويها لبعضنا البعض عند احتساء فنجان القهوة، أو نستقبلها من بائع الحليب صباحاً، أو نقرأها في صفحة الحوادث في الجريدة اليومية، وصولاً إلى منحها صفة الظاهرة وصياغتها في دراسات علمية جادة.
لقد أدت قدرة الأسطورة على الاستجابة والتعبير عن المعضلات الاجتماعية الراهنة إلى إيلائها قدرا كبيرا من الاهتمام الأكاديمي وغير الأكادمي كما يظهر جلياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفي غيرهما من بلدان العالم الأخرى، وأصبحت دراسة الفولكلور الحضري ذات شأنٍ عظيم، وتشهد نموا مضطردا في الكثير من الأكاديميات المرموقة حول العالم. ففي الولايات المتحدة خصصت جامعة إنديانا مركزًا لدراسة الأسطورة الحضرية، وفي باريس أنشئ في عام 1984 معهد لدراسة الشائعات (La Fondation pour l etude et l information sur les rumeurs) وفي عام 1991 تأسست الجمعية الدولية لدراسة الأساطير الحديثة (International society for Contemporary Legend Research) ويصدر عنها مجلة Contemporary Legend إلى جانب عقدها مؤتمرات سنوية ذات الاختصاص. وفي روسيا تم تشكيل مجموعة بحثية حملت مسمى "مراقبة الفولكلور التطبيقي" تضم في عضويتها مؤلفتي هذا الكتاب.
وكما تشير مؤلفتا الكتاب فقد ظلت دراسة نصوص الأساطير، ولفترة طويلة، حصرا على علم المورفولوجيا (الذي يُعنى بدارسة الشكل، سواء فيما يتعلق بالأحياء أو بالفنون... إلخ) ومن المعروف أن الفضل في إحداث اختراق كبير في دراسة الحكايات الخرافية يعود للباحث الروسي فلاديمير بروب، مؤسس طرق المقارنة في المادة الفولكلورية (توفي عام 1970).
وبالنسبة للبناء الهيكلي للأسطورة في الاتحاد السوفيتي، ولاسيما في حقبته الأخيرة، فهو يعتمد في معظمه على ثلاثة عناصر: أولا( التقاء بطل الأسطورة بالعدو). ثانيا قبول البطل هدية العدو برغم التحذيرات من احتمالية الخداع. ثالثا(النهاية المأساوية للبطل. وليس مصادفة أن واحدة من أكثر القصص شيوعًا في ذلك الزمن تلك التي تتمحور حول الصبي الذي لم يلتزم بحظر التعامل من الأجانب فأخذ العلكة المسمومة منهم ومات.
بيد أنَّه، وبداية من عام 2000 شهد الحقل المعرفي تحولا إدراكيا حاسما في مرجعية علم الإنسان، فنقل الباحثون اهتمامهم من نص الأسطورة أو الحكاية الشعبية إلى دراسة إدراكها، أي التحول من دراسة الإشارات الخفية للأسطورة، إلى مراقبة سلوك الأشخاص وذلك بغض النظر عن معرفة الشخص بالأسطورة من عدمها، ثقته بها أو غير ذلك، وإن كانت تثير مخاوفه أم لا، وأصبحت الأسئلة الأهم على النحو التالي: كيف تشكل الشائعات أوهامًا جماعية؟ وكيف يظهر الذعر في المجتمع؟ وما إلى ذلك من أسئلة تتعلق بالإدارة الجماعية.
تتبع المؤلفتان أسلوب التحليل النفسي، فتقدمان للتداول العلمي مصطلحين: التعبير الذاتي الفلكلوري، والتعويض الفولكلوري؛ بمعنى أنهما تعتقدان أن الأسطورة تنطوي على وظيفة علاجية ولكن على المستوى المجتمعي وليس الشخصي. عدا ذلك نجد أن الأسطورة الحضرية تساعد على إيضاح الحالات العاطفية غير المعقدة وغير المريحة لفئة ما من المجتمع. نأخذ مثالاً سلسلة الجرائم التي شهدتها مدينة أتلانتا الأمريكية عام 1980 في حق مراهقين من أصل أفريقي، فانطلقت الشائعات التي تربط مقتل المراهقين للحصول على مادة معينة يحتاجها الأطباء البيض لدراسة الإنترفيرون، وهي مادة لا تتوفر إلا في أجساد أصحاب البشرة السوداء! وقتذاك استنتج علماء النفس الأمريكان أنه، ومن خلال إطلاق تلك الشائعات حول تهديد جسدي مُعين، عبّر الأفارقة عن شعورهم بتهديدٍ أكثر تجريدًا تجاههم، لاسيما وأنهم مجموعة اجتماعية تُعاني من التمييز.
إلى ذلك وجدت الباحثتان أنَّ الأسطورة الحضرية تقدم تعويضًا للجمهور على هيئة حلٍ رمزي للمشكلة؛ فهي لا تعبر عن مشاعر الخوف فحسب، بل تعوضه وتصور الواقع بشكل أكثر بساطة وأمانًا، فضلاً عن أنها لا تشير فقط إلى الشعور المكبوت بالذنب بقدر ما تساعد على التغلب عليه. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك أنَّ الأسطورة الحضرية تقاوم الطب الرسمي السائد، وهي تصور الواقع كما يودُّ الجمهور أن يكون. لذا، وبدلاً من البحث عن الأسباب الحقيقية لمشكلة ما، يدفعُ القلقُ أفرادَ المجتمع إلى فهم التهديدات وكأنها قادمة من مجموعة اجتماعية أو عرقية مزعومة. نأخذ مثالاً وباء الكوليرا الذي ضرب عام 1830 أجزاء من الإمبراطورية الروسية، فأحيلت مسألة زحف الوباء إلى ما عرف آنذاك بأعمال شغب الكوليرا والنتيجة وفاة أعداد كبيرة من النَّاس. وكان الزناد الذي عمّم الكارثة، الانتشار الواسع للشائعات القائلة بأنَّ التفسير الرسمي للمرض كان مجرد غطاء، في حين أنه من فعل العملاء البولنديين واليهود.
تشكك الباحثتان في حداثة معظم الأساطير الحضرية، فتعطيان فكرة أن العديد من الأساطير الحضرية تتحول عبر الزمن وتكتسب تفاصيل حديثة. من هنا ظهرت في روما القديمة (مثلا) أسطورة عن الأخطبوطات الساكنة في حفر المجاري؛ ألا يبدو الأمر شبيهاً بالشائعة الحديثة القائلة بأن التماسيح التي تلتهم البشر تعيش في مجاري نيويورك؟ أو كالقصة المتداولة في الاتحاد السوفيتي في فترة الثمانينيات وتتحدث عن شخصٍ يلتقط الأطفال ليمتص الدم منهم ويملأ به أقلام الحبر؟ تعيد المؤلفتان هذه القصة إلى أسطورة "فِرية الدم" التي تتهم اليهود بقتل الأطفال في طقوسهم الدينية، ولكن، وبما أنَّه لا مكان للدين في الحقبة السوفيتية، تفقد الأسطورة مكوّنها الديني، فيتحول اختطاف الأطفال باعتباره سعياً لليهود الروس لتحقيق مصالح مالية.
أما الفصول الخمسة المتبقية فتبتعد عن القواعد النظرية، وتتوزع مواضعيها على مناطق مختلفة. فيتحدث الفصلان الثاني والثالث عن الأساطير الحضرية التي شرعتها السلطات، أي تلك التي تبلورت في الأعلى، وسربتها الحكومة السوفيتية للسيطرة على سلوك المجتمع، وصدّ المواطنين عن تصرفات غير مرغوبة، عادة ما تكون مشوبة بالسياسة.
يتناول الفصل الثاني "العلامات الخطيرة" للمؤامرات التي ظهرت بفضل الدعاية الرسمية للعقد الثالث من القرن الماضي، أي ما جرى المؤرخون على تسميته بعصر الإرهاب العظيم في الاتحاد السوفيتي تحت حكم ستالين، ومن الأمثلة على ذلك حين طُلب من المواطنين فضح مكائد الأعداء المندسين في كل مكان، أي المعارضين السياسيين للحاكم، وفي المقام الأول زعيم المعارضة ليون تروتسكي. يناقش الفصل الثالث موضوعة "كيف أصبحت الأسطورة سلاحاً أيديولوجيًا" ويناقش طريقة عمل الدعاية السوفيتية في استخدام الشائعات والأساطير للتأثير على المشاعر العامة والتلاعب بها. يحكي الفصل الرابع والخامس والسادس عن القصص المرعبة العجيبة التي ظهرت وانتشرت بين المواطنين السوفيت على المستوى الأفقي، ولا علاقة بالمؤسسات الرسمية بتصديرها، وإن كانت قد عززت روايات الدعاية الرسمية، وأحياناً تعاد صياغتها لصالح المؤسسة الرسمية أو يتم تحديها ودحرها في مناسبات أخرى. سيتعرف القارئ في هذا الفصل على حزمة من الممنوعات التي تحولت إلى أساطير مُلتحمة بالحياة اليومية للفرد السوفيتي ومصدرا لمخاوفه الفطرية وهي من قبيل الآثام المترتبة عن التفاعل مع الغرباء والتي سادت فترات مختلفة من التاريخ السوفيتي، إلى جانب المخاوف التي تسربت إلى حكايات الأطفال السوفيت. ولكن تأتي المخاوف من الاصطدام النووي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في مقدمة تلك المخاوف المؤسطرة. والحال كذلك؛ فلا شك أن ذروة هذه المخاوف تجلت في الأزمة الكاريبية عام 1962 عندما قام الاتحاد السوفيتي بزرع صواريخ تحمل رؤوسا نووية في كوبا، ونتيجة للضغط الدعائي والمخاوف التي أطبقت على المجتمع السوفيتي كان الناس يحلمون في منامهم بأهوال الحرب القادمة والانفجارات النووية المرعبة.
تؤكد المؤلفتان على أن الأسطورة الحضرية السوفيتية كانت لها خصوصية تعود إلى الظروف الاستبدادية التي سادت، وفي ظل رقابة أيديولوجية صارمة. لذلك هدفت الأساطير أساسا للعثور على أعداء خارجيين وداخليين يتربصون بالفرد السوفيتي ودولته.
لقد عاشت الأسطورة السوفيتية، وبخلاف الأسطورة الغربية، وتطورت في ظروف علاقات صعبة ربطت بين الإنسان والسلطة، إذ لم يقتصر الأمر على المواجهة بين الطرفين ولكن هناك التأثير المُتبادل أيضاً. فعلى الرغم من حقيقة أنَّ مروجي الشائعات كانوا يُدانون ويتم اضطهادهم من قبل الدولة طوال الحقبة السوفيتية، إلا أنَّ الأسطورة لم تكن فقط اللغة التي يتناقل بها النَّاس معلومات غير رسمية، بل غالبًا ما كانت اللغة التي حاولت بها مؤسسات الدولة التأثير على سلوك النَّاس.
أدى كل هذا إلى انتشار ظاهرة apophenia أو الاستسقاط، ولكن بنموذجها السوفيتي، إذ إنها لم تكن فردية وإنما جماعية. وتفسير هذه الظاهرة علمياً حين يقوم الفرد بمنح الأشياء اليومية من حوله معاني جديدة تختلف عن المعاني التي وجدت عليها؛ يحدث ذلك بصورة مُفاجئة وبلا مُقدمات، تماماً مثلما يحدث في ساعة الإلهام، وبه تستبد الهواجس والأوهام على الأفراد من وجود أعداء غير منظورين، وتظهر أمامهم علامات يُلفّقها التوهم، وبه أيضاً تشكّل الذعر لدى المواطن السوفيتي من الصليب المعقوف الفاشي، وظهرت الأساطير حول المنازل والغابات التي تتشبه بالصليب المعقوف، والادعاء بأنها من عمل الجواسيس. وتسوق الكاتبتان مثالا على هذه الدوامة من الترهيب الدعائي من فترة المواجهة الحزبية بين ستالين والمعارضة فكانت لحية تروتسكي الشهيرة تترائى للناس في كل شيء يرونه أو يلمسونه. وتورد المؤلفتان جانبا من الاستبيان الذي استوحيت منه لوحة الغلاف (أي علبة الكبريت). يقول أحد الأشخاص الذين انضموا للاستبيان: "في طفولتي لم يكن هناك كلمات مروعة في البث الإذاعي أكثر من اسم تروتسكي والتروتسكية. أتذكر عندما عاد والدي ذات مرة من العمل ووضع أمامي علبة كبريت وقال: حاول العثور على صورة رجل له لحية في اللهب الذي على الصورة! فسألته أمي: ما معنى ألغازك هذه؟ رفع أبي عينيه وقال بجدية: الحقيقة أن مدير مصنع الكبريت تم القبض عليه أمس بسبب هذا الملصق على العلبة" (ص: 110).
في الختام نُلاحظ أنَّ الصبغة العلمية هي أكثر ما تميز به هذا الكتاب؛ فلم تكتف الباحثتان بإعادة سرد الأساطير الحضرية والشائعات التي سادت في الحقبة السوفياتية، ولكن، وهو الشيء الأهم، تطبيق النهج العلمي لدراسة محتواها وأسباب ظهورها. بفضل هذا يكون بمقدورنا البحث في تقنية ظهور النمائم والأخبار المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم.
------------------------------------------------
الكتاب: أشياء سوفيتية خطرة.
المؤلف: أليكساندرا أرخيبوفا وآنا كيرزيوك .
دار النشر: ن.ل.أو./ موسكو/ 2020.
اللغة: الروسية
عدد الصفحات: 536
*أكاديمية ومستعربة روسية