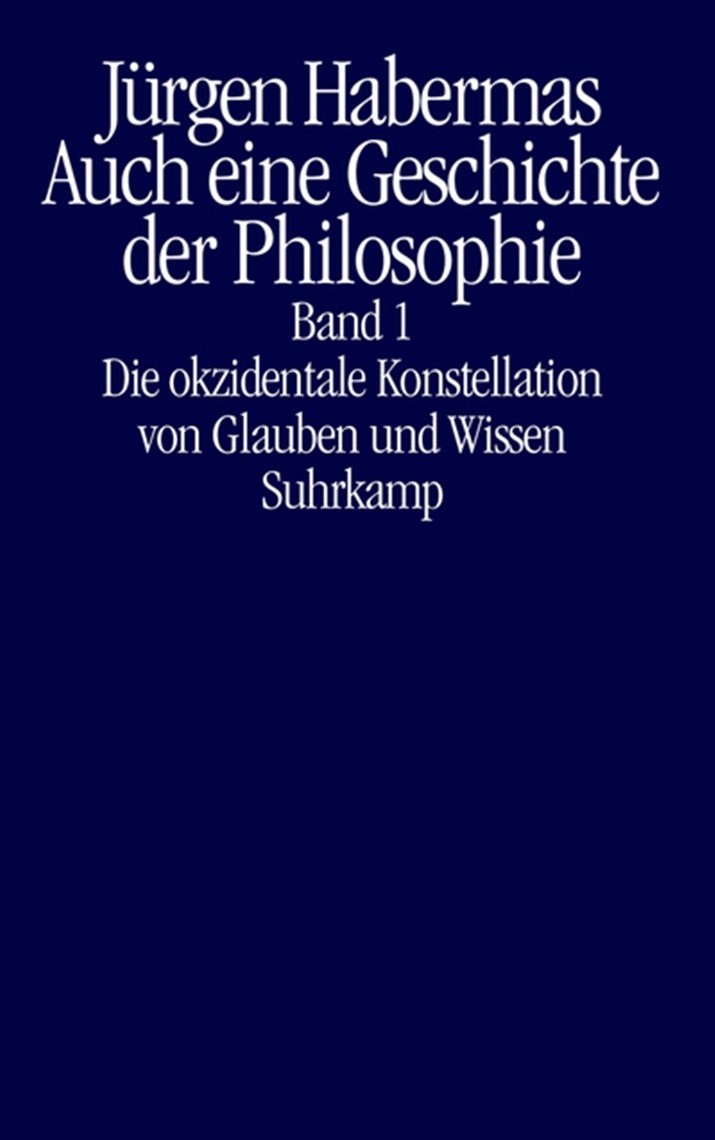يورغن هابرماس
علي الرواحي
يطرح الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس -والبالغ من العُمر 90 عاماً- في هذا العمل -والمُكوَّن من جزءين، تاريخاً جديدا للفلسفة الغربية؛ لذلك نجد أن العنوان يبدأ بكلمة أيضا، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن هذا العمل إضافة إلى أعمال غربية، وغير غربية كذلك، تناقش، وتؤرخ لمسار الفلسفة الغربية، ومساراتها الضمنية، والصريحة على حد سواء؛ حيث ينتمي هذا العمل إلى ما يُعرف بعلم أنساب الفلسفة الغربية، المعني بشكل كبير بالأسماء، والشخصيات، والأفكار التي ساهمت في ظهور- ما أصبح يُعرف حسب هابرماس في أعمال ٍ سابقة - التفكير ما بعد الميتافيزيقي... ينقسم هذا العمل إلى قسمين؛ يتناول الجزء الأول السناريوهات والأزمات المختلفة التي مرت بها الفلسفة، ولحظات الاضمحلال في القرن العشرين. كما يتطرق للوضع الديني في الوقت الحاضر، على اعتبار أنه يمثل العقل الموضوعي. في حين يتناول لاحقاً مسار التطور الغربي وادعاء العالمية بعد الفكر الميتافيزيقي. كما يتطرق بعد ذلك للاختراق المعرفي والاحتفاظ بالنواة المقدسة، وهو ما يُعرج لاحقاً على العلاقة بين الأسطورة والطقوس، ليوضح معنى المقدس، مرورا بكيفية تحول المحور الديني (كما سيتم توضيحه لاحقا) إلى الوعي الديني، وصولا إلى الحديث عن أخلاق التقديس وتفكيك التفكير الأسطوري.
مُتطرقا بعد ذلك إلى الديانة اليهودية والتوحيد، وفيما بعد إلى التعاليم والممارسات البوذية، والكونفوشوسية والطاوية، مرورا بالفلاسفة الطبيعيين اليونانيين إلى سقراط، وإلى نظرية أفلاطون حول الأفكار. في الفصول اللاحقة من الجزء الأول، يدخل هابرماس إلى المسيحية الأصلية ويسوع والوعاظ، وكل هذه التفاصيل المختلفة، ليصل إلى اللقاء الذي حدث بين المسيحية والهلينية إبان الإمبراطورية الرومانية. وفي منتصف الفصل الأول يتحدث عن الكنيسة، والمجتمع، والدولة في أوروبا المسيحية، مرورا بالتحديات التي واجهت اللاهوت في القرن الثالث عشر، متطرقا إلى إجابات الأكويني في هذا الصدد، كما يتحدث عن التمايز الوظيفي الذي حدث بين القانون والسياسة والذي أنتج شكلا جديدا من الاندماج الاجتماعي، لينتقل في نهاية الجزء الأول إلى سلطة الدولة لدى ميكيافيللي.
في حين يبدأ الفصل الثاني بمارتن لوثر، وكسره للعادات السائدة في تلك الفترة، وتحديدا العادات الدينية، وتغييره لمسار اللاهوت بشكل كامل، بعد ذلك يرسم هابرماس ويحدد المسار اللاهوتي والاجتماعي والسياسي للعقل الحديث انطلاقا من تفاعل التنمية العلمية مع آليات التاريخ الاجتماعي وهذا يأتي في سياق قانون العقل الحديث.
مهما يكن الأمر، فإنه ومن خلال عناوين قسميْ الكتاب، يتضح أن هناك مزاوجة بين التاريخ الغربي العام والشامل من جهة، ولحظات الفلسفة الكبرى والمحورية في أوروبا، تلك اللحظات التي أسهمت ليس في ارتقاء العالم الغربي، بل وانعكس ذلك بشكل كبير وجوهري على بقية أنحاء المعمورة.
ويتتبع هابرماس بشكل تدريجي كيف انفصلت الفلسفة عن التفكير الديني في التاريخ الروماني والغربي، حيث أصبحت الفلسفة لاحقا دنيوية، مهتمة بالقضايا والمسائل اليومية. كما أن هذا العمل يوضح بشكل تحليلي كبير، تاريخ، أو قصة انعكاس هذه التغيرات على مواضيع أصبحت حساسة، ومهمة مثل الحرية المسؤولة للتواصل المجتمعي بين الذوات. من جهة أخرى، يُظهر هذا العمل ماذا يعني ظهور، أو نمو المعرفة العلمية لنا نحن البشر، بما رافق ذلك من آثار مختلفة كظهور الحداثة المعُاصرة، والفردانية.
غير أنَّه وقبل ذلك، يبدأ هابرماس هذا العمل بنقد تشخيصي حاد للمشتغلين بالفلسفة، وبشكل مواز لذلك للمشتغلين ببقية العلوم التي أصبحت الآن، متداخلة إلى مرحلة تبدو فاقدة للتخصصية، والاختلاف. حيث إن بعض الفلاسفة ينظرون لأنفسهم على أنهم "عُمال" أو يقدمون خدمات مفاهيمية، وتحليلية، لعلوم مختلفة، كعلم الأعصاب، وعلوم الوعي، وذلك لما يرون من تنوع في المعارف العالمية التي يجب الاستفادة منها، غير أن هذه المسارات تطرح تحديات كثيرة على تشكيل العالم البشري.
لذلك؛ لا ينبغي على الفلاسفة أن يفقدوا بصيرتهم حول رؤية "الكُلي" التي يضعها هابرماس بين قوسين، في ظل الظروف والاتجاهات التي أصبحت لا مفر منها، حيث ينبغي المساهمة في التوضيح العقلاني لفهمنا لأنفسنا وللعالم، الذي يمثل صلة الوصل المهمة لهذا التخصص.
فمنذ الصفحات الأولى يزيل هابرماس الشك، أو اللبس، عن أن المقصود من هذا العمل يسعى لتقديم فهم كامل حول معنى ووظيفة الفلسفة في هذا العصر متداخل الاختصاصات، وشرح معنى نمو، وازدهار المعرفة العلمية بالنسبة للبشرية بشكل عام. فالفلسفة ستخون نفسها، وصحتها، إذا كشفت عن المرجعية الشاملة لتوجهاتنا، بحسب تعبير هابرماس، وهو في ذلك يلتقي مع كانط الفيلسوف الألماني الذي أشار إلى أن الفلسفة عليها تقوية الناس في "الاستخدام المستقل" لعقلهم، وتشجيعهم، بالمعنى الذي طرحته النظرية النقدية المبكرة لدى هوركهايمر، وروبرت ماركوزه، وعلى وضع هذه النظريات قيد التطبيق. وهذا الدافع التنويري الفلسفي يتغذى على مبادرات تبدو غير واضحة حول استخدام الحرية الفردية المسؤولة والتي حاول الفلاسفة من كانط إلى ماركس فتحها والتي تُشكل الخيط المُشترك في هذا العمل. كما يسعى هابرماس من خلال هذا العمل الضخم إلى الاحتجاج، ورفض، الجانب التحليلي للفلسفة، الذي يعتبر مُلتزما بالمفاهيم والعمليات النظرية للعلوم الطبيعية، والاسمية، في حين أنه من خلال تتبع تاريخ الفلسفة الغربية يسعى هابرماس لإعادة الحق الدائم في الفلسفة، انطلاقا من كانط وطرح الأسئلة الكبيرة، والأساسية والتي تتمثل في: ما الذي يمكنني معرفته؟ ماذا عليّ أن أفعل؟ ماذا يمكنني أن أتمنى؟ وما هو الإنسان؟
من هنا، نجد أهمية ما أسماه هابرماس "المرجع الذاتي التاريخي" للفلسفة، والذي من خلاله تضمن وحدها "استقلالية حكمها" بشكل يسعى لإعادة بناء بدايات الفلسفة الغربية باعتبارها ميتافيزيقية، والتي تُعتبر مُتعلقة إلى حد كبير بالرؤية الدينية. فمنذ الأفلاطونية المسيحية في الإمبراطورية الرومانية، حُددت مهمة الفلسفة باعتبارها مُكملة لتطور العقائد الدينية، وذلك من حيث أنها (الفلسفة) تحتوي على خصائص جوهرية دينية.
وفي خضم ذلك، وبالرغم من خطابه الموجه تجاه "المجتمعات ما بعد العلمانية"، إلا أنه يميل تجاه المنظرين العلمانيين، وليس تجاه "المحافظين" في رؤية نحو عودة الدين في المجتمعات. لكنه، لا يشكك في أن الوعي الديني يحتوي على إمكانيات ذات صلة أخلاقية من المعنى ربما لم يتم استثمارها بشكل فلسفي بعد. وبالرغم من الادعاءات المستمرة بوجود "الحقيقة الكلية"، إلا أنه لا يجب على الفلاسفة استبعاد أن المضامين الدينية من الممكن أن نجد بها تقاليد دينية تدعم الحرية، والتضامن، والعدالة، وهو في ذلك يريد أن يُبقي باب الحوار بين الجانبين مفتوحا.
فمنذ فترة هيوم، وبنتام، من جهة، وكانط، شلنغ، وهيغل من الجهة الأخرى، نجد أن التفكير ما بعد الميتافيزيقي أصبح أمام مسارين، حدَّدا النماذج التحليلية أو الأنساق الفكرية المتنافسة للخطاب الفلسفي حتى الوقت الحاضر؛ حيث يصر هابرماس على أن هذه الاختلافات لا يمكن فهمها بشكل كاف في ظل الانقسامات السياسية المعُاصرة، غير أن المواءمة التي حدثت بين العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية كانت عالية جدا، وبحسب ألفاظ هيغل فإن هذا العقل الموضوعي أثر إلى حد كبير على مسار التفكير بشكل كامل، وموقعه، وهذا يعود من الجانب الآخر، بحسب هابرماس، إلى سهولة انتقال هذه النماذج التحليلية أو الفكرية من فلسفة الموضوع إلى فلسفة اللغة، وهو ما اتضح جليا في عمله الكبير والمؤسس "نظرية الفعل التواصلي".
يتَّسم هابرماس في هذا العمل مثل معظم أعماله بالحذر الشديد؛ حيث ميز نفسه وبشكل مبكر جدا عن "المهندسين المعماريين لتاريخ الحداثة المتدهور"، أولئك الذين ظهروا في النصف الأول من القرن العشرين، مثل كارل شميدت، ليو شتراوس، هايدغر، وغيرهم، الذين لم يتبنوا المفهوم الحقيقي للفلسفة من خلال العودة إلى اليقين الميتافيزيقي لما قبل العصر الحديث. وعلى الرغم من أن طريقة التفكير العلمانية الجديدة قد ظهرت في الفلسفة الحديثة كأثر من آثار التعليم الجديدة، فإن العودة لكل هذه السياقات التفصيلية المختلفة يعتبر مهما جدا، لفهم هذا المسار المتبصر الذي يقضي بأن الفلسفة في طريقها لتوضيح الصورة الذاتية للمجتمع بشكل عقلاني، تساهم أيضا في اندماجها، وليس في عزلتها، أو انفصالها.
وبالعودة للزمن المحوري حسب تصنيف الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز(1883-1969م)، في كتابه أصل الهدف التاريخي المنشور في عام 1949م، فإن هذه الفترة كانت ما قبل الميلاد، والتي تأسست فيها العقائد الدينية، والرؤى الميتافيزيقية، والتي ما زالت مؤثرة، ومحورية حتى اليوم، مثل الزرادشتيه في إيران، والكونفوشوسية والبوذية في الصين، والهندوسية في الهند، والميتافيزيقيا الوثنية في اليونان. حيث إنه -وحسب هابرماس وبعض النقود التاريخية- فإنه يجب الأخذ بالحسبان نقاط أساسية مترابطة، وهي: تأثير اللفظ المقدس، وهي تلك الفترة التي اتخذت فيها الأديان شكل تعاليم عقائدية، تشكلت على إثرها حضارات بأكملها، الأمر الذي يعني وجود وحدة للتفسير العالمي عن طريق طقوس معينة، نابعة من أساطير مختلفة، ما زالت لم يتم اختراقها أو لم يتم تحليل جوانبها بعد، حيث تواصلت هذه الأساطير من خلال التنفيذ الطقسي الجماعي لهذه المعتقدات من جهة، ومن خلال تأثير النصوص المقدسة من الجهة الأخرى، تلك التي تركت بصماتها في هذه الحضارات العريقة، والثرية. حيث يُعيد ياسبرز لتلك الفترة الممتدة من 800 إلى 300 قبل الميلاد، تشكّل وجهات النظر الدينية العالمية، وظهور هذه الديانات، التي كانت في جانب من جوانبها ضد التعددية، كما هو الحال لدى الديانات الأوراسية التي ظهرت في تلك الفترة تقريبا. غير أنه مع ظهور العصر الحجري الحديث حسب الكثير من وجهات النظر التاريخية، والأنثروبولوجية المختلفة، فإن هناك الكثير من الطقوس، والاعتقادات التي تأثرت من الفترة السابقة، والتي واصلت استمراريتها في العصور اللاحقة. في حين أن هناك الكثير من الآثار المختلفة التي وجدت في فترات سابقة لذلك، كما هي الحال في أستراليا.
ومن الممكن القول، بطريقة أو بأخرى، بأن هذا العمل يعتبر خلاصة لعقود طويلة من الاشتغال الفلسفي وتحديدا لتاريخ ظهور مفهوم التفكير ما بعد الميتافيزيقي في أعماله الأخيرة من جهة، ومفهوم العقل العمومي كما صاغه الفيلسوف الألماني كانط منذ فترة طويلة من الجهة الأخرى. كما يعتبر من جهة أخرى مراجعة معُمقة لما يمكن تسميته التأثير المُتبادل بين الإيمان والمعرفة في الفترات الزمنية الطويلة سابقا، وهذا لا يمكن فهمه بشكل جيد دون الالتفات إلى التأثير اللغوي على الإيمان، والعقائد، والحمولة المعرفية الجوهرية التي تنعكس جراء ذلك على أنماط التأويل المختلفة في هذا السياق، بما فيها أثر ذلك على رؤية العالم، والإنسان على حد سواء. من جهة أخرى، يذهب في هذا العمل إلى ما وراء أطروحاته السابقة، وذلك لتوسعة تلك الأطروحات، والمفاهيم، مثل: عقلنة الإيمان بالتحاور والتواصل مع الأسباب والجوانب العقلية.
هذا الحوار بين الجانبين المهمين في الحياة البشرية، بقي لفترات زمنية طويلة، وبشكل خاص في مرحلة انتصار التنوير، مفقودا، وتشوبه الكثير من التوترات، والقلق، حيث تم إقصاء صوت الإيمان، والتصورات الدينية، من الفضاء العمومي الذي يعتبر هابرماس المُنظر الأكبر له في الفترات الزمنية الماضية. لذلك نجد أنه توصل إلى مصطلح تأويلي، وواقعي حاسم في هذا الشأن، يصف من خلاله المجتمعات التي تجاوزت هذه القطيعة السلبية، والإقصائية، بين الدين والفضاء العام، إلى وصفها بالمجتمعات ما بعد العلمانية؛ حيث إن هذه العلاقة المتصالحة بينهما أدت لتعميق وجود مسارات متوازية في الدولة، وغير مؤثرة بشكل سلبي على المؤسسات التي ينبغي أن تبقى حيادية، وغير مُتحيزه. كما أن الحداثة -يضيف هابرماس في الكثير من أطروحاته المختلفة- عبارة عن منتج جاء نتيجة لزيادة العقلنة، وتعميق الاختلاف في الكثير من المناطق والمواضع الاجتماعية الفرعية، وغير الرئيسية، والتي أصبحت ملموسة، وواضحة للعيان في الوقت الحاضر، مثل: فصل الكنسية عن الدولة، والفن عن الأخلاق. كما أن التلفظ الزائد بالمقدس والحديث عنه يساهم في تفكيكه، وتخفيف حدة الأفكار الدينية والميتافيزيقية، حيث أنه في الفترة الأخيرة أصبح الدين حليفا مُرحبا به في المجتمعات التي سيطرت عليها جوانب محددة، كالجانب الطبيعي، والتقني، أو أنماط العقلنة الاقتصادية وترشيد الإنفاق. فالتفكير ما بعد الميتافيزيقي لم يحارب الدين أو التصورات الدينية بقوة، وبعنف، بل وضع نفسه في إطار منتج مثل التصورات الميتافيزيقية. فهذا النوع من التفكير يقود في الفترة الحالية، الزخم الكبير الذي تتمتع به هذه الأعمال.
ومن المواضيع المهمة التي استحوذت على الأعمال الأخيرة لهابرماس، ومنها هذا العمل، العلاقة بين الأسطورة والطقس، وذلك في سياق الحديث والتفكير في المعرفة والإيمان، وفي معنى المقدس أيضا، وعلاقته بالجذور المقدسة للفترة المحورية سابقة الذكر، حيث يرى بأن بين السرديات الأسطورية والطقوس علاقة وثيقة تربط بينهما، حتى وإن كانتا لم تقعا في نفس الفترة الزمنية تقريبا. فهذه السرديات زودتنا في البدء بمفاتيح لفهم هذه الطقوس، وبلغة معيارية خاصة لهذا الفهم تطورت مع مرور الزمن، ومع تعدد السياقات المختلفة التي يتم تأديتها فيه. كما أنها زودت المؤدين لها بعدد كبير من التصورات، والتعابير المختلفة في التعامل مع ظروف الحياة اليومية، مثل: أنماط الموسيقى، والرقص، والتعامل مع الكوارث الطبيعية، والمجاعات، والأوبئة، أو هجمات العدو. بالإضافة لذلك، تقوم هذه الطقوس بوظائف حيوية جدا، كتلبية الرغبة في المطر، أو بعث الأمل، وتجنب المجاعات، والحصول على صحة جيدة.مهما يكن الأمر، فإن هناك سؤالا حاسما في هذا السياق، يطرحه هابرماس، حول توازي تطور الطقوس مع الأساطير؟ إذا أخذنا في الحسبان التطورات اللغوية التي حدثت في التاريخ البشري، بما يرافق ذلك طرق التعبير، والكتابة وغيرها.
وفي النقطة الأخيرة المتعلقة بالعلاقة بين المعرفة والإيمان، ينطلق هابرماس من هيوم وكانط، وبشكل خاص بالتركيز على كانط، وتحديدا بعد محاضرته حول نفس الموضوع في عام 2007م، فهذا التاريخ يعني بكل بساطة تاريخ العقل، ومساره، أو ربما أحد مساراته. حيث تعود هذه التحولات التي طرأت على فلسفة الدين – حسب هابرماس وبعض المفكرين الثيولوجيين الألمان- إلى التأويل الفردي للوعي الذاتي المعاش، الذي يستبطنه المؤمن منذ فترات زمنية طويلة، مقارنة مع التحولات الجذرية التي تأتي عن طريق الفتوحات العلمية، وأثرها على الوعي الديني من جهة، والسلوكيات التي ما زالت متشبثة بالقناعات التي كونها الأفراد عبر رؤيتهم للعالم، دونما محاولة التكيف، والانخراط في الواقع الجديد. وفي هذا السياق، لكي يحافظ العقل الديني على مرونته -يقول هابرماس- من الضروري أن يبقى مستعدا ليتعلم، وأن ينفتح على بقية الظواهر المختلفة، وتأويلاتها الجديدة في العالم، وهذا ينطبق بشكل مواز أيضا على العقل العلمي الحديث، الذي من الضروري أن يتعلم من الفكر الديني أيضا، دون أن يتخلى عن استقلاليته.
---------------------------
- الكتاب: "أيضا تاريخ آخر للفلسفة".
- المؤلف: يورغن هابرماس.
الناشر: Suhrkamp، بالألمانية، 2019م.
- عدد الصفحات: 1700 صفحة (على جزءين).