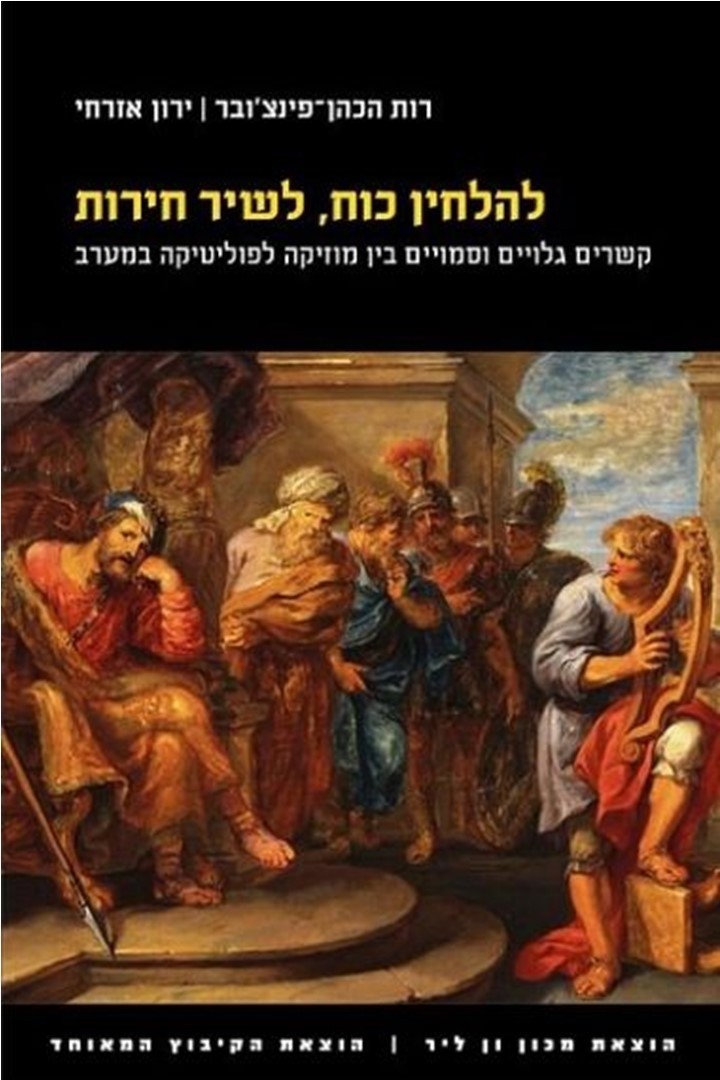أميرة سامي *
يسعى مؤلفا كتاب "تلحين القوة.. وغناء الحرية" (وهما روت هكوهين-فينتشوفر ويارون إزراحي) إلى كشف النقاب عن تعدد أوجه الاتصالات المفتوحة -العلنية منها والخفيّة- بين الموسيقى والسياسة، كما تكشفت وتطورت في القرون الأخيرة في الغرب؛ حيث تحول الحوار بالتدريج إلى مغامرة حماسية أدت إلى اكتشافات المسار المشترك بين الموسيقى والسياسة، والتي أعطيت محاضراتها في عام 2000 بالجامعة العبرية، وكانت المحطة التالية ثلاث محاضرات عامة في معهد فان لير عام 2003.
وتلقى المؤلفان ردود أفعال إيجابية وضعا بها مفهوم الأساس الجوهري للتشابه الذي بين عالمي الخبرة والمعرفة، ثم بدأت عملية طويلة من الدراسة، وبعد البحث الموسع عن المفاهيم والنظريات للمبادئ التي ستشكل تغييرًا وتحديًا لهما، أجريت دراسات منفصلة في هذه الفترة الطويلة أدت أيضًا لمساهمة مشتركة لفهم الأحداث الصعبة والمشجعة في العالم السياسي والأحداث المثيرة في العالم الموسيقي، وكان الحوار المستمر مع الزملاء والأصدقاء والطلاب، وأقوالهم وكتاباتهم له صدى ليس أقل ثراءً في جميع فصول الكتاب، فقد شغلت قضية الموسيقى مساحة واسعة من السمو الروحي الذي غرس فينا المحبة لصوت الفن، وسمح لنا بالحصول على الأساسيات الضرورية للفهم المتعمق للسرية، ولقد فهم آباؤنا الطيبون والأبرياء، أن الإمكانات المتواصلة في الموسيقى لتحرير روح وخيال الإنسان يمكن توظيفها أحيانًا لتكون أقل ضررًا وخطورة بين تجارب رفع مستوى الصوت للامبالاة الأخلاقية وبين قوة الموسيقى وقوة السلطة.
وفي الأساس، يكشف الكتاب النقاب عن النسيج الوجداني والجمالي للأنظمة الملكية، والقومجية، والشمولية، والليبرالية، والديمقراطية، كما تتجسد من خلال هذه العلاقات، ويتساءل الكتاب عن الموسيقى ومالها بالأروقة السياسية للسلطة التي هي هالة من الهيبة للمملوك، ومشاحنات صاخبة للحكام، ويبدو أن الملوك والحكام عرفوا كيف يسخرون الموسيقى لتجميل القوة وتعظيمها، كما وجدت مكانها أيضًا في تشجيع التضامن والحماس في صفوف الثوريين، وفي طقوس الدفن الملكية والرسمية، قامت الموسيقى بتقديس سيرة الحاكم المتوفى وضخت الآمال بمستقبل زاهر، وعلى الرغم من شعبيتها الكبيرة، إلا أنها ارتبطت بتاريخ السياسة الحقيقية ولم تكن الموسيقى، على الأقل في الغرب، حتى لو رغبت في ذلك على اتصال مباشر بالواقع السياسي للسلطة، بل كانت في جوهرها حادة ومليئة بالتناقضات والمخاطر، وتميل إلى فصل نفسها عن السياسة حتى عندما ترتبط بها طواعية أو من البداية في السياقات الأيديولوجية القمعية (الكئيبة) أو المخربة، لتتم تعبئتها لخدمة الأمة أو الطبقة أو الكنيسة حتى إنها تبدو كملزمة (مرغمة) وفقا للخطاب أو القضية الملحة.
التجرد، والمتعة، والشمولية، وأيضًا التغييرات.. هذه الصفات الأربع للموسيقى الغربية في فتراتها المختلفة، التي تتناقض مع بعضها البعض جزئيًا، لذا من المستغرب أيضا دمجها مع بعضها البعض، توضح ظاهريًا الشهادة السياسية للموسيقى، التي ربما كانت تغني عن نفسها، كما صنعت منذ أيام أورفيو بمانتوفا (مانتوفا، مدينة شمال إيطاليا في إقليم لومبارديا)، للمؤلف الإيطالي مونتيفيردي في بداية القرن السابع عشر، أو ربما كان هذا ما أراده أولئك الذين تمنوا لها إغفالها من معاقبة هذه -السياسة- التي كانت في ظل قوى قوية مثل فورتونا ومنيرفا (آلهة العقل والحكمة وربة جميع المهارات والفنون والحرف اليدوية عند قدماء الرومان)، وبسبب هذه الصفات التي ارتبطت بالموسيقى هناك ادعاءات بالاشتباه والشعور بالذنب والخيانة والتحريض واللامبالاة.
وفي الدولة القومية تمكنت الموسيقى من التغطية على ارتعاد الفرائص من الموت بإيقاعات وأناشيد لجنود يسيرون بخطى حثيثة وراء العلم نحو ساحات الوغى، لكنها منحت في الوقت ذاته تعبيرًا لمشاعر الخوف من الموت والتمرد المناهض للحرب، فكانت حقلاً لازدهار اليوتوبيا حول المجتمع المثالي، وتعبئة الذكريات الأسطورية من العصر الذهبي الذي سيعود، كما راعت مساحة أحلام الحرية والفداء والاستقرار؛ فالسياسة لن تتردد في الاعتراف بأنها تحتاج للموسيقى ليس فقط لإشعال روح المعركة، بل أيضًا للتمجيد والإثارة؛ فالموسيقى يمكن أن تحفز روح المنافسة بين المثل العليا للحياة المشتركة والمجتمع الذي يطمح إلى المساواة، لكنها تحترم العالم الداخلي للفرد.
وبروح الليبرالية الصاعدة، يدعي المؤلفان أن الموسيقى نجحت في العديد من المرات في تجسيد دواخل الفرد وعزلته، لكنها نمت في الوقت ذاته جمالية الحوار الثنائي؛ وفي الديمقراطية سعت الموسيقى لإسماع "صوت الشعب".. استُخدمت الموسيقى -وما زالت- لاصطياد الزبائن والمشترين في الثقافة الرأسمالية، إحدى الظواهر المركزية في تاريخ الموسيقى في الغرب بصفة رئيسة لما قبل العصر الحديث "الممتدة بالسياقات المعروضة أمامنا، بين أيام أواخر العصور الوسطى حتى القرن السابع عشر، والتي وجدت أيضًا فيما بعد وهي ظاهرة الولاية أو الوصاية أو الرعاية؛ حيث تحتاج الموسيقى لرعاة أو ولاة، وفي السياق التاريخي الموثق يعرف الرعاة الأوروبيون، الذين تولوا مسؤولية جميع فروع النشاط الموسيقي تقريبًا، حتى أواخر القرن الثامن عشر على الأقل"، هذا إلى جانب تعبيرها عن صرخة المقموعين في أحياء الفقر، ونظرًا لحرية الموسيقى في القرن السابع عشر، في الأنظمة المختلفة "أنْسَنَت" الموسيقى صوت المرأة المقموعة وضحية الخيانة، وكذلك صوت الأنثى التي تسعى لتحدي القيود الاجتماعية وقيود الوعي، لكن هل كان النقد السياسي ممكنًا من وجهة الموسيقى التي تهدف لإلقاء أذن رعاها؟ لقد أظهرت فيما بعد رؤية الأركادييم أو الأركاديان التي تم تفسيرها بشكل رائع، وأظهرت أن هذه الموسيقى تخريبية، ويمكن أن تدعم البديل السياسي، كنوع مختلف من النظام من وجهة نظر الحكام على سبيل المثال: لماذا اخترقت أصوات النساء في المقدمة في بداية القرن السابع عشر في هذا النظام، الذي كان أبويًا (بطريركيًّا) بشكل واضح؟ وما أسهمت فيه قوة الروح التي أعطيت لهم في عملية خلق لغة جديدة من الأصوات، ووجود التعبيرات والعواطف التي لم تعرفها الأماكن الشخصية والعامة من قبل؟ هذه هي إحدى القضايا التي تم تناولها في الكتاب، وعلى أي حال، فإن الصلة بين الموسيقى والسياسة هي أكثر تعقيدًا مما هو مرئي (أو مسموع)، ويمكن الوصول إليها جزئيًا فقط بشكل غير مباشر -أما الشيء الواضح تمامًا: هي عمليات التحرير المختلفة التي هزت السيادة المطلقة، من القرن الثامن عشر فصاعدًا، في "فرنسا، روسيا، إسبانيا، إيطاليا"، وغيرت الأمور في ذلك الوقت؛ حيث اختفى الوصاة أو الرعاة الأرستقراطيون أو تم تهميشهم، وذهبت أصولهم النبيلة وظهرت الخريطة الاجتماعية والسياسية، كما وصفها المفكرون مثل روسو، وديديروت، وجيفرسون، وماركس، وكونتي، والتي وضعت على مبادئ أخرى؛ أبرزها: مبدأ سيادة الشعب الناقل لمبدأ السلطة السياسية من أعلى إلى أسفل، وبسبب هذا التحول، بدأ إطلاق الموسيقى تدريجيًّا من طقوسها التقليدية حتى نالت الحرية المطلقة.
ما الآليات المتبادلة لهذين الفنين المراوغين -النغمة والحكم- التي تمكن من ابتكار تنويعة واسعة من تصميمات الذات وشخصية الحاكم وحكومته؟
ويقود الكتاب القراء -عبر العديد من الأمثلة التاريخية- نحو عدد من الإجابات المبدئية على هذا السؤال، وتنبع جميعها من خلال الخواص المتفردة لكل واحدة من الظواهر التي يناقشها الكتاب، كما جرى تصميمها في السياقات الثقافية المختلفة.
لقد تنوعت فصول الكتاب، الذي اشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وكودا (في الموسيقى)، بمعنى تقفيلة، وهي قطعة موسيقية تأتي في نهاية لحن CODA، وكانت المقدمة حوارًا عن خيالات الموسيقى وأوهام السياسة وتناول الفضل الأول مقابلة بين السيادة الملكية وعدم الانسجام (في الموسيقى)، وكان الفصل الثاني حول تصميم وتأسيس موسيقى سياسية مميزة للمجتمعات والأفراد، بينما دار الفصل الثالث حول تغيير الحوارات الموسيقية والسياسية للتخريب والاحتجاج والمصالحة، وكان الجزء الأخير من الكتاب يدور حول كودا بين الأصوات الواحدة والأصوات المتعددة عبر التلحين الإسرائيلي والألماني.
وتتناول الفصول الثلاثة الرئيسية، ثلاثة أنواع من الصلة التاريخية والأساسية بين الموسيقى والسياسة، والتي تنبع جزئيا من الاستقلال النسبي لكل من الميدان، والتغيرات التي حدثت داخلها: النوع الأول يتعلق أساسًا بالأعمار الملكية التي تسعى إلى تطبيع التنافر أو إرساء عدم الانسجام في هياكل متناغمة، وينصب التركيز الرئيس على اللحظة التاريخية، التي هيمن فيها مفهوم الوئام العالمي على الغرب لقرون عديدة؛ مما أدى إلى ضعفها وأفسح مجالاً لمفاهيم الوئام الجزئية، والمختلطة، والأقل هرمية، سواء في الموسيقى أو في السياسة.
وهكذا.. فإن الكثير من النقاش مكرس لتوضيح التحولات الأنطولوجية والمعرفية التي شكلت الأساس لصعود التناظرات أو الأقيسة لهذه المفاهيم التوافقية المتناغمة في الموسيقى والسياسة وفي العلاقات بينهما، وعلى خلفية الأنماط المتناغمة الجديدة الناجمة عن ذلك، نشبت الأصوات الفردية في جو تعبيري جديد، يبرز ظهور الجماعات والطبقات الهامشية، وفي الوقت نفسه، اتضح بشدة استبعاد الأفراد والجماعات التي تحيد عن هذه الأنماط، فضلاً عن ذلك مساهمة الموسيقى في سياسات الهويات، وتمثيل الآخر وتصميمه في الموسيقى، ومحاولات تطبيق الأنماط التوافقية الجديدة، كما في السياقات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية، وتم تعريف النوع الثاني "التمثيل داخل التصميم" في هذه التركيبة كتجسيد ورسم متحرك موسيقي من الجهات الفاعلة الحقيقية والخيالية في الساحة السياسية، وهم الملك والشعب والجيش والدولة، وأيضًا الفرد، والمرأة، والأجانب، والأقليات -الأمر الذي يتحول بدوره في بعض الأحيان إلى تحدٍ، هذا النوع، كما سنرى، هو سمة خاصة من أشكال الحكم الجمهوري الشيوعي، وعلى الرغم من أنها تستمد أصولها من السياق الملكي، ويخصص المؤلفان قسمًا مركزيا في هذه المناقشة لتحليل نوع (لحن جنائزي أو مارش حزين أو موسيقى حزينة) في مساعيها المهيمنة والتخريبية في مختلف السياقات التاريخية والسياسية، أما النوع الثالث فيعنى التجلي وهو التحول الروحي ويركز على لحظات من تشغيل الموسيقى في محاولة لخلق نظام بديل للهيمنة الثقافية والسياسية، هو أمر يشهد وضعه الرمزي أو يشجع على الأقل اتجاه التغيير في الهيكل السياسي القائم، وفي لحظة معينة سيتحول النمط الموسيقي أو النوع والنظام السياسي إلى كيان جديد أو مختلف لأجل حدوث العملية، وهكذا تنشأ الحوارات الموسيقية والسياسية للتخريب والاحتجاج والاسترضاء، إلى جانب مكافحة القمع والطاعة والعنف في سياقات ديمقراطية وشمولية وسياقات أخرى.
تعادل هذه الأنواع الثلاثة -تطبيع التنافر في الهياكل التوافقية، والتمثيل داخل التصميم والتحول- في الواقع ثلاثة "أشكال من الفكر" أو "المدارات" في مجال البلاغة الكلاسيكي: القياس، والكناية، والاستعارة.
إن الإحالة إلى الخطابة في السياق المشترك للموسيقى والسياسة ليس من قبيل الصدفة، وإنما ماهية الممارسة تعاليمها معها، والتي اتخذت الاثنين منذ وقت سحيق كمساحة مرجعية خصبة، كل واحد منهما اكتشف طرقًا لإثراء كلماتها وتعبيرها، نود أن نقول إن هناك صلة بين التغييرات التي حدثت في الكلام الكلاسيكي أثناء الانتقال إلى أنماط الاتصال والإقناع في العصر الحديث وبين التطورات الموازية في الجوانب البلاغية للسياسة والموسيقى في العصر الحديث، وقبل صياغة الخطابات السياسية وإدراج تكنولوجيا الإنتاج الموسيقي الجماهيري، تم توحيد المعايير الجمالية والأيديولوجية والسياسية في مختلف السياقات الزمنية والمكانية، وكانت هذه التطورات تتطابق مع الاتجاهات الواسعة للتكامل الاجتماعي والتدوين، والتي ارتبطت ثقافيا ببناء الدول القومية والديمقراطية الحديثة.
تصورنا لدور البلاغة في السياسة وأهميتها للخطابة في هذا المجال يعبر عنه مفهوم "الخيال السياسي"، وغالبًا ما نستخدمه ونحن نرى هذا المفهوم من الصور العادية وهو من مفهوم الخيال السياسي، الذي يتم تعريفه كرابطة مختلفة لاختلاق الوهم والاستعارات والأفكار حول النظام الاجتماعي لاكتساب المركز وقوة الهدف وتصميم وتنظيم مؤسسات وأنماط السلوك السياسي؛ ولذلك فإن هذا النوع من الخيال يشكل أنواعًا من الديمقراطية الجماعية التي تخلق وتعزز النظام الاجتماعي السياسي في الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء وتوجيه وتشكيل المؤسسات وأنماط السلوك السياسي التي تجسدها، الملكية، والديمقراطية، والفاشية هي أنواع مختلفة ومعقدة من هذا الخيال.
وفيما يتعلق ببلاغة هذا الخطاب والبنية الأساسية المنهجية الأساسية، يمكننا أن نقول إنها تستند إلى مفاهيم نظرية متقاربة، ظهرت على التوالي من النشاط السياسي والموسيقي، وكلاهما نشأ على خلفية ثقافية مفاهيمية مشتركة، وقد تكرر النقاش في هذا الكتاب بحيث اشتمل على أمثلة كثيرة من الموسيقى كأمثلة من الأوبرا، وهاليد، والموسيقى الشعبية، والسينما، والفيلم الوثائقي..إلخ، والسياسة الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية وصلاتها بالشرق الأوسط، والتي تمكننا ليس فقط من إظهار وتقديم الأفكار النظرية، ولكن أيضًا من خلال التفسير الذي يطالبون به لشحذ أسئلتنا وتعميق رؤيتنا، وتم تسهيل القراءة من خلال جمع الأمثلة المختلفة لقراءة النص بأبعاده المختلفة.
وأخيرًا.. الموسيقى في هذه التركيبة مبنية بشكل أساسي كالفنون المتضمنة أصواتًا غير لغوية -مع أو بدون ارتفاع محدد- في أوراق منظمة من القيمة الجمالية في ثقافة معينة، وحتى عندما تعلق على نص أو صورة أو إجراء دراماتيكي، فإن وزنه المحدد، كما هو مبين في معاييره الفريدة، أمر محوري في السياق المعروض علينا لفهم استخداماته وآثاره السياسية. ومع ذلك، في الصفحات المعروضة علينا أن نفهم أحيانًا على نطاق أوسع، باعتبارها الشيء الذي يرسي البعد الصوتي ككل في المجتمع والثقافة، والذي يعد مثالية متباينة في صياغة أشكال أخرى من الفن تطمح إلى حالة أو شأن أو كيفية خاصة بها.
إن تناول مصطلح "الموسيقى"، لفترة طويلة في تاريخ الغرب يعود إلى نظرية رياضية تأملية حول بنية الكون ونموذج العلاقات المتناسبة في فعل الإنسان، والتي بطبيعة الحال لها أثرها على الممارسة الموسيقية، وقد تم تكريس الفصل الأول لآثاره السياسية في وقت لاحق من هذه المرحلة التاريخية، وسوف يستمد القارئ من الكتاب الكثير من التفسيرات لمصطلح الموسيقى.
------------------------
- الكتاب: "تلحين القوة، وغناء الحرية: علاقات علنية وخفية بين الموسيقى والسياسة في الغرب".
- المؤلف: روت هَكوهين-فينتشوفر، ويارون إزراحي.
- الناشر: دار النشر معهد فان لير، ودار النشر هكيبوتس هميؤوحاد، 2017، باللغة العبرية.
- عدد الصفحات: 275 صفحة.
* أكاديمية مصرية