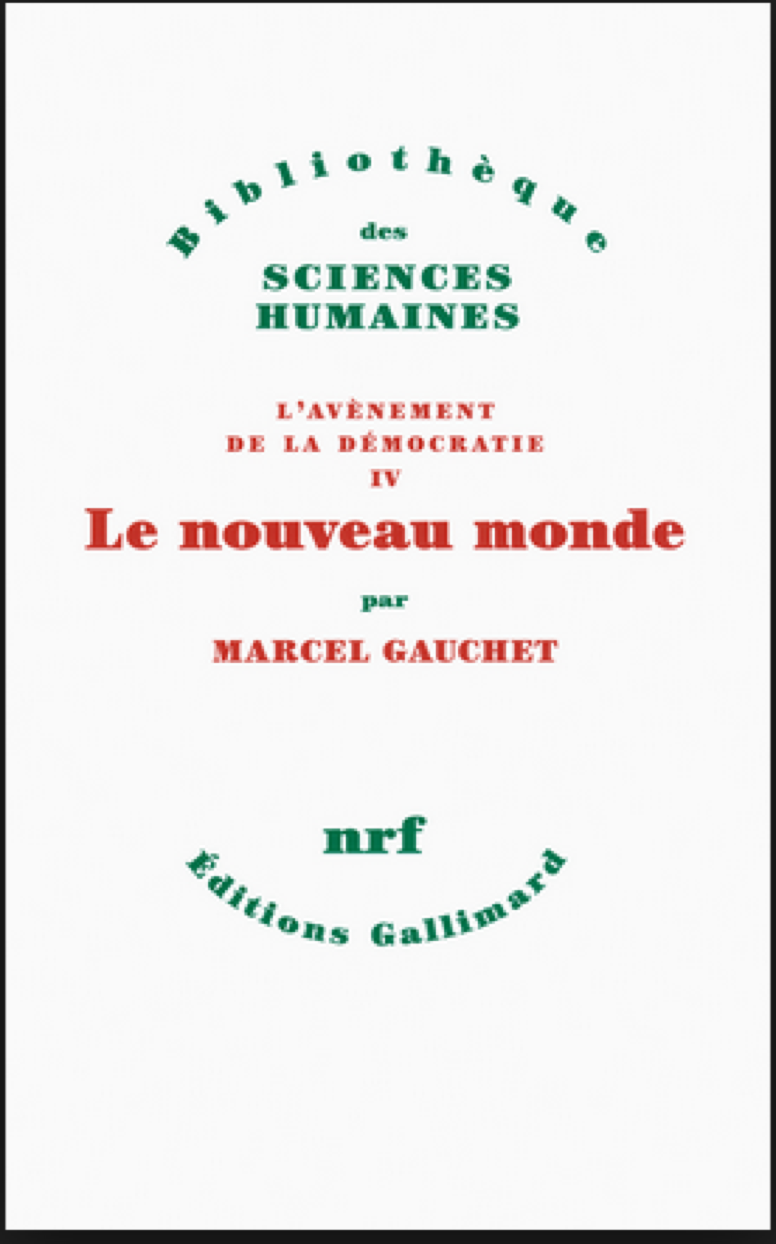مارسيل غوشيه
محمد الشيخ
إذا ما صَحّ قول الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون بأنّ ما مِن مفكر، مهما كثرت أنظاره وتعددت مؤلفاته، إلا ويدافع عن فكرة واحدة ووحيدة ما يفتأ يعبر عنها في مختلف هذه التآليف، وما يزال ينقحها التنقيح، حتى تستقيم استقامتها الأخيرة، فإنّه يصح القول - بالتطبيق - إنّ ههنا مفكرا وفيلسوفا سياسيا فرنسيا ما فتئ، منذ ما ينيف عن أربعين سنة، يدافع عن أطروحة أساسيّة مفادها أنّ الحداثة تعني "حركة الخروج (من) الديانة". وليس يعني مارسيل غوشيه (1946 -) بقوله الجامع "الحداثة هي حركة الخروج من الديانة" دلالة أنّ "الحداثة هي حركة الخروج (عن) الديانة"؛ بمعنى الإلحاد بالرب؛ إذ "الإلحاد قديم في البشرية"، كما قال أبو العلاء المعري. أكثر من هذا، من شأن هذا الخروج (من) أن قوَّى إيمان المؤمنين، كما رأينا ذلك مع الحركة الإصلاحية البروتستانتية والكاثوليكية. فكان إصلاح الدين تقوية للإيمان، عند المصلحين وأتباعهم، لا مروقا من الديانة.
وإنّما تعني الأطروحة أنّ الديانة لم تعد تلعب، في المجتمعات الحديثة، الدور المحوري الذي كانت تلعبه في المجتمعات القديمة، فالخروج (من) الديانة، وليس "عن" الديانة، يعني الخروج من التنظيم الديني للعالم. ذلك أنّ المجتمعات القديمة كان مدار وجودها وحياته على الديانة؛ بحيث كانت الديانة تحدد فيها نوع السلطة السياسيّة التي تحكم الناس، ونمط العلاقات الاجتماعية التي تجمع بين الناس، وشكل التجمّعات البشرية التي تؤلف بين الناس.. وكل هذا "الجامع" تمّ تفكيكه في خلال خمسة قرون من الحداثة. ويجد مارسيل غوشيه في هذا التعريف للحداثة أنّه "تعريف حدّي"، وأنّه "تعريف شامل"؛ وذلك لأنّ من شأن هذا التعريف أن يفسر كل الظواهر الأخرى المرافقة للحداثة - العقلانية، الفردانية، الحرية ... - كما من شأنه أن يسمح بتعميم شمولي ينتج معنى لجميع تفاصيل هذه القرون الخمسة من الحداثة التي عاشتها المجتمعات الأوربية والتحقت بها غيرها من المجتمعات غير الأوربية.
هو ذا الشق الأساسي الأول من أطروحة الرجل والتي لطالما أدار أفكاره عليها، لكن الشق الثاني المكمل هو أنّ مجتمعات الحداثة - بعد أن تحررت من الديانة، وأمست مجتمعات تحكم نفسها بنفسها وليس بدعم من الغيب - ما عادت هي تَعْرِف ما الذي تفعله بهذه الحرية التي كسبتها: الحرية من أجل ماذا؟ وما الذي يمكن أن نفعله بهذه الحرية؟ وكيف لنا أن نمارسها؟ هي ذي معضلة مجتمعات ما بعد تحقيق الحرية. وبهذه المعضلة صار مجتمع الخروج من الديانة أصعب عالم يمكن السيطرة عليه.
والحال أنّه ظهرت الملامح الأولى لهذه الأطروحة في كتاب مارسيل غوشيه المبكر الذي اشتهر به عام 1985 ـ "انبطال سحر العالم" ـ والذي ذهب فيه إلى أنّه ما عاد البشر يسلمون مفاتيح فهم مجتمعاتهم وقيادها إلى أرباب الأديان، وما بقيت الديانات هي ما ينظم حياة الناس في الزمان وفي المكان، وما ظلت هي ما يشكل التجمّعات الجماعية، ويدير السلطة. لقد انتهى عهد استتباع المجال البشري إلى الترتيب الإلهي. وإنّما أمست المجتمعات البشرية "مستقلة" و"متحررة"؛ أي أنّها باتت عن تدبير الغيب لها بمعزل. وهكذا صار بنو البشر لا يرجعون في تدبير أمورهم إلى مرجعية أخرى، اللهم إلا سلطان العقل، وأمسوا يُعملون حريتهم في تشكيل العالم وفق إرادتهم لا وفق مشيئة الأرباب. على أنّ الترتيب الديني لم يختف هكذا فجأة عن غدارة، إذ ظل في الخلفية دوما ذاك "المحدد الخفي" أو قل "النواة السرية" التي هي الديانة. وما كان الانسلال من ربقة الدين بالأمر الهين، ولا بالنهر المنساب من دون عائق يعوق، فدون تحققه التحقق النهائي عقبات، وفي وجه اكتماله الاكتمال الأخير معضلات.
وبعد مضي أزيد من عقدين من الزمن على صدور هذا الكتاب - الذي بات يعد أحد أهم المراجع الفكرية في فلسفة السياسة وفلسفة الدين والفلسفة الاجتماعية في زماننا هذا - طفق الباحث يطور هذا الحدس الجوهري التطوير؛ وذلك بإصداره لسلسلة من أربعة كتب تحت العنوان الجامع "بزوغ (صعود، بُدُوُّ) الديمقراطية": "الثورة الحديثة" (2007)، "أزمة الليبرالية" (2007)، "على محك التوتاليتاريات (الأنظمة الكليانية أو الشمولية)" (2010)، "العالم الجديد" (2017). وفي هذه الرباعية يواصل فيلسوف السياسة تحليله للمروية المؤسسة للحداثة - الخروج من الديانة - مؤرخا ومحللا لهذا المسار المتعرج المضطرب المليء بالعوائق وبالأزمات.
وهكذا، ففي كتابه "الثورة الحديثة" ـ الذي هو بمثابة التمهيد إلى الأوديسة الرباعية ـ يقف الرجل عند الخلفية المؤسسة للحداثة - ثورة استقلال المجتمعات الحديثة ضد الاستتباع إلى الديانة - التي جرت على مدى أربعة قرون: من 1500 م إلى 1900 م. ولا سيما على مكونات الثورة الثلاثة التي ترتب عليها العالم المنبطل السحر: السياسة والحق والتاريخ. ذلك أن أصالة الديمقراطية الحديثة تعود - في نظره - إلى تلك الكيمياء العجيبة التي حدثت بين هذه العناصر الثلاثة، والتي سمحت ببزوغ الذاتية الحقوقية - الذات الحاملة لحقوق ولواجبات - والتي تأسس فيها مفهوم "الفرد" على أساس من مفهوم "الحق"، وتأدى ذلك إلى تشجيع استقلال الفرد بذاته. على أن الصيغة الدينية المسيحية المشجعة لاستقلال الفرد كانت لا تزال تلعب دورها في خفاء. ثم إنه عن التركيز على البعد الحقوقي للفرد تخلَّقت أزمة الديمقراطية الحديثة والمعاصرة.
وفي الجزء الثاني من الأوديسة - أزمة الليبرالية - يحلل الباحث سنوات 1880-1914 التي تشكل، حسب نظره، "مصفوفة" و"سدى" القرن العشرين وأسباب نجاحاته وإخفاقاته. ففي الوقت الذي أرسيت فيه قواعد الديمقراطية الليبرالية، بالتوليف البديع بين النظام التمثيلي والاقتراع العام، فإنّ العالم الذي برز إنما فَجَّرَ الإطار الموروث عن العالم الديني الذي كان - ويا للمفارقة! - قد "دعم" في خفاء بناء الحريات المكتسبة، لكن تأتي أيضا عن ذلك التفجير نشوء الحماقات التوتاليتارية، وذلك بالقدر نفسه الذي تأتى عنه دعم تعميق الديمقراطيات الليبرالية واستقرارها. وتلك هي الحقبة الحاسمة التي سوف يفحصها الجزء الثالث - على محك التوتاليتاريات- .
وأما الجزء الرابع - العالم الجديد - فسوف يكرس لإعادة توجيه حياة المجتمعات الغربية، وذلك من أواسط السبعينيات من القرن الماضي إلى الأزمة الجديدة لنمو الديمقراطية التي تتخبط فيها هذه المجتمعات اليوم. والشأن الغريب في المجتمعات الغربية - الذي يقف عنده غوشيه بالتحليل - هو أنّها أضحت تحيا على ضرب من "القلق العميق" - وتلك بحد ذاتها مصيبة، لكن المصيبة أعظم حين يتبين أنها لا تعرف حتى كيف تسمي هذا "القلق". ففي نهاية القرن التاسع عشر كان الجواب واضحا: لدى الرجعي سبب القلق هو الزيغ السياسي، وعند الماركسي هو الاستغلال الرأسمالي الذي يستدعي القيام بالثورة، وعند عدو الحداثة: هو الفساد الأخلاقي. لكن اليوم فقد الأوربيون سذاجة وصرامة رجال القرن التاسع عشر. ولهذه الحيثية، يعلن مارسيل غوشيه: "لقد أمسينا كلنا شركاء، لا ندرك كيف نسمي ما يزعج هذا العالم".
يفتتح الرجل كتابه بعبارة تلخص كل مرامه في هذا الكتاب: لقد غيرنا - معشر الأوربيين - العالم، لكن هذا التغيير فتح مشكلتنا العظمى من جديد. لقد سرَّعنا بمجيء عالم مختلف جذريا عن سابقه، لكنه عالم حامل لصعوبات غير مسبوقة. ما العالم الذي ودعناه؟ وما العالم الذي حييناه؟ ودعنا "العالم القديم"، وحيينا مجيء "العالم الجديد". والحال أن "العالم الجديد" تعبير مستهلك، لكن الظرفية تبرر إعادة إحيائه وتحيينه. والباحث يستعمل هنا عبارة "العالم الجديد" لا بمعناها الجغرافي، وإنما بمعناها التاريخي. "العالم القديم" هو عالم التدين الأصلي، و"العالم الجديد" هو عالم الخروج من الديانة. وهو عالم لا يهم أوربا وحدها، بل يعني حتى الشعوب غير الأوربية - بفعل عوادي العولمة - التي أمست تهتم بالحداثة. وما الاضطرابات التي تحدث باسم الدين اليوم - التطرف والإرهاب - إلا عبارة عن ردات فعل عن انهيار السند الديني بسب من الرجة التي أحدثتها فيه الحداثة.
لقد قطع الأوربيون، من غير أن يدركوا، جولة حاسمة في مغامرتهم الأولى بالخروج من الديانة، وأمضوا في الأمر إلى نهايته وفق سيرورة شكلت منذ خمسة قرون "روح أوديستهم"؛ وذلك بأن أنهوا اليوم خروجهم من البنينة الدينية. قفزوا نحو المجهول وما شعروا بذلك. اختفت بُنَى الاستتباع إلى الفوق، إلى الغيب، إلى الأرباب، وتقوت بُنَى الاستقلال. وقد ترتبت عن هذه النقلة أزمة. وهي "أزمة نمو": ذلك أن تنامي إمكانات قدرة المرء على أن يمسي حرا، كان ثمنها تناقص قدراته على استعمال هذه الحرية نفسها. لقد حُكم على الأوربيين أن يتقدموا من غير ما نبراس يرشدهم. وإنما الانخراط في الحداثة انخراط في هوات سحيقة لا يدرك لها قعر. وإذ قاد الأوربيون البشرية نحو تحديدها لنفسها من غير ما سند من "فوق"، فإن تواجدهم في المقدمة كان له ثمن: ما كان للزيغ الذي تتخبط فيه المجتمعات من منبع آخر سوى تبدد هذه النواة السرية (الديانة) التي كانت هي عادة ما يمنحهم وسائل أن يفكروا في ذاتهم، وأن يحصلوا دلالة أنفسهم، وأن يريدوا أمرهم، وأن يدبروه. وإذ حُرمت هذه المجتمعات من هذا السند، فها هي تجنح من غير أن تعلم ما هي ولا إلى أي اتجاه تسير. وإنها لواقعة تحت صدمة "المرحلة النهائية من سيرورة الخروج من الديانة".
ما الذي قاد حديثا إلى هذا؟ كل الكتاب مخصص إلى تحليل هذا الأمر. والمنطلق هو ما حدث بعد السبعينيات من القرن الماضي. والجواب أنه حدثت ثلاث ظواهر: تطور شكل الدولة القومية، تعميق التوجه التاريخي، توسيع تفريد الحق. هي ذي العناصر المنظمة للظرفية غير المسبوقة التي أسسها تحول ما بعد السبعينيات. وهي الظواهر التي عززت الليبرالية الجديدة. وكما كانت قد ساهمت من قبلُ قوةُ الدولة والإيمان بخصوبة التاريخ في تعزيز الاشتراكية، فإن سيادة الفرد والقول بنهاية سيرورة التاريخ وسيادة الشأن السياسي السيادة الشاملة قد عززوا هيمنة الليبرالية في ما بعد. لكن للانتشاء بانتصار الفرد صاحب الحقوق ـ والذي عليه مدار الأدلوجة الليبرالية المنتصرة ـ ثمن. وهذا الثمن يتمثل في أن تكثير وسائل استقلال الفرد وانعتاقه قابَله انعتام الغايات التي يُفترض أنه يسعى إليها. ففي الوقت الذي ازدادت فيه إمكانات الاستقلال الافتراضية، ضاقت فيه إمكانات الاستقلال الواقعية. ولا تشابه بين أزمة الأمس ـ ظهور الأنظمة الكليانية ـ وأزمة اليوم - أزمة الديمقراطية - إذ أزمة الأمس نمت عن حنين إلى الماضي - إلى دعامة الديانة التي اختفت - أما أزمة الحاضر، فقد قطعت مع هذا الشكل السابق لاستبدال الديني بالسياسي. لقد ولت الوحدة الروحية إلى الأبد، وترسخت الوحدة السياسية، وما عاد ينظر إلى الدين بديلا عن السياسة. أكثر من هذا، ما عادت تلوح في الأفق توتاليتاريات: ما عاد من وجود لجماهير فاعلة، ولا لإيديولوجيات مجنِّدة، ولا لأحزاب مؤطِّرة. لقد صار الأوربيون اليوم في حمى من تهديدات عودة الماضي الديني التي كانت تهدد متقدميهم، لكنهم أمسوا أمام مخاطر أخرى: لقد تبخرت أشكال الشأن الجماعي من أفق ما يمكن أن يُفكَّر فيه وما يمكن أن يُعتَقد فيه. لكن كان لهذا التبخر المخلِّص ثمن: "الغياب التام لأي أفق تاريخي". غاب حفظ المسافة عن حاضر مُداهِم، وغاب إمكان تصور أي مستقبل واعد، وما عاد التعويل إلا على النفس حيث ما بقيت هناك إشارات عن سيرورة تاريخية ممكنة، بل وحتى متخيلة يوطوبية، وانجرف الكل في مهواة سحيقة. أدهى من هذا، صار الكل يتحسس الأزمة، لكن من غير أن يدركها الدرك. وأمسى الكل يغوص بأكمله في حاضر بلا أسئلة وبلا انفتاحات.
ولعل أحد أسباب القلق الذي يستبد اليوم بالمعاصرين انهيار البعد الأخلاقي في العلاقات بين المواطنين لصالح تضخم البعد الحقوقي: لقد أمسى كل تعامل بين أفراد الجماعة مبنيا على الحقوق والواجبات، لا على "الفضائل" و"السجايا"، وكان أن ساد "العدل" وتوارى "الفضل"، وأمسينا نعيش في عالم حقوقي متطلب جدا، ما يفتأ المواطن فيه - وقد نسي الدلالة الأخلاقية لمواطنيته واستحضر فقط الدلالة الحقوقية لها - يصرخ: حقوق، حقوقي.
وبمبعد عن كل تفاؤل وعن كل تشاؤم، وفي مزيج غريب يمكن أن نسميه، تبعا للروائي الفلسطيني إميل حبيبي، "تشاؤل"، يرى غوشيه أنّ الإنسان هو النوع المتناقض بامتياز، بحيث يمسي الشيء ونقيضه بالنسبة إليه صحيحين معا، فمثلما هو قادر على الأفضل، قادر هو على الأسوأ أيضا. ولقد كان أول من أدرك هذا الأمر الفيلسوف الألماني كانط لما تأمل في "اجتماعية الإنسان" وكشف أنّها "اجتماعية غير اجتماعية". ولربما تناسى غوشيه الحكاية الشرقية القديمة التي أوردها الفيلسوف الألماني شوبنهاور: "مثل الإنسان والإنسان كمثل حيوان الشيهم. يحكى أنّه ذات صبيحة باردة، تضامت الشياهم إلى بعضها طلبا للدفء، لكن سرعان ما شعرت بآلام حادة من وخزات مشاوكها، فما لبثت أن ابتعدت عن بعضها. وسرعان ما عاودها الإحساس بالبرد، فكان أن دفعتها غريزتها إلى الالتصاق من جديد، وكان أن عاد الألم، وهكذا أمضت سحابة يومها تجرب الموقف المرار العدة؛ إلى أن أدركت المسافة الوسط، فلزمتها". أكثر من هذا، لم يعلم تدبر الحكيم أبي عبد الله بن بكر في شأن تآلف الناس في زمانه وتخالفهم لما قال: "الناس أشبه شيء يكونوا بالتيوس: إن اجتمعوا تناطحوا، وإن افترقوا تصايحوا".
تلك على وجه الجملة هي معاطب زماننا بعد أن خرجت المجتمعات الغربية من الديانة خروجها المعلوم. لكن لا توجد أية نزعة حنينية إلى الماضي عند مارسيل غوشيه. فلا هو يدعو إلى العودة إلى الديانة بعد الخروج عنها. ولا هو ينادي بتسحير العالم الجديد بعد انبطال سحر العالم القديم. بل بالعكس يقول بالذهاب بإبطال السحر إلى آخر مداه، ويرتئي تقدير نوع الحرية الذي يمنحنا انقشاع السحر إياه. ويجد في ذلك ممارسة للحرية لا سابق لها في تاريخ البشرية.
وبعد، حال المحدثين أشبه شيء يكون بحال البحارة البرتغاليين في بداية عهد الحداثة، كانوا لا يولون شطر وجههم إلى ما كان يدعوه العرب القدامى "بحر الظلمات" إلا بعد أن يودعوا أهلهم كأنه الوداع الأخير، وذلك بعد أن أصروا على الإقبال على مغامرة استهوتهم لكنهم لا يعرفون مآلها، وفي الوقت نفسه لا يشعرون بالندم على إقبالهم على ما أقبلوا عليه، فكذلك هو حال مغامرة الحداثة بالخروج من الديانة والانغمار في عالم مجهول..
---------------------------------------------
عنوان الكتاب: العالم الجديد
سلسلة الكتاب: صعود الديمقراطية (الجزء الرابع)
المؤلف: مارسيل غوشيه
لغة الكتاب: الفرنسية
سنة الصدور: 2017
دار النشر: منشورات غاليمار
عدد الصفحات: 749