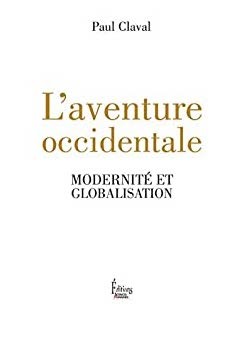لبول كالفال
مُحمَّد الحداد
هل قضت العولمة على الحداثة، ووضعت حدًّا لمغامرة انطلقت من أوروبا منذ أربعة قرون؟.. هذا هو السؤال الذي يطرحه بول كلافال في كتابه الصادر مؤخرا. والكاتب كما هو معروف يعدُّ مؤسس الجغرافيا الثقافية، درَّس هذا الاختصاص أكثر من خمسين سنة بجامعة السوربون بباريس، وعمل على إثرائه بالعديد من المؤلفات من أحدثها "فضاءات السياسة" (2010م)، و"من الأرض إلى البشر" (2012م)، و"التفكير في العالم من خلال الجغرافيا" (2015م)، فضلا عن الكتابين الذين لقيا شهرة عالمية قبل ذلك؛ وهما: "الأساطير المؤسسة للعلوم الإنسانية" (1980م)، و"الجغرافيا في القرن الحادي والعشرين" (2003م).
وقد سعى كلافال في الكتاب الحالي إلى تقديم عرض شديد الكثافة لما دعاه بالمغامرة الغربية، في علاقة بالعولمة والحداثة. يحاجج الكتاب على أطروحة رئيسية وهي التمييز الحاسم بين هاتين الظاهرتين، عكس ما هو شائع لدى الباحثين عادة. ويؤكد أنهما يمثلان مسارين مختلفين لكل منهما منطقه الخاص، وليست العولمة نتيجة الحداثة كما يقال دائما، وإن ارتبط مصير هذه بتلك في بعض المراحل التاريخية. إنّ جوهر الأزمة التي تعيشها البشرية حاليا تتمثل من وجهة نظر الكاتب في تحوّل العلاقة من الارتباط إلى التعارض، واكتشاف أنّ الارتباط ليس القاعدة بل هو الاستثناء.
يُحاجج الكاتب على هذه الأطروحة بحجج مختلفة منها العودة إلى البدايات؛ حيث نتبين أننا أمام لحظتين تارخيتين مختلفتين. فاللحظة التاريخية لانبعاث الحداثة هي القرن السابع عشر، وقد جاءت نتيجة الحروب الدينية في أوروبا والحلول الجديدة التي تصورها الفلاسفة والسياسيون آنذاك للخروج من عُنق الزجاجة وكوراث التعصب الديني؛ فقامت الثورة الإنجليزية المدعوّة بالمظفرة سنة 1688، وكانت فاتحة التنظيمات الحديثة التي تجسدت شيئا فشيئا في الدولة الوطنية والاقتصاد الصناعي والتعليم المدني.
أمَّا العولمة، فقد بدأت قبل ذلك بكثير، في عهد الاكتشافات الجغرافية الكبرى، وارتبطت بكريستوف كولومب (اكتشاف أمريكا) وفاسكو دي غاما (اكتشاف رأس الرجاء الصالح) وماجلان (أول رحلة بحرية حول العالم).
إنَّ التغييرات النوعية غير المسبوقة التي تراكمت في السنوات الخمسين الأخيرة تدفع إلى التساؤل من جديد عن العلاقة بين الحداثة والعولمة، ومناقشة الافتراض القائل بأنّ العلاقة بين العولمة والحداثة قد دخلت مرحلة من الصراع. يكفي أن نسجّل الارتفاع الهائل لعدد سكان المعمورة من 2 مليار نسمة سنة 1930، إلى ثلاثة مليارات سنة 1961، إلى سبعة مليارات سنة 2010، أو أن نتأمل السرعة الفائقة التي أصبحت تميز تبادل المعلومات بين سكان المعمورة بفضل الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة. والسؤال المطروح هنا هو التالي: ما هو محرك هذه التغييرات غير المسبوقة في تاريخ البشر، أهي الحداثة (التطور) أم العولمة (إذا سلمنا مع الكاتب بالفرق بين الظاهرتين)؟
يعرِّف الكاتب الحداثة بأنها يوتوبيا اجتماعية نشأت في القرن السابع عشر في أوروبا وامتدت بعد ذلك إلى العالم كله، ومن أهم أركانها "الدولة الوستفالية" (نسبة إلى سلام "وستفالي" سنة 1648 الذي أنهى الحروب الدينية في أوروبا، والذي أرسى مبدأ سيادة الدولة والتقسيم القانوني للفضاء الوطني السيادي، وهي التي أصبحت تعرف منذ القرن التاسع عشر بالدولة الوطنية. ولعلَّ أبرز شاهد اليوم على تراجع يوتوبيا الحداثة نستمده بالذات من الأزمة العميقة لهذه الدولة في كلّ أرجاء العالم حاليا. ومع أنّ هذا الشكل من التنظيم السياسي قد شهد عدّة أزمات في تاريخه فإن أزمته الحالية تعتبر الأكثر خطرا وقد تكون القاتلة.
ويُؤكد الكاتب أن المجتمع الأوروبي في نهاية العصر الوسيط لم يكن يختلف اختلافا كبيرا عن المجتمعات الأخرى مثل العالم الإسلامي أو الصين أو الهند. والسبق الوحيد الذي تميزت به أوروبا -وقد أصبح حاسما بعد ذلك- هو تطويرها للأسلحة النارية ولصناعة البواخر الحربية. ومع أن هذا الأمر كان يبدو ثانويا في البداية، فإنه مكّن أوروبا شيئا فشيئا من أن توسّع حدودها التجارية إلى ما وراء البحار، وترسي لأول مرة فارقا بين الحدود الوطنية والحدود التجارية. وكانت عمليات السيطرة على القارة الأمريكية أو فتح طرق مواصلات مكثفة نحو الهند دافعا رئيسيا لقيام ما أصبح يدعى لاحقا بالدولة الوطنية؛ إذ إنّ هذه العمليات تطلبت تمويلات ضخمة لا يمكن توفيرها إلاّ عبر الدول، وهكذا بدأت أوروبا تقسم إلى دول "وستفالية" سيادية أسهمت بدورها في تنمية الموارد المالية الناتجة عن الاكتشافات الكبرى. وفي هذه الظرفية بالذات، بدأت الفلسفة السياسية الحديثة تتخيل الاجتماع السياسي البشري في شكل تعاقدي محوره الحرية والمبادرة، بديلا عن النظرة الهرمية السائدة قديما للمجتمع والسلطة.
ولم يكن لهذا العقد أن يتجسد إلاّ بشروط، منها توحيد اللغة داخل الفضاء السيادي الواحد (نشأة اللغات الوطنية)، وتعميم التعليم كي يصبح كلّ السكان واعين بحقوقهم وواجباتهم وقادرين على التفاوض حولها بطريقة معقلنة (نشأة التعليم العمومي)، وإخضاع كل مجالات الحياة البشرية إلى التقنين الموحّد والمساوي بين المواطنين (الدستور والقانون المدني)..الخ. وقد نشأت منذ البداية ثلاثة تأويلات كبرى لنظرية العقد: التنازل الطوعي عن الحرية الشخصية مقابل الحماية (العقد الاجتماعي من وجهة نظر هوبس)، أو دعم الحريات الشخصية بالليبرالية الاقتصادية (العقد حسب جون لوك)، أو إخضاع الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى الإرادة العامة والمصلحة العليا (العقد الاجتماعي لدى روسو). وكل تجارب الدولة الحديثة قد سلكت أحد هذه التأويلات فأفرزت ثلاثة أنماط كبرى: القومية والليبرالية والاشتراكية. لكن هذه الأنماط لم تخرج عن يوتوبيا الدولة الوستفتالية. ومن هنا، فإنَّ الأزمة الحالية للدولة الوطنية تبدو مختلفة عن سابقاتها؛ لأنها تتمرَّد على اليوتوبيا الحديثة للدولة التي تواصلت منذ القرن السابع عشر وانتشرت من أوروبا إلى العالم كله. لقد عدّت بعض الأزمات السابقة بمثابة الانحراف عن الأصل، مثل النازية والفاشية والستالينية، أما ما يحدث اليوم فهو أقرب لانهيار النموذج المألوف.
وفي الواقع، ليست هذه أول مرة تهدّد فيها العولمة مبدأ الدولة الوطنية، لكن هذه أول مرة يبدو من العسير إيجاد توافق بينهما. لنتذكر أنّ فلسفة الأنوار كانت قد انتشرت تاريخيا في فترة تميزت عالميا بتطور مكثف للمبادلات التجارية، وكان ذلك سببا من أسباب انتشار التفاؤل بمستقبل العالم وانتشار فكرة الكونية، لكننا نعلم أيضا أنّه لا يوجد مثال واحد لتجربة حداثة واقعية تطورت خارج الدولة الوطنية. فما حصل فعلا هو أنّ الدول الوطنية الكبرى، مثل إنجلترا وفرنسا، نجحت في تحويل فضاءاتها الوطنية المستقرَّة إلى فضاءات اقتصادية مستفيدة من العولمة، وقد حصل ذلك في حدود الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. ومع أنّ هذا التطوّر قد تسبب في منافسة قوية بين الدول انتهت بكارثة الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإن يوتوبيا الدولة الوستفالية لم يسقط بل على العكس، أصبح محور النظام العالمي الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة.
لكنَّ الوضع بدأ بالتغير منذ السبعينيات من القرن العشرين. وكان لوسائل التواصل دور مهم في هذا التغير. يمكن على سبيل المثال أن نقارن بين النتائج المترتبة على ظهور سكك الحديد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتلك المترتبة على انتشار الإنترنت في النصف الثاني من القرن العشرين. فلقد ساهمت سكك الحديد في صهر فئات الشعب الواحد وتقريب الشقة بين أنحاء الوطن الواحد، فأسهمت بذلك في دعم يوتوبيا الدولة الوطنية. أما الإنترنت فإنها تفكِّك التواصل بين مواطني البلد الواحد بإعادة توزيع معولم للتواصل بين البشر. وإذا كانت سكك الحديد والإنترنت يشتركان في توسيع المبادلات التجارية، فإنهما يختلفان في رسم الإطار العام الذي يحصل فيه هذا التبادل. وبعبارة أخرى، لقد نجحت الدول الوطنية الكبرى سابقا في توظيف العولمة لصالحها، بينما أصبحت هذه العولمة منذ سبعينيات القرن العشرين تعمل ضدّها. لقد انتهت مرحلة التوافق بين الظاهرتين واستبدلت بصراع يهدّد إحداهما، أي الدولة الوطنية التي تمثل عماد المغامرة الحداثية كلها.
لقد بدا -مع الثورة الصناعية- أنَّ يوتوبيا الحداثة قد أصبحت قدرا بشريا جامعا، يوحد الفئات الاجتماعية ويربط بين المصالح الاقتصادية والمصالح الوطنية، ويقلّص الهوة بين المدن والأرياف بفضل وسائل التواصل الحديثة، ويعمّم الطبقة الوسطى في كل مكان. ولم يكن الصراع بين الليبرالية والاشتراكية إلا صراعا بين تأويلين مختلفين لهذه اليوتوبيا. وفي خضم هذا الصراع بين الأيديولوجيتين في القرن العشرين، لم ينتبه كثيرون إلى أنّ الخاسر الأكبر كان المجتمع الزراعي التقليدي الذي انهار تماما، وانهارت معه العديد من القيم التقليدية التي كانت تحقق التجانس في المجتمع العميق. وعلى سبيل المثال، كان عدد المزارعين في فرنسا سنة 1911 يمثل حوالي 42 بالمائة من مجموع القوى العاملة، بينما يمثل المزارعون حاليا أقل من 3 بالمائة من هذا المجموع. ويرى الكاتب أن العالم التقليدي هو الذي كان يرفد المجتمع بالقيم الأساسية التي تمثل "هويته" العميقة، وأن انهياره هو الذي فتح ما يعرف اليوم بأزمات الهوية، لا سيما وقد انفتحت كل المجتمعات على الهجرات المكثفة من الخارج وتعدّدت المنظومات القيمية فيها وتصادمت.
ليست الدولة الوطنية المؤسسة الوحيدة التي تنهار اليوم بسبب العولمة؛ فالمدرسة مثلا كانت ركنا من أركان اليوتوبيا الحداثية منذ بداية المغامرة. صحيح أن المدارس عرفت منذ أقدم العصور، لدى الإغريق مثلا، لكنها كانت في السابق نخبوية لا يرتادها إلا قلة من المواطنين. أما الحداثة فقد طرحت تعميم التعليم وفتحه لكل الفئات وللبنات والبنين، وجعلته يبدأ في مرحلة متقدمة من حياة الإنسان وينتهي في مرحلة متأخرة نسبيا، فكان وسيلة انصهار قوية للشعوب. وقد ارتبط التعليم الحديث بتغليب الكتابة على كل أشكال التواصل الأخرى، وعقلنة الفعل التواصلي عبر تقنين النشاط المكتوب. لكن التعليم يفقد اليوم وظيفته الانصهارية أمام وسائل التواصل الجديدة التي تقوم على المشافهة وتعيد الغلبة للملفوظ على المقروء، وتزعزع التنظيم المعقلن للتواصل العام وتحوله من الاستدلال إلى الانفعال (يمكن أن نرى نتائج ذلك بوضوح في المجال السياسي؛ حيث أصبحت الانتخابات تدور حول إثارة انفعالات الناخبين بدل دفعهم إلى التفكير المعقلن في برامج المترشحين). فكأن الثقافات الشعبية الشفهية قد ثأرت لنفسها بعد أن أعلنت الحداثة موتها منذ ظهور الطباعة وتعميم فكرة المعارف الكونية الجامعة.
لقد مثل ظهور وسائل التواصل الجماهيري ثم الاجتماعي ضربة قوية لليوتوبيا الحداثية بأن أعاد الكاريزما إلى المجال السياسي. وكم يبدو بعيدا اليوم ذاك التقسيم الذي وضعه ماكس فيبر، في قمة ازدهار الحداثة، بين الحكم التقليدي القائم على الكاريزما والزعامة، والحكم الحديث القائم على العقلنة (نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة يمكن أن تضاف شاهدا حاسما في استدلالات الكاتب في هذا الموضوع). فهذا العالم الكبير في علم الاجتماع لم يتوقع ظهور القنوات الفضائية والإنترنت ليشهد عودة المشافهة والخطابة في أحدث الوسائل التقنية، ما يترتب على ذلك من سيادة منطق الانفعال على منطق التعقل، واستعادة الذاكرات الشخصية والفئوية على حساب المصالح الوطنية أو المبادئ الكونية.
ولم تضعف الحداثة نتيجة هذا التغير في العلاقة بالعولمة فحسب؛ فثمة أيضا عوامل "داخلية" يستعرضها الكاتب، منها ظهور فلسفات ما بعد الحداثة منذ شوبنهور ونيتشة، وفلسفات الارتياب مع ماركس وفرويد، والثورة العلمية الثانية المرتبطة بنظرية النسبية والفيزياء الكوانتية، ومنها خيبات الأمل التي نتجت عن الحروب المدمرة والمشاريع الاستعمارية. فقد عصفت مثل هذه العوامل بالإيمان بالعلم والتقدم بل أصبح العلم في قفص الاتهام لأنه تحول أحيانا إلى نقمة على البشر؛ فهو مصدر الأسلحة الفتاكة والمواد السامة التي تهدّد البيئة والتخلص من العمال باستبدالهم بالآلات...إلخ. فهيأت هذه السياقات بدورها المجال أمام تحقيق الغلبة للعولمة على الحداثة، مع أن بعضا مما ينسب إلى الحداثة من آفات هو من ذنوب العولمة.
هكذا انتقلت العلاقة بين العولمة والحديثة من الاحتواء إلى التناقض؛ فالعولمة التي نشأت مع الاكتشافات الكبرى ووفرت الأموال الضخمة لتحقيق تحولات نوعية في حياة البشر منحتهم ازدهارا أعطى الانطباع بانتصار نهائي لمشروع الحداثة الذي طرحه الفلاسفة والمنظرون بداية من القرن السابع عشر، هي التي تقوم منذ سبعينيات القرن العشرين بوظيفة عكسية، إذ تعطي الانطباع المعاكس باستنفاذ هذه اليوتوبيا الجديدة تاريخيا كما استنفذت يوتوبيات أخرى قبلها. وما أزمات الدولة الوطنية اليوم، أو التعليم، أو البطالة، إلاّ نتائج مباشرة لهذا التحوّل العميق.
بَيْد أنَّ الكاتب لا يخصص إلا الفقرات الأخيرة من كتابه للتفكير في مستقبل هذا الوضع. وهو يرى أنّ العولمة لا تحمل بديلا عن الحداثة فلذلك يقترح تدارك الأوضاع و"تعديل" اليوتوبيا الحداثية كي لا تنهار تماما. والواقع أنّ هذا الكتاب ينبغي أن يفتح نقاشا حول المستقبل أوسع بكثير مما يرد في صفحاته الأخيرة؛ لأنَّ لُب الموضوع هو بالذات غياب البديل. ما هو البديل المطروح اليوم عن الدولة الوطنية سوى الفوضى الاقتصادية والسياسة؟ وما هو البديل عن تعميم التعليم سوى انتشار الجهل والتطرف؟ وما هو البديل عن الدور التعديلي للدولة في الاقتصاد سوى قانون الغاب وتدهور مستوى عيش قطاعات واسعة في المجتمع؟
أم أنه يمكن أن نتصوّر العالم يعيش مستقبلا دون يوتوبيا ومثل عليا، وينظم نفسه حسب موازين القوى الواقعية أو الافتراضية التي تخلقها وسائل التواصل الجماهيري والاجتماعي؟ هل نصل هنا إلى نهاية التاريخ بنهاية اليوتوبيا بكل أشكالها، إذا سلمنا مع الكاتب أن الحداثة يوتوبيا اجتماعية ومغامرة غربية استمرت أربعة قرون؟
أم أنه يمكن أن نتصور مسلكا ثالثا، يتمثل في نشأة يوتوبيات عديدة في عصر العولمة الجامعة، وأن نهاية المغامرة الغربية هي بداية مغامرات أخرى "قطاعية"، تعلن نهاية سيطرة أوروبا على التخيل البشري للمجتمع والمعرفة؟
.. إنَّ المعطيات المكثفة التي جمعها المؤلف في كتابه تمثل في كل الحالات مدخلا متميزا لفتح حوار فلسفي وحضاري عميق حول مجموع هذه الإشكالات، وهي بالتأكيد إشكالات موحدة بين البشر وإن لم تكن حلولها بالضرورة موحدة بينهم.
------------------------------
- الكتاب: "المغامرة الغربية: الحداثة والعولمة".
- المؤلف: بول كلافال.
- الناشر: منشورات العلوم الإنسانية، باريس، 2016.
- اللغة: الفرنسية.