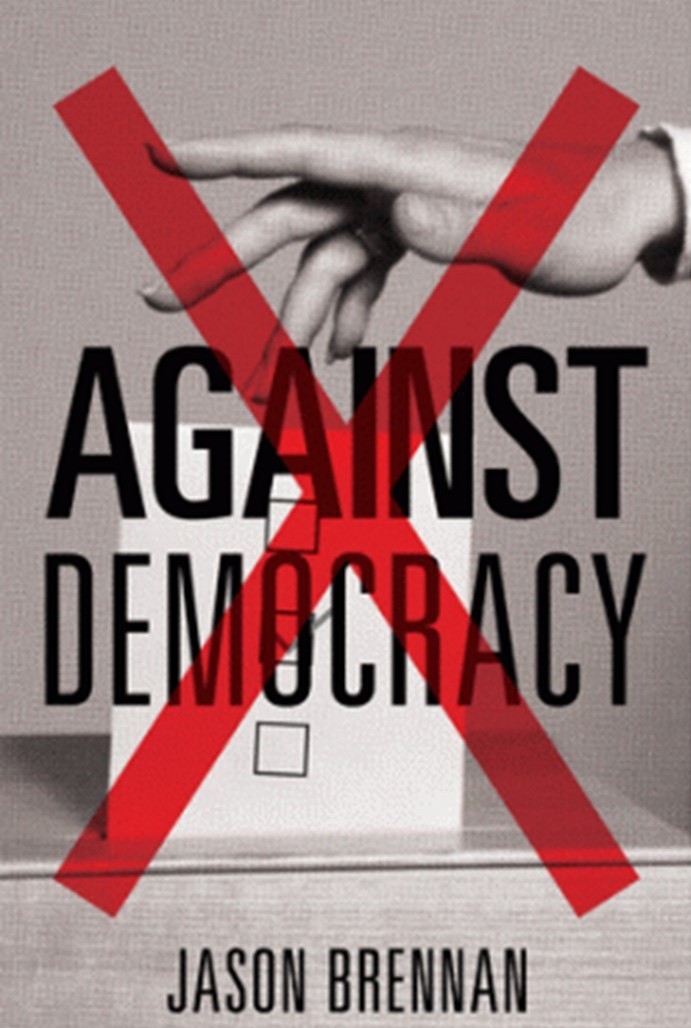لجيسون برينان
مُحمَّد الشيخ
أَن يكتب الفلاسفة القدماء ضد الديمقراطية؛ فذلك أمرٌ عهدناه منذ أيام أفلاطون وأرسطو حتى أيام فلاسفة الإسلام -من الفارابي إلى ابن رشد- فما بعد. لكن أن يكتب الفلاسفة المعاصرون اليوم ضد الديمقراطية، فهذا ما لم نعهد له من مثيل اللهم إلا في ما ندر. ولقد كان الفيلسوف السياسي الأمريكي المعاصر جيسون برينان بدعا من هذا. وهو الفيلسوف الذي يشتغل بحقول نظر أربعة: الفلسفة السياسية، والأخلاقيات التطبيقية، والفلسفة العامة، والاقتصاد. ويهتم بمجالات منها مخصوصة: أخلاقيات التصويت، والحرية السياسية، والنظرية الديمقراطية، والفضيلة المدنية، والتجارة والأخلاق، ونقط تلاقي السياسة والفلسفة والاقتصاد، والاقتصاد السياسي، والواجبات والكفاءة والنية الحسنة، وحسن استعمال السلطة والنفوذ وسوء استخدامهما. وهو الرجل الذي يعمل حاليا أستاذا للإستراتيجية والاقتصاد والأخلاقيات والسياسة العمومية بجامعة جورج تاون الأمريكية.
يروي صاحبنا في ديباجة كتابه هذا -الذي لا محالة أنه محدث لجدل واسع في أوساط فلاسفة السياسة وعلمائها ومفكريها بالغرب، وقد أعلن الألمان والبرتغاليون والإيطاليون والسويديون عن تعاقدهم مع المؤلف قصد ترجمة الكتاب وإخراجه إلى الوجود في هذه اللغات عام 2017- يروي كيف أنه منذ عقد من الزمن اكتشف أن أغلب نظريات الديمقراطية إنما هي نظريات باعثة على الحيرة أشد حيرة تكون. إذ يبدو أن الفلاسفة والمنظرين السياسيين مأخوذون برمزية وتعبيرية ومثالية الديمقراطية أكثر مما هم مهتمون بإشكالاتها ومعضلاتها. فهم ما يفتؤون ينشؤون النظريات المثالية في المسار الديمقراطي تلو النظريات التي لا تكاد تشبه بأي شبه عالم الديمقراطية الواقعي، اللهم إلا فيما قل ولم يدل. والذي يعلنه جيسون برينان في وجه هؤلاء جميعا قاطعا في هذا لا يكاد يستثني: "كلا، ما كانت الديمقراطية قصيدة شعرية"!
ثم إنَّه بعد ذلك، أدرك أن عدم رضاه عن النظرية الديمقراطية الفلسفية، كان داعيا مهما إلا الاشتغال في هذا المضمار -مضمار الديمقراطية- بدلًا من الانسلال منه. لذلك؛ يرى أنه على الأقل تحتاج النظرية الديمقراطية إلى امرئ واحد يلعب دور "محامي الشيطان". وما كان هذا الشيطان سوى "نقد" الديمقراطية نفسه. ويعلق جيسون برينان ساخرا: "على الرغم من أني سعيد بلعب هذا الدور، فإني -وفي إطار الموضة الشيطانية الحقيقية- أمسيت أشك فيما إذا كنتُ الآن أدافع حقا عن الشيطان، هذا بينما الفلاسفة والمنظرون السياسيون يُفترض أنهم يدافعون عن الملائكة"!
والحال أنه ما كان نقده للديمقراطية سوى الشجرة التي تخفي الغابة، وما كانت هذه الغابة في تقديره سوى السياسة نفسها؛ إذ إنَّ ثمة ثلاثة "نقود" متلازمة عنده متداخلة تداخل الدمى الروسية في بعضها البعض: نقد مبدأ "الحق في التصويت" الذي كان قد أفرد إليه كتابيْن: "أخلاقيات التصويت" (2011)، و"التصويت الإجباري: مع وضد" (2014)، ونقد الديمقراطية، ونقد السياسة. وهذا الكتاب ينساق ضمن هذا السياق الثلاثي. ففي كتاب "التصويت الإجباري" يدافع الفيلسوف السياسي عن فكرة أن إجبار الناس على التصويت، على نحو ما يفعل في العديد من الدول، أمر لا مبرر له ولا مسوِّغ بأي حال من الأحوال. وفي كتاب "أخلاقيات التصويت" يذهب إلى القول بأن أفضل طريقة إلى ممارسة الفضيلة المدنية إنما تقع خارج مضمار السياسة، وبأن أغلب المواطنين لهم إلزام أخلاقي بالامتناع عن التصويت لا بالتصويت؛ وذلك على الرغم من أن لهم حق التصويت. أما كتابه هذا -"ضد الديمقراطية" (2016)- فيخطو فيه خطوة أبعد؛ بحيث يُهاجم السياسة نفسها مهاجمة راديكالية. وذلك حتى كاد أن يسمي كتابه -باعترافه هو- "ضد السياسة". إذ يرى أن العديد من الباحثين لهم نظرة رومانسية إلى السياسة: من شأن السياسة أنها هي ما يجمعنا ويوحدنا ويهذبنا ويشذبنا ويجعل منا أصدقاء مدنيين، بينما يرى أنَّ السياسة تقوم بأضداد هذه: من أمر السياسة أنها تعزلنا عن بعضنا البعض وتبلدنا وتفسدنا وتصنع منا أعداء مدنيين لبعضنا البعض! ولهذا، فإنه من الناحية المبدئية لا ينبغي للسياسة أن تحتل إلا منزلة ضئيلة في حياة الفرد، وعلى أغلب الناس أن يمضوا سحابة يومهم في التعاطي إلى الرسم والشعر والموسيقى والمعمار والنحت وكرة القدم... وذلك لما عرف عن المشاركة في السياسة من مفاسد.
ولئن هي كانت العديد من الكتب المؤلفة عن الديمقراطية والانخراط المدني تشتكي من تدني مستوى المشاركة في الانتخابات، وتعزو السبب في ذلك إلى أن المواطنين ما عادوا يأخذون مسؤولياتهم في حكم ذاتهم -وهذا هو المعنى الأصلي للديمقراطية- مأخذ الجد، فإن جواب برينان مختلف باختلاف شديد ومفاجئ: إن في أفول الانخراط السياسي علامة مشجعة على بداية جديدة، لكن أمامنا طريق طويل وشاق علينا أن نسلكه: أن ننتقل من نظام حكم "الديمقراطية" -حكم الشعب بما فيه دهماء الشعب- إلى نظام حكم ما يسميه "الإبستقراطية" -أو "الكفائية" أو "الدرائية"- التي هي حكم أهل الخبرة والكفاءة والدراية والحنكة والبصيرة والحكمة.
ومنطلق برينان أنَّ الناس يختلفون في صلتهم باعتقاداتهم السياسية اختلافا بيِّنا: بعضهم يتعصب لها وبعضهم لا، ويختلفون في عدد هذه الآراء: بعضهم له رأي في كل شيء، وبعضهم لا رأي له في أي شيء، ويتباينون في إسناد رأيهم: بعضهم بإسناد قوي، وبعضهم بلا سند. ويختلفون في طريقة جوابهم عن مخالفيهم: البعض يشيطن مخالفيه والبعض لا، والبعض يُحَمّقهم والبعض لا. فالاختلاف شائع. لكن هلَّا أمكن اختزاله في نماذج؟
هو ذا التحدي الأكبر في هذا الكتاب: هل من صنافة للناس في علاقتهم بالسياسة؟ الذي عند المؤلف أن الناس على ثلاث فرق، وكل فرقة تحمل، عنده، أسماء عجيبة غريبة: فرقة يسميها فرقة "الهوبيتس" (Hobbits) -أو سكان الحفر- واسمها مستوحى من رواية الكاتب البريطاني تولكين الفنتازية "سيد الخواتيم"؛ حيث يدل هذا الاسم على قوم من الأقزام كثيفي الشعر الذي ينمو على أرجلهم، وذوي آذان حادة وأوجه شديدة الحمرة. والحق أن أغلب الناس، عنده، من هذا الصنف: جاهلون هم بالسياسة غير مبالين بها. يفتقدون إلى آراء قوية في مجمل المسائل السياسية التي تكون حاسمة وثابتة. ولا معرفة لهم اجتماعية علمية بالعالم المحيط بهم؛ بحيث يكادون يجهلون كل شيء. وهم يفضلون حياتهم اليومية دون أن يولوا أية عناية إلى أمور السياسة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن أنموذج غير المصوت هو من هذا الفريق بلا مدافعة.
ثم هناك صنف ثان من الناس مستوحى اسمه هذه المرة من المتعصبين إلى فرق كرة القدم "الهوليغانس" (Hooligans)، وهم على العكس من الفرقة الأولى لهم رؤى للعالم قوية وصلبة وثابتة. لكن أهم ما يميزهم سمتان: الانحياز المفرط والحماسة الزائدة. هم قوم لا يستمعون إلى آراء الآخرين، ولا يبحثون إلا على الحجج التي تزكي قناعاتهم المسبقة. رؤاهم السياسية تشكل جزءا من هويتهم، هم الفخورون بالانتماء إلى طائفة سياسية مغلقة. يميلون إلى احتقار من لا يتبنى مواقفهم، عادّين إياه بليدا شريرا أنانيا، وفي أفضل الأحوال سيء الطوية. ويرى برينان أن أغلب المصوتين بانتظام والمشاركين السياسيين بنشاط، والمنضوين في الأحزاب، والسياسيين، هم من هذا القبيل.
وأخيرا.. ثمة من يسميهم باسم مستوحى من سلسلة خيال علمي تلفزية شهيرة -ستار تريك- "الفيلكنس" (Vulcans)، وهم من الناس من يفكر بعناية وعلمية في أمور السياسة، ويستمدون آراءهم من علوم الاجتماع والسياسة، ملتزمون بالحجة أنى وجدوها فهي ضالتهم، قادرون على فهم مختلف وجهات النظر وعللها، مهتمون بالسياسة من غير هوى، يسعون إلى ألا تستبد بهم منازع السياسة، لا يعتقدون أن من يخالفهم الرأي بليد أو شرير أو أناني أو سيئ النية.
على أن هذه هي الفئة القليلة. أما أغلب الأمريكيين فهم عنده من "الهوبيتس" ومن "الهوليغنس" أو هم بين بين؛ إذ معظم الهوزبيتس هوليغانس بالقوة. وفي كل النزعات السياسية -ديمقراطية أو جمهورية أو حرانية أو فوضوية أو غيرها- تجد هذه الفئات الثلاث حاضرة.
إذا ما نحن أخذنا الناس هذا المأخذ، فأية ديمقراطية يمكن أن تقوم بينهم؟ ثمة نزعة ما تفتأ تعلن انتصار الديمقراطية، وذلك لبعض المزايا التي تجدها لهذا النظام السياسي: منها المزية المعرفية الأداتية التي ترى أن الديمقراطية والمشاركة الموسعة أمر حسن لأنها تنزع نحو الأمر العادل والفعال وتحقق الثمار الثابتة على الأقل إذا ما نحن قارناها بباقي الأنظمة السياسية. ومنها المزية الفضائلية ومقتضاها أن الديمقراطية والمشاركة الديمقراطية الواسعة حسنة لأنها تنزع نحو تربية المواطنين وتنويرهم وتنبيلهم. ومنها المزية الجوانية التي وفق مقتضاها الديمقراطية أمر حسن لأنها غاية في ذاتها. وفي كتابه هذا، يهاجم المؤلف هذه النزعة الانتصارية مبطلا "فضائل" الديمقراطية "المزعومة" واحدة واحدة:
كلا، ما كانت المشاركة السياسية ثمينة بالنسبة إلى معظم الناس، بل بالضد تفعل بالكثير منا القليل من الخير وتلحق به الكثير من الأذى، بل تسعى إلى تبليدنا وإفسادنا وتحويل بعضنا لبعض عدوا.
وكلا، ما كان لأي مواطن كائنا من كان الحق في التصويت أو الترشح لشغل مناصب رسمية، بل علينا بيان ذلك. فالحق في التصويت لأي كان مؤذ أكثر منه نافع؛ إذ من شأن صوت جاهل أن يؤذي غيره بأشد أذى يكون. والحق في التصويت ليس مثل الحريات المدنية الأخرى، كحرية التعبير وحرية التدين وحرية التجمع.
وكلا، ما كانت الديمقراطية الشكل الوحيد الصالح جوانيا للحكم. ذلك أن الاقتراع العام -الذي لا حد له، والذي يتساوى فيه كل من هب ودب- قابل لكي يُعترض عليه أخلاقيا. والمشكلة هي: الاقتراع العام ينزع بمعظم المصوتين إلى اتخاذ قرارات سياسية جهلا، مما يضر بالكثير من الأبرياء. وما ذنبهم إذا كانت الأغلبية جاهلة بحيثيات اختياراتها السياسية؟
وإذ يقر الفيلسوف السياسي أن أفضل المناطق للعيش اليوم هي الديمقراطيات وليس الديكتاتوريات، إلا أنه يلح على أنه لا ينبغي أن نظهر الديمقراطية كما لو كانت هي "المثال الأعلى" أو حتى "أفضل نظام ممكن"، إذ علينا أن نكون قادرين على التخيل والمبادرة والإتيان بالبديل. وما كان هذا البديل عنده سوى ما يسميه "حكم أهل الكفاءة" -الإبستقراطية. والمؤلف لا ينكر أنه يعود إلى أفلاطون -حيث يعلن: "في السنوات الأخيرة عاد أفلاطون عودته"- لكي يزكي فكرة انزعاجه من الناخب الديمقراطي الذي قد يكون بليدا وغير عقلاني التصرف وجاهلا حتى يسمح له بأن يحكم الحكم الجيد. ومنه يستمد الفكرة وإن لم يستمد الاسم: "الإبستقراطية" التي تعني حكم المعرفة والدراية. وعنده أنه يكون حكم ما حكما درائيا وكفائيا -"إبستقراطيا"- بقدر ما تكون السلطة فيه موزعة تبعا للكفاءة والمهارة وحسن الطوية في التصرف حسب منطق المهارة.
على أن نظام حكم أهل الكفاية لا ينبغي أن يحذو نموذج أفلاطون وحاكمه الغريب -الفيلسوف الحاكم أو الفيلسوف الملك- حذو النعل للنعل. إنما حكم أهل الكفاءة صنوف وألوان يعددها المؤلف. وبهذا يعد "الإبستقراطية" التحدي الوحيد الذي يمكنه أن يزيل "الديمقراطية" عن عرشها. وفي كتابه تكمن أطروحته الأساسية في تفنيد القول، أولا، بأن لا خيار إلا الديمقراطية، حيث يرى أن ثمة إمكان خيار -أداتيا وليس غائيا- بين "الديمقراطية" و"الإبستقراطية": أيهما سوف ينجز أكثر ويحقق أعظم في العالم الواقعي. وهو واثق من أن "الإبستقراطية" سوف تتجاوز مقدرة "الديمقراطية" على إثمار نتائج إيجابية، حتى وإن لم تكن لنا حجة -ميتافيزيقية- على أن "الإبستقراطية" تفضل فضلا نهائيا حاسما على "الديمقراطية"؛ وذلك لأنَّ معظم أشكال "الإبستقراطية" لم تُجرَّب ولم تُخبَر إلى حد اليوم.
وعلى هذه الأطروحة الأساسية دارت فصول الكتاب الثمانية، حيث أوضح المؤلف -في الفصل الأول: "الهوبيتس والهوليغانس"- حيثيات وخلفيات تأليفه الكتاب على نحو ما أوضحناها. وأفرد الفصل الثاني -"قوميون جهال غير محيطين بالأخبار الصحيحة"- لمراجعة أدبيات سلوك المصوت. مؤكدا أنَّ أغلب المواطنين والناخبين الديمقراطيين وطنيون قوميون جهل غير عاقلين وغير مطلعين، وكيف أنهم يرتكبون زلات في فهم العديد من القضايا في أساسيات الاقتصاد والاجتماع والسياسة، وكيف أنهم ينزعون إلى التحيز وإلى عدم التعقل، كما يقدم الحجة على أن أغلب المواطنين من صنف "الهوبيتس" والبقية معظمهم من صنف "الهوليغانس". وفي الفصل الثالث -المشاركة السياسية مفسدة"- يُحاجج دفاعا عن فكرة أن المشاركة السياسية تنزع إلى جعل الناس أسوأ وليس أفضل. وحتى الديمقراطية التشاورية لا تعالج الكثير من أمراض الناس، فالتشاور لا ينزع إلى تنبيلنا وإنما إلى تبليدنا. ولا يعود الأمر إلى مجرد جهل الناس بطرق التشاور، بل إلى قلب الديمقراطية نفسها؛ فالدودة توجد في قلب التفاحة. وفي الفصل الرابع -"كلا، ما كانت السياسة لتمنحني السلطة لا أنا ولا أنت"- يُهاجم طائفة من الحجج التي تدعي أن المشاركة السياسية والحق في التصويت أمران صالحان، بداعية أنهما يقوياننا ويمنحاننا السلطة. وهو يرى بالضد أن كل هذه الحجج داحضة. إذ من شأن الديمقراطية أن تعزز تحكم الجماعات لا الأفراد. وفي هذا الفصل وعلى أساس هذه الحجة يهاجم راولز وأتباعه. وفي الفصل الخامس -"كلا، ما كانت السياسة قصيدة شعرية"- ينتقد جُملة من الحجج التي تزعم البرهنة على أن الديمقراطية وحقوق التصويت المتساوية والمشاركة السياسية أمور حسنة وعادلة بحكم ما تعبر عنه أو ترمز إليه. وينتهي إلى التأكيد على أن هذا الصنف من الحجج الرمزي والمبني على التقدير فاشل. صنف يفشل في إظهار أية قيمة حقيقية للحقوق الديمقراطية. كما أن ليس من شأنها أن تقنعنا بأن نفضل "الديمقراطية" على "الإبستقراطية". وفي الفصل السادس -"الحق في حكومة ذات كفاءة"- يدافع عما يسميه "مبدأ الكفاءة" الذي يرى أن الرهان في القرارات السياسية افتراض أنها غير عادلة وغير مشروعة وتفتقد إلى القوة الإلزامية إذا ما هي تم سنها سنا غير كفء، أو عن سوء نية. ويهاجم الديمقراطيات على أساس أنها تخرق مبدأ الكفاءة خرقا خلال الانتخابات. وفي الفصل السابع -"هل الديمقراطية ذات كفاءة؟"- يناقش بعض أجوبة دعاة الديمقراطية الذين يرون أن الهيئة الانتخابية في مجملها تميل إلى اتخاذ قرارات ذات كفاءة حتى وإن كان العدد العديد من الناخبة جاهلا. وهو يفند كل هذه المزاعم وسندها في الرياضيات الاحتمالية. وفي الفصل الثامن -"دور العارفين"- يشير إلى مختلف السبل لإقامة حكم "الإبستقراطية" الذي يبشر به، ويناقش بعض المزايا والمخاطر الممكنة لمختلف أشكال نظام الحكم هذا، كما يجيب عن العديد من الاعتراضات. وفي الفصل الأخير -"الأعداء المدنيون"- والذي هو عبارة عن "ذيل وتكملة"، يُعيد التأكيد على أن المؤسف في السياسة أنها تجعل منا أعداء مدنيين لبعضنا البعض، وذلك لا فحسب بحكم أننا عادة ما نكون منحازين وقبليين، وأننا ننزع إلى كراهية أولئك الذين لا يوافقونا الرأي لا لشيء إلا لأنهم لا يوافقونا الرأي، وإنما بالأحرى لأن بنية السياسة تفرض علينا أن نتخاصم، ولأن معظم مواطنينا يتخذون قرارات غير ذات كفاءة. ولهذا يدعو إلى توسيع مجال المجتمع المدني وتضييق مجال المجتمع السياسي. وتلك وصيته الأخيرة في هذا الكتاب.
-----------------------
- الكتاب: "ضد الديمقراطية".
- المؤلف: جيسون برينان.
الناشر: مطابع جامعة برينستون - 2016.
- عدد الصفحات: 288 صفحة.