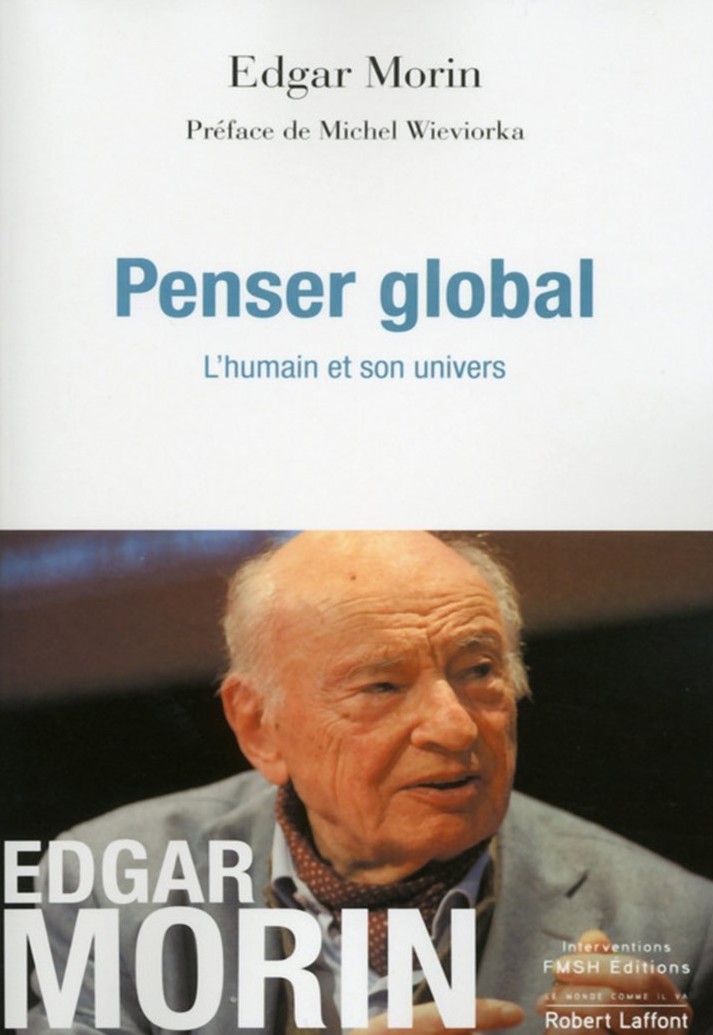لإدغار موران
مُحمَّد الحدَّاد
تُمثل المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع رافدا رئيسيا لهذا العلم، منذ أن أسهم مؤسسها أميل دوركايم (1858-1917) مُساهمة فاعلة في وضع أسسه ومفاهيمه. وفي العصر الحالي، احتلَّ مُفكران من هذه المدرسة مكانة بارزة عالميا؛ هما: "آلان توران" و"إدغار موران". وكنا قد قدَّمنا في عدد سابق الكتاب الأخير لتوران بعنوان "نحن..الذوات الإنسانية"، (عدد فبراير)، ونقدِّم هنا الكتاب الأخير لموران بعنوان "التفكير بشمولية" (باريس-2015)؛ لأنه جاء مثل سابقه، بمثابة الجمع التأليفي للأفكار الكبرى لكاتبه، بعد سبعين سنة من البحث والتأليف؛ استنادا إلى أهم المقولات التي صاغها في مؤلفاته السابقة، وقد تجاوزتْ الستين كتابا، وتُرجمت إلى 28 لغة؛ أهمها: سلسلة في ستة أجزاء عنوانها "المنهج"، وكتاب "الفكر المتشعب"، وقد حاز بفضلها إدغار موران على ثلاثين دكتوراه شرفية من مختلف جامعات العالم.
إنَّ التفكير بشمولية -وهو موضوع الكتاب- يعني أيضا الرؤية الشاملة التي توصل إليها الكاتب بعد عقود من التفكير. لقد نشأ علم الاجتماع في الأصل ليدرس تشكل المجتمع الصناعي، ثم اتسع بعد الحرب العالمية الثانية لتحليل كل المجتمعات وأنماط إنتاجها وعيشها. لكن موران يسعى في هذا الكتاب إلى ما هو أبعد من ذلك، أي تحويل علم الاجتماع إلى نوع من الدراسة الشاملة للإنسان والإنسانية. ومن ثمَّ، يُمثل كتابه دعوة إلى تحويل علم الاجتماع إلى نوع من الفلسفة الحديثة، مدارها التفكير في ماهية الإنسان ومصير الإنسانية.
ولكن: ما الإنسان؟ يتأسف موران لغياب هذا السؤال عن أنظمتنا التعليمية؛ إذ يقع عادة الفصل بين المكونات الثلاثة للإنسانية: البيولوجي والنفسي والاجتماعي، ويدرس كل منهما على حدة في علم من العلوم، ويترتب على هذه الوضعية انتشار رؤية اختزالية للإنسانية. وحتى الإنتربولوجيا (علم الإناسة) لم تنجح في لم شتات هذه الرؤية، فقد تقرر بصفة اعتباطية تخصيصها لدراسة الأطوار المدعوة بالبدائية للإنسان، فأسهمت بدورها في هذا الاختزال بالفصل بين عهد يعتبر بدائيا وعهد متطور.
لم يعد مقبولا اليوم أن تظل العلوم تعمل منفصلة عن بعضها البعض؛ فالإنسان كائن بيولوجي ونفسي واجتماعي في الآن ذاته، وينبغي أن تتضافر الاختصاصات الثلاثة لتقديم رؤية شاملة وجامعة بشأنه. كما يتعين ربط الإنسان بالكون الذي هو جزء منه وترسيخ الشعور لديه بأن مصيره مرتبط بمصير البيئة التي يعيش فيها وبفضلها. ولقد كان من الخطأ أن تتحول قضية حماية البيئة إلى قضية سياسية وحزبية وكأنها تهم جزءا من البشر دون الآخرين.
علينا أن ندرك -في ضوء الاكتشافات العلمية الأكثر جدة- أنَّ خلايا الإنسان تحمل في ذاتها مكونات بيئته وآثار تاريخه الطويل، وهي تنسف التقسيمات والاختصاصات التي تعتمدها الأنظمة التعليمية والتي كثيرا ما تؤدي إلى منازعات مفتعلة ونقاشات بيزنطية بسبب محاولات كل اختصاص الاستئثار بالقدر الأكبر من القضايا واختزال الموضوع الإنساني في زاوية تحليله.
إنَّ الإنسانية لا تختزل في الذات ("الأنا")؛ فهي أيضا الشعور بالانتماء الجماعي الذي يبدأ مع المولود منذ اللحظات الأولى من ولادته، عندما يسعى لتحسُّس المحيطين به ويشعر بضرورة التواصل معهم عاطفيا، ولولا الطمأنينية التي توفرها ألفة الأصوات والروائح حوله لما كان قادرا على الرضاع والنوم، أي أن البعد الاجتماعي للإنسان ينشأ منذ اللحظات الأولى لوجوده وهو الذي يُسهم في تمكينه من الحياة والنمو. وبالمثل، فإنه يعد من باب الاختزال ما وقع التعارف عليه إلى حد الآن من أن بداية الإنسانية قد مثلها "الإنسان العاقل" (Homo sapiens)؛ فالعقل رافد من إنسانية الإنسان لكنه ليس الرافد الوحيد، يوجد أيضا "الإنسان الهاذي أو الجامح" (Homo demens)، الذي يعيش بفضل العاطفة والخيال والضحك. وبين الحاجة للعقل الصارم والحاجة للجموح، تنشأ إنسانية متوازنة تقوم على إرادة الاستكشاف وعلى العاطفة في الآن ذاته. ولو أخذنا أكبر عالم رياضيات وافترضنا أنه يقضي كل حياته في حل المعادلات الرياضية وينظر إلى الكون كله على أنه سلسلة من المعادلات، فإن السؤال الذي يظل عالقا هو التالي: ما الدافع إلى كل هذا الولع بالرياضيات؟ والجواب لا يمكن أن يكون عقليا بل عاطفيا، فعلاقته بالرياضيات هي من صنف علاقة شخص آخر مغرم بكرة القدم مثلا، إنها علاقة تأسَّست على العاطفة، وجموح لا يقوم في ذاته على قاعدة منطقية وعقلية.
كأن إدغار موران يسعى -دون أن يصرح- إلى نسف الكوجيتو الديكارتي "أنا أفكر إذن أنا موجود"، ليؤكد أن الإنسان موجود بالعاطفة أيضا، ودون هذه العاطفة لا يتحقق له الوجود، فليس الكوجيتو إلا صيغة من صياغات الاختزال الفلسفي الحديث للحقيقة الإنسانية.
ومن هنا، يدعو موران إلى الاهتمام بالتاريخ العريق للعقائد والأديان، وهو تاريخ قد همش نتيجة اختزال الإنسانية في التفكير العقلاني والأداء التقني؛ فالإنسان يحتاج في الحقيقة إلى أكثر من ذلك، قديما وراهنا. ومنذ الآثار الأولى الباقية شاهدا على وجود الإنسان على البسيطة، يتبين أنه كان يدفن بسلاحه وببعض المؤونة، بما يؤكد أن الإنسان قد آمن منذ الأزل بحياة أخرى بعد الموت. ولم يفلح التقدم التقني في حجب هذا الشعور لديه إلى اليوم، بدليل أن أكثر بلد متطور تقنيا وهو الولايات المتحدة الأمريكية هو أيضا البلد الذي يضطلع فيه الدين بدور قوي في السياسة والمجتمع. بل إن العودة إلى الأديان، كما نشهدها حاليا، إنما تأتي نتيجة فشل الأيديولوجيات التي أرادت أن تصبح أديانا علمانية، وأبرزها الشيوعية. فعندما تأكد البشر من زيف وعود المجتمع المثالي كما تعد به الشيوعية، عادوا إلى أديانهم المعهودة، رغم أن التطور التقني حاليا أكبر بكثير مما كان عليه عند ظهور الفلسفة الشيوعية. وهذا ما يؤكد أن الشعور الديني لا تحكمه تطورات التقنية.
وليس الإنسان أيضا كائنا اقتصاديا (Homo economicus) يتحدد سلوكه بالحساب البارد للربح والخسارة. فالجموح الذي هو خاصة الإنسان كما رأينا، يجعل منه كائنا مغامرا، وقد يتخذ العديد من القرارات التي تؤدي إلى الخسارة بدافع الرغبة في المغامرة. وهكذا فإن طغيان الاقتصاد حاليا لم يؤد إلى طغيان منطق الربح والخسارة بقدر ما أدى إلى منطق المغامرة. فاقتصاد اليوم أصبح قائما على المضاربة التي هي مغامرة ومقامرة. والشخص الذي يضارب في البورصات يتصرف مثل المعجب بفريق كرة قدم، إنه يتصرف بالولع والجموح وليس بالعقل وحساب الربح والخسارة.
ولئن كنا اليوم نشكو من هيمنة الاقتصاد على السياسية، فإن استعادة التوازن لا تحصل -حسب الكاتب- بالعودة إلى السياسة المعقلنة والقائمة على التخطيط، بل بتوجيه الولع الإنساني إلى الآداب والفنون؛ حيث يجد الإنسان ما لا يقدر الاقتصاد والسياسية معا على توفيره، أي متعة أن يعيش حياته بشاعرية. وللتعليم دور مهم في دفعه بهذا الاتجاه، فلئن كان من المهم أن يحصل الفرد على مجموعة من المعارف يستعملها لاحقا للعمل، فإن الحياة لا يمكن أن تختزل في العمل فحسب، ولا السعادة أن تختزل في مجموعة من المعطيات الرقمية الجافة مثل معدلات النمو والفقر. إنَّ التعليم الحقيقي هو الذي يمنح الفرد مجموعة من الكفاءات كي يتفادي الخطأ ما أمكن، وشرط النجاح توفير الانفتاح الذهني والقدرة على التمييز والتمحيص.
ويُطالب موران -بكل صراحة- بمراجعة إعلان نهاية السرديات الكبرى؛ ذلك الإعلان الذي قام عليه فكر ما بعد الحداثة منذ أن صاغه فرنسوا ليوتار في كتاب مشهور. ففي الفترة ذاتها التي ظهر فيها هذا الإعلان، كانت قد بدأت تتشكل سردية جديدة هي الأكبر في تاريخ الإنسانية، تنطلق من المعطيات العلمية المتاحة حول الكون والإنسان، وقد تكون هي السردية التي يحتاجها الإنسان اليوم إذا طرحت متكاملة لا مجزأة ومختزلة.
لقد أثبتتْ البشرية قدرة كبيرة على التكُّيف، وانتقل الإنسان من عصر الصيد والرعي إلى العصر الزراعي، ثم منه إلى العصر الصناعي، وانتظم سياسيا في نظام الدولة-المدينة ثم في النظام الإمبراطوري، ثم أنشأ حديثا نظام الدولة الوطنية القائمة على فضاء جغرافي أوسع من المدينة وأصغر من الإمبراطورية. ولقد نجحت العديد من المجموعات البشرية في الاندماج ببعضها البعض لتشكل أمما، بينما فشلت أخرى في الاندماج أو لم تجد الوقت الكافي لتحقيق ذلك، فتردت في النزاعات والحروب. وهكذا فإن الأزمات التي يشهدها العالم لا تعدو أن تكون نتائج طبيعية لتطوره، والأشكال التي أصبحت اليوم مقبولة على نطاق واسع، كانت تمثل استثناء وبدعة عند ظهورها، مثل الدولة الوطنية التي بدأت في الظهور أولا في بعض أجزاء من القارة الأوروبية، ومثل الثورة الصناعية التي نشأت في إنجلترا. بل إنَّ هذه المعاينة تنسحب أيضا على الماضي؛ فالأديان الكبرى مثل البوذية والمسيحية والإسلام كانت في بداياتها خروجا عن السائد والمألوف. فالتجديد هو قانون التاريخ والأزمات جزء منه، مثلما أن تجديد الخلايا في الجسم هو قانون التطور البيولوجي. بيد أن التطور لا يمثل أبدا خطا مستقيما يمكن التنبؤ مسبقا بمساره، والعلم يفكك ألغاز التاريخ والطبيعة، لكنه لا يفسر أسرار هذا وذاك. فلا بد من القبول بمساحة للشك تحكمها عناصر من غير الممكن توقعها أو التحكم فيها كليا.
هذا مثلا هو مصير العولمة التي يرى الكاتب أنها ظاهرة حصلت أكثر من مرة في التاريخ، أولها مع ظهور نشاط الزراعة في الشرق الأوسط وامتداد هذا النشاط في العالم كله، وثانيها عند اكتشاف كولمبوس للقارة الأمريكية، وثالثها في فترة الحرب العالمية والمستعمرات، وأخيرا العولمة الرابعة التي نعيشها اليوم وقد بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وقامت على أساس عولمة التقنية ووسائل الاتصال. لكن في الوقت الذي تعولم فيه الاقتصاد والتواصل تضاعفت فرص انهيار المجتمعات والأوطان، بما لم يكن متاحا لأحد أن يتوقعه في البداية. فالعولمة قد فرضت نمطا غربيا على العالم فدفعت مجموعات عديدة إلى التعبير عن الرفض والمقاومة والمطالبة بحقوقها الثقافية والتمسك بتميزها أمام هذا السيل الجارف. يكفي أن نراجع مثلا كتاب "آلان مينك" الصادر سنة 1997 بعنوان "العولمة السعيدة" كي نرى الفارق بين أحلام البداية وواقع اليوم.
ما هي حينئذ آفاق المستقبل؟ يَرَى الكاتب أن العولمة لئن وفرت مكاسب لجزء من البشرية فإنها دفعت أيضا لسيطرة اقتصاد تتحكم فيه المضاربة ولم يعد خاضعا لتحكم هيئات محلية أو عالمية. والعالم يعيش حاليا أزمة حضارية وليس من المتأكد الخروج منها قريبا. لكن علينا أن نتذكر أن التاريخ تصنعه أيضا الصدف: لقد تغير الاقتصاد العالمي سنة 1973 بسبب الأزمة النفطية، وتغير النظام العالمي سنة 1989 بسبب سقوط حائط برلين، وتغير الأمن العالمي سنة 2001 بسبب الهجومات الإرهابية على مركز التجارة العالمي، وتغير النظام المالي العالمي سنة 2008 بسبب أزمة القروض، وتغيرت العلاقة بين الشمال والجنوب سنة 2011 بسبب أحداث الربيع العربي. كل هذه الوقائع لم يتوقعها أحد قبل وقوعها؛ لذلك من غير المرجح أن يخبرنا أحد عن سيناريو الخروح من الأزمة الحضارية الراهنة. والأمر المتأكَّد أن التاريخ لا يتطور باتجاه واحد وخطي، ولا يمكن أن توجد اليوم إلا توقعات قطاعية، أي توقعات في ميدان محدد مثل الاقتصاد أو الأمن، لكن هذا الصنف من التوقعات كثيرا ما يخيب لأنه يستند إلى جزء من النشاط الإنساني دون تطور الإنسانية كلها.
ومع ذلك، يُحاول الكاتب رصد بعض الأطروحات حول المستقبل. الأولى أطروحة نهاية التاريخ، بمعنى بلوغ الإنسانية أفضل نظام سياسي ممكن وهو الديمقراطية التمثيلية وأفضل نظام اقتصادي ممكن وهو اقتصاد السوق. ويرفض الكاتب هذه الأطروحة ويرى أن النهاية المطلوبة إنما هي نهاية الصراعات والحروب بين البشر، وأن أفكارا جديدة قد تظهر في المستقبل لتحقيق هذه الغاية. والثانية أطروحة صراع الحضارات، ويشكك أيضا في قيمتها، لأن الصراعات الحالية لئن بدت في بعض المناطق دينية، كما هو الشأن في الشرق الأوسط، فإن العولمة قد حققت في مناطق أخرى من العالم تآلفا بين مجموعات مختلفة دينيا وثقافيا. ثم إنه لا يمكن الجزم بأن صراعات الشرق الأوسط صراعات دينية، ناهيك عن أنها تحدث جزئيا داخل دين واحد وحضارة واحدة، وتواجه بين المسلمين المعتدلين والمسلمين المتطرفين المنتمين للقاعدة و"داعش".
ويُدافع الكاتب عن أطروحة ثالثة وهي أنَّ مُستقبل الإنسانية سيتحدد بالعلاقة بالبيئة التي أصبحت مهددة، ولا بد من إيقاف تدهورها، وأنه لا مناص من تحقيق تغيرات نوعية لا تقتصر على الإجراءات المعهودة لحماية البيئة، بل تتعداها إلى تغيير جذري في النمط السائد عالميا في الانتاج والاستهلاك. فلا بد من الحد الطوعي من النمو الاقتصادي والتكالب على الاستهلاك للمحافظة على الحد الأدنى من التوازن البيئي العالمي.
ثمَّة حينئذ تحديات ضخمة مطروحة اليوم، وضرورات لا بد من التسريع بإنجازها، ولا توجد نهاية ولا صراع، وإنما هي مرحلة حضارية جديدة ينبغي الاستعداد لمواجهتها عالميا. فهل ينبغي أن نتفاءل أم نتشاءم بقابلية الإنسانية على رفع هذا التحدي؟ من الطريف أن نجد الكاتب يصنع ما صنعه الروائي العربي أميل حبيبي، فينحت في لغته كلمة مستحدثة تؤدي معنى كلمة "متشائل". وهو يصر على التأكيد على أن أفضل وسيلة للنجاح في رفع التحدي هي المراجعة الشاملة والإصلاح الجذري في نظم التربية والتعليم. ويؤكد على ضرورة التخلص من الرؤى الجزئية والاختزالية التي ما يفتأ يقدمها الخبراء في المجالات المختلفة، وإعداد خبراء ينظرون إلى الإنسان والوقائع الإنسانية في شموليتها، وعلى ضرورة التخلص من المعنى الاختزالي لكلمة "أزمة" المستعملة بإفراط، واعتبار ما ندعوه بالأزمة أنها هو نتيجة تحولات عميقة سيحدد المستقبل نتائجها. إنَّ استعمالنا المفرط لكلمة "أزمة" يعود إلى كوننا نقارن بالماضي أكثر مما نحاول فهم هذه التحولات واستشرافها في المستقبل. وإذا كان ثمة من عناصر تفاؤل في الوضع الحالي، فهي تعود أساسا إلى ما تبشر به البيو-تكنولوجيا والنانو-تكنولوجيا من إمكانيات؛ إذ يمكن للأولى أن تقدم في المستقبل حلولا جذرية لمشاكل الغذاء في العالم، والثانية أن تساعد البشر على إنجاز العديد من الخدمات اليومية. لكن يمكن أيضا لهذا وذاك أن ينفلتا ويفتحا المجال لمخاطر جديدة على حياة البشر لا يمكن توقعها الآن. يكفي أن نتعظ بتجربة التواصل على الإنترنت التي فتحت للبشر مجالا واسعا للحرية، والحصول على المعلومات، لكنها جعلتهم أيضا مراقبين في حركاتهم وسكناتهم من أطراف خفية لا يمكن دائما تحديدها.
--------------------------
- الكتاب: "التفكير بشمولية".
- المؤلف: إدغار موران.
- الناشر: باريس - 2015.