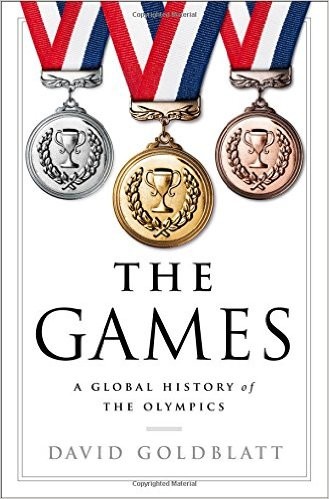لدافيد غولدبلات
مُحمَّد السمَّاك
يُخطئ الناسُ إذا كانوا يعتقدون أنَّ الهدف الوحيد للألعاب الأولمبية هو إقامة علاقات تعارف بين شباب وشابات العالم؛ تعزيزاً لقيم السلام والمحبة والاحترام بينهم؛ فالألعاب الأولمبية كانت دائماً مسرحاً للتنافس السياسي والقومي، وحتى العنصري، ولا تزال.. هذا ما ينتهي إليه المؤرِّخ دافيد غولدبلات في كتابه الذي يُؤرِّخ للألعاب الأولمبية من زوايا جديدة غالباً ما كانت طي الكتمان، أو طي النسيان. ولإثبات وجهة نظره، يكشف النقاب عن وقائع لم تكن معروفة من قبل، ويُؤرِّخ ما أهمله تاريخ الأولمبياد منذ بداياته الأولى حتى اليوم.
ومن المعروف أنَّ الألعاب الأولمبية بدأت في أثينا في اليونان القديمة. ولكن خلافاً لما هو معروف وشائع، لم يكن الهدف من تنظيمها في ذلك الوقت التشجيع على الرياضة، كان الهدف الاستعداد للحرب، وكان التنافس بين الرياضيين هدفه الكشف عن مؤهلات وقدرات العناصر الأفضل لتتولى مقاليد القيادة في المعارك الحربية.
واذا كانت هذه البداية تحمل طابعاً عسكريًّا، فإن كل الدورات الأولمبية التي عرفها العالم الحديث ومنذ القرن التاسع عشر، كانت مجبولة بالأهداف والطموحات السياسية، تحت شعارات إنسانية واهية.
ومن أجل ذلك، حاول أرستقراطي فرنسي -هو البارون بيار دي غوبرتين- في العام 1892 تنظيم دورة أولمبية على قواعد مختلفة هدفها إبراز قيم الرجولة. إلا أنَّ الرجولة كانت تعني عنده حصر المنافسات بالرجال، وإقصاء النساء عن المشاركة فيها. ولا عجب في ذلك؛ فالرجل كان متديناً كاثوليكياً. وقد تقدم للانضمام إلى سلك الكهنوت في فرنسا إلا أنه لم يُقبل. وكان يقول "إن الرياضة النسائية هي أكثر المظاهر اللاأخلاقية التي يمكن أن تراها عين الإنسان".
وبصرف النظر عن صوابية هذا الرأي أو خطئه، فإن الفاتيكان -المرجعية المسيحية الكاثوليكية الأولى في العالم- فرض على رجال الكهنوت حظراً شاملاً سواء لحضور أو لمشاهدة الألعاب الرياضية للنساء.. واستمر هذا الحظر حتى العام 1960.
وفي هذا الإطار أيضاً، يكشف الكتاب عن حقيقة مؤلمة ومخجلة في الوقت ذاته، وهي أن الفتيات المشتركات في الألعاب الرياضية كنّ يخضعن لفحوص باليد للتأكد من أنهنّ فتيات فعلاً. وهو إجراء مهين للكرامة الإنسانية!
ويُخصِّص الكتاب صفحات واسعة منه لموضوع الاستغلال السياسي للألعاب الرياضية، ويبين كيف أن هذا الاستغلال كان يتم حتى على حساب قدرات الدولة المنظمة لدورة الألعاب ولإمكاناتها المالية؛ فالحكومة اليونانية مثلاً التي نظمت دورة الألعاب الأولمبية في أثينا في عام 2004، كلَّفت خزينة الدولة 16 مليار دولار، أي ما يساوي خمسة بالمئة من الدين العام. وقد بقيت أحواض السباحة التي أنفق الكثير على إنشائها من دون استعمال؛ لأنه لم تكن هناك في الأساس حاجة إليها كلها!! وكما لم تكن اليونان مُؤهَّلة اقتصاديًّا لتتحمل هذه الأعباء في العام 2004، كذلك لم تكن مؤهلة لتحملها في العام 1896 عندما نظمت دورة الألعاب في ذلك الوقت.
ويُزودنا الكتاب بخلاصة مهمة في هذا الشأن تقول بأنه بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى العام 2002، فإن كل الدول التي نظمت دورات أولمبية خرجت منها وهي تعاني من أزمة اقتصادية شديدة؛ وذلك باستثناء الدورة التي نظمتها الولايات المتحدة في لوس أنجلوس في العام 1984، فقد حققت أرباحاً من مدخول الإعلانات وبيع حقوق النقل التليفزيوني.
ومن خلال ذلك، يُقدِّم الكتاب فرضيتين تؤكد الأرقام صحتهما. تقول الفرضية الأولى هي أنه ليس صحيحاً أن تنظيم دورة ألعاب أولمبية يحقق للدولة المنظمة أرباحاً وعوائد اقتصادية من خلال التسويق السياحي أو التجاري.
أما الفرضية الثانية، فتقول إنه ليس صحيحاً أيضاً أن الألعاب الأولمبية تشكل حافزاً للرأي العام في الدولة التي تتولى تنظيمها للتوجه نحو الرياضة والصحة الرياضية؛ فالأرقام الإحصائية تشير إلى أن الإقبال على الرياضة بعد الدورة هو أقل ما كان عليه قبلها!
ولا شك، استناداً إلى الكتاب، أن أول دولة وظفت دورة الألعاب الأولمبية على نطاق سياسي واسع، كانت ألمانيا في عهدها النازي؛ ذلك أنَّ أدولف هتلر وقيادة دولته وأركان حزبه لم يحرصوا فقط على حضور حفل الافتتاح، ولكنهم لم يتغيبوا عن أي يوم من أيام الدورة التي جرت في برلين في العام 1936. وقد تحولت تلك الدورة الرياضية، أو جرى تحويلها، إلى أول إطلالة دعائية على نطاق عالمي للحركة النازية، التي دمرت فيما بعد ليس ألمانيا وحدها، بل أوروبا كلها، وتسببت في تدمير مناطق عديدة أخرى من العالم.
ويكشف الكتاب عن وقائع لم تكن معروفة من قبل حول الأبعاد الدينية والعنصرية في هذه الدورات الرياضية؛ فيقول مثلاً إن رئيس اللجنة الأولمبية الأمريكية أفيري برونداج كتب إلى زميله رئيس اللجنة الأولمبية الألمانية رسالة أكد له فيها "أن الأندية الرياضية التي يشرف عليها في شيكاغو لا تقبل عضوية اليهود فيها، ولا تقبل أي مشاركة لأي منهم في أي من أنشطتها وفرقها".
وحتى عندما ارتفعت أصوات داخل الولايات المتحدة تلفت إلى معلومات تتردد حول استبعاد اللجنة الأولمبية الألمانية للرياضيين اليهود، أعلن رئيس اللجنة الأمريكية أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنه متأكد من عدم صحتها. على أن فصول الكتاب تبدو أكثر إثارة عندما تتناول قضايا التمييز العنصري، سواء ضد السود، أو ضد المرأة.
ويروي المؤلف عدداً من الوقائع، منها مثلاً أن أول ميدالية ذهبية حصلت عليها الولايات المتحدة كانت في العام 1924 خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وقد فاز بها الأمريكي الأسود (من أصول إفريقية) وليم دي هارت هوبارد، في مباراة القفز الطويل. ولكن رغم أهمية هذا الانتصار التاريخي الأول عالمياً للرياضة الأمريكية، فإن الصحف الأمريكية لم تشر إليه من قريب أو من بعيد؛ فقد اقتصر نشر النبأ في الصحف المحلية الصغيرة التي تصدرها حركات الأمريكيين السود، أما على الصعيد الأمريكي القومي، فقد مرّ الحدث التاريخي وكأنه لم يكن!
وحتى في دورة الألعاب الأولمبية في برلين التي جَرَت بعد عقدين من الزمن، تعمَّدتْ الصحف الأمريكية عدم الإشارة إلى فوز الأمريكي الأسود جيسي دوينز بأربع ميداليات ذهبية. وكأن الفائز ليس أمريكياً.. أو كأنه لم يكن هناك فائز في الأصل، وبهذا العدد الاستثنائي من الميداليات الذهبية!
طبعاً هذا الشعور العنصري لم يكن غريباً في ذلك الوقت، ولعله لا يزال مألوفاً حتى اليوم، كما تشير إلى ذلك الأحداث العنصرية الدموية بين الشرطة والسود في بعض المدن الأمريكية. ثم إنَّ رد فعل الأمريكيين السود لم يكن دائماً الصمت والخضوع للأمر الواقع؛ ففي دورة الألعاب التي جرت في المكسيك في عام 1968، فاز اثنان من الأمريكيين السود هما توم سميث وجون كارلوس بسباق المائتي متر. وأثناء حفل منحهما ميداليتي الفوز قدما التحية لحركة "القوة السوداء" التي كانت تقاتل من أجل حقوق السود في الولايات المتحدة، ورفعا علمها. يومها طلب رئيس اللجنة الأولمبية الأمريكية من رئيس البعثة الأمريكية إلى المكسيك طردهما. وقد حصل ذلك فعلاً.
ولا يقتصر البعد العنصري على الولايات المتحدة وحدها؛ ففي العام 1964 حرمت دولة جنوب إفريقيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية على خلفية سياستها العنصرية (الأبارتيد). وفي العام 1968 سُمح لها من جديد، ولكن ذلك القرار جوبه بمعارضة عالمية شلَّت تنفيذه.
ويكشفُ المؤلف في كتابه عن وقائع من التمييز العنصري سبقت الدورات الرياضية، ويروي مثلاً كيف أن المنشآت الرياضية التي أقيمت في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة والتي استضافت دورة 1996 قامت على سواعد العمال السود والمهاجرين المكسيكيين، وبأجور منخفضة جدًّا، ويروي أيضاً كيف أنه قبيل بدء دورة الألعاب قامت السلطة المحلية بتجميع كل هؤلاء العمال -وكذلك المشردون في المدينة- وقدمت لكل واحد منهم بطاقة سفر مجانية بالقطار أو بالأوتوبيس للانتقال إلى أي مدينة أمريكية أخرى يختارها، على أن لا يعود إلى أتلانتا إلا بعد نهاية الدورة.
وحتى المكسيك التي نظمت دورة أولمبية في العام 1968، تعمَّدت اختيار متطوعين للعمل في الإدارات التنظيمية من أصحاب البشرة البيضاء، واستبعاد السود وأصحاب البشرة الداكنة عن أي عمل أو نشاط تطوعي في إطار الدورة.
ومن القصص العنصرية ضد المرأة مثلاً، يروي المؤلف قصة الرياضية الهولندية فاني بلانكرز كووين التي فازت بأربع ميداليات ذهبية في الركض (لعدة مسافات) في دورة الألعاب التي جرت في لندن عام 1948. وبدلاً من أن تنهال عليها التهاني والثناء والتشجيع، تلقت العداءة سيلاً من الشتائم ورسائل القدح والذم لأنها كشفت ساقيها خلال المباريات!
ويذكِّر المؤلف هنا بنظرية الارستقراطي الفرنسي بيار دي غوبارتين الذي كان شديد الحرص على استبعاد العنصر النسائي -لأسباب أخلاقية- من دورات الألعاب الأولمبية التي قام بتنظيمها في فرنسا لأول مرة في العام 1898. وكانت نظريته تقوم على أساس أن الرياضة هي للرجال فقط وأن المشاركة النسائية غير أخلاقية.
وفي الواقع، فإنَّه بين عامي 1928 و1968 كانت المشاركة النسائية في مسابقات الركض التي تنظمها دورات الألعاب الأولمبية تقتصر على المسافات التي لا تتعدى المائتي متر فقط. وكان تبرير ذلك هو أن المرأة تتعرض للإنهاك والتعب الشديدين. واستمر هذا الإجراء حتى عام 1984، ولكن منذ ذلك التاريخ أصبحت المرأة تشكل نسبة الخمس من عدد الرياضيين المتنافسين.
أما البعد السياسي-الوطني للألعاب الأولمبية، فلم يغب عن هذه الدراسة الجديدة والممتعة؛ فأشار المؤلف مثلاً إلى أن تايوان (التي كانت تعرف بالصين الوطنية والتي كانت تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي كانت فيه الصين تعتبر خارجة على القانون الدولي)؛ حافظت على موقعها في دورات الألعاب الأولمبية ممثلة للصين -كل الصين- حتى بعد أن نزعت الأمم المتحدة عنها صفتها التمثيلية تلك وأعادتها إلى بكين!
ويروي المؤلف قصة الرياضي الصيني الذي كانت بلاده تعلق عليه أملاً بالفوز بالميدالية الذهبية في مباراة القفز العالي في دورة الألعاب الأولمبية التي جرت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في العام 1984، غير أنَّ الحظ لم يحالفه؛ فعاد إلى مدينة شنجهاي بخفي حنين. وتعبيراً عن خيبة أمل مواطنيه، وجد بيته محطماً، وعائلته مشردة وهي في حالة هلع وذعر شديدين!
وتعكسُ هذه الحادثة ومثيلاتها البعد السياسي-الوطني للمشاركات الدولية في دورات الألعاب الرياضية، والتي تتعدى مفهوم الرياضة والروح الرياضية.
ومن هنا، تدخل قضية المنشطات.. لم تكن هذه القضية موضع اهتمام إلا في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي؛ كان الاهتمام في ذلك الوقت محصوراً فقط للتمييز بين الرياضيين الهواة الذين لا يسمح لهم بتناول المنشطات، والرياضيين المحترفين. وكانت الألعاب الرياضية وقفاً على الفئة الأولى منهم فقط، إلا أنه جرى تجاوز ذلك أو الالتفاف عليه من قبل بعض الدول، إلى أن أصبح استخدام المنشطات وباء يشوه صورة الرياضة والتنافس الرياضي. وهي التهمة التي وجهتها الهيئة المختصة في اللجنة الأولمبية إلى الاتحاد الروسي، واعتبرتها موسكو تهمة سياسية وليست رياضية.
كان الأرستقراطي الفرنسي غوبارتين يتطلع إلى ما هو أبعد من منصة تتويج الفائزين الرياضيين. كان يروج لثقافة التنافس الشريف بين الرجال، وكان الفائز الأول يحصل على ميدالية فضية، ولم تكن الميدالية الذهبية متداولة عنده. كذلك لم يكن يقبل بالمراهنات التي أصبحت اليوم أحد أهم المظاهر المترافقة مع المباريات، بل لعلها أصبحت أهم "المنشطات" لتنظيم هذه الدورات الرياضية. لقد مات غوبارتين مفلساً بعدما كان من أثرياء فرنسا. واندثرت حركته الرياضية الأخلاقية لتحتل الأولمبياد بكل "منشطاتها" مسارح الاهتمامات في العالم.
---------------------
- الكتاب: "الألعاب..التاريخ العالمي للأولمبياد".
- المؤلف: دافيد غولدبلات.
- الناشر: نورتون - 2016.
- عدد الصفحات: 516 صفحة.