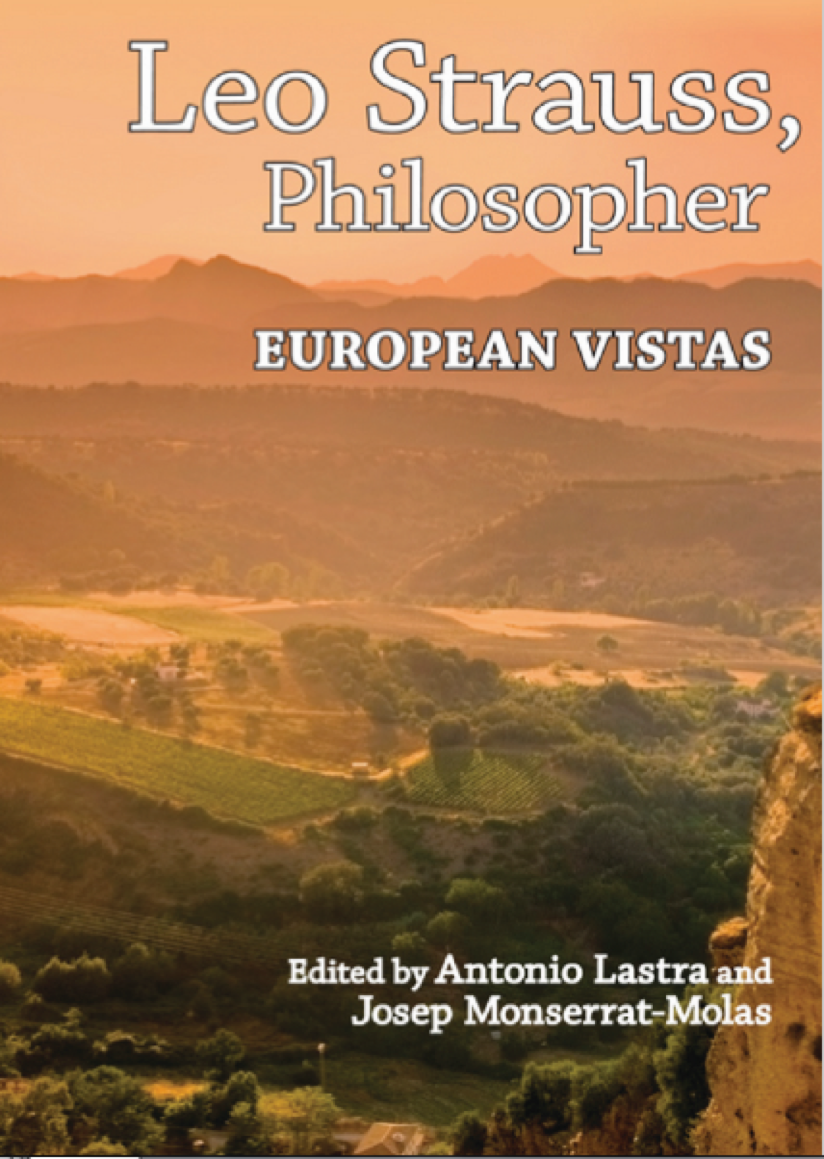تأليف جماعي تحت إشراف: أنطونيو لاسطرا وجوزيف مونسيرا-مولاس
محمد الشيخ
تآلف جمع من أساتذة الفلسفة بأوروبا (إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا) لكي يخرجونا من "تسييس" فلسفة المفكر الألماني الأمريكي ليو شتراوس (1899- 1973) ـ القائم على تأويل فلسفته السياسية تأويلا يمينيا صرفا، وعدِّه أحد منظري اليمين الأمريكي الحالي، على نحو ما هو رائج بالولايات المتحدة الأمريكية ـ إلى آفاق فلسفية أوسع لفكر الرجل عن اليمين واليسار بمبعد. فهذا المؤلَّف يقدم لأول مرة للقراء بالإنجليزية مقاربات لا ترتكز على علم السياسة بالأولى، وإنما على نظره الفلسفي، همها البحث في شتراوس قارئا للنصوص. وقد جاء هذا الكتاب في وقته، لأننا لا نكاد نسمع منذ صعود اليمين الأمريكي المتدين ـ على أسلوب آل بوش ـ إلا عن شتراوس والمحافظين. وتلك من مفارقات تلقي فكر فيلسوف لطالما امتعض من "أدلجة" الفلسفة، لا سيما السياسية منها، ولطالما شدد على الفجوة الحاصلة بين الفلسفة والسياسية! هو ذا الرجل، وهذه أعماله تعرض بين أيدينا:
- رجل حضرت محاضراته بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان هاجر إليها فرارا من النازية، نخبة من رجالات الفكر والفلسفة والأدب، من أمثال الفيلسوف السياسي الأمريكي المتخصص في الفلسفة السياسية الكلاسيكية سيث بنارديت، وفيلسوف الأدب المقارن والترجمة الأمريكي الفرنسي جورج شتاينر، وفيلسوف القانون والسياسة والكلاسيكيات الأمريكي جورج أناستابو، والفيلسوف الأمريكي المهتم بتاريخ الفلسفة وبالفلسفة السياسية ستانلي روزن، والفيلسوف الأمريكي الشهير ريتشارد رورتي، والكاتبة والمناضلة الأمريكية سوزان سونتاغ.. دون أن ننسى الباحث العراقي محسن مهدي.. وكلهم شهدوا له بالمنزلة الاستثنائية التي كانت تحظى بها قراءة النصوص الفلسفية في محاضراته، وبفلاحه في الأخذ بيدهم على نحو تدريجي من أفكار الحس المشترك ـ الأفكار العامة ـ إلى الحياة السياسية كما كانت تحدث في الواقع، فإلى تحليلها والتأمل فيها وفق لغة أكاديمية عالية.
- ورجل أسس لمنهجية أصيلة في قراءة النصوص الفلسفية سميت "القراءة بين السطور" تقوم على فكرة وجود "كتب متأبية" تتضمن تعليمين: واحد ظاهر على سطح النص، وثان خاف بين السطور؛ ومن ثمة لا بد من "استنطاق النص" كي يبوح بما ظن به على غير أهله. كذا فعل على نحو عجيب في كتابه الشهير: الاضطهاد وفن الكتابة (1952)، حيث عمد إلى قراءة أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي واسبينوزا لا في ما كتبوه وإنما في ما لم يكتبوه وإنما أوحوا به في ما بين ما سطروه. وقد أوحى بتطبيق المنهج عينه في قراءة نصوص مفكري الإسلام من أمثال الفارابي وابن رشد وابن طفيل وابن سينا وابن وحشية وابن الراوندي...
- ورجل كان سباحا ضد التيار بامتياز. إذ وعلى عكس خطاب الحداثة الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، فضل هو العودة إلى القدامة، ومعاشرة الأقدمين من الأموات، على خلاف المحدثين من الأحياء: قدامي هو ما بين المحدثين، ووله بالفكر القديم ما بين يقظى الفكر الحديث.
يأتي هذا الكتاب إذن لكي ينسينا في شتراوس الذي استغل سياسيا بأبشع استغلال يكون، ولكي يذكرنا بذلك الذي يكاد يصيرـ على الساحة الفكرية إعلاميا ـ نسيا منسيا: شتراوس الذي طيلة مساره الفكري لم يفعل إلا شيئا واحدا: قراءة النصوص الكلاسيكية: من اسبينوزا إلى ابن ميمون، ومن أفلاطون إلى هوبز، ومن زينوفان إلى مكيافلي.. ولا يقرأها إذ يقرأها إلا بسلطان القراءة في ما بين السطور. لم يتفلسف إلا داخل النصوص بحيث فكر مع النصوص في النصوص وضد النصوص. وذلك لأنّ النصوص، لا سيما تحت تأثير الاضطهاد، قد يلجأ أصحابها إلى آليات الصمت والتكرار والتناقض والإغماض والتلبيس لتوصيل الحقيقة التي أرادوا قولها - عبر الإخفاء والتعمية - في ما بين السطور.
في التقديم
في تقديم الكتاب، يعود بنا جامعاه - الباحثان الإسبانيان أنطونيو لاسترا وجوزيف مونسيرا- مولاس - إلى التساؤل عن وضع الفلسفة والفيلسوف اليوم، وعن مسألة التمييز بين "الفيلسوف" و"أستاذ الفلسفة": ما المنزلة التي يحتلها الفيلسوف في المجتمع وفي الأكاديمية بحسبانه أستاذا وبوصفه مواطنا؟ وما صلته بالسلطات بما في ذلك تلك المنتخبة دستوريا وتلك المسؤولة داخل الديمقراطيات المعاصرة؟ ويجيب المقدمان: لربما ما عاد من باب المبالغة في شيء القول إنه ما بقي ثمة من "فلاسفة" اليوم، ولا حتى سوف يبقى "أساتذة فلسفة" في المستقبل. ذلك أن الفلسفة لما أدمجت في التعليم الرسمي أمست مهنة تمارس ـ مهنة عمومية وسياسية ـ ومن ثمة فقدت منزلتها الحرة ـ حقا ـ الليبرالية ـ ممارسة ـ بما أن المجتمع صار يطلبها في "برنامج دراسي" أمسى ضروريا وإجباريا لكل المواطنين. وهكذا بات أساتذة الفلسفة خداما وموظفين للمجتمع وللدولة. فأية حرية بعد هذا بقيت لأستاذ الفلسفة اليوم؟ وقد طرح المقدمان هذا السؤال بمناسبة الحديث عن الفيلسوف ستراوس الذي لطالما تساءل عن الصلة بين الفلسفة والسياسية، ولطالما ساءل النصوص الفلسفية أمام طلبته بكل حرية واقتدار، حتى أنه لربما صار "أخر أكبر شارح" في تاريخ الغرب يستحق أن يقرأ قراءة عميقة وبعرفان، وحتى أمست فلسفته لربما آخر "فلسفة شراح" شهد عليها الغرب.
ولئن كان لنا أن نسمي فلسفة الرجل، فإن علينا أن نسميها بالاسم المفارق: "فلسفة شتراوس السياسة الأفلاطونية" – وهي مساهمة في فلسفة الشراح، وفي تاريخ الفلسفة، وفي الفلسفة مفهومة على أنها سعي إلى الحقيقة المرفقة بالقناعة أن هذا السعي هو ما يجعل الحياة تستحق فعلا أن تعاش، والتي يعززها التوجس من نزوع الإنسان الطبيعي إلى أن يكتفي بقناعات حتى وإن كانت مُشكَلة. على أن شتراوس وإن سلم بما قاله أفلاطون في الجمهورية "بلا مدن لا وجود للفلاسفة"، فإنه رأى أن الفيلسوف الحق لا يجد موطنه في المدينة. أَوَ ليس هو ناقد نواميس المدينة وهادم التقليد؟ لقد تعلم شتراوس من تحشياته على الكتابات الفلسفية اليهودية والإسلامية الوسيطة أن الحياة الفلسفية مكتفية بذاتها، فهي حياة النوابت، لكن عليها أن تعاش في ما وراء حدود المدينة الضيقة ـ غير الكونية ـ من غير أن تمسي حياة الفيلسوف في خطر؛ ومن ثمة لجوء الفيلسوف إلى "الكتابة بين السطور".
ثم يقدم الباحثان بحوث الكتاب، ذاكرين أن كتاب هذه الفصول أساتذة فلسفة أوربيون، وأن عنوانه "آفاق أوربية" إنما هو صدى لعنوان والت ويتمان "آفاق ديمقراطية"، وأن كل فصل هو تحشية على عمل من أعمال شتراوس.
في المدخل
كتب هذا المدخل الباحث أنطونيو لا سترا ـ وهو أستاذ فلسفة جامعي إسباني ومترجم العديد من أعمال شتراوس إلى الإسبانية ـ منطلقا من قول نيتشه: "ما من فلسفة إلا وتثوي خلفها فلسفة أخرى" . إذا فهمنا هذا أدركنا أن فلسفة شتراوس "القدامية" إنما تخفي ـ ويا للمفارقة! ـ "فلسفة المستقبل". لكنها تبقى دائما فلسفة تدبير الإنسان المتوحد ـ أشبه شيء يكون بالنابتة المتبتل المعتكف منه بالمواطن المنخرط الملتزم ـ تتخذ لها موطنا ـ وهي الفلسفة السياسية بامتياز، والفلسفة السياسية عند شتراوس هي "الفلسفة الأولى" ـ عن السياسة بمنأى. المجتمع بالضرورة تواضعي توافقي تديني، بينما الفلسفة بالضرورة استثنائية انعزالية متمردة. وشأن من هذا شأنه ألا يكتب للعموم، وحين يكتب يكتب لكي يخفي لا لكي يبدي. وفي ذلك ما يجمع بين شتراوس ونيتشه: فلسفة الكهوف القائلة وراء كل كهف كهف. ومن هنا أيضا وجه اتصال هذه الفلسفة بفيلسوف كهوف وهروب آخر هو ليسنغ. لكن إذا كنت حيثما وليت وجهك تجد المدينة الحديثة، فإن كلا من ليسنغ وشتراوس هربا إلى النصوص القديمة: مدينة الكلمات، لا مدينة الواقع. وفي ذاك سر العودة إلى القدامة. وقد قادهما ذلك إلى اكتشاف "أرض مجهَلة": الكتابة الملغِزة التي تحتاج إلى فن القراءة في ما بين السطور.
في الفلسفة وتاريخ الفلسفة
كتب هذا الفصل كارلو ألتيني ـ وهو أستاذ فلسفة إيطالي محاضر في جامعات أوربية عدة ـ لكي يبرز الصلة بين شتراوس وتاريخ الفلسفة. وقد ذكرنا، بداية، بأن لعودة الرجل إلى الفلسفة ما قبل الحديثة سياق: "أزمة القيم" التي خلقتها الحداثة. والحال أنّ إعادة بناء فلسفات الفلاسفة الذين عاد إليهم لم تكن مجرد بحث ذي طبيعة تاريخية، يسعى إلى كشف حقائق الماضي، بل كان ضربا من العودة إلى حدود الحداثة، وذلك عبر تفكيك الفلسفة السياسية الحديثة. لقد نشأت تساؤلات شتراوس عن الحداثة من خلال التفكير في الأزمة المعاصرة، وتطورت بتملك الأدوات التاريخية للوصول إلى فهم جديد للوضع الحالي. ويلاحظ الباحث أن شترواس يميز تمييزا شديدا بين "التاريخ" و"الفلسفة"، إذ الأول معرفة خاصة والثانية معرفة كونية. على أن الذي خلط بين الأمرين هو النزعة التاريخانية التي أعلنت أن ما من شيء إلا وهو مشروط بالتاريخ، ومن ثمة قدمت نظرة نسبية عن الفلسفة، وأنكرت أن تكون قضايا الفلسفة قضايا عابرة للزمان، بل أنكرت حتى أن تكون ثمة حقيقة في الفلسفة. وكان من نتائج ذلك القول بنسبية القيم، بل وحرمان الإنسان الحديث من كل تقويم، وتلك عرفناه "أزمة القيم" التي أدت إلى "العدمية". والذي رد به شتراوس على تغلب هذه النزعة التاريخانية أن ثمة استقلالا للمعرفة الفلسفية عن الشروط التاريخية الضيقة؛ أي عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى القول بالنسبية وبالإيديولوجيا، وأن سؤال معنى "الحياة الطيبة" سؤال طرح منذ القدم ولا يزال قائما إلى اليوم، بما دل على أن الفلسفة قد تعبر حدود الزمن، وأن إمكان الفلسفة، والفلسفة السياسية بخاصة، إمكان أبدي غير مرهون ببعدي "الهنا" و"الآن"، وأن مهمة الفلسفة السياسية هي معرفة ما الحسن من الفعل وما القبيح منه بالنسبة إلى الجماعة السياسية؟ وهو سؤال علم لا سؤال رأي. وقد خصص الباحث جزءا مهما من بحثه إلى نموذج تطبيقي: رد شتراوس على كولنوود أحد أشهر ممثلي النزعة التاريخانية.
في الوفاء ومحبة الحكمة في جمهورية أفلاطون
أنشأت هذا الفصل إليساندرا فوسي ـ وهي أستاذة فلسفة الأخلاق بجامعة بيزا الإيطالية ـ لكي تذكرنا، بدءا، أن شتراوس كتب الكثير عن الفلسفة القديمة، وكلما فاضل بين القديم والحديث فضل الأول. على أنه آثر من بين الأقدمين أفلاطون إيثارا خاصا، وذلك لأن ثمة علقا نفيسا بين الرجلين: كلاهما توجس من الإكثار من الاستدلال في الفلسفة بحكم أنه علامة ضعف لا قوة ـ وهو ما يشين أعمال المحدثين. وكلاهما ما عد الفلسفة مهنة أكاديمية وإنما أسلوب عيش، بل أفضل أساليب العيش غير المليء بالتهجسات والآمال الكاذبة. أما مجال السياسة والديانة، فهما مجال التعلق بالآراء والاعتقادات، ومن ثمة يتحاميان الفلسفة. وما كان الوفاء إلى آراء الرجال من الفلسفة في شيء، وإنما الوفاء ـ كل الوفاء ـ إلى حب الحكمة من حيث هو البحث النزيه غير المتحيز لا إلى الأهواء ولا إلى الرجال. ولهذا كان التوتر دائما بين الوفاء للآراء والرجال، وبين محبة الحكمة الصافية. ولقد كان أفلاطون نموذجا للفيلسوف الذي ما قال برأي قط، ولا حتى بنظرية، فضلا عن أن يكون قد قال بعقيدة، وإنما اختفى دوما خلف محاوريه. كما أنّ اليونانيين بعامة ميزوا بين الحياة السياسية القائمة على التقليد، وبين المعرفة بهذه الحياة ـ الفلسفة ـ القائمة على نقد التقليد. إذ ما كل قديم بحق. ومن هناك ضرورة التحرر من التقليد، من الكهف، من القيد.
في المواطنة الملتزمة
أنشأ هذا الفصل جوردي ساليس – كوديرش ـ وهو أستاذ فلسفة بجامعة برشلونة عميد كلية الفلسفة بنفس الجامعة سابقا ورئيس الجمعية الكاتلانية للفلسفةـ لكي يبين مزايا الرجل وفلسفته: عناية خاصة بقراءة النصوص وإقرائها لطلبته، مراوحة المسير والغدو بين الحياة السياسية كما تمارس في الواقع والنظر السياسي التأملي، إلقاء عين على الواقع وعين على منح مواطني وسياسيي المستقبل خطابا لا يتخلى عن مسؤولية تحقيق الخير المشترك إذ يسعون إلى خيرهم الشخصي، إرادة قوية في أن يمكنوا من الأدوات الضرورية لمساءلة الاعتقادات التي يقوم عليها المجتمع من غير تدمير الجو الذي تزدهر فيه المدينة. وكل هذه السجايا يعكسها كتابه الكلاسيكي: "المدينة والإنسان" (1964) الذي يذكر في مقدمته أن الذي حمله على تأليفه ما لاحظه من "أزمة" في الغرب تأدت إلى فقد المجتمع القناعة بمعتقده الفكري وبعزيمته وبمشروعه. ذاك هو الداء، أما الدواء فكان العودة إلى الفكر السياسي القديم الذي ـ وعلى خلاف فكر الحداثة ـ ما كان فكرا "قوميا" وإنما فكرا "كونيا" كان: إن مجتمعا تعود على فهم ذاته باستخدام تعابير ذات أفق كوني لا يمكنه أن يفقد الإيمان بهذا الأفق من غير أن يصير فاقدا لبوصلته بالتمام. على هذا كان المجتمع القديم، وما على هذا أمسى المجتمع الحديث القائم على الإيديولوجيا. ولنا أن نتمثل بمثال أرسطو الذي رسم معالم المواطن المنخرط لا الحزبي المتراجع: المواطن المتبصر العامل الدؤوب على بناء المدينة، مهما تداولتها من الأنظمة وتعاورتها من الأحزاب - هو ذا "الوطني" لا "المشايع".
في المدينة والغريب
يتناول هذا الفصل الذي كتبه أستاذ السياسة والقانون والعلاقات الدولية الإيطالي ماورو فارنسي كاميلون تحشية شتراوس على كتاب "النواميس" لأفلاطون الذي كان قد اعتبره عملا سياسيا بامتياز وتعبيرا عن جوهر الفلسفة السياسية. ويتساءل الباحث: لماذا وعلى خلاف كل محاورات أفلاطون لا يحضر هنا سقراط محاورا وإنما الغريب الأثيني. وبحث الباحث أشبه شيء يكون باستقصاء بوليسي. استقصاء يستدعى فيه رأي الفارابي ـ ذاك الملخص والشارح الآخر للنواميس ـ القائل بقول الملاماتية الفلسفية: ضرورة إخفاء قوال الحقيقة ـ الفيلسوف ـ نفسه حتى لا يفقد حياته. وكيف يكون الأمر على خلاف ما ذهب إليه المعلم الثاني ورهان المحاورة صعب ـ التشريع ـ والفيلسوف دائما مهدد لأنه ناقد التشريعات الموروثة؟ هو ذا ما يفسر اختفاء سقراط في هذه المحاورة، بل وحتى عدم الحسم في أمور خطرة شأن صلة الفلسفة بالسياسة وبالمجتمع.
في أهمية ليسنغ للفيلسوف
يذكرنا أستاذ الفلسفة الألماني تيل كينزل بداية أن الفلسفة في حسبان شتراوس أسلوب عيش بالأولى، وأن الفلاسفة الذين عاد إليهم إنما نظر في فلسفاتهم من حيث هي كانت أساليب عيش. لكن، غريب حقا أمر موقفه من الفيلسوف الأنواري الألماني ليسنغ: ما خصه بكتاب، وإن عاد إليه المرار! وأغرب منه موقف الباحثين المعاصرين الذين قلما كلفوا نفسهم عناء البحث في هذه المفارقة ! والذي عند الباحث أن شتراوس لطالما أسف على عدم تمكنه من تخصيص كتاب كامل لليسنغ. أَوَ ليس هو القائل شبه المعتذر: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله إنما كان هو التشديد على أفضل تلامذتي بالعودة إلى ليسنغ، والبوح في مناسبات عدة بما الذي أنا مدين به إلى ذاك الرجل". على أن لا أحد من هؤلاء التلامذة النبهاء عمل بنصيحة الشيخ. وقد شدد الباحث على أن صلة شتراوس بليسنغ ما كانت مجرد صلة باحث بمصدر ببليوغرافي، وإنما كان الرجل معجبا بأسلوب عيش الفيلسوف ـ الأفلاطوني ـ القائم على التكتم، الميال إلى القدماء في تحررهم منه إلى المحدثين، فضلا عن أن كتاباته وفرت له أدوات فن القراءة. لكنه في كل هذا، ما عاد إلى ليسنغ المعروف وإنما إلى ليسنغ "الحقيقي غير المعروف" الذي أقر أنه "مدين له بكل شيء"، والذي كان همه السعي إلى الحقيقة لا بالقول بامتلاكها.
ضميمة
في الضميمة التي كتبها أحد معدي الكتاب ـ أستاذ الفلسفة الإسباني جوزيف مونسيرا مولاس ـ عودة إلى إشكال شتراوس الأساسي: لقد حولت الحداثة الفلسفة السياسية إلى نزعة نسبية، تقوم على تنسيب فكرتي "الحسن" و"القبيح"؛ مما أدى إلى أزمة القيم، بما أن المحدثين حرموا من وسائل المحاججة للاختيار في ما بين القيم المتاحة وفي ما بين أساليب العيش الممكنة. وبغاية تجاوز الأزمة، لطالما ذكر الرجل بضرورة أن يدرك الإنسان حدوده (فشل نزعة التقدم)؛ ومن ثمة أهمية العودة إلى الأقدمين، إلى العقلانية السياسية الكلاسيكية، تحت شعار: "كلنا مبتدئون". ألم يقل الحكيم الإباضي أبو محمد ويسلان بن يعقوب: "من قرأ الكتاب مرة إنما قرأ كتابا واحدا، ومن قرأه مرتين فكأنما قرأ كتابين، وكذلك على حسب ما قرأت". ذاك فن القراءة بين السطور الذي ما سمع به شتراوس ولا درى.
------------------------------------------------------------
عنوان الكتاب :ليو شتراوس فيلسوفا آفاق أوربية
منسقا الكتاب : أنطونيو لاسترا وجوزيف مونسيرا- مولاس
عدد الفصول : ستة فصول مع تقديم ومدخل وضميمة
عدد الصفحات : 163
دار النشر ومكانه : Sunny Press, New York
سنة النشر : 2016