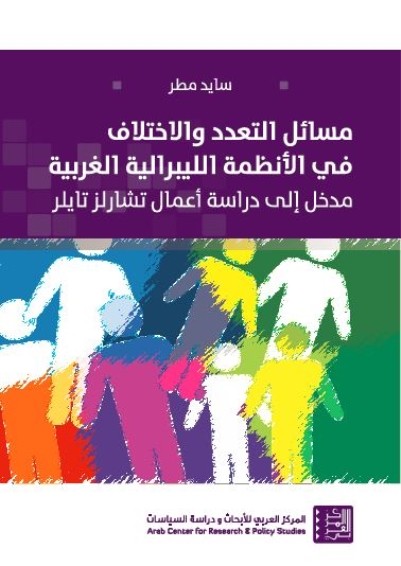رضوان السيد
تشارلز تايلر فيلسوف كندي، ولد في مونتريال عام 1931 من أب أنجلوفوني وأم فرانكوفونية. وهو أستاذ سابق في الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة ماكجيل (MacGill) الكندية بين عامي 1961 و1997. تأثر فكره بمذاهب فلسفية شتى؛ منها: الفلسفة التحليلية والظاهراتية، وعلم التأويل، والفلسفة الأخلاقية، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والسياسة، والتاريخ. وقد عيَّنته الحكومة الكيبكية مع عالم الاجتماع جيرار بوشار عام 2007 رئيسين للجنة الاستشارية الخاصة بممارسات التكيّف المتصلة بالاختلافات الثقافية.
تُدْرجُ فلسفة تشارلز تايلر الأخلاقية والسياسية بطابعها الجماعتي (Communautariste) في إطار التقليد الليبرالي الحديث؛ وذلك لأخذها الصريح بأهم مكتسبات الديمقراطيات الليبرالية الغربية، وهي المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية الأساسية. وهو وإن كان يرفض جميع أشكال القيم والمعتقدات التي تناهض "الحداثة" وتراثها الأدبي والفكري، لكنه يوضح أن فلسفته تُعرض عن تصور الحريات الأساس هذه باعتبارها حريات ذاتية مجردة قوامها "الفردانية" الأخلاقية ونهجها نهج "الأداتية" السياسية.. والفردانية تنامت مع تراجع الدين وانحسار التقليد اللذين لم يحددا قديماً معايير الواجبات والحقوق وطبيعة الحكم السياسي فحسب، بل كانا منذ وجودهما، الضمانة للحمة الجماعة وتماسكها. ونتيجة هذا التراجع، فقدت المجتمعات الحديثة شيئاً فشيئاً روابط الوحدة والائتلاف، فأخذت بالتفكك وتراجعت فيها قوة التضامن بين الأفراد التي كان يضمنها الدين والتقليد.
ومع إقصاء الدين والتقليد عن الحيز السياسي، كان لا بد من إيجاد معايير جديدة تحدد طبيعة النظام الحديث وتنظم قواعد الاجتماع السياسي، وفقاً لحقوق وحريات فردية لم يشهدها تاريخ هذه المجتمعات قبلاً. وكان العقد الاجتماعي الحديث المستند الشرعي الذي قامت على أساسه هذه المعايير، فنهضت بالمجتمع وبمؤسساته السياسية والقانونية العامة. أما شرعية العقد هذه فاستندت إلى قوة معيار المساواة في الحقوق والحريات بين جميع الأفراد المشاركين في صَوْغ العقد؛ حيث إنَّ الأفراد هم وحدهم مصدر جميع السلطات وما ينتج من ذلك من معايير عامة ناظمة يتفق عليها الجميع. وتعني المساواة هنا رفض التمييز بين قدرات الأفراد ومؤهلاتهم الطبيعية أو التفرقة فيما بينهم وفقاً لطبقتهم الاجتماعية أو لانتمائهم الثقافي.
الفصل الأول: "القديم والحديث بين النزاع والمصالحة"
يُقسِّم سايد مطر كتابه إلى أربعة فصول؛ يتناول الفصل الأول -وهو بعنوان "القديم والحديث بين النزاع والمصالحة"- مسألة الاختصام الذي نشب بين الموروثات القديمة (الدين والتقليد) والمكتسبات الحديثة (الحريات الفردية)؛ إذ أدى هذا الاختصام إلى نشوء عسير في هوية المجتمعات الليبرالية الحديثة. وينظر هذا الفصل في الانقسام الحادّ الذي نشأ بين مكتسبات الحداثة؛ من انعتاق للعقل من روابط الدين والتقليد وإعلان الثورة المساواتية في الحقوق والحريات الفردية من جهة، والموروثات الثقافية التقليدية القديمة من جهة أخرى. ويعمد المؤلف إلى إيضاح سعي تايلر لاستجلاء معاني العُسر والانقسام بين الحديث والقديم والعمل على إمكان المصالحة بينهما.
ويرى تايلر أنَّ المساواة أخذت تتيح للفرد "عبوراً مباشراً إلى المجتمع" من دون وساطات دينية أو تقليدية، لذلك جاءت هذه المساواة مجرّدة، باعتبارها قيمة "فرضية" "خيالية" أو اصطناعية منعتقة من روابط الاختلاف المتمثلة في الدين والطبيعة والتقليد. ويعتبر تايلر أن ذلك جعل الفرد نظرياً (لا واقعياً) القاعدة النهائية التي نشأت عليها ركائز الاجتماع السياسي في المجتمعات الغربية الحديثة، وأدت هذه الفردانية -بوصفها عماد الحضارة الغربية- إلى دحر المقومات الجماعية المتمثلة في هيمنة الدين ووطأة التقليد.
كثيراً ما يهاجم تايلر الغلو العقلاني في مؤلفاته؛ لأنَّ العقلانية المسرفة تتميز بطموحها الصريح لبلوغ "الموضوعية" في التشريع وسن المعايير الأخلاقية والقوانين العامة، لكنها لا تنسلك في السياق التاريخي الحياتي الثقافي المتعدد الآفاق والرؤى. وتستند تلك الموضوعية بالدرجة الأولى إلى نهج فكري يذهب بالعقل إلى "الانعتاق من الروابط" التاريخية ريثما يبلغ الكلية.
إنَّ انعتاق العقل الحديث من روابط الطبيعة والثقافة، وتوسّله بمعايير مجردة وبقيم افتراضية، هو الذي جعله عقلاً أداتياً فقد صلته بالغايات الطبيعية والتقليدية، لذا أخذ يسخّر الأشياء والإنسان تسخيره لوسيلة يحقق من خلالها غاياته النفعية الصرفة. فانعتاق العقل ونشوء الفردانية هو ما مهّد الطريق إلى قلب المعايير التقليدية أو التراثية، إذ أضحى الفرد يختار غاياته الحياتية والوجودية ولا يكتشفها في التقليد والتراث أو في الطبيعة، كما ساد الاعتقاد منذ أرسطو. والغايات الجديدة المتاحة أصبحت غايات تخضع للمصالح الذاتية الأنانية وتنشغل انشغالاً لا يهدأ بمسائل الاقتصاد والمنفعة. وهكذا تحوّل العقل الحديث إلى عقل أداتي صرف يقوم باحتساب الإمكانات والطاقات ويجعل كل شيء وسيلةً لتحقيق غايات شخصية أو اقتصادية محضة. فالعقل الأداتي -بحسب تعريف تايلر- هو هذا النوع من العقلانية التي نتوسّل بها بغية احتساب الطريقة الأكثر اقتصاديًّا أو نفعيًّا في سبيل غاية ما.
كان لهيجل الأثر البالغ في فكر تايلر في عدد من مؤلفاته، وله كتاب عنوانه "هيجل والمجتمع الحديث"؛ إذ جارت فلسفة تايلر فلسفة هيجل في الكثير من جوانبها، خصوصاً فيما يتعلق باللغة، بالقول إن اللغة هي الوسيط الوحيد الذي لا يعبر عن أفكارنا وعواطفنا فحسب، بل يسهم أيضاً في تكوين الأفكار وتظهيرها، غير أنه ما لبث أن تمايز عن هيجل واختلف معه. وسبب الخلاف هو ادعاء هيجل أن الوعي الذاتي (التفكر) لا يعبر عن معانيه في العمل الإنساني وحده، بل يتعدى ذلك وصولاً إلى تكشف المعاني الذاتية تكشفاً نهائيًّا تاماً. وربما يفسر هذا التباين بين الفيلسوفين لجوء تايلر إلى مجاراة الفلسفة الهايدجرية والاقتباس منها في بعض من جوانبها المتصلة باللغة. فخلافاً لهيجل، يعتبر هايدجر -بحسب مفهومه الأنطولوجي الأساسي للوجود- أن اللغة تجتهد في وضع المعاني الوجودية في موطن التكشف الأصيل والمستمر للكينونة، لكن من غير أن تقفل إقفالاً نهائياً على باب هذا التكشف. وبيت القصيد في ذلك كله -بحسب تايلر- هو أن العلوم الإنسانية لم تعد علوماً تأويلية.
واللغة حركة حيوية تُدرج أصولها في إطار جماعي مشترك، بمعنى أن لا وجود لأي شكل من أشكال الفردانية التي تستنبط لذاتها لغة فردية ومستقلة. فبالنسبة لتايلر، استناداً إلى فتجنشتاين، ليس من نشاط لغوي شخصي، وما التحاور والتخاطب والتفاعل الإنساني إلا نشاط فكري وعملي ينسلك ضروريًّا في شبكة من التواصل الخاصة بلغة مشتركة. غير أن ما يميز المجتمع الحديث هو اتساقه الآلي وانتظامه الفرداني، وهو مفهوم اجتماعي سياسي يرى في بنية المجتمع كتلة من الأفراد، يروم كل فرد فيها على حدة ابتكار مفاهيم لغوية مختلفة وأنماط عيش منوعة. وهو ما يرفضه تايلر لاعتقاده بأن النشاط التحاوري والتواصلي مشترك وجماعي في صلبه، معولاً على نظرية هيردر للغة، معتبراً أن من المحال فصل الفكر عن وسيطه التعبيراني: "إن اللغات التي تستعملها الشعوب تعكس في واقع الأمر رؤاهم المختلفة للعالم".
وبناء عليه، فإن تاريخ الناس -بحسب هيردر- هو تاريخ للحوادث التي ترمي إلى غايات وأهداف معينة، فالتاريخ يحدد هويتهم ويكونها.
واللغة -بحسب تايلر والفلاسفة الجماعتيين- وسيط "تعبيراني" يُستخدمُ أيضاً للتعبير عن مفاهيم العدالة. ولا تقتصر اللغة على التعبير عن "تصور الخير" الثقافي أو الخلفيات الثابتة ودلالاتها فحسب، بل تتعدى ذلك حتى ترتكز معايير العدالة على هذه التصورات وهذه الخلفيات الثابتة. وإذا نظرنا إلى تصورات الخير فسنجد أنها محكومة بالاختلافات والتنافسات حتى النزاعات في كثير من الأحيان. وعلى هذا يُطرح السؤال: كيف يمكن تصور العدالة الاجتماعية والسياسية وتأسيسها على مفاهيم الخير، في حين أن هذه المفاهيم نفسها تتضارب فيما بينها ويناقضُ بعضُها بعضاً؟ والحال أن هذا التناقض بين تصور الخير (النسبي واللا معقول) وتصور العدالة (الكلي) هو ما حدا تاريخيًّا بالديمقراطيات الليبرالية إلى أن تعتنق مبدأ الحياد السياسي إزاء تصورات الخير المتنافسة، وفرض المساواة بين الجميع بلا استثناء ودون تمييز.
أمَّا مسعى تايلر الفلسفي، فهو نقدي لا يناهض اللبرالية الحديثة في حد ذاتها، إنما ينسلك فيها ويتفاعل معها فيستجلي نقاط ضعفها ومخاطرها، خصوصاً انحرافاتها الفلسفية المصطنعة. وهو يرى أن أصالة الفرد الأخلاقية لا تتحقق في معايير أخلاقية مجردة مفترضة أو مصطنعة أو في عقل أداتي نفعي، بل في التعبير عما يسمى "الخلفيات الثابتة"، أي الموروثات الثقافية الثابتة التي رسختها الرومانسية مثمنة دور اللغة والتقليد، وحتى الدين، في تكوين البنية الأنثروبولوجية. فهذه الموروثات تُنشئُ هوية الفرد التاريخية وتعتمل في تضاعيفها العملية والوجودية اعتمالَ التمايز والأصالة.
ويعتبر تايلر أن هذه الموروثات الثقافية هي قيمةٌ أخلاقيةٌ بحد ذاتها، تساعد الفرد في فهم ذاته وتحقيقها من ناحية، وتمثل مرتكزاً أساساً لفهم أصول الشرعية السياسية التي تُبْنى عليها التشريعاتُ والقراراتُ العموميةُ من ناحيةٍ أُخرى. من هنا أهميةُ الثقافة والبحث فيما تمثله من حيث الأصالة والرصانة على المستوى الأنثروبولوجي والاجتماعي. فالثقافة -بحسب تايلر- ليست مسألة ثانوية تتعلق حصراً بما هو خاص، كما ساد الاعتقاد منذ الحداثة التي فصلت سياسيًّا وقانونيًّا بين السياسي (العام) والمدني (الخاص)، إنما هي مكونة للبنية الفكرية الأنثروبولوجية ومصدر جوهري يستند إليه تواصل الأفراد وتفاعلهم السياسي والمجتمعي. الثقافة هي منبع الفكر والعمل الإنساني التي بها يبلغ الفرد غاياته الطبيعية مبلغاً خاصًّا فريداً، ومنها يستقي معاني حريته الديمقراطية فلا يعتصم بحرية مجردة مصطنعة فارغة من المعاني الثقافية والدلالات التاريخية الأصيلة؛ لأنَّ نشاطه السياسي يصبح تعبيراً عن انتمائه التاريخي الحضاري.
الفصل الثاني: الاعتراف بالتعددية الليبرالية السياسية
في الفصل الثاني، يبرز المؤلف الأهمية القصوى للخلفيات الثابتة أو الموروثات الثقافية التي تعتمل في هوية الفرد التاريخية وتكون بنيتها الأنثروبولوجية تكوينًا أصيلًا، وهو ما يؤكد -بحسب تايلر- ضرورة الاعتراف السياسي والقانوني بهذه الموروثات، بالنظر إلى أن لها أثرًا بالغ الأهمية في حياة الفرد وفي استنهاض المعية الإنسانية على المستوى العملي والوجودي.
ومن المعلوم أن المنظومة الليبرالية الكلاسيكية تشدد على ضرورة هذا الفصل بين الخاص والعام؛ باعتباره يدعم شرعية الحيادية السياسية للدولة إزاء التعقيدات اللاعقلانية التي تتميز بها "العقائد الشاملة" الدينية والفلسفية والأخلاقية. وتجلى هذا الفصلُ لاحقاً في فصل الواقعة الاجتماعية عن المعيار (Norm) في نطاق التواجه بين العلوم الإنسانية والنظرية المعيارية في العلوم السياسية. وكانت أسباب هذا التواجه الصراع الذي نشأ في الأصل بين الإنسانيات والعلوم الإنسانية. وهذا ما يفسر -بحسب تايلر- الأسباب الرئيسية الثلاثة التي تكمن وراء نشوء عصر الحداثة، ألا وهي زوال البعد الأخلاقي النوعي المتمايز أنطولوجيًّا، وانتصار العقلانية الأداتية، وما يلي ذلك من تفتيت للجسم الاجتماعي.
ويرى تايلر أن الشعور بالعسر في الغرب يتولد من جراء انجراف المجتمعات الغربية المعاصرة إلى الأخذ بمخلفات الحداثة في فردانيتها الأداتية، على حساب روح الجماعة وقيمها التقليدية؛ فالعقل الأداتي هو نوع من العقلانية المنعتقة من روابط الغائية الطبيعية والثقافية، وهي روابط ما برحت ضرورية، من أجل تحقيق الذات والقدرات الإنسانية الكامنة. وقد نشأ نهج العقلانية الأداتية مع بروز المؤسسات الاقتصادية الصناعية الحديثة وأسواق التبادل التي نتجت عنها.
من التعددية الثقافية إلى الاعتراف السياسي
ينظر هذا الفصل أيضاً في ضرورة الاعتراف السياسي بالاختلافات الثقافية والعرقية؛ استنادًا لما لهذه الاختلافات من أهمية بالغة على الصعيدين العملي والسياسي. ومن ثَم تجري محاولة التحقق من توافق الاعتراف والليبرالية السياسية التي اعتادت تقليديا الحيادَ إزاء هذه المسائل الشائكة والنسبية والمعقدة.
والاعتراف السياسي بالثقافة ضروري -بحسب تايلر- فهو اعتراف يعرف الثقافة كمنبع أصيل لتعيين المعايير الأخلاقية ويلهم التوجهات السياسية الخليقة ببناء المدينة الإنسانية خير بناء.
وأصبحتْ المجتمعات الغربية اليوم مجتمعات تتعدد فيها الثقافات والأفكار الفلسفية الأخلاقية والسياسية، يسودها الاختلاف حتى التناقض والتنازع؛ لذا فقد تحولت إلى مجتمعات "متعددة الثقافات" بفعل تنقل الأفراد الحر في ما بينها، وتنامي موجات الهجرة إليها. وقد حتمت هذه التغيرات النظر في تداعياتها على هذه المجتمعات وتأثيرها البالغ في استقرارها الاجتماعي والسياسي.
لماذا يصر تايلر على ضرورة الاعتراف السياسي والقانوني بالاختلافات العرقية الثقافية والدينية، خصوصاً وأن تنامي هذه الاختلافات من حيث تمايزها هو مدعاة قلق على وحدة المجتمع وتماسكه؟ وألا تكفل المعايير العامة، من حقوق وواجبات أساسية، في هذه الدول الديمقراطية الغربية، مثل هذه الاختلافات وتصونها في الدساتير وترعاها في الممارسات؟
وبتعبير آخر: ألا تكفي المساواة الديمقراطية في الحريات وأمام القانون في الذود عن حق التمايز والاعتناق الحر لأنماط عيش فريدة يختارها الفرد (أو الجماعة) ويعرف بها هويته الأخلاقية والوجودية؟ أم أنه يجب على هذه الدول أن تبدل في عقيدتها السياسية وتغير في نظرتها القانونية الكلاسيكية بموازاة هذه التغيرات حتى تواكبها؟
يقول الباحث سايد مطر إنَّ قوام هذه الأسئلة هو الاستفسار عن دور ممكن لليبرالية السياسية إزاء مسألة الاعتراف. وهي الليبرالية التي ما برحت تقليديًّا تعتنق "الحياد" إزاء المسائل العرقية والثقافية، بوصفها مسائل لا تعدو كونها خاصةً ولا طاقةَ للدولة على النظر في شأنها.
فقد كان التصور الليبرالي التقليدي يرى في الحياد السياسي ضرورة قصوى للنهوض بالاستقرار الاجتماعي، وإحدى الركائز النهائية التي تؤسس "الشرعية السياسية"، وذلك لسببين رئيسين هما: حماية الحريات المدنية من تدخل الدولة في مسائل كحرية الضمير والدين والاجتماع، ومنعها من أن تكون طرفاً ببت بطلانها أو أحقيتها. والثاني يُعزى إلى حماية الدولة نفسها من الجماعات العرقية والدينية، نائيةً بنفسها عن الحكم في تصورات الخير المختلفة التي ربما تعمد فئةٌ إلى فرضها في الحيز العمومي على فئة أو جماعة أخرى.
الفصل الثالث: "وحدة المجتمع في المشاركة المنوعة والاندماج"
الفصل الثالث، وعنوانه "وحدة المجتمع في المشاركة المنوعة والاندماج"، يظهر فيه الكاتب إيجابية الاعتراف السياسي بالتنوع الثقافي والتعدد العرقي، بناءً على أنه محفز يشجع الأقليات على المشاركة السياسية في شؤون المدينة الإنسانية والاندماج في النسيج الاجتماعي. ويكون هذا الاندماج محكومًا بالتنوع؛ لأن التمايزات الثقافية تظهر في الحيز العام آخذةً بالتلاقي، ساعيةً للتشارك، مستنهضةً للتفاعل فالتقابس. ويركز المؤلف في هذا الفصل على الدور المحوري الذي تمثله المشاركة السياسية في تواصل جميع المكونات المنوعة، خصوصًا الأقليات والجماعات العرقية، ودمجها في الأكثرية حتى تحقيق وحدة المجتمع وتماسكه.
ويعتبر تايلر أن أفراد المجتمع يفصحون عن هويتهم ويطورونها في كنف مؤسسات وبينات وأعراف وعادات مشتركة. إذ يصور الأفراد أنفسهم على أنهم أعضاء ينتمون إلى جماعة سياسية معينة، جماعة تستمد تماسكها ووحدتها بفضل وجود مؤسسات تتفاعل فيها الحياة العمومية وبفضل ممارسات تنمو فيها الحياة الاجتماعية نمواً أصيلاً فريداً. وبهذا المعنى، يعود إلى الأفراد أن يفسروا أنفسهم ويفهموا ذواتهم بمقتضى المسؤولية البنيوية التي يضطلعون بها في داخل المجتمع الذي ينتمون إليه. هذه الممارسة في فهم الذات، "مع ما تنطوي عليه من بُعد معياري هي، بالنسبة إلى تايلر، حاضرة أصلاً في الوقت نفسه في تكوين الهوية المشتركة وتؤثر في الأعمال والتوجهات المنبثقة عنها".
ما السبيل إذاً إلى إيجاد أنموذج للاندماج السياسي يضمن تمثيلاً عادلاً للتنوع العرقي والثقافي، باعتبار أن هذا التنوع هو تنوع يحتشد في الحلبة السياسية ويتنازع في داخلها؟ وفي ذلك بالتحديد تكمن المفارقة الخاصة بفكرة الأمة، بحسب ما يقول ميشال تريشتنكو، التي تتركز وظيفتها على توحيد قوى متضاربة متصارعة. فهي "مفارقة تقوم من جهة على تصورات غير عقلانية وذاتية بدت متعارضة مع عقلانية الدولة الحديثة. في حين أن قوة الأمة من جهة ثانية تُعقد على بسط مشروعيتها التي تنبثق منها كل سلطة سياسية، وعلى وجه خاص سلطة الدولة. فهذا هو الوجه الأسود والوجه الأبيض لفكرة الأمة".
ومن هنا، كان تشديد تايلر على تأسيس وحدة قومية تفيد الاندماج وتستمد جذورها من عاملين متمايزين متكاملين لا يتنافيان: التقارب والشراكة. فتراه يؤكد ضرورة الحصول على تقارب في حده الأدنى بين تعدد الثقافات، لا يكون كاملاً بغية اجتناب الوقوع في معاثر التجانس المُقصية الاختلافات، كما كان سائداً إبان حكم "اليعقوبية" الخاص بالتقليد الجمهوري الفرنسي.
وحقيقة الأمر أنَّ التقارب لا يُفهم إلا على نحو التشارك في ضُمة ضرورية من الحقوق (حقوق الفرد الأساسية بالنسبة إلى تايلر). إلا أن هذا التقارب لا يستنهض العناصر المكونة لوحدة التداول ويستنفدها بالكامل. وبهذا المعنى يؤكد تايلر خطأ الفكرة التي تقول إن وحدة التداول لا تقوم إلا بقيام عناصر مشتركة جامعة، وذلك أن "الخطاب المثالي الشامل لا يفسح المجال للنقاش ولإمكان التعديل".
الفصل الرابع: "العلمانية وتحديات مطالب التكيف"
يطرح الفصل الرابع "العلمانية وتحديات مطالب التكيف" منافع الانفتاح السياسي على التعدد الثقافي، وما يولده هذا الانفتاح من مخاطر الاعتراف القانوني بمطالب الجماعات العرقية والدينية بالنسبة إلى وحدة المجتمع وتماسكه، على أن مطلب تكيف هذه الجماعات أو الأقليات يكون مطلبًا "عاقلًا" عندما يكون ذا جدوى تجاه المصلحة العامة، فلا يعطل عمل المؤسسات العمومية والخاصة التي تجيزه، ولا يتعارض، على أي نحوٍ من الأنحاء، وضرورات تكييف المعايير العامة التي توافقه. ويُناقش في هذا الفصل أيضًا سعي بعض الأقليات والجماعات العرقية المهاجرة، أو غيرها، للمطالبة بأن تكيف الدولةُ المعاييرَ العامة الناظمة حتى تراعيَ بعض ما تُلزمهم به معتقداتهم الدينية. ويرمي المؤلف من هذا الفصل إلى مصاحبة تايلر في استفساره: أيتوافق هذا النوع من التكيف وروح العلمانية أم يعارضها؟
ويقول مطر إن تايلر يحاجج بذوده عن مطالب التكيف الدينية رغم تعارضها الظاهر مع مبادئ العلمانية، بأن حرية الدين لا تعني حرية اختيار المعتقد الديني فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الحق في إظهاره وممارسته في الحيز العام. ويرى تايلر أن الحرية الديمقراطية المجردة غير كافية ويجب عليها أن تتصل بمضامين الثقافة والمجتمع، وضرورة الاعتراف بالمضامين تهدف إلى أبعد من مجرد حصرها في استيعاب الأقليات أو الجماعات العرقية في ثقافة الأكثرية الأرحب؛ فالاعتراف يسهم في مساعدة الأفراد على توجيه حياتهم العملية والوجودية، ويحثهم على الاندماج الاجتماعي ويشجعهم على المشاركة السياسية الفاعلة. ويرفض تايلر مقولة إن الاعتراف يضعف الوحدة الاجتماعية ويشجع الأقليات على الانطواء والانكفاء عن المشهد العام. فهو اعتراف يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي لما يحمله من طاقات التواصل والائتلاف.
---------------------
- الكتاب: مسائل التعدد والاختلاف في الأنظمة الليبرالية الغربية: مدخل إلى دراسة تشارلز تايلر.
- المؤلف: سايد مطر.
- الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015.