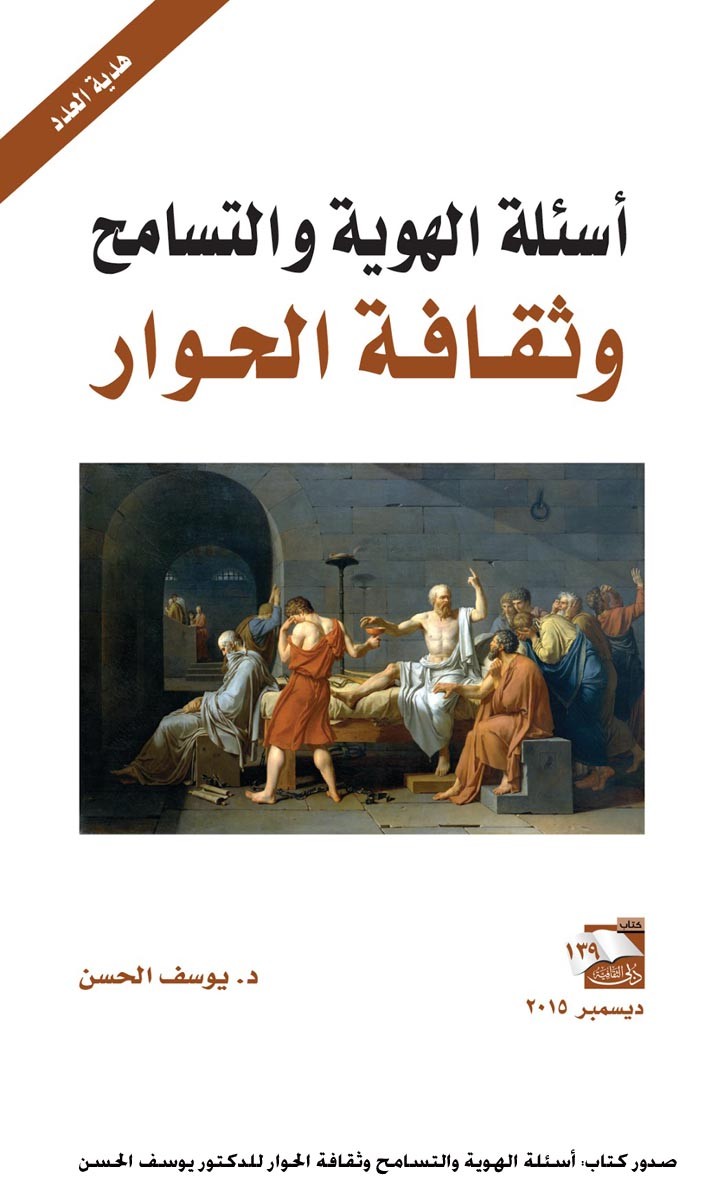فاطمة ناصر
في كتابه "أسئلة الهوية والتسامح وثقافة الحوار"، يُكرِّر الكاتب الدكتور يوسف الحسن أهمية ثقافة الحوار، وأثرها العظيم في المجتمع، وأهمية التناغم مع الاختلاف، وفتح جسور التواصل للتعرُّف على الآخر.
وكمثال على ذلك، يستعرض الكاتب حوارَ الطاولة المستديرة الذي نظَّمته وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في أبوظبي، في مايو 2014، والذي شارك به -حسب ما هو مذكور- مُسلمون ومسيحيون وهندوس وسيخ وآخرون. استعرضوا فيه أعيادَ الفصح وكنيسة المهد التي أمر الشيخ زايد -رحمه الله- بترميمها عام 2002، بعد أن أُصيبت بأضرار جسيمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد أقْلَق الكاتبَ في هذا الاجتماع سُوءُ فَهْم مُمثل الكنيسة الكاثوليكية؛ حيث يقول الممثل إنَّ ثمة جدرانا بين رجال دين الكنيسة وما يقابلهم من علماء دين مسلمين في الإمارات. ويقول الكاتب إنَّ الحوار في الإمارات هو حوار تعايش وحياة، وليس حوارا لاهوتيا. فاللاهوتي له خصوصيته وشخوصه، ويجب أنْ لا يتعرض له العامة، وأرى إن كُنا نُريد حوارا حقيقيًّا وتعايشا بين الناس، فأفضل من يروِّج لهذا الحوار هم رجال الدين! أمَّا ما نراه اليوم من العيش في جُزر مُنفصلة؛ كلُّ دين يُكلم فيه أتباعه فقط، وكل دين ينشر فكره السامي، الذي قد ينتقص فيه من الآخر بقصد أو دون قصد، فهو لا يخلق ثقافة حوار. كما أنَّ المسلم يرى في رجال الدين قدوة، إن نبذوا هم الحوار، فمِنَ الطبيعي أنْ لا يتشجع إليه هو.. فهل يُمكن في مُجتمعاتنا تحديداً، تشجيع الحوار، دون حثِّ المؤسسة الدينية عليه؟!
وفي مثالٍ آخر، يتحدَّث عن استضافة ممثلين من الوفد الإماراتي مع أبرز الإعلاميين على هامش أحد المؤتمرات، ويصفه بأنه لقاء ينوي زجهم في قضايا شائكة، دون الحديث عن هذه القضايا وعن الأسئلة المطروحة لهم. ولا يكتفي عند هذا الحد، بل يستعرض بطولته في الرد على أسئلة امرأة في المؤتمر، يصفها بأن هدفها تشويه سمعة الإمارات، والزج بوفدها في فخ سياسي، حين سألت: "إذا كانت هناك حرية دينية، لما لا تسمحون ببناء معهد يهودي في الإمارات؟". وينتصر عليها بقوله إنهم يحترمون جميع الأديان، ولكنهم لم يتلقوا رغبة في بناء معبد من أي يهودي حسب علمه. وتضجُّ القاعة بالتصفيق، وتخرج السيدة خائبة. وخرجتُ كقارئة خائبة أيضاً، دون الحصول على إجابة لسؤال: "هل كانت الإمارات ستسمح ببناء معبد يهودي لو تلقت طلباً بذلك؟
بعدها، يعرضُ الكاتب رسالة مُوجَّهة إلى قداسة البابا فرنسيس، تعقيباً على زيارته للأرض المقدسة عام 2014، يُطالب فيها البابا بتذكُّر شناعة أفعال المحتل برعاياه وكنائسهم، كما يذكره بتاريخ حائط البراق، الذي كان وقفاً إسلاميًّا منذ 1929...وغيرها من المآسي التي مُورست ضد المسيحيين والمسلمين. كلام الكاتب جميل، ولكنه لا يناقش كيفيه تحقيق الحوار والتسامح؟ وهو كلام عاطفي، يعرض وجهة نظر واحدة، ويعرض نقطة بَدْء لطرف دون آخر، فماذا كان حائط البراق قبل الإسلام؟ إنه أثرٌ مُقدَّس لليهود والمسلمين على حدٍّ سواء. فلماذا حصره على المسلمين فقط؟! فإنْ كان قد سُمِّي حائط البراق لأنه يُعتقد أنَّ الرسول قد ربط فيه دابة البراق قبل الإسراء، فهو حائط المبكى لدى اليهود، لاعتقادهم كذلك أنه آخر أثر لهيكل سليمان. والحقيقة لا نحن كمسلمين نملك دليلا على ربط البراق فيه، ولا اليهود يملكون دليلا قاطعا على ملكيته. وفي النهاية نرى جدارًا من تراب وحجر، مثار جدال ومحل نزاع بين البشر! فعن أي حوار نتكلم إن كنا نثيره كقضية نزاع وإثبات نسب؟!
التسامح
أمَّا في التسامح، فلا يتعرَّض الكاتب لمشكلة التسامح لدينا، ولكنه يقذف بالكرة ويلعب بها في ملعب الغرب. ويستعرض تاريخه المظلم في قمع الآخر في عصور الظلمات (وهذه تسمية الغرب لتلك الحقبة السوداء في تاريخهم)، وإننا كمسلمين وعرب ضربنا أمثلة مُشرقة له في الماضي والحاضر. وإنه ليس علينا سوى استنهاض القيم التي هي حقًّا موجودة لدينا، ولكن يبدو للكاتب إننا عطَّلناها. وقد انتهيت في حيرة من أمري، فأرى الكاتب تارة ينقد محاكم التفتيش في ماضي الغرب الأسود، ويقول إنَّ ماضينا كان أكثر إشراقاً، وتارة يقول يجب أن نُقر بفضلهم في تطورنا الحضاري وأن نُعزِّز حركة الأفكار بين الحضارات. فهل نأخذ منهم، أو نأخذ من ماضينا المشرق في احترام الآخر، أم نأخذ من الاثنين معاً؟ وهذا ما أُفضِّل أخذه شخصيًّا بعد الحيرة التي وقعتُ بها، رغم أني كقارئة كنت أتمنى أن يكون الكاتب أكثر وضوحا في مبتغاه، وفي عرض أفكاره. ماضينا قد يكون في معايير زمانه أيقونة في التسامح، ولكن هل يمكننا اليوم أن نفرض الجزية على الوافدين من الديانات الأخرى مقابل الأمان الذي توفره لهم دولنا؟!
ومن الأمثلة على التسامح التي أوردها الكاتب: اتخاذ صلاح الدين الأيوبي -أثناء حربه على الفرنجة- موسى بن ميمون طبيبا له، وهو كما يقول فيلسوف وطبيب هرب من الظلم الأوروبي. ولا أعلم أين أقف هنا، فهل اتخاذ صلاح الدين لطبيب ماهر تسامح؟! هل كان سيُضحِّي بصحته بين يدي طبيب يهودي، لمجرد كونه يهوديًّا أو ليضرب أمثلة التسامح لنا؟! أم لأنه قدَّر علمه؟! وبين التقدير والتسامح فارق كبير. وتوقفتُ مرة أخرى لأبحث عن تسامح صلاح الدين، فوجدت تضاربا بين رؤيته كبطل، وإجماع معظم المؤرخين على أنه حين دخل مصر وأنهى دولة الفاطميين الشيعية، قام بحرق كتبهم في "دار الحكمة"! مثالٌ لا يدل على التسامح بين مسلمين مثله يشهدون بـ"لا إله إلا الله" ولكنهم يختلفون معه في المذهب. أم أنَّ حالنا هذا رافقَنَا منذ القِدَم، وقد نكون أكثر تسامحا مع الغرب المختلف في العقيدة، ولكننا أقل تسامحا مع المتفق معنا في العقيدة، وإنْ كان مُختلفا معنا في المذهب؟! فعلينا عدم المبالغة في تنزيه أبطالنا التاريخيين؛ لقد أصابوا في أمور، وأخطأوا في أخرى، وهذا حال البشر.
ومن بَيْن السطور، يُثير الكاتب في ذهني تساؤلات عديدة، أشكره عليها؛ أهمها: مصطلح "التسامح" ومعانيه. ورغم أنَّ الكاتب لم يتعرَّض لهذا المفهوم ومعانيه، أرى أن عرضها عليكم ضروري.
مفهوم "التسامح"
يقول الكاتب إنَّ الشاعر أدونيس لا يُحبِّذه، ويفضِّل عليه مفهوم "المواطنة"، وكذا الحال في ماليزيا؛ حيث المؤتمر الذي حضره كانوا يفضلون مفهوم "التناغم" على "التسامح". ولم يقف الكاتب عند هذه الفكرة. فما القاسم المشترك بين هؤلاء؟ ولماذا يرفضون لفظة "التسامح"؟ نرى أنَّ بين أدونيس ونظرة ماليزيا قواسم مشتركة، فكلاهما يعتقد أن "التسامح" مفهوم استعلائي، يُطلقه من يظنُّ أنه أسْمَى وأفضل، على قدرته في تقبُّل من يظنه أدنى شأناً.
يُنهي الكاتب هذا الفصل بدعوته إلى إدخال مفاهيم التسامح إلى تربية النشء منذ الصِّغر، مع ضرورة أخذ التشريعات الدولية التي صاغتْ قيم التسامح وحدَّدت مجالاتها، وتضمينها في المناهج التربوية. ولم يناقش الكاتب للأسف هذه المضامين والتشريعات الدولية، وهل تتماشى مع دساتير دولنا الإسلامية مثلا؟! وهل ستقبل هذه الدول معايير التسامح الغربية من تقبُّل المختلف ليس في الديانة وحسب، بل المختلف في توجهاته الجنسية مثلا؟ أصاب بخيبة لعدم وجود الإجابة هنا.
التكفير والتراث
لعلَّ هذا الفصل أكثر الفصول إقناعا، وبه مُكاشفة واعتراف بالمشكلة التي تواجه عالمنا اليوم. يقول الكاتب إن "ذئب التكفير موجود في البيت العربي"، وإن الفكر هذا انتشر منذ فترة، ولم يلقَ التصحيح اللازم، وإن فتاوى ابن تيمية وغيره ممن أباحوا الدماء، ونشروا ثقافة التكفير والجهاد دون تدبُّر معانيه الصحيحة. وفي مناخ أتاح لهذه الحركات أن تتطوَّر، ظهرتْ جماعات كثيرة كالتكفير والهجرة، والطليعة المقاتلة، والجهاد الإسلامي، والقاعدة، وصولا إلى "داعش" اليوم. ومن المهم أن نقف وقفة أمام أدبيات هذه الجماعات، وكيف أنَّ النتاج الفكري كان مُلازما لها ولظهورها وتطوُّرها. ومن المهم دراسة أبرز أدبياتهم: ككتاب "معالم على الطريق" لسيد قطب، و"إدارة الفوضى المتوحشة" وهو كتاب نُشر عبر الإنترنت. وأضيفُ لما ذكره الكاتب أنَّ أسانيد هذه الجماعات تتعدَّى هذه الكتب، فهي تطال حتى كتب الحديث التي لم تُنقَّح من الضعيف والموضوع فيها.
أجدُني أيضًا مُلزمة بأن أعترفَ، بأنَّ حالي كان حال الكثيرين ممن يتلقون العلم على ألسنة شيوخهم المفضَّلين، ولم أنبش كُتبَ التراث بنفسي. ولكن مساري تغيَّر، فأنا اليوم أسمع من الآخرين، وأقرأ لنفسي أيضًا؛ فلا يوجد نقل دون إضافة وجهة نظر شخصية، حتى قراءتي هذه تحملُ وجهة نظري الشخصية حول هذا الكتاب، وأقول لكم لا تكتفوا بما أكتب، ولا تتأثروا به كثيرا.
تفاءلتُ خيرًا حين شدَّد الكاتب على ضرورة إعادة فهم وقراءة التراث؛ فهو ليس بصنمٍ وإنما بصُنْعِ بشر مثلنا. وتفاجأتُ بعدها بأنَّ الكاتب يستثني السُّنة من هذا التراث البشري، ويقول إنها ليست من التراث وإنها عقيدة إلهية! السُّنة التي نهى الرسول عن تدوينها، ودُوِّنت بعد وفاته بقرون، وتحديدا في عهد عُمر بن عبدالعزيز -الملقب بخامس الخلفاء الراشدين- كيف تكون مُنزَّهة ونضعها في مَقام القرآن، وكلنا يعلم أن بها أحاديث ضعيفة وموضوعة كذلك؟!
أثارَ الكاتبُ أيضًا نقطة مُهمَّة في هذا الفصل، حول تكفير الجماعات المتطرفة كـ"داعش" مثلاً، فهل نُؤيد تكفيرها، أم أنَّ الأزهر أصاب في عدم تكفيرها. يرى الناس أن عدم تكفير "داعش" هو تأييدٌ لهم. ويُنبهنا الكاتب مشكورا إلى أنَّ التكفير لا يعني القبول، ويقول إنَّ عَليًّا قاتل الخوارج، ولكنه لم يُكفرهم؛ لأن التكفير مسألة شرعية، ومردُّها إلى الله. تكفير "داعش" قد يكون رغبة غالبية الناس، الذين يتألمون من الفظاعات التي يرتكبها هذا التنظيم. ولكن هل الحل أن نسلك مسلكهم، فنكفرهم كما يكفروننا؟!
الهُوية والثقافة
الأمن الثقافي، مُصطلح مهم، يرى الكاتب أنَّ تقارير التنمية تتجاهله، وهو الذي لا يقل أهمية عن الأمن الصحي، والأمن البيئي...وغيرهما. لا يُنكر أحد أن من أبرز مشكلات الأمم هي أزمات الهُوية. لا يتكلم الكاتب عن مصدر الأزمة، ولكنه يعرضُ حلولا جيدة. وقبل البدء في سردها، سأقول باختصار إنَّ الأمة أو النظام المهيمن، يفرضُ سيطرته على مناحٍ كثيرة؛ أحدها الهيمنة الثقافية. النظام الرأسمالي اليوم، يفرض ثقافته على التابعين له، والأمر يواجه العرب، كما يواجه الغرب على حد سواء. إن التفاصيل الثقافية تتلاشى شيئا فشيئا، فنرى تشابه الأزياء، وتشابه اللسان -هيمنة لغة على لغات أخرى. لهذا قد تكون الوطنية والاعتزاز بتاريخنا أمرًا مُهمًّا لمواجهة التغريب.
وعن الثقافة ودور المثقفين، يعتبُ الكاتب عَتَباً كبيرًا على مُثقفينا، وعلى تحزُّبهم وفرقتهم. فكلٌّ يُدافع عن حزبه؛ فالإسلامي يدافع عن مشروعه، والليبرالي كذلك، وقد تعدَّى الأمرُ ليصل إلى دفاعهم عن المذاهب التي يعتنقونها! وبين هذه الجزر المتفرقة، يغيبُ العمل الحقيقي في الميدان، الذي من شأنه التقريب والفهم. ويُعرِّج بعدها على الحديث عن أهمية الثقافة السياسية، ودور الدول في رعاية وإبراز قيم التسامح والحوار والمساواة بين المواطنين، وعدم تجاهل طرف دون آخر يعيشون معاً في الوطن نفسه.
ملاحظات ختامية
أولا: أهو قول الكاتب أم نقله؟.. في بداية الكتاب يذكُر الكاتبُ أنه جاءه مُشارك في أحد المؤتمرات يسأله: كيف يكتب ما يكتبه عن الحوار الإسلامي؟ فرد عليه: "أتصوَّر دائماً أنَّ مسيحيًّا يقف وراء ظهري، ينظر إلى ما أكتبه، وكأني به يريدني أن أكتب على الأقل ما يُنصفه ولا يغيظه، وأن أذكر القواسم المشتركة...". وفي مصادفة -أحاول أن أُحْسِن الظن بها- تردُ ذات العبارة في آخر الكتاب على لسان رجل لاهوت مسيحي!
ثانياً: الانتقائية.. الحديثُ عن التسامح يجدر به أن يكون شاملا وليس انتقائيًّا، ولكنَّ الكاتب يحصر دعوات التسامح والحوار على المسيحيين، ولا يتعرَّض لليهود!
ثالثا: الحلول التي وضعها الكاتب لتعزيز قيم التسامح والحوار جيدة، ولكنه يحصرها في دور الدولة، ويستثني دور علماء الدين، الذين ربما يكون خطابهم سبباً من أسباب هذا الصراع الطائفي. فكيف لا نُشركهم في الحل؟! فكم من دولة تسامحتْ في سياستها، خرجت منها عقول مُغيَّبة، بسبب عدم مراجعتها الخطاب الذي تبثُّه مساجدها وجوامعها؟!
--------------------
- عنوان الكتاب: "أسئلة الهوية والتسامح وثقافة الحوار".
- المؤلف: د.يوسف الحسن.
- الناشر: دار الصدى للصحافة والنشر، دبي.
- سنة النشر: 2015.