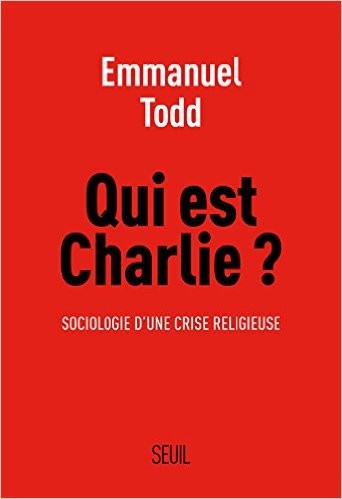لإمانويل تود
مُحمَّد الحدَّاد
يُعتبر إمانويل تود من أبرز المفكرين الفرنسيين من ذوي الإنتاج الثقافي المتنوِّع والمجدِّد، ولقد جَمَع في تكوينه الأكاديمي بين اختصاصات ثلاثة؛ هي: الأنثربولوجيا، والتاريخ، والديمغرافيا؛ بما جعله ينظر إلى قضايا العصر بطرق تختلف كثيرا عن السائد، ويتنبأ بأحداث قبل وقوعها؛ مثل كتابه الأول الصادر عام 1976 بعنوان "محاولة في درس انحلال المنظومة السوفييتية". وقد تجرَّأ عام 2002 بإصدار كتاب عنوانه "ما بعد الإمبراطورية..محاولة في درس انحلال المنظومة الأمريكية"، والذي أَحْدَث جدلاً كبيرًا في أوساط المثقفين والسياسيين. وفي العام 2008، أصدر كتابا أثار بدوره جدلا واسعا وكان عنوانه "ما بعد الديمقراطية".
ويُعتبر تود من المجددين في الدراسات الاجتماعية منذ أن أصْدَر عام 1983 أطروحته "الكوكب الثالث: البنى الأسرية والمنظومات الأيديولوجية"، وقد خطَّ فيها منهجا متميزا يعتمد على البحث في العلاقة بين الأيديولوجيات التي تنتشر في فترات معينة والسلوك الأسري والإنجابي الذي يتوازى معها. ويمكن القول بأن كتابه الأخير "من هو شارلي؟" (2015)، تطبيق جديد لهذا المنهج الذي افتتحه منذ أكثر من ثلاثين عاما على موضوع حارق وهو العلاقة بين الأديان، وتحديدا ضرورة قبول الغرب بحقيقة أن الدين الإسلامي أصبح جزءًا من مجتمعاته وتركيباته السكانية.. فالكتاب يتقاطع مع الاهتمامات التقليدية الثلاثة لكاتبه؛ وهي: متابعة تطورات المجتمعات الغربية (صدر له سابقا "ابتداع أوروبا" 1990م)، ومتابعة قضايا الهجرة (صدر له سابقا: "مصير المهاجرين" 1994م)، وحوار الأديان (صدر له سابقا: "الموعد بين الحضارات" 2011م).
ومن جهة الأسلوب، يتميَّز الكتاب الحالي بالمخاصمة والاستفزاز، وأطروحته واضحة منذ صفحاته الأولى؛ فهي إنذارٌ حازم بأن تنامي كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) في الغرب أصبح خطرا على المجتمعات الغربية ذاتها، والكتاب دعوة قوية لضرورة احترام أديان الغير، واحترام الإسلام تحديدا الذي أصبحت أطراف عديدة تستعمله كشماعة تعلق عليها فشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتَّخذ تود وطنه فرنسا مختبرا أساسيا لإثبات أطروحته، رغم أنه لا يفتأ يذكر في ثنايا الكتاب أنَّ المشكل ذو بُعد أوروبي بالأساس. انطلق الكاتب من المسيرة الضخمة التي نُظِّمت في المدن الفرنسية يوم 13/01/2015 للتنديد بعمليات استهداف الصحيفة الساخرة "شارلي إيبدو"، وقد حصل شبه إجماع بين الطبقة السياسية والثقافية على أنها مسيرة الوحدة الوطنية، بما أنها جمعتْ حوالي أربعة ملايين متظاهر رفعوا جميعا شعار "أنا شارلي..أنا فرنسا". الكاتب يتحدَّى هذا الإجماع المزعوم ليعلن -انطلاقا من تحليل سوسيولوجي للتركيبة الديمغرافية للمتظاهرين- أنَّ هذا الحدث مثَّل ضربًا من الجنون الجماعي والعنصرية الخفية، وخروجا على المبادئ الحقيقية للوحدة الوطنية. فمن الذي سمح للمتظاهرين بأن يساووا بين الانتماء إلى فرنسا والانتماء إلى شارلي؟ ومن الذي منحهم الشرعية للسخرية من عقائد الآخرين باسم الحرية، مع أنَّ الحرية التي كان يدعو إليها فلاسفة التنوير هي تلك التي تقوم على مبدأ نقد الذات وليس على التعامل البغيض مع الآخر؟ وهل يمثل أربعة ملايين متظاهر إلا حوالي 6% من مجموع الفرنسيين، فكيف يمكن الزعم أنهم يتحدثون باسم فرنسا، وأولى زعمهم التحدث باسم الإنسانية والكونية؟
إنَّ "شارلي" -بمعنى الشخص الذي نزل للتظاهر يوم 13/1، رافعا شعار "أنا شارلي"- إنما هو الشخص الأناني الذي ينتمي إلى الشريحة المستفيدة من النظام الاقتصادي السائد، والذي يشعر بالقلق على مستقبله، فيبحث عن كبش فداء يُحمِّله مسؤولية الفشل والتهديد؛ وذلك عبر النفخ في الإسلاموفوبيا وتوجيه الحقد إلى الأقلية المسلمة. يُبيِّن تود -عبر تحليل دقيق للتوزيع الديمغرافي للمتظاهرين- أنَّ ثمة تطابقا تاما بين نسب توزيعهم بين المناطق والشرائح يوم 13/1 ونسب التصويب بالإيجاب في الاستفتاء الشعبي على معاهد ماستريخت سنة 1992. ويفترض الكاتب أنَّ جوهر القضية ليس موقف الفرنسيين من الإسلام، ولكن أزمة الدين في الضمير الفرنسي، والغربي عامة. فهو يرى أن الجزء الذي فقد حماسته الدينية للمسيحية قد حوَّل هذا الإيمان إلى أوروبا، واقتنع بأنَّ الوحدة الأوروبية التي أرستها معاهدة "ماستريخت" ستحقِّق له الجنة الليبرالية الموعودة والأخوة بين الشعوب الأوروبية، لكنه يشعر اليوم بفشل هذا المثل الأعلى الذي استبدل به إيمانه الديني القديم، فيستعيد شعورا قديما بالكراهية للإسلام كي يحمله مسؤولية هذا الفشل، باتهامه بتغذية الإرهاب وإعاقة اندماج أبناء المهاجرين وتهديد الحريات، مع أنَّ هذه القضايا محدودة وهي من صنف النتائج لا الأسباب، حسب الكاتب؛ لذلك يُثبت الكاتب -حسب دراسة التوزيع الديمغرافي للمتظاهرين- أنهم لم ينجحوا في استقطاب العمال والشباب وكل الفئات التي تعاني -مثل المهاجرين المسلمين- من الآثار المدمِّرة لليبرالية الاقتصادية التي فرضتها الوحدة الأوروبية.
"شارلي" يَكْرَه الإسلام لأنه لا يريد الاعتراف بحقيقة فشل المنوال الاقتصادي الأوروبي ومسؤوليته في تنمية الفقر والحيف. والإسلام يستقطب أعدادا متزايدة من الشباب المسلم والمتحول إلى الإسلام لأنه يؤجج من جديد مبدأ المساواة الذي تسعى الأيديولوجيا المهيمنة إلى إقناع الناس بأنه لم يعد مطلوبا ولا مرغوبا، وأن وجود ملايين العاطلين عن العمل والمهمشين هو من حتميات الأقدار والقوانين الطبيعية وليس من نتائج السياسات الأوروبية المعتمدة. لقد ضعف الإيمان المسيحي في نفوس هؤلاء، ثم ضعف الإيمان السياسي بأوروبا، فتحوَّلت طاقتهم الإيمانية نحو معاداة دين آخر وشيطنته، في محاولة أخيرة للمحافظة على التوازن النفسي في عالم أضحى مُفرَّغا من المعنى وخاويا من المثل العليا.
ويَرَى الكاتب أنَّ أوروبا شهدتْ مَوْجتين من تراجع الإيمان الديني، وأنها استبدلت في الأولى الإيمان الديني بالفلسفة الاشتراكية الحالمة بالفردوس البروليتاري، والمجتمع الذي تنمحي منه الطبقات وتعم فيه المساواة. ثمَّ استبدلتْ في الثانية الإيمان الديني بالوحدة الأوروبية التي تحقق الرفاه والأمن للجميع. ويحذِّر الكاتب من أنَّ كل عملية "تحوُّل" إيماني في التاريخ ترتَّبتْ عليها حتمًا موجات من الاضطرابات الاجتماعية والعنف الجماعي. وكما وُلدت النازية من رحم الأزمة الدينية الأولى، وحمَّلت اليهود مسؤولية الأزمة، وترتب على ذلك اضطهاد الملايين منهم، فإنَّ الإسلاموفوبيا بصدد النشأة والتضخم من رحم الأزمة الدينية الثانية لتحمل المسلمين المسؤولية. والخطر لا يُهدِّد الأقلية المسلمة فحسب، بل يهدد -حسب الكاتب- الأقلية اليهودية التي ستجد نفسها مجددا ضحية اللاسامية، ويهدد الطبقات العاملة والمحرومة التي سيواصل النظام الاقتصادي القائم سحقها دون رحمة؛ فالتهديد يتجه إلى المجتمع كله وإلى تجانسه، والذين ظنوا أنهم يُجسِّدون الوحدة الوطنية يوم 13/1 قد دقُّوا إسفين الشقاق الثقافي والاجتماعي بين أفراد الشعب وفئاته. وداخل الأقلية المسلمة ذاتها، سيجد المعتدلون أنفسهم -وهم الأكثر- بين مطرقة التطرف الإسلامي وسندان تصاعد الإسلاموفوبيا، فتضعف مواقعهم وتتراجع شيئا فشيئا لصالح المتطرفين. يقول الكاتب: "إن النجاح الأكبر الذي حققته الإسلاموفوبيا هو تحويلها النتيجة إلى سبب؛ بادعاء أنَّ الاختلاف الثقافي هو الذي يمنع سكان الأحياء الفقيرة من الاندماج في المجتمع، ويفسر النسبة المرتفعة للبطالة لديهم" (ص:193).
... إنَّ هذا القلب في وضعية الأشياء هو الذي يفضي إلى حلقة مفرغة، أي مزيد تقوقع المسلمين على أنفسهم واتجاههم إلى الراديكالية، مُستقطبين معهم جزءا من الشباب المهمش المتحول إلى الإسلام (يقدره الكاتب بنسبة 20%)، ثم مزيد الاضطرابات داخل الأحياء الفقيرة، بما في ذلك تنامي أعداد المتعاطفين مع الإرهاب، فردة فعل عاطفية وانفعالية من الجزء الآخر من الشعب نحو مزيد من الكراهية للإسلام وتشجيع التيارات السياسية والثقافية العنصرية. أما الإمكانية الأخرى الإيجابية، فتتمثل في اندماج المسلمين مع النصف الآخر من الشعب الذي يعاني الآثار المدمرة لسياسات الحيف والتفقير، وهذه الإمكانية واردة ولها في العمق ما يسمح بالسير في اتجاهها؛ إذ إنَّ هذا الالتقاء يُمكن أن يحدث لا على أساس ديني وإنما على أساس مبدأ المساواة الذي يشترك فيه الإسلام وشعار الجمهورية الفرنسية. لكنَّ الكاتب يشكُّ في تحوله إلى واقع قائم، ويرى أن النصف الأول من المجتمع -المستفيد من الوضع الحالي- يستعمل كل ما في وسعه للمحافظة الأنانية على امتيازاته بتحويل الصراع من حقيقته الاجتماعية إلى صورة دينية، ويؤجِّج المعاداة البدائية للإسلام والقلق النفسي للأفراد الذين خسروا في الآن ذاته إيمانهم المسيحي ومثلهم الأعلى الأوروبي، فأصبح معاداة الآخرين الرابط الأيديولوجي الذي يُوحِّد بينهم؛ لذلك اختار تود في هذا الكتاب أسلوبا تحليليا مستفزا ومباشرا ليقرع نواقيس الخطر الداهم.
لقد حلَّل تود حدثا بارزا حصل في بداية السنة 2015، ويعتبره المراقبون حدثا فارقا في الوضع الأوروبي برمته؛ إذ أدَّى إلى زلزلة المنظومة الأمنية الأوروبية برمتها (نظام "شينجان")، وغيَّر العديد من التحالفات السياسية. ومن المفيد تقييم الكتاب بعد أن بلغنا آخر السنة وحصل منذ ذلك الحين ما حدث، خاصة:
1- العملية الإرهابية الثانية التي حصلتْ في فرنسا يوم 13/11، وأدت إلى عدد أكبر بكثير من الضحايا، بما أثبت أنَّ الوحدة الوطنية وكل الإجراءات التي اتخذت بعد العملية السابقة لم تجد نفعا. ومن هذا المنظور، يُمكن القول بأنَّ تحاليل تود قابلة للمراجعة؛ فالإرهاب ليس ظاهرة محدودة كما افترض في كتابه، وليس مجرد رد فعل من شباب عاطل عن العمل يشعر بالتهميش والنقمة. الإرهاب مشروع مُعولم يستفيد من العولمة الليبرالية المتوحشة التي نقلت جزءًا من السياسات الخارجية من المطابخ الدبلوماسية إلى أجهزة المخابرات وألغت الرقابة على العمليات المالية، بما جعل جزءا مهمًّا من القرارات في السياسة الدولية يحصل خارج المراقبة الديمقراطية للشعوب والمفاوضات الرسمية بين الدول، والسماح بتعريض شعوب بأكملها للإبادة من أجل السيطرة على حقول النفط أو توقيع المعاهدات الاقتصادية غير المتكافئة. ومن هنا تتنزل مسؤولية الحكومات الأوروبية التي لم تستفد من الوزن الاقتصادي الأوروبي لمعارضة هذا التوجه، بل انخرطت فيه وأساءت التقدير في العديد من الملفات -مثل: سوريا وليبيا- ولا علاقة لذلك بوضع الأحياء الفقيرة أو اندماج المهاجرين، أو لنقل إن هذه العلاقة تأتي من باب النتيجة لا السبب.
2- التردُّد الأوروبي في مواجهة الخطر الإرهابي بين موقف يدعو إلى سياسية وقائية تعتمد التدخل المباشر في بؤر التوتر الإقليمية لإيقاف الإرهاب من المنبع، وموقف يفضل النأي بالبلدان الأوروبية عن التوترات الإقليمية، مُحافظة على مصالحها وأمنها وسلامة مواطنيها. ومن هذا المنظور تبدو تحاليل تود سليمة ومُحقَّة؛ لأنها قد حذَّرت من أن أوروبا بقيت في مستوى السوق المشتركة، ولم ترتقِ إلى مستوى القوة السياسية والأمنية المشتركة، فظل كل بلد يراعي مصالحه الخاصة. وقد حصلت في أواخر السنة 2015 تطورات بارزة؛ لعل أهمها: قرار ألمانيا بإرسال قوات محاربة لمعاضدة الجيش الفرنسي في مالي، وهذا أول تدخل عسكري ألماني خارج الحدود منذ الحرب العالمية الثانية، وقرار بريطانيا توسيع ضرباتها الجوية إلى سوريا بطلب من فرنسا، لكنَّ السؤال المطروح: هل هذه القرارات بداية لتوحيد السياسة الخارجية والأمينة لأوروبا، أم هي من قبيل رفع العتب وذر الرماد في العيون؟
3- أزمة اللاجئين: وهي أزمة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد جعلت أوروبا تتحمل رغما عنها نتائج الأوضاع الإقليمية، ووضعتها في خيار صعب بين مبادئ التوقي الأمني والتطبيق الحرفي للقوانين والمعاهدات من جهة، والموقف الإنساني المتمثل في استقبال الآلاف من النساء والأطفال الفارين من بؤر الصراع من جهة أخرى. وطبعا لم يتوقع تود هذه الأزمة عند تحرير كتابه، إلا أنَّه طرح أسئلة جديدة ومهمة حول قضية اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية. وعلى سبيل المثال: نرى مع أزمة اللاجئين أن استقبال ألمانيا لعشرات الآلاف منهم لا يمكن أن يفسر فقط بأسباب إنسانية؛ فثمة أيضا خلفيات ديمغرافية -هرم سكان أوروبا- واقتصادية -الحاجة مجددا إلى يد عاملة رخيصة لاستعادة النشاطات الصناعية التي تحولت إلى البلدان الصاعدة منذ بداية العولمة- فقضية الهجرة والاندماج تحتاج لمراجعات جذرية ترتبط بدراسة حاجيات المجتمعات الغربية نفسها وليس حاجيات المهاجرين فحسب. وقد ساهم تود في فتح هذه المراجعات في هذا الكتاب، وأيضا في كتابه السابق "مصير المهاجرين" 1994م.
4- تنامي حركات اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا؛ بسبب انتقال الأزمات إلى الداخل الأوروبي، مقابل تنامي اهتمام الرأي العام بما يحصل في الشرق الأوسط ودول الجوار وتعالي الأصوات التي تحمل الحكومات الأوروبية المسؤولية؛ بسبب الصمت أو التواطؤ أو سوء التقدير عند ضبط السياسات الخارجية. كما أثبتت أزمة اللاجئين وجود تعاطف عميق لدى المواطنين العاديين مع معاناة الآخرين، وتطوعهم لمساعدتهم بصرف النظر عن الاعتبارات الدينية أو السياسية. ومن هذا المنظور، يُمكن القول بأن تحاليل تود -والجدل الكبير الذي أحدثه كتابه عند صدوره- قد ساهمت في التنبيه إلى أنَّ تنامي الإسلاموفوبيا يخدم صعود اليمين المتطرف، لكن النصف المستفيد من المجتمع، كما دعاه تود، لن يسلم زمام أمره بسهولة إلى هذا اليمين. وفي الانتخابات الجهوية التي شهدتها فرنسا في بداية شهر ديسمبر 2015، حَظِي حزب "الجبهة الوطنية" (أقصى اليمين) بأعلى نسبة تصويت في تاريخه، لكنه في الآن ذاته لم ينجح في الوصول للمرتبة الأولى في أي جهة من الجهات الفرنسية.
أجل.. ثمَّة إعادة رسم للخارطة السياسية الداخلية في البلدان الأوروبية، لكنها ليست بالضرورة بالشكل الاستقطابي الحاد والمتشائم الذي تصوره تود.
وتظلُّ أهمية الكتاب في إدانته القوية والصريحة للإسلاموفوبيا، وتوجيه كل الاتهامات للإسلام والمسلمين، بدلًا من السعي لحل المشكلات المتراكمة للمجتمعات الأوروبية؛ سواء منها الداخلية (البطالة، وتراجع النمو، وهجرة الصناعات إلى البلدان الصاعدة، والتفكك الأسري...إلخ)، أو الخارجية (السياسات القصيرة النظر)، أو البينية (غياب القواعد الواضحة للسياسات الأوروبية المشتركة في الكثير من المجالات الحيوية، وقد برز هذا الأمر بجلاء مع أزمة اللاجئين). والكاتب مُحقُّ عندما يؤكد أن شعار "أنا شارلي" ليس إلا شعارا للتعمية على تلك المشكلات، واختزال بسيط لقضايا معقدة في حقِّ حرية ثلب ديانة أخرى.
------------------------------
- الكتاب: "من هو شارلي؟ تحليل اجتماعي لأزمة دينية".
- المؤلف: إمانويل تود.
- الناشر: باريس، منشورات سوي، (باللغة الفرنسية).
- سنة النشر: 2015.