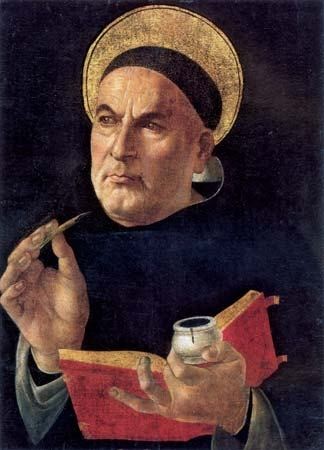شفيـعة بليـلى|أستاذة جامعية بالمدرسة العليا للأساتذة بالجزائر
إن ثمة تأثيراً للأشياء بعضها في بعض؛ أي أن الموجودات تخضع لسلسلة من العلل، وأن هذه العلل لا يمكنها ألا تنتهي؛ فالعالم عبارة عن مجموعة أو سلسلة من الحوادث، وكل حادث يفترض محدثا؛ أي أن كل مفعول أو فعل يتطلب فاعلا؛ " فالكتابة لا بد لها من كاتب، ولا بد للصورة من مصوّر، وللبنّاء من بانٍ، وإنّا لا نشك في جهل مَنْ أخبرنا بكتابة حصلت لا من كاتب، وصياغة لا من صائغ، فوجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها(1)، والحوادث والموجودات لا يمكن أن تكون العلة المؤثرة أو الفاعلة لنفسها؛ وإلاّ وجب وجودها قبل وجودها، وهذا خلف. فهي إذن تحتاج إلى علة خارجة عنها، وهذه العلة تحتاج بدورها إلى علة أخرى، ومهما بدت سلسلة العلل طويلة فإنه يمكن حصر حلقاتها في: معلول أخير لعلّة متوسطة وهو ليس بعلّة، وعلة متوسطة للمعلول الأخير من جانب، ومعلول للعلة الأولى من جانب آخر، وعلّة أولى هي علة عامة للعلة المتوسطة وللمعلول الأخير. ولكي توجد الموجودات يجب أن يتوفر شرطان ضروريان هما:
الشرط الأول: أن توجد العلة الأولى؛ لأنها رأس السلسلة، فلو ارتفعت أو انعدمت انعدم ما ينجر عنها من معلول أخير وعلل متوسطة.
الشرط الثاني:عدم التسلسل اللانهائي في العلل المتوسطة؛ إذ القول بإمكان الرجوع إلى ما لانهاية له في تسلسل العلل هو استغناء عن العلّة الأولى؛ لأن علّة المتأخّر في المتقدم، ومن استغنى عن المتقدّم استغنى عن المتأخر والمتوسط أيضا، ومن ثمي لا وجود للفاعل ولا للمفعول، في حين أن وجود المفعول يثبته الواقع وهو الموجودات والحوادث، فمنهضرورة الوقوف عند علة أولى فاعلة مؤثرة.
والعلل المتسلسلة هي تلك التي لا تتماسك فيما بينها من خلال رابطة عرضية؛ بل تلك. التي وجود إحداها منوط بأخرى لأجل ذلك يستحيل فيها أن تتسلسل إلى غير نهاية بالذات كأن تكون العلل المقتضاة بالذات لمعلول ما متكثرة إلى غير النهاية، كما لو تحرك الحجر من العصا، والعصا من اليد، وهكذا إلى ما لا يتناهى؛ ولكنه لا يستحيل فيها أن تتسلسل بالعرض كأن تكون جميع العلل المتكثرة إلى غير النهاية في مقام علة واحدة فقط وإنما تكثرت بالعرض؛ ولكي يوضّح الأكويني هذه الفكرة، يعطى مثالا قدّمه " الغزالي" ليؤكد وجود كثرة غير متناهية بالعرض. فيقول :" كما يفعل الصانع بمطارق كثيرة بالعرض لانكسار الواحدة بعد الأخرى، فيعرض إذاً لهذه المطرقة إن تخلفت الأخرى في الفعل، وكذا يعرض لهذا الإنسان من حيث يولّد أن يكون متولّداً من آخر؛ لأنه إنما يوّلد من حيث هو إنسان لا من حيث هو ابن إنسان آخر، فإن الناس المولّدين لهم مرتبة واحدة في العلل الفاعلية، وهي مرتبة المولّد الجزئي، وعلى هذا فليس يستحيل أن يتولّد إنسان من إنسان إلى غير نهاية؛ وإنما يستحيل ذلك لو كان توليد هذا الإنسان متوقفاً على هذا الإنسان، وعلى الجسم العنصري، وعلى الشمس، وهكذا إلى ما لا يتناهى"(2).
ويشير الأكويني إلى أن تسلسل العلل غير مقيد بالتتابع الزمني؛ بل هو مقيد بشرط الوجود، كما أن كل فاعل ينتج معلولاً مشابهاً له وفقا للمبدأ القائل: " لا يمكن أن يعطي الفاعل إلاّ مما يملك "؛ يقول الأكوينى:
" إننا نجد في المحسوسات الشاهدة ترتباً بين العلل المؤثرة، وليس يرى مع ذلك، ولا يمكن أن شيئا يكون علة مؤثرة لنفسه للزوم وجوده قبل نفسه، وهذا محال، والتسلسل ممتنع في العلل المؤثرة؛ لأن الأول بين جميع العلل المؤثرة المترتبة هو علة الوسط، والوسط هو علة الأخير سواء كان ثمة وسط واحد أو أوساط كثيرة؛ لكنه إذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، فإذاً لو لم يكن في العلل المؤثرة أول لم يكن فيها أخير ولا وسط، ولو تسلسلت العلل المؤثرة لم يكن علة أولى مؤثرة، فلم يكن معلول أخير، ولا علل مؤثرة متوسطة، وهذا بيّن البطلان، فلا بد إذن من إثبات علة مؤثرة أولى وهي التي يسميها الجميع الله"(3).
يقترب الأكويني بقوله هذا من رأي ابن سينا، الذي يرى:" أنه إذا فرضنا معلولاً، وفرضنا له علة، ولعلته علة، فليس يمكن أن يكون لكل علة بغير نهاية؛ لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض؛ كانت علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليهما... ولكل واحد من الثلاثة خاصية، فكانت خاصة الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء، وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره، وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرف. وليس يجوز أن تكون جملة علل موجودة، وليس فيها علة غير معلولة وعلة أولى؛ فإن جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف، وهذا محال"(4).
يعزو الأكويني تأثره في هذه القضية إلى أرسطو، وبالضبط إلى الكتاب (II من الإلهيات)،(5)فإذا رجعنا إلى هذا النص وجدنا أن أرسطو يبين فعلاًاستحالة التسلسل في جنس العلل المادية أو المحرّكة أو الغائية أو الصورية (6)؛ ولكنه لايعدّ فعلا العلة الأولى علة فاعلة؛ بل علة محرّكة وغائية. كيف نسميها فاعلة؟ وهي لم تفعل سوى إخراج الأشياء من القوة إلى الفعل، أو ربط المادة بالصورة، فلم تخلق شيئا، ولم تحفظه، بل لا علاقة لها بالعالم؛ لأنها تجهل أصلا هذا العالم، ففعلها إذن لم يتجاوز كونه عملا طبيعيا فقط. يقول ابن رشد: " إن الفاعل عند أرسطو ليس هو جامعاً بين شيئين بالحقيقة؛ وإنما هو مخرج ما بالقوة إلى الفعل " (7).في حين أن العلة الفاعلة عند مفكري الإسلام جميعهم وعند الأكويني أيضًا ليست علّة التغير، أوتنقل الأشياء من القوة إلى الفعل فقط؛ بل علة منتجة وخلاّقة تمضي بمعلولاتها إلى الوجود، من هنا كان الوجود كله-وهو المفعول بفعل الخلق- أثراً للفاعل الأول والحقيقي وهو الله. يقول الأكويني: " لما كان كل فاعل يجب أن يتصل بما يفعل فيه مباشرة، وأن يماسّه بقدرته ... وكان الله هو عين الوجود بماهيته، يجب أن يكون الوجود المخلوق هو أثره الخاص، كما أن إصدار الناريّة هو أثر النار الخاص(8).
لا يتوقف دور العلّة الفاعلة هنا؛ بل هي تحفظ وجود الأشياء باستمرار الخلق، وبتوجيهها إلى الغاية، والاعتناء بها، وصرف العدم عنها. هذا التصوّر للعلة الفاعلة تصوّر جديد، وغريب عن روح أرسطو، نجده عند علماء الكلام، وعند ابن رشد الذي يقول: " العالم لا يستغني عن صانعه مثلما يستغني البيت عن البنّاء بعد اكتماله، بينما الفاعل الإلهي أشرفوأدخل في باب الفاعلية؛ لأنه يوجد ذلك المفعول ويحفظه باستمرار"(9). كما نجد التصوّر نفسهعند الأكويني الذي يقول: إن الله ليس يحرك الأشياء إلى الفعل باستخدامه صورها وقواها للفعل فقط ،كما يستخدم الصانعُ القَدُومَ للقطع مع كونه قد لا يَهَبُ القَدُومالصورة بل يهب المخلوقات الفاعلة الصور،ويحفظها في الوجود أيضا، فهو إذن ليس علة للأفعال من حيث يهب الصورة التي هي مبدأ الفعل فقط ،كما يقال للمولّد: إنه علة حركة الأجسام الثقيلة والخفيفة؛ بل من حيث يحفظ أيضا صور الأشياء وقواها على نحو ما يقال للشمس إنها علّة ظهور الألوان؛ من حيث تهب الضوء الذي به تظهر الألوان وتحفظه" (10).
ومن أهم شروط الفاعل الأول عند الغزالي أن يكون مريداً مختاراً وعالماً، فمن قال بأن الله هو الفاعل الأول وسلبه الإرادة والاختيار لم يكن فاعلا على الحقيقة؛ بل كان مجازا فلا يجوز إذن أن يسمى كل سبب -بأي وجه كان- فاعلا، ولا كل مسبب مفعولا (11).
هذا الرأي لم يكن رأي الغزالي فقط؛ بل أغلب الأشاعرة الذين لا يقبلون إلاّ بالله سبحانه وتعالى فاعلاً حقيقيا ووحيداً، ويرفضون أي واسطة بينه وبين مخلوقاته؛ لأنه خلق العالم بسلطانه المطلق دون أي واسطة، وهو يدبر العالم أيضاً بسلطانه المطلق دون واسطة، وكل ما يوجد في العالم إنما يوجد مباشرة بفعل من أفعال الخلق الإلهي، وذلك تمشيا مع الفكرة الأساسية الموجودة في القرآن وهي : قدرة الله المطلقة وإثبات المعجزات. قال تعالى: { الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار}(12).
فهؤلاء -ومنهم الغزالي- أنكروا السببية الطبيعية، وقالوا -كما نقل عنهم ابن رشد في كتابه( تفسير ما بعد الطبيعة) والذي اطّلع عليه الأكويني-:" إن ها هنا فاعلاً واحداً لجميع الموجودات كلها، وهو المباشر لها من غير وسط.. فجحدوا أن تكون النار تحرق والماء يروى والخبز يشبع، قالوا لأن هذه الأشياء تحتاج إلى مبدع ومخترع" (13) .وقال الأكويني:"فالنار( حسب بعض علماء الكلام) لا تحرق؛ ولكن الله سبّب الحرارة بحضور النار، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المعلولات الطبيعية "(14)، وقال أيضاً: " إن بعض علماء الكلام المسلمين يرون أن الأعراض نفسها لا تصدر من فعل الأجسام؛ لأن العرض لا ينتقل من جسم أو موضوع إلى آخر، ومنه يستحيل أن تنتقل الحرارة من جسم ساخن إلى جسم آخر. وبهذا المعنى فإن جميع الأعراض مخلوقة من الله" (15).
فالمتكلمون الأشاعرة -وعلى رأسهم الغزالي- يرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات ليست ضرورية؛ لأنها لوكانت كذلك لما استطاع الله أن يتدخل في الكون قضاء وقدرا وتدبيرا وعناية، ولما استطاع أن يبطل فاعلية الأسباب كما فعل في النار التي أريد بها إحراق إبراهيم عليه السلام.
وعدم جزم الغزالي بوجود الضرورة لا يتبعه جزم بأن جريان العالم هو على غير نظام؛ يقول الغزالي: "إن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يديره، وفاعل يحكمه ويقدره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره، ومصرفة بمقتضى تدبيره"(16)، فالغزالي ينفي تأثير الظواهر الطبيعية باسم ( الضرورة التي تعني: (دائما)، أو باسم (الطبيعة) التي يعرّفها ابن سينا في رسالة (الحدود) أنها: " مبدأ أول لكل تغير ذاتي وثبات ذاتي"(17)، وهو تعريف قريب من تعريف أرسطو. ووجد في لفظ ( العادة) الذي يعني (غالبا) وصفاً مناسباً لانتظام الحوادث المتتابعة، التي يمكن أن تخرقها المعجزات.
وتجدر الإشارة إلى أن الغزالي يستعمل أيضا لفظ ( السنة) بمعنى ( العادة)، ويستعمل لفظ (الشرط) عوض ( السبب)؛ إذ يقول : " إن خلق الجسم شرط لحدوث الحياة، لا أن الحياة تتولد من الجسم"(18). وإذ حدث أن استعمل لفظ (السبب) فهو لا يعني به العلّة.
على نقيض هؤلاء، فإن الفلاسفة لا ينكرون السببية على الإطلاق؛ أي أن يكون للموجودات طبيعة تقتضي الشيء إما ضرورياً أي دائماً وإما أكثرياً (19). ولا يستثنى من هؤلاء الفلاسفة توما الأكويني، كما لا يستثنى بعض علماء الكلام الذين قالوا بالسببية فاستشنعوه كما قال ابن ميمون (20)، استشنعه خصومه من الأشاعرة الذين لم يقبلوا هذا الرأي. هؤلاء الذين قالوا بالسببية لم يذكرهم ابن ميمون؛ ولكن إذا عدنا إلى علم الكلام علمنا أن القائلين بالسببية هم المعتزلة الذين يحكّمون العقل كثيرا، ونخصّ بالذكر معمر بن عباد السّلمي(ت220) والنّظام(231 هـ) كما نذكر ابن حزم الأندلسي(ت 406 هـ).
يرى (معمر) أن الله تعالى لم يخلق شيئا من الأعراض، من لون أو طعم أو رائحة أو حياة أو موت أو سمع أو بصر، وأنه لم يخلق شيئا من صفات الأجسام(21)؛ فالله في رأيه خَلَقَ الأجسام، ثم إن الأجسام أحدثت الأعراض على أساس أن كل ما سبق من حياة وموتوسمع وبصر ولون وطعم ورائحة ما هو إلاّ عرض في الجسم من فعل الجسم بطبعه، والأصوات عنده فعل الأجسام المصوّتة بطباعها، وفناء الجسم عنده فعل الجسم بطبعه، وصلاح الزروع وفسادها من فعل الزروع عنده (22).
وفهم"معمر" الحضور الإلهي بمعنى أن الله هو الذي أوجد قوانين السببية التي تحدث بموجبها كل الأشياء في العالم(23).
ذكر الأكويني رأي معمر دون أن يذكر اسمه، فقال: " إن الأجزاء التي لا تتجزّأ والتي تكوّن مع الأعراض، الأجسام الموجودة سوف تكون قادرة على البقاء إذا ما رفع الله هيمنته عنها(24)؛ ذلك لأن فناء كل فان فعلٌ له بطبعه، وأنه ليس لله تعالى في الأعراض صنعٌ ولا تقدير(25) حسب (معمر).
أما النّظام -الرافض لنظرية الجزء الذي لا يتجزأ والمعروف بنظرية الطبائع والكمون- فإنه يرى كما حكى عنه (الكعبي) أن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة؛ أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعا، وخلقه خلقة، إذا دفعته اندفع، وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طيعا(26)؛ فالنّظام يصف الحركات المختلفة للحجر بأنها فعل الله، وهو ما يعني بوضوح أن العلية في العالم ترجع إلى طبع أوجبه الله في العالم وقت خلقه له وبه يبقى مهيمنا عليه. فالطبع الذي خلقه الله يعتمد في فعله في العالم على الله وليس على نفسه، إذ هو مجرد أداة تفعل في الأشياء بقدرة الله وأمر منه، وهذا الطبع قابل لأن يتغير بقدرة الله. "فالخفيف والثقيل من الأجسام مع اختلافهما في جنسيهما واختلاف جهتي حركتهما يتداخلان"(27).
هذا ويتجلى اعتراف ابن حزم بالسببية في نقده لرأي الأشعرية حيث يقول: "ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة، وقالوا : ليس في النار حرّ ولا في الثلج برد، ولا في العالم طبيعة أصلا. وقالوا: إنما حدث حرّ النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة. قالوا: ولا في الخمر طبيعة إسكار ولا في المني قوة يحدث بها حيوانٌ؛ ولكن الله عزّ وجلّ يخلق منه ما شاء. وقد كان ممكنا أن يُحدث من مني الرجل جملا، ومن مني الحمار إنسانا، ومن زريعة الكزبر نخلا "(28).
يفهم من هذا أن ابن حزم يقول بالسببية وبالطبائع؛ ولكن لا يرد خلق هذه الطبائع والأعراض إلى الطبيعة نفسها مما يحول دون قدرة الله عليها وتدخّله فيها وعنايته لها؛ فهذا القول أو الرأي هو في غاية الغباوة، وجهل بالطبيعة. ومعنى لفظ الطبيعة إنما هي قوة الشيء تجري بها كيفياته على ما هي عليه، وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا يعقل، وكل ما كان مما لا اختيار له -من جسم أو عرض كالحجارة وسائر الجمادات- فمن نسب إلى ما يظهر منها أنها أفعالها مخترعة لها، فهو في غاية الجهل. وبالضرورة نعلم أن تلك الأفعال خَلْق غيرها فيها، ولا خالق لها ها هنا إلاّ الله تعالى، خالق الكل، وهو الله لا إله إلاّ هو (29).
لم ينقد الأشاعرة ومنكرو السببية من طرف ابن حزم فقط؛ بل نقدهم ابن رشد نقدا لاذعا وأهمهم الغزالي، ثم نقدهم الأكويني؛فقال ابن رشد : " إن العقل ليس هو شيئا أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها وبه( أي بهذا الإدراك) يفترق عن سائر القوى المدركة، فمنرفع الأسباب فقد رفع العقل"(30). فقول المتكلمين:إن الله تعالى أجرى العادة بهذه الأسباب، وإنه ليس لها تأثير في المسببات بإذنه: قول بعيد جدا عن مقتضى الحكمة؛ بل هو مبطل لها؛ لأن الترتيب والنظام وبناء المسببات على الأسباب هو الذي يدلّ على أنها صدرت عن علم وحكمة. بالإضافة إلى هذا يتساءل ابن رشد: ما جدوى وجود الموجودات على اختلافها إذا لم يكن لها فعلٌ ودور يخصها ؟ فهو يقول : " إنه من المعروف بنفسه أن للأشياء ذوات وصفات هي التي أقتضت الأفعال الخاصة بموجود موجود وهي التي قِبَلِها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها، فلو لم يكن لموجود موجود فعلٌ يخصّه لم يكن له طبيعة تخصه، ولو لم يكن له طبيعة تخصّه لما كان له اسم يخصه ولا حدّ ، وكانت الأشياء كلها شيئا واحدا "(31). هذا النقد الأخير هو النقد نفسهالذي وجهه الأكويني إلى منكري السببية، ويقصد الغزالي بالذات قائلا:" إن بعضا أرادوا بفعل الله في كل فاعل أن ليس لقوة مخلوقة فعلٌ في الأشياء؛ بل إنما يفعل الله جميع الأشياء مباشرة؛ فالنار مثلا لا تسخّن بل الله يسخّن في النار، وهلم جرا. على أن هذا مستحيل؛أما أولا: فللزوم عدم ترتيب العلة والمعلول في المخلوقات، وهذا يرجع إلى عجز الخالق؛ لأن إيتاء الفاعلِ مفعولَه قوةَ الفعلِ راجع إلى قدرته. وأما ثانياً: فلأنه لو كانت الأشياء لا تفعل شيئاً بما ركّب فيها من القوى الفاعلة لم يكن في وجود تلك القوى فائدة، بل لم يكن على نحو ما فيما يظهر فائدة في وجود شيء من المخلوقات إذا لم يكن لها فعل؛ إذ كل شيء موجود لأجل فعله؛ لأن الناقص هو دائما لأجل الأكمل... فالله يفعل في الأشياء بحيث يكون للأشياء أيضا فعل خاص يستند إليها"(32).
نقد الأكويني علماء الكلام بعد اطّلاعه على آرائهم في السببية، من خلال ابن رشد الذي ذكر رأيهم ونقَدَه لهم كما رأينا، ومن خلال( دلالة الحائرين) لابن ميمون الذي يقول عنهم: " قالوا : " إن الانسان إذا حرّك القلم فما الإنسان حرّكه؛ لأن هذا الحراك الذي حدث في القلم هو عرض خلقه الله في القلم، وكذلك حركة اليد المحرّكة للقلم بزعمنا عرض خلقه الله في اليد المتحركة، وإنما أجرى الله العادة بأن تقارن حركة اليد حركة القلم لا أن لليد أثرا بوجه، ولا سببية في حركة القلم" (33).
كما اطّلع الأكويني على ملخصات اليهود الذين نقلوا كثيرا من الأفكار الشائعة بين علماء الكلام في عصرهم أو ما قبل عصرهم دون أن يذكروا أصحاب هذه الأفكار.
إن نفي السببية في رأي الأكويني وفي رأي ابن رشد هو جُحدٌ لجزء كبير من موجودات الله، هذه الموجودات التي هي دليل على وجود صانع وخالق للعالم، ومن ثم جُحْدٌ للخالق وإنكار للحكمة في مخلوقاته. يقول الأكويني: "تماشيا مع الحكمة الإلهية فإن الحكيم ( الذي هو الإله) لا يفعل عبثا. وفي ظلّ فرضية عدم الفاعلية المطلقة للمخلوقات؛ فإن الإله يكون أوجد الكل مباشرة، ومن ثم يكون استعماله للمخلوقات في إنتاج المعلولات بلا جدوى، وهذا مناف للحكمة الإلهية "(34).
ففي نظر الأكويني يظل أولئك الذين ينزعون عن المخلوق نشاطه الخاص -لكي يعظموا بعملهم هذا الخالق- في ضلال؛ فما ينقصونه من كمال المخلوقات-حسب قوله- ينقصونه من كمال الإله بالذات؛ لأن الإله أراد أن يعمم صفاته على مخلوقاته؛ فالتشبه بالإله -بالنسبة إلى مخلوق ما- لا يعني فقط وجوده؛ بل كونه سببا هو بدوره. وليس في هذا أي تجديف ولا أي انتقاص من مجد الإله؛ فالسببية في المخلوقات تشتق من السببية في الخالق(35).
ويرى الأكويني أن إرادة الإله_ التي تعدّ العلة الأولى والكلية في وجود الأشياء- لا تنفي دور العلل الثانوية أو المتوسطة وقدرتها في إصدار بعض المعلولات؛ إلاّ أنه لما كانت جميع هذه العلل غير مساوية لقدرة العلة الأولى، كان في قدرة الإله وعلمه وإرادته أمور كثيرة لا تندرج تحت ترتيب العلل السافلة(36) .كما يمكن لهذه الأخيرة أن يحدث شيء خارجاً عن ترتيبها، وأن يتخلف المعلول عنها بسبب علة أخرى جزئية مثلها مانعة، ولكن لا يمكن أن يحدث هذا مع العلة الأولى أوالكلية التي تندرج تحتها جميع العلل الجزئية. ويعطي الأكويني مثالا على ذلك فيقول: يمكن أن يمنع نجم عن إصدار أثره، إلا أن كل أثر صادر في الجسمانيات عن علة جسمانية مانعة يجب إسناده -بعلل متوسطة- إلى القوة الكلية التي هي السماء الأولى. فإذاً إرادة الإله هي العلة الكلية لجميع الأشياء، ويستحيل تخلف معلولها، حتى وإن ظهر أنه خارج عن الإرادة الإلهية بحسب ترتيب آخر. كما أن الخاطئ الذي في حد ذاته يخرج بالخطأ عن الإرادة الإلهية ثم يقع في ترتيبها من حيث يعاقب على خطئه (37). إن المعلولات التي تصدر عن العلل الثانوية أو المتوسطة معلولات لا تتعلق بإرادة الإله وحدها؛ بل بترتيب علة أخرى، أما المعلولات الأولى-الصادرة عن الإله مباشرة- فهيمعلولات تتعلق بالإرادة الإلهية وحدها. ومهما وجدت فواعل كثيرة ومترتبة؛ فإن الفاعل الثاني يفعل دائماً بقوة الفاعل الأول؛ لأن الفاعل الأول يحرك الثاني إلى الفعل، وبهذا الاعتبار كانت جميع الأشياء تفعل بقوة الإله فيكون علة لجميع أفعال الفواعل(38). وهذا بالضبط ما قاله ابن رشد في كتابه تهافت التهافت: " لا ينبغي أن يشك في أن هذه الموجودات قد تفعل بعضها بعضا، ومن بعض، وأنها ليست مكتفية بأنفسها في هذا الفعل، بل بفاعل من خارج، فِعْلُه شرطٌ في فِعْلها، بل في وجودها فضلا عن فعلها"(39).
هذا ويمضي الأكويني في أهمية ودور العلل الثانوية حتى في التدبير الإلهي،فالتدبير الإلهي غير أزلي، بل هو زماني، وهو يتم ببعض الوسائط؛ لأن الإله يدبّر الأدنى بواسطة الأعلى حتى يشرك المخلوقات في شرف العلّية، وليس هذا نقصاً في قدرته، بل دليل على كمال علّية الموجودات. فاستعانة الملك بمن ينفّذون تدبيره شرفٌ له؛ لأن السلطة الملكية تزداد رونقا بمرتبة الوزراء(40).
وعلى الرغم من دور العلل الجزئية فإنه يستحيل أن يحدث شيء بغير قضاء التدبير الإلهي، لأنه العلّة الأولى والكلّية لجميع الموجودات، وحتى إذا ظهر أن شيئا خرج من جهة عن ترتيب العناية الإلهية بالنظر إلى علة جزئية فلا بدّ أن يندرج في ذلك الترتيب عينه بالنظر إلى علّة أخرى(41).
أما العناية فتكون مباشرة من الإله دون العلل الثانوية، مثلما أن الخلق فٍعلٌ خاص بالإله فقط.
إن الإله هو العلة الفاعلة والغائية ومن ثم علة العلل، وهو العلة الكلية المطلقة، تصدر عنه موجودات وأفعال لا تكون لغيره مثل خلق الموجودات والعناية بها، حيث يخلقها بإرادته وحده، وعلمه وحده، ويعتني بها وحده عناية مباشرة، في حين يدبر أمور الكون بواسطة العلل المتوسطة أو العلل الجزئية التي يسمح لها بقدرته وبإذنه أن تفعل أو أن تصدر بعض المعلولات. إن هذا التمييز الوارد والفاصل بين العلة الكلية المطلقة والعلة الجزئية نجد نموذجه الأصلي عند ابن رشد عندما ميّز بين الفاعل المطلق الذي يفعل في الغائب- وفِعْلُهُ: أن يغيّر العدم إلى الوجود- والفاعل المقيد الذي يفعل في الشاهد، وفِعْلُهُ: أن يغير الموجود من صفة إلى صفة (42).
إن الإله علّة كلّية، خلق الموجودات وأعطاها دورا في هذا العالم، ويبقى هو الأول والوحيد في خلق الوجود من العدم، وفي حفظه من العدم باستمرار خلقه. هذه النتيجة التي خلص إليها الأكويني يتفق فيها مع علماء الكلام ، وهو يعلم ذلك؛ ولكنهيصرّح بأنه يستبعد تماما المقدمات التي انطلقوا منها للوصول إلى هذه النتيجة، وهذه المقدمات أو الآراء -في بقاء وحفظ الوجود- يذكرها الأكويني كما وصلت إليه عن طريق ابن ميمون وهي:
الرأي الأول:
" لإثبات حاجة العالم إلى الله ليبقى عليه وجوده واستمراره، زعموا أن كل الصور عرضية، وأن كل عرض لا يبقى زمانين، وهكذا تكوّن الموجودات، فهي في تغير مستمر" (43).
أي أن الحوادث التي تطرأ على الجوهر الفرد أو على الأجسام هي متغيرة، ومتعاقبة بشكل لا ينقطع، ومادامت لا تبقى زمانين، فهي تخلق باستمرار وتوجد على الدوام، وهكذا يحفظ الله وجود الأشياء. هذا الدليل أورده ابن ميمون كما يلي:
قولهم: إنه ليس ثَم غيرُ جوهرٍ وعرض، وإن الصور الطبيعية أيضا أعراض(44).وقولهم: إن العرض لا يبقى زمانين (45).
يعقّب الأكويني على هذا الرأي قائلا: " وكأن الموجودات لا تحتاج إلى العلة الفاعلة إلاّ في تغيّرها (46).
الرأي الثاني:
أن الأجزاء التي لا تتجزأ، والتي تكّون جميع الجواهر هي دائما الوحيدة التي تستمر في البقاء بعض الوقت إذا سحب الله تدبيره عن العالم (47).
هذا الرأي يرده المستشرق اليهودي ( هاري.أ. ولفسون) إلى المتكلم معمر بن عباد السلمي(48).
الرأي الثالث:
أن العالم لا يمكن أن يكف عن الوجود إن لم يتدخل الله في إنهاء وجوده(49 ).
ولقد جاء هذا الرأي في ( الدلالة لابن ميمون ) كما يلي: " أما بعضهم فقال: إنه إذا أراد الله إفساد العالم يخلق عرض الفناء لا في محل فيقاوم ذلك الفناء لوجود العالم "(50).
وهذا الرأي لمحمد بن عبد الوهاب الجبائي (المتوفى فى295 هـ) وابنه أبي هاشم عبد السلام(المتوفي سنة 321 هـ )(51)
هذا وإذا كان الأكويني لم يقبل بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ في إثبات وجود الله -كما أفاد بها علماء الكلام- فهذا لم يمنعه من التأكيد معهم أن الفاعل أو المؤثرالحقيقي هو المركّب بين الأشياء؛ " إذ الأشياء المغايرة بين أنفسها لا تتفق في واحد ما إلاّ بعلّة جامعة لها(52) " ،وهي الله.
خاتمة
إن الاعتراف بالعلل الثانوية، ودورها في الوجود بعد العلة الفاعلة الأولى عند القديس الأكويني وابن رشد وغيرهما من مفكري الإسلام - يقرب من مفهوم السببية العلمي؛ فكشف النواميس يبين أن الأحداث تقع عن طريق الدفع والتأثير من العلل في المعلولات وهذا يمكّننا من تحصيل المعارف في العلوم الطبيعية، التي لا تستمد أدلتها إلاّ من المعلولات أو الموجودات نفسها،وهذا الاعتراف لا يتنافى مع قدرة وإرادة الله؛ لأن كل مخلوق يعمل تحت سلطته وإرادته ،ولما كان من رحمة وفضل الله على الإنسان أن سخّر له الموجودات أو الطبيعة؛ فإن هذا التسخير لن يتم دون فهم الإنسان لهذا النظام ،ولو كان هذا الأخير غير محكم بفعل التأثير بين العلل-أي عشوائياً-ما تمكّن الإنسان أن يفهمه ومن ثم العيش وفقه.
هوامـش البحـــــث:
-
الباقلاني، ( محمد بن الطيب)، التمهيد في الرد على الملحدة المعطّلة والرافضة والخوارج والمعتزلة. تقديموتعليق: محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أبوريدة.دار الفكر العربي. القاهرة .ص 45.
-
الأكويني ( توما ) ،الخلاصة اللاهوتية، ترجمة الخوري بولس عواد. المطبعة الأدبية. بيروت1887،المجلد1، مبحث 46، فصل2، ص 569.
-
الأكويني (توما)،إلخ، اللا.م1. مب2، ف3، ص 33 وكذلك مجموعة الردود.ك1،ف13،ص63.
-
ابن سينا، الشفاء، الإلهيات، القاهرة. المطابع الأميرية 1960. المقال 2، الفصل 1، ص 327- 328.
-
انظر الأكويني ،مجموعة الردود على الخوارج. ترجمة وتعليق: المطران نعمة الله أبي كرم المروني. مطبعة اللبنانيين. لبنان. 1931.كتاب1.فصل 13 ص36
-
) Gilson (Etienne).leThomisme. Introduction à la Philosophie de SaintThomasd’Aquin. Librairie Philosiphique.J.Vrin.6ème Edition. revue1972. P 79
-
ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة. ضمن: "ابن رشد" ليوحنا قمير دار المشرق 1986. ص90
-
الأكويني، الخ، اللا. م 1، مب8، ف1، ص85.
-
تهافت التهافت، تحقيق:سليمان دنيا،دار المعارف، مصر،ط4،دون تاريخ ج2.ص428
-
الأكويني. إلخ. اللا. م3، مب1. ف5، ص11.
-
انظر: الغزالي، تهافت الفلاسفة، ص 81 -87.
-
سورة إبراهيم : آية : 32
-
ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ضمن كتاب"ابن رشد" ليوحنا قمير.ص91
-
انظر: [) Saint Thomas d’Aquin .Somme contra Gentilles, traduction de M-J- Gerlaud, Texte de l’Edition léonine. P. Lethielleux, 1950,L III, Chap 69, p 319. ]
-
انظر: [C.G.L III, Chap 69, p 321]
-
الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الثقافة، الجزائر، الطبعة1، 1991 . ج1.ص29
-
جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني 1982، ج 2، ص 13.
-
الغزالي، إحياء علوم الدين ، ج 4، ص 239.
-
ابن رشد، تهافت التهافت، ج2، ص 786.
-
ابن ميمون (موسى)، دلالة الحائرين، ترجمة حسين أتاي، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الثانية 1993،ج1 ف73، ص 20.
-
عبد القاهر البغداي، الفرق بين الفرق، تعليق الشيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت ط 36، 2001، ص144.
-
عبد القاهر البغداي، الفرق بين الفرق. ص 144
-
انظر: هارى أ. ولفسون، فلسفة المتكلمين في الاسلام. ترجمة وتعليق مصطفى لبيب عبد الغني، المجلس الأعلى للثقافة 2005،ج2،ص731
-
انظر: [C.G.L III Chap،65، P 303 ]
-
البغداي، الفرق بين الفرق. ص 144
-
الشهرستاني، الملل والنحل، تقديم وتعليق محمد السيد كيلاني، القاهرة ،ص 55.
-
البغداي، الفرق بين الفرق ،ص 132.
-
ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مطبعة الموسوعات،القاهرة، مصر، ج5، ص14 ،15.
-
المصدر السابقنفسه،ج 3، ص 59.
-
تهافت التهافت،ج2، ص 785
-
المرجع السابقنفسه، ج2،ص 782 ، 783.
-
الأكويني، الخ، للا، مجلد3، مب1، ف5، ص 11 ، 12 .
-
ابن ميمون، دلالة الحائرين،ج1،ف73، ص203.
-
انظر: [,G,L III, Chap 69 ,p 321. C]
-
إدوار جونو ،الفلسفة الوسيطية في الغرب المسيحي K ترجمة: علي زيغور.المنشورات العربية ( سلسلة ماذا أعرف)ص 77.
-
الأكويني. خ. اللا. م 1. مب 19 ف7. ص 266.
-
نفس المصدر السابق.ف6. ص 263.
-
الأكويني، الخ.اللا. مجلد3.مب1 ف5. ص12
-
ج2.ص 787.
-
الخ.اللا. م2. مب103ف6. ص 597.
-
المصدر السابق نفسه، ص 59.
-
انظر ابن رشد، تهاتف التهافت،ج1. ص 366.
-
انظر: [C.G.L III. Chap 65. p303. ]
-
الدلالة. ج1. ص206.
-
المرجع السابقنفسه ، ص201.
-
انظر: [C.G.L III. Chap65 .p303.]
-
انظر: [Ibid. ]
-
ولفسون، فلسفة المتكلمين،ج2.ص75 .
-
انظر: [C.G.L.III Chap 65. p303]
-
ج1.ف73. ص 202.
-
ولفسون، فلسفة المتكلمين. ج 2.ص 751.
-
إلخ، اللا،م1، مب2 ف7، ص47.