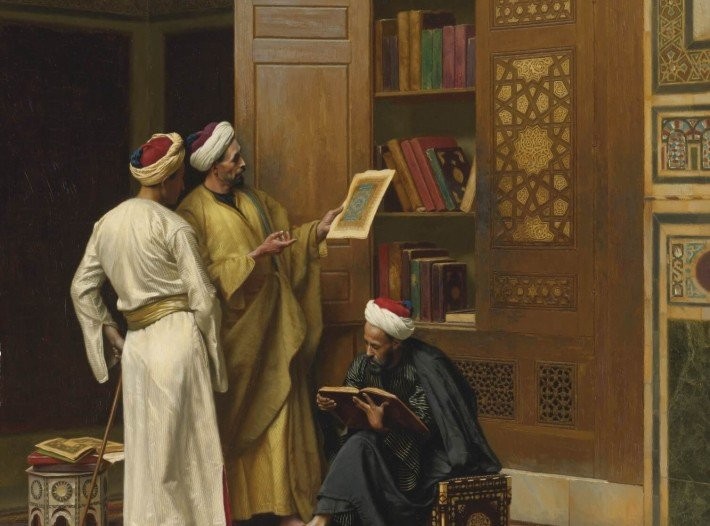فوزي البدوي | أستاذ الدراسات اليهودية والأديان المقارنة جامعة منوبة تونس.
تجربة رودولف بولتمان ومشروع نزع الأَسْطَرَة
مقدّمة
في نص شهير للبابا أدريان السادس الهولندي الأصل - والمعروف بالبابا الهرطقي – (1)قبل توليه كرسي البابوية لسنة يتيمة 1522 / 1523 كتب عما كان يعتقد أنه حال الكنيسة الرومانية الكاثوليكية قائلا:"نحن نعلم علم إلى اليقين أن ممارساتٍ غير لائقة حدثت حتى داخل مقر البابوية، وقيض لنا أن نكون شاهدين عليها، وعلى تجاوزات في المسائل الكنسية يمكن وصفها بالبليغة والخطيرة، والأمر لم يفتأ ينتقل إلى ما هو أشد سوءًا، ونحن جميعا -بمختلف رتبنا- ابتعدنا عن الطريق القويم ...ولهذا السبب بالذات وجب أن نَعِدَ باسمنا كل مسيحيي ألمانيا الثائرين بأننا سنعمل بكل ما في وسعنا حتى تعرف الكنيسة الرومانية طريق الإصلاح " ولهذا السبب بالذات ربما " لم يظهر ابتهاجا حينما انتخب على رأس الكاثوليكية؛ بل اكتفى بأن أخذ تنهد طويلاً " على ما ترويه بعض سيره (2)، ويبدو أن هذه التنهيدةمأساة الكاثوليكية الرومانية، بل ومأساة المسيحية، التي اختلط تاريخها بتاريخ أوروبا حتى لم يكن تاريخ سواه طيلة اثني عشر قرنا، وكان هذا اعترافاً بأن المسيحية تحتاج إلى حركة إصلاح ديني لم تبطئ في الظهور في إحدى المقاطعات الألمانية، فكانت حركة هزت أوروبا في نهاية القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر، حركة غيرت ملامح أوروبا والعالم تدريجيا، وبدأت بأن تزعمها دينيون تأثروا بأفكار الحركة الإنسية، وفتحوا المجال للانشقاق عن الكنيسة، التي عدّت نفسها -ولقرون عديدة"- الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية "، وطالبوا بإصلاح ديني يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت البروتستانتية هي الإجابة المباشرة للكاثوليكية التي تيبست عبر القرون، فجاء إصلاحها وريثاً لحركة النهضة، ومواصلة لها في اتجاهات لم تطلها الحركة السابقة له،ا وهكذا كان الإصلاح -كما يقول جعيط- ملخصاً الموقفَ الغرامشي من التجربة الأوروبية في مواجهة الإصلاح الديني اللوثري شعبويًّا، وكانت النهضة أرستقراطية. ولقد كان الإصلاح جموحًا عن الثقافة وعقيمًا من البُعد الجمالي؛ في حين كانت النهضة تبشِّر بالإبداعي والجمالي."كان مارتن لوثر زعيم هذه الحركة يحتج على صكوك الغفران مستعيضاً عنها بعقيدة التبرير بالإيمان، معترضاً على لاهوت التبرير الكاثوليكي، وناشرا لقضاياه الخمس والتسعين على باب كاتدرائيّة فيتنبارغ، متفرغاً لترجمة للكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية، فاتحاً المجال لتشكل اللغة القومية الألمانية من جهةٍ، ووضع اللبنة الأولى لانهيار سلطة طبقة رجال الدين الكاثوليك في ثورته الشهيرة Sola scriptura،وكانت ثورة الفلاحين التي قادها لاحقا توماس مونتسر هي الترجمة العملية لإحدى خصائص الإصلاح الحقيقي من حيث هو اقتحام للعوام والبسطاء والمهمشين حركة التاريخ(3)، وكانت صرخة مارتن لوثر في القضية السادسة والثمانين موجهة إلى البابا بأن يقوم ببناء كنيسة القديس بطرس من ماله الخاص لا من مال الفقراء: الأساس النظري لثورات الفلاحين والمعدمين اللاحقة وتشكُّل البروتستانت في كل من سويسرا وغيرها من البلدان الأوروبية .
واستمرت حيوية الفكر البروتستانتي في فرعه اللوثري -على وجه الخصوص- تسعى جاهدة إلى إيجاد توافق بين هذه الحداثة الأوربية، وهذه الأنوار التي أفسحت المجال للعقل ولقيم المواطنة والعقد الاجتماعي، ولخصها الفيلسوف الألماني كانط في العبارة الشهيرة Sapereaude المنسوبة للفيلسوف اليوناني هوراس في كتابه ما الأنوار؟ والتي أقضت حتى مضاجع اليهودية الأرثوذوكسية حينما أخرجت سقراط برلين ولوثر اليهود موشيه مندلسون ليكتب قبيل كانط بسنوات قليلة نصه الشهير Ueber die Frage: was heißtaufklären? حول مسألة: ماذا نعني بفعل التنوير؟ (4)
ويمكن القول دون مبالغة :إن الحلقة الفاصلة اليوم في الفكر المسيحي البروتستانتي المعاصر اذا ما تجاوزنا الحقبة الحديثة: حقبة الإصلاح اللوثري وزمن الحداثة، كما حددها المؤرخ الفرنسي الشهير بيار شونو(5)-هو بلا منازع من اجتمع في شخصه اللاهوت والتاريخ والفلسفة- ونعني رودولف بولتمان، ولئن تقادم عهده وكتاباته فإنه يظل بمثابة مصدر الإصلاح الديني المسيحي المعاصر وإن طال السفر، منه يتم الانطلاق، وحوله تتم المراجعات بالنظر إلى حجم تأثيره البالغ الذي يمكن مقارنته بالأثر الذي خلفه يوليوس فلهاوزن في دراسات النقد الكتابي المعاصر Biblical criticism
رودولف بولتمان منهو؟
رودولف بولتمان (6) هو من جيل اللاهوتيين البروتستانت الألمان المعاصرين، وهو -إلى جانب كارل بارط. مفسر للعهد الجديد (7)- من رواد الثيولوجيا الليبيرالية للقرن التاسع عشر، اشتهر بأنه مفسر للعهد الجديد، وخصوصاً للأناجيل المتقابلة أو الإزائية(8)، مؤرخ أديان، وفيلسوف وجودي، اشتهر خصوصاً بمشروعه حول "تأويل الأسطورة"(9) بنزعها Démythologisation من خلال النظر في سيرة يسوع، ودراسة التصور الأسطوري في العهد الجديد، وهذا المشروع هو نتيجة انخراط هذا اللاهوتي المؤرخ والفيلسوف في "الوضعية التأويلية الجديدة" التي تعيشها المسيحية، والتي حتمت عليها الاعتراف بأهمية المناهج النقدية التاريخية في مقاربة النصوص الدينية، مع السعي إلى استيعاب الدرس التيولوجي منها، إضافة إلى الاعتراف بأهمية الفلسفة الوجودية – في صيغتها الهيدغرية - خصوصا في نقد مفهوم التاريخ المموضع objectivante وفي الخروج بالثيولوجيا من مأزقها المعاصر. وهو الأمر الذي لم تتقبله الأوساط اللاهوتية التقليدية بترحاب حتى أيامنا هذه(10).
وتسعى هذه الدراسة إلى النظر في مسائل المقدس والأسطورة والنقد الكتابي، وكلها من صميم مسائل تاريخ الأديان، ومن القضايا التي أرقت المسيحية المعاصرة، إضافة إلى ما أضفاه عليها بولتمان حينما جمع بينها من أجل خوض الإشكالية " الكلامية" التي عاشها بوصفه فيلسوفاً من جهة ورجل دين من جهة أخرى، ونعني الإشكالية التالية: هل يمكن أن يجد الإيمان في التاريخ سنداً له؟ أو بعبارة أخرى: هل يمكن للبحث التاريخي أن يكون أساساً لقيام ثيولوجيا للإيمان بالنسبة إلى المؤمن المعاصر المنخرط في الوضعية التأويلية الجديدة وما تستتبعه من "دائرة تأويلية" قوامها "أن نفهم لكي نؤمن ونؤمن لكي نفهم" ،ثم النظر في صنوف النقد التي تعرض إلى ها مشروعه من أجل التفكير معه وضده في الوقت نفسه.
-
وتحقيقا لهذا سنسعى إلى بيان الطريقة التي درس بها بولتمان الأناجيل المتقابلة أو الإزائية ؟ ليعالج القضية التي شغلت الأوساط اللاهوتية قبله ومن بعده.
-
وهي المقابلة بين يسوع التاريخ ويسوع الإيمان، وخصوصاً قضية الوعي المشيحاني عند يسوع، وهي دراسة اعتمد فيها بولتمان مناهج مدرسة تاريخ الأشكال (11)) Formgeschichtlicheschule التي يعدّ أحد مؤسسيها إضافة إلى زميله ديبليوس Dibelius(1.
-
ثم دراسته للمسألة الأخرى المتعلقة بالأسطورة في العهد الجديد معتمدا في ذلك على مناهج تاريخ الأديان، وهي الدراسة التي أدت به إلى وضع مشروعه لتأويل الأسطورة السابق "لكونه ليس مطلباً من مطالب الإنسان الحديث فحسب؛ بل لكونه مطلباً للإيمان نفس،ه الذي يدعونا -إذا ما أردنا تقبل الأساسي في هذا الفكر الديني المسيحي؛ أي نواته غير الأسطورية: نواة البشارة Kerygma-إلى أن ننخرط في هذا المشروع(1، "فالاهتمام بالأسطورة هو حجر الرحي في مشروع بولتمان، وهو أمر لا أن يفهم إلا بوصفه استجابة لاهوتية من المسيحية التي عاصرت وشاهدت ما يسميه ماكس فيبر بخيبة العالم، أو نزع الأسطرةبوصفها مرحلة لاحقة على الوعي الميثي وبين نوع الأسطورة من حيث هي عملية تلغي الأسطورة من الوجود أو تعدّها خرافة، وهو ما لاحظه ألان غريش نقلاً عن ريكور في حديثه عن التفريق بين عبارة نزع الأسطورة démysthisation وعبارة نزع الأسطرة، منبهاً إلى أن كلا المصطلحين لا يعني التهوين من الأسطورة démystification" ،وكانت نقطة البداية بالنسبة إليه هي تلك المفارقة التي كانت أساس الانطلاق في فلسفة شيلنغ،ومفادها أنه إذا اهتممنا بالأسطورة اليوم فلأننا تركنا الوعي الميثي وراءنا، وإذا فهم نزع الأسطرة على أنه خروج من الوعي الميثي فذلك أمر واقع لا رجعة فيه بالنسبة إلى الثقافة المعاصرة، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل نحن أمام خيارين إمّا الإيمان بالكهرباء وإما الإيمان بالصراع بين النور والظلمة؟ وهذا الشكل التبسيطي للأمور لا يترك لنا فرصة للنظر الفلسفي للأسطورة، وتبقى الكلمة الأخيرة إلى عملية نزع للأسطورة راديكالية ونهائية؛ أي للهالة الأسطورية من حيث هي تصفية نهائية للموضوع"(14).
ومنذ هذه اللحظة يكف بولتمان عن أن يكون مؤرخاً ليصير مؤرخاً ضد التاريخ أو ضد تصوّر معيّن للتاريخ المموضع، فيستعين بالفلسفة الهيدغريةخصوصا- كما تجلت في كتاب الوجود والزمان Sein UndZeit-ليبحث في تجديد للإيمان، يقوم على تصوّر وجوديّ للتاريخ يسمح له بأمرين هما: "استيعاب" الدرس النقدي و"تحين" النص الديني، وهذا التصور الوجودي هو أساس التعريف عنده كما عند غيره بين التاريخ بما هو Historie والتاريخ من حيث هو Geschichte(15).
-
التاريخ في مشروع بولتمان لنزع الأسطرة:
إن الصلة بين مشروع نزع الأسطرة عند بولتمان والتاريخ وثيقة جدا؛فبولتمان هو من أولئك الذين احترفوا تفسيراً خاضعا للمنهج التاريخي النقدي؛ ولم يتوان أبداً عن إظهار التبعات التي تنجر عن هذا المنهج بالنسبة إلى الإيمان؛ فقد أراد أن يكون مؤرخاً صارماً بكل ما يتطلبه هذا المفهوم من إيجابية نقدية بالنسبة إلى عصرنا؛ ولكنه أراد أيضا أن يكون تيولوجيا حسب طريقته الخاصة؛ أي طريقته كمؤرخ(16).
فالمنهج النقدي التاريخي –إضافة إلى مناهج علوم الإنسان- بصفة عامة هو الذي كان وراء الكشف عن الوضعية التأويلية الجديدة التي تعيشها المسيحية، وهي الوضعية التي كانت أساس ظهور مشروعه المتعلق بنزع الأسطورة؛ فلقد كان هناك دوما في المسيحية "مشكل تأويلي" -كما يعلق بول ريكور- "ارتبط بحياة شخص هو يسوع المسيح؛ بمعنى أن المسيحية ليست تأويلاً لعهد قديم فحسب مثلما ظنت الأجيال المسيحية الأولى، ولا تضخيماً لفهم نص الإنجيل من جهة العقيدة والعمل من أجل إظهار الاتفاق بين تأويل الكتاب وتأويل الحياة مثلما نجد في التصور البوليسي؛ ولكن "المشكل التأويلي" الحقيقي يعود إلى أن "نواة البشارة" ليست تأويلا لنص فحسب بل هي تبشير بشخص؛ بمعنى أن الانجيل ليس كلاماً؛ بل هو يسوع المسيح"(17)، وإضافة إلى أن المشكل التأويلي نشأ أيضاً من المفارقة التالية، وهي أن "هذه النواة نفسها قد وقع التعبير عنها في صيغة شهادة Témoignage أي في صيغة كتابة،ومن ثم في نصوص تحتوي على أول شكل من أشكال العقيدة وعلى أول طبقة من طبقات التأويل، وهنا أدرك العصر الحديث أن هذه النواة هي فعلا عهد بالمعنى الذي فهمته الأجيال الأولى؛ ولكنه أيضا عهد جديد يستدعي هو أيضا التأويل؛ فهو مؤول للقديم ومؤول للحياة؛ ولكنه موضوع للتأويل هو أيضا، وهو ما نفى عنه صفة المعيار الذي تقاس به النصوص والحياة. ولم يكن هذا البعد ليظهر إلا أخيرا –رغم كمون مظاهره منذ البداية – بعد رجوع علوم الإنسان على هذا النص الديني، وخصوصا النقد التاريخي، ولعل هذا التأخر يجد تفسيرا له في الوضعية التأويلية الأولى نفسها، حيث نجد أن الإنجيل –في صيغته المكتوبة – قد صار يعبر عن مسافة تفصله عن الحدث الذي أعلنته البشارة، وما انفكت هذه المسافة تكبر منذ الشهادة الأولى مرورا بمن سمعها ووصولاً إلى دونها، ولم يكن الإنسان الحديث قادراً على اكتشاف هذه المسافة العفوية التي صارت تفصله عن نواة البشارة، وهي مسافة بعيدة جدا لا في المكان فحسب بل في الزمان أيضا"(18).
ولهذا يذهب اللاهوتي بولتمان إلى ضرورة اصطناع منهج يمكّننا من تقبُّل "الأساسي" في هذا الفكر البروتستانتي الألماني والغربي بصفة عامة، قادر على إنجاز هذه المهمة، مادام خطاب المنهج قد صار احتكارا غربياً منذ القرن الثامن عشر. وهذه الحاجة هي التي كانت أساس مشروعه المرسوم "بنزع الأسطرة"، بمعنى أن هذه الوضعية التأويلية في شكلها الثالث هي نتاج الحداثة الأوروبية، وهي التي مهدت لظهور هذا المشروع.
فلقد كان بولتمان-كما يقول بيار بارتيل- "منشغلاً كما انشغل من قبله مؤسسو" مدرسة الأساطير" بالرغبة في الوصول إلى صياغة هرمنوطيقية "راقية" مبررة علميا؛ أي أن يستطيع تقديم تأويل للنصوص المؤسسة للمسيحية، يكون قادرا على تجاوز القراءة النحوية أو المعجمية أو التاريخية أو حتى الفينومينولوجية الصرفة، كتلك التي اكتفى بها السابقون، ولهذا حدد بولتمان لنفسه هدفا تأويلياً مناقضاً لذلك الذي وضعه ديلثاي للتأويل، وهو أن يتمكن "من فهم المؤلف القديم أفضل مما فهم نفسه، وهذا البحث عن مبدأ تأويلي راق هو الذي ألقى ببولتمان إلى مؤلفات مارتن هايدغر وفكره حين التقاه في جامعة ماربورغ زميلاً ومدرِّساً ما بين السنوات 1924-1928 وهي سنوات كانت مصيرية بالنسبة إلى بولتمان؛ لأنها مكنته من وضع مبدئه التأويلي"(19). ولم يكن غير بولتمان قادرا على وضع مثل هذا الهدف الذي كان يفترض من أي تيولوجي أن يشارك في اهتمامين معرفيين أساسيين وهما التاريخ والفلسفة، من الناحية التاريخية كان بولتمان أحد رواد مدرسة تاريخ الأشكال الشهيرة إلى جانب ديبليوس، وكذلك مدرسة تاريخ الأديان الألمانية إضافة إلى الفلسفة الوجودويةexistentialالهيدغرية، وهذه المشاركة هي التي مكَّنته من الخروج من المأزق الذي وقعت فيه الثيولوجيا الليبيرالية في القرن التاسع عشر.
ولقد اعتقد بولتمانأن مضمون هذه "المسافة" وشكْل التعبير فيها عن نواة البشارة أنها هو شكل ميثي أسطوري وبمعنى آخر فإن كلّ الفكر الذي ينكشف عنه للعهد الجديد إنما فكر أسطوري"، والأسطوري عند بولتمان هو كل نمط تمثيلٍ، يبدو فيه ما ليس من هذا العالم جزءٌ منه، وذلك وفق صياغة إنسانية، بل إنسانية جدا، وهو يرى أن "الأسطورة تتحدث عن واقع réalité، ولكن بكيفية غير مناسبة inadéquate" وبالعودة إلى مختلف المواضع التي يحدد فيها بولتمان مفهوم الأسطورة نلاحظ تطورا واضحا في فهمه لها، وهو تطور يسير في اتجاه التوسع، سواء في الاسم أو في الصفة؛ ففي كتابه "تاريخ تراث الأناجيل المتقابلة أو الإزائية" رأىبولتمان أن "الميثي هو كل قصة عن الآلهة، وهذه الأساطير يجب تمييزها عن الخرافات التي لا صلة لها بالآلهة ولا تقص قصتها"، أما في بيانه الصادر سنة 1941 فقد نظر بولتمان للموضوع من زاوية أخرى؛ إذ رأى أن عقيدة المسيحيين -كما تتجلى في العهد الجديد- تحددها رؤية أسطورية للعالم،فالكوسمولوجيا الإنجيلية تقوم على وجود عالم ذي ثلاثة طوابق، لكل واحد منه سكانه الخاصُّون = سماويون، أرضيون، تحت أرضيين، حيث يتدخل سكان العالم العلوي دوماً في حياة سكان العالم الأرضي، مثلما يتجلى ذلك في قصص المعراج ونزول المسيح إلى الجحيم وعودته إلى الغيوم ورفع المؤمنين إلى السماء، والإيمان بالأرواح والجن والمعجزات المذكورة في العهد الجديد، إضافة إلى كل الأسكاتولوجيا=الأخروية الموروثة عن اليهودية، والأساطير الغنوصية، وقد أثرت كل هذه التصورات في تصوّر العهد الجديد للإنسان نفسه؛ إذ نُظر إليه بوصفه منقسما هو نفسه إلى أجزاء يوحي إليها، وتقوده قوى إلهية أو شيطانية(20).
ويرىبولتمان أن صعوبة النظر في الأسطورة إنما تعود إلى أنها لا تكشف أبداً مقصدها؛ فهي غامضة. وهو يعتمد على تاريخ الأديان- وخصوصاً على أعمال رودولف أوتو وفان دار لوف(21)Van der Leeuw و R Oto- ليبيّن كيف أن علاقة الإنسان بالتعالي هي دوماً علاقة "محرفة"؛ فالإنسان "البدائي" يعرف هو أيضاً هذه "الرغبة في أن يتصرف في نفسه عن طريق تحييد القوة التي تتحكم فيه وترويضها، وذلك عن طريق إلغاء سيطرتها عليه، وهذا الفعل هو الذي يؤدي إلى الميثولوجيا وهي عقلانية الإنسان البدائي، وهذا التوضيع كثيراً ما يقع تحليله في تاريخ الأديان وتاريخ الأديان المقارن، ويعترف بولتمان بأنه ليس من المجددين في هذا، ولهذا يشاطر عالم الأديان الهولندي القول بأنه الميثولوجيا إنما هي السيطرة على القوة عن طريق وسائل أربعة هي: التشكيل والتسمية والتخليد والاحتفاء(22).
وبهذه الوسائل الأربع تتم عقلنة الأسطوري وتوضيعه، "وذلك بأن تحول ما هو موجود هناك au-delà إلى موجود هنا en deçà بأن تجعله حقيقة ماثلة؛فالأسطرة إذن مرادفة للعقلنة حسب بولتمان، وهو لا يفتأ يذكرنا بأن كل الميثولوجيا اليونانية مكونة من كلمة لوغوس التي تعني العقل؛ ولكنها إذ "تتحدث عن هذا التعالي أو الواقع فإنها تتحدث عنه بطريقة غير ملائمة"، وبهذا يكون الفكر الأسطوري مناقضاً للفكر السحري؛ لأن هذا الأخير يسعى إلى الاتحاد بالعالم حتى يكون جزءا منه في حين أن الفكر الأسطوري يسعى إلى فصله عنه وجعله خارجه، فمن يريد أن يفهم الأسطورة إذن عليه كما يقول Van der Leeuw" ألا يبحث فيها عن تفسير لبعض الظواهر الطبيعية، ولكنّ شكلاً من أشكال السيطرة على العالم تريد أن تنزع عن "الأنت" ما يأخذه السحر من القوى الأخرى غالبا"(23).
ولتحقيق الهدف الذي وضعه بولتمان لنفسه -وهو تقبل "الأساسي" في هذا الفكر المسيحي، و "تحيينه"، والقضاء على هذه المسافة الزمانية والمكانية التي تعشش فيها الأسطورة- فإنه يلتجئ إلى مشروعه في نزع الأسطرة، الذي يعرفه بأنه "مسلك هرمونيطقي = تأويلي يسائل الملفوظات أو النصوص الميثولوجية عن محتواها الحقيقي،وهذا يفترض إذن أن الأسطورة تتحدث عن واقع ولكن بطريقة غير ملائمة، كما يفترض أيضاً فهْماً محدداً للواقع"(24).
وهكذا نفهم منذ البداية أن موقف بولتمان من الأسطورة ونقده لها غير التصور الوضعي أو العقلاني؛ "إذ الأسطورة ليست خرافة؛ فهي تحتوي حقيقةً على دلالة يجب تشفيرها وفكها إذا ما أردنا سماع نواة البشارة وفهمها" ،وبهذا المعنى فإن أول تحديد لنزع الأسطرة هو تحديد سلبي من حيثإنها تعني السعي إلى "الوعي بالملبوس أو الغلاف الميثي الأسطوري الذي اتخذته البشارة، التي تقول بأن "مملكة الرب قد اقتربت بشكل حاسم في شخص يسوع المسيح"، وهو الوعي الذي قادنا إلى اكتشاف أن هذا الاقتراب أو "المجيء" قد عبر عن نفسه في صيغة تمثيل ميثولوجي للعالم من الناحية الكوسمولوجية، وهكذا فإن نزع هذا الغلاف الميثولوجي معناه "-بكل بساطة- اكتشاف المسافة التي تفصل ثقافتنا وجهازنا المفهومي عن الثقافة التي عبرت فيها البشارة عن نفسها، وبهذا المعنى فإن نزع الأسطرة صارت تعني استعمالاً جديداًللهرمنوطيقا، لا يقوم على التأسيس edification؛أي بناء معنى روحي على معنى حرفي، بل الحفر تحت المعنى الحرفي نفسه أي تحطيما destruction وتفكيكا déconstruction للحرف نفسه ولظاهر اللفظ"، وهذه المهمة "إنما تعود إلى عصر ما بعد نقدي للإيمان"، الغاية منه أن يكون مشروع نزع الأسطرة مشروعاً تحركه "إرادة فهم النص بشكل أفضل؛ أي تحقيق مقصده في أن يتحدث عن "الحدث" لا عن نفسه، وليس في إنكار أي مقصد فيه، وهو ما يعني الرجوع إلى الوضعية الأولى: وضعية الإنجيل من حيث هو كلام عن شخص هو يسوع المسيح"(25).
ولا شك أن هذا المشروع يتطلب اصطناع منهج في الفهم والتفسير ونظرية في التاريخ، تجعل تحقيق هذا الهدف التيولوجي في "تحيين الحدث المسيحي وإعادة إدماجه في الوجود الفردي والجماعي" أمراً ممكنا.
-
مستويات "نزع الأسطرة" والدائرة التأويلية:
إن أحد المواضع الأساسية التي نجد فيها موقف بولتمان واضحا فيما يتعلق بنظريته في الفهم والتأويل وعلاقة مشروعه لنزع الأسطرة بالتاريخ هو: التفسير الإنجيلي؛ فلقد عُدّبولتمان-حتى داخل الأوساط الكاثوليكية والأكثر تقليدية- من أفضل مَنْ مارس "التفسير العلمي"، وقد حاول من خلال هذا التفسير أن يجيب على السؤال التالي: كيف يستطيع المؤمن والعالم في الوقت ذاته أن يتصلا بيسوع الإيمان من خلال هذه الوثائق، وهذه الكيفية هي التي يريد بولتمان أن يفهمها وهو يحيلنا على نظريته في التأويل، التي يحكمها ما يسميه بول ريكور "الدائرة التأويلية"، وقوامها ارتباط الفهم بالإيمان، أو "لكي نفهم يجب أن نؤمن ولكي نؤمن يجب أن نفهم"، فوراء الإيمان -كما يقول- هناك أسبقية لموضوع الإيمان على الإيمان، ووراء الفهم هناك أسبقية للتفسير ونهجه على القراءة الساذجة للنص بحيث إن الدائرة التأويلية الحقيقية هي دائرة منهجية؛ أي أن الدائرة المكونة من الموضوع هي التي تحدد الإيمان وتحكمه، وكذلك المنهج هو الذي يحدد الفهم، ومنشأ هذه الدائرة عنده أن المفسر ليس سيد نفسه، وبعبارة أخرى فإن الموضوع يضبط الإيمان في حين يضبط المنهج الفهم، كما يقول بولتمان.
والواقع أنه لا يمكن فَهْم ما يقول بولتمان بصدد التأويل دون أن يضع المرء في خلده أثر هايدغر، وخصوصا كتابه Sein undZeit في بناء نظريته حول نزع الأسطرة؛ بل يبدو أن موقف بولتمان من التاريخ -وخصوصا في صورته المموضعة كما يتجلى في مقاله حول التأويل- ليس سوى تَبَنٍّ حرفي لما جاء في الفقرتين 31و 32 من كتاب هايدغر المذكور، وخصوصا استعماله لمفاهيم الهيدغرية الثلاثة، ونعني: الفهم، والفهم القبلي، والفهم الذاتي؛ إذ يذهب هايدغر إلى أن كل فهْم إنما يحكمه فهم قبلي سابق pré compréhension لموضوعٍ ما هو فهم قبلي يحكمه اهتمامنا بهذا الموضوع المتعلق "بالفكر المفكر" pensée pensante-حسب التقسيم الهيدغري- لنوعي الفهم = الفكر المفكر = الفكر المموضع، وهذا الفهم الذاتي يسبق الفهم المصوغ الشهادة، الرواية والفهم التفسيري(26) .
ولعل أفضل المواضع التي عبر فيها بولتمان عن مثل هذه الأفكار هي مقاله الموسوم بـ "هل يوجد تفسير دون افتراضات؟"(27)، وفي هذا المقال يذهب بولتمان إلى القول بأن وجود تفسير دون افتراضات أمر ممكن إذا كان المقصود "عدم افتراض نتائج هذا التفسير"، وهو الأمر الذي طبقه في أعماله بصرامة كبيرة جعلته موضع تنويه من كارل ياسبرز، الذي وصفها بأنها "صرامة مطلقة"، ولكن ينفي بولتمان في المقابل وجود تفسير خال من الافتراضات؛ "ذلك أن التفسير ليس صحيفة بيضاء؛ بل إنه يقترب من النص من خلال أسئلة محددة، أو بالأحرى من خلال طريقة محددة لوضع السؤال، إضافة إلى أنه لا يخلو من بعض المعرفة بالموضوع الذي يتحدث عنه النص، ولهذا يلخص بولتمان موقفه في النقاط التالية:
-
أن التفسير ليس له أن يفترض نتائجه، بمعنى أن يكون دون مسبقات، وهو واجب يستدعي التخلي عن المجازاتوالمسبقات الأخرى ذات الصلة مثلا بالوعي المشيحاني عند يسوع.
-
يجب التفريق بين غياب الافتراضات -الذي يعني غياب المسبقات- والغياب الآخر الذي يعني غياب تصورٍ ما للمفسر عن موضوع النص أو التفسير، وهو الأمر غير الممكن قطعا(28).
والواقع أن العلم التاريخي ومناهج النقد التاريخي هي التي ستتكفل بتوضيح ذلك عند بولتمان، وقد نبه إلى نتائج ما سبق على التفسير الكتابي وذلك ضمن النقاط التالية:
-
أن التفسير الكتابي يجب أن يتم دون مسبقات مثل أي تأويل لا من نص آخر أدبي أو شعري أو غيره.
-
أن هذا التفسير ليس خلوا من الافتراضات؛ ذلك أن التفسير من حيث هو تفسير تاريخي فإنه يفترض تطبيق منهج البحث التاريخي النقدي.
إضافة إلى الافتراض السابق ينضاف الافتراض القائم على وجود علاقة حية بين المفسر والموضوع الذي يتحدث عنه الإنجيل ومن ثم افتراض وجود فهم قبلي، ويذهب بولتمان إلى أن هذا الفهم القبلي يتأسس على إشكالية "البحث عن الإله"، وهو البحث الذي يشغل بال الإنسان(29).
ويرى أن هذا الفهم القبلي مؤقت ولذلك هو مفتوح دوما بكيفية تجعل من الالتقاء الوجودي بالنص أمرا ممكنا من ثم "قيام قرار وجودي décision existentielle، وهذا الالتقاء الوجودي مع النص بإمكانه أن يؤدي إلى قرار -بنعم أو لا- إلى الإيمان أو عدمه من حيث إن النص يوجه إلى المفسر طلبا éxigence ويعطيه فهما ذاتيا، له أن يقبله أو أن يرفضه، فهو يقبله وصفه هبة don مادام يدفعه إلى اتخاذ القرار، وحتى في صورة الرفض فإن الفهم يظل فهما مشروعا وإجابة حقيقية على السؤال الذي يطرحه النص، وهي إجابة لا يمكن أن يدحضها أي احتجاج مادامت قرارا وجوديا، كما يقول.
إن فهم النص ليس نهائيا؛ ولكن يظل معنى الكتاب المقدس معنى متجددا في كل لحظة من لحظات المستقبل فما دام النص يتحدث عن الوجود؛ فإنه لن يفهم بشكل نهائي، والقرار الوجودي الذي يكشفه التفسير لا يمكن توارثه ولا نقله؛ بل يجب أن يعاش من جديد، كما يحب أن يوضح.
وهكذا فإن الدائرة التأويلية التي يحكمها طرفا الفهم والإيمان تعني في النهاية "أن نخضع لما يريد الموضوع قوله، وهنا يختلف بولتمان مع ديلثاي الذي يرى أن فهم النص معناه أن نجد فيه تعبيرا عن الحياة حياة صاحب النص، حيث يجب على المفسر أن يتمكن من فهم صاحب النص أفضل مما فهم نفسه، ولكن بولتمان يرفض هذا الموقف،فلا يعرى أن حياة المؤلف هي التي تحدد الفهم، وهو يتفق مع كارل بارط عندما يذهب في تفسيره للرسالة إلى أهل رومية إلى أن الفهم خاضع لموضوع الإيمان؛ بيد أن ما يفرق بين بولتمان وكارل بارط هو أن بولتمان فهم جيدا أن أسبقية الموضوع وأسبقية المعنى على الفهم لا تتم إلا من خلال الفهم نفسه؛ أي من خلال العمل التفسيري، ولذا وجب الانغماس أكثر فأكثر في الدائرة التأويلية...فالإيمان من حيث هو موضوع النص يجب أن يقع تشفيره في النص الذي يتحدث عنه في عقيدة الكنيسة الأولى التي عبرت عن نفسها في النص" ، ولهذا السبب يتحدث عن وجود دائرة تأويلية؛ بمعنى أنه "لكي نفهم النص يجب أن نعتقد ونؤمن بما يقوله النص لنا، غير أن ما يقوله النص لنا لا يوجد إلا في النص، ولذا وجب فهم النص لكي نؤمن".
والواقع أن فهم مشروع بولتمان لنزع الأسطرة إن قام على ما سبق بيانه -من نظرية في الفهم والتأويل- فإن فهمه كما ينبغي يجب أن يدفع بنا إلى التفريق داخل هذا المشروع بين مستويات استراتيجية ثلاثة، لا شك أن عدم فهمها قد أدى إلى وصف بولتمان بشتى النعوت، ولنؤكد على أن كل مستوى من هذه المستويات يرافقه تحديد خاص لمفهوم الأسطورة ولمفهوم التاريخ؛ ذلك أن بولتمان – وهذا أمر يجب ألا يغيب عن أذهاننا – لاهوتي قبل كل شيء وإن اشتغل بالتاريخ والفلسفة.
ففي المستوى الأول -وهو المستوى الخارجي والأكثر سطحية- نلاحظ "أن الإنسان الحديث هو الذي يقوم بنزع هذه الأسطرة متمثلة في هذا الشكل الكسمولوجي للبشارة الأولى؛ إذ إن الأسطورة في التحديد البولتماني "تفترض فهما محددا للواقع" ، غير أن هذا الواقع يفهم حسب بولتمان في معنين: أولهما: أن يقصد بالواقع "واقع العام كما تتمثله النظرة المموضعة" وهي نظرة علوم الطبيعة والتقنية، وهذه النظرة يعدّها بولتمان "نازعة للأسطرة بدورها démythogisante من حيثإنها تقصي أفعال القوى الخارقة للطبيعة التي تحكي الأسطورة قصتها" وهكذا فالأسطورة في هذا المستوى الأول إنما تفهم بوصفها "تفسيرا ما قبل علمي ذا طبيعة كسمولوجيةوأخروية صارت غير مقبولة بالنسبة إلى الإنسان الحديث... ثم إن العلم والتقنية لا يكتفيان بإقصاء الشكل الكسمولوجي، بل يقصيان كل ما يستتبعه ذلك من تمثيل "يصنعه الإنسان لمسؤوليته الأخلاقية والسياسية"، وقد طلب بولتمان أن يتم نزع الأسطرة في هذا المستوى دون تحفظ ولا نقصان.
وفي هذا المستوى يعترف بولتمان بأهمية التاريخ Histoire أو العلم التاريخي في صبغته المموضعة، ممثلا في مناهج مدرسة تاريخ الأشكال ومدرسة تاريخ الأديان المقارنة في كشف المسافة التي صارت تفصل مسيحي اليوم عن نواة البشارة. ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن بولتمان يفرق -اعتمادا على نظريته في الإنسان المستمدة من الفلسفة الوجودية الهيدغرية- بين مفهومين للتاريخ يعكسهما المصطلحين الألمانيين Geschichte و Historie، والواقع أن كتابه "التاريخ والأسكاتولوجيا"(30) يمثل أفضل تصوراته وتأملاته النظرية في التاريخ والكتابة التاريخية، وهو يذهب إلى أن التاريخ بمعنى الـ Historie هو التاريخ الموضوعي؛ أي التاريخ "الذي لا ينزع إلى التأويل ويكتفي بملاحظة الوقائع ووصفها وتنظيمها منظورا إليها من زاوية "حقيقتها الموضوعية"، وهو يرد على المعترض بعدم وجود "وقائع محضة" بأن ذلك صحيح إلى حدٍ ما؛ فكل جرد للوقائع التاريخية لا يخلو من نظرية ظاهرة أو باطنة في التأويل، ولكن بولتمان يريد أن يقلل من إطلاق هذا الزعم؛ أي بوجود جزء على الأقل من "الوقائع المحضة" التي هي مجال البحث التاريخي، تقبل بذلك كل الضمائر الحرة الخالية من النوازع المسبقة وكل ما هو من مجال الطبيعة يمكن أن يكون موضوعا للبحث العقلي، وإذا كان مجموع العلوم المسماة صحيحة قادرا على أن يبرز لنا معرفة بالغير به بوصفه جوهرا Was فإن التاريخ العلمي بالمعنى السابق بمقدوره أن يعطينا معرفة بالماضي بوصفه معطى gegebenheit؛ فدراسة الوثائق القديمة -أدبية كانت أو أركيولوجية- تؤسس شكلا من أشكال الموضوعية تتعلق بالأحداث والأفعال التي تتحدث عنها. يقول بولتمان:إن البحث المنهجي الصرف بإمكانه أن يعرف بشكل موضوعي جزءاً ما من سير التاريخ أي الأحداث بوصفها أحداثا فحسب حدثت في لحظة ما من الزمن والمكان. انطلاقا من هذه الزاوية فإن القول بأن كثيرا من يقينية التأكيدات التاريخية هي نسبية لا يشكل اعتراضا حقيقيا؛ إذ إن كثيرا من الأحداث بطبيعة الحال لا يمكن ضبطها؛ لأن الشهادات التي وصلتنا عنها غير كافية أو غامضة، ولأن فطنة المؤرخ وقدرته لها دوما حدود، بيد أن هذا لا أهمية له نظريا؛ ذلك أن البحث التاريخي المنهجي بإمكانه مبدئيا أن يصل إلى معرفة موضوعية في هذا الميدان.
وانطلاقا من هذا التصور للتاريخ في معناه الأول فإن المسيحية بوصفها حدثاً يتنزل في الزمان والمكان- تخضع خضوعا تاما للنقد، ثم إن النقد التاريخي عامة والنقد الكتابي بصفة خاصة يتطلبان نزاهة كبيرة تستدعي وتستوجب "غياب كل المسبقات" فيما يتعلق بنتائج البحث؛ فالمؤرخ مثلاً ليس له أن يخضع "إلى رغبته في أن يؤكد النص رأياً محدداً عقائديا، أو أن يعطيه تعاليم صالحة للعمل إلى باحث سلبي، بل بالعكس فالمقصود هو أن يوظف كل ثقافته وطاقته وصفاء ذهنه وذكائه في موضوع دراسته، وبهذا فإن "العلم" الأكثر "ذاتية" هو ذلك الذي يكون أكثر "موضوعية"، بل ويذهب في موضع آخر إلى التأكيد بأن "ذاتية المؤرخ إنما هي عامل ضروري لقيام معرفة تاريخية موضوعية". ويوضح بولتمان مفهوم الموضوعية لديه بأن الموضوعية في التاريخ" ليس لها المعنىنفسه في العلم الطبيعي؛ بل إن هناك وجهتي نظر يجب الفصل ينهما في الكتابة التاريخية لكي نفهم الموضوعية في العلم التاريخي: وجهة النظر الأولى هي ما أسميه بالمنظور، أو وجهة النظر التي يختارها المؤرخ. والثانية أسميها -كما يحلو لي- باللقاء الوجودي بالتاريخ"(31).
ويفسر بولتمان معنى "المنظور" أو وجهة النظر بأن "الظاهرة التاريخية يمكن أن تدرس من خلال عدد من وجهات النظر مختلفة؛ وذلك بسبب أن الإنسان كائن معقد"، ولهذا فإن الحقيقة في التاريخ "تصير بداهة وجهات موضوعية بالنسبة إلى وجهة نظرٍ ما. فالذاتية-ذاتية المؤرخ- لا تعني بأنه يرى بشكل فاسد، ولكن تعني أنه اختار وجهة نظر معيّنة، وأن بحثه يبدأ من تساؤل خاص، ثم يضيف بولتمان حجة أخرى، وهي أنه لما كان "موضوع المعرفة التاريخية هو الإنسان نفسه-في طبيعته الذاتية- فإنه لا يمكن في هذا السياق أن يقع الفصل جذريا بين الذات وموضوع المعرفة"(32).
لقد اعترف بولتمان بالجميل وبالدين الذي عليه للتفسير الليبيرالي في القرن 19 وبداية الـ 20 ، ونحن نعلم أنه كان صحبة كارل بارط وآخرين من رواد "اللاهوت الديالكتيكي؛ ولكنه اعترف منذ البداية بأن "التجديد اللاهوتي يجب أن يأخذ بعين الاهتمام النقد التاريخي في صرامته، وهو موقف كان أحد أسباب انفصاله التدريجي عن كارل بارط، الذي لا يحفل في نظره كثيرا بالتفسير العلمي؛ أي ذاك الذي يأخذ بمتطلبات البحث التاريخي في معناه الأول -وهو يكشف عن هذا الدين تجاه الليبيراليين الكبار الذين حسّسوا علماء اللاهوت بأهمية النقد التاريخي خصوصا والنقد عموما بقوله في نص جميل: "لقد قربوا إلى أنفسنا النقد، أعني الحرية والحقيقة، ونحن الذين أتينا من أفق الثيولوجيا الليبيرالية،إنه لم يكن في مقدورنا أبدا أن نصير علماء لاهوت أو أن نبقى كذلك، لو لم نلتق داخل الثيولوجيا الليبيراليةبالجدية: جدية الحقيقة الجذرية. لقد كنا ننظر إلى العمل التيولوجي الجامعي الصارم في تقصيه وحرصه على الدقائق على أنه تمرين على قبول التسويات، تسويات لم نكن نستطيع أن تكون فيها سوى كائنات أو وجود منكسر في داخله. ولهذا ثار بولتمان ضد كل الأرثوذوكسيات الدينية وضد التضحية بمقتضيات العلم، وشدد على أن العمل النقدي الذي قامت به الأجيال السابقة يجب ألا يتلف؛ بل يجب أن يستعاد بطريقة إيجابية.
ولكي نتعرف على أثر المنهج التاريخي -متمثلا في مدرستي تاريخ الأشكال وتاريخ الأديان- يجدر أن ننظر إلى بعض المجالات التطبيقية، ونعني قضية يسوع التاريخ ويسوع الإيمان وصلتها بقضية الوعي المشيحاني عنده.
-
يسوع التاريخ ويسوع الإيمان:
إن النقد الأساسي الذي وجه بولتمان للثيولوجيا التاريخية النقدية الليبيرالية في القرن 19 هو توهمها أنه بالإمكان أن تعثر في التاريخ عن أساس للإيمان، "وهو ما يعدّه بولتمان وهْماً وخطأ ثيولوجياً. فهو وهْمٌ بالنظر إلى نتيجة 150 سنة من البحث التاريخي الذي خصص للكشف عن يسوع التاريخي، فهذه السنوات الطوال تؤكد عدم جدوى مواصلة قطع هذا الطريق. فتعده "البورتريهات" دليل على عبثية هذا المسعى. ويعود السبب الأول في فشل هذه المحاولات إلى المصادر التي تعتمد عليها؛ فقد بين بولتمان-اعتمادا على منهج تاريخ الأشكال- أن هذه المصادر لم تكن تلقي بالا إلى حياة يسوع الحقيقة أو الموضوعية، كما أنها لم تكن تلقي بالا إلى شخصيته وحياته الداخلية والنفسية إذا كانت مسكونة بها جنس مخالف، فقد كتبت استجابة لدوافع وحجات ثيولوجية أساسا غير تاريخية، ولهذا فهي تحمل بعد مشروعا للبشارة ولعقيدة هي عقيدة الجماعة التي كتب فيها وبيَّنها، وهذا هو الذي نبه إليه بولتمان من خلال دراسته للأناجيل المتقابلة أو الإزائية.
ولهذا يقول في كتابه عن يسوع: "إن المسيح -من حيث هو جسد- لا يهمني، إنني لا أعرف ولا أريد أن أعرف ما الذي دار بخلد يسوع"، كما يضيف في موضع آخر: "إن يسوع لم يعط تعاليم تخص شخصه؛ ولكنه أشار إلى أن المهم هو حمله البشارة... بشارة السعة الأخيرة وما يشر به يسوع لا يبشر بهعدُّه أمرا جديدا أو لا مثيل له، ولكن الحاسم فيه هو أن يبشر به ويعلنه" الآن "، ولهذا ينتهي إلى القول صراحة إلى أنه "لا يمكننا أن نعرف شيئا تقريبا عن حياة يسوع وشخصه؛ وذلك أن المصادر التي بأيدينا لم تلق بالا إلى هذا الأمر، إضافة إلى عدم وجود أي مصدر آخر عن يسوع"، معتبرا كل ما كتب عن حياة يسوع منذ حواليقرن ونصف عن شخصه وتطوره الداخلي النفسي إنما يدخل في صنف الرواية الخيالية، وهكذا فإن منهج تاريخ الإشكال سيؤدي عند تطبيقه على مسألة الوعي المشيحاني عند يسوع إلى قلب الهم السائد، بكيفية جعلت البعض يتساءل عن وجود مفارقة في عمل بولتمان هذا اللاهوتي الذي يعتمد النهج التاريخي المموضع ليخرج "بنتائج هزيلة" تفقر من صورة يسوع التي رسمها اللاهوت المسيحي طوال تاريخه.
-
قضية الوعي المشيحاني:
كان الرأي السائد في هذا الموضوع "هو أن عقيدة الجماعة المسيحية الأولى في مشيحانية يسوع تقوم على وعي يسوع بنفسه أنه المسيح –أو ابن الإنسان حقا. وهذا الرأي هو مذهب كتبة الأناجيل أنفسهم؛ ولكن الإشكال يتعلق فعلا بالتساؤل عما إذا لم يكونوا هم أصحاب هذه الفكرة، الذين أدخلوها في الروايات المتعلقة بيسوع؛ إذ من المحتمل جداً أن يكون الإيمان بمشيحانيته قد ظهر نتيجة الإيمان بقيامته.
إن روايات الأناجيل المتقابلة أو الإزائية لا تشك لحظة في أن حياة يسوع ونشاطه تخلوان من أي مظهر من مظاهر الماشيحانية رغم كل التغييرات التي أصابتها. وتظهر حياة يسوع في كثير من النصوص حياة رجل عادي،خالية من كل تلك العظمة المشيحانية، وهو ما تؤكده الرسائل إلى أهل رومية. ويستدل بما تشير إليه أعمال الرسل من أن الجماعة المسيحية الأولى قد جعلت بداية مشيحانية يسوع إنما تعود إلى زمن قيامته فحسب. ويشير إلى لفظ مشيح يعني المخلص في الآخرة. ولكنه أخذ لاحقا معنى الملك؛ ولكن يسوع لم يظهر أبدا بوصفه ملكا بل كان نبيا وعلما وراقيا، ولا تعثر أبدا على كل تلك القوى والعظمة التي تحملها كلمة مشيح العبرية، ولا نعثر أبدا على مظاهرها في حياة يسوع ولا حتى في رقاه وما ينسب إليه من معجزات؛ ذلك أنه حسب الفهم اليهودي لكلمة مشيح فإن الأزمنة المشيحانيةإن كانت الخوارق والكرامات من علامتها؛ فإن المسيح نفسه ليس صانع كرامات ولا مدعيا لها، وحتى ما يمكن أن يرد به من القول تبعا لأقواله عن ابن سينا؛ فإن يسوع لم ينظر إلى المشيح بوصفه ملكا داودياَّ، ولكن بوصفه حكماً ومخلصاً سماوياً.
إن النقد التاريخي في عرف بولتمان يكشف كيف أن المظهر الإلهي ليسوع في صبغة الميتولوجيةالمموضعةالمعقلنة قد أقحم لاحقاً في الروايات الأقدم، ولا شك أن مثل هذه النتائج لم ترض الأوساط اللاهوتية المحافظة؛ ولكن بولتمان-المنخرط في الوضعية التأويلية الجديدة- لا يستطيع أن يعرض عن النقد التاريخي الحديث لمجرد الحفاظ على "أيمان العجائز"، ولذلك يقر بأن الإيمان لا يمكن له ولا يجب أن يعتمد على "عكاكيز" من مثل المعجزات. والبحث التاريخي ينكر أن يكون ليسوع معجزات، وكل ما ينسب إليه من إبراء الأكمه والأبرص والكرامات قد فعل مثله كثير من الأحبار والربانيين اليهود، وهو على كل حال مما عرفته الشعوب السامية آنذاك؛ ولهذا فإنه يرفض أن يكون للتاريخ المموضع (33) objectivant أي دور في تأسيس الإيمان، وهذا الموقف هو مدخله الطبيعي إلى تصوره الآخر للتاريخ؛ أي التاريخ الوجودي.
فهل أن التاريخ المموضع في علاقته بمشروع نزع الأسطورة نازع للأسطورة هو أيضا كالفكر العلمي والتقني؟ عن هذا السؤال يجيب بولتمان بنعم أو (ل)، "فالعلم التاريخي=المموضع نازع للأسطورة مادام يفهم المسار التاريخي على أنه تتابع مغلق للوقائع؛ ذلك أن المؤرخ لا يستطيع أن يقبل فكرة انقطاع الأحداث عن طريق تدخل قوى غيبية. فهو لا يعرف بأي معجزة ولا بأي حدث لا يجد له سببا في غير التاريخ نفسه، فالتاريخ نفسه العلمي لا يمكنه أن يتحدث كما تتحدث الأناجيل عن تدخل الإله في مسار التاريخ لأنه لا يستطيع أن يرى سوى الإيمان بالفعل الإلهي كظاهرة تاريخية عليه أن يؤولها؛ لأنه يطرح مشكلة المعنى: معنى الخطاب الميثولوجي الذي هو ظاهرة تاريخية.
ولهذا السبب بالذات رأىبولتمان "أن الأسطورة غير الخرافة؛ لأنها تحتوي فعلا على دلالة يجب تشفيرها إذا ما أردنا الاستماع إلى نواة وفهمها؛ ذلك أن غاية الأسطورة هي التغيير عن الطريقة التي يفهم بها الإنسان نفسه في هذا العالم، وهي من ثم تعبر عن وعي الإنسان بأنه ليس سيد نفسه تابعا لعالمه المألوف فحسب؛ بل وللقوى التي تتحكم به وهي التبعية التي يبحث الإنسان عن إمكان للتحرر من استعبادها أي أن الأسطورة في العهد الجديد تعكس بداية نقد الإنسان لتمثيلاته المموضعة ولذا وجب دراسة الأسطورة لا للكشف عن محتواها، بل لمعرفة الوجود الذي يعبر عن نفسه من خلال التمثيلات الأسطورية؛ فالأسطورة؛ تتحدث عن واقع الإنسان نفسه ، ومن ثم عن وجوده، ولذا فإن ما يهمنا منها هو "تعبيرها عن فهم محدد للوجود البشري... وفي مواجهة النزعة المموضعة للفكر الميثي فإن نزع الأسطرة يسعى لإظهار المقصد الحقيقي للأسطورة؛ أي مقصدها في الحديث عن واقع الإنسان وحقيقته"، وهكذا فإنه في هذا المستوى" يقف مشروع نزع الأسطرة في مقابل حركتها المموضعة يستدعي التجاء إلى التأويل الوجودي على الطريقة الهيدغرية، وهو التأويل الذي يصطدم بالزعم الفلسفي الذي يرى إمكانية معرفة معنى الواقع من خلال العلم والتقنية وحدهما".
-
مصاعب القراءة البولتمانية:
لقد عرضنا فيما سبق بعض ملامح هذا المشروع البولتماني، وأفسحنا له المجال ليتحدث بنفسه في مقاطع تبدو أحيانا طويلة، أو من خلال أهم شراحه، وهو المشروع الذي ملأ القارة العجوز، وشغل الأوساط اللاهوتية والفلسفية المهتمة بقضايا "التخوم" -كما يسميها بول ريكور- وقضايا تجديد الفكر الديني في المسيحية، وبالرغم من انقضاء فترة طويلة فإن السؤال البولتماني لا يزال حيا، وهو سؤال كل من لا يزال يعتقد أن في الأديان بقية حياة، والإنسان الديني الذي يتحدث عنه تاريخ الأديان لا يمكن أن ينقرض لمجرد غلبة النزعة التقنية على العالم المعاصر، فالعلم التقني لا يفكر كما يقول هابرماز ومادام هناك طرح مستمر لقضايا المعنى والوجود والألم والشر وغيرها؛ فلا شك أن الدين سيظل قائما يقدم إجابةً ما تشكِّل جزءاً من وجود الإنسان المعقد. وربما كانت حيوية الفكر البروتستانتي ذي الأصول الجرمانية هي التي تفسر كون أغلب محاولات تجديد الفكر الديني كانت ألمانية في الأساس، تلقفتها بعد ذلك الأوساط الأوروبية الأخرى الفرنسية والإنجليزية ثم الأنجلوسكسونيةعموما(34)،وكانت التقاليد الفرنسية قد تعرفت عليه مبكرا مع بول ريكور البروتستانتي هو أيضاً، والواقع أنه هو مَنْ أحسن الإصغاء إلى ما يقوله بولتمان، ولخص موقفه منه بقوله: "إن ما يقوله بولتمان يدعو إلى التفكير؛ ولكن ليس كل ما يقوله قد تم التفكير فيه كما ينبغي. ولذلك يحتاج إلى أن نفكر معه وضده في الوقتنفسه"(35)، وإذا كان ريكور منذ زمن بعيد منشغلا بمسائل الدين -وهو البروتستانتي الذي ترك فيه غابرييل مارسيل أثراً لا يمحى- فإنه قد جاء إلى بولتمان من خلال تأملاته في نظرية النص التي كتب فيها لاحقاً أفضل إنتاجاته، وأشاد في مقدمته عن بولتمان إلى أهمية انفصاله مع التقاليد الرومنسية ذات المنزع التاريخاني والنفسي التي عبر عنها كل من شلايماخروديلثاي على ما بينا، ليهتم بالنص أساسا ويخضع لقوانينه(36)، وهو أن شاطر بولتمان وجود لحظتين أساسيتين هما اللحظة التركيبية النصية المموضعة، واللحظة الوجودية المرتبطة بالمؤلف، إلا أنه أكد اختلافه عنه؛ لأن الصلة بين هاتين اللحظتين لم تكن دوما واضحة بالنسبة إلى بولتمان، وهو سريع الميل إلى التضحية باللحظة المموضعة لحظة تفسير النص وشرحه من أجل المرور إلى اللحظة الوجودية: لحظة الالتقاء بنواة البشارة بكيفية غير مقنعة(37) وهذا ما يعني أن ما يعيبه ريكور بالأساس على بولتمان هو رؤيته أن النص هو مجال التأويل الأساسي الذي لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه والمسارعة إلى المؤلف،ومن ثم فالتأويل الكتابي هو تأويل ذو طبيعة مزدوجة، يستدعي طرح الجوانب النفسية في عملية التأويل من ناحية، وبناء الابستمولوجي على قاعدة الأنطولوجي؛ أي ربط الحقيقة بالمنهج بحسب عبارة غادامير الزميل الأثير لبولتمان في جامعة ماربورغ، مثلما يلاحظ الباحث زافييهإمهارت عن حق. ومن هنا يتبين أن ريكور الفيلسوف لا يستطيع أن يتجاوز التأويلية الفلسفية من أجل تأويلية كتابية يراها متسرعة وغير راديكالية، وهذا هو ما يجب الإقرار به؛فبولتمان ظل لاهوتيا قبل كل شيء وإن اشتغل بالفلسفة والتاريخ، في حين ظل ريكور في نظرته لبولتمان فيلسوفا بالأساس مثلما لاحظ عن حق إليانكوفيلييه(38)، وهو ما تعكسه أيضا مقدمته لبولتمان التي أعاد ضمها إلى كتابه صراع التأويلات اللاحق ،كما لم يفت ريكور أن يعترض على سذاجة بولتمان حينما عابه كما بقي ألان غريش على الاعتقاد في وجود نواة غير أسطورية؛ إذ بحسب بولتمان فإنه بالإمكان أن نستخرج أو نقتطع من الأسطورة أو الميث رسالة أو نواة وجودية لا تشوبها شائبة sans reste؛ أي أن نقتطع لغة يمكن وصفها بأنها غير مموضعة(39) non-objectivante وهو الأمر الذي لم يقبله ريكور، وجعله يتساءل "عن هذه اللغة" لغة الإيمان، عندما تكف عن أن تكون لغة مموضعة: هل هي ممكنة فعلا؟ ثم إذا افترضنا جدلا أنها صارت لغة غير مموضعة هل معنى ذلك أنها صارت لغة شفافة لا شبهة فيها؟" ليتهمه في النهاية بقوله: "إن بولتمان لا يظهر قدرا كافيا من الاهتمام بما تتطلبه هذه اللغة لغة الإيمان، في حين كان شديد الشك والريبة تجاه لغة الأسطورة". وينتهي إلى القول: "إن بولتمان يبدو وكأنه يعتقد أن لغةً ما عندما تكف عن كونها مموضعة تصير بريئة؛ ولكن هل بقيت لغة عندئذ؟ ما الذي تعنيه؟"(40)
لا شك أن مشروع بولتمان يحتاج منا إلى مزيد تدبر وروية، ويحتاج إلى أن ندرك كل النقد الذي وجه إليه في الأوساط الجرمانية الأنجلوسكسونية خصوصا، وهو أمر يكشف حيوية الفكر المسيحي الذي غامر منذ وقت مبكر في مشروع الإصلاح الديني، وليس أمام المسلمين إلا تدبر هذه المغامرة؛ لأن ما كتبه بولتمان من ضرورة البحث عن تأسيس الإيمان على غير التاريخ في معناه الحدثي والوقائعيإنما هو ضرورة ملحة، وهو يعبر عن أن أزمة الفكر الديني على المستوى الكوني واحدة منذ أن أطلت الحداثة برأسها،وبإمكان المسلمين هم أيضا استئناف تقاليدالقدامى في المشاركة في علوم عصرهم وتيارهم، ما قد يسمح لنا بنشأة كلام جديد لا يجتر الماضي فقط؛ وإنما يحاور ويناظر ويجادل؛ حتى يخرجوا مما وصفه موشيه مندلسون بصدد إلى هودية من إسار يهودية المتسفوتأو الهلاخا أي إسار ديانة الأحكام وثنائية الحلال والحرام فقط؛ التي تفقر الأديان فقرا لا مزيد عليه.إننا لم نكن لنلقي بالا إلى بولتمان أو أرنست كازمان أو يورغنمولتمان أو بول تيليش وغيرهم لو لم نجد عندهم الأسئلة نفسهاالتي تؤرقنا،ولذلك دعونا دوما إلى التفكير فيما يمكن أن تجلبه مثل هذه التساؤلات على الفكر الإسلامي، وتكتفي بالإشارة إلى أهمية ذلك من خلال ما خلّفه الاستشراق التقليدي نولدكه وتاريخ القرآن مثلا، أو ما أنتجته المدرسة المراجعيةالأنجلوسكسونية الحديثة منذ نهاية السبعينات، متسائلين: ألا يمكن أن نجد في التعامل البولتماني مع الوضعية التأويلية الجديدة مخرجا للفكر الإسلامي يمكّنه من استيعاب المناهج النقدية التاريخية ومشتقاتها الأخرى مطبقة على نصوصه الثرية، وخروجه منها بأخف الأضرار؟ أم هل باستطاعته أن يعيش حداثته ووضعيته التأويلية الجديدة مع غض النظر عن المرحلة النقدية التاريخيةيتوارى من حركة الإصلاح الديني الكونية من سوء ما بُشِّر به ؟
***
المراجع والمصادر:
-
انظر حول سيرته الاستثنائية ومواقفه من العقيدة[Adrien VI et la possibilité du pape hérétique. https://lebloglaquestion.wordpress.com/2c013/02/08/adrien-vi-et-la-possibilite-du-pape-heretique/]
وردت هذه الحادثة في [Ludwig vonPastor, Histoire des papes depuis la fin du Moyen Âge, vol. IX, Paris, 1913, chap. 1 et 2]
-
انظر: [Bloch, E. (1921). Thomas MunzeralsTheologe der Revolution. Munchen: K. Wolff.]
-
انظر: [Kant, I., Bahr, E. (1983). Was istAufklärung: Thesen und Definitionen. Universal BibliothekStuttgart :
Moses Mendelssohn, Qu’est ce qu’éclairer ? In Kant, I., Mendelssohn, M. (2006). Qu'est-ce que les lumières ?Mille et une nuits. Paris : Mille et une nuits.]
-
انظر: [Chaunu, P. (1975). Le temps des Reformes : Histoire religieuse et système de civilisation : la crise de la chrétienté : l'éclatement (1250-15500). Le monde sans frontières. Paris : Fayard.]
-
انظر: [Hammann, K., &Devenish, P. (2013). Rudolf Bultmann: A Biograpghy. Salem, Oregon :Polebridge Press. ]
-
هو الوجه الآخر لبولتمان، وهو عميد اللاهوت الكاثوليكي المعاصر الذي لا نعرف عنه في العربية أي شيء تقريبا. انظر للتعريف به [Busch, E., & Bowden, J. (1976). Karl Barth: His Life from Letters and Autobiographical Texts. London : SCM Press.]
-
المشكلة الإزائية أو السينوبتيّة هذه المشكلة "لم تعشها الكنيسة الشرقية بوجه عام، كما يقول المقص تادرس يعقوب الملطي؛ وإنما شغلت أذهان دارسي الكتاب المقدّس في الغرب منذ متصف القرن الثامن عشر، خاصة مع بدء القرن العشرين. كلمة Synoptic (...) تعني رؤية الكل معا بنظرة تكامليّة، فهي تخص الأناجيل الثلاثة: متّى،ومرقس،ولوقا؛بكونها أناجيل تحوي هيكلا متشابها ومواد متشابهة، وإن وجدت أيضا مواد غير متشابهة. فالمشكلة هي كيف حدث هذا التشابه؟ هل اعتمدت الأناجيل بعضها على بعض، أم رجعت إلى مصدر بدائي واحد، سواء كان شفاهيا كالتقليد أو كتابيا، أو أكثر من مصدر؟" [راجع: http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretation/Holy-Bible-Tafsir-02-New-testament/Father-Tadros-Yacoub-Mataly/00-General/Introduction-About-The-Four-Gospels_El-Anageel-El-Arba3a-07.html ] وعنها كتب بولتمان مؤلفه الأساسي: [Bultmann, R. (1921). Die Geschichte der synoptischenTraduction. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.Bultmann, R., & Malet, A. (1973). L'Histoire de la tradition synoptique traduit de l'allemand par André Malet ([Ed.] suivie du complément de 1971 éd.) Paris : Editions du Seuil.]
-
يرجع الفضل في الحقيقة إلى الفيلسوف إلىهودي هانس جوناس 1903-1991 في نحت هذا المفهوم منذ سنة 1930 ،وهو بولتمان؛ ولكن التلميذ أعطى لأستاذه ما كان ينقصه ليبني صرح مشروعه الفكري الأساسي، وله معه محاورات ومراسلات. انظر حوله وحول صلتهما: [Frogneux, N. (2001). Hans Jonas ou la vie dans le monde. De Boeck Supérieur. Note 20 p 243.]
-
انظر مثالا لا حصرا كارل ياسبرز من المعاصرين له:[ Karl Jaspers, "Wahrheit und Unheil der BultmannschenEntmythologisierung. In:KerygmaundMythos Bd. III, 1954, p.19 ] وفي أيامنا هذه انظر مثلا بعض الأوساط الكاتوليكية التقليدية[le système de Bultmann est extrêmement dangereux" (Abbé Jean Carmignac). (s.d.). OverBlog.http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-le-système-de-bultmann-est-extremement-dangereux-abbe-jean-carmignac-95391356.html ]
-
انظر: [Dibelius, M. (1919). Die Formgeschichte des Evangelismus, von Martin Dibelius. Tübingen, J.C.B. Mohr ] وحول أهمية مقاربة هذه المدرسة للأناجيل الإزائية راجع:[ Grobel, K. (1973).Formegeschichte und SynoptischeQuellenanalyse. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.]
-
حول أهمية ديبليوس في نشأة هذه المدرسة وفي تكوين بولتمان نفسه انظر: [Paperback, P. (s.d.). Analyse und Kritik der formgeschichtlichenArebeiten von Martin Dibelius und Rudolf Bultmann. Basel: F. Reinhardt]
-
[Ricoeur, P. (1969). Le Conflit des interprétations, essais d'herméneutique. Paris: Editions du Seuil.]
-
راجع كتابه: [Greisch, J.(2001). Paul Ricoeur, l'itinérance du sens. Grenoble: J. Million. P 112-113]
-
انظر: [François Jaran – "De la différence entre l'histoire comme événement et l'histoire comme science chez Heidegger" 105 Klēsis – revue philosophique ]
-
حول صلة بولتمان بالتاريخ انظر: [Odette., L. (1958). Bultmann et l'histoire. Revue d'histoire et de philosophie religieuses (RHPR), vol.38., p.219-231.]
-
انظر: [Ricoeur, P. (1969). Le conflit des interprétations, essais d'herméneutique. Paris : Editions du Seuil. ]
-
انظر: [[1]Ricoeur, P. (1969). Le conflit des interprétations, P 373-375]
-
انظر: [Barthel, P. (1963)..Interprétation du langage mythique et théologie biblique, études de quelques étapes de l'évaluation du problème de l'interprétation des représentations d'origine et de structure mythiques de la foi chrétienne. Leiden: E.J. Brill p69. ]
-
انظر: [Malet, A. (1962). André Malet,…Mythos et logos, la pensée de Rudolf Bultmann. Genève: Labor et fides p 45-48 Barthel, P. (1963)..Interprétation du langage mythique et théologie biblique, p69. ]
-
انظر: [Leeuw, G.v.d. (1948). G. Van der Leeuw,… La Religion dans son essence et ses manifestations, phénoménologie de la religion ["Phänomenologie der Religion"]. Edition française refondue et mise à jour par l'auteur avec la collaboration du traducteur, Jacques Marty. Paris: Payot. (1) Otto, R., &Jundt, A. (1929). R. Otto,… Le Sacré. L'Élément non rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le relationnel. Traduction française par André Jundt. Paris : Payot. ]
-
انظر: [Malet, A. (1962). André Malet,… Mythos et logos, la pensée de Rudolf Butmann. P48]
-
نفسه ص 47
-
نفسه ص 49
-
انظر: [[1]Ricoeur, P., &Greisch, J. (2013). Le conflit des interprétations essais d'herméneutique 5préface de Jean Greisch] ([Nouvelle éd.] ed.). Paris : Ed. du Seuil.]
-
راجع حول هذه النقطة: [Foi et compréhesion1, L'historicité de l'homme et de la Révélation Seuil 1970; [2], Eschtalogie et démythologisation Seuil, 1987.]
-
انظر: [Bultmann, R. Foi et compréhension. p]
-
هذا ما يوافقه عليه ريكور؛ ولكنه يعترض عليه في بعض فهم بولتمان لهايدغر في مسألة الافتراضات المتصلة بالفهم والتفسير في مجال الدراسات الكتابية، وهو موقف يعكس أيضا صعوبة تعامل ريكور نفسه لامعبولتمان بل مع هايدغر بالأساس ولمراجعة هذه النقطة يمكن الرجوع إلى الفصل الثامن من كتاب زافييها مهارت [Amherdt, F-X., (2004). L'herméneutique philosophique de Paul Ricoeur et son importance pour l'exégèse biblique, en débat avec la New Yale TheologySchool Editions Saint-Augustin. P371] ويعيب عليه تعامله الانتقائي مع هايدغر، فكأنه يؤمن ببعض هايدغر ويكفر ببعض، فهو لم يحتفظ منه إلا ببعض المقولات الانتروبولوجية التي تسمح له بالقيام باستنتاجات تخدم التفسير الكتابي ص 371-372 من كتاب امهارست.
-
انظر: ["La précompréhension est fondée sur la quête de Dieu qui préoccupe l'homme (…) La rencontre existentielle avec le texte peut aussi bien conduire au oui qu'au non, à la foi confessante qu'à l'incrédulité complète, puisque le texte adresse à l'exégète une exigence, qu'il lui offre une compréhension de soi qu'il peut accepter comme don ou rejet, puisque, enfin, il l'oblige à la décision".]
-
انظر: [Bultmann, R., & Brandt, R. (1969). Histoire et eschatologie Traduction [de l'anglais]… par R. [Roger] Brandt. Neuchâtel Paris:Delachaux et Niestlé. ]
-
انظر: [(…) la rencontre existentielle avec le texte peut aussi bien conduire au oui qu'au nom, à la foi confessante qu'à l'incrédulité complète, puisque le texte adresse à l'exégète, qu'il lui offre une compréhension de soi qu'il peut accepter comme don ou rejeter, puisque, enfin, il l'oblige à la décision. Rudolf Bultmann, Mythologie et démythologisation, Le Seuil, 1968, page 35. ]
-
انظر: [Bultmann, R., & Brandt, R. (1969). Histoire et eschatologie Traduction [de l'anglais]…par R. [Roger] Brandt. Neuchâtel Paris : Delachaux et Niestlé.²]
-
للنظر في هذا المفهوم وتمييزه عن مفهوم الوجودي بمعنى الهيدغرية من الأفضل الرجوع إلى مقال أندري غونيل الت إلى [Existentialisme et théologie. (s.d). http://andregounelle.fr/vocabulaire/existentialisme-et-theologie.php]
-
حول تطور المدرسة البولتمانية لاحقا انظر الفصل المتعلق بهذا الموضوع في [Barthel, P. (1963). Pierre Barthel. Interprétation du langage mythique et théologie biblique, études de quelques étapes de l'évolution du problème de l'interprétation des représentations d'origine et de structure mythique de la foi chrétienne. Leiden: E.J. Brill. P101-102]
-
انظر: [Pinart, M.-G (2002). Hans Jonas et la liberté dimensions théologiques, ontologiques, éthiques et politiques. Paris : J. Vrin.p20-21 ]
-
انظر: [Ricoeur, P., &Amherdt, F-X. (2001). L'herméneutique biblique présentation et tard. Par François-Xavier Amherdt. Paris: les Ed. du Cerf. P49. ]
-
لقد لخص الباحث لاين بلند أهم اعتراضات ريكور على بولتمان من هذه الزاوية فليرجع إليه [Pland, L.M. (1985). Literary criticism and biblical hermeneutics: a critique of formalist approaches. Chico, Calif.:ScholarsPress. Chap.1.pp11-64; ] ولمن يريد التوسع أكثر في اللغة الفرنسية في هذه النقطة بإمكانه الرجوع إلى: [Amherdt, F-X. L'herméneutique biblique. Chapitre7 (cf. infra, pp.366-374)]
-
انظر: [Avon, D., & Fourcade, M. (2009). Un nouvel âge de la théologie, 1965-1980: colloque de Montpellier, juin 2007. Paris: Karthala. P247. ]
-
لقد نوقش مفهوم التوضيع طويلا ويمكن الرجوع إلى أولي الدراسات في الفرنسية: [Kesel, J.D. (1981). Le Refus Decide de l'Objectivation : Une interprétation Du Problème du Jésus Historique Chez Rudolf Bultmann. Gregirian&BiblicalPress. ]
-
انظر: [Paul Ricœur, préface à Rudolf Bultmann, Jésus. Mythologie et démythéologisation. Seuil, 1968, p.9-27] وقد ترجم مقال "مقدمة عن بولتمان" إلى العربية ضمن ترجمة كتاب: ريكور، ب. (2005): صراع التأويلات: دراسات هرمنوطيقية. ترجمة منذر عياشي. دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت، لبنان.