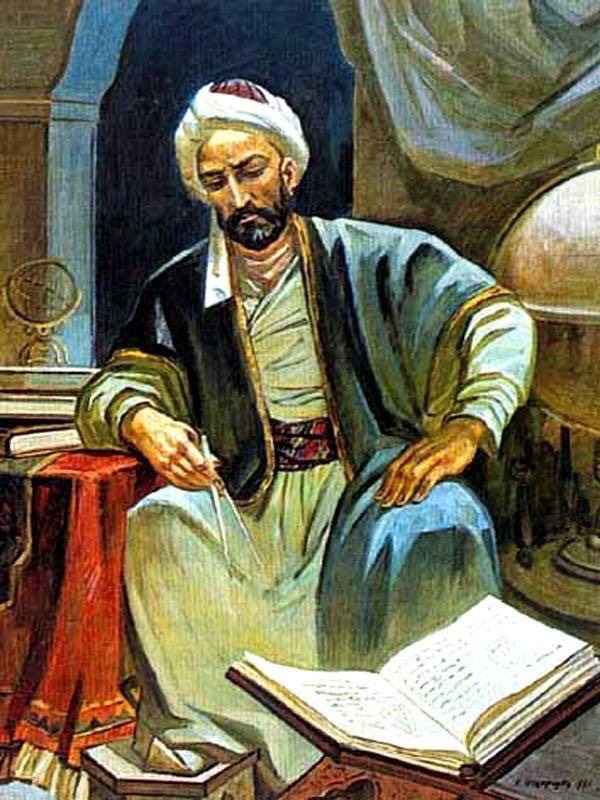مهدي سعيدان | أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة تونس
القول بأن المعرفة تحصل بالطبع قول قال به جملة من المتكلمين المتقدمين وقد أطلق عليهم مؤرخو الفرق الإسلامية اسم أصحاب المعارف. وكان من أشهرهم الجاحظ (ت 255 هـ) لكنه لم يكن الوحيد. والمعلومات التي وصلتنا بشأن أصحاب المعارف قليلة وأغلبهم فيما يبدو كانوا من المعتزلة الأول. واقترن قولهم في المعرفة بأصلين أساسيين: أنها ضرورية وأنها ليست موضع تكليف. واقترن قول بعضهم في المعارف بقولهم بالطبع. وهم بذلك يقدمون مقالة في المعرفة تتعارض مع القول بأنها مكتسبة وأنها تنتج عن فعل الإنسان واختياره ونفى بعضهم أنها واقعة نتيجة للنظر والاستدلال.
أصحاب المعارف
ذكر أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 هـ) في كتابه أصول الدين أن المعتزلي صالح بن صالح المعروف بصالح قبة (ت 246هـ/860م) كان ممن يقول بأن المعارف كلها ضرورية وقال "زعم صالح أن المعارف كلها ضرورية يبتديها الله عز وجل في القلوب اختراعا من غير سبب يتقدمها من نظر واستدلال"(1) وذكر أيضا أن بعضا من الروافض قالوا بأن "المعارف كلها ضرورية إلا أن الله لا يفعلها في العبد إلا بعد النظر والاستدلال."(2) في نفس هذا السياق قال البغدادي "زعم الجاحظ وثمامة أن المعارف ضرورية".(3) وقد ورد التطرق إلى مقالة هؤلاء الذين يقولون بأن المعارف ضرورية في سياق التطرق إلى مسألة التكليف بالمعارف.
ثمامة بن الأشرس والقول بالتوليد
ورد ذكر أصحاب المعارف على وجه الخصوص عند الخوض في مسألة التكليف بالنظر. ولهذا المعنى ذهب أبو المظفر الاسفرائيني(ت 471 هـ) في ذكر مقالة من يقول بأن المعرفة ضرورية. فلهذا القول عنده علاقة بمسألة التكليف من جهة، وهو يقف كبديل من جهة أخرى عن القول بأن المعرفة تحصل للإنسان بالتعليم أو نتيجة لما يخلقه الله له. إذ يقول أن ثمامة بن الأشرس النميري (ت 213 هـ) بنى على القول بأن المعارف ضرورية قوله "أن من لم يعرف الله سبحانه وتعالى ضرورة ليس عليه أمر ولا نهي، وأن الله خلقه للسخرة والاعتبار، لا للتكليف في جنة ولا نار، وأن الله يجعلهم في الآخرة ترابا". ويقول إن مما ذهب إليه الجاحظ أن "المعارف كلها طباع، وأن كل من عرف شيئا فإنما يعرفه بطبعه لا بأن يتعلمه ولا أن يخلق الله له علما به".(4) وقد بنى ثمامة قوله في المعرفة على قوله في المتولدات. فرأيه هذا في النظر يتبع قوله في التولد. إن المتكلمين عموما يسندون صفة الفاعل لمن توفرت فيه شروط الحياة والإرادة والقدرة. ويبدو أن ثمامة قد تمسك بهذا الأصل لكنه أراد أن يسند للجمادات تأثيرا وفعلا فاعتبر المتولد عنها أفعال لا فاعل لها. ومقالة الجاحظ الذي جعل المعرفة تحصل طباعا تمثل فيما يبدو مواصلة لهذا التوجه لكن عوض اللا تعين الذي بقيت عليه نسبة المتولدات عند ثمامة رد الجاحظ ما يصدر عن غير الفاعل، أي عن غير المتصف بالحياة والإرادة والعلم، إلى الطبع.
المعرفة والقول بالطبع
ذكر القاضي عبد الجبار اختلاف المعتزلة في المتولدات وجعله يتفرع إلى ثلاث شعب. فجعل مقالة ثمامة بن الأشرس إحدى هذه الشعب وذكرها مثلما ذكرها البغدادي والشهرستاني فقال "فأما ثمامة فقد جعل هذه الحوادث (أي المتولدات) ما عدى الإرادة حدثا لا محدث له." فالقول بأن المعارف ضرورية كان تابعا في هذه المباحث الكلامية لمسألة التكليف من جهة ولمسألة أصل المعرفة وفاعلها من جهة أخرى.
فيبدو أن ما كان يميز الجاحظ عن غيره من المتكلمين الذين كانوا يقولون بفعل الطبائع كإبراهيم النظام ومعمر بن عباد أنه جعل الطبع مبدأ لتفسير ما يصدر عن الإنسان من أفعال مثلما هو مبدأ يفسر ما يتولد عن الجمادات. فالمقصود بالطبع عنده هو الطبع الإنساني أو طبع الكائن الحي عموما وليس فقط طبائع الجمادات. وقد ذكر القاضي عبد الجبار (ت 415) في المحيط بالتكليف أن الجاحظ يثبت الطبع "للحي تارة وللمحل أخرى."(5) وقال في المغني أن أبا عثمان الجاحظ "يذهب في التولد مذهب أصحاب الطبائع" لكنه يخالفهم فيما يقع من القادر. "لأنه يقول إنما يقع بالطبع عند الحوادث والدواعي... وليس كذلك طريقة أصحاب الطبائع".(6)ويقول الشهرستاني أن من قول الجاحظ أنه ليس للعبد كسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعا... وزاد على ذلك بإثبات الطبائع للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة."(7)
الجاحظ وقوله في المعارف في كتاب المسائل والجوابات في المعرفة
وقد دفع هذا الموقف المتميز من المعرفة الجاحظ إلى إكثار التأليف في هذا الموضوع. ويعترف الجاحظ أنه قد اهتم اهتماما خاصا بهذه المسألة ويذكر أن هنالك من أنكر عليه هذا الاهتمام الذي زاد فيما يبدو عما هو موجود عند غيره من المتكلمين.(8) ويذكر ابن النديم الوراق في كتابه الفهرست أن من مؤلفات الجاحظ "كتاب المعرفة، كتاب جوابات كتاب المعرفة، كتاب مسائل كتاب المعرفة، كتاب الرد على أصحاب الإلهام."(9) لكن لسوء الحظ لم يصلنا من هذه المؤلفات سوى فصول من كتاب جوابات كتاب المعرفة.(10) لم يتوسع الجاحظ في هذه الفصول في ذكر اختلاف أصحاب المذاهب في مسألة المعرفة ولم يذكر مقالة أبي الهذيل فيها. ولعله فعل ذلك في فصول أخرى من كتابه. أما في الفصول التي وصلتنا فإن هدفه الأساسي فيها هو بيان فساد أصول خصومه في هذه المسائل. وقد شرع الجاحظ أولا في ذكر مقالات خصومه من المعتزلة وبدأ بمقالة بشر بن المعتمر (ت 210هـ/825م) وأصحابه، ثم ذكر مقالة شيخه إبراهيم النظام (ت 232 هـ/847 م) وأنهى بمقالة معمر بن عباد السلمي(ت 215هـ/830م). ويبدو أن الخلاف قائم بينه وبين بشر وبينه بين النظام على وجه الخصوص، إذ خصهما بالذكر عند الشروع في الكلام على من خالفه الرأي في مسألة المعرفة دون معمر.(11)
- خلافه مع بشر بن المعتمر
وإن كانت الإدراكات عند بشر تقع على ما طبع عليه البشر، فهي عنده على ضربين: إما إدراكات تحدث بموجب قصد الإنسان وإرادته واختياره فهي "تحصل متولدة عن فعله" وتعود في النهاية إلى قدرته، وتحدث بما يتقدمها من سبب منه وبما يوجبها من علة من أفعاله،(12) والإنسان في هذه الحال هو فاعل إدراكاته بفعله أسبابَها وعللها، وإما إدراكات تتم عن غير قصد المدرِك ودون اختياره وإرادته، وهي عندئذ من فعل الله، والله هو الذي أحدثها في الإنسان. وما يبدو مما يروى عن مقالة بشر في المعرفة أن الإدراكات عنده تقع متولدة لكنها تؤول في نهاية الأمر إلى قدرة فاعل، كان هذه الفاعل الإنسان أو الله. ولا يمثل الطبع عنده سوى واسطة تتحقق بمقتضاها ووفقها أفعال الفاعل القادر. فقول بشر بالتولد لم يجعله يقول بأن للجمادات فعل ولا أن للطبائع فعل، وإنما الطبع عنده هو من قبيل الأسباب والعلل وهي أسباب وعلل لا تحدث إلى بفعل فاعل قادر هو الله أو الإنسان. هذا ما يبدو على الأقل مما يروى عن مقالته في الإدراكات الحسية.
لكن المعرفة عند بشر لا تقف في حدود الإدراكات الحسية. وإن كان "درك الحواس أصل المعارف... وبقدر صحته تصح المعارف،"(13) فإن "معرفة الله ورسوله، والعلم بشرائعه، وكل ما فيه اختلاف منازعة، لا يعرف حقائقه إلا بالتفكر والمناظرة، دون درك الحواس الخمس."(14) فغير ما يدرك بالحواس من علوم ومعارف وصنائع كالحساب والهندسة والصياغة والفلاحة إنما تستخرجه الأذهان من الإدراك الحسي، وتظهره العقول بالبحث، وتدركه النفوس بالفكر.(15)
وما يؤكد عليه الجاحظ في روايته لمقالة بشر بن المعتمر في المعرفة هو أن المعارف عنده، إن كانت عن قصد، فهي في مجملها من فعل الإنسان وكسبه، كانت هذه المعارف إدراكات حسية أو معارف مستخرجة من هذه الإدراكات (أي معارف نظرية). فهي في كل الحالات معارف يفعلها الإنسان بإيجاب الأسباب وتقدم العلل إما بالقصد للإدراك الحسي أو بالنظر والتفكر للعلوم الأخرى. وإذا كانت العلوم جميعها من فعل الإنسان فهي تحصل باختياره وليست تقع باضطرار. وسبب تأكيد الجاحظ على هذه النقاط من مقالة بشر في المعرفة واضح. إذ هذه هي مواضع خلافه معه. ففي مقابل قول بشر بأن المعارف تحصل بموجب فعل الإنسان يقول الجاحظ أنها تقع بموجب الطبع. وفي مقابل تأسيس بشر المعارف على الاختيار يؤسسها الجاحظ على الضرورة. لكن قد يوجد في مقالة بشر ما يجعله يقترب من مقالة الجاحظ وهو ما يرويه عنه الجاحظ من قول في الإدراك الحسي غير المقصود وأنه فعل الله "على ما طبع عليه البشر وركب عليه الخلق". فإن كان بشر يقول بالطبع في هذا النوع من الإدراك فقد يكون هذا قول مشترك بينه وبين الجاحظ. وقد يكون الجاحظ قد أخذ ما قاله بشر في المدركات غير المقصودة وعممه على كل المعارف. لكن أغلب الظن أن الخلاف مع بشر يكمن أساسا في أن بشر يقول بالتولد ويرد كل ما يحدث إلى فعل الإنسان وفعل الله، في حين كان الجاحظ يقول بالطبع ويرد كل ما يحدث عدى الإرادة إلى الطبع.
- خلافه مع إبراهيم النظام
إن كان الجاحظ يشترك مع شيخه النظام في القول بالطبائع فأنه يخالفه في مذهبه في المعرفة. ويروي الجاحظ عن النظام أنه كان يقول أن المعارف "ثمانية أجناس" سبعة منها اضطرار وواحد منها اختيار. وموضع النزاع في هذا الجنس الأخير. إذ الجاحظ يقول أن هذا الجنس من المعرفة لا يكون اختيارا إلا عند تساوي الدواعي أما إذا قويت فإنها تصبح من قبيل ما هو ضروري. والعلم الذي هو موضع هذا النزاع هو "كل ما كان فيه الاختلاف والمنازعة" وكان سبيله "النظر والفكرة".(16) إن المعرفة النظرية إذن هي التي قال فيها أبو إسحاق النظام بأنها بالاختيار وقال الجاحظ أنها باضطرار. ويدخل ضمن هذا الصنف من المعرفة "العلم بالله ورسله، وتأويل كتابه، والمستنبط من علم الفتيا وأحكامه، وكل ما كان فيه الاختلاف والمنازعة."(17) ويبدو أن قول الجاحظ في المعرفة لا ينفي كونها تحصل بالنظر وإنما يقول أن ما يوجد عند النظر ليس من فعل الناظر بل هو واقع بالطبع.(18) وقد خصص عبد الجبار فصلا للكلام على أبي عثمان الجاحظ في المغني قال فيه :" اعلم أنه رحمه الله كان يقول في المعارف أنها تقع ضرورة بالطبع عند النظر في الأدلة، ويقول في النظر أنه ربما وقع طبعا واضطرارا وربما وقع اختيارا. فمتى قويت الدواعي في النظر وقع اضطرارا بالطبع، وإذا تساوت، وقع اختيارا."(19) فإذا كان النظام قد ميز بين المعارف التي سبيلها النظر وبين المعارف التي هي إدراك الحواس، بأن جعل الأولى اختيارا و جعل الثانية اضطرارا، وهي على ما يبدو واقعةٍ عنده بالطبع،(20) فإن الجاحظ قد سوى بين المعارف النظرية وبين المعارف التي هي إدراك المدركات، واعتبر أن الجميع يقع بالطبع.(21)
القول بالمعارف في كتاب الحيوان
استعان الجاحظ في تأليف كتاب الحيوان بمصادر متنوعة (أشعار العرب، قرآن، حديث، آراء لمتكلمين، ما ورد في كتاب الحيوان لأرسطو، آراء لجالينوس(22)) وكان غرضه أن يبين ما للحيوان من صفات اعتمادا على ما ورد في أشعار العرب والأعراب وأخبارهم وأمثالهم وفي آيات القرآن والسنة النبوية.(23)
- قيام المعرفة عند الجاحظ على القول بالطبع والقول بالتوحيد
لقد قال الجاحظ بالطبائع. وقد رأينا أنه اتبع في ذلك مذهب شيخه النظام.(24) لكنه خالف شيخه فيما يتعلق بأصل التوحيد إذ رده إلى الخبر ولم يرده إلى النظر. ونجد في كتاب الحيوان سعيا إلى إثبات التكامل بين القولين أي القول بالطبائع والقول بالتوحيد. والقولان في الحقيقة يمثلان امتدادا لما وضعه الجاحظ من أصول في المعرفة. فهو قد جعل، من جهة، القول بالطبائع امتدادا لقوله بأن التجارب هي الأصل في معرفة العالم ومعرفة مجرى الطبيعة، وهو قد بنى، من جهة أخرى، قوله في التوحيد على الخبر. فما تقوله الشرائع يحيل على التوحيد ويقبل به الجاحظ من جهة ما هو متدين، وما تخبر به التجارب يحيل على الطبائع ويقبل به الجاحظ من جهة ما هو متكلم وفيلسوف.(25) وهو يعترف مع ذلك بما في هذا الجمع بين القول بالطبائع والقول بالتوحيد من صعوبة ويقول "ولعمري إن في الجمع بينهما لبعض الشدة."(26)
ويؤكد الجاحظ على أن القول بالطبائع لا يتناقض مع التوحيد ويعتبر أن على عالم الكلام أن يجمع بينهما ويقول "وليس يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنا في الصناعة، يصلح للرياسة، حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة. والعالم عندنا هو الذي يجمعهما ، والمصيب هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال."(27) إن الجمع بين القول بفعل الطبائع والقول بالتوحيد يوازيه عند الجاحظ الجمع بين الاعتماد على التجربة والاعتماد على الخبر. وهو لا يغلب أحدهما على الآخر وإنما يجعل أحدهما إما دليلا على الآخر أو داع لتعديله أو رده. ويحدث أن يحترز الجاحظ من الرواية ويضع شروطا لقبولها وكيفية تأويلها حتى لا تتناقض ولا تناقض العيان والتجربة.(28) وقد يحدث أن يرد حديثا ويتهكم من رواته إذا رأى فيه أمرا مخالفا لمقتضى الطبائع وينعتهم "بأصحاب الجهالات".(29)
المعرفة لدى الحيوان
وأكثر ما يركز عليه الجاحظ في بيان أن الحيوان يدل على خالق حكيم مدبر، هو سعيه إلى إثبات أن للحيوان معرفة يكتسبها بطبعه الذي ركبه الله عليه دون تعليم ولا تلقين.(30)
وتمثل هذه الفكرة إحدى الأطروحات الأساسية التي دافع عنها الجاحظ في كتاب الحيوان ضد من ينكرها من المتكلمين والفلاسفة ورجال الدين(مفسرين وفقهاء). وقد يكون الجاحظ قد استقى فكرته هذه من أرسطو إذ يمكن أن نجد عند أرسطو ما يدل على أنه كان يقول بأن للحيوان معرفة.
- قول أرسطو في المعرفة لدى الحيوان
هناك على الأقل فكرتان أساسيتان تتخللان كتاب الحيوان للجاحظ وتوجدان عند أرسطو. تتعلق الفكرة الأولى بمسألة الغائية وتقوم على اعتبار أن الحيوان محكوم ببنيته وسلوكه بنظام الأصلح والخير وقد اتخذت هذه الفكرة عند الجاحظ منحا يراد به إثبات العناية الإلهية.
و تتعلق الفكرة الثانية بسلوك الحيوان وما يدل فيه على أن له ذكاء وفطنة ومعرفة تجعله شبيها من هذه الناحية بالإنسان، وهو قول قال به أرسطو أيضا. ويبدو أن هنالك تشابه بين أرسطو والجاحظ فيما يتعلق بهذه الفكرة. وقد تساعدنا المقارنة بين أقاويل أرسطو وأقاويل الجاحظ في هذه المسألة على فهم مذهب الجاحظ في المعرفة. ومعلوم أن أرسطو قد أكد من جهة على تميز الإنسان عن الحيوان فيما يتعلق بالمعرفة والقدرة على الكلام والقدرة على التعلم، وأشار من جهة أخرى إلى وجود نقاط اشتراك وتشابه بين الإنسان والحيوان فيما يتعلق بهذه الخصائص بالذات. فقد قال أرسطو في كتاب السياسة إن من الحيوان أكثرها يحيا وفق الطبيعة τῇφύσειζῇ، والقليل منها يعيش وفق ما تعودت عليه τοῖςἔθεσιν، أما الإنسان فيحيا وفق العقل λόγῳ، فوحده الإنسان يملك العقل μόνοςγὰρἔχειλόγον ومن خاصية الإنسان أنه يعرف ἴδιον الخير والشر والعدل والظلم وله ما إلى ذلك من الإدراكات αἴσθησιν.(31)
وقد أكد أيضا على تميز الإنسان واختلافه عن الحيوان في كتاب الأخلاق(32) حيث انتهى في بحثه عما ينفرد به الإنسان إلى القول بأن ذلك يكمن في الفعل القائم على امتلاك العقل. وفي مقارنته بين الملكات التي للإنسان وتلك التي للحيوان يسند أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة للحيوان قوة التخيل والذاكرة والقدرة على اكتساب بعض التجارب ويخص الإنسان بالصناعة والعقل. فللحيوانات بطبعها الملكة الحاسة αἴσθησιν وتحصل لبعضها من هذه الملكة [القدرة على] التذكر μνήμη وهذا ما يجعلها أذكى φρονιμώτερα من غيرها وأكثر قدرة على التعلم μαθητικώτερα، وهذه الحيوانات الذكية φρόνιμα تكون قادرة على التعلم بقدر ما تجمع بين القدرة على سمع الأصوات δύναταιτῶνψόφωνἀκούειν والقدرة على التذكر. فالحيوانات التي لا تتوفر في حياتها سوى على التخيلات φαντασίαις وعلى الذكريات μνήμαις لا يحصل لها من التجربة ἐμπειρίας سوى نفع قليل . أما النوع الإنساني فيستفيد في حياته من الصناعة τέχνῃ ومن العقل λογισμοῖς... فالعلم ἐπιστήμη والصناعة يحصلان لدى الإنسان من التجربة.(33) ويتبين من كلام أرسطو على العموم أنه رغم وجود تشابه بين الإنسان والحيوان من جهة المعرفة والذكاء فإنه يجب مع ذلك الفصل بينهما والتمييز بين الإنسان والحيوان على أساس ملكة أو ملكات معرفية لا توجد لدى الحيوان.(34) ورغم أنه من غير المرجح أن يكون للجاحظ اطلاع مباشر على النصوص أرسطو التي ذكرناها هنا إلا أن بعض الإشارات تدل على أنه قد تبنى موقفا مشابها بموقف أرسطو.
المعرفة لدى الحيوان عند الجاحظ
كثيرا ما ينسب الجاحظ للحيوان العلم والمعرفة.(35) والمعرفة التي لدى الحيوان إنما هي له من قبل طبائعه "فمعارفها مطبوعة عليها".(36) وإن كان الجاحظ يرد هذه المعارف إلى إلهام إلهي(37) فذلك لأن الله عنده قد ركب الحيوان وأعطاه طبيعة يهتدي بها إلى مصالح معاشه.(38) وبهذا المعنى يكون الله قد "أودع الحيوان" ضروبا شتى من المعارف و"سخر لها الصنعة".(39) وألهمها جملة من المعارف.(40) و"فطرها غريب المعرفة".(41) ولا يقتصر مصدر المعرفة عند الحيوان على الإلهام والطبع بل إن الجاحظ ينسب لها أيضا القدرة على التعلم فالحيوان "يلقن ويحكي ويكيس ويُعلَّم فيزداد بالتعليم".(42) وينسب الجاحظ للحيوان "الإحساس الصادقة، والتدابير الحسنة والروية والنظر في العاقبة والاختيار لكل ما فيه صلاح المعيشة."(43) وقد يحدث أيضا أن ينسب الجاحظ إلى الحيوان العقل مثل أن يقول أن للنعامة القدرة على أن تعقل الإشارة وأنها "تجاوبها بما تعقل عنها."(44) أو مثل أن يقول عن الحمام أن له "جودة الاستدلال" ثم يقول عنه "والدليل على أنه يستدل بالعقل والمعرفة، والفكرة والعناية، إنه إنما يجيء من الغاية على تدريج وتدريب وتنزيل."(45) ويشبه قوله هذا ما ورد عند أرسطو من نسبة ضرب من العقل العملي للحيوان يمكنه من الاستدلال اعتمادا على قياس عملي.(46)
تميز الإنسان عن الحيوان
وإن كان الجاحظ يجعل من المعرفة والعلم والتعلم والتدبير والصناعة أمورا مشتركة بين الإنسان والحيوان، وربما ضم إلى ذلك أيضا بمعنى ما العقل، فإن ما يؤكد عليه هو أن الخاصية المميزة للإنسان هي الاستطاعة فيقول "والفرق الذي هو الفرق إنما هو الاستطاعة والتمكين".(47) فأن يكون الإنسان قادرا على الطاعة هو الذي يجعله متميزا عن الحيوان. وهذه الاستطاعة هي التي تؤسس نوعا من العقل ونوعا من المعرفة يختلف بهما الإنسان عن الحيوان: "وفي وجود الاستطاعة وجود العقل والمعرفة."(48) ويؤكد الجاحظ على أن التميز ينبع من الاستطاعة وينسحب على المعرفة والعقل وليس العكس: "وفي وجود الاستطاعة وجود العقل والمعرفة. وليس يوجب وجودهما وجود الاستطاعة".(49) فالإنسان عنده هو أولا كائن مستطيع، يصح منه الفعل استجابة للتكليف، وهذه القدرة هي التي تجعل له عقلا غير عقل الحيوان ومعرفة غير معرفته. وأصل التمييز بين العاقل وغير العاقل إنما هو عند الجاحظ العمل . "فبأعمال المجانين والعقلاء عرفنا مقدارهما من صحة أذهانهما وفسادها، وباختلاف أعمال الأطفال والكهول عرفنا مقدارهما في الضعف والقوة، وفي الجهل والمعرفة. وبمثل ذلك فصلنا بين الجماد والحيوان، والعالم وأعلم منه، والجاهل وأجهل منه."(50) فالأفعال إذن هي أساس التمييز بين من له المعرفة والعقل ومن لا يملكهما، والملكات المعرفية تمثل عنده قاسما مشتركا بين الإنسان والحيوان ويأتي الاختلاف والتميز في مستوى العمل الذي يعود على الملكة فيغير طبيعة ما ينتج عنها "فلو كان عند السباع والبهائم ما عند الحكماء والأدباء، والوزراء والخلفاء والأمم والأنبياء، لأثمرت تلك العقول باضطرار إثمار تلك العقول"(51) إن ما يظهر من عمل الحيوان يدل حسب الجاحظ على أن لها معرفة ولها عقولا وبالتالي فإن تميز الإنسان عن الحيوان لا يمكن أن يكون من جهة المعرفة والعقل وإنما من جهة الفعل والعمل: "وإنما يتفاضل بالبيان والحفظ، وبنسق المحفوظ، أما المعرفة فنحن فيها سواء. ولم نعرف العقل وعدمه ونقصانه، وإفادته، وأقدار معارف الحيوان إلا بما يظهر منها."(52)
ويشبه أن يكون التمييز بين الإنسان والحيوان في هذا السياق متعلقا أساسا بمسألة التكليف لأن الاستطاعة ضرب من القدرة على الفعل وهي الفعل المستجيب للتكليف، لذلك يكون الإنسان معنيا بالتكليف من دون الحيوان: "ولو كان للكلب آلة يعرف بها عواقب الأمور وحوادث الدهور... ويتثبت في العلة ويخاف زيغ الهوى وسرف الطبيعة لكان من كبار المكلفين ومن رؤوس الممتحنين."(53) فالإنسان هو المكلف دون غيره وهو المأمور بالطاعة المثاب عليها والمعاقب على العصيان أما الحيوان فقد خلق للسخرة لينتفع به الإنسان في معاشه لكن أيضا، وهذا ما ينبه عليه الجاحظ طوال كتابه، ليعتبر به ويعرف منزلته في الخلق ويستدل به على حكمة الخالق.
وفي إطار هذا التمييز يحدث أن ينفي الجاحظ عن الحيوان القدرة على "معرفة عواقب الأمور" ومعرفة "مصادرها ومواردها" وينفي عنه القدرة على الاختيار بناء على هذه المعرفة.(54) ويبدو أن تعليق المعرفة بالطبع ونسبتها إلى الحيوان والإنسان على حد السواء قد اضطر الجاحظ إلى أن لا يجعل التمييز بين الإنسان والحيوان قائما على العلم والعقل. وهو وإن جعل العقل ميزة الإنسان لا يجعله مفردا وإنما يقرنه بالفعل والاستطاعة والنطق.(55) لكن العقل عند الجاحظ لا يتحدد باعتباره الملكة التي من شأنها أن تدرك العام والكلي كما هو الأمر عند أرسطو وإنما العقل هو جملة من العلوم الإدراكات التي تجعل الإنسان يعرف مجرى الطبيعة وما هو ضروري للبقاء عند الكائن الحي. فهو أقرب إلى المعرفة التجريبية العملية منه إلى المعرفة الكلية النظرية. وهي معرفة تجريبية عملية تمكن من الانتقال من مقدمات إلى نتائج وتجعل بالإمكان قياس ما نشاهده على ما لا نشاهده. وبهذا المعنى يتحدد العقل في سياق كلام الجاحظ في كتابه المسائل والجوابات في المعرفة عن بلوغ الإنسان القدرة على الاستدلال على صحة نبوة النبي وتمييزه بين المعجزة ومجرد الحيلة بناء على معرفة الممكن والممتنع. ففي سياق الجواب عن سؤال "كيف جرب ذلك وعقله؟ يتحدث الجاحظ عن البلوغ المقترن بالعقل باعتباره "استحكام" الأمور التجريبية غير المقصودة في قلب الإنسان وثبوتها في خلده.(56) مما يدل على أنه يعطي العقل معنى جملة من العلوم والمعارف التجريبية التي تمكن من القياس العملي والاستدلال النظري.(57) والأكيد أن أنطولوجيا علم الكلام المتقدم التي كان الجاحظ منخرطا فيها بحكم انتمائه المذهبي كانت تمنع تبنيه لمعنى العقل كما هو عند أرسطو والذي يقترن بمنزلة الكلي من جهة وبطبيعة النفس من جهة أخرى.(58) ورغم هذا الاختلاف في تصور العقل فإن الجاحظ قد يكون ينح منحى أرسطو في نسبة ضرب من العقل العملي للحيوان وما سماه الجاحظ معرفة لدى الحيوان وعلما يكني به عما جعله أرسطو مشتركا بين الإنسان والحيوان من ضرب من الحكمة العملية التي تخول لكليهما كسب المعاش والتصرف فيما يصلح به أمر الكائن الحي ويحفظ بقاءه.(59)
ومما لا شك فيه أن الجاحظ قد جعل تميز الإنسان مقترنا بالاستطاعة. وقد حدد الجاحظ الاستطاعة بجملة من الخصال،(60) وهو ينكر على المتكلمين تحديدهم الاستطاعة بمجرد الصحة، إذ الصحة والسلامة البدنية لا تكفي وحدها لتجعل الإنسان مستطيعا.(61) ولا شك أن للأهمية التي يوليها الجاحظ للاستطاعة علاقة بتوجهه الاعتزالي إذ معلوم أن المعتزلة قد أكدوا على أن الإنسان قادر على الفعل وأنه من هذه الجهة مكلف محاسب مثاب ومعاقب. وقد يوجد في نصوص أرسطو ما يمكن أن يحيل إلى معنى الاختيار والإرادة باعتباره الصفة المميزة للإنسان. كما أن فكرة أن الفعل والعمل هما اللذان يحددان تميز الإنسان بصفة العقل يوجد ما يشبهها عند الطبيعيين القدامى. فقد ذكر أرسطو أن أنكساغوراس قد قال بمثل هذا القول عندما جعل الإنسان يتميز بيديه وبما يقدر على فعله بهما.(62) وقول الجاحظ في العقل، باعتباره لا يمكن أن يتأسس على القول بوجود النفس على شاكلة ما يقول به أرسطو، ينح المنحى الطبيعي الذي يؤول في نهاية الأمر إلى رد تميز الإنسان إلى الفعل والسلوك العملي لا إلى العقل كجوهر مفارق لما هو طبيعي.(63)
وعندما يقارن الجاحظ بين عمل الإنسان وعمل الحيوان يصف الإنسان بأنه ذو العقل والتمكين والاستطاعة ويجعله مختلفا في فعله وعمله عن الحيوانات "ذوات الطبائع المسخرة والغريزة المجبولة". ويتمثل الاختلاف في أمرين أساسيين. إن الإنسان قادر على الموازنة بين الأمور ومعرفة ما فيها من خير ومنفعة أو شر ومضرة فيختار الخير والمنفعة. يقول "والعادة القائمة، والنسق الذي لا يتخطى ولا يغادر، والنظام الذي لا ينقطع ولا يختلط، في ذوي الاستطاعة والتمكين، وفي ذوي العقول والمعرفة، أن أبدانهم متى أحست بأصناف المكروه والمحبوب، وازنوا وقابلوا، وعايروا وميزوا بين أتم الخيرين وأنقص الشرين، ووصلوا كل مضرة ومنفعة في العاجل بكل مضرة ومنفعة في الآجل، وتتبعوا مواقعها، وتتدبروا مساقطها، كما يتعرفون مقاديرها وأوزانها، واختاروا بعد ذلك أتم الخيرين وأنقص الشرين." وهذه القدرة القائمة على التدبر والموازنة والمقارنة لا توجد عند الحيوان الذي يعمل "من جهة التسخير والتنبيه" وهي إذ تبلغ ما تبلغه بأفعالها إنما تبلغه "بغير معاناة ولا روية ولا توقف، ولا خوف من عاقبة". فأفعالها باعتبارها نابعة من طبيعتها ليست أفعالا اختيارية ولا تقوم على الروية والموازنة وإنما هي ضرورية مثلها مثل فعل "السم الذي يقتل" و"الغذاء الذي يغذو" (64)
وبالجملة فإن الأفعال تدل على وجود المعارف والعقل وهذان مشتركان لدى الإنسان والحيوان على السواء إذ كلاهما يفعل وكلاهما له معرفة، لكن الاختلاف يكمن في أصول هذه الأفعال. فأصلها الروية والموازنة والفكرة والاختيار عند الإنسان، وأصلها الطبع عند الحيوان. واختلاف أصول الفعل يجعل شكل الفعل مختلفا أيضا. فإذا كان الحيوان يفعل على وجه الضرورة بمقتضى ما أكسبه الله من طبيعة وهيأه له وسخره لبلوغه فهو ليس قادرا على وجه الحقيقة إذ القدرة والاستطاعة مقترنة بالاختيار، أما الفعل الذي هو بالطبع فهو يدخل في حد الغلبة والضرورة ولا يقال فاعله مستطيعا إلا بالمجاز.(65)
وتنبع من هذه الخاصية، التي تحدد الاختلاف بين الإنسان والحيوان، الخاصية الثانية والمتمثلة في أن الإنسان قادر على أنواع كثيرة من الأعمال في حين لا يتقن الحيوان إلى فعلا واحدا.(66) فالحيوان قاصر على القيام بالأفعال المغايرة للأعمال التي جبل عليها لأنه لا يقدر على الاستدلال واختيار الفعل والترك على السواء. فالقدرة على الفعل القائم على الاختيار "لا يصاب إلا عند من جهته العقل، ويمكنه الاستدلال، والكف عنه والقطع له إذا شاء، وإتمامه إذا شاء، وبلوغ غايته، والانصراف عنه إلى عقيبه من الأفعال، ومن جهته تعرف العلل، ويمكنه إكراه نفسه على المقاييس والتكلف والتأتي."(67) رغم وجود شبه بين الإنسان والحيوان فإنهما في الحقيقة مختلفان عند الجاحظ. لكن أكثر ما يؤكد عليه الجاحظ هو أن الملاحظة تدل على أن للحيوان معرفة وعلم وفطنة ودراية وأنه في ذلك يشبه الإنسان بل يفوقه في بعض الأحيان. ويوجد مثل هذا التأكيد على وجود شبه بين الإنسان والحيوان عند أرسطو.
ما يشترك فيه الإنسان والحيوان عند أرسطو
رغم ما رأيناه من تأكيد على أن الإنسان وحده هو الذي يجب أن يعد عاقلا ناطقا يؤكد أرسطو في مواضع أخرى من كتبه على أن للحيوان ملكات معرفية تشبه تلك التي لدى الإنسان. وقد رأينا أنه في مطلع كتاب ما بعد الطبيعة ينسب للحيوان نوعا من العقل أو الذكاء ويعتبر أن بعضها أذكى φρονιμώτερα من بعض، وينسب لها المعرفة أيضا، لأن ما يدل على وجود المعرفة وعلى غيابها عنده هو بالجملة توفر القدرة على التعليم والتعلم، وهو قد ذكر أن للحيوان مثل هذه القدرة. لكن هناك احتمال أن لا يكون للجاحظ علم بما ذكره أرسطو في هذا الموضع إذ معلوم أن الترجمة العربية لكتاب ما بعد الطبيعة لا تتوفر على النصوص الأولى من مقالة الألف الكبرى أين وردت المقارنة بين ملكات المعرفة لدى الإنسان وما يشبهها لدى الحيوان، لكن في مقابل ذلك لابد أن يكون الجاحظ قد اطلع على ما ورد في كتاب تاريخ الحيوان أين يعتبر أرسطو في مطلع المقالة الثامنة(68) أنه يوجد لدى الحيوان رسوم أو آثار ἴχνη(69)من سمات النفسτὴνψυχὴν τρόπων(70) هي أظهر لدى الإنسان. وقد كان منهج أرسطو في كتاب تاريخ الحيوان يعتمد على وصف ما للحيوان من أعضاء ووظائف بمقارنتها بما يوجد لدى الإنسان.(71) وبعد أن انتهى من الحديث عن الخصائص الجسمية شرع في المقالة الثامنة في الحديث عن سلوك الحيوان وطرق عيشه معتمدا نفس المنهج. ويقول أرسطو أنه مثلما أن هناك شبه في الأعضاء الجسمية بين الحيوان والإنسان، يوجد شبه أيضا في السمات النفسية. فما نلاحظه في الحيوان أن منه الأرعن ومنه الوديع ومنه الشجاع ومنه الجبان ومنه الكريم ذو المروءة ومنه اللئيم، إلخ، ويذهب أرسطو إلى حد القول بأنه فيما يتعلق بالفكر περὶτὴνδιάνοιαν يوجد لدى كثير من الحيوان ما يشبهه ὁμοιότητες من الحصافة والفهم συνέσεως . والصفات التي هي من هذا القبيل توجد لدى الإنسان كما توجد لدى الحيوان لكن قد تختلف عند هذا وذاك من الجهة الأكثر والأقل. لكن أرسطو يؤكد في مقابل ذلك أن هناك من الصفات ما لا يتجاوز فيها التشابه مجرد التناسب τῷἀνάλογον. فمثلما أننا نجد عند الإنسان الصنعة τέχνηوالحكمة σοφία والحصافة σύνεσις(72)نجد أيضا عند الحيوان من القوى الطبيعية ما يقوم مقام هذه الصفات.
ومثل هذه المقارنة بين الإنسان والحيوان نجدها عند الجاحظ الذي يعدد بدوره جملة الصفات التي يمكن أن تطلق على الحيوان مثلما تطلق على الإنسان ويقول مثلما يقول أرسطو أن هناك "مناسبة" وهناك "مشاركة"(73) للحيوان في صفات الإنسان وإن الحيوان يتقدم على الإنسان في بعض هذه الأمور ويتقدم الإنسان في البعض الآخر. لكن لم يرد عند الجاحظ أن هذه الصفات هي من طبيعة نفسية. ولا يذكر الجاحظ، خلافا لأرسطو، النفس في سياق الحديث عن الملكات المعرفية التي للحيوان ولا عند ذكر تلك التي للإنسان. والمتكلمون المتقدمون على العموم لا يقولون بوجود النفس على الطريقة التي قال بها الفلاسفة وقال بها أرسطو. وتصورهم المادي للعالم يمنع من تبني مثل هذا المعنى للنفس.(74)
وقد قارن أرسطو أيضا بين الإنسان والحيوان من جهة ما يوجد من تشابه بينهما عند ملاحظة ما للطفل الصغير من قدرات معرفية لا تختلف كثيرا عما للحيوان من قوى شبيهة بها. واعتبر أن نفس الإنسان في سن الطفولة لا تختلف عن نفس الحيوان. وأنه ليس من الباطل في شيء أن نقول أن علاقة ما للحيوان من القوى بتلك التي لدى الإنسان منها التماثل ταὐτὰ ومنها التقاربπαραπλήσια ومنها التناسب ἀνάλογον.(75) ورد عدم الاختلاف الذي يوجد بين الإنسان والحيوان إلى ضرب من الاتصال συνεχεία بين مختلف أجناس وأنواع الكائن الحي وبين الحيوان والنبات وبين الكائن الحي وغير الحي. إذ الطبيعة تمر من هذا إلى ذاك على التدريج وشيئا فشيئا حتى ليصعب تحديد الحد الذي يوجد فيه التمايز بين أنواع الكائنات وأجناسها.(76) وفي سياق ذلك يمكن أن ننزل قول أرسطو بالكون التلقائي ἡγένεσιςαὐτόματός لبعض الكائنات الحية التي اعتبر أرسطو أنها يمكن أن تتولد من التراب أو من الماء وليس بالضرورة من بذرة ومن ذكر وأنثى.(77) وقد قال الجاحظ بمثل هذا الكون للحيوان وسماه "تخلقا". وقال أن من شأن الضفادع أن تتخلق من طباع التربة.(78) لكن الجاحظ رغم ما يبدو من ميله إلى القول بوجود ضرب من التقارب بين أنواع الحيوان(79) وخلافا لأرسطو الذي أثبت ضربا من الاتصال بين أنواع الحيوان، يؤكد على أن القول بالتخلق لا يؤدي إلى القول بتولد الحيوان بعضه من بعض.(80) ورغم أن حجة الجاحظ في دفع من قاس إمكان تولد الأنواع بعضها من بعض على إمكان التخلق الحيوان من التراب أو من الماء غير واضحة إلا أن الظاهر من قوله أنه يعتبر أن أفراد الحيوان كل في نوعه جواهر ليس من قوتها التحول إلى غيرها أو توليد نوع آخر غير نوعها. وهو يعتبر أن هذا الإمكان، وإن قرب في الوهم، فإنه بعيد من جهة "الطبيعة والعادة".(81)
يبدو أذن أن المنطق الذي قاد أرسطو إلى إثبات وجود تشابه بين الإنسان والحيوان من جهة القدرات المعرفية والذي ارتكز على ضرب من التقارب في القوى المعرفية بين الإنسان والحيوان يذهب إلى حد التماثل عندما يكون الإنسان في سن الطفولة، ليس هو نفسه المنطق الذي قاد الجاحظ إلى إثبات المعرفة والعلم لدى الإنسان والحيوان على السواء.
هل النطق ميزة إنسانية؟
لم يؤدي القول بإمكان التخلق عند الجاحظ إلى القول بإمكان تولد الأنواع بعضها عن بعض. وإنما هو قد جعل الكائنات رتب وفصل فيما بينها واعتبر أن العلاقة بين الإنسان والحيوان هي مثل العلاقة بين الحيوان والنبات وهذه مثل العلاقة بين النبات والجماد.(82)
كما لم يؤدي القول باشتراك الحيوان والإنسان في المعرفة عنده إلى القول بتماثل على مستوى القوى النفسية. لكن يبدو أن الجاحظ مثلما جارى أرسطو في قوله بالتخلق يجاريه أيضا في القول بأن النطق سمة مميزة للإنسان.
وقد ميز أرسطو بين الصوت أو الصياح ψόφος والصوت المقطع أو اللغة φωνὴ والكلام διάλεκτος.(83) وقال أن من الحيوان ما يصدر صوتا مقطعا لكن لا واحدا له الكلام إذ أن هذه خاصة ἴδιον للإنسان.(84) ويقوم هذا الإقرار على التمييز الذي يجعله أرسطو بين الصوت والصوت المقطع والكلام أو النطق λογὀς. فالذي يميز مجرد الصوت عن الصوت المقطع هو أن هذا الأخير صوت يدل على شيء ما σημαντικὸςγὰρδήτιςψόφοςἐστὶνἡφωνή(85) والذي يميز الكلام والنطق عن مجرد الصوت المقطع هو أن النطق لا يعبر فقط عما هو مباشر من قبيل الألم واللذة والحاجة وإنما يعبر أيضا عما هو من قبيل الخير والشر والعدل والظلم فهو إذن دليل على وجود العقل λόγος. ومن هذه الجهة يمثل النطق خاصية إنسانية، إذ الإنسان وحده قادر على إدراك أمور من هذا القبيل.(86) بناء على تحديد مستويات مختلفة من القدرة على التصويت تتحدد إذن عند أرسطو منزلة ما يصدره الحيوان من أصوات: فللحيوان قدرة على تقطيع الأصوات وصوته بهذا المعنى يحمل دلالة σημαντικὸς ، هو عندئذ بين الصوت المحض الخالي من الدلالة وبين منطق الإنسان وكلامه الذي يحمل معاني تحيل على وجود العقل. ويبدو أن الجاحظ قد ذهب مذهب أرسطو في جعل الحيوان قادرا على تقطيع الأصوات دون أن يجعله مماثلا للإنسان في كلامه ومنطقه.
وقد قسم الجاحظ، مثله مثل أرسطو، الحيوان إلى فصيح وأعجم.(87) وميز بين الحيوان الذي لا صوت له وسماه "الحكل"،(88) وبين الحيوان الذي يصدر صوتا يدل على "حرجه، وضجره، وطلبه ما يغذوه" أو "هياجه إذا أراد السفاد، أو عند وعيد لقتال، وغير ذلك من أمره".(89) وقد ذكر في هذا السياق رأيا نسبه للهند يقول أن كثرة الأصوات وتنوعها يكون بحسب الحاجة. فالاختلاف بين الإنسان والحيوان فيما يتعلق بالأصوات هو من هذه الجهة "فسبب ما له كثر كلام الناس واختلفت صور ألفاظهم... كثرة حاجاتهم. ولكثر حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم، واتسعت على قدر اتساع معرفتهم."(90) ومن هنا يتحدد وفق هذا الرأي الاختلاف بين الإنسان والحيوان من جهة الكلام وإصدار الصوت والمعرفة.
وبيّن أنه يذهب في أصوات الحيوان مذهب أرسطو ويعتبر أن للحيوان قدرة على تقطيع الأصوات للتعبير عن حاجاته. وقد ذكر في هذا السياق رأيا لأرسطو وقال "زعم صاحب المنطق، أن كل طائر عريض اللسان، والإفصاح بحروف الكلام منه أوجد."(91) لكن القدرة على التصويت والصياح عند الحيوان لا تعني أنه يستوي والإنسان في القدرة على الكلام. فالجاحظ يؤكد على أن وجود التشابه بين الإنسان والحيوان لا يعني التماثل. وأن النطق والفصاحة ميزة إنسانية. فيقول "قد علمنا أن العجم من السباع والبهائم، كلما قربت من مشاكلة الناس كان أشرف لها. والإنسان هو الفصيح وهو الناطق."(92) ويعتبر أن إطلاق اسم الناطق على الحيوان إنما هو من قبيل الاشتقاق، ومن قبيل التمييز في الحيوان بين ما يصوت ويصيح وبين الصامت."ولهذا الفرق أعطوه هذه المشاركة، وهذا الاشتقاق. فإذا تهيأ من لسان بعضها من الحروف مقدار يفضل به على مقادير الأصناف الباقية، كان أولى بهذا الاسم عندهم."(93) فالمسألة إذن، في هذا السياق، لا تعدو أن تكون مسألة لغوية، وهي لا تعبر عن حقيقة نسبة النطق للحيوان. ويظهر إنكار الجاحظ لنسبة الكلام إلى الحيوان بشكل أوضح فيما نجده عنده من نقد لاذع لمن أثبت هذه النسبة خاصة منهم أحمد بن حائط.
أحمد بن حائط ومذهبه في نطق الحيوان وكلامه
كان أحمد بن حائط من أصحاب النظام وأخذ عنه كثيرا من آرائه واشتهر بقوله بالتناسخ وتوفي بين سنة227هـ وسنة 232 هـ.(94) وقد ذكر البغدادي أحمد بن حائط في الفرق بين الفرق وسماه ابن خابط(95) وقال أنه كان يقول بوجود الروح وأنها هي حقيقة الإنسان والحيوان وأن الأجسام قوالب للأرواح. وقد ذهب إلى القول بأن الله قد خلق في البدء الأرواح من دون الأجسام ثم لما عصاه في بعض ما أمره به "أخرجه إلى الدنيا، وألبسه بعض هذه الأجسام التي هي القوالب الكثيفة، وابتلاه بالبأساء والضراء، والشدة والرخاء، واللذات والآلام، في صور مختلفة من صور الناس والطيور والبهائم والسباع والحشرات وغيرها." وغني عن القول أن مثل هذه المقالة تضرب بجذورها في تيارات فكرية قديمة ومتنوعة وقد ذكر البغدادي أن القائلين بالتناسخ أصناف. منهم من ظهر قبل الإسلام وذكر من هؤلاء المانوية والسمنية والفلاسفة. ثم قال "وذكر أصحاب المقالات عن سقراط وأفلاطن وأتباعهما من الفلاسفة أنهم قالوا بتناسخ الأرواح."(96) ولا شك أن في ما ذهب إليه ابن حائط شبه بما ورد عند أفلاطون في بعض محاوراته.(97) وفي تفصيل قول ابن حائط بالتناسخ يقول البغدادي أنه كان يعتبر أن الله خلق الخلق "سالمين عقلاء بالغين، في دار سوى الدنيا التي هم فيها اليوم، وأكمل عقولهم، وخلق فيهم معرفته والعلم به."(98) وأن الروح بعد خروجه من الدار الأولى التي كان فيها أولا بسبب عصيانه، و "لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصور مختلفة ما دامت طاعته مشوبة بذنوبه ويكون منازل قوالبه في الإنسانية والبهيمية، ثم لا يزال من الله تعالى رسول إلى كل نوع من الحيوان، وتكليف للحيوان أبدا إلى أن يتمحض عمل الحيوان طاعات فيرد إلى دار النعيم الدائم وهي الدار التي خلق فيها، أو يتمحض عمله معاصي فينقل إلى النار الدائم عذابها."(99)
وقد ذكر الجاحظ ابن حائط في سياق الحديث عن كلام الحيوان كما ذكره عند الحديث عند ذكر بعض الآيات من القرآن التي يمكن أن تأول على أنها تفيد أن الحيوان مكلف وأنه أمم مثل أن الناس أمم وأن الله يبعث في أمم الحيوان أنبياء مثلما يفعل للناس.
وتفهم مقالة الجاحظ بشأن نطق الحيوان وكلامه بناء على ما يمكن أن نستنتجه من موقفه من مقالة ابن حائط ومن تمييزه بين أربع مقالات مختلفة بشأن نسبة النطق للحيوان. وأول هذه المقالات، وربما أدناها عنده من جهة الوجاهة ومن جهة الحاجة إلى الرد عليها، هي التي نسبها إلى "ناس من غير المتكلمين" الذين يتبعون "ظاهر الحديث وظاهر الأشعار". وقد اعتبر هؤلاء أن الحجارة كانت تعقل وتنطق، وإنما سلبت المنطق فقط، فأما الطير والسباع فعلى ما كانت عليه."(100) وقد ذهب هؤلاء إلى أن بعضا من أنواع الحيوان مطيع مثاب والبعض الآخر عاص معاقب.(101) وزعموا أن الأشياء كلها كانت ناطقة، وأنها أمم مجراها مجرى الناس".(102) وأكثر ما أكد عليه الجاحظ في الرد على هؤلاء هو إنكاره أن يكون الحيوان مكلفا وهو يبين تهافت تأويلهم الأحاديث بإبراز تناقضهم. وينسب أصحاب هذه المقالة إلى العوام ويعتبر أنهم ليسوا ممن "يفهم تأويل الأحاديث."(103) ونعتهم بأصحاب الجهالات. وتأكيد الجاحظ على اعتماد هؤلاء على الأحاديث يرجح أن المقصود بهم أصحاب الحديث أو أهل الخبر (في مقابل المتكلمين أو أهل النظر)، أي أولئك الذين أصطلح على تسميتهم عند المعتزلة "بالحشوية".
والمقالة الثانية التي يذكرها الجاحظ بشأن مسألة نسبة النطق والكلام للحيوان هي مقالة بعض المتكلمين ويخص بالذكر ابن حائط. ويقول "وذهب ابن حائط ومن لف لفهم من أصحاب الجهالات مذهبا."(104) وقد ذكر الجاحظ أنه تعلق في إثباته مذهبه بتأويل الأحاديث.(105) وقرن الجاحظ في موضع آخر مذهب ابن حائط بمذهب بعض الصوفية وقال عنه "زعم ابن حائط وناس من جهال الصوفية، أن في النحل أنبياء، قوله عز وجل "وأوحى ربك إلى النحل".(106) ولم يورد الجاحظ في هذا السياق ردا على ابن حائط يعتد به، واكتفى بأن جعله خارجا عن الإسلام، فلا وجه، يقول الجاحظ، لتمسكه بما ورد في القرآن!(107) والظاهر أنه لم يول اهتماما جديا بالرد على مقالة ابن حائط، على الأقل في كتاب الحيوان، واكتفى بأن بين إنكاره لمذهبه في نطق الحيوان وكلامه وإنكاره خاصة لما ذهب إليه من أن الحيوان مكلف، مثاب معاقب. ولا شك أن ما رأينا من تأكيد الجاحظ على أن الإنسان وحده هو الذي يجب أن تنسب له الاستطاعة وأنه بالتالي الوحيد الذي يجب أن يعتبر مكلفا، يوجب الاختلاف بين مقالة الجاحظ عن مقالة ابن حائط وعدم إمكان التوفيق بينهما. وما تجدر ملاحظته هو أن الجاحظ لم يجد داعيا للتطرق إلى مذهب ابن حائط في تناسخ الأرواح وأغلب الظن أنه رأى في مقالته هذه رأيا متهافتا لا حاجة لإبطاله. ولا حاجة للتذكير في هذا السياق بأن عمدة ابن حائط في القول بالتناسخ هو قوله بالنفس أو الروح وأنها أزلية وأنها مختلفة عن الأجساد وتتخذ من هذه الأجساد "قوالب" تمكنها من أن ترتقي من مرتبة إلى أخرى في مراتب الكمال. وهذا القول في النفس بعيد عما يقول به الجاحظ كمتكلم استقى تصوره عن الإنسان من فلسفة الطبيعيين على وجه الخصوص.
قول الجاحظ في نطق الحيوان
إن كان الجاحظ يفهم كلام الحيوان مع الإنسان مثلما ورد في الخبر وفي القرآن على أنه من قبيل المعجزة والاستثناء الخارق للعادة، في سياق رده على الدهرية في إنكارهم لما ورد في القرآن من خبر عن كلام الطير أو غيره من الحيوانات،(108) فإنه مع ذلك، وفي سياق حديثة عن طبائع الحيوان، يعتبر أن ما تصدره الحيوانات من أصوات إنما هي تصدره للتفاهم فيما بينها ويسمي هذه الأصوات بهذا المعنى نطقا أيضا. ويذهب في هذا المعنى الأخير للمنطق المنسوب للحيوان مذهبا نسبه إلى الهند وهو يجعل تطور اللغة مرتبطا بالحاجة. فيقول عن الطير: "ولها منطق تتفاهم بها حاجات بعضها إلى بعض. ولا حاجة بها إلى أن يكون لها في منطقها فضل لا تحتاج إلى استعماله. وكذلك معانيها في مقادير حاجاتها."(109)
فيبدو إذن أن النطق عند الجاحظ لا يكون للحيوان فقط من جهة الإلهام والتسخير أي فقط من جهة الاستثناء الخارق للعادة، وإنما أيضا من جهة الطبع.(110)
لكن إلى جانب نقضه لرأي من ينفي النطق عن الحيوان يؤكد الجاحظ على أن القول بأن للحيوان نطق لا يعني إثبات تماثل بين نطق الإنسان وبين ما للحيوان من أصوات وإنما يعني فقط القول بضرب من التشابه بينهما. وقد رأينا أن الجاحظ ينح منحى أرسطو في القول بضرب من التقارب بين المعرفة التي للإنسان والتي للحيوان وأن ما ذكره المعلم الأول من "تناسب"للتعبير عن هذه العلاقة سماه الجاحظ "مشاكلة". وفي سياق مناقشه مسألة النطق نلمس مثل هذا المعنى في المقارنة بين الإنسان والحيوان والذي يفيد تقاربا لا يبلغ حد التماثل. يقول في هذا السياق "والفرق بين الإنسان والطير أن ذلك المعنى معنى يسمى منطقا وكلاما على التشبيه بالناس."(111) ويقول أيضا "وقالوا منطق الطير على التشبيه بمنطق الناس".(112)
وقد رأينا أن الجاحظ ينسب للحيوان العقل. لكنه يعتبر مع ذلك أن لعقل الإنسان درجة متميزة عن عقل الحيوان. ويبدو أنه يذهب، فيما يتعلق بالمنطق المنسوب للحيوان من جهة طبعه، إلى رأي مشابه. أو بالأحرى يؤسس رأيه في منطق الحيوان على رأيه في العقل. فالاشتراك في النطق بين الإنسان والحيوان يقوم على اشتراك في درجة محددة من العقل. تلك التي تقف عند مجرد إدراك الحاجة والسبيل إلى تحقيقها ولا تتجاوز ذلك إلى معرفة عواقب الأمور. وفي سياق الحديث عن النطق عند الحيوان والتأكيد على أنه فقط شبيه بنطق الحيوان يؤكد الجاحظ على أن نسبة العقل للحيوان هي أيضا من هذا القبيل فيقول عن وصف الشاعر للطير بالعقل "وإنما قال ذلك على التشبيه، فليس للشاعر إطلاق هذا الكلام لها، وليس لك أن تمنعها ذلك من كل جهة وفي كل حال."(113)
أن المنطق الذي يمكن أن يوجد للحيوان لا يجعله إذن مماثلا للإنسان وإن كان شبيها به. وهو في كل الأحوال لا يرقى به إلى أن يكون مكلفا محاسبا على فعله. ويحرص الجاحظ على أن لا يجعل هذا المنطق حتى وإن كان على سبيل الإلهام والتسخير مفيدا للتكليف موجبا للعقاب عند المعصية.(114) وفي سياق التمييز بين الإنسان والحيوان يورد الجاحظ قول القائل "الإنسان هو الحي الناطق" وقد رأينا أنه يقول في سياق تحديد المعنى الذي يقال به الحيوان ناطقا "قد علمنا أن العجم من السباع والبهائم، كلما قربت من مشاكلة الناس، كان أشرف لها. والإنسان هو الفصيح وهو الناطق." بمعنى أن النطق على وجه الحقيقة أي بما هو دال على العقل المقترن بالاستطاعة يجب أن ينسب إلى الإنسان على وجه التخصيص. ويقول في هذا المعنى إن القرآن، عند ذكره منطق الطير، "لم يذكر منطق البهائم والسباع والهمج والحشرات" وذلك لأن "حيثما تجد المنطق تجد الروح والعقل والاستطاعة".(115) ورغم أن الجاحظ قد ذكر في هذا السياق الروح وقرنه بالمنطق إلا أننا لا نجد عنده في أي موضع آخر ما يدل على أنه يعطي الكلام بعدا نفسيا. ولا أنه يتصور العقل على أنه قوة من قوى النفس على الشاكلة التي يقول بها أرسطو. وإن يحدث أن يقول الجاحظ أن "مدار الأمر على فهم المعاني لا الألفاظ"،(116) ويقول على الحيوان إن "معانيها في مقادير حاجاتها"(117) فإنه لا يعتمد على لفظ المعنى لتحديد دلالة الكلام والنطق، ولا يحيل الكلام عنده إلى معنى داخلي أو ذهني أو قائم بالنفس. ورغم أننا يمكن أن نعثر على هذا المعنى للكلام عند بعض المتكلمين،(118) إلا أننا لا نجد عند الجاحظ ما يفيد صراحة هذا المعنى للنطق بما هو يدل على المعنى القائم بالنفس. وأقصى ما يمكن أن نجد عنده أن النطق بما هو سمة مميزة للإنسان، يقترن "بالحفظ". إذ يقول "وإنما يتفاضل بالبيان والحفظ، وبنسق المحفوظ"(119)
وقد يكون في ذلك دلالة على اقتران النطق بقوة الذاكرة وإن هذه القوة هي التي تميز الإنسان عن الحيوان. ويذكرنا هذا ولا شك يما ورد عند أرسطو في كتاب الحيوان عندما قال "ومن الحيوان ما هو شديد الحفظ، مثل الجمل والحمار، وأما تذكر المنسي فللإنسان وحده". لكن فيما عدى ذلك ليس للنطق عند الجاحظ دلالة نفسية.
لم يعول الجاحظ على المعنى القائم بالنفس في فهمه لمعنى النطق كما لم يعتمد عليه في تفسيره مصدر المعرفة عند الحيوان ولا عند الإنسان وكانت هذه هي نقطة الاختلاف الرئيسية التي تميزه على أرسطو. ورغم اشتراكه معه في القول بأن للحيوان ذكاء وفطنة ومعرفة فإنه لا يرد مصدر كل هذا إلى قوى نفسية توجد عند الإنسان ولدى الحيوان وإنما يردها إلى طبع وجبلة خلق عليها الحيوان والإنسان. وإن كان الحيوان يقف في حدود هذا الطبع الذي له من قبيل التسخير فإن من شأن الإنسان أن يتجاوز التسخير إلى الاختيار والاستطاعة.
العقل عند الجاحظ
لا يتميز الإنسان عن الحيوان عند الجاحظ لا بالصورة ولا بالمعرفة والعقل.(120) ويؤكد الجاحظ عند تحديد الخاصية مميزة للإنسان بوجه خاص على "الاستطاعة التمكين". وقد رأينا أنه يجعل هذه الصفة أصلا للعقل والمعرفة. ومعنى العقل عنده كما يبدو من نسبته إلى الإنسان والحيوان على السواء يؤول إلى جملة من العلوم الأولية الحاصلة بالتجارب. وأغلب الظن أن هذه العلوم هي على الأخص المتعلقة بمجرى الطبيعة وموجب العادات. وعلى أية حال لا شك أن العقل عند الجاحظ ليس قوة تنسب للنفس ولا هو بالجوهر المفارق. ويجعل الجاحظ هذا العقل المشترك بين الإنسان والحيوان مقترنا بالحاجة مثله مثل النطق.(121)
ومن المرجح أن الجاحظ يعطي للعقل معاني أخرى غير تلك التي تجعله تعبيرا عن الحاجة وهو ينسبه عندئذ إلى الإنسان ويسميه ذهنا ويجعل محله عند الإنسان القلب أو الدماغ ويعتبر أن العقل بهذا المعنى علامة على تميز الإنسان وتفوقه. فإذا كانت حواس الحيوان "أدق وأرق وأبصر وأنفذ"، فإن ذهن الإنسان "يبلغ بالروية والتصفح، والتحصيل والتمثيل ما لا يبلغه شيء من السباع بالبهائم."(122) ويجب أن نفهم تميز الإنسان بهذا النوع من العقل على أساس تميزه بالاستطاعة إذ أن هذه الميزة هي التي تفيده هذا النوع من العقل. فإذا كان الحيوان يدرك بموجب طبائعه ويعرف ويعلم "سهوا وهويا" فإن الإنسان "يكره نفسه على التفكير، وعلى إدامة التنقير والتكشيف والمقاييس."(123) فهو يحمل نفسه على ما لا يقبل عليه عن طواعية، ويتكلف البحث عن المعرفة رغم أنه "يستثقله" فيحصل له بهذا العناء من العلم والمعرفة ما يتجاوز مجرد الحاجة فيجاوز الحيوان ويفوقه. وكثيرا ما يقابل الجاحظ بين طبع الحيوان الذي يفيده معرفة وعلما وبين روية الإنسان التي تقوم عنده بنفس الوظيفة. وقد اعتبر في كتاب المعلمين أن الإنسان يشترك مع الحيوان في كثير من الصفات "ثم فضله الله تعالى بالمنطق والروية وإمكان التصرف".(124) وقال في كتاب الحيوان في نفس هذا المعنى أن الحيوان يدرك أمورا "بالطبع من غير روية" ويبلغ في ذلك "ما لا يبلغه ذو الروية التامة" فالإنسان ذو العقل والاستطاعة، والتصرف والروية" يختلف في إدراكه للعلوم عن الحيوان الذي يقتصر على الطبع ولا يتكلف الوصول إلى مثلها بالروية.(125)
لكن رغم ذلك لا شيء يدل على أن الجاحظ يجعل العقل الإنساني مقترنا بالعلم النظري أو بمعرفة الكلي في مقابل معرفة الجزئي عند الحيوان. فهذا التمييز الذي قد نجده عند أرسطو لا نعثر على مثله عند الجاحظ. ويشبه أن يكون الاختلاف بين العقل الإنساني عقل الحيوان عند الجاحظ حاصل من جهة كم العلوم (ثراؤها وتنوعها واختلاف مواضيعها) لا من جهة كيفها (كلي في مقابل الجزئي). ومعنى العقل الإنساني الذي هو جملة العلوم التجريبية، قابل للتزيد بمقتضى تراكم التجارب. وبهذا المعنى يميز الجاحظ، فيما يبدو، بين عقل "غريزي" وهو معارف وعلوم توجد لدى الإنسان أو الحيوان بمقتضى الطبع وما ركبه عليه خالقه من طبيعة، لذلك يسميه أيضا "العقل المطبوع،"(126) وهو جبلة مفطورة موجود في الإنسان وفي الحيوان، وهو جملة من العلوم الأولية من قبيل معرفة الرضيع كيفية الارتضاع بالفطرة دون اكتساب لا بالتجربة ولا بالتعليم،(127) وبين عقل "مكتسب"، وهو جملة العلوم التي تحصل للإنسان بالتجارب، وبما تدفع إليه الحاجة. وهو يزداد بما يختبره الإنسان والحيوان بمقتضي وجوده في "الدنيا" ووقوفه على مجرى الأمور الطبيعية. وهو أيضا جملة العلوم التي تحصل بمقتضى التعلم، إما بشكل مباشر (التعليم)، أو بشكل غير مباشر (الكتب). ويوضح الجاحظ هذا التمييز بين نوعين من العقل اعتمادا على تشبيه درج على ذكره "الحكماء" فيقول "وقد أجمعت الحكماء على أن العقل المطبوع والكرم الغريزي، لا يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة العقل المكتسب، ومثلوا ذلك بالنار والحطب، والمصباح والدهن."(128) ورغم أن فحوى هذا التشبيه غير واضح تمام الوضوح إلى أن الأغلب أن المقصود به أن العقل الغريزي هو بمثابة النار والعقل المكتسب بمثابة الحطب وكذلك الشأن في المصباح الذي هو بمثابة العقل الغريزي والدهن الذي يقوم مقام العقل المكتسب. وقد نفهم من ذلك أن العلم هو بمثابة النور والضياء الذي يزداد بازدياد الحطب في النار وبازدياد الدهن في المصباح. ويشجع على هذا التأويل ما يضيفه الجاحظ من أن "العقل الغريزي آلة والمكتسب مادة." ويتأكد ذلك بالمعنى الذي يعطيه الجاحظ للعقل الغريزي على أنه غير قابل للتزيد في مقابل العقل المكتسب. إذ يقول "وإنما الأدب عقل غيرك تزيده في عقلك"، ويفهم الأدب هنا بمعنى عام هو التعلم، أو بمعنى أعم علوم الدنيا والدين.(129) وفي نفس هذا المعنى على ما يبدو يقول الجاحظ إن "العقل المولود متناهي الحدود، وعقل التجارب لا يوقف منه على حدّ."(130) فالعقل المكتسب القابل للتزيد أبدا هو العلوم الحاصلة بالتجارب. وبهذا المعنى يجعل الجاحظ زيادة العقل مقترنة بطول التجارب فيقول "وطول التجارب زيادة في العقل".(131) ويقول الجاحظ أن العقل المكتسب "مادة" مثل أن الحطب هو المادة التي تضاف إلى النار لتتقد والدهن هو المادة التي تضاف إلى المصباح ليضيء ويقول عن الغريزي أنه "آلة"، مثلما أن المصباح آلة بها يكون النور. ورغم أن التشبيه يوحي بالاختلاف الجذري بين العقلين: الغريزي والمكتسب، بمعنى أن أحدهما يمثل علوما والآخر أداة لاكتساب العلوم، إلا أن الغالب على الظن أن الاختلاف لا يذهب عند الجاحظ إلى هذا الحد. فإما أن التشبيه الذي أورده "حكماء" لا يتطابق في جميع جوانبه مع ما يراه الجاحظ بشأن العقل أو أن المعنى المقصود بالآلة يقف في حدود معنى العلوم الأولية التي تمثل شرطا لاكتساب علوم أخرى. وليس في ذلك معنى يفيد أن العلوم التي هي العقل الغريزي هي مبادئ العقل المنطقية، إذ لا شيء يشير إلى أن الجاحظ يقول بمثل هذا الرأي الذي سيتبناه متكلمون متأخرون.
....
المراجع والمصادر:
- البغدادي، أصول الدين، اسطنبول، 1928، ص، 31. وإن كان صالح ابن صالح (ت 246 هـ/ 860 م) يعد فعلا من أصحاب المعارف فإن ذلك يعني أن هذه التسمية لم تطلق على من كان يرد المعرفة إلى الطبع وأن القول بالطبع لم يكن قولا مشتركا أسسعليه أصحاب المعارف قولهم في المعرفة. فصالح بن صالح كان على الأرجح يميل إلى ما ذهب إليه أبو الهذيل العلاف (ت 227 هـ/ 842 م) من قول بالتجويز (أنظر الأشعري، مقالات الإسلاميين، نشرة محمد عبد الحميد، دار الحداثة، 1985، ج2، ص، 12) لذلك فهو أقرب إلى القول بالعادة منه إلى القول بالطبع (أنظر الأشعري مقالات الإسلاميين، ج2، ص، 82-83 أنظر أيضا: Perler, Dominik & Rudolph, Ulrich, Occasionalismus, Theorien der Kausalitat imarabisch-islamischen und im europaischen Denken, Abhandlungen derAkademie der Wissenschaften in Gottingen, Philologisch-Historische Klasse,Folge 3, Nr. 235, Vanderhoeck & Ruprecht, Gottingen, 2000, p. 39-40.
- البغدادي، أصول الدين، ص، 31-32.
- نفسه، ص، 32. وذكر أبو المظفر الإسفرائيني (ت 471 هـ) في كتاب التبصير في الدين أنثمامة ابن الأشرس كان زعيم القدرية في أيام المأمون وزاد على أسلافه من ملاعين المعتزلة شيئين: أحدهما قوله أن المعارف ضرورية كما تقوله الجاحظية." التبصير في الدين، تحقيق كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، 1983، ص. 79
- التبصير في الدين، المرجع نفسه، ص، 81.
- القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف، ج3، ص، 291.
- انظر عبد الجبار ابن أحمد، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج12 في النظر والمعارف، تحقيق إبراهيم مدكور، ص، 316.
- الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص، 88.
- الجاحظ، أسئلة عن المرائي والإبصار، ضمن رسائل الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2002، الرسائل الأدبية، ص، 480.
- ابن النديم، الفهرست، نشرة رضا تجدد، ص، 210.
- أو قد تكون من كتاب مسائل كتاب المعرفة. وردت هذه الفصول في مجموعة مختارات عبيد الله بن حسان التي نشرها عبد السلام محمد هارون ضمن رسائل الجاحظ، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1979، الجزء الرابع، ص، 47-65.
- انظر نفسه، ص، 52.
- انظر الجاحظ، المسائل والجوابات في المعرفة، ص، 47.
- الجاحظ، المسائل والجوابات في المعرفة، ص، 48.
- نفسه، ص، 47.
- نفسه، ص، 47.
- الجاحظ، المسائل والجوابات في المعرفة، ص، 51.
- المرجع نفسه، ص، 51.
- انظر، عبد الجبار، المغني، ج12 في النظر والمعارف، ص، 96.
- المغني، المرجع المذكور، ص، 316.
- انظر الجاحظ، المسائل والجوابات في المعرفة، ص، 51.
- انظر عبد الجبار، المغني، المرجع المذكور، ص، 316.
- ذكر الجاحظ جالينوس في كتاب الحيوان ونقل عنه أقوالا في معارف الحيوان وذكائه، وقال في هذا السياق "قال جالينوس في الإخبار عن معارف البهائم والطير، وفي التعجب من ذلك..." ج7، ص، 24. ولا نعلم على وجه الدقة من أين أخذ الجاحظ هذه الآراء خاصة وأن جالينوس لم يكن ممن اتبع أرسطو في قوله بنسبة الذكاء إلى الحيوان ولم يجاري أولئك الذي نسبوا له العقل والمعرفة والعلم على غرار بلوتارك. وإنما ذهب في ذلك مذهب الرواقيين الذين أنكروا أن يكون للحيوان ذكاء على غرار ما للإنسان.
انظر في شأن الرواقيين : Urs Dierauer, « Raison ou instinct »,in L'animal dans l'Antiquité, Par Barbara Cassin, J. L. Labarrière, Librairie Philosophique J. Vrin, France, 1997, pp. 18-20)
انظر في شأن جالينوس: Urs Dierauer, « Raison ou instinct », op. cit., p. 27.
- انظر: الحيوان، ج4، ص، 208-209.
- اقترن قول النظام بالطبع بقوله بالكمون ويمثل أحدهما في الحقيقة تتمة للآخر. فأن يقال أن للجسم طبع فذلك يعني أنه يولد أجساما أخرى كانت كامنة فيه. إذ خلافا لما ذهب إليه معمر بن عباد من أن الأجسام تولد أعراضا بطبعها (أنظرالأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1950، ج2، ص، 82 والبغدادي، الفرق بين الفرق، ص، 152، وانظر أيضا الخياط، كتاب الانتصار الرد على ابن الراوندي الملحد، تحقيق نيبرج، مكتبة الدار العربية للكتاب، مكتبة أوراق شرقية، القاهرة، 1925، بيروت، 1993، ص، 53-54)، يعتبر النظام أن ما يتولد عن طبع الأجسام هو أيضا أجسام إذ هو لا يثبت من الأعراض شيئا عدى الحركة (أنظر الأشعري، مقالات الإسلاميين، المرجع نفسه، ج2، ص، 31 وص، 81، البغدادي، الفرق بين الفرق، ص، 131، والشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص، 69-70،) وقد أشار الجاحظ إلى الخلاف بين إبراهيم النظام وضرار بن عمرو (ت 180 هـ/796م) وقال "كان أبو إسحاق يزعم أن ضرار بن عمرو قد جمع في إنكاره القول بالكمون الكفر والمعاندة، لأنه كان يزعم أن التوحيد لا يصح إلا مع إنكار الكمون." أنظر الحيوان، ج5، ص، 10.
- يقول الشهرستاني عن الجاحظ أنه"طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، وخلط وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته البليغة " (الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص، 88) ويبدو أنه قد اتبع في ذلك شيخه النظام إذ سبق وأن قال الشهرستاني عن هذا الأخير أيضا أنه "قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة." نفسه، ص، 67.
- الحيوان، ج2، ص، 135.
- الجاحظ، الحيوان، ج2، ص. 134-135.
- انظر مثلا الحيوان، ج1، ص، 294 وما يليها.
- انظر مثلا الحيوان، ج4، ص، 287.
- نفسه، ص، 35-36.
- أرسطو، السياسة، 1253a8.
- انظر أرسطو، أخلاق نيقوماخوس، 1097b33-1098a4.
- انظر أرسطو، كتاب ما بعد الطبيعة، 980a 21 – 981a
- انظر فيما يتعلق بما ينسبه أرسطو من معرفة وذكاء وقدرة على التعلم (J. L. Labarière, « De la phronesis animale », dans Biologie, logique et métaphysique chez Aristote, Actes du séminaire CNRS-NSF d’Oléron du 28 juin – 3 juillet 1987, Paris, CNRS, 1990, pp. 408-418. ) / Thierry Gontier, L’homme et l’animal, La philosophie antique, Presses Universitaire de France, 1999, pp. 7-30. / Jean Bouffartigue, « Les animaux savent-ils ? Réponses grecques antiques à cette question », Schedae, 2009, prépublication n° 11, (fascicule n° 2, p. 21-32).
- انظر الجاحظ، كتاب الحيوان، ج1، ص، 36، ج 4، ص.82، ج. 5، ص، 422، ج. 6، ص، 6، ص. 10، ص، 316، ص، 373-374، ج7، ص، 9، ص، 18، ص، 373-374. وينسب الجاحظ للحيوان العلم فيقول عنه أنه "يعلم" ج6، 373 وما يليها.ج7، ص، 18، ج7، ص، 32-36، ج7، ص،40، ج7، ص،71.
- الجاحظ، الحيوان، ج7، ص، 71.
- نفسه، ص، 35.
- انظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها وما يليها.
- الجاحظ، الحيوان، ج7، ص، 18.
- نفسه، ص، 9.
- الجاحظ، الحيوان، ج6، ص، 6.
- نفسه، ص، 316. ولم يذكر الجاحظ رأيه في مسألة معرفة الحيوان للخير والشر بشكل صريح ومباشر لكنه ذكر مقالة بشر بن المعتمر وفيها ما يدل على أنه يميل إلى اعتبار أن للحيوان علم بما هو خير وما هو شر لم ينكر الجاحظ مقالته هذه (ج6، ص، 320) وذكر في المقابل قول صاحب فرقة البكرية الذي زعم أن الحيوان لا يأثم لأنه لا يعرف الخير والشر (أنظر ج6، ص، 320) لكن رغم كل ذلك لا نعتقد أن الجاحظ يقول بأن للحيوان معرفة بالخير والشر وليس ذلك لأنه قول مخالف لما قال به أرسطو وإنما لعدم توافقه مع ما يقول به الجاحظ من أن الإنسان وحده هو المكلف كما سنرى.
- انظر الجاحظ، الحيوان، ج6، ص، 10؛ ج3، ص، 152.
- الحيوان، ج4، ص، 401.
- الجاحظ، الحيوان، ج3، ص، 214 والتي تليها.
- انظر أرسطو، حركة الحيوان، Περί ζώων κινήσεως، 701a 33-34، أين يقول أرسطو "أن الحيوانيقبل على الحركة والفعل بمقتضى المخيلة والفكر" διὰ φαντασίας καὶ νοήσεως، وكان قد مال إلى أن يسند للحيوان قدرة على أن يعقل διανοουμένοις وعلى أن يقيس أو يستدل συλλογιζομένοις، 701a. وقد رأى بعض الدارسين المحدثين أن في ذلك دلالة على أن أرسطو يعتبر أن الحيوان يفعل بشكل يدل على ضرب من العقل. انظر: Richard Sorabji, Animal Minds and Human Morals: The Origins of the Western Debate, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1995, p. 16.
- الحيوان، ج5، ص، 543.
- نفسه، الصفحة نفسها.
- نفسه.
- الحيوان، ج4، ص، 81.
- الجاحظ، الحيوان، ج4، ص، 81.
- نفسه، ص، 82.
- الحيوان، ج2، ص، 144.
- انظر كتاب الحيوان، ج2، ص، 144.
- مثل أن يقول عنه أنه "ذو العقل والتمكين، والاستطاعة والتصريف، وذا التكلف والتجربةوذا التأنّي والمنافسة، وصاحب الفهم والمسابقة، والمتبصّر شأن العاقبة، متى أحسن شيئا كان كلّ شيء دونه في الغموض عليه أسهل" ج1، ص. 36. أو يقول "الإنسان الذي جعله الله تعالى فوق جميع الحيوان في الجمال والاعتدال وفي العقل والكرم" ج 5، ص، 484. وأيضا "لتعلم أنك مع فضيلة عقلك، وتصرف استطاعتك إذا ظهر عجزك عن عمل ما هو أعجز منك أن الذي فضلك عليه بالاستطاعة والمنطق هو الذي فضله عليك بضروب أخر. ج 7، ص، 11 وأيضا "والإنسان ذو العقل والاستطاعة" ج7، ص، 72.
- انظر الجاحظ، المسائل والجوابات في المعرفة، المرجع المذكور، ص، 63-64.
- انظر أيضا الحيوان، ج، 7، ص، 56.
- يحدث أن يذكر الجاحظ كلمة النفس في سياق الحديث عن المعرفة كأن يقول عن الحيوانات أنها "تدرك بالطبع من غير روية، وبحس النفس من غير فكرة" الحيوان، ج7، ص، 72. لكن استعماله له يبقى استثنائيا ولا يدل على أنه يولي أهمية خاصة للنفس في مسار المعرفة.
- انظر بشأن هذا المعنى المشترك بين الإنسان والحيوان (Stephen T. Newmeyer, Animals in Greek and Roman Thought, Routledge, London and New York, 2011, pp. 8-9.
- انظر الجاحظ، المسائل والجوابات في المعرفة، المرجع المذكور، ص،57.
- الجاحظ، نفسه، الصفحة نفسها.
- يقول أرسطوإ"أن أنكساغوراس كان بقول إن الإنسان هو الأذكى φρονιμώτατον من بقية الحيوانات لأنه بملك يدين". أنظر أجزاء الحيوان، 687b.
- أكد الشهرستاني على أن التوجه العام لمذهب الجاحظ هو توجه طبيعي يختلف عن مذهب اللاحقين من الفلاسفة المسلمين ذو التوجه الأفلاطوني المحدث. وقال "ومذهب الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة. إلا أن الميل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين منهم أكثر منه إلى الإلهيين". الممل والنحل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1993، ج1، ص، 89.
- انظر، كتاب الحيوان، ج2، ص، 145 وما يليها.
- انظر في هذا المعنى المسائل والجوابات في المعرفة، ص،58.
- الحيوان، ج2، ص، 146.
- كتاب الحيوان، ج2، ص، 146.
- يحوم شك حول صحة نسبة هذه المقالة والمقالة التي تليها إلى أرسطو وذلك لوجود تنافر بين ما يجد فيهما من آراء عن قدرة الحيوان على التفكير والاستدلال وما أثبته أرسطو في كتبه الأخرى من تميز الإنسان بهذه القدرة أنظر في ذلك D. M. Blame, History of Animals VII-IX, edited and translated by D. M. Blame, Cambridge-London, Harvard University Press, 1991, Introduction. / [Pamela Huby, “Theophrastus in the Aristotelian corpus, with particular reference to biological problems” in Aristotle on nature and living things. Philosophical and historical studies, presented to D. M. Blame on his 70th birthday, ed. by A. Gotthelf, Pittsburg-Bristol, Mathesis Publication, Bristol Classical Press, 1985, p. 313-325.]
وفي مقابل ذلك هناك من دافع على صحة نسبة المقالة الثامنة والتاسعة من كتاب الحيوان لأرسطو أنظرD. M. Blame, History of Animals VII-IX المرجع المذكور، وأيضا: (J. Berthier, « Introduction à l’étude de l’Histoire des animaux », dans Recherches sur la tradition platonicienne (Platon, Aristote, Proclus, Damascius), publier par le CNRS, Paris, Vrin, 1977, p. 32 sq.
- تعني كلمة τὀ ίχνιον في الأصل الأثر الذي يدل على المسير كما تحيل مجازا إلى المقدار الضئيل أو البقايا. وتترجم في العادة بـ traces في الإنجليزية والفرنسية. وترجمها Urs Dierauer بـ signe. انظر [Urs Dierauer, « Instinct ou raison ? » op. cit., p. 17.]
- انظر: Aristote, Histoire des animaux, 588b 16. وتعني كلمة ὀ τροπός الأسلوب والعادة الحميدة ويمكن أن تؤدي معنى الطريق والمسلك وكيفية الفعل، وهي في هذا السياق تفيد سمة مميزة. وتترجم qualitie في الإنجليزية [J. Barnes,ThecompleteworksofAristotle,] وترجمت faculté في الفرنسية.
- حول منهج أرسطو في دراسة الكائن الحي انظر: [Thierry Gontier, L’homme et l’animal. La philosophie antique, Presse Universitaire de France, 1999, p. 7 sq.]
- تفيد كلمة σύνεσις معنى حدة الفهم وسرعته أو الذكاء، وقد تحيل على الوعي فتترجم أحيانا conscience. وليس لها هذا المعنى الأخير في سياق قول أرسطو.
- انظر: كتاب الحيوان، ج7، ص، 10.
- بشأن الاختلاف بين تصور الفلاسفة للنفس وتصور المتكلمين أنظر مقداد عرفة منسية، علم الكلام والفلسفة، دار الجنوب للنشر، تونس، 1995، ص، 95-96.
- انظر أرسطو، تاريخ الحيوان، 589a
- انظر أرسطو، تاريخ الحيوان، 588b4–12 وأيضا أرسطو، أجزاء الحيوان، 681a10–15.
- انظر، أرسطو، كون الحيوان، 762a– 10.
- انظر، الجاحظ، كتاب الحيوان، ج3، ص، 372.
- انظر، كتاب الحيوان، ج2، ص، 182. ويبدو أن ما ورد هنا هو الذي دفع شارل بيلا إلى القول بأن
للجاحظ ما يشبه نظرية في تطور الكائن الحي. - انظر [C. Pellat, « Ḥayawān, » art. in EI, T. III, p.]
- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج3، ص، 373.
- نفسه.
- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج6، ص، 14. أنظر أيضا ج4، ص، 82.
- انظر أرسطو، تاريخ الحيوان، 535b
- انظر، أرسطو، تاريخ الحيوان، 537a.
- أرسطو، كتاب النفس، 420b– 30.
- أرسطو، السياسة، 1253a
- انظر، الجاحظ، كتاب الحيوان، ج1، ص، 31.
- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج4، ص، 21.
- نفسه.
- الجاحظ، الحيوان، ج4، ص، 21-22.
- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج5، ص، 288.
- نفسه، ص، 286.
- نفسه. ص، 286.
- انظر ما يقول عنه نيبارج في النتصار للخياط، المرجع المذكور، ص، 222-223.
- انظر البغدادي، الفرق بين الفرق، المرجع المذكور، ص، 277. وفيما يتعلق بقوله بالتناسخ ص، 274. أنظر أيضا ابن حزم، الفصل في الأهواء والملل والنحل، دار الجيل، بيروت، دون تاريخ، ج1، ص، 165-166. وورد ذكره عند الشهرستاني في الملل والنحل (المرجع المذكور، ج1، ص، 74.) وكذلك الإسفرائيني في التبصير، المرجع المذكور، ص، 136. وورد ذكره أيضا في الانتصار للخياط، المرجع المذكور، ص، 148. وقد يكون اسم ابن خابط (مثلما ورد عند البغداديوالشهرستاني والإسفرائيني) أو ابن حابط (مثلما ورد عندابن حزم) تشويه أقدم عليه خصومه. وأغلب الظن أن اسمه أحمد بن حائط كما ورد عند الجاحظ في كتاب الحيوان ج4، ص، 288. وعند الخياط في المرجع المذكور.
- البغدادي، الفرق بين الفرق، ص، 271-272. انظر أفلاطون، فيدون، 81b، مانكسان 81a، الجمهورية a614، فيدروس، 248d، جورجياس، 525c. وقد ذكر ديوجين اللايرتي أن فيثاغورس كان يقول بتناسخ الأرواح. انظر: [Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, VIII, 36.]
- البغدادي، الفرق بين الفرق، ص، 274.
- البغدادي، المرجع نفسه، ص، 275.
- انظر كتاب الحيوان، ج4، ص، 288.
- نفسه، الصفحة نفسها.
- نفسه، ص، 287.
- نفسه، ص، 289.
- نفسه، ص، 288.
- انظر نفسه، ص، 293، 294.
- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج5، ص، 424.
- نفسه، ص، 425.
- وقد تطرق الجاحظ للخصومة معهم في عرضه لمسألة الهدهد.أنظر الجاحظ، الحيوان، ج4، ص، 77 وما يليها. وهي المسألة التي تطرق فيها الجاحظ إلى قضية منطق الطير من خلال تفسير الآية عشرين وما يليها من سورة النمل. وتفيد هذه الآيات أن للطير، ممثلا في الهدهد، كلاما ومنطقا ومعرفة وأنه "أعلم من ناس كثير من المميزين المستدلين الناظرين". وفي هذه الآيات ما يفيد أن الهدهد يميز بين الطاعة والمعصية وأنه يصح عليه التكليف والثواب والعقاب. ويقول الجاحظ : "فطعن في جميع ذلك طاعنون." وواضح من سياق مناقشة هذه المسألة أن خصوم الجاحظ فيها هم الدهرية الذين يعتبرون أن جميع ما ورد في القرآن بشأن الهدهد هو من قبيل "خرافات العرب والأعراب في الجاهلية." أنظر الجاحظ، الحيوان، ج4، ص، 80.
- الحيوان، ج7، ص، 56.
- الجاحظ، الحيوان، ج7، ص، 57.
- نفسه، ص، 58.
- نفسه، ص، 49.
- نفسه، ص، 58.
- انظر، الجاحظ، الحيوان، ج4، ص، 83.
- الجاحظ، الحيوان، ج7، ص، 49.
- الجاحظ، الحيوان، ج5، ص، 542.
- الجاحظ، ج7، ص، 56.
- من شأن الكلام عند بعض المتكلمين أن يحيل إلى المعنى القائم بالنفس. وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن الأشعري قد أثبت "الكلام القائم بالنّفس بطريق النّقل والعقل." (ديوان المبتدأ والخبر ، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعةالثانية، 1408 هـ - 1988 م، ص، 588.)لكن لفظ "المعنى" يطرح مشكلا عند المتكلمين من جهة دلالته عندهم, وقد كتب فرانك في مقال له صدر سنة 1967 يقول : إن المحاولات قد تعددت لتحديد المفهوم الحقيقي للفظ المعنى. [Richard M. Frank, « al-Ma‘nā, some reflections on the technical Meaning of the term in the Kalam» JAOS 87, Fasc. 3, 1967.] ولعل كل الإمكانيات لفهمه يمكن أن ترجع إلى أصلين: إما أن له دلالة واقعية، وإما تصورية. ويوجد بالتأكيد تبرير لفهمنا إياه على هذه الشاكلة أو تلك. ويقول فرانك أن هذا اللفظ يرد عند معمر(معمر بن عباد (ت 220) من الطبقة السادسة، معتزلة البصرة) وأنه عنده صفة موضوعية و ليس لها دلالة تصورية. ويخالف بذلك أستاذه ولفسن.إن القول بالمعنى التصوري عند المتكلمين يمثل خطرا على بقية الأصول الكلامية المتعلقة بالنفس وبالتكليف. ولا يجب أن يخفى علينا المشكل الأساسي الذي يمثله هذا المعنى للفظ "المعنى" إذا ربط بالنطق والكلام لدى المتكلمين إذ هو يحيل بالضرورة إلى معنى التصور وبالتالي إلى النفس. وقد وقف المعتزلة على خطورة القول بالمعنى التصوري إذ أنه يؤدي ضرورة إلى إثبات جوهرية النفس واختلافها عن الجسم وذلك رجوع إلى مقالة الفلاسفة بما فيها من خطر على العقيدة في رأيهم. وقد لخص الشهرستاني موقفهم هذا أحسن تلخيص فقال متحدثا على لسانهم: "وأنتم يا معشر الأشاعرة انتهجتم مناهج الفلاسفة حيث حددتم الكلام بالنطق النفسي كما حدوا الإنسان بقولهم الحيوان الناطق وجعلوا النطق أخص وصف تميز به عن سائر الحيوانات وجعلوه الفصل الذاتي ويلزمكم على مساق ذلك أن تكون النفس الناطقة هي الإنسان من حيث الحقيقة، والبدن يكون آلة وقالبا لها. ثم يلزم منه أن يكون الخطاب والتكليف على النفس والروح دون البدن والجسد. وأن يكون المعاد للأرواح والنفس والثواب والعقاب لها وعليها."الشهرستاني، نهاية الأقدام في علم الكلام، مكتبة المثنى، بغداد، دون تاريخ. ص. 325.
- الجاحظ، الحيوان، ج7، ص، 82.
- الجاحظ، الحيوان، ج5، ص، 542-543. يقول الجاحظ في أوضح ما يوجد في كتاب الحيوان للتمييز بين الإنسان والحيوان : "فأقول: إن الفرق بين الإنسان والبهيمة، والإنسان والسبع والحشرة، والذي صير الإنسان إلى استحقاق قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه" ليس هو الصورة، وأنه خلق من نطفة وأن أباه خلق من تراب، ولا أنه يمشي على رجليه، ويتناول حوائجه بيديه، لأن هذه الخصال كلها مجموعة في البله والمجانين، والأطفال والمنقوصين. والفرق الذي هو الفرق إنما هو في الاستطاعة والتمكين. وفي وجود الاستطاعة وجود العقل والمعرفة. وليس يوجب وجودهما وجود الاستطاعة." وبفهم من قوله أن للحيوان العقل والمعرفة دون الاستطاعة وأن وجود العقل لا يعني وجود الاستطاعة كما لا يعني جواز التكليف والحساب. ويبدو أن في تخصيصه ذكر اليدين إشارة إلى ما ذكره أرسطو من أن أنكساغوراس يرد تميز الإنسان عن باقي الحيوان إلى يديه.يقول أرسطو "أن أنكساغوراس كان بقول إن الإنسان هو الأذكى φρονιμώτατον من جملة بقية الحيوانات لأنه بملك يدين". أنظر أجزاء الحيوان، 687b.
- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج7، ص، 56. وقد يكون للاستعمال الجاحظ لكلمة العقل في هذا السياق قرابة لما يطلق عليه أرسطو اسم νοῦςوالذي إن كان له قرابة لما لدى الحيوان من قوى نفسية فهو في ذلك مختلف عن العقل بمعنى λόγος الذي يعتبره أرسطو كما رأينا خاصية إنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن إسحاق بن حنبن ترجم νοῦς بكلمة عقل في سياق الحديث عما للحيوان من قوة يدرك بها الغاية والوسيلة لتحقيقها. فترجم قول أرسطو [ὅθεν διαποροῦσί τινες πότερον νῷ ἤ τινι ἄλλῳ ἐργάζονται ] بقوله: " هل ما تفعله إنما تفعله بعقل أو بمعنى آخر" أنظر: أرسطوطاليس، الطبيعة، ترجمة إسحاق بن حنين، حققه وقدم له عبد الرحمان بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1984، ص، 150.
- الجاحظ، الحيوان، ج7، ص، 17.
- نفسه، الصفحة نفسها.
- الجاحظ، كتاب المعلمين، ضمن رسائل الجاحظ، ج3، ص، 34.
- انظر، الجاحظ، الحيوان، ج7، ص، 72. أنظر أيضا ج1، ص، 205 أين تقترن الروية بالعقل والاستطاعة. ولا ندري إن كان لمعنى الروية عند الجاحظ معنى قريبا لما يمكن أن يكون قد قرأه عند أرسطو في سياق ذكره لما يميز الإنسان عن الحيوان عندما استعمل كلمةβουλευτικὸν (أنظر، أرسطو، تاريخ الحيوان، 489a 24) وتجدر الإشارة إلى أن إسحاق بن حنين قد ترجم قول أرسطو في كتاب الطبيعة [ Μάλιστα δὲ φανερὸν ἐπὶ τῶν ζῴων τῶν ἄλλων, ἃ οὔτε τέχνῃ οὔτε ζητήσαντα οὔτε βουλευσάμενα ποιεῖ· ]
بقوله "وقد يظهر هذا المعنى ظهورا أكثر في سائر الحيوانات التي تعمل أعمالا لا بصناعة ولا بنظر وبحث وروية." أنظر: أرسطوطاليس، الطبيعة، ترجمة إسحاق بن حنين، حققه وقدم له عبد الرحمان بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1984، ص، 150. وهو ما يدل على أن لكلمة βουλευτικὸν معنى الروية في الأدبيات القديمة.
ويحيل فعلβουλεὐω على العزم والإرادة مثلما يحيل على الاختيار، وتترجم ἠ βουλευσις عادة كما وردت عند أرسطو في كتاب أخلاق نيقوماخوس 1112b-2، délibération. وتجدر الإشارة أن أرسطو يستعمل هذا المفهوم للدلالة على معنى النظر الذي يهدف إلى تحقيق الخير أو تحقيق غاية ما. وهو بهذا المعنى مرادف لـ φρόνησις كما ترد عند أرسطو في كتاب أخلاق نيقوماخوس 1140b. لكن أرسطو يقول عن الحيوانات أن بعضها أذكى φρονιμώτερα من بعض. فيسند لها التدبير φρόνησις في كثير من الأحيان أنظر ما بعد الطبيعة، A, I,980b22، أخلاق نيقوماخوس، VI, 7, 1141a 26-28 ؛ أجزاء الحيوان، II, 2, 648a 6-8 ، كون الحيوان، III, 2, 753a 10-13..
- انظر الجاحظ، رسالة في المعاش والمعاد، ضمن رسائل الجاحظ، ج1، ص، 96.
- ويسمي الجاحظ هذا النوع من المعرفة "هداية" ويعتبرها "شيئا مجعولا في طبيعة الإنسان".أنظر الحيوان،
ج2، ص، 156. - الجاحظ، رسالة المعاش والمعاد، ضمن رسائل الجاحظ، تحقيق، عبد السلام محمد هارونالناشر: مكتبة الخانجي،
القاهرة، 1384 هـ - 1964 م، ج1، ص، 96. - العلم والأدب مقترنان عند الجاحظ وهما يكادان يكونان مترادفين مثلما في مطلع رسالة الحنين إلى الأوطان
(ضمن رسائل الجاحظ، ج2، ص، 383.) ويعتبر الجاحظ في رسالة المعاش والمعاد أن الآداب قائمة على
أصول الطباع ويربطها بالعقل ويقول:"واعلم أنّ الآداب إنّما هي آلات تصلح أن تستعمل في الدّين وتستعمل في
الدنيا." أنظر، الجاحظ، المعاش والمعاد، ضمن رسائل الجاحظ، المرجع المذكور، ج1، ص، 99. - الجاحظ، الأوطان والبلدان، ضمن رسائل الجاحظ، ج4، ص، 112.
- الجاحظ، البيان والتبيين، دارومكتبةالهلال،بيروت، 1423 هـ، ج3، ص، 307