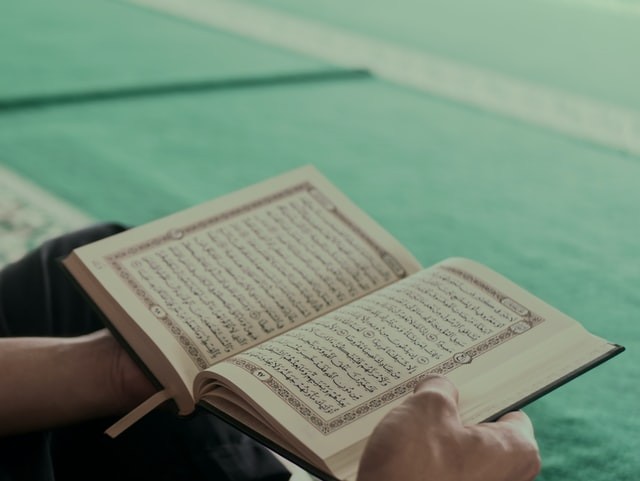محمد المنتار رئيس مركز الدراسات القرآنية، الرابطة المحمدية للعلماء | المملكة المغربية.
أولاًـ الأمن والخوف ونظائرهما في القرآن الكريم
- مفهوم الأمن لغة:
الأمن والأمان لغةً: مصدران بمعنى الطمأنينة وعدم الخوف، قال ابن منظور في اللسان: الأمان والأمانة بمعنىً، وقدأَمِنْتُ فأنا أمينٌ وأَمَّنْتُ غيري، من الأمن والأمان، والأمن ضد الخوف... واستأمن إليه: دخل في أمانه، وقد أمَّنتهُ وآمنه... والمأمَن: موضع الأمن.وأمن فلان على كذا وثق به، واطمأن إليه، أو جعله أمينا عليه، قال تعالى: (قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ) (يوسف: 64).
وقال ابن فارس: "الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة، التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر: التصديق"(1).
وقال الزبيدي: "الأمن: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصله طمأنينة النفس، وزوال الخوف"(2). وقال الفيروز آبادي: "ورجل أُمَنَةٌ كهُمزة...: يأمنه كلُّ أحدٍ في كل شيء"(3). وعند الخليل: "الأمان: إعطاء الأَمَنَة، والأمانة: نقيض الخيانة"(4). وقال أبو هلال العسكري: "الأمن: سكون النفس، والخوف: انزعاجها وقلقها"(5).
وقد وفق الراغب الأصفهاني في بيان معنى الأمن في نص بديع دقيق، يكاد يكون جامعا لما تفرق في غيره من المصادر، يقول: "أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمن والأمانة في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة لما يؤمن عليه الإنسان... وقوله سبحانه وتعالى: (ثمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)(التوبة: 6) أي: منزله الذي فيه أمنه... وآمَنَ: إنما يقال على وجهين: أحدهما متعدياً بنفسه، يقال: آمنته، أي: جعلت له الأمن، ومنه قيل للهننن: مؤمن. والثاني: غير متعدّ، ومعناه: صار ذا أمن... والإيمان هو التصديق الذي معه أمن "(6).
وكأن الإمام الراغب لا يتصور أن يكون هناك مؤمن وليس عنده أمن؛ أي سكينة واطمئنان، بمعنى استقرار لا اهتزاز فيه،ولا خوف، ولا اضطراب، ولا قلق، ولا حير؛، لأنه مطمئن إلى ربه،قال عز وجل: (أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)(الرعد:28)، وقال جل ذكره:(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ) (الفتح:4).
إن الأصل الذي تدور عليه مادة (أ م ن)-سواء في صورة "أَمِنَ"، أو في صورة "آمَنَ" المتعدي واللازم، كما نبه لذلك الراغب- هو وجود السكينة والاطمئنان في القلب، وهي طمأنينة وسكينة تأتيان في حقيقتهما بعد نوع من الاضطراب، وبعد قدر من الخوف، وهذا الخوف يعبّر عنه بلفظ الخوف نفسه، وأحيانا يعبر عنه بالفزع، قال عز وجل:(وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) (النمل:89)، كما عبر عنه بألفاظ أخرى -مثل لفظ البأس، ولفظ الوجل-تحدث في مجملها لدى الإنسان أضرُبًا من الخوف.
من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أن المعنى اللغوي لمفهوم الأمن يدور حول أمور، منها:
- الشعور بالاطمئنان.
- الاستقرار والسكينة.
- عدم الخوف والفزع.
أما عند المفسرين الأوائل وأصحاب كتب اصطلاحات الفنون فإن مصطلح الأمن قد عرف بتعاريف أقرب إلى المعاني اللغوية التي سبق استعراضها؛ فالأمن عند أبي حيان التوحيدي هو: "زوال ما يُحذر"(7)، وقال البقاعي: "الأمن: هو سكون النفس بتوقع الخير"(8). والأمن عند المناوي:"عدم توقع مكروه في الزمن الآتي"(9).وعرفه عبد القاهر الجرجاني بأنه: "عدم توقع مكروه في الزمان الآتي"(10).
- مفهوم الأمن في السياق القرآني:
ورد لفظ الأمن ومشتقاته في السياق القرآني موزعا على عشرين صيغة، وهي: أَمِنَ، أَمِنْتُكُم، آمنوا، آمنكم، تأمنَّا، تأْمنْه، يأمن، يأمنوا، يأمنوكم، آمنا، آمنة، آمنوا، آمنين، أمنا، أمنة، مأمنه، مأمون، آمنهم.
وهي صيغ جاءت موزعة في أربع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم، وقد وردت مجتمعة في ثمانٍ وأربعين موضعاً من كتاب الله، موزعةً على ثلاث وأربعين آية: 31 موضعًا في القرآن المكي، و17 موضعا في القرآن المدني.
ولأهمية الأمن في القرآن الكريم، فقد جعله الله سبحانه مِنَّة ونعمة من أعظم النعم التي منّ بها على خلقه، قال عز وجل:(وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُون) (القصص: 57).أي جَعَلَهُمْ الله فِي بَلَدٍ أَمِينٍ، وحَرَم مُعَظَّمٍ آمِنٍ مُنْذُ وُضع، فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْحَرَمُ آمِنًا فِي حَالِ كَفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ، وَلَا يَكُونُ آمِنًا لَهُمْ وَقَدْ أَسْلَمُوا وَتَابَعُوا الْحَقَّ"(11)كما أخبر الله أنه امتنّ على أصحاب الحِجْر بالأمن فقال: (وَكَانُواْ يَنْحِتونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِين) (الحِجر: 82).
وبإحصاء جميع المفردات التي تعود إلى الجذر الاشتقاقي"أمن"، نجد أن لفظ "الأمن"، جاء معرفا في ثلاثة مواضع:
- مرة واحدة في قوله تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(النساء:83).
- ومرتين في قوله تعالى: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾الأنعام:80-82).
وورد في موضعين منكرا، أولها: قوله عز وجل: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) (البقرة:125). والآخر قوله سبحانهوتعالى: (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) (النور:55).
كما ورد لفظ (أمن) على غير الصورة الاسمية في عدة مواضع، إما بصيغة الماضي، أو بصيغة المضارع، أو في صيغة المشتق، كاسم الفاعل المفرد أو الجمع. والملاحظ أنه"لم يرد مقيداً بشيء؛ لا بوصفٍ، ولا بإضافةٍ، ومعنى ذلك أنه غير قابل للتبعيض، فالأمن شيء كلي شامل لا يقبل التبعيض، فهذه نقطة مهمة، وهي أن الأمن نعمة يتنعم بها الناس إما أن تكون وإما ألا تكون، ولا يمكن أن تكون مبعضة، بمعنى ينعمون بنوع من الأمن، ولا ينعمون بأنواع أخرى، ولا سيما بالنسبة لأهل الإيمان؛ لأن المنطق الذي يحكم دائرة الإيمان بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو دائرة التكليف، ودائرة الشهادة على الناس، بينما الدائرة الأخرى ليست مكلفة، ولذلك إذا تمت الاستجابة للتكليف تكون النتائج، وتكون الآثار الطيبة، وتكون الثمرات وتكون الخيرات، وإذا لم تتم الاستجابة تكون العقوبات. بينما في دائرة غير الإيمان قد يتم التنعم الدنيوي، حتى يرتحل الناس، ولا يكون إشكال؛ لأنهم ليسوا مكلفين بهذه الأمانة"(12).
والمتأمل في سياقات ورود لفظ "الأمن" يجد أنه في العديد من الآيات يتعدى الأمن حدود الحياة الدنيا ليشمل الآخرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة) (فصلت: 40)، وقوله جل ذكره: (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون)(النمل: 89)، وقوله عز وجل: (إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين) (الحجر: 45-46)، وقوله عز وجل: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا إلى الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون)(سبأ:37)، وقوله سبحانه وتعالى: (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين)(الدخان:52).
ومما يلاحظ كذلك في السياق القرآني لورود لفظ الأمن الارتباط الوثيق بين الأمن وبينقيم التوحيد، والإيمان، والعمل الصالح، وهو ما نلمسه في آية سورة إبراهيم، يقول الله عز وجل: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا البَلَد آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) (إبراهيم:35)، حيث يظهر مستوى من مستويات الأمن؛ وهو الأمن العقدي، والأمن الروحي.
وهو ما يظهر أيضاً في دعاء إبراهيم عليه السلام بأن يجعل بلده آمنا، ويرزق أهله من الثمرات، قال الله عز وجل: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (البقرة: 126). وهو دعاء صريح في توق إبراهيم عليه السلام لمستوى آخر من مستويات الأمن، وهو الأمن الغذائي.
وهي المقتضيات نفسها التي جاء التذكير بها بشكل أصرح وأوضح في قول الله جل وعز: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (التوبة:55).
وبالإضافة إلى الأمن العقدي والأمن الروحي والأمن الغذائي يرشدنا السياق القرآني إلى أنواع أخرى؛ منها: الأمن النفسي، والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والأمن الديني، والأمن السياسي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأصلوالمدار الذي تدور عليه مادة "أمن" يجمع معاني ودلالات مترابطة،تدل على أن كل أمْنمتصلٌ بالآخر ومتوقف عليه؛ إذ لا يتصور حصول أمن في مجال دون مجال، ولا يقع في خَلَدِ أحد إمكانية استقرار العمران بتخلف أمنٍ واحد من تلك المنظومة المتماسكة والمتكاملة التي يعضد بعضها بعضا، وهذا دليل على كلية مفهوم الأمن في الرؤية القرآنية، بحيث مَن تحقق أمنه- فردا كان أو مجتمعا- اطمأن في حياته، وسعد في آخرته.
نخلص إلى أن للفظ (الأمن) في القرآن الكريم معاني ثلاثة:
أولها: الأمن الذي يدل على الأمانة، وضد الخيانة، ومنه قوله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) (البقرة:283)، وقوله سبحانه وتعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) (آل عمران:75)، وفيه تنبيه إلى أن فئة من أهل الكتاب يتخلقون بخلق الأمانة.
الثاني: الأمن الدال على المكان الآمن، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (التوبة:6)، بمعنى موضع أمنه ومكانه،ومنه قوله عز وجل: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) (البقرة:125)، أي: مكاناً آمناً للناس.
الثالث: الأمن المقابل للخوف، ومنه قوله عز وجل: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن) (الأنعام:82)؛أي أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحوه قوله عز وجل: (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا) (آل عمران:154)، والأمن والأَمَنَة بمعنى واحد، أي: أنزل على المؤمنين أماناً تاما بعد الخوف الذي دخلهم من جراء ما ظنوا أنه كثرة لأعدائهم،وهم في قلة عدد وعُدَّةٍ.
- الخوف ونظائره في القرآن الكريم
قال أبو هلال العسكري: "الخوف: خلاف الأمن والأمن: سكون النفس، والخوف: انزعاجها وقلقها، وهو معنى غير العلم؛ لأن العلم يبقى بعد ذهاب الخوف. وأصله من النقصان، ومنه قيل: خوفت الشيء: إذ أنقصته، ودينار مخوف: ناقص الوزن.
وقد يجيء الخوف بمعنى العلم، قال الله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) (البقرة:229)، وكذلك الخشية بمعنى العلم، قال الله: (فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) (الكهف:80)، وقالوا: الخوف كالظن يكون شكا ويقينا، وأنشد:
أخافُ إِذَا مَا مت ألا أذوقها
أي أعلم، وموضعه في الظن قولك لصاحبك قد أبق غلامك، فيقول: قد خفت ذاك، ويجوز أن يكون هذا من الخوف خلاف الأمن"(13).
وحدد أهل الوجوه والنظائر للخوف في القرآن الكريم خمسة أوجه:
الأول: القتل، وهو قوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ) يعني: القتل، وليس بالوجه؛ لأن قوله تعالى: (وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ) قد تضمن القتل، ولكن معناه الخوف على الأنفس لكثرة الأعداء، وذلك كان حال أهل المدينة بعد الهجرة، وهم مخاطبون بهذه الآية.
الثاني: الحرب، قال الله عز وجل: (فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ)، يعني: الحرب، وسماها خوفا؛ لما فيها من الخوف، كما تسمى الحرب روعا لما فيها من الروع، والروع والخوف سواء.
الثالث: العلم، قال الله عز وجل: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا) أي: علم... ومثله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) أي: فإن علمتم، وأول الآية: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) يعنيلا يحل للرجل أن يأخذ مهرها على الكره، ولا على سبيل الإلجاء لها إلى دفعه إليه لتتخلص منه؛ إلا أن يكون الرجل على حال لا تصبر المرأة عليها، فتفتدي منه بمهرها وله أن يأخذ ذلك منها، ويسرحها.
الرابع: الخوف بعينه، قال اللَّه عز وجل: (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) وقال: (أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا) وقوله: (وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا) وقوله: (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا).
الخامس: التخوف، وليس هذا بابه، وهو التنقص، قال: (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ) أي: تنقص أموالهم وثمارهم حتى يهلكهم"(14).
ثانيا ـ أوجه اقتران مفردتي الأمن والخوف في القرآن الكريم
مر معنا أن سياق ورود لفظ الأمن في القرآن الكريم يؤكد دوران معنى مادة (أمن) في اللسان العربي على السكينة، والاستقرار، والطمأنينة، وزوال الخوف، يقول الراغب الأصفهاني: "أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف"(15)، ويقول الجرجاني: "الأمن: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي"،(16) ويقول الكفوي: "والأمن في مقابلة الخوف مطلقا"(17). وهذا يفسر وجهاً من أوجه اقتران مفردتي "الأمن" و"الخوف" في العديد من السياقات القرآنية، من مثل قوله عز وجل: (وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا)(النور:55)، وقوله تعالى: (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنعام:81)، وقوله تعالى: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به) (النساء:83).
ومَنْ تدبر في آي القرآن وجد تلازماً وثيقاً في عدد من آياته بين الأمن ورغد العيش من جهة، وبين الخوف والجوع من جهة أخرى، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، وهما نعمتان من أعظم النعم التي تشبع حاجتين أساسيتين من حاجات البشر، وهما:
- الكفاية من العيش.
- والأمن من الخوف.
قال عز وجل ممتناً على قريش: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)(قريش:3-4). وقال سبحانه وتعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْـجُوعِ وَالْـخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)(النحل:112). وقال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْـخَوْفِ وَالْـجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)(البقرة:155). وشر ما يبتلى به مجتمع أن يُسلب هاتين النعمتين، فيصاب بالجوع والخوف، وهما من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى.
بل إن الرسول الكريم كان يستعيذ من الجوع، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ"(18).
وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا"(19).
وفي إطار جدلية العلاقة بين الأمن والخوف، يتبادر سؤال إلى ذهن القارئ، حول محدد الأمن: أهوشرط أم نتيجة؟ أو بصيغة أخرى : أهو شرط في حدوث الاستقرار، وشيوع السكينة، وتنمية الازدهار الحضاري، والاجتماعي، والعمراني، أم أنه نتيجة؟
يتبين من خلال بعض السياقات، أن الأمن شرط في قيام الاستقرار والنماء والازدهار، وليس نتيجة، وقد استوعب الإمام الرازي الدلالة الشرطية للأمن، وصاغ استشكالاً حول شرطية أمن الدنيا لصلاح أمر العبادة، ثم أجاب بما يدل على شرطية الأمن بين يدي أي فعل استخلافي مهما كان شأنه؛ يقول: "المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمنا كثير الخصب، وهذا مما يتعلق بمنافع الدنيا، فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها؟والجواب عنه من وجوه:
أحدها: أن الدنيا إذا طلبت ليُتقوى بها على الدين، كان ذلك من أعظم أركان الدين، فإذا كان البلد آمنا وحصل فيه الخصب تفرغ أهله لطاعة الله تعالى، وإذا كان البلد على ضد ذلك كانوا على ضد ذلك.
وثانيها: أنه تعالى جعله مثابة للناس، والناس إنما يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطرق آمنة والأقوات هناك رخيصة.
وثالثها: لا يبعد أن يكون الأمن والخصب مما يدعو الإنسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة، فحينئذ يشاهد المشاعر المعظمة والمواقف المكرمة، فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله في تلك الطاعة(20)
وهو ما يبين أن الأمن في الرؤية القرآنية شرط أساسي لقيام الإنسان بدوره الاستخلافي، وإقامة ضروريات الدين، وبناء نفسه الفردية والجماعية، فلا استقرار ولا نماء، ولا ازدهار ولا تنمية، ولا سلم ولا سلام-إلا بوجود الأمن والأمان؛ فبوجود الأمن توجد الحياة، وبانعدام الأمن تنعدم مقومات الحياة.
وهذا ما يظهر فيالدعاء الإبراهيمي:(رب اجعل هذا البلد آمنا) فالبدء بطلب الأمن في ها الموضع. له دلالة الشرط، ويظهر الأمر بشكل أوضح في قوله عز وجل: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)؛ حيث جاء الأمر الإلهي بالعبادة بوصفها مظهرا من مظاهر الاعتراف بنعم الله، والسعي إلى شكره عليها سبحانه، جاء بعد أن تحقق الأمن بأنواعه: الغذائي، والنفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي. يقول ابن كثير: "تفضل عليهم-على قريش- بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: "وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة "(21).
ومن مقتضيات الدلالة الشرطية في أسبقية الأمن أن صارت العبادة معللة بتحققه، وأضحى "رب البيت" موصوفا به؛ يقول الشوكاني: "ولولا الأمن بجوارهم البيت لم يقدروا على التصرف، أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما أنعم به عليهم؛ أي إن لم يعبدوه لسائر نعمه؛ فليعبدوه لهذه النعمة الخاصة المذكورة"(22).
وبالنظر لما لشرطية الأمن من دور فعال في نهوض الإنسان بأمانة دوره الاستخلافي، فقد ورد نقيضه- أي الخوف - بصيغة النكرة، وزاد من أهميته، وعظم شأنه: سياق الورود المشبع بامتنان الله على أهل مكة، وهو ما تنبه لهالسمين الحلبي: "والتنكير للتعظي؛، أي من جوع عظيم، وخوف عظيم "(23). ولا ينتفي الخوف العظيم إلا بحصول أمن في مثل عظمته أو أقوى منه، وهو ما يمتن به الله على الإنسانية جمعاء، ليشكل لها هذا المقصد الكلي محضنا لها يمكّنها من الانخراط في سلك العابدين، ومن تحقيق الخضوع الكلي للخالق الباري سبحانه.
ثالثا ـ مرتكزات تحقيق الأمن في الرؤية القرآنية
إن أساس تحقيق الأمن -أيا كان نوعه-هو الإيمان والعمل الصالح، قال سبحانه وتعالى: (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون. الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُون) (الأنعام: 81-82)، وقال عز وجل: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون) (النور: 55).
وقد ورد لفظ (أمن) في هذه الآية نكرة، مما يدل على كليته وعظمته، يقول ابن عاشور: "وتنكير (أمنا) للتعظيم، بقرينةكونهم بدلاً من بعد خوفهم المعروف بالشدة"(24).
كما أن سياق الآية يرشد الناظر إلى ضرورة تحصيل أسباب تبديل الخوف بالأمن، يقول ابن عاشور:
"ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا: إيماء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه، مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إنهم أخذوا في ذلك، وأنملاكذلك هو طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم (وإن تطيعوه تهتدوا)، وإذا حلال اهتداء في النفوس نشأت الصالحات، فأقبلت مسبباتها تنهال على الأمة، فالأسباب هي الإيمان وعمل الصالحات. والموصول عامٌّ لايختص بمعين، وعمومه عُرْفي؛ أي: غالب فلا يُنَاكِدُهُما يكون في الأمة من مقصرين في عمل الصالحات؛ فإن تلك المنافع عائدة على مجموع الأمة"(25).
وقد جعل الله سبحانه نعمة الأمن من أعظم النعم التي امتن بها على عباده والتي تستحق الشكر والتوجه إليه سبحانه وحده بالعبادة الخالصة، لاسيما أنه سبحانه جعل أماكن العبادة موطن الأمن والسلام، فلا يجوز أن يتعرض مَنْ دخلها للترويع والتخويف بأية وسيلة من الوسائل، بل إن الذين يتعرضون لهذه الأماكن بالصد عنها لم يكن لهم أن يدخلوها إلا خائفين كما قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم) (لبقرة: 114).
مما سبق يتضح أن أساس تحقق الأمن في الدنيا والآخرة للمؤمنين هو الإيمان والعمل الصالح، فوجود هذا الأساس يحقق الأمن للمؤمنين في الدنيا بعد الخوف، والتمكن بعد الضعف، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون) (النور: 55)، فهذا وعد من الله تعالى لرسوله بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض؛ أي أئمة الناس والولاة عليهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً لقاء إيمانهم وعملهم الصالح.
يقول ابن عاشور: "والخطاب في (منكم)
لأمة الدعوة بمشركيها ومنافقيها، بأن الفريق الذي يتحقق فيه الإيمان وعمل الصالحات هو الموعود بهذا الوعد.
والتعريف في ( الصالحات ) للاستغراق؛ أي: عملوا جميع الصالحات، وهي الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح، وترك الأعمال التي وصفها الشرع بأنها فساد؛ لأن إبطال الفساد صلاح... واستغراق ( الصالحات ) استغراق عرفي؛ أي عمل معظم الصالحات ومهماتها ومراجعها ممايعود إلى تحقيقكليات الشريعة "(26).
وكليات الشريعة معلومة هي: الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالمحافظةعليها: الأمن على الدين، والأمن على النفس، والأمن على العرض أو النسل، والأمن على العقل، والأمن على المال.
وقد بين الله تعالى أن استقرار الإنسان، وسبيل سعادته في العاجل والآجل يكمن في حفظ هذه الضروريات، ومكملاتها، وتوابعها، وقد تعززت هذه الضروريات في الرؤية القرآنية بأحكام شرعية، تكليفية ووضعية، مبثوثة في تضاعيف كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، موصلة بكليتها إلى تحقيق صلاح الإنسان، وصلاح الكون، على السواء، مثل قوله عز وجل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) (النحل:90)، وقوله جل وعز: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون) (البقرة: 277)، وقولهعز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم) (النساء:29). وقوله في سياق الذم: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد) وقوله جل ذكره: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) (محمد:23).
يقول ابن عاشور رحمه الله: "وهذه التكاليف التي جعلها الله لصلاح أمور الأمة، ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن: صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لها،و كانت الموعدة كالمسبب عليها، فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع، وجعل الإيمان عمودها وشرطا للخروج من عهدة التكليف بها، وتوثيقا لحصول آثارها بأن جعله جالب رضاه و عنايته. فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح، وبه يحف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها، بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع، وربما حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بها، وعند تخليطهم الصلاح بالفساد، فرفق بهم، ولم يعجل لهم الشر، وتلوم لهم في إنزال العقوبة"(27).
ومقتضى هذا الكلام هو صريح قوله عز وجل: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء:105-107).فالإسلام يسعى إلى تحقيق التعارف بين الأمم المختلفة، على أساس تعرف كل منها على ما عند الأمم الأخرى؛ للإفادة منه، والإسهام في تحسينه صُعْودًا نحو تعزيز الأمن، والسلام، والرخاء، والتنمية الشاملة، والتعاون والتكامل بين الشعوب، ودعم قيم الحرية والعدل، والتنافس في الصلاح، ونشر الخير والفضيلة، وجلب المنافع ودرء المفاسد؛ قال عز وجل: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات: 13).
والنتيجة الكبرى لكل ذلكأنالأمنفيالدنيا-وفق هذه المحددات- يورث الأمن في الآخرة، فمن حصل له الأمن في الدنيا- نتيجة للإيمان والعمل الصالح- فإن له الأمن في الآخرة، الذي هو مفتاح سعادته.
رابعا ـ مشاهد الأمن بعد الخوف في القرآن الكريم في حياة الإنسان
- مشهد إبراهيم عليه السلام مع الملائكة لما دخلوا عليه وهو لا يعرفهم
ذكر الله تعالى في سورة الذاريات مشهد إبراهيم عليه السلام مع الملائكة، لما دخلوا عليه وهو لا يعرفهم، فقام تجاههم بواجب الضيافة ؛ حيث قدم لهم الطعام، فلما لم يمدوا أيديهم خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام(28)؛ قال عز وجل: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام. عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم) (الذاريات: 24-30).
فلما خاف عليه السلام قالت الملائكة: لا تخف، وكُن آمناً، فإنّا ملائكة ربك، أرسلنا الله تعالى إلى قوم لوط الذين فعلوا الأمر العظيم الذي يستحقون بسببه العذاب الأليم، ومما زاد في طمأنينة إبراهيم عليه السلام ونزول السكينة عليه تبشير الملائكة له بغلام عليم(29).
وهذا المشهد القرآني حمل أيضا إشارة لطيفة إلى نوع من أنواع الأمن النفسي والوجداني، وهو الخوف من الحرمان من الولد والذرية مع وجود الكبر و العقم عند زوجته سارة، فبشره الله بالولد رغم ذلك عن طريق هؤلاء الضيف المكرمين، وهم الملائكة الذين أمنوه بعد أن كان خائفا منهم بالبشارة بالولد العليم.
وقد نقلت لنا سورة الحجر هذا المشهد القرآني بسياق آخر، جاء التعبير فيه عن الخوف بالوجل، قال عز وجل: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) (الحجر: 51-56).
- مشهد تحقيق الأمن مع لوط عليه السلام
قال الله جل وعز: (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ) (الحجر: 57- 68).
قدمت لنا آيات سورة الحجر مشهد خوف لوط من قومه، وأن خوف لوط uإنما كان على ضيوفه؛ لأن قومه كانوا معروفين بأن من عاداتهم إتيان الرجال، وأمّنّه الله تعالى بأن أنزل العقوبة على قومه، ونجّى لوطاً وأهله، إلا امرأته كانت من الغابرين، وهو ما جاء واضحا في مواضع متفرقة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: (وَلَمَّا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِين) (العنكبوت: 33).
وقوله عز وجل:(وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيب. وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيد. قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد) (هود: 77-80)
إن في قصة لوط (30) مع قومه إشارة إلى أنواع من الأمن؛ هي: الأمن الاجتماعي، والأمن النفسي، والأمن القيمي والأخلاقي، فلما جاءت الرسل لسيدنا لوط أصبح عنده خوف نفسي من إيذاء قومه للضيوف، حينئذ أمنته الملائكة بأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليهم، وبشروه بإنزال الأمن والسكينة على قلبه، وعلى قلب من آمن معه.
- مشهد حي للعلاقة العكسية بين الأمن والخوف من خلال قصة نبي الله موسى عليه السلام
قدم القرآن الكريم نموذجا حيا للعلاقة العكسية بين الأمن والخوف، وكشف عن أهمية الأول في القضاء على الثاني، وذلك من خلال قصة موسى عليه السلام في العديد منالسور، وخاصة سورة القصص، حيث لامس الخوف نفسية موسى عليه السلام بعد أن واجه مشكلات، وتعرض لفتن منها إقدامه على الدفاع عن رجل مظلوم، فكان أن قتل الظالم دون نية مبيتة، وقد صور القرآن تلك الحالة النفسية لموسى في قوله تعالى: (فأصبح في المدينة خائفا يترقب) (القصص:18)، حتى صار الدعاء الأثير لموسى هو أن يدعو الله أن ينجيه من القوم الظالمين، يقول سبحانه: (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين) (القصص:20-21).
وقد أدرك شعيب عليه السلام- بمقتضى الوحي الرباني- هول الخوف بداخل موسى عليه السلام، فقام أولاً بإشعاره بالأمن، ثم أكرمه ثانياً باقتراح زواجه من إحدى ابنتيه؛ إيماناًمنه بأن الأمن شرط أساسي للتخلص من مختلفالأحوال النفسية والروحية المهتزة، كما أنه-أي الأمن- مقدمة لحصول التوازن والطمأنينة، والهناء، والسكينة. يقول تعالى: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين) (القصص:25).
وتأكيدًا لهذا الأمن النافي للخوف فقد تضمن جواب شعيب عليه السلام الكلمات نفسها التي صاغ منها موسى دعاءه لربه عز وجل: (نجني من القوم الظالمين)، فكان طلب النجاة ابتداء، وكانت النجاة انتهاء بفضل تحقق الأمن وزوال الخوف.
وهذا مبدأ تشريعي يستفاد من قصة موسى، يقوم على أساس أن الأمن مقدم على كل التزام، وأن تحققه شرط في إقامة الدين وحفظ ضرورياته؛ بل إن الأمن هو كل أساس خير، وغيره ينبني عليه.
وعندما أمكن تحقق الأمن-في هذا المشهد القرآني-صار بإمكان موسى أن يستجيب لاقتراح شعيب عليهما السلام، وأمكن له كذلك أن يتخذ له زوجاً يسكن إليها، وينظم حياته، ليدعم استقراره، بشكل يمكّنه من التهيؤ لتلقي أنوار الوحي الكريم، بأمن وأمان، بعد خوف واضطراب، وهو صريح قوله تعالى: (يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين) (القصص:33).
-مشهد قصة ثمود مع نبي الله صالح عليه السلام
ذكر القرآن الكريم قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه، وفصّلها في سورة الشعراء، يقول عز وجل: (أتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ.وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ) (الشعراء: 146-152).
وقد ذكرت الآيات الكريمةالأمن والرزق كمتلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، ونجد دائماً الأمن يتقدم الرزق؛ لكونه الوسيلة لحصوله ودوامه، كما تبين الآيات بجلاء أن الكفر ومخالفة شرع الله من أهم ذهاب أمنها وهلاك رزقها، فالفساد في الأرض أثر من آثار ضياع الأمن والاستقرار.
- مشهد الأمن في الأوطانفي دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام
الأمن في الأوطان هو دعوة أبينا إبراهيمعليه الصلاة والسلام، وفي ذلك يقول الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِير) (البقرة: 126).
وقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة؛ ذلك أن"أمن البلاد والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة، ويقتضي العدل، والعزة، والرخاء؛ إذ لا أمن من دونها، وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة، فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة: وإذا اختل الأول اختلت الثلاثة الأخيرة، وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه؛ لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع الإسلام"(31).
وقد ذكر الدعاء نفسهفي سياق سورة إبراهيم، في قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَام) (إبراهيم: 35)، وقد استجاب الله له، فقال عز وجل: (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم) (العنكبوت: 67)وهو ما قررته سورة آل عمران:(إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا) (آل عمران: 96 ـ 97).
إن ما يمكن استخلاصه من مشهد الأمن بعد الخوف الذي أكدته كل الآيات السالفة أن مفتاح تحقيق الأمن وقوامه هو ما جاء في سورة البقرة: (مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)، وكذا ما ذكر في سورة إبراهيم: (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَام). وعند الحديث عن مدخل الإيمان نستحضر محدد العمل الصالح، وما يرتبط بها من قيم التوحيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستباق الخيرات.
- مشهد الأمن بعد الخوف في تجربة قريش
وصف الله نعمة الأمن الذي أنعم به على البيت الحرام بأنه آيةٌ من الآيات البينات؛ أي علامة ظاهرة، ودلالة بينة، وشاهدة للناس إلى يوم القيامة بوجوب شكر الله تعالى عليها ، قال تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِي.، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين) (آل عمران: 96-97).
ولأهمية الأمنقد امتنَّ الله عز وجل على قريش بهذه النعمة، فقال عزَّ من قائل: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) (العنكبوت:67). ولأهميته كذلك وعد عباده المؤمنين إن هم أقاموا شرعه أن يُبدِلَهم من بعد الخوف أمنًا.
هذا الخوف جعله الله عز وجل ابتلاءً واختبارًا لعباده المؤمنين؛ ليكون الأمن منه جزاء نجاحهم في الاختبار؛ قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) (البقرة:155).
وقد امتنّ الله تعالى على قريش بأن أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد(32)، ومن دخله كان آمنا، فهم في آمان عظيم، والأعراب حولهم ينهب بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، ومع ذلك كان شكرهم لهذه النعمة أن أشركوا بالله وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد(33)، فقال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُون) (العنكبوت: 67).
وقد خصهم بنعمة الأمن العظيمة في أوطانهم وطرق تجارتهم في الشتاء والصيف، قال الله تعالى: (لإِيلاَفِ قُرَيْش. إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْت. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْف) (قريش: 1-4)، قال صاحب الكشاف: "دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط؛ لأن المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم، أي أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة"(34)، يقصد نعمة الأمن بعد الخوف.
وقال ابن عاشور: "أجري وصف الرب بطريقة الموصول الذي أطعمهم من جوع؛ لما يؤذن به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير التجارة لهم، وذلك مما جعلهم أهل ثراء، وهما نعمة إطعامهم وأمنهم. وهذه إشارة إلى ما يسر لهم... من سعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم، كذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة... فتأتيهم فيها الأرزاق ويتسع العيش، وإشارة إلى ما ألقي في نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف، وتلك دعوة إبراهيمعليه السلام، إذ قال عز وجل:(رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات)"(35)
إن سورة قريش تحمل دلالة فريدة وصريحة في الآننفسه لمشهد الأمن بعد الخوف، وذلك لأن "(مِنْ) الداخلة على (جوع) وعلى (خوف) معناها البدلية؛ أي: أطعمهم بدلاً من الجوع وآمنهم بدلاً من الخوف. ومعنى البدلية هو أن حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع. فإطعامهم بدل من الجوع الذي تقتضيه البلاد، وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل بأس... فجعل الله لهم الأمن في الحرم، عوضاً عن الخوف الذي تقتضيه قلتهم قال تعالى:(أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم).
وتنكير (جوع) و(خوف) للنوعية لا للتعظيم؛ إذ لم يحل بهم جوع وخوف من قبل، قال مساور بن هند في هجاء بني أسد:
زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف
أولئك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا"(36)
إن للأمن أثرًا كبيرًا على استقرار البلاد والعباد وحسن معايشهم ومن تدبَّر في آي القرآن وجد تلازمًا وثيقًا في عدد من آياته بين الأمن ورغد العيش من جهة، وبين الخوف والجوع من جهةٍ أخرى.
ولما كان الأمن من آثار الإيمان بالله ورسوله، بين الله تعالى في مشهد القرية أن زوال هذه النعمة يكون بزوال سببها، قال تعالى:(وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُون) (النحل: 112).
وقد جعل القرآن مثل القرية موصوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل، وليكون ذلك تنبيها للمؤمنين إلى المنظومة الأساسية للعيش الرغيد والسعادة الحقيقية للمجتمع المطمئن المستقر، قال تعالى: (كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) ثلاث صفات كل واحدة منها ركن ركين لا بد منه في كل مجتمع: الأمن من الخوف، والاستقرار في الأرض وراحة البال، ووفرة العيش وتيسره، "وقدم الأمن على الطمأنينة؛ لأنها لا تحصل دونه، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق"(37).
......
المراجع والمصادر:
-
معجم مقاييس اللغة، باب الهمزة والميم وما بعدهما في الثلاثي.
-
تاج العروس (أمن)
-
القاموس المحيط (أمن).
-
العين، وفي الحديث الشريف: "النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم، أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد". رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري.
-
الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (الخوف).
-
المفردات في غريب القرآن،الراغب الاصفهاني، دار العلم الدار الشامية، كتاب الألف.
-
البحر المحيط، لأبي حيان، 2/68.
-
نظم الدرر، للبقاعي، 3/577.
-
فيض القدير، المناوي، ص94.
-
التعريفات، للجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت،
ط: 2، 1992، باب الألف. -
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 6/246.
-
مفهوم الأمن في القرآن الكريم، الشاهد البوشيخي.
-
الوجوه والنظائر، لأبي هلال العسكري، مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 2007،
الباب السابع: فيما جاء من الوجوه والنظائر وفي أوله خاء. -
المرجع السابق.
-
المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني.
-
التعريفات، للجرجاني، ص: 55.
-
الكليات، للكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة،
بيروت، ط:2، 1998، ص: 187. -
سنن أبي داود: باب في الاستعاذة، رقم الحديث: 1549.
-
سنن ابن ماجه: الزهد، رقم الحديث:4141.
-
مفاتيح الغيب، للإمام الرازي، تقديم وتحقيق وتعليق: هاني الحاج وكمال زكي
البارودي 15/ 112. -
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/684.
-
فتح القدير، الشوكاني،5/597.
-
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، دار القلم، دمشق 11/
117. -
التحرير والتنوير، لابن عاشور، طبعة دار سحنون، د.ت، 19/287.
-
التحرير والتنوير 19/283.
-
التحرير والتنوير، 19/ 284.
-
التحرير والتنوير 19/ 284.
-
ذلك لأن العرب كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يجئ
بخير، وأنه يحدث نفسه بأمر سوء. -
انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل
من فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي، ط
1429هـ/2008م، 11/7091. -
انظر التحرير والتنوير، لابن عاشور، 1/715.
-
العاكف: المقيم فيه والملازم له، الباد: الواصل إليه من البادية، انظر: فتح
القدير، الشوكاني، دار الفكر، بيروت 3/ 446،وراجع، معاني القرآن وإعرابه،
للزجاج، طبع عالم الكتب،3/421. -
تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، 3/422.
-
الكشاف للزمخشري، طبع مكتبة العبيكان، 5/435.
-
التحرير والتنوير، لابن عاشور، 31/ 561.
-
نفس المصدر، 31/ 561-562.
-
التحرير والتنوير، 14/305.