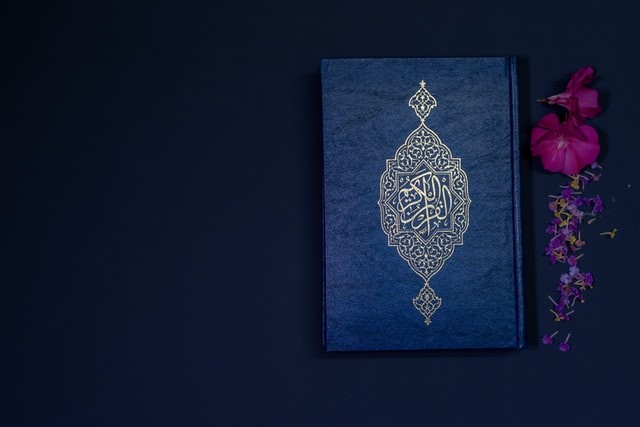محمد الناصري
مما لا شك فيه أن المسألة التاريخية من أكثر الموضوعات التي حفل بها القرآن الكريم، فالقرآن الكريم دائما يوجه أنظار قارئيه إلى استنطاق التاريخ واستقراء الحوادث، ومحاولة فهم هذه الحوادث فهما يمكّن من معرفة حركة الوجود وطبائع الحياة، وسنن العمران وأسباب الاستخلاف وسبل التحضر.
فثمة حقيقةٌ أساسية تبرز واضحة في القرآن الكريم، هي أن مساحة كبيرة من سوره وآياته قد خصصت للمسألة التاريخية التي تأخذ أبعاداً واتجاهاتٍ مختلفة، وتندرج بين العرض المباشر والسرد القصصي لتجارب عدد من الجماعات البشرية، وبين استخلاص يتميز بالتركيز والكثافة للسنن التاريخية التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكان...وتبلغ هذه المسألة حدا من الثقل والاتساع في القرآن الكريم، بحيث إن جل سوره لا تكاد تخلو من عرض لواقعة تاريخية، أو إشارة سريعة لحدث ما، أو تأكيد على قانون أو سنة تتشكل بموجبهما حركة التاريخ(1). مما يمكن القول معه: إن القرآن الكريمهـو مصدر وعي تاريخي للإنسان؛ فهو الذي أثار الرغبة في الاطلاع والتشوف إلى التعرف على أحوال الأمم السابقة، وسبب سقوطها، وسنن التداول الحضاري، حتى إنه لم يدع الإنسان أمام هـذا الغيب المجهول المحرم على حواسه؛ بل قدم له مساحاتٍ كبيرةلقصص السابقين قبل اختراع الكتابة وتدوين التاريخ، غطى فيها جميع جوانب النشاط البشري العبادي والفكري والسياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي، بما يمكن أن نطلق عليه اليوم التاريخ الحضاري، وامتد إلى أنباء الغيب، والغيب هـنا يعني الماضي الغائب عن ساحة المعرفة والشهود.
لقد امتد الوحي في رؤيته التاريخية إلى مرحلة بدء الفعل التاريخي، وحض على النظر في كيفية بدء الخلق،قال تعالى: "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْق"(2). كما غطى الكثير من المساحات المجهولة للإنسان، وعلى الأخص في مرحلة ما قبل الكتابة، وامتد بملامح الرؤية التاريخية لتشمل الماضي والحاضر والمستقبل، إلى درجة يمكن القول معها: إنالقرآن يُعدّ-بهذا المعنى الوثائقي (وليس الديني فقط)- أقدم وثيقة تاريخية وردت بطريق علمي صحيح بمعايير البشر، لذلك نرى أن القرآن يشكل مصدرًا تاريخيًا للكثير من العقائد والأديان والأقوام والمواقع الجغرافية على خارطة الزمن الطويلة؛ حيث لا توجد وثائق معتمدة تغطي هـذه الفترات التاريخية.(3)
وعليه فالقرآن الكريم هـو مصدر المعرفة التاريخية(4)، ومصدر الوعي التاريخي في وقت واحد، خاصة وأنه طلب التوغل في التاريخ، ودعا إلى السير فيالأرض، ولفت النظر إلى أهمية الاتعاظ بأحوال الأمم السابقة، وأتى على نماذج منها، مما دفع الإنسان المسلم للبحث والتنقيب التاريخي لمعرفة هـذه الأحوال، والخروج من عهدة التكليف الشرعي بتحقيق العظة والعبرة والوقاية الحضارية، قال تعالى: " قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين. هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِين"(5) ، وقال:" لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ"(6) ، وقال: " وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هـَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للمؤمنين(7)، حتى إن القرآن قد جعل المعرفة التاريخية ومسالك الأنبياء مع أقوامهم مصدر تبين واهتداء، ومنهج اقتداء للموحى إليه: " أُولَئِكَ الَّذِينَ هـَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ"(8)، ولئن كانت هـذه المحركات للنزوع التاريخي بالنسبة للموحى إليه المستغني عنها بالوحي، فهي بالنسبة للمسلم المسترشد بالوحي -بعد توقفه- أشد لزوما(9)
- القرآن الكريم والتاريخ الإنساني:
يملك القرآنُ الكريم تصوراً للتاريخ يعتمد على ثلاثة عناصر: الزمان، والمكان، والفكرة. أمّا الزمان فينقسم إلى ثلاثة أقسام: الزمان ما قبل التاريخ أو ما فوق التاريخ، والزمان الطبيعي، والزمان التاريخي. وأَقصِدُ بالزمان ما فوق التاريخ ما يذكُرُهُ القرآنُ الكريم من خطاباتٍ وإشاراتٍ وقَصص عن عوالم الملائكة والجنّ، وعن آدم في الجنّة، وعن الجنة والنار، وعن القيامة والمصائر الكونية والإنسانية في ظلِّها. وهو "ما فوق التاريخ"؛ لأنه لا يرتبط بحقبةٍ معيَّنةٍ، كما أنه لا يرتبطُ بالمكان, فالزمانُ الإنساني حالةٌ أو عددٌ أو خطابٌ يتحدد بالمكان، وليس الأمرُ كذلك في الخطابات القرآنية بشأن العوالم أو الذوات أو الأشياء الأُخرى؛ بيد أنّ هذه "الزمانيات" التي تحدث ما قبل الزمان الإنساني أو ما بعده لا يُحكَمُ عليها بالصحة أو عدمِها من طريق مدى ارتباطها بالمكان؛ لأنها في الأصل غير مكانية، وإنّما تتجلَّى أهميتُها في التصورات الكلية التي تُريدُ تثبيتَها فيما يتعلَّقُ بالكون وقدرة الله عزَّ وجلَّ، كما تتجلَّى تلك الأهميةُ في الفكرة التي تريد تثبيتها عن خَلْق الإنسان ومصائره ووظيفته في هذا العالم. وهكذا فالزمان ما فوق التاريخي -أو ما قبل التاريخي- يقوم على الغائية، ويملك وظائف تصوُّرية وأُخرى تفسيرية، ولكلا الأمرين أبعادٌ رمزيةٌ كبرى. وأما النوعُ الثاني من الزمان في القرآن فهو الزمانُ الطبيعي، وهو يظهرُ في النصوص التي تتحدث عن خَلْق العالَم والإنسان، وهي متصلةٌ بفيزياء العالَم وبيولوجيا الكائنات, وهي طبيعيةٌ وليست تاريخية رغم حدوثها في هذا العالم؛ لاستنادها إلى قوانين ثابتة تضمنُها قدرة الله -عزَّ وجلَّ- وإرادتُه، ولا مدخل للإنسان في كينونتها الأُولى، وإن أثَّر المكانُ وأثَّر الإنسانُ في مراحلها التطورية. هذا النوعُ من الزمان تاريخيٌّ بالمعنى العامّ؛ لأنّ لمحتوياته بدايةً، كما أنه قابلٌ للدراسة والتفحُّص بالمعنى العلميّ لذلك. ورغم ظهوره وإدراكه بالحواس وخضوعه للاختبار؛ فإنّ القصْد القرآنيَّ ليس تتبُّع فسيولوجياته أو كيميائياته (كما يعتقد باحثو الإعجاز العلمي)؛ بل -كما فهم المسلمونالأوائل- الاستدلال على وجود الله وقدرته وإحكام صناعة الخَلْق. أمّا النوع الثالثُ من الزمان -وهو الذي سميتُهُ الزمان التاريخي- فهو يحدث في المكان، وهو يتضمن وقائع محدَّدة(دعوات الأنبياء، ومسالك الأُمَم إزاءها). والقرآن في هذا الصدد واضحٌ لجهتين: القَصَص المتعلّق بالنبوات والأُمم، وضرورة إفادة النبي والمسلمين منها بالإقبال على اعتناق دعوة النبي لكيلا يصيب المسلمين ما أصاب الذين خالفوا دعوات أنبيائهم.
والقرآنُ -بوصفه كتاباً دينياً- يرى العالَمَ في هذا الإطار؛ أي أنه صراعٌ بين الخير والشرّ، وبين الحق والباطل، ولسوف ينتصر الخير بالتأكيد إذا أفاد مُعاصرو دعوة النبي من الماضي وتاريخ الدعوات، وإذا ما التزموا بالمبادئ الكبرى للدعوة. ولذا فإنّ القرآن يذكر على سبيل المثال وقْعة بدر، وكيف وفَّق الله المسلمين لكسْبها، كما يذكر وقعة حنين، وكيف كاد المسلمون يخسرون لولا رحمةُ الله بهم؛ في حين كانت هزيمةُ أُحُدٍ درساً لمّا لم يتبعوا إرشادات نبيهم، ما كان منها عاماً وما كان منها خاصاًّ بترتيبات القتال. وهكذا فالزمان التاريخي في القرآن له ركيزتان: ارتباط الزمان بالمكان، وارتباطه بالفكرة أو الدعوة؛ بمعنى أنّ النصّ القرآنيَّ لهذه الجهة إنما يؤرّخ لمصائر الدعوة الدينية في التاريخ. والدعوةُ هذه هي دعوةٌ مهدويةٌ؛ أي أنها تتقصَّدُ دَفْعَ الناس والزمان والمكان باتجاه الهداية التي يترتب عليها عُمرانُ العالَم وازدهارُه، كما تترتّب عليها مصائرُ أديانٍ وأُمَم؛ إذ ينتصر المستضعَفون وينهزمُ المستكبرون، وتقوم علاقاتٌ مع "أهل الكتاب" تبعاً للكلمة السواء التي دعاهم النبي والمسلمون إليها. فالتاريخُ بهذا المعنى -وإن بدا في صورة تكرار: دعوة، فرفض، فهلاك. أو دعوة، فقبول، فانحراف أو تحريف- يبقى شديد الحيوية؛ ومن هنا تأتي قُدسية هذا التاريخ: أنه مهدويٌّ وغائيٌّ(10).
هذه القدسية-أي قدسيةفكرة التاريخ في القرآن الكريم- تقوم على أن للتاريخ معنى أخلاقياً وروحياً مؤسساً على علاقة الألوهية الحقة بالكون، ودور الإنسان فيه، وذلك بوصفه خليفة الله في أرضه. وكثيرٌ من النصوص القرآنية تؤكد هذا المعنى في مناسبات مختلفة، فهي تحضّ الإنسان على الإقبال على الحياة والعمل؛ ولكنها تحذره في الوقت نفسه من غرور يتهدده؛ فيكون مصيره الهلاك؛ كما حدث لكثير من الأمم من قبل؛تصديقاً لقول الحق سبحانه وتعالى: "سنّة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً "(11)، "فهل ينظرون إلا سنة الأوّلين فلن تجد لسنّة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا "(12)
ولعل الذي يضفي طابعاً من التفرد والموضوعية الحضارية على فكرة التاريخ في القرآن الكريم هو أنه ينبثق عن رؤية الله، وهي تختلف عن الرؤية الوضعية؛ وذلك لأنها تحيط علماً بوقائع التاريخ، بأبعادها الزمنية الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، وببعدها الرابع، الذي يغيب كثيراً عن ذهن الإنسان مهما كان على درجة من البصيرة والذكاء؛إنه البعد الذي يغور في أعماق النفس البشرية فيلامس فطرة الإنسان وتركيبه الذاتي، والحركة الدائمة في كيانه الباطني، ويتسرب بعيداً صوب اهتزازاته العقلية والوجدانية، وإرادته المستقلة، وما تؤول إليه هذه جميعاً من معطيات تمنح حركة التاريخ أبعادها الحقيقية، ويمتد - كذلك - لكي يشتبك في العلاقات الشاملة للمصير؛ ذلك أنها رؤية الذات الإلهية التي وسعت كل شيء علماً، ولهذا صنعت الواقعة التاريخية ووضعتها في مكانها الطبيعي من خارطة التاريخ البشري والكوني على السواء، ولكن الرؤية الوضعية تمتد إلى الماضي لتقتبس منه، وتختار ما يعزز وجهات نظرها المسبقة، والرؤية القرآنية تحيط بالماضي لكي تكثفه في قواعد وسنن تُطرح أمام كل باحث في التاريخ يسعى إلى فهمه، وإلى أن يرسم على ضوء هذا الفهم، طرائق حياته الحاضرة والمستقبلة، على أساس أن الأزمان الثلاثة إنما هي وحدة حيوية تحكمها قوانين واحدة كتلك التي تحكم الحياة سواء بسواء(13).
فالقرآن الكريم يقدم أصول منهج متكامل في التعامل مع التاريخ البشري، والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب إلى محاولة استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية التاريخية(14).لذلك أصبح التاريخ في القرآن الكريم مصدرًا للعظة والعبرة التي يجب أن يتلمسها الإنسان في أخبار الأمم الماضية في تدبر وإمعان .
يقول الله تعالى: " فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"(15). ودعوة القرآن الكريم إلى التأمل والتفكر في آثار الأمم والحضارات هـي دعوة للمؤمنين بتجنب المصير ذاته، فإنه يضع سننًا وقواعد في الحياة، بمراعاتها تستمر الحضارات وتزدهر المجتمعات، ويعيش الناس في أمن ودعة وسلام. أما الانحراف والعزوف عنها وإهمالها أو تجاهلها، فسيؤدي إلى كارثة تحل بتلك الحضارات لا محالة(16)
وهذا الفهم هو ما سجله ابن خلدون في مقدمته، فأعطى بذلك الإشارة لغيره من فلاسفة التاريخ، الذين ما تلقوا إشاراته تلك وبنوا عليها إلا بعد انقضاء عدة قرون(17).لقد أفاد ابن خلدون من منطق القرآن فيما نص عليه من سنن في تاريخ الأقوام والشعوب أو تاريخ الاجتماع الإنساني في بلورة نظريته الاجتماعية. وإذا كان ابن خلدون قد قام برصد السنن من خلال حركة التاريخ أو مجرياته وأحداثه؛ فإنه قد فعل ذلك لأن التاريخ هو المعرض الطبيعي لهذه السنن. والسنن تعدُّمحور مقدمة أو نظرية ابن خلدون؛ ولا نعتقد أن محور هذه النظرية هو العصبية أو الدولة أو البداوة والحضارة وما يقع بينهما من صراع، كما اعتقد كثير من النقاد والباحثين؛ لأن حديث ابن خلدون عن هذه المحاور الثلاثة إنما جاء في سياق حديثه عن سنن الاجتماع أو العمران البشري؛ أي أن هذه السنن انطوت على هذه المحاور جميعا، ومن هنا، فإن لنا أن نقول: إن القضية المحورية في مقدمة ابن خلدون أو إن نظريته هي السنن(18).
إن ما سطره ابن خلدون فيما يرتبط بقضية السنن عائد بالأساس إلى إفادته الكبيرة من القرآن الكريم؛ حيث إن السنن تأتيفي القرآن الكريم مرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفته؛ على أساس أن القرآن الكريم كتاب هداية وعملية تغيير، وإخراج للناس من الظلمات إلى النور .
ب) القرآن الكريم: مناهج المراجعة وسنن الاستبدال
قد لا يكون مستغربا-بعد أن أشرنا إلى أهمية التاريخ وبُعده الحضاري ودور الإنسان في صناعته- أن يجعل القرآنُ التاريخَ مصدرا للمعرفة، التي تستوعب المعلومة، وتوسع الخبرة، وتصنع الحكمة، وتحقق الموعظة والعبرة، وتغني التجربة، وتؤكد اطراد السنن وفاعليتها، ويستنكر على من يقعدون عن السير في الأرض، والتوغل في التاريخ والاطلاع على الأحوال، ويتعرفون على أسباب التداول الحضاري، بقوله تعالى: "أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم"(19)
فالقرآن الكريم لم يرض للإنسان أن يكون مصورا للواقع، ومسجلا لأحداث التاريخ من الخارج؛ بل لفت نظره إلى أهمية المراجعة والتقويم التاريخي(20)؛ حيث قام القرآن بمراجعة تراث الأنبياء والمرسلين، ومراجعة تراث الأمم السابقة وحضاراتها وثقافاتها، وسائر أطوار نهوضها وتراجعها، ورقيها وصعودها وتخلفها وانهيارها، وفي كل ذلك يبين الأسباب والعوامل والوسائل، وينبه على القواعد الحاكمة في ذلك كله. ومن مكنون القرآن الكريم قدرته التامة على مراجعة تاريخ البشرية من خلال عديد السنن التي حفل بها(21).
وتأتي السنن في القرآن الكريم باعتبارها؛ مجموعة القوانين التي يسير وفقها الوجود كله، وتتحرك بمقتضاها الحياة، وتحكم جزئيتها ومفرداتها، فلا يشذ عنها مخلوق. وما في الكون ذرة أو حركة إلا لها قانون وسنة، فكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات...إلا ولها قانون. وما من كوكب أو نجم، وإلا وله قانون لا إرادي أو لا ذاتي يسير وفقه. وما من حركة نفسية أو اجتماعية أو نقلة حضارية، إلا ولها قانون أيضاً يتجلى في الأسباب والعوامل المؤدية إليها. وبهذا المعنى تنقسم السنن إلى قسمين:
سنن إجبارية تجري على كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان. وذلك كالولادة والموت والحياة وكالأوصاف الخلقية والحالات الفطرية للإنسان وكل ما في عالم الغيب بما اختصت به القدرة والمشيئة الإلهية من الأمور التي لا طاقة للإنسان بها.
سنن اختيارية: وهي القائمة على مستوى إرادة الإنسان الداخلة في دائرة القدرة الإنسانية(22). وهذا النوع من السنن هو أساس نجاح الإنسان أو فشله في المشروع الاستخلافي الموكل له بوصفه خليفة لله سبحانه وتعالى، بتعبير آخر، فالإنسان لن يحقق مشروع الاستخلاف كما ارتضاه الله، ولن يبني الحضارة والعمران المنشود، إلا عن طريق فهمه للسنن الإلهية وتسخيرها، ومنذ تلك اللحظة أصبحت السنن هي القانون الوجودي والكوني والتاريخي الذي يحكم عمران الإنسان واستخلافه(23).
وعلى هذا الأساس يتضح أن مفهوم السنن يشكل بُعدا محوريا في فهم حقيقة الإنسان، وحقيقة وظيفته الاستخلافية في هذا الكون، ومنهجا لنقد وتقويم ومراجعةأحداث التاريخ ووقائعه، وفق قوانين مطردة لا تعرف التغير ولا التبدل، كما يصرح القرآن الكريم في قوله تعالى: " سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا"(24).
وقد أكد ابن خلدون-في معرض حديثه عن التاريخ والعمران وسننه- كيف أن العالم والبشر محكمون بهذه السنن الثابتة والمطردة، وخاضعون لها بشكل صارم ودقيق في تقلباتهم وأحوالهم وما يعرض لهم من الاختلافات عبر الزمن فهو يقول: "إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر؛ إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سنة الله التي قد خلت في عباده"(25).
وفي السياق ذاته وتأكيدا للمعنى نفسه يقول محمد عبده: " فمما جاء في الكتاب العزيز مقررا لهذا الأصل:
"قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين"، "سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا""فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا"، "أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم".في هذا يصرح الكتاب أن لله في الأمم والأكوان سننا لا تتبدل والسنن: الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حسبها تكون الآثار، وهي التي تسمى شرائع أو نواميس، ويعبر عنها قوم بالقوانين. ما لنا ولاختلاف العبارات؟ الذي ينادي به الكتاب أن نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل، وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماع أن ينظر في أصول هذا النظام؛ حتى يرد إليها أعماله، ويبني عليها سيرته وما يأخذ به نفسه. فإن غفل عن ذلك غافل فلا ينتظرن إلا الشقاء، وإن ارتفع إلى الصالحين نسبه، أو اتصل بالمقربين سببه. فمهما بحث الناظر وفكر، وكشف وقرر، وأتى لنا بأحكام تلك السنن، فهو يجري مع طبيعة الدين، وطبيعة الدين لا تتجافى عنه، ولا تنفر منه، فلم لا يعظم تسامحها معه؟(26)
في فلسفة سنن الاستبدال:
تأسيسا على هذه الرؤية يُعدُّ مفهوم السنن منهجاً من مناهج المراجعات التي تأسست عليها الرؤية القرآنية للحياة والوجود والإنسانوالتاريخ؛إذ يمثل القرآن الكريم الإطار العظيم الذي تجمعت فيه سنن الحياة التي لن تتغير ولن تتبدل، ومن أعظم هذه السنن سنةُالاستبدال.
وعمل هذه السنة يقتضي أنه إذا لم يقم الإنسان المستخلف -أفراداًوجماعاتٍ- بواجبه الديني والأخلاقي؛فإن الله عز وجل يستبدله، ويأتي بغيره، يكون هذا المستخاَفقادراً على الوفاء بواجبه الاستخلافي، وهذا ظاهر صراحة في قوله عز وجل: "وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ"(27).
ولا يعني الاستبدال الإبادة وهلاك الاستئصال للأفراد؛ بل قد يحدث أن تتحلل المجتمعات وتنهار قوى الأمم، ويمحى أثرها الاجتماعي والسياسي في حياة الناس القائمة، ومع ذلك فإن عدد أفرادها ونسبة سكان مجتمعات هذه الأمة لا تتغير بل قد يزيد، ويحتفظ كل فرد بغريزة حب البقاء والعيش في جماعة أكثر من ذي قبل، وبهذا يغدو هؤلاء الأفراد أنقاضا ومعالم كيان إنساني باهث وواقع حضاري آفل(28).
وإذا كان من معاني الاستبدال زوال سلطة الأمة وسلطانها وضياع رسالتها في تاريخ البشرية وواقع الإنسانية، دون ذهاب أو هلاك أفرادها وشعوبها؛ فإن القرآن الكريم قد ذكر عددا من الآيات التي تبين هذه السنة؛ أي قيام دول وحضارات تأخذ بزمام القيادة الإنسانية الحضارية بدل أو مكان تلك الأمم الذاهبة، ومن ذلك قوله تعالى: "وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين"(29)، وقد أكد القرآن الكريم أن استبدال أمة ونشأة أخرى ليس عبثا؛ ولكنها سنة الله في الأمم لتجدد الحياة الحضارية وتداولها بين البشر ليستمر العالم وتستمر الحياة، وإن هذا كله قد مضى سنناً في الأمم الخالية؛ قال تعالى: "إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين"(30). وبهذا فالاستبدال سنة من سنن الله في الاجتماع البشري، وهذا الاستبدال يكون مبنيا على أعمال الناس، ولا يكون لفريق دون آخر جزافا، إنما يكون لمن عرف أسبابه ولم يتجنبها(31).
وقد تعرضت ثلاث آيات قرآنية إلى أسباب الاستبدال وهذه الآيات هي:
- قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"(32).
فالله عزوجل يقول مخبرا عن قدرته العظيمة بأن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته؛ فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم"، وقال تعالى: "إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين "،وقال تعالى: "إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز" أي: بممتنع ولا صعب. وقال تعالى هاهنا:"يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه" أي: يرجع عن الحق إلى الباطل(33).
فالارتداد عن دين الله يوجب الاستبدال، والأصل في هذا الاستبدال استبدال قومٍ غير صالحين بقومٍ صالحين،حدد القرآن الكريم صفات أولئك الصالحين في ست؛ الأولى: أنه تعالى يحبهم، الثانية: أنهم يحبون الله تعالى الصفتان الثالثة والرابعة: الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين،الصفة الخامسة:الجهاد في سبيل الله. الصفة السادسة: كونهم لا يخافون في الله لومة لائم.والصفات الست هذه فضلٌ الله يعطيه من يشاء من عباده، فيفضلون غيرهم به، وبما يترتب عليه من الأعمال، وأن مشيئة الله سبحانه، لمثل هذا الفضل، تجري بحسب سنته التي أقام بها أمر النظام في خلقه، فمنهم الكسب والعمل النفسي والبدني، ومنه سبحانه آلات الكسب والقوى البدنية والعقلية، والتوفيق والهداية الخاصة، واللطف والمعونة"والله سميع عليم"فلا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن فضله ومنته، وما يقتضيه من شكره وعبادته(34).
- قوله تعالى:"هَا أَنتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ"(35).
هذه الآية بينت سببا آخر للاستبدال، وهو ترك تعاليم الله وشريعته، ومنها الإنفاق في سبيل الله، وقد ذهب صاحب (الكشاف) إلى أن معنى قوله تعالى: "يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ" أي: يستبدل قوما غيركم، يخلق قوما سواكم على خلاف صفتكم راغبين في الإيمان والتقوى، غير متولين عنهما"(36) وإلى المعنى نفسهذهب صاحب (التحرير والتنوير)؛ إذ جاء فيه: "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم" عطف على قوله: "وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم" والتولِّي: الرجوع، واستُعير هنا لاستبدال الإيمان بالكفر، ولذلك جعل جزاؤه استبدال قوم غيرهم كما استبدلوا دين الله بدين الشرك. والاستبدال: التبديل، فالسين والتاء للمبالغة، ومفعوله قوما. والمستبدل به محذوف دل على تقديره قوله "غيركم" ، فعلم أن المستبدل به هو ما أضيف إليه (غير) لتعين انحصار الاستبدال في شيئين، فإذا ذكر أحدهما علم الآخر. والتقدير: يستبدل قوما بكم لأن المستعمل في فعل الاستبدال والتبديل أن يكون المفعول هو المعوض ومجرور الباء هو العوض كقوله: " أتستبدلونالذيهو أدنى بالذي هو خير" والمعنى: يتخذ قوما غيركم للإيمان والتقوى، وهذا لا يقتضي أن الله لا يوجد قوما آخرين إلا عند ارتداد المخاطبين، بل المراد: أنكم إن ارتددتم عن الدين كان لله قوم من المؤمنين لا يرتدون، وكان لله قوم يدخلون في الإيمان ولا يرتدون (37).
ج) قوله تعالى: "إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"(38)،تطرقت هذه الآية إلى سبب مهم للاستبدال وهو ترك جهاد أعداء الله، فالله عز وجل يبين سخطهالعظيم على المتثاقلين; حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدارين، وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوما آخرين خيرا منهم وأطوع، وأنه غني عنهم في نصرة دينه، لا يقدح تثاقلهم فيها شيئا(39).فالمقصود تهديدهم بأنهم إن تقاعدوا عن النفير هاجمهم الأعداء في ديارهم فاستأصلوهم وأتى الله بقوم غيرهم .
هذه أسباب ثلاثة للاستبدال، فما إن تبلغ أمة من الأمم درجة من التقدم والرقي المادي وتطمئن لذاتها وتعجب بحالها وتنسى أساسيات الحياة ومقومات البقاء والاستمرار؛ حتى يداهمها بأس الله ويحل بها سخطه بسبب هذه العوامل الداخلية ذاتها. ولكي تستأنف الإنسانية رسالتها وتحافظ على جنسها ونوعها البشري، فإن الله من رحمته لا يعمم الفساد في الإنسانية حتى لا يعم الهلاك، وتبقى القلة على ما هي عليه لكيتكون فرصة استبدال قوم بقوم وأمة بأمة(40)
وترتبط بسنة الاستبدال سنة التداول بين الأمم المنصوص عليها في قوله تعالى: "وتلك الأيام نداولها بين الناس"(41). والأيام: جمع يوم وهو في أصل اللغة بمعنى الزمن والوقت، فالمراد بالأيام هنا أزمنة الظفر والفوز. ونداولها بينهم: نصرفها فتكون تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء. فالمداولة بمعنى المعاورة، يقال: داولت الشيء بينهم فتداولوا، تكون الدولة فيه لهؤلاء مرة وهؤلاء مرة، ودالت الأيام: دارت، والمعنى أن مداولة الأيام سنة من سنن الله في الاجتماع البشري، فلا غرو أن تكون الدولة مرة للمبطل ومرة للمحق؛ وإنما المضمون لصاحب الحق أن تكون العاقبة له؛ وإنما الأعمال بالخواتيم.
وسنة المداولة سنة من سنن الاستبدال؛ فهي قاعدة كقاعدة "قد خلت من قبلكم سنن" ،وهي ظاهرة بين الناس بصرف النظر عن المحقين والمبطلين، والمداولة في الواقع تكون مبنية على أعمال الناس؛ فلا تكون الدولة لفريق دون آخر جزافا؛ وإنما تكون لمن عرف أسبابها ورعاها حق رعايتها؛ أي إذا علمتم أن ذلك سنة فعليكم ألا تهنوا وتضعفوا بما أصابكم؛ لأنكم تعلمون أن الدولة تدول. والعبارة تومئ إلى شيء مطوي كان معلوما لهم، وهو أن لكل دولة سببا، فكأنه قال: إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التي تفضي إليها كالاجتماع والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة وأخذ الأُهبة وإعداد ما يستطاع من القوة؛ فعليكم أن تقوموا بهذه الأعمال وتحكموها أتم الإحكام . وفي الجملة من الإيجاز وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة ما لا يعهد مثله في غير القرآن (42)
ولقد خضعت آية المداولة لتفسيرات كثيرة واجتهادات عديدة في دراسة حركة التاريخ وتفسير الدورات الحضارية،وشأن هذه الآية شأن كثير من الآيات الأخرى كالآية الثانية عشرة من سورة الرعد(43)، التي اتخذت قاعدة في تفسير وتعليل التغيير الاجتماعي، والآية الثانية والخمسين من سورة فصلت(44) التي اتخذت قاعدة في تفسير الإبداع من خلال القرآن الكريم.
وآية المداولة أو التداول تقف في الأحكام القرآنية على تعليل قضية من أكبر قضايا أبحاث التاريخ؛ وهي قضية الدورات الحضارية، فهي تلخص في ألفاظها القليلة قصة التاريخ الإنساني والتطور الاجتماعي منذ بدء الخليقة. ولعل هذا التعاقب والتداول الحضاري بين الأمم يوحي بأكثر من معنى أو تُستنبط منه سننٌ وقوانين كثيرة؛ منها أن لكل حضارة أجلاً محددًا، ولا تستبدل أية حضارة أو تسقط حتى تستنفذ مبررات بقائها على يد الإنسان صانعها الأول، ويصبح لزاما أن تقوم حضارة أخرى. والشواهد على تفسير ظاهرة أو قضية التداول والاستبدال الحضاري كثيرة في القرآن الكريم(45).
على سبيل الختم:
إن القرآن حين يعرض المسألة التاريخية في ارتباط بمسألة السنن لا يتحدث عن مجموعة سنن مجزَّأة ومعزولٍ بعضُها عن بعض، بل على العكس تماما، فهو يعرضها وحدة كلية مرتبطاً بعضُها ببعضٍ أشد الارتباط. والقرآن يعرض كلا متناسقا من السنن المتفاعلة والمتداخلة، التي لا يمكن أن تفهم إلا بدراستها المتداخلة والمتكاملة، بوصفها شبكة من المعاني والعلائق والروابط والضوابط والمعايير، التي تسمح بتوليد الأفكار واستخراج القوانين التي تساعد الإنسان على اكتشاف هذا النسق المتفاعل والمتكامل من السنن، وتوظيفه في استقراء القوانين التي تحكم الأشياء وصيرورتها، وتسخير هذه السنن والقوانين المستولدة من هذا النسق المتكامل في معالجة المشكلات، ومداواة أمراض العمران والحضارة والإنسان(46).
إن عملية التعامل مع السنن لن تؤتي ثمارها المرجوة على مستوى الفهم والاكتشاف والتسخير، ما لم نكتشف شبكات السنن، وكيف تتشكل في الواقع البشري وتؤثر فيه. ومن هنا فإنه من المطلوب أن تدرس السنن، بوصفها مفهوما حيويا فعالا، له صلة مباشرة بتفاعلات الواقع، وتدافعات الحياة، وصيرورة الأحداث والوقائع، على المستوى الكوني والعمراني(47).
وما أحوجنا اليوم إلى استعادة صرخة محمد عبده في دفاعه عن علم السنن، إذ يقول في تفسير قوله تعالى: "قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين"(48):إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سننا يوجب علينا أن نجعل هذه السنن عِلْما من العلوم المدونة؛ لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه ، فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في خلقه، كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال، وقد بينها العلماء بالتفصيل عملا بإرشاده ، كالتوحيد والأصول والفقه . والعلم بسنن الله - تعالى - من أهم العلوم وأنفعها(49). فهل إسهامات واهتمامات الفكر الإسلامي المعاصر في مستوى الاستجابة لصرخة الإمام؟.
.......
المراجع والمصادر:
-
عماد الدين خليل، حول إعادة تشكيل التاريخ الإسلامي، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط، الأولى، 2005م، ص .60
-
سورة العنكبوت، الآية 20.
-
عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب، المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف، قطر، ع. ستون، رجب 1418هـ، ص 12.
-
إذا خصصنا متن بحثنا للحديث عن معالم الرؤية القرآنية للتاريخ، فهذا لا يعني أن السنة النبوية لم تعن بالمسألة التاريخية، على العكس من ذلك فالسنة النبوية قد انطوت على منظومة خصبة من مفردات المعرفة التاريخية، وهي بهذا تؤكد معطيات القرآن الكريم في مجال التاريخ. انظر، مصطفى محمد طه، تفسير التاريخ الإسلامي بين الموضوعية والذاتية، م. التفاهم، وزارة الأوقاف، سلطنة عمان، شتاء 2014م، ع. الثالث والأربعون، ص 303.
-
سورة آل عمران، الآيتان 137-138
-
سورة يوسف، الآية 111.
-
سورة هود، الآية 120.[1]
-
سورة الأنعام، الآية 90.
-
عمر عبيد حسنة، من مقدمة كتاب المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب، م.س، ص14-15.
-
رضوان السيد، القرآن والتاريخ: الرؤية القرآنية في الأمم والحضارات، م.
التفاهم، وزراة الأوقاف، سلطنة عمان، ع. الثاني والثلاثون، ربيع 2011م،
ص11-13. -
عماد الدين خليل، مقالات إسلامية، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط، الأولى،
2005م، ص 113-114. -
عماد الدين خليل، حول إعادة تشكيل التاريخ الإسلامي، م.س، ص 60.[1]
-
سورة الحج، الآيتان 45-46.
-
سالم أحمد محل، المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب، م.س،
ص 61. -
عماد الدين خليل، حول إعادة تشكيل التاريخ الإسلامي، م.س، ص 60.
-
عدنان زرزور، ابن خلدون وفقه السنن، م. إسلامية المعرفة، المعهد العالمي
للفكر الإسلامي، ع. الخمسون، خريف 1428هـ، ص 16. -
سورة غافر، الآية 82.
-
عمر عبيد حسنة، المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب،م.س،
ص 24. -
طه جابر العلواني، نحو التجديد والاجتهاد: مراجعات في المنظومة المعرفية
الإسلامية، دار تنوير للنشر، القاهرة، ط، الأولى 2008م، ص33. -
محمد هيشور، سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها، المعهد العالمي للفكر
الإسلاميـ القاهرة، ط، الأولى، 1996م، ص 27.[1] -
عبد العزيز برغوت، ملاحظات حول دراسة السنن الإلهية في ضوء المقاربة
الحضارية، م. إسلامية المعرفة، ع. التاسع والأربعون، صيف 2007م، ص
17. -
سورة الإسراء، الآية 77.
-
عبد الرحمن ابنخلدون، المقدمة، دار الفكر، دون تاريخ، دون طبعة، ص 28.
-
محمد عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،
ط، الأولى، 2012م، ص 77 وما بعدها. -
سورة محمد، الآية 38.
-
انظر، مالك بن نبي ميلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعية، ترجمة عبد
الصبور شاهين، دار الفكر، الجزائر، دمشق، ط، الثالثة، 1986. -
سورة الأنبياء، الآية 11.
-
سورة المؤمنون، الآيتان 30-.31
-
محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، دار الكتب
العلمية بيروت، ط، الثانية، 2005م، ج، 4.تفسير الآيتين 137-138 من
سورة آل عمران. -
محمد رشيد رضا، م.س، ج6، تفسير الآية 54 من سورة المائدة.
-
سورة محمد، الآية 38.
-
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف، مكتبة العبيكان،
الرياض، ط، الأولى، 1998م، تفسير الآية 38 من سورة محمد. -
الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، دون تاريخ،
تفسير الآية 38 من سورة محمد.[1] -
سورة التوبة، الآية 39.
-
الزمخشري، تفسير الكشاف، م.س، تفسير الآية 39 من سورة التوبة.
-
محمدهيشور، سنن الله في قيام الحضارات وسقوطها، م.س، ص 282.
-
سورة آل عمران، الآية 140.
-
محمد رشيد رضا، تفسير المنار، م.س، تفسير الآية 140 من سورة آل عمران.
-
وهي قوله تعالى: "ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
-
وهي قوله تعالى: " سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ". -
محمد هيشور، سنن الله في قام الحضارات وسقوطها، م.س، 187
-
عبد العزيز برغوث، ملاحظات حول دراسة السنن في ضوء المقاربة
الحضارية، م.س، ص 44. -
نفسه، ص 45.
-
سورة آل عمران، الآية 137.
-
محمد رشيد رضا، تفسير المنار، م.س، تفسير الآية 137 من سورة آل عمران.