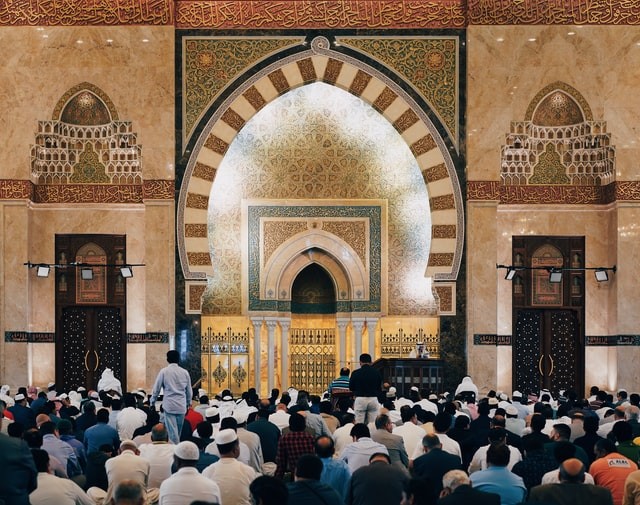رضوان السيد
المعتزلة: التسمية وأصل العدل
درجْتُ في السنوات العشر الماضية -خلال العمل على مسائل القيم وإشكالياتها في مجلتي التسامح والتفاهم الزاهرتين- على قراءة قضايا صفات الله عزّو جلّ لدى المتكلمين المسلمين، والفضائل المتصلة بها بوصفها قيماً تشكّل المنظومة الأخلاقية في القرآن الكريم، وقد رأيت أنّ مداخلها أو فضائلها الرئيسة التي تتفرع عليها اعتباراتٌ سلوكية وسياسية وتنظيمية هي: المساواة، والرحمة والإحسان، والعدل، والمعروف والتعارُف، والخير العام. وما كنتُ الرائد في تصور هذه المصفوفة القيمية، فقد فكّر فيها قبلي الشيخ محمد عبد الله دراز وإيزوتسو وطه عبد الرحمن وآخرون(1)
على أنّ هذا التفكير وردتْ عليه أخيراً إشكالياتٌ كثيرةٌ، أهمُّها اثنان: عدّالأُصوليات الإسلامية أنّ هذا النزوع الأخلاقي في فهم الدين وتفسيره يُنافي الطبيعة العقدية والقانونية والإلزامية للشريعة كُلِّها! والاعتراض الآخر أنّ علم الكلام الإسلامي ذو طبيعةٍ سياسيةٍ غلاّبة. فليس صحيحاً أنّ القائلين بالعدل والتوحيد كان قصدهم تنزيه الله عزّ وجلّ بالدرجة الأُولى، بل القول بالحرية الإنسانية في مواجهة جبرية الأُمويين. أما القائلون بالعناية والرحمة فقد كان قصدهم صرف الأنظار عن مظالم العباد الدنيوية، ونصحهم وتوجيههم باللجوء إلى الله عزّ وجلّ، والتوكُّل عليه، وتصعيد الرجاء في رحمة الله في الآخرة، والانصراف عن الفعالية السياسية ضد الظلم!
ولستُ معنياً هنا بنقد الأُصوليات؛ فلذلك مكانٌ آخر، مع أنّ هذا المنطق داحض؛ فالفقهاء خاضوا جميعاً في مسائل التعليل للحكم الشرعي، وتعقيل الأوامر والأحكام، وقد أوصل ذلك في الحقبة الكلاسيكية إلى مقولة "مقاصد الشريعة" التي ظلت هائلة التأثير حتى الحقب الحديثة والمعاصـرة. ثم من قال: إنّ "الواجـب الأخلاقي" يعني تمييعاً للشريعة وأحكامها! نحن معنيون هنا بالأصول والسِمات الدينية لعلم الكلام. فصحيحٌ أنّ مـباحث مثل القَدَر إثباتاً أو نفياً، ومثـل الكبائر وعلائقها بالإيمان- تأثرت بالأحداث السياسية العاصفة في القرنين الأول والثاني؛. بيد أنّ هذا التأثر كان على سبيل التَبع، أمّا القضيتان الأُوليان في علم العقائد وهما الإيمان والقَدَر-وهما أصلالأُصول في علمالكلام- فإنهما قرآنيتان، وسابقتان على الاختلافين السياسي والديني. والدليل على ذلك أن علم الكلام ما انتهى في القرن الثاني الهجري عندما انفصلت قضاياه بوضوح عن المسائل السياسية، بل استمرّ حتى اليوم، رغم ذهاب كثيرين -بينهم الغزالي وابن خلدون أنه غيرُ مُجدْ أو غير مفيد- أو أنه مُضِرٌّ باعتقادات الناس وأخلاقهم!
العدل والتنزيه
يقول الشهرستاني في (الملل والنحل): " وأمّا العدل فعلى مذهب أهل السنة أنّ الله تعالى عدلٌ في أفعاله، بمعنى أنه متصرفٌ في مُلكه ومِلْكه، يفعل ما يشاءُ، ويَحكم ما يريد؛ فالعدل وضع الشيء في موضعه، وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم، والظلم بضدّه، فلا يُتصوَّرُ منه جَورٌ في الحكم وظُلْمٌ في التصرف. وعلى مذهب أهل الاعتزال(2): العدلُ ما يقتضيه العقلُ منالحكمة، وهو إصدارُ الفعل على وجه الصواب والمصلحة".
إنّ اختلاف المذاهب الكلامية إذن يؤول -في جزءٍ كبيرٍ منه- إلى الاختلاف في دلالات الالفاظ، رغم استخدام المفردات نفسها؛ بيد أنّ قيمة العدل أو صفة العدل إنما تقع في قلب الكلام المعتزلي(3)، فقد سمَّى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والعدلية؛ فقدموا في التسمية -على الأقلّ- هذه الصفة أو القيمة على أصل الأُصول في الدين وهو التوحيد. وقد حاول القاضي عبد الجبار في المحيط بالتكليف، وشرح الأصول الخمسة شرح الأمر بوصفه لفظياً، والتوحيدمقدَّمٌ على العدل عندهم، وهو يعود مرةً أُخرى لإثبات تقدم العدل في الذكر وليس في الاعتبار. يقول القاضي: "والأصـل في ذلك أنّ الذي يلزم العـلمُ به أولاً هو التوحـيد، ويتـرتب عليه العدل لوجهين:
أحدهما: أنّ العلم بالعدل علمٌ بأفعاله تعالى، فلا بُدَّ من تقدم العلم بذاته ليصحَّ أن نتكلم في أفعالـه التي هي كلام في غيـره.
والثاني: "أنّا إنما نسـتدلُّ على العدل بكونه عالماً وغنياً، وذلك من باب التوحيد. فلا بد من تقدم العلم بالتوحيد لينبني العدل عليه". والقاضي -إذ يُدافعُ عن تقديم التوحيد- يُقرُّ بأنّ آخرين من المعتزلة ما يزالون يخالفونه، وهؤلاء لا يقولون بأنّ أهمية العدل آتيةٌ من الأمر الإلهي؛ بل يرون أنّ العدل ذاته ضروريٌّ للتنزيه، ولذا لا حرج في تقديمه.
لكنْ هنا مشكلةٌ بل مشكلتان:
الأُولى: أنّ تعليل الطرفين لموقع العدل المركزي فيالمنظومةالمعتزلية لا يذكر لها أحدٌ سبباً سياسياً كما يقول سائر دارسي المعتزلة في الأزمنة الحديثة كما أنّ هذا التركيز على العدل لا يجعلهم يعدونه صفةً لله عزوجلّ لها انفصالٌ عن الذات، أوأنها مثلاً من صفات الأفعال ( كما يقول الآخرون)؛ بل - هي مثلغيرها من الصفات - مندغمة في الذات حتى لا يتعدد القدماء. في حين رأى معتزلةٌ مبكرون وآخرون من المدرسة البغدادية أنّالحياة والعلم صفتان يمكن إثباتهما أو إضافتهما لله - عز وجلّ - بوصفهما صفتين ضروريتين حتى في الألوهية والتنزيه .
الأستاذ عبد الرحمن بدوي لا يرى أنّ أصل العدل لدى المعتزلة سياسي، بل السياسي هو اسم "المعتزلة" الذي سُمُّوا به تبعاً للمعتزلة الأوائل الذين كانوا محايدين في الحرب الأهلية بين علي ومعاوية(4). فلمّا انقضت تلك الظروف السياسية نسي الناس- ومنهم المعتزلة أنفسهم(!) - أصل التسمية، وعدلوا عنها إلى العدلية وأهل العدل والتوحيد والتسميات الأُخرى؛ لتمييز أنفسهم عن أهل السنة والجماعة،بسبب خلافاتهم اللاهوتية أو الكلامية معهم في القدرة والصفات، وخلق القرآن، والعقل والنقل. وهذا الرأي في الأصل لكارلو نللينو المستشرق الإيطالي الذي ترجم له بدوي مقالةً في ذلك(5).بيد أن المهمَّ هو الاستنتاج الذي يتوصل إليه بدوي بعد النقاش الطويل؛ فليس بصحيح عنده أنّ المعتزلة كانوا في الأصل فرعاً أو استمراراً للقدرية في القرن الأول، وأنّ نقطة بدئهم كانت مذهب الاختيار وحرية الإرادة(6).
المعتزلة إذن لاهوتيون أو متكلمون، وليس استناداً إلى رأي بدوي، بل إلى كلام القاضي عبد الجبار. والعدل إذن هو جزءٌ من التنزيه أو أنه فرعٌ على التوحيد. لكنّ المعتزلة عندما يضعون العدل بهذه المنزلة ثم لا يؤدّي بهم ذلك إلى عدِّه صفةً يجب إثباتُها لله عز وجل؛ فإنهم يقدمون في مبحث العدل مسألة الاستطاعة. فهي سابقةٌ على الفعل كما قالوا، بينما قالت الأشعرية: إنها مقارنةٌ له. فالاستطاعة الحقيقية هي "القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل"، وهي عند القاضي عبد الجبار:" معنىً موجود في الجسم، يصح من العبد الفعل والتصرف بها... ويصح أن يفعل بها الخير والطاعة، كما يمكن أن يفعل بها الشر والمعصية، فلذلك قلنا: إنها مقدَّمةٌ على الفعل"(7). ويقتضي ذلك القول بأنّ العبد "خالقٌ" لأفعاله على الحقيقة. ويذهب الجويني في الإرشاد إلى أنّ المتقدمين منهم ما كانوا يتجرأون على نسبة فعل الخلق إلى العباد، ثم جرؤ المتأخرون(8). والواقع أنّ المتقدمين (من القدرية) كانوا يذهبون إلى أنّ الخير من الله، والشر من العبد، وهذا لا يستقيم عنج المعتزلة؛ لأنّ الاستطاعة سابقةٌ على الفعل، كل فعل سواء أكان خيراً أم شرا؛ فالإنسان عند المعتزلة – بحسب الأشعري-"فاعلٌ ومُحدثٌ ومخترع ومُنشئ على الحقيقة دون المجاز"(9). وإصرار المعتزلة على ذلك ناجم عن تنزيههم لله عز وجل أن يكونَ خالقاً لأفعال العباد ثم يحاسبهم عليها؛ لأنه بذلك يكونُ غير عادل، وهذا مستحيلٌ على الله. أما الآيات القرآنية (مثل: خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون) فيجري تأويلُها أو "ليّ عنقها" كما يقول محمد آيت حمو لتستقيم مع دلالة العقل الذي يحظى بالأسبقية عليها(10)؛ وذلك لأنّ العقل هو "فيصل التفرقة" بين المحكم والمتشابه، وبين الدلالة الظاهرة والأُخرى المعقولة. ولا يجوز عند المعتزلة أن يكون الشيءمقدوراً لقادرَيْن أو قدرتين في الوقت نفسه؛ لأنه يؤدي إلى إمكان وجود الشيء وضده(11). والنتيجة هي بطلانعزْو أفعال العباد إلى الله، ودحض آراء من يزعم إضافتها إليه؛ ذلك أنّ القول بأنّ الله هو المخترع لأفعال العباد يوجب "ألا يستحق أحدٌ من أحدٍ في الشاهد والشكر على ما يأتيه من الإحسان، لأنّ ذلك حادثٌ من قِبَلِ الله تعالى"(12)، ويوجب أيضاً" ألا يستحق الذمَّ على القبيح ممن فعله؛ لأنه المُحِدثُ له دون العبد"(13). والمعتزلة يذهبون إلى ذلك ليس دفاعاً عنحرية الإنسان ومسؤوليته بالدرجة الأولى؛ بل هودفاعٌ عن تنزيه الله عن فعل القبائح والمحظورات، وإنفاذٌ لأصلالوعد والوعيد.وإن لمتكن ظواهر النصوص تؤيده، فينبغي تأويلهاعقلياً؛لأنّ فعله عزّ وجلّ ينبغي أن يتّسم بالحكمة والمعقولية.
والأمر هناك في دحض حجج المجبرة ليس لمنافاته للعدل والتنزيه فقط، بل ولمنافاته أيضاً للأصلالمعتزلي الآخر وهو أصل الوعد والوعيد؛ فالوعد: " كل خبرٍ يتضمن إيصال نفعٍ إلى الغير، أو دفع ضررٍعنه في المستقبل. ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاً، وبين ألا يكون كذلك"(14). أمّا الوعيد عند القاضي عبد الجبار فهو: " كل خبرٍ يتضمن إيصال ضررٍ إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل، ولا فرق بين أن يكونَ حسناً مستحقاً، وبين ألا يكونَ كذلك"(15). وعلةُ ذلك أنه يفعل ما وعد وتوعد به، لا يخلف ولا يكذب في وعده ووعيده؛ لأنه مُنافٍ للحكمة والتنزيه. ولذلك- وفي عودةٍ إلى أصل العدل- لا يتحقق العدل الإلهي إلاّ إذا استوفى شروطاً ثلاثةً وهي: أنه يجب على الله أن يجازي المحسن وأن يعاقب المسيء، وأن يكون الحسن والقبيح ذاتيين في الأفعال، وأن يريد الله صلاح ما فيه العباد، وأن يرى منه ما كان الأصلح(16).
العدل والكسب والعناية والرحمة:
يكون علينا عندما ندرس مسألة العدل في الكلام الأشعري أن نلحظ أمرين اثنين: اختلاف الرؤية والاعتبار في المنظومة الكلامية للأشعرية من جهة، ومن جهةٍ ثانية الطبيعة الجدالية لمذهبهم؛ لأنهم في الأصل انشقاقٌ عن المعتزلة (أبو الحسن الأشعري نفسه). أما الأمر الثالث فهو أنهم كانوا متكلمين أيضاً؛ فهم ليسوا مسيَّسين، وكما أنهم لم يقيموا مقولاتهم على وقائع سياسية؛ بل إنهم أبعدُ من المعتزلة عن هذا النوع؛ لأنهم تأخروا في التبلور حتى القرنين الرابع والخامس للهجرة. ولذلك ليس هناك خلافٌ حول أوَّليتهم أو أصولهم، بل - بالإضافة إلى الرؤية المتفرعة عن التقليد السني - هناك النضج الذي كان علم الكلام قد بلغه، لجهة الغايات ولجهة الوسائل . وقد كتب الأشعري رسالةً في "استحسان الخوض في علم الكلام"، الذي عنى بالنسبة له إثبات العقائد السمعية بالأدلة العقلية. ولذا فهناك نَسَبٌ بينه وبين المعتزلة بوصفه كان منهم، ولأنه اتبع المنهج نفسه؛ أي المنهج الكلامي. وإنما الفرق- كما سبق القول في الرؤية - في أربعة أمور أساسية: قيام العلاقة بين الله وعباده عند الأشاعرة على العناية والرحمة والفضل،وعند المعتزلةعلى العدل، وإثبات الصفات لله عز وجل، والتفرقة فيها بين صفات المعاني وصفات الأفعال، والعدل من صفات الأفعال، بينما الرحمة والرحيم منصفات المعاني، وتقديم النقل على العقل في غير الأصول الأولى، وقراءة مسألة الفعل الإنساني من جهة الكسْب وليس من جهة الإحداث والخَلْق.
ولأنهم ظهروا متأخرين، وافترق شيخهم عن الاعتزال منضماً إلى قُدامى أهل النص دون أن يستطيع إرضاء الحنابلة؛ فإنه كان يواجه خصماً ومنافساً، والخصم هو المعتزلي القائل بالتنزيه والعدل، والحسن والقبح الذاتيين في الأشياء، والصلاح والأصلح، والوجوب على الله. بينما انصرف الأشاعرة عبر ثلاثة أجيال لمجادلة الخصوم، ولتمييز أنفسهم عن المنافسين، وبسبب اختلاف الرؤية بين هذين المذهبين الكلاميين فإنَّ أولوياتهم كانت مخلتفة، رغم اعتماد الطرفين على قياس الشاهد على الغائب.
بدأ الأشعري بإنكار حصول الاستطاعة قبل الفعل، بل باقترانهما. لكنْ بحسبه فإنّ هذه الاستطاعة أو القدرة الحادثة غير مؤثرة. ولذلك فقد اتهمه خصومه بأنه يقول بجبريةٍمستترة. لكنّ رأس الجيل الثالث من أبناء المدرسة وهو الباقلاّني أثبت تأثيراً للقدرة الحادثة بالتفرقة بين الأفعال الإرادية والأُخرى الاضطرارية فالكسب عند الأشاعرة "عبارة عن تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدور"(17).
ويقول الأشعري:" والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن يقع الشيئ بقـدرة محدثة، فيـكون كسباً لمن وقـع بقدرته"(18) وقد رأى الباقلاّني أنّ للقـدرة الحادثة تأثيراً في المقدور، وهذا مسوِّغ كسب الفعل من جانب العبد ونسبته أو إضافته إليه:" لأنّ الفعل إنما يُسند لمن قام به لا لمن أَوجده"(19).
وطوَّر الجويني في الجيل الرابع- إلى جانب الغزالي- هذه الرؤية لكسْب العبد لأفعاله؛ دون أن يصل الأمر بالطبع إلى عدّ الإنسان خلاقاً لأفعاله(20). إنما في كلا المنظومتين فإنّ المركزية- كما هو شأن كل المتكلمين – إنما ظلت لله سبحانه وتعالى. ولأنّ فعلَ الخَلْق لله، والله لا يجوزعليه فعلُ القبيح، فإن الحسن والقبح في الأفعال ليسا ذاتيين؛بل إنّ الحسن هوما حسّنه الشرع، والقبيح ما قبّحه الشرع. أما متأخرو الأشاعرة فإنهم انتهوا للقول بالتحسين والتقبيح العقليين، فيحين يظلُّ ترتُّب الثواب والعقاب علىالفعل المكسوب شرعياً أومنصوصاً عليه. المعتزلي يخشى القول بشمولية الخَلْق لله؛ لمايترتب عليه من نسبة الشر إلى الله، والأشعري يخشى القول بأنّ العبد يخلق أفعاله؛ لما يترتب عليه من تعدد الخالقين. أما المسؤولية المترتبة على الفعل فإنها تثبت بالعقل قبل الشرع عند المعتزلة، وبالشرع عند الأشعرية.
ولذلك كان هناك من قال: إن المعتزلة منطقيون نظريون، بينما الأشعرية مجوِّزون تجريبيون. وبينما يرفض المعتزلة خلق الله سبحانه لأفعال العباد؛ لأنه منافٍ للعدل، يقول الأشاعرة بأنّ العبد مسؤولٌ عن أفعاله، لكنّ المَآلَ إلى رحمة الله وعنايته وليس إلى عدله. ولو كان الأمر على غير ذلك لما نجا أحدٌ من خَلْقه. وبسبب نظرية المعتزلة في الوجوب؛ فإنهم أوجبوا على الله سبحانه اللطف تجاه العباد، ومن ذلك بعثة الأنبياء والرسل. ويقول الأشعرية: إنّ اللطف والصلاح مُرادان لله؛ لكنهما ليسا واجبين عليه (21). وقد قال سبحانه: الله رؤوفٌ بعباده، وما الله يريد ظلماً للعباد، ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب على نفسه الرحمة. ومن ضمن مقولة الوجوب( المنطقي أو العقلي؟) جاءت مسألة الوعد والوعيد عند المعتزلة كما سبق القول؛ فالله سبحانه وعد وتوعد ويجب عليه الوفاء بوعده ووعيده. وكما ردَّ الأشاعرةُالمعتزلةَمقولة في الصلاح والأصلح، ردُّوها أيضاً في مسألة الوعيد، وليس لأنّ الله لا يفي بوعده أو وعيده؛ بل لأنه سبحانه لا يجب عليه شيء، لأنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة. وهو يعامل عباده بفضله وعنايته لا بعدله؛ لأنه رؤوفٌ بعباده، وقد وسعت رحمته كل شيء(22).
هنـاك في الإسـلام إذن مذهبـان كلاميان أو لاهوتيـان: مـذهب العدل ومـذهب العنـاية والفضل، وربما كان هذان التياران أو التصوران في سائر الديانات الإبراهيمية. وأقول: إنهمامذهبان فحسْب؛ لأنّ سائر الفِرَق الإسلامية اعتنقت هذا المذهب أو ذاك، وليس من الضروري من الناحية التاريخية أن يقع المعتزلة والأشاعرة في أصل هذين المذهبين أو المنزعين أو الاتجاهين؛ فالإباضية أقدم من المعتزلة، والمرجئة أقدم من أهل السنة. وقد ربط كثيرون من المحدَثين كلا المذهبين بالظروف السياسية التي وقعت في زمن النشوء؛ لكنني وبعد طول تأمُّل لا أرى ذلك؛ فصحيح أنّ المحكِّمة خضغوا في نشأتهم لظروفٍ سياسيةٍ قاسية؛ لكنّ تطورهم الكلامي تحرر من تلك الظروف، وكثير من اعتقاداتهم لا يمكن إرجاعُها إلى أصلٍ سياسي. والمعتزلة في النشأة وفي التطور أقلُّ تأثراً بالمسائل السياسية، والدليل على ذلك هذا الخلاف في أسباب التسمية أو التسميات، بما يشي بغموض النشأة، ولو كانت سياسية لما كانت مجهولة.
ثم بسبب هذه المسائل والبحوث المتكاثرة لديهم والتي ليست لها صلة ظاهرة أوباطنة بالسياسة. ومن المسائل الشديدة الظهور فيعقائدهم قضية خلق القرآن، والتي ما أمكنإيجاد تفسيرٍ لهاعلى كثرة ما كُتب حولها، فكيف ببحوث الجوهر والعَرَض والأحوال. والقدرية من قبل ما بقي أحدٌ ممن كتب عنهم إلاّ فسّر منزعهم وتعرُّض بني أمية لهم بأنّ ذلك كانبسبب ثوراتهم على "الجبر" الأُموي؛ لكنّعبد الحميد كاتب الأُمويين المُعاصر لهم علَّل ملاحقتهم بأنها كانت بسبب "منازعتهم لله في سلطانه"؛ أي بأنهم كانوا يقولون:إنّ العبد مختارٌ في أفعاله، أو كما قال المعتزلة لاحقاً بأنه يخلُقُ أفعاله! وعندما نقرأُ سخرية الجاحظ من النابتة أوأهل السنة نجده يتهمهم بأنهمعوام أو طغام، ويأخذون بظواهر النصوص بطرائق تشبيهية وتجسيمية، ولا يوجِّه إليهم (وهو المقرَّب من السلطات العباسية) أي تهمةٍ سياسية. ويتهم المؤرخون الجهم بن صفوان بالجبر لكنه كان ثائراً سياسياً.وأبو حنيفة من المرجئة؛ لكنه أيَّد بعض الثائرين على السلطات أيام الأمويين والعباسيين.
لكن يكون علينا أن نُقرَّ بأنّ المعتزلة كانوا الأكثر إغراءً للباحثين بوصفهم مفكري الحرية الإنسانية والسياسية، فهم يقولون بأنّ العبد حُرٌّ في فعله وتركه، والأصل الخامس في عقائدهم هو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكننا لا نعرف عنهم أولهمغير تأييدهم لتمرد يزيد بن الوليد على ابن عمه، وما يقال عن ميلهم أو ميل بعضهم إلى الثائر محمد النفس الزكية. ولستُ أدري لماذا يجب أن تكون للرأي السياسي دائماً صلةٌ بالاعتقاد الديني؟! وهذه سيرة المؤسس لمذهب الاعتزال واصل بن عطاء، لا نجد فيها أيَّ ذكرٍ لتوجُّهٍ سياسيٍّ له هو أو لزميله عمرو بن عُبيد. وبالنسبة لأصل الأمر بالمعروف، هذا كتاب مايكل كوك الضخم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، الذي يُثبت أنّ هذا الأصل أو المبدأ كان حاضراً في أفكار ومذاهب كل المذاهب الدينية والفكرية في الإسلام عبر العصور. لذا يذهب كوك إلى أنه جزءٌ من روح الإسلام.
وليكن لدينا عَودٌ على بدء. إنّ أصل العدل عند المعتزلة متعلقٌ بعلائق الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو تابع عندهم أو متفرع على مبدأ التنزيه، ولا شيء يُشعر بأنه كان مذهباً في الحرية أو أنّ أعلام الاعتزال فكروا فيه بوصفه كذلك. والنزعة اللاهوتية البحتة تظهر لدى الأشاعرة أكثر من المعتزلة؛ فالعدل عندهم من صفات الأفعال، والمنزع الغالب عندهم تنزيه الله عن الظلم، أما الهم الأكبر لديهم فهو الانضواء في عناية الله ورحمته، ودائماً استناداً إلى رؤيةٍ لاهوتية لعلاقة الله بالعالم والإنسان.
المعتزلة والأشاعرة إذن أهل كلام أو لاهوت، والمعتزلة أكثر من الأشاعرة نزوعاً إلى "عقلنة" العقائد الدينية، ويميل الأشاعرة لإثبات العقائد السمعية بالأدلة العقلية؛ لكنهم متكلمون أيضاً وليس أكثر، وذوو منازع فلسفية وفكرية ازدهرت في الحضارة الإسلامية الوسيطة.
وللرؤيتين المعتزلية والأشعرية غائياتٌ أخلاقية من نوعٍ ما؛ لكنها غائياتٌ أو رؤًى في تصورهم لله - عزّ وجلّ -، وليس للإنسان بالدرجة الأولى؛ لأنهم لاهوتيون، والتصورات هذه لا تهدف لبناء مذهب أخلاقي، ولا لجأت للقرآن لقراءة شبكة القيم القرآنية في بنيتها الداخلية.
وكنتُ قد ذكرتُ في مقدمة هذه المقالة أنني عملتُ في السنوات الماضية على منظومة القيم في القرآن، والتي تبرز فيها قيم المساواة والرحمة والعدل والمعروف والتعارف والخير العام. ولكلٍ من هذه المفردات/ المفاتيح اشتقاقات وتفرعات وشبكات لا تكاد تنتهي.
وقلتُ: إنّ هذه المفاهيم عمل عليها عديدون من قبل، ومنهم دراز وإيزوتسو، وتفرد بها في العقود الثلاثة الأخيرة الأستاذ طه عبد الرحمن. وبعد طول بحثٍ وتفكير أرى أنه لا يمكن تركيب أو تشكيل هذه المصفوفة أو المنظومة استناداً إلى المفاهيم والمقولات الكلامية، بل لا بد من العودة فيها إلى القـرآن مبـاشرةً لفهم واستنـطاق العالم المفهومـيللقرآن. لقدعدّ الشيخ مصطفى عبد الرازق المتكلمين فلاسفة الإسلام الحقيقيين، وأنا أرى أنّ الفلسفة الأخلاقية في القرآن هي مبحثٌ منفرد أو متفرد، ولا تنفع فيها مقولات المتكلمين ومسبباتهم ومصادراتهم، دون أن يقلِّل هذا الاستنتاج من الأهمية الاستثنائية لعلم الكلام في الأزمنة الوسيطة والحديثة.
لقد درسنا هنا بإيجاز موقع قيمتي العدل والرحمة في المنظومتين المعتزلية والأشعرية، ووجدنا أنهما متعلقتان عند الطرفين برؤية العدل والرحمة فيهما، وهي رؤية عقائدية وليست سياسيةً أو حتى أخلاقية،ولذلك ينبغي في الدراسة لهما في الأزمنة الكلاسيكية عدم إخراجهما من سياقاتهما. وهذا لا يعني عدم إمكان استنطاقهما من جديدٍ في السياقات المعاصرة(23)؛ بيد أن الأفضل فيما يتصل بمبحث القيم الاتجاه مباشرةً إلى القرآن، مع الاستعانة بإمكانيات القراءة الحديثة.
......
المراجع والصادر:
- قارن على سبيل المثال / مجلة التسامح، عدد 12، ص 11-28، ومجلة التسامح، عدد 28، ص 12-36.
- الشهرستاني: الملل والنحل ( نشرة 1986)، 1/42.
- محمد آيت حمو: مشكلة الأفعال الإنسانية، 2015، ص 78، وهانم ابراهيم يوسف: أصل العدل عند المعتزلة، 1992، ص 16-27.
- بدوي: مذاهب الإسلاميين، 1996، ص 38-39.
- بدوي : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (1965) ص 190-192. وقارن بعبد المجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام (1993)، ص 50-53 وهو يغلِّب الاسباب السياسية في نشأة علم الكلام كله.
- مذاهب الإسلاميين، مرجع سابق، ص 39.
- القاضي عبد الجبار: المختصر في أصول الدين؛ في: رسائل العدل والتوحيد، نشرة محمد عمارة، 1/246. وقارن بعرض الأشعري لرأي المعتزلة في: مقالات الإسلاميين، ص 300.
- الجويني: الإرشاد، ص 173-174.
- مقالات الإسلاميين، ص 219.
- القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، م8، ص 110.
- محمد آيت حمو: مشكلة الأفعال الإنسانية، مرجع سابق ، ص 147.
- المغني 8/194.
- المغني 8/196.
- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص 134.
- المصدر نفسه، ص 135.
- سعيد بنسعيد العلوي: الخطاب الأشعري(1995)، ص 11.
- التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، م3، 1563-1570.
- الأشعري: مقالات الإسلاميين، ص 22.
- الباقلاني: التمهيد، ص 347. وقارن بشرح المقاصد للتفتازاني، م4، ص 223.
- الجويني: الإرشاد، ص 180، والعقيدة النظامية، ص 42-43.
- الجويني: الإرشاد، ص 321. وقارن بالبلاقاني: التمهيد، ص 400.
- هذا ما فعله محمد عبده في رسالة التوحيد. وانظر عن تأثيرات المعتزلة في الفكر العربي الحديث والمعاصر: صدى المعتزلة في الفكر الإسلامي بين الماضي والحاضر. إشراف حمادي ذويب. مؤمنون بلا حدود، 2017.