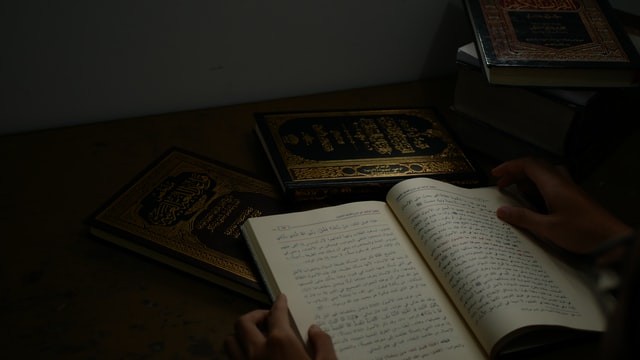فتحي المسكيني
توطئة
في سنة 2004 - بالإيطالية، ثمّ في ترجمة إنجليزية سنة 2005- نشر ريتشارد رورتي وجياني فاتّيمو كتابا طريفا تحت عنوان مستقبل الدين. تضامن، محبّة، تهكّم، أشرف على تحريره باحث من جامعة القدّيس لاتيران في روما هو سانتياغو زابالا(1)، مع ملاحظة أنّ العنوان الإنجليزي لم يبق على العنوان الصغير. والكتاب يضمّ مقدّمة وضعها زابالا تحت عنوان "دين من دون متألّهين ولا ملاحدة"(ص1-27)، ثمّ مقالة أصلية لرورتي تحت عنوان " العداء لرجال الدين والإلحاد" (ص29-41)، ثمّ مقالة طريفة لفاتّيمو تحت عنوان "عصر التأويل" (ص43-54)، وأخيرا محاورة بين المفكّرين الثلاثة تحت عنوان "ما هو مستقبل الدين بعد الميتافيزيقا؟" (ص55-81).
حاول زابالا أن يعيّن إطار اللقاء الفلسفي الذي جمع بين رورتي وفاتّيمو: بين ممثّل البراغماتية ما بعد الحديثة في شمال أمريكا، وبين رائد "الفكر الضعيف" كصيغة ما بعد تأويلية عن أوروبا الفلسفية منذ نيتشه وهيدغر. وذلك من خلال هذا الرهان المثير: أنّه "بعد الحداثة لم تعد ثمّة مبرّرات فلسفية قويّة، سواء لأن يكون المرء ملحدا يرفض الدين، أو لأن يكون متألّها يرفض العلم"(2). ثمّة وضع روحي جديد تكوّن في أفق "ما بعد الحداثة" يحمل مفارقة مذهلة؛ إنّها عودة "الإيمان" أو الدين بعد ولكن خاصة بسبب ما أعلنه نيتشه تحت عنوان "موت الإله". أيّ إيمان بعد موت الإله؟ وبم سوف يؤمن المؤمنون؟ ما يلفت الانتباه هنا هو أنّ زابالا يماهي بين موت الإله وبين "علمنة المقدّس". لا يخلو الأمر من التباس كبير؛ ألا تعني علمنة المقدّس إبطال الدين القائم على فكرة الإله ؟ ومن ثم إلغاء الجهاز الروحي الذي يجعل ظاهرة الإيمان ممكنة ؟
ينبّهنا زابالا إلى أنّ صلة عميقة تربط بين ظاهرة العلمنة وحرص الأوروبيين على التشبّث بماضيهم الديني. ثمّة تداخل محيّر بين التحرّر من الدين المسيحي وبين الحفاظ على علاقة مفضّلة معه.
يقول:" على عكس شطر واسع من اللاهوت المعاصر، فإنّ موت الإله هو شيء ما بعد-المسيحي(3) أكثر منه شيئا ضدّ-المسيحي(4)؛ نحن الآن نعيش في العصر ما بعد المسيحي لموت الإله، حيث أصبحت العلمنة هي المعيار بالنسبة إلى كلّ خطاب لاهوتي"(15).
وفي هذا السياق المخصوص ينزّل زابالا طبيعة الإسهامات الفلسفية لكلّ من ريتشارد رورتي وجياني فاتيمو: إنّهما رائدان لنوع جديد من الثقافة هي "الثقافة ما بعد الدينية"، وهي تعني تحديدا "مستقبل الدين بعد تفكيك الأنطولوجيا الغربية"(16). لا يتعلق الأمر بمجرد "فهم" موضوعي جديد للدين؛ بل بثقافة أو نوع جديد من الفكر، أُطلق عليه اسم "الفكر الضعيف" أو "المخفّف" (weak thought)، وهو ليس ضعيفا أو واهنا إلاّ في أمر واحد هو العزوف الحاسم عن الرغبة في "التأسيس" الأنطولوجي لأيّ خطاب حول حقيقة الكينونة.
علينا الآن أن نتعرّف إلى صيغة المشكلة كما طرحها فاتيمو، ثمّ نتعرض إلى ملاحظات رورتي عليها.
عصر التأويل
تحت عنوان طريف هو "عصر التأويل"(17)، يقدّم فاتيمو صيغة مركّزة عن إسهام الهرمينوطيقا في النقاش حول مستقبل الدين. ينطلق فاتيمو من التنبيه إلى أنّ التأويل هنا ليس "قضية موضوعية"؛ أي ليس قولا حول "ماهية" الأشياء؛ بل هو انخراط صريح فيما أشار إليه نيتشه بعبارته "لا توجد وقائع، بل تأويلات فقط". وهو ما انخرط فيه هيدغر منذ بداياته، وخاصة في الكينونة والزمان. لا يقدّم الفيلسوف التأويلي "أدلّة"؛ بل فقط "أجوبة على وضعيات وجد نفسه متورطا فيها، ملقى بها داخلها"(18) وما تعلمناه من هيدغر هو أوّلا "أنّ المعرفة هي دائما تأويل ولا شيء آخر"، وثانيا أنّ "التأويل هو الأمر الواقع الوحيد الذي عنه يمكننا أن نتكلم"(19)، وثالثا أنّه كلّما حاولنا الإمساك بالتأويل في "أصالته"(Eigentlichkeit) وقفنا على "طابعه التاريخي" أو "الحدثي" (ereignishaft)، ورابعا أنّ التأويل لا يمكن أن نحتج له إلاّ بوصفه "جوابا مهمّا عن وضعية تاريخية مخصوصة"(20)
نحن لا نعرف إلاّ بقدر ما نفهم معنى كينونتنا؛ ونحن لا نؤوّل إلاّ لأنّ كينونتنا هي أمر واقع وليس اختيارا؛ ونحن لا نملك من الأصالة أو الخصوصية إلاّ ما يخصّص كينونتنا؛ أي ما يحدث لنا على نحو مخصوص، ونحن لا نؤوّل إلاّ بقدر ما نقدّر حجم تورّطنا في وضعية ما وتاريخية ما. ولذلك ينبّه فاتيمو إلى أنّه "لا أحد يستطيع الكلام عن التأويل من دون عقاب (with impunity)؛ التأويل مثل الفيروس أو حتى الفارماكون الذي يصيب أيّ شيء يدخل في اتصال معه"(21). الداء المعاصر هو ما شخّصه نيتشه تحت اسم العدمية، وأطلق عليه هيدغر اسم "نهاية الميتافيزيقا". وهنا نجد أنّ فاتيمو يجري تعديلا طريفا على هذا الوضع الجديد: إنّ القصد هو تقديم التأويلية بوصفه فلسفة "عصر" معيّن "حدث" فيه شيء غير مسبوق؛ هذا الحدث هو "نهاية المركزية الأوروبية" في جملة تنويعاتها، وخاصة أنّه لم يعد هناك "صورة واحدة عن العالم". وهو ما عبّر عنه ليوتار بصيغة "نهاية السرديات الكبرى". الطرافة هنا تقديم هذا العصر ما بعد الميتافيزيقي بوصفه "حدثا" خاصا بثقافة بعينها. وبعيون هيدغر يعني ذلك أنّ نهاية السرديات لا تعني "رفع النقاب عن وضع "حقيقي" للأشياء، فيه لم تعد السرديات أمرا ممكنا"؛ بل الأمر يتعلق -حسب فاتيمو- بمسار نحن ملقون فيه، و"غارقون فيه، ولا يمكننا أن ننظر إليه من خارج"، هذا الوضع المحبط هو الذي يجعل منّا "مؤوّلين"، وليس "مسجّلين موضوعيين للوقائع" (22)
ما يثير في طرح فاتّيمو أنّه يأخذ قولة نيتشه "موت الإله" بوصفه تنويعة سردية على موت الإله المسيحي، ومن ثم على أنّ ثمّة صلة بنيوية بين "نهاية الميتافيزيقا" وبين ظهور "البشارة المسيحية". وهو يعتمد في هذا التخريج على مقطع طريف عثر عليه في كتاب دلتاي "مقدّمة إلى العلوم الإنسانية" (1883)، حيث يزعم دلتاي أنّ "مجيء المسيحية هو الذي جعل ممكنا التفكّك المتدرّج للميتافيزيقا"، والذي بلغ ذروته مع كانط(23) هذا الطرح يسحبه فاتيمو على عدمية نيتشه ونهاية الميتافيزيقا لدى هيدغر. وهنا تتوضح الصورة: أنّ الهرمينوطيقا منحت الفلسفة الصيغة الأخيرة من "حدث" مسيحي، كان هو نفسه في زمنه قطيعة جنينية مع الميتافيزيقا اليونانية. قال فاتيمو:" إنّ الهرمينوطيقا هي عملية تطوير وإنضاج للرسالة المسيحية"(24).
وهذا يعني أنّ ظهور الدين التوحيدي على الساحة العالمية هو الذي دشّن عملية تفكك الخطاب الميتافيزيقي، وذلك منذ صلب المسيح. وهكذا فإنّ "عصر التأويل" هي تشير إلى اللقاء الطريف بين الهرمينوطيقا والمسيحية. والسؤال أو الرهان الفلسفي الذي يحرّك فاتيمو هو:" هل يمكننا أن نحتجّ بأنّ العدمية ما بعد الحديثة إنّما تشكّل الحقيقة الراهنة للمسيحية؟"(25)
صحيح أنّ تغييرات كبيرة قد طرأت على المشهد التأويلي؛ مثل: أنّ الكنيسة التي تتدخل في نقاشات البيو-إتيقا لا تفعل ذلك باسم "الوحي" الديني بل باسم "الإنسانية"(26)، وأنّ نوعا غير مسبوق من الأسئلة قد ظهر؛ مثل: لماذا يُنادى الله "أبا" وليس "أمّا" ؟(27) لكنّ ما هو طريف هنا هو أنّ عصر التأويل قد مكّن المسيحية من أن تتحمّل "كلّ مفعولها المضاد للميتافيزيقا"، وهو يتمثل أساسا في أنّ "الواقع" قد تحوّل في حقيقته إلى مرتبة "الرسالة": كل قوة المسيحية -من حيث هي "رسالة خلاص"- إنّما تكمن -حسب فاتيمو- في "تفكيك الادّعاءات القطعي للواقع"(28). إنّ الواقع لم يعد موضوعا. وعلينا أن نقرأه في معنى إشارة فتغنشتاين إلى أنّ الفلسفة جُعلت لتحريرنا من الأوثان. وحسب فاتيمو هذه الفلسفة ليست شيئا آخر إلاّ "الفلسفة ما بعد الميتافيزيقية التي جعلها المسيح ممكنة"(29). لكنّ أخطر مكسب فلسفي هنا ليس مكسبا معرفيّا. لا تنتج الفلسفة بعد الميتافيزيقا معرفة أكثر حقيقة؛ بل طريقة أكثر ملاءمة لعصرنا في الحديث عن أنفسنا. ثمّة ثقل سياسي للتحرر من طريقة الميتافيزيقا في الحديث عن حقيقة الكينونة، ومن ثمّ عن معنى وجود الله.
يقول فاتيمو:" عموما، إنّ نظاما ديمقراطيا يحتاج إلى تصوّر غير موضوعي وغير ميتافيزيقي حول الحقيقة؛ وإلاّ فإنّه يصبح مباشرة نظاما تسلّطيّا"(30)
إنّ المشكل هو العلاقة مع الحقيقة. كان أرسطو يقدّم الحقيقة على صداقة أفلاطون. لكنّ المسيحية غيّرت هذا الخيار. لم يأت الكتاب المقدّس من أجل أن يمنحنا معرفة الحقيقة (كينونتنا، وجود الله، طبيعة الأشياء، قوانين الهندسة...) بل لكي يعلّمنا طريقة في الخلاص. وأهمّ درس هنا هو أنّه لا يوجد خلاص بواسطة "المعرفة". وحسب فاتيمو فإنّ الدرس الذي لا يمكن "أسطرته" هنا هو "حقيقة المحبة (love)، حقيقة الإحسان(charity)"(31). وكلّ دين يواصل الإصرار على أنّه يمتلك الحقيقة هو دين تسلّطي، وهو من ثم عبارة عن ميتافيزيقا.
ما هو طريف في طرح فاتيمو هو محاولة استثمار أهمّ مكسب حققه الفكر ما بعد الميتافيزيقي حول معنى الحقيقة (أنّها ليست تطابقا بين الحكم والشيء؛ بل ضرب من المشاركة أو "انصهار آفاق" المعنى) في إعادة تخريج دلالة التجربة المسيحية. وهو لا يتردد في صياغة ذلك في شكل حادّ أو في هيئة مفارقة قائلا:" إنّ العدمية ما بعد الحديثة هي حقيقة المسيحية"(32) وذلك يعني أنّ ما بعد الحداثة هو عصر التأويل الذي أصبح من الممكن فيه أن نرى الدور الذي أدّته المسيحية في تفكيك التصور الميتافيزيقا للحقيقة. المثال الذي يسوقه فاتيمو عن "العدمية" هو المصطلح المسيحي "kenosis "- "إخلاء النفس" أو "إفراغ النفس": إنّ الله قد تخلّى عن تعاليه من أجلنا(33). جاء المصطلح من نص "الرسالة إلى مؤمني فيلبي، 2، 7":
"فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو أيضا في المسيح يسوع؛ إذْ إنّه- وهو الكائن في هيئة الله- لم يعدّ مساواته لله خُلسة، أو غنيمة يتمسّك بها، بل أخلى نفسه، متّخذا صورة عبد، صائرا شبيها بالبشر؛ وإذ ظهر بهيئة إنسان، أمعن في الاتّضاع، وكان طائعا حتى الموت، موت الصليب".
من هذا المعنى الإنجيلي يقتبس فاتيمو تخريجا طريفا لطرح رورتي عن "النزعة اللاّتأسيسية" في الفلسفة ما بعد الحديثة: إنّ كوننا لم نعد تأسيسيين نظرتنا للحقيقة هو موقفي روحي لم يكن ممكنا أبدا إلاّ لأنّنا نعيش داخل ثقافة "كتابية، وخاصة مسيحية"(34). وحدهم الكتابيون- وخاصة المسيحيين- يمكنهم تحمّل "العدمية"؛ أي عملية إفراغ الكينونة من حقيقتها الموضوعية ومن ماهيتها الميتفيزيقية، وعيشها كحدث خاص. ليس من السهل أبدا على بشرية غير مسيحية أن تحتمل تفريغ "الواقع" من موضوعيته، وتحويله إلى مجرد تأويل. وحدها المسيحية فتحت الباب أمام ثقافة بإمكانها أن "تكتشف أنّ تجربة الحقيقة هي فوق كل شيء؛ تجربة سماع وتأويل للرسالات"(35)
ولكن ما الذي يمنعنا إلى حدّ الآن من أن نرى "التبعات الميتافيزيقية المضادة للمسيحية" ؟ جواب فاتيمو هو: "لأننا لسنا عدميين بما فيه الكفاية، وبعبارة أخرى لسنا مسيحيين بما فيه الكفاية" ! (36)نلاحظ هنا أنّا عصر التأويل لا يعني عصر التديّن بل دخول الثقافة في أفق رسالة محدّدة تؤخذ على أنّه شرط إمكان سردي لا يمكن تعويضه أو الاستغناء عنه. لسنا عدميين يعني أنّنا لم نقبل بعد بالتبعات ما بعد الميتافيزيقية الخطيرة وغير المسبوقة لكلامنا عن الدين. لم يبق من الدين المسيحي غير رسالته، أي إفراغه للواقع أو للعالم من موضوعيته، وتحويله إلى قصة عميقة عن أنفسنا. ما يمكن أن تخسره الإنسانية التي ترفض تعويض الواقع بالرسالة هو الموقف السردي فقط. ذاك الذي قد يساعدها على "تملّك تاريخيتها"؛ أي على تأكيد نمط انتمائها إلى نفسها. ويتمثّل فاتيمو هنا بقولة قصوى لبينيديتو كروتشه :" لا نستطيع ألاّ نسمّي أنفسنا مسيحيين". المشكل هو "تسمية النفس" وليس الإيمان بالمسيحية. ومعنى استحالة تغيير الانتماء إلى أنفسنا يعني تحديدا "نحن لا نستطيع أن نضع أنفسنا خارج التراث الذي انفتح بفضل إعلان المسيح"(37) يبدو الأمر متعلقا بحدّ سرديّ أو هوويّ، وليس بمضمون عقدي. هذا الحدّ هو أنّ عالما مات فيه الإله لا يمكن العيش فيه إلاّ بشكل تأويلي؛ أي لا نجاة فيه لما هو بشري بالاعتماد على "الوصية المسيحية بالمحبة"(38). إنّ المحبة إذن مشكل تأويلي، وليس علاقة وفاء مع الحقيقة.
الإلحاد والديمقراطية
تحت عنوان "العداء لرجال الدين والإلحاد" طرح رورتي مشكلا مخصوصا: ما هو نوع الأسئلة المناسبة أو السليمة حول الدين راهنا؟ يفتتح رورتي مقالته بعرض نبوءة تخص مؤرّخي الفكر في المستقبل. سوف يقولون: إنّ القرن العشرين قد كان القرن الذي كفّ فيه الفلاسفة عن طرح "الأسئلة السيّئة". وهي حسب رورتي أسئلة الفلاسفة طيلة تاريخهم: أ- "ماذا يوجد حقّا؟" (السؤال اليوناني)؛ ب- "ما هو مدى وما هي حدود المعرفة الإنسانية؟" (سؤال المحدثين)؛ ج- "بأيّ وجه تتّصل اللغة بالواقع؟" (سؤال المعاصرين) (39)
إنّ الجديد هو البحث عن موقف "لا-ماهوي" تماما من المفكّر فيه. وبالنسبة إلى السؤال عن الدين يعني ذلك "إضعاف" أيّ رأي يقابل بشكل حادّ بين "معتقدات علمية" و"معتقدات دينية".
يقول:" هذه التطوّرات قد جعلت كلمة 'ملحد' أقلّ شعبيّة ممّا ينبغي. والفلاسفة الذين لا يذهبون إلى الكنيسة هم الآن أقلّ ميلا إلى وصف أنفسهم بأنّهم يعتقدون بأنّه ليس هناك إله. هم يميلون أكثر إلى استعمال هذه التعابير على طريقة ماكس فيبر في معنى 'غير موسيقية دينيّاً' "(40)
ما تمّ فقدانه بلا رجعة هو "الحق في ازدراء" الآخرين الذين يعتقدون شيئا مختلفا عمّا نعتقد. إنّ الفرق بين إيمان وآخر هو فرق "موسيقي"؛ أي بلا أيّ مضمون أخلاقي. ومن لا يقبل بهذا الوضع "الجمالي" لأيّ إيمان هو نمط "غير موسيقي" من الناس.(41) ولذلك يجب إخراج معنى الإلحاد من خانة المعرفة إلى خانة السياسة: ليس الإلحاد عقيدة علمية؛ بل هو مشكل سياسي، يتعلق بما يسمّيه رورتي "معاداة الإكليروس" أو معاداة الكهنوت في الحياة الحديثة. لكنّ ما هو طريف فلسفيّا هو التمييز اللطيف الذي يجريه رورتي بين أن يدّعي الفيلسوف أنّه "ملحد" وبين أن يكون فقط "علمانيّا معاصرا". إنّ الملحد يدّعي أنّ "الإيمان الديني غير عقلاني"، في حين أنّ العلماني المعاصر سوف يكتفي فقط بالقول: إنّ الإيمان الديني "خطير سياسيّا". ويتمثّل هذا الخطر في تجاوز الدين لحدود "الإيمان الخاص" والامتداد إلى استعمال "مؤسسات كهنوتية" من أجل فرض "أغراض سياسية" بعينها. ما يطالب به رورتي أن يتفّق "المؤمنون وغير المؤمنين على اتّباع سياسة تتمثّل في أن تعيش وتترك الآخرين يعيشون" (a policy of live and let live ).(42)
ينتمي الفيلسوف -حسب رورتي- إلى أولئك الذين لم يتعلّقوا بأيّ دين بعينه. يقول:" نحن أولئك الذين يسمّون أنفسهم 'غير موسيقيين دينيّاً'"(43)، في معنى غير منسجمين، غير مطربين، غير معزوفين بشكل جيّد. يركّز رورتي على مجاز الموسيقى حتى يبرز كون المشكل مع الدين ليس لاهوتيا. إنّه مشكل موسيقي؛ كأن نقول: ما هو العزف العمومي المناسب لمنطقة الإيمان؟
من أجل ذلك يعلّق رورتي على عودة فاتيمو إلى تديّن شبابه بناءً على تساؤل ناتج عن فشل ما لدى الجيل ما بعد الحديث، وهو فشل لا يعرف سببه العميق. والمشكل هو: هل العودة إلى الدين معناه التديّن أم هو شيء آخر؟ إنّ إجابة فاتيمو عن السؤال: "هل أنت الآن مرة أخرى تؤمن بالله؟" والتي تصاغ هكذا: "أنا أجد نفسي قد صرت دينيّا أكثر فأكثر، ومن ثم أنا أفترض أنّه ينبغي أن أؤمن بالله"، هي حسب رورتي إجابة غير مناسبة؛ إذ كان الأجدر أن يقول:" أنا صرت دينيّا أكثر، فأكثر ومن ثم أنا مقدم على ما يسميه بعض الناس إيمانا بالله، إلاّ أنني ليس متأكدا من أنّ اللفظ 'الإيمان' هو الوصف الصحيح لما أنا عليه"(44)
الدين الخاص
طرافة موقف فاتيمو تكمن حسب رورتي في أنّه يخرج الدين من مجال المعرفة. الإيمان ليس مشكلا إيبستيمولوجيا؛ لكنّ السؤال هو: هل الدين اسم مناسب للإيمان؟ منذ وليام جيمس تمّ الفصل بين السؤال: "هل لي الحق في أن أكون متديّنا؟" عن السؤال: "هل ينبغي على كلّ واحد من الناس أن يؤمن بوجود الله؟". موقف رورتي هو أنّ "التديّن (religiosity ) ليس مخصّصا على نحو سعيد بواسطة مصطلح الإيمان"(45) لكنّ أهمّية فاتيمو هو كونه لا يقبل الحلّ الذي أعطاه كثير من الفلاسفة منذ شلايرماخر؛ أولئك الذين عوّلوا على نوع من "لاهوت الأشكال الرمزية"؛ أي على العلاقة المريبة بين الحقيقة والمجاز، بوصفها حلاّ مناسبا لنا، يمكن أن يساعد على وضع الله في منزلة "الآخر بإطلاق"، ليس فقط آخر المحسوس بل آخر الخطاب العقلي أيضا (كيركغارد، بارت، ليفناس..).(46) لا يكفي فلسفيّا أن نعوّل على ما هو "رمزي" أو "مجازي" أو "أخلاقي"..حتى نفهم الإيمان. ولذلك بحث فاتيمو عن نوع من "اللاهوت الوجودي" قد يكون علاجا مناسبا لمن يسميهم "أنصاف المؤمنين".
لكنّ الصعوبة الفلسفية التي تواجه فاتيمو في تأويله لمسألة الــ"kenosis" – أي فهم "تجسّد" الإله بوصفه تخلّيا عن كل قدراته لفائدة الكائنات البشرية بما في ذلك "غيريته" أو "آخريته": أنّ الله قد تخلّى عن كلّ شيء من أجلنا- هي استعداده للتخلّي عن "الحقيقة" لفائدة "المحبة". وهذا موقف -حسب رورتي- تعرّض إليه هيغل من قبل وأعطى عنه حلاّ آخر. لم يضحّ بالحقيقة لصالح المحبة بل حوّل التاريخ البشري إلى "دراما سردية"، تحركها غائية داخلية تنحو نحو الحقيقة أو المعرفة المطلقة. أمّا لدى فاتيمو فليس ثمة أيّة دراما كبرى في تاريخ البشر، بل فقط "الأمل في أن ينتصر الحب"(47)
بل إنّ فاتيمو يفترض أنّ الفلسفة يمكن أن تستفيد من انهيار "السرديات الميتافيزيقية الكبرى" بأنْ تعيد اكتشاف "الطابع المستساغ(plausibility ) للدين"، وذلك يعني بشكل متحرّر من انتظارات عصر التنوير منها. بهذا الثمن هو يجد صيغة للتعايش بين العلوم الطبيعية والمسيحية من خلال التأكيد على أنّ هوية المسيح ليس الحقيقة أو السلطة بل المحبة(48) أهميّة هذا التخريج تبدو -حسب رورتي- في كون التقليد الذي يعتمد عليه فاتيمو (أي نيتشه وهيدغر) يلتقي بشكل ما مع التقليد الذي ينهل منه رورتي (أي جيمس وديوي)، وذلك في نقطة محددة:
"أنّ البحث عن الحقيقة أو المعرفة ليس أكثر أو أقل من البحث عن اتفاق بيذاتيّ (intersubjective agreement). إنّ حلبة المعرفة هي فضاء عمومي، فضاء منه يمكن وينبغي للدين أن ينسحب منه. وإنّ إدراك أنّه ينبغي أن ينسحب من هذا الفضاء ليس اعترافا بالماهية الحقيقية للدين؛ بل فقط واحد من الدروس التي ينبغي استخلاصها من تاريخ أوروبا وأمريكا" (49)
لكنّ سحب الدين من الفضاء العمومي والدفاع عن "دين شخصي" أو عن "ديانة خاصة" هو أيضا ليس حلاّ مريحا. وذلك لأنّ استعمال أطروحة هيدغر عن "الأنطو-ثيولوجيا" لإنقاذ الدين ليس حلاّ. صحيح أنّ العلوم الحديثة قد بلغت إلى مماهاة "الكينونة" مع "الموضوع" القابل للحساب والتحكّم التكنولوجي. ومن ثم لم يعد ثمة مكان مناسب أو خاص للقول الديني في فلسفة تقوم على الفصل الحاسم بين ما هو "معرفي" وما هو "لا معرفي" (كانط). وهكذا فإنّ الثمن الذي أشار إليه نيتشه وهيدغر أو جيمس وديوي هو ضرورة تعويض ذلك الفصل بتمييز من نوع آخر، ألا وهو التمييز بين "إشباع الحاجات العمومية" و"إشباع الحاجات الخاصة" (private needs )(50). دور الفلسفة هو أن تحررنا من أفق لا يزال يعوّل على أنّ الإيبستمولوجيا هي الفلسفة الأولى، ومن ثم فإن كلّ أقوالنا ليس لها سوى "مضمون معرفيّ" أو "عرفاني"(cognitive). هذا "الأفق من التفكير هو عدوّ للحرية ولتاريخية الوجود"(51)، حسب تعبير فاتيمو في كتابه الإيمان.
ما يهدف إليه فاتيمو هو إرجاع الدين إلى نواته المسيحية الأصلية: "المحبة" (charity)، وهذا الشرط هو وحده الذي يمكّن -حسب تأويله- من فهم الوعد الإنجيلي بأنّ الله لن ينظر إلينا بوصفنا "عبادا" أو "خدماً" (servants) بل بوصفنا "أصدقاء"(52). ثمّة رابط بين "تخلي" الله عن نفسه من أجلنا وبين عدّ "المحبة" هي نواة الدين في أفق البشر. ولذلك ثمّة رابط حسب فاتيمو بين العلمنة وبين الدين المردود إلى شأن شخصي أو خاص: لا يمكن علمنة عالم لا يزال الله يمتلكه. إنّه فقط حين يتخلى الله عن ذاته من أجلنا يمكن عندئذ أن نعلمن العالم.
ما هو مهمّ في هذا النوع من الطرح يكمن -حسب رورتي- في كونه يعزف عن أيّ اهتمام بمراقبة مدى تديّن الناس أو عدم تديّنهم. لم يعد ممكنا البحث عن صيغة "مشروعة" أو "صالحة" عن المسيحية. المشروعية مفهوم غير ممكن تطبيقه حسب رورتي على "وحدتنا" أو ما نفعله في وحدتنا(53). قال:" إنّ الدين الذي يرى أنّ السؤال عن الإيمان بالله أو الإلحاد به سؤالاً بلا أيّ أهمّية قد يمكن أن يكون هو ما يناسب وحدتك"(54).
سكوت الدين عمّا هو خارج نطاق الإيمان يمكن أن يكون -حسب رورتي- عملا ملائما للحياة ضمن مجتمع ديمقراطي، وهو سكوت متبادل بين المؤمنين وغير المؤمنين: على المؤمن أن يكفّ عن النظر إلى "افتقاد الشعور الديني"، على أنّه "علامة على الابتذال" أو الفظاظة، كما أنّ على غير المؤمن أن يكفّ عن النظر إلى امتلاك مثل ذلك الشعور بوصفه "علامة على الجبن"(55)تبعث على الازدراء. ينظر المؤمن إلى "حدث في الماضي" بوصفه مقدّسا؛ لأنّه تجسيد لقرار الله بأن يتحوّل من التسلط على البشر إلى "محبة" البشر؛ في حين أنّ غير المؤمن يفترض أنّ القداسة تسكن فقط في "مستقبل مثالي"، بناء على "الأمل" في أن تتحقق يوما ما حضارة كونية حيث يسود "الحب" بوصفه القانون الوحيد(56) تعريفان مختلفان ولكن لشيء واحد هو "محبة البشر". وحسب رورتي فإنّ معنى المحبة الذي ورد في التقليد المسيحي (الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، 13) يصلح أيضا لـــ"غير المتديّنين" مثل رورتي، الذين يرون أنّ معنى "السرّ المقدّس" (mystery) على الأرجح "يتمثّل في الأمل في مستقبل أفضل للبشر. والفرق بين هذين النوعين من الناس هو ذلك الذي بين الامتنان الذي لا يمكن تبريره والأمل الذي لا يمكن تبريره. وهذا ليس مادة لمعتقدات متصارعة حول ما يوجد فعلاً وما لا يوجد" (57)
كذا يترنّح الفكر الغربي بين "ذاكرة" الحدث المسيحي ("الله محبة") وبين "حرية" العدمية الأوروبية ("موت الله"). وليس أجمل من التقابل الصديق ولكن العميق بين فاتيمو ورورتي لتجسيد هذه الفرادة الروحية. في هذا السياق أتى السؤال الذي دارت حوله المحاورة ما بعد الحديثة بين فاتيمو ورورتي وزابالا الذي رتّب اللقاء، هذا السؤال هو :" ما مستقبل الدين بعد الميتافيزيقا؟"(58)
ما مستقبل الدين بعد الميتافيزيقا؟
ينزّل زابالا هذا اللقاء بين فاتيمو ورورتي في إطار ما سمّاه فاتيمو نفسه "الفكر الضعيف"(weak thought) دون أن يعني ذلك بالتأكيد ضعف الفكر. وهي عبارة أُطلقت سنة 1984 في مؤلف جماعي (أشرف عليه مع ألدو روفاتي) تحت عنوان Il Pensioro debole. هاهنا قدّم فاتيمو ما يقصده من "الفكر الضعيف" على أنّه استئناف داخلي لما أشار إليه هيدغر الثاني بعبارة "Überwindung/Verwindung" ،"مجاوزة" الميتافيزيقا في معنى العمل على "شفائها" أو تحريرها من الداخل، حيث يكون الفكر ضربا من "التقوى" ما بعد الميتافيزيقية التي لا "تؤسس"، ولكن "تعيش من جديد" التراث الذي تنتمي إليه، وتكتفي بــ"نقله" (Über-lieferung) أو استيراثه دون أن تزعم أنّها تستطيع أن تبني أيّ معرفة "موضوعية" حول "حقيقته"(59) والمشكل هو كيف ننزلق من فكر "الاختلاف" (الذي ما يزال يبحث عن موضع "آخر" للفكر) إلى "الفكر الضعيف"، (الذي صار يعوّل على "أنطولوجيا ضعيفة" من دون مطامح ميتافيزيقية). الفكر الضعيف هو هنا الفكر المناسب لثقافة "ما بعد-ميتافيزيقية"؛ أي لم تعد تملك "سردية كبرى" حول نفسها.
في هذا السياق تمّ تنزيل السؤال عن مستقبل الدين. يتصوّر رورتي أنّ المسيحية الحديثة قد عرفت " تضعيفاً (weakening ) متتدرّجاً من عبادة الله بوصفه سلطة /قدرة (power)" انزاح بها بشكل تدريجي إلى "عبادة الله بوصفه محبّة"، وهو يبني توازيا طريفا بين الانتقال "من السلطة إلى المحبة" (في المسيحية) وبين الانتقال من "اللوغوس الميتافيزيقي" إلى "الفكر ما بعد الميتافيزيقي" (في الفلسفة ما بعد الحديثة أي منذ نيتشه/هيدغر وجيمس/ديوي).(56)
أمّا الأرضية التي تمّ عليها هذا الانتقال المضاعف فهو ما أشار إليه غادمير بقولته الشهيرة :" إنّ الكينونة التي يمكن فهمها هي اللغة". وحسب فاتيمو فإنّ هيدغر في الكينونة والزمان قد عرض تأويلا براغماتيا لمعنى الكينونة: أنّ الأشياء لا ماهية لها وإنّما هي تظهر أو تأتي إلى الكينونة في نطاق الكلام اليومي حولها. ومن ثمّ فإن "الكينونة ليس شيئا سوى اللوغوس المتأوّل بوصفه حوارا، Gesprch، بوصفه النقاش الجاري بين الناس".(57) ولذا فإنّ المشكل الأول هنا هو "مقاييس" الحوار. يستبعد فاتيمو صيغة "ألعاب اللغة" التي أطلها فتغنشتاين: هناك شيء "اعتباطي" في أيّ لعب. ولذلك هو يختار الهرمينوطيقا؛ لأنّها تولي أهمّية لــ"تاريخية" القواعد التي نلعب بها. لكنّ الهرمينوطيقا تبدو في نظره في حاجة ماسّة إلى "ميتا-قاعدة"(metarule) حتى تؤدّي مهمّتها، وهذه "الميتا-قاعدة" ليست شيئا آخر -حسب فاتيمو- سوى "المحبة" المسيحية (charity)؛ "لأنّ المحبّة يمكن أن يُفكَّر فيها بوصفها ميتا-قاعدة تلزمنا وتدفعنا نحو قبول ألعاب اللغة المختلفة، والقواعد المختلفة لألعاب اللغة"(58)
يفترض رورتي أنّ المحبة هي "ممارسات وتقاليد" وليست "لعبة لغوية"، وهي تتمثّل في أن نكون على "استعداد" لالتقاط تقاليد أناس آخرين وأخذ ممارساتهم من دون تعلّم أيّ قواعد، بل عن طريق "خبرة عملية" (know-how). وإذا كان ثمّة شيء "اعتباطي" فهو الادّعاء بأنّ ممارستنا الخاصة هي الممارسة الوحيدة المناسبة(59) يرتبط أيّ ادّعاء بضرب من الذاتية. حسب فاتيمو هنا تكمن إسهامات الهرمينوطيقا في "تضعيف الذاتية": أن نشعر بأنّ اللغة تتكلّم عبرنا، ورغم ذلك نواصل الزعم بأنّنا "ذوات"(60) موقف رورتي هو أنّ علينا أن نميّز بين "عظمة" الذات وبين ما سمّاه إشعيا برلين "العمق الرومانسي". علينا أن نعامل فكرة العمق من دون أيّ ادّعاء ميتافيزيقي، إذن من وجهة نظر الفكر ما بعد الميتافيزيقي يبدو "العمق اللامتناهي" - حسب رورتي - فكرة سيّئة مثله مثل "السلطة اللامتناهية". الفكر ما بعد الحديث ليس فكرا ثوريّا. عليه أن يطالب فقط بتغييرات صغيرة؛ إنه فكر يؤمن بالتناهي.
هذا التخريج اعتمده فاتيمو من أجل استدعاء مقولة هيدغر الثاني Ereignis / الحدث؛ لإلقاء ضوء جديد على معنى الدين أو العودة إلى المسيحية. المقصود هو أنّ الكينونة ليست ماهية موضوعية؛ بل "الكينونة هي الحدث، هي ما حدث فحسب(just what happened)"(61). ما هو مغزى هذا المفهوم في صلته بالدين؟
يفترض فاتيمو أنّ تاريخ الميتافيزيقا مرتبط في بناه العميقة مع تاريخ السلطة في الغرب. أنّ السلطة في أيدي "قلة" من الناس وأنّ باقي الناس هم "عبيد" هو جزء من تاريخ الميتافيزيقا. ولذلك فإنّ "الميتافيزيقا قد ظلّت على قيد الحياة؛ لأنّ البنية القديمة للـ'سلطة' قد بقيت على قيد الحياة (معها). ولهذا لم تكن الكنيسة المسيحية- وقد صارت رأس الإمبراطورية الرومانية- تستطيع التخلي عن بنية السلطة هذه- ولم تكن قادرة على تطوير كلّ الاستتباعات الميتافيزيقية المضادة (antimetaphysical) التي تنطوي عليها المسيحية" (62) .
هذا يعني أنّ المسيحية التقليدية نفسها لم تعد قادرة على استجلاء كل الإمكانات ما بعد الميتافيزيقية للإيمان. نكتة الإشكال تكمن في القبول بتاريخيّة الحدث المسيحي. لأنّه "حدث" فهو يطرح مشكلا لا تستطيع الكنيسة التقليدية (ولا الميتافيزيقا) أن تجيب عنه. ويختبر فاتيمو هذا الموقف الهرمينوطيقي غير المسبوق من خلال قوة لا تخلو من مفارقة:" شكرا لله أنا ملحد(thanks to God I am an atheist)"؛ لكنّ الفرد ما بعد الحديث لم يصبح ملحدا (بالإله التقليدي) إلاّ بفضل الحدث المسيحي. الملحد هو الذي لم يعد يقبل بأيّ نوع من التأسيس لعالم موضوعي وواقع ثابت وحقيقة مطلقة...أي أنّه وقف على تاريخيّة وجوده بشكل جذري.
يقول فاتيمو:" إنّه لم يعد يوجد أيّ تأسيس ميتافيزيقي هو لا يزال تأسيسًا. وإذا ما قبلت بتاريخيّتي بشكل جذري؛ فأنا لا أرى أيّ إمكانية أخرى غير أن أتكلّم في الدين...لأنّه إن لم أكن مسيحيّا فأنا سوف أكون على الأرجح ميتافيزيقيّاً"(63) ذلك يعني أنّ من لا يأخذ تاريخيّته مأخذ الجدّ- أنّه مجرد نتيجة لتاريخه الخاص فحسب- يواصل التمسّك ببنية موضوعية (ماهويّة) للواقع. ويريد أن يفرضها على الآخرين. وهكذا يفترض فاتيمو أنّه بفضل تاريخ الله أو تاريخ الوحي فقط إنّما يمكن للمرء أن يكون ملحدا. أو هو موقف روحي لا يظهر إلاّ في هذا الأفق.
لذلك يعيد زابالا السؤال عن مستقبل الدين إلى الواجهة، منطلقا من حديث هيدغر عن "الإله الأخير". والسؤال هو:" كيف يعمل الفكر الضعيف لدى نهاية الميتافيزيقا من وجهة نظر دينية؟"(64)
ما يقترحه فاتيمو هو رصد نوع الارتباط الذي صار مفيدا بين تعريفين جديدين لما هو "ميتافيزيقي" وما هو "ديني": كل موقف يصرّ على التمترس وراء متوالية من المقولات أو التعريفات أو المنطوقات أو العلاقات أو السلطات فوق التاريخية أو الأبدية أو المطلقة حول الحقيقة أو الواقع أو الله...هو موقف "ميتافيزيقي".
وفي المقابل فإنّ الاستتباعات الدينية هي دائما ناجمة عن الوهن الروحي الذي يلحق بأيّ موقف ميتافيزيقي. وحسب رورتي فإنّ الحدث المسيحي (ميلاد المسيح والتاريخ قبله وبعده) لم يعد مهمّا منذ الثورة الفرنسية، التي نقلت مذهب "المحبة" المسيحي إلى جهاز "أمل" من نوع جديد، عبّر عن نفسه من خلال ثلاثية "الحرية والمساواة والأخوة"، يمكن أن نسميه الأمل "الرومانسي"؛ أي الذي يأخذ بجدّية فظيعة قدرة المخيّلة البشرية على خلق التاريخ.
سياسات الإيمان
المشكل حسب تعبير زابالا: هل المؤمن اليوم يؤمن بــ"إله أنطولوجي"، أم بنوع من "الإله الضعيف" (a weak God)؛ أي إله غير مسيطر بل إله محبّ ؟(65)
يصرّ فاتيمو على الربط الشرطي بين الهرمينوطيقا أو البراغماتية وبين المسيحية: لا يمكن التفلسف بشكل تأويلي أو بشكل براغماتي من دون أن تكون مسيحيا. المعنى هو أنّ الخروج من نطاق الميتافيزيقا (خطاب الماهية أو الموضعة الأنطولوجية للحقيقة) هو بالضرورة تلفّت إلى ميدان الأسئلة الدينية (أسئلة المحبة أو العمل المشترك بناءً على تأويلات مختلفة لشيء ما).
وفي تقدير فاتيمو، حين نقبل بأنّ الكينونة هي حدث لغوي؛ وأنّ اللغة هي حوار؛ وأنّ الحوار هو مجموع التأويلات المقترحة، فإنّنا سوف نمتنع من أنفسنا عن الطمع في أيّ "تأسيس" لكينونة الأشياء: ليس الكينونة غير نتيجة الحوار البشري(66) ورغم أنّ المسيحية أو الثورة الفرنسية قد حرّرت الإنسان المعاصر من الحاجة إلى التأسيس الكبير، ومن "أيّ نوع من التأسيس لا يكون على صلة بالمحبة"، فإنّ المتفلسفة ليسوا بعدُ "عدميين بما فيه الكفاية"؛ أي لم يتخلّوا بعد عن أجزاء كبيرة من الطابع التسلّطي؛ (أي الميتافيزيقي) للحياة الغربية(67)
المشكل ليس في قطع الدين عن المؤسسات الاجتماعية التي عاش عليها (الكنائس، المعابد..)؛ بل في ترتيب علاقة من نوع آخر بينهما. وحسب فاتيمو المحبة يمكن أن تكون أنموذجا روحيا حاسما هنا؛ يقول:" أريد أن أؤكّد أنّ مشكل مستقبل الدين كان يمكن أن يُترجَم في مشكل أصغر، ولكن لا يقل أهمية، هو ذاك المتعلق بمستقبل الكنيسة. على سبيل المثال إنّ مستقبل الفن مرتبط بمستقبل المتاحف"(68) طبعا يمكن الاعتراض على ذلك - كما يفعل رورتي- بأنّ من يؤسس كنيسته الخاصة ينتهي إلى فرض مؤسسة تسلطية جديدة أكثر رعبا. لكنّ فاتيمو يعتمد على تأويل افترعه روبرت براند وذكره رورتي، يقول بأنّ أفضل ترجمة لمصطلح "Geist" لدى هيغل فينومينولوجيا الروح، هو "الحديث" أو "التحادث" (conversation) البشري؛ أي تبادل المعنى أو مساحة اللغة بين البشر، وهو يذهب بهذا التأويل إلى معنى "الروح الموضوعي" لدى هيغل؛ أي كل ميدان الماضي الروحي والأشكال الرمزية وحتى بنية السلطة، ولكن في معنى المؤسسات الديمقراطية. الديمقراطية هي مساحة "روحية" أي مساحة حوار بشري حول السلطة. وليس ثمّة من طريقة لتغيير المؤسسات غير الخطاب المتبادل حول ما نؤسسه معا.
لكنّ التحادث مع البشر ليس حديثا من أجل الله؛ بل من أجل من يعيش معنا؛ ولذلك لا يوجد واجب -حسب رورتي- إلاّ ما يجب علينا تجاه "مواطنينا" (fellow citizens)، من يرافقوننا في الوطن؛ المواطنة أو المسؤولية المدنية هي سابقة على ما سمّاه أفلاطون "العقل"(69) لكنّ السؤال الذي يُطرح لا محالة هنا، وهو ما قدّمه فاتيمو: "ماذا نستطيع أن نفعل مع أناس هم -على ما يبدو- لا يتقاسمون معنا هذه المسؤولية المدنية، سواء أكان ذلك في داخل مجتمعنا أو خارجه؟..ماذا يحدث عندما نصل إلى مكان حيث يرفضوننا، كما هو الحال في أجزاء من العالم الإسلامي؟"(70)
هذا التساؤل الذي صدر عن فاتيمو ليس له من معالجة -حسب رورتي- غير العمل على إعادة أوروبا إلى "رسالتها الحضارية"، وهي أنّ أوروبا ليست فقط هيمنة أو رأسمالية بل أيضا حضارة. في هذا الأفق لا يمكن معالجة أيّ جزء من الإنسانية على أنّه مصدر"كراهية". ينبغي مساعدة الشعوب على نسيان الاستعمار، وذلك بـــ"إعادة تأهيل" تلك الرسالة الحضارية. ولذلك ينبّه رورتي إلى أنّ الرابط بين المسيحية وبين "إعادة اختراع" الديمقراطية ربّما كان مجرّد رابط عرضي وليس قدرا؛ وإلاّ فإنّ الديمقراطية لن تنجح إلاّ في مجتمع مسيحي(71) يبدو أنّ العلاقة بين الديمقراطية والدين ليست علاقة بديهية. ولذلك لا يتردد رورتي في الاستدراك قائلا:
"مهما كان الأمر، يبدو لي أنّ فكرة إجراء حوار مع الإسلام هي بلا فائدة(pointless). لم يكن ثمّة حوار بين الفلاسفة (the philosophes) وبين الفاتيكان في الثامن عشر، ولن يكون هناك حوار بين ملالي (mullahs) العالم الإسلامي وبين الغرب الديمقراطي...ولكن لحسن الحظ، فإنّ الطبقة الوسطى المثقفة في البلدان الإسلامية سوف تحقّق تنويرا إسلاميّا، لكنّ هذا التنوير لن يكون له أيّ صلة بــحوار مع الإسلام" (72)
بدلا من ادّعاءات الحوار بين جهازيْ سلطة متصارعين، علينا التفكير في انتهاج سبيل التنوير؛ لكنّ أهمّ شيء في هذا التنوير أنّه لا يأتي من الخارج. التنوير ليس حوارا مع الآخر؛ بل هو حركة طبقة مثقّفة تحاور تراثها من الداخل. هكذا فقط يمكن للدين أن يدخل في أفق الديمقراطية. بيد أنّ عنصر الطرافة هنا هو أنّ رورتي وفاتيمو يميلان إلى فهم درس الديمقراطية بوصفه درسا سياسياًّ يقدّم صيغتين مختلفتين من هاجس واحد: إنّه هاجس "الحب". صيغة تأويلية (فاتيمو، غادمير..) تعمل على "تملّك" جديد للرسالة المسيحية حول "الله محبة"؛ وصيغة براغماتية (رورتي، ديوي..) تعمل على "تبرير" الديمقراطية على أساس "التحادث" الذي لا يسوغ فيه إلاّ مبدأ واحد "أنّه لا قانون إلاّ الحب"(73) تحتاج الديمقراطية إلى فكر لا مضمون له سوى الحب، ولا ضرّ إن كان حبّا "دينيّا" أم حبّا "علمانيّا".
وحده الحبّ يخلق نمطا من الانتماء أو من "التبعيّة" التي لا نتمرد عليها. وحسب فاتيمو فإنّ شعوره بأنّه "مسيحي" ليس له من معنى سوى أنّه يشعر بتبعيّة ما تجاه "التقليد الكتابي"؛ هذا الشعور بالتبعيّة تجاه تقليد روحي مخصوص هو شكل الحبّ. وهو نوع التبعيّة الوحيد الذي نقبل به: إنّه التبعيّة "تجاه الناس الذين نحبّهم"(74) لكنّ رورتي – الفيلسوف العلماني - يفضّل كلام ديوي عن "إيمان مشترك" (A Common Faith) بين جميع البشر في العالم: الإيمان بأنّنا جزء من كلٍّ عظيم هو الكون، الذي لا يعدو أن يكون "بانثيوسيّة رومانسية واسطة النطاق"(75). وعلى عكس فتيمو هو يتصوّر أنّه ليس ضروريا عندئذ أن يتمّ الإعلان بشكل كنسيّ عن وجود "الله"ومحورة الحياة حوله.
أمّا آخر نقطة في هذا الحوار ما بعد الحديث عن الإيمان فقد تعلّقت بمسألة "الجنس" في ضوء تساؤل طرحه فاتيمو في بحث آخر:" الأخلاق دون التعالي؟"( Ehics without Transcendance ?). إلى أيّ مدى يمكننا أن نبرّر أخلاقنا أو قيمنا من دون أيّ إيمان بشيء يتجاوز كينونتنا في العالم؟ هل يمكن أن نبرّر الأخلاق من دون أيّ حاجة إلى المقدّس؟ يؤكّد فاتيمو على أهمّية رفع الكنيسة للموانع الجنسية؛ لكنّ الكنيسة توجد دوما على خط التماس بين الجنس و"الطهارة" (purity )، والمفارقة هنا هي حسب تعبير رورتي:" إنّه بمجرّد اختزال المسيحية في الدعوة إلى أنّ الحب هو القانون الوحيد يفقد مثال الطهارة أهمّيته"(76). بين البشر لا يوجد حبّ عمودي، قائم على "التعالي" فقط. ومن دون محبّة أفقيّة لا وجود لأخلاق؛ بل إنّ المسائل المتعلق بالطهارة وبالأخلاق الجنسية هي قد انتقلت -حسب فاتيمو- من الكنيسة إلى "البيو-إتيقا"؛ وصار من "عدم اللياقة" اتهام الكنيسة بأنّها تدافع عن تصوّر "طبيعي" للجنس. لكنّ المشكل -في رأي رورتي- أعمق من ذلك؛ لأنّه يحتاج هنا إلى إشارات دريدا الطريفة حول العلاقة بين "الجنس" و"الميتافيزيقا"(77)
وزبدة هذا الحوار هي أنّ مستقبل الدين يقع "ما وراء الإلحاد والإيمان"؛ إنّه يحتاج إلى صيغة " غير أخرويّة(noneschatological)" عن كينونة "الروح". روح لا تجد كمالها في "الذات" الديكارتية بل في شيء آخر(78)