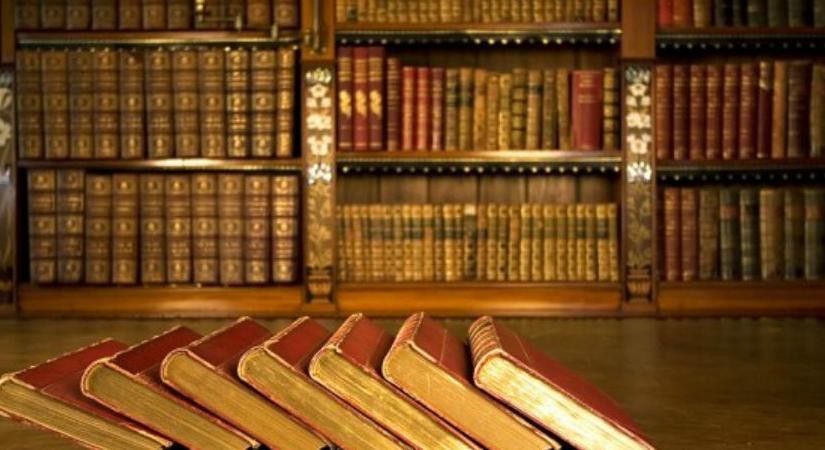دراسة تطبيقيّة في محاولات الأصوليّين «الشاطبي نموذجاً»
بلخير عثمان | أستاذ الفقه الإسلامي، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر.
يمكن أن يسهم النقاش في قضايا تجديد المنظومة الأصولية في إنضاج فكر أصولي تطبيقي يرشد تنزيل الأحكام وتطبيق الشريعة، ومن ثم يكتسب أهمّيته العملية، فقضية تنزيل الشريعة وتطبيقها قضية حيويّة، خصوصاً مع تنامي الدعوة إلى حاكمية الشرع، حيث أصبحت مجالاً للصراع الفكري، وموقع نظر ومحك اختبار نجاح أو فشل.
وإذا كان المرء يطمئن إلى أن أطوار التأليف في أصول الفِقه عرفت ازدهاراً أسفر عن ظهور مؤلفات ذات جودة عالية، فإنه يطمئن تمام الاطمئنان أيضاً إلى أن التجديد في علم أصول الفِقه ظل موجوداً عبر التطور التاريخي؛ حيث نجد نماذج من المجتهدين تعدّ من أجود الحلقات الإبداعية، فكثير من العلماء والباحثين يعدّون الشاطبي والقرافي وابن القيم ـ رحمهم الله تعالى ـ مجددين في علم أصول الفِقه من خلال ما أتوا به، فالنـاظر في كـتاب الموافقات مثلاً، ومن خـلال محـاورة الإمام الشـاطبي لتلك الشخصية المفترضة(1)، تتبيّن معالم مشروع إصلاح لعلم أصول الفقه، إصلاح خرج من رحم سهر الليالي، ومكابدة معاناة الطريق. وقد أكّد كل من تناول كتاب الموافقات بالدراسة أنه قد «سَرَت روح التجديد في معظم ما تناوله ذلك المؤلف من مسائل وفصول»(2)
فكرة التجديد:
لا بدَّ من جعل أحد أهم اهتمامات بناء المباحث الأصولية متوازنة بين فهم النصوص الشرعية، وتنزيلها على الوقائع والمحالّ، وإيلاء هذه الخاصّية لأحكام الشريعة الخالدة كل العناية والاهتمام، وجعل مضمونها قاعدة كلية شاملة، فتكون بذلك إحدى ثوابت المنهج العلمي الأصولي.
فمجرد النظر في تاريخ علم أصول الفقه وتتبّعه واستقراء تطوره يكشف الاهتمام بالتأصيل: أي بالتنظير، والذي نلمسه هنا ونلحظه هو الاهتمام بمنهج الفهم والاحتفاء به وتقعيده، رغم أنهم ملكوا قواعد وضوابط التنزيل؛ ولكن غاب تقعيده والانتباه له والتصدي له في المباحث الأصولية، فأصبحت مباحث الأصول تنزع منـزعاً نظرياً، يلمس فيه الإبداع في وسائل تسديد الفهم والاستنباط، وتهمل وسائل تسديد التنزيل والتطبيق.
وفي الحقيقة كان هذا هو الحال، إلا انتباهات قليلة لبعض الفقهاء والأصوليين، الذين أدركوا أهمية الجانب الثاني دون أن يكشفوا عن مناهج هذه الصياغة، وضوابط مراعاة هذا الواقع عند تنزل الأحكام، ومنهم الإمام ابن القيم، والعز بن عبد السلام والإمام الشاطبي.
لذلك لا بدَّ من بعث روح التوازن بين قواعد الاستنباط وقواعد التطبيق من خلال ربط علم أصول الفقه بالهدف من الشريعة، وهو تمثّلها على مستوى الواقع البشري؛ ذلك أنّ توقيع الأحكام هو غاية التكليف وثمرته، ونحن أمام حالتين:
ـ إما أن تبقى الأحكام على مستوى النـظر حبيسة الذهن ولو في أعلى صورة لها من الصحة، فإنها لا تغني شيئاً في ميزان الخير والسعادة.
ـ وإما تطبيقها دون ضوابط منهجية وقواعد تسديد لهذا التطبيق، فتؤدي إلى عدم تحقيق مقاصدها الشرعية، والغاية من تشريعها، أو يؤدي هذا الأمر إلى عصيان الأحكام في وقت قصير.
فتلافي الحالتين إلى أحسن منهما يكون ببيان صياغة سليمة تستخرج الحكم وفـق محله.
والمقصود بالتوقيع هنا: النظر الشرعي لاستخلاص حكم شرعي يحكم أفعالاً أو تصرفات أو قضايا، مقترناً بحيثيات تلك الوقائع والنـوازل.
إن مفهوم التوقيع وإجراء الأحكام وحتى التنزيل ـ كما يقول النجار ـ كان يمكن ألا يُبحث ولا ينصب عليه نظر، لكن الشرع أصّل مفهومه ـ كما سوف نراه ـ واحتل مكاناً راقياً في المنظومة التشريعية لوجود معطيين مهمين، احتكم إليهما كل من أهمته فكرة تنـزيل أحكام الشرع وهما:
ـ أن لشريعة الإسلام مقاصد وغايات، وقد وُضِعت هذه الشريعة ـ من خلال أحكامها المختلفة ـ لأجل تحقيقها لتلك المقاصد والغايات بما يصب في النهاية في مصلحته العباد.
ـ أن الأفعال والوقائع والأحداث تختلف فيما بينها اختلافاً عظيـماً، بل إن الاختلاف سُنَّة من سنن الله في الخلق، فلا تكاد تجد واقعة تشبه أخرى.
إن اعتماد رؤية واحدة في النظر الشرعي قائمة على وجود حكم لمسمًى معيَّنٍ، كالحدِّ الشرعي للسرقة، وعدم إلحاق ولد الزنا بنسب الأب، وأن القتل العمد لا يثبت بالمثقل.. مع وجود وقائع كثيرة لمسمى واحد، ووجود مقصد واحد ـ يؤدي أحياناً إلى مخالفة مقاصد الشارع من وراء تشريع الأحكام؛ لذلك احتجنا لنظر زائد عن نظر الاستنباط، وهو نظر التنزيل.
وإنما سمي تنـزيلاً؛ لأنه نزول من مستوى النظر والتجريد إلى الواقع ومفردات النازلة، لأن التعريف يذكر مستوى النظر الشرعي، وهو لا يكون إلَّا بالعقل مستنداً إلى الشرع، ومستوى آخر وهو الواقع، فكان ذلك النظر مقترناً بتلك الواقعة فكأنه نزول إليها؛ لينتج عنه حكم لتلك الواقعة بقواعد ذلك النظر.
إن الاجتهاد التنزيلي اجتهاد قائم بذاته، وقسيم للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية وهو النوع الثاني، وهذا يُثْبِت أن مرحلة الفهم تعتمد نظراً (قواعد وآليات) يقوم على إثبات الحكم بالمدارك الشرعية، وأن مرحلة تنزيل الحكم تحتاج نظراً آخر (قواعد وآليات) يتعلّق بتعيين المحل، وذلك ظاهر من خلال التعريف السابق.
مظاهر التجديد في البحث الأصولي:
سنحاول إعطاء بعض المظاهر التي يمكن أن تكون انعكاساً لمسألة العودة بأصول الفقه إلى التوازن بين المباحث النظرية والتطبيقية:
محاولة ربط العلم بالعمل
يجدر التنبه إلى أنّ الثمرة المطلوبة من العلم هي الثمرة العملية، وهذه مقدمة تُبعد ما أَلِفَتْه النفوس والعقول من النزوع النظري في الكتابات الأصولية، لذلك فمحاولة التجديد والابتكار في هذا العلم، لُبُّهُ ربط العلم بالعمل، وعليه يقوم هذا المشروع الإصلاحي من خلال محاولة إعادة التوازن إلى علم أصول الفقه بتغليب روح العمل، وقد أتى الله تعالى بأدلة التوحيد ليتوجه الناس إليه وحده، فقال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾(3)
وقال الإمام الشاطبي أيضاً في مقام إبراز ارتباط العلم بالعمل: «العلم الذي هو العلم المعتبر شرعاً ـ أعني: الذي مدح الله ورسوله وأهله على الإطلاق ـ هو العلم الباعث على العمل»(4)
كما أنّ الشرع استقبح ما لا ينبني عليه عمل من العلوم: فقد قال الإمام الشاطبي في المقدمة الخامسة: «كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدلّ على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب والجوارح من حيث هو مطلوب»(5)
ومن أدلة بيان وجوه عدم الاستحسان:
ـ استقراء الشريعة دلَّ إلى أن الشارع يعرض عمّا لا يفيد عملاً مكلفاً به، وشواهد ذلك من القرآن الكريم متعددة، كقوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(6)، فأجاب الله عز وجل بما يتعلّق به التكليف العملي، وقصده في ذلك الإعراض عن قصد السائل عن الهلال.
وأيضاً فشواهد عدم استـحسان الشرع له وإعراضه عما لا يفيد عملاً واضحٌ من خلال تَتَبّع أحـوال السُّنَّة النـبوية، ومنـها ما روي عن أنس بن مـالك رضي الله عنه، قال: «بينما أنا والنبي (ص) خارجان من المسجد، فلقِيَنا رجلٌ عند سدَّة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي (ص): مـا أعْـدَدْتَ لَـهَا؟ فكـأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت».
وكذلك تشرّب الصحابة ذلك فكرهوا العلم بـما لا يفيد عملاً، ومنـه تأديب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ لما تكلف السؤال عن متشابه القرآن(7)
الدعوة إلى استقلال المباحث الأصولية
حينما نتوجه إلى استقراء آراء مجتهد كالإمام الشاطبي وموقفه من كثير من المباحث الأصولية نجده متذمراً مما آل إليه الحشو في مؤلفات علم الأصول، فنجده مثلاً يقول: «وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها..»(8)
لا شك أن الشاطبي رحمه الله في هذه العبارات وغيرها يكْشف عن عدم رضاه عن الطروحات التي آلت إليها كثير من مباحث علم أصول الفقه. لذلك فقد دعَا إلى استقلال مباحث علم أصول الفقه، وإخراج ما كان فيها عارية لا يؤدي غرضاً تطبيقياً، فقال الشاطبي رحمه الله : «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوَضْعها في أصول الفقه عارية، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختَصْ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مُفيداً له، ومحقّقاً للاجتهاد فيه، فإذا لم يُفِد ذلك فليس بأصلٍ له»(9)
وقد توجد مسائل أصولية ينبني تحتها عمل، إلَّا أنه لا يحْصل من الخلاف فيها خلاف في الفروع الفقهية، فحشوا أصول الفقه بوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله، كسابقةٍ عادية في المسائل الأصولية ينبغي تخليص أصول الفقه منها(10).
ووِفق التقعيد السابق في بيان ما هو من أصول الفقه وما ليس منها، «يخرج كثير من المسائل الأصولية التي تكلم عنها المتأخرون وأدخلوها فيها»(11)، ومما يذكر من تلك المسائل ما يلي(12):
أولاً: مسألة ابتداء الوضع
فقد مهّد الأصوليون المباحث اللغوية بالحديث عن مبدأ وضع اللغات، وقد اختلفوا كالآتي:
ـ القول بالتوقيف: وذلك عن طريق وحي الله تعالى، لا عن طريق اصطلاح الناس عليها، ومن الأصوليين الذين بحثوا مسألة ابتداء الوضع، وأعطوها حجماً مثل غيرها الإمام الآمدي(13).
وإلى هذا الرأي ذهب الأشاعرة وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء محتجين بقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَـئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَـؤُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾(14) فدلّت الآية على أن آدم والملائكة لا يعْلمون إلا بتعليم الله تعالى(15)
ـ القائلون بالاصطلاح: وهم الذين قالوا بأن مبدأ اللغات من وضع الناس واصطلاحهم عليه، وذلك «أن واحداً أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها، ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار، كما يفعل الوالدان بالولد الرضيع، وكما يعَرّف الأخرسُ ما في ضميره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى»(16)
وإلى هذا الرأي مال جماعة من المتكلمين.
ـ المتوقّفون: الذين يرون أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته، وأما وقوع بعضه دون بعض فليس عليه دليل قاطع، وإليه مال جماعة من المتأخرين(17).
وبإمعان النظر في طريقة معالجة الأصوليين لهذه المسألة، يُلاحظ جليًّا أنهم خَصُّـوها ببحوث مستفيضة تكاد تربو عما جاء به اللغويون، والمتأمل يجدُ نصّاً للإمـام أبي حامد الغزالي، يؤكد كلام الشـاطبي رحمه الله وإنْ كان سابقاً له بقرون، قال: «أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطْمع في معرفته يقيناً إلا ببرهان عـقلي، أو بتواتر خبر، أو سمع قاطع، ولا مجال لبرهان العقل في هذا، ولم يُنقل بتواتر، ولا فيه سمع قاطع، فلا يبقى إلا رجْم الظن في أمرٍ لا يرتبِط به تعبّد عملي، ولا تُرهِق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه إذن فضول لا أصل له»(18)
ثانياً: مسألة تتعلّق بمباحث لها أصول كلامية
تمتد الدعوة إلى إخراج ما لا ينبني عليه عمل من المسائل الأصولية، لتشمل المناداة بالتخلي عن ذِكر المسائل التي لها أصول كلامية، كمسائل شكر المُنعم، ومسائل المعدوم، وهل كان النبي (ص) مُتَعبَّداً بشرعِ من قبله؟ ومسألة البحث في هل المباح تكليف؟ إلى غيرها من المباحث.
ولقد بحث الأصوليون القدامى هذه المسائل، وأجْهدوا أنفسهم ودواوينهم الأصولية في البحث فيها، وبحثها المتأخرون، غير أن هؤلاء المتأخرين أرجعوا أسباب تناولها إلى اتباعهم لنَسَق المتقدّمين في الـتأليف ومجاراتهم، فالفطام عن المألوف شديد، والنفوس عن الغريب نافرة(19).
إلا أنّ مرارة الفطام والإقبال على التجديد أهون في التمادي في التقليد.
ومن ضمن تلك المسائل الكلامية مسألة أمر المعدوم، والمتتبع لطريقة معالجة الأصوليين لهذه المسألة يجدهم يعترفون ابتداءً بأنها من أصعب المسائل الأصولية، وأن الخلاف حولها لا ينبني عليه عمل، ولا يرجى منه تحصيل الفائدة، ومـن هنا تأتي ضرورة حذفها من مباحث علم أصول الفقه، والعودة ـ إن أريد التفصيل فيها ـ إلى مستنداتها في مظانها الأصلية من مدونات علم الكلام، وعدمُه يوقع الأصوليين في مفارقات تفقدهم في غالب الأحيان طابع التوفيق بين الاتجاه الكلامي والدرس الأصولي(20).
ثالثاً: مسألة تتعلّق بالمباحث المنطقية
الملاحظ على تطور مسيرة الفكر الأصولي هو توجهه لتأسيس نمط تفكير مميز، يجسد الخصوصية الذاتية للثقافة الإسلامية بعيداً عن الاستعانة بالثقافة اليونانية، غير أن الملاحظ هو تغيّر هذا النسق ابتداءً من القرن الخامس الهجري، وبدأ عمل الأصوليين يمزج بين الأدوات المعرفية للثقافة الإسلامية والأدوات المعرفية والمنهجية للثقافة اليونانية، فبعدما كان المنظرون المسلمون لا يلتفـتون إلى طريق المناطقة، وكانوا يعيـبون مباحثها ويثبتون اعتلالها، جاء أبو حامد الغزلي ومزج كتب الأصول بأصول المنطق، وخلطه به، ثم بعده تكلم في تلك المسائل علماء المسلمين بالإغراق في التفصيل(21)
فقد أوْرد الإمام الغزالي مقدمة منطقية، صرّح بأنها ليست من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة؛ بلْ هي مقدمة العلوم كلها، ومن لم يحِط بها علماً ودَرْكاً فلا يُوثَق بعلمه ومعرفته.
وقد دأب المصَنِّفون في علم الأصول على نهجه فأصبحت المسائل المنطقية نسَقاً مُطَّرداً في مصنفاتهم.
ولعلّه من الجدير بالذكر التنبيه على أن المطالبة باستقلال علم أصول الفقه، والدعوة إلى إخراج ما ليس منه، لا يراد منها إبعاد المشتغل بالشريعة عن التضَلّع في بعض العلوم الأخرى، فلا بدّ أن يكون الناظر في أحكام الشريعة متضَلِّعاً ومستوعباً لتلك العلوم بالقدر الذي يستطيع به الانتصاب لمهمة النظر والاجتهاد، والمآخذ ترجع إلى كون تلك العلوم والتبحر فيها من علم أصول الفقه، ومن أدخلها فيه فمن باب خلط بعض العلوم ببعض.
مبرّرات التجديد وضروراته:
لا يُخفى أن أحد الأبعاد المهمة في عملية التوقيع والتنزيل والإجراء هو التحقّق من حصول المقاصد الشرعية في آحاد الوقائع والجزئيات؛ ذلك أنه لما كان «المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين هو تفهيم ما لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم»، فقد حق على كل ناظر في المسائل الشرعية استحضار هذا القصد؛ لأن حقيقة الاجتهاد تكمن في «التحويـم على إصابة قصد الشارع»(22)، ومن ثم يبرر البحث في الآليات التي بها يتحقق من حصول المقاصد الشرعية في آحاد أفعال الناس، ووقائع الحال.
فإذا علم المقصد من الحكم بصفة نظرية، فإن على المجتهد أن ينظر في ذلك المقصد من حيث ما يؤول إليه من تحقيق للمقاصد أو عدمه، حينما تُجرى الأحكام المجرّدة مشخّصة على أفعال المكلفين؛ ذلك أن معرفة المقصد الشرعي لا يمكن دون اللجوء إلى تتبع الحكم في الواقع، فرب عمل يدخل على شخص صلاحاً، ويدخل على غيره الفساد، وإنما ذلك يكون لاختلاف المناطين، وبالنظر لحال الوقت والشخص.
فينبغي الالتفات إلى المقاصد الشرعية، وخصوصاً إلى الأيلولة الواقعية للمقاصد الثابتة للحكم نظراً، وذلك عندما تتنزل على الأفعال والوقائع، وينبه في هذا الالتفات إلى أنه ينبغي أن يتم إجراء الأحكام عليها بالكيفية التي تتحقق بها المقاصد(23)
ـ قال الإمام الشاطبي: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فَهْم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط على فهمه إياها».
ومراده بوصف الكمال في معرفة مقاصد الشريعة التحقق من إدراكها كما وضعها الشارع لا من حيث أدركها المكلف؛ لأن هذا الأخير قد يرى بأن مقاصد الشرع ما لاح له عند أول اختبار، ولا يعرف الثابت منها والظاهر، والمنضبط، والمطرد.
وأما مراده بالوصف الثاني فهي المعرفة التي تُتِيح له إدراك الحكم الشرعي وفهمه، وهي من وسائل الأول وخادمة له.
إن الـغفلة عن معاني قواعد تسديد التوقيع في المباحث الأصولية، ثم الغفلة عن ضـبط قويم لهذه القواعد، قد يؤدي إلى عكس المقاصد التي شرعت لأجـلها الأحكام، كما أنه يؤدّي إلى عدم تمثل الناس لهذا الهدي الإلٰهي، وعصيان الأحكام في وقت قصير.
بل لو غفل عن هذا التسديد، وأجيز التطبيق الآلـي «مع ما آل إليه واقع المسلمين من تعقيد شديد وتشابك في الأسباب، فإن الضرر الذي سيحصل ربما يتجاوز ما يلحق المسلمين من حرج إلى أصل الوضع العقدي لِقَـيُّومِيَة الشريعة، وحينئذ فسيؤول الأمر إلى عكس الواجب المرغوب».
وقد لخص الأستاذ أحمد الريسوني قاعدتين جليلتين، هما:
•
قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع، وألا يقصد خلاف ما قصد.
• من ابتغى في التكاليف ما لم تُشَرّع له فعمله باطل.
والمكلف في ذلك أمام أمرين:
أولهما: أن يؤدي تمثله لحكم إلى ما لا يتحقق معه مقصد الشارع من حصول مصلحة المكلف، وذلك كالفعل المأذون فيه «يكون فيه مصلحة للنفس ومضرة للغير».
فلأنه لا يحقق مقصود الشارع، رغم أن الشـرع أقره في التشريع جلباً لمصالح ودرءًا لمفاسد، ولكن لما كان قصد المكلف غير قصد الشارع، أو لما أوقع الفعل على أوجه من الواقع منعت حصول المقصد، منعه الشارع. قال الإمام الشاطبي عنه: «وإما فاعلٌ لمأمور به على وجه يقع فيه مضرة، مع إمكان فعله على وجه لا يلحق فيه مضرة، وليس للشارع قصد في وقوعه على الوجه الذي يلحق به الضرر دون الآخر».
ثانيهما: أن يتوخى تمثلاً لمجرد التكاليف عارية عن المقاصد التي شرعت لأجلها، وهذا باطل أيضاً؛ «لأن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي، فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد؛ إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصداً آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له».
..............
المراجع والمصادر والهوامش:
(1)وذلك في مثل قوله: «أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم، الطالب لأسنى نتائج الحلوم... فإنه قد آن لك أن تصغي إلى مـن وافـق هواك هواه» ص 17، ثم يعـود لمنـاجاته بقولـه: «ليـكون أيها الخل الصفـي، والصديق الوفي هذا الكتاب عـوناً لك في سلوك الطريق..»، ص 19، الموافقات، ج 1.
(2)كمال راشد، مجلة المعيار، ص 214، كلية أصول الـدين والشريعة والحضارة الإسلامية؛ قسنطـينـة، العدد: الثاني، سنة النشر 1423هـ/2002م.
(3)سورة محمد، الآية رقم: 19.
(4)الموافقات، ج 1، ص 51.
(5)الموافقات، ج 1، ص 34.
(6)سورة البقرة، الآية رقم: 189.
(7)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: القضاء والفتيا في الطريق، تحت رقم: 6734.
(8)أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في السلب في النفل، تحت رقم: 974. والقصة كاملة رواها الدارمي عن سليمان بن يسار «أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعدّ له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه، وقال: أنا عبد الله عمر، فجعل له ضرباً حتى دَمِي رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي». أخرجه الدارمي في سننه، باب: التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سُنَّة، تحت رقم: 144.
(9)الموافقات، ج 1، ص 31 وص 32.
(10)الموافقات، ج 1، ص 31.
(11)الموافقات، ج 1، ص 33.
(12)الموافقات، ج 1، ص 31، ص 32.
(13)هو أبو الحسن علي بن أبي علي التغلبي الآمدي (ت سنة 631هـ) شافعي المذهب، من مؤلفاته في أصول الفقه: الإحكام في أصول الأحكام. (ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية للإسنوي، ج 1، ص 74).
(14)سورة البقرة، الآيتان رقم: 30 ـ 31.
(15)الآمدي، أبو الحسن علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 110، دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة: الأولى، سنة النشر: 1404هـ، تحقيق: د. سيد الجميلي.
(16)المرجع السابق، ج 1، ص 110.
(17)المرجع السابق، ج 1، ص 111.
(18)الغزالي؛ أبو حـامد، المستصفى، ص 181.
(19)المرجع السابق، ص 09 (بتصرف).
(20)عبد الحميد العلمي، منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، ص 62.
(21) المرجع السابق، ص 64. (بتصرف).
(22)السيوطي؛ جلال الدين، صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، ص 113، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: بدون سنة النشر: بدون تعليق: الدكتور سامي النشار.
(23)الموافقات، ج 4، ص 106.