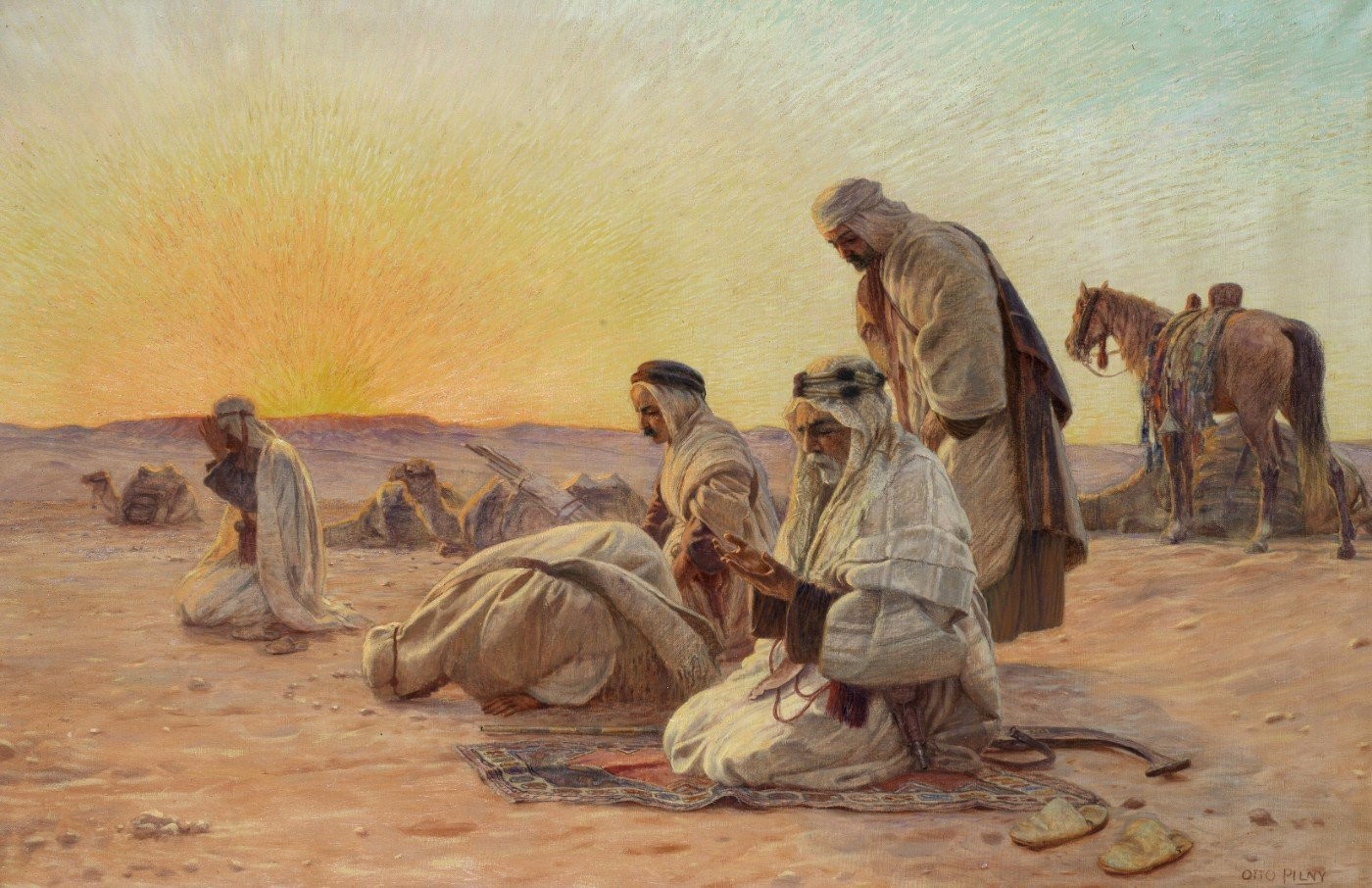حسن الخطاف | أستاذ مشارك بجامعة أرطغلو التركية.
من المعلوم أنّ المدرسة الاعتزالية ـ بشقّيها البصري والبغدادي ـ كان لها حضور لا يُنكر في الساحة الإسلامية، ولا سيما في عهدها الأوّل قبل انشقاق أبي الحسن الأشعري عنها.
كان انفصال واصل [ت: 131] عن الحسن البصري [ت: 110] بداية ظهور المعتزلة كمدرسة رسمية فكّرية لها اتجاهاتها ومنهجها، ولها أعداؤها ومواليها، لكن فكر واصل والمعتزلة لم يأتِ من فراغ؛ بل كانت لهم جذور تصلهم بمن قَبْلهم، وقد ذكرتْ لنا كتبُ المِلل والتاريخ شخصياتٍ سبقت واصل بن عطاء، وأن لهذه الشخصيات أفكاراً مركزية تشكِّل ـ مع فكر واصل ومن تبعه ـ قواسم مشتركة، غير أن هذه الأفكار التي وجدت قبل المعتزلة كانت بمثابة خمائر أو بذورٍ للفكر المعتزلي، ولم تكن على شكل نسق كلامي كما عرفت عند المعتزلة. تسعى هذه المقالة إلى رصد الشخصيات السابقة للفكر الاعتزالي، والتي كانت أفكارها بمثابة الجذر للمعتزلة تاريخياً وفكرياً، ويمكن أن نطلق على هذه الشخصيات اسم القدرية الأوائل.
المقصود بـ «القدرية الأوائل» أولئك النفر الذين سبقوا واصل بن عطاء، فمن هؤلاء؟ وكيف تأثر بهم واصل؟
نجد جواباً لهذين السؤالين في النصين التاليين؛ يقول الأسفراييني [ت: 471] «إن معبد الجهني [ت: 80]، وغيلان الدمشقي [ت: 99] كانا يضمران بدعة القدرية، ويخفيانها عن الناس، ولمّا أظهرا ذلك في أيام الصحابة لم يتابعهما على ذلك أحد، وصارا مهجورين بين الناس بذلك السبب، إلى أيام الحسن البصري [ت: 110]، وكان واصل... يضمر اعتقاد معبد وغيلان، وكان يقول بالقدر»(1)
ويقول الشهرستاني [ت: 548] «وأما الاختلافات في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ويونس الإسواري [ت: ؟] في القول بالقدر، وإنكار إضافة الخير والشر إلى القدر، ونسج على منوالهم واصل بن عطاء الغزال [ت: 131] وكان تلميذ الحسن البصري [ت: 110]، وتتلمذ له عمرو بن عبيد [ت: 144]، وزاد عليه في مسائل القدر»(2).
يُبرز هذان النصان مُعْطَييْن:
المعطى الأول: أن القدرية نِسْبَةٌ إلى القول بالقدر، والمراد به هنا إنكار إضافة الخير والشر إلى الله، والمراد بالخير والشر هنا أفعال العباد وتصرفاتهم؛ أي إن الإنسان مسؤول عن تصرفاته؛ لأنه هو المحْدث لها، وأن هذه التصرفات لا تسند إلى الله تعالى لِما فيها من قبحٍ وشرور؛ يقول الإيجي [ت: 756]: «ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم»(3).
الذي ينظر إلى الواقع الذي نشأ فيه القول بالقدر يجد أن المسألة كان ينظر إليها من الناحية الأخلاقية، لا من الناحية الفلسفية، فالبُعد الأخلاقي كان حاضراً ومؤثراً في نشوء القول بالقدر، وهذا البُعد الأخلاقي ـ الذي كان باعثاً على بروز هذه القضية ـ يُفهم من مجيء معبد الجهني [ت: 80] وعطاء بن يسار [ت: 103] إلى الحسن البصري [ت: 110] قائلين له: «يا أبا سعيد إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين، ويأخذون الأموال، ويفعلون ويفعلون، ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله، فقال: كَذَبَ أعداءُ الله»(4)
المعطى الثاني: إن معبد الجهني [ت: 80] أول من تكّلم بالقدر، جاء في صحيح مسلم: «عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَال: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (ص) فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّـقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْـنُ عُمَـرَ بْنِ الْخَطَّاب [ت: 73] دَاخِلاً الْمَسْجِدَ... فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ، يقرؤون الْقُرْآنَ... وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، لَـوْ أَنَّ لِأَحَدِهِـمْ مِثْـلَ أُحُـدٍ ذَهَـباً فَأَنْفَقَهُ، مَـا قَبِلَ اللهُ مِنْـهُ حَـتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ»(5).
إذاً أولُ من تكلّم في القدر معبدٌ(6)، ولكن ليس معبداً هو الوحيد الذي تكلّم بالقدر؛ فهناك غيلان الدمشقي [ت: 99]، كما أن هناك الجعد بن درهم [ت: 120]، وجهم بن صفوان [ت: 128].
فمن هؤلاء؟ وكيف أثروا في المعتزلة؟ ولماذا قتل هؤلاء الأربعة؟
معبد الجهني
هو أبو روعة معبد بن خالد الجُهَني البصري(7)، وقيل: معبد بن عبد الله بن عويمر(8)، وقيل: هو معبد بن عبد الله بن عليم(9)، وقيل: عكيم بدل عليم(10)، وكما اختلف في نسبه اختلف في وفاته، وكيف توفي.
قيل: صلبه عبد الملك بن مروان [ت: 86] في دمشق سنة ثمانين ثم قتله(11)، وقيل: عذبه الحجاج [ت: 95] ثم قتله(12)، وروي في هذا الشأن أن الحجاج كان يعذبه بشتّى أصناف العذاب، فلا يجزع ولا يستغيث(13)، وكان قد خرج إلى الحجاج يحاربه في كل المواطن(14)
أما عن سنة قتله فالأرجح أنه قُتل سنة ثمانين(15)، وإذا اختلف في اسمه، وسنة قتله فقد اتفق مَنْ تَرْجَمَ له أن قَتْله كان بسبب خروجه على بني أُمية(16).
اتصف معبد بالعبادة والزهد(17)، وهو تابعي ثقة لا يُتهم بكذب(18)، حدَّث عن عدد من الصحابة ووثقه ثُلَّةٌ من علماء الجرح والتعديل، منهم يحيى بن معين [ت: 233] فقد قال عنه: «ثقة»، وقال فيه أبو حاتم الرازي [ت: 327]: صدوق في الحديث(19)، وقال ابن حجر العسقلاني [ت: 852هـ]: «تابعي صدوق»(20).
روى له ابن ماجه حديثاً واحداً (21)، وروى له أحمد(22)والبيهقي(23) والطبراني(24).
بعد هذا، أكان القول بالقدر نابعاً من فكر معبد [ت: 80] كما تقول معظم الروايات السابقة؟ أم إنه استقى هذا القول من غيره؟
تحاول بعض كتب أهل السُّنَّة أن تنسب فكرة القول بالقدر إلى مصدر غير إسلامي، ومصدر هذه الفكرة عند هؤلاء شخصية اختلف في اسمها، واختلف في المِلة المنتسب لها.
هذا الشخص الذي ادُّعي أن معبداً أخذ منه القول بالقدر؛ فهو عند ابن تيمية [ت: 728] «سيسويه» وديانته «مجوسية»، وفي هذا يقول: «روى أن أول من ابتدعه [أي القول بالقدر] بالعراق رجل من أهل البصرة، يقال له سيسويه من أبناء المجوس، وتلقاه عنه معبد الجهني»(25).
ولعل ابن تيمية أخذ هذه التسمية من الإمام البخاري [ت: 256] الذي يقول: «سيسويه كان مجوسياً فادعى الإسلام»(26)، أو من اللالكائي [ت: 418] الذي أطلق على هذا الشخص اسم «سيسويه» وأنه أول من تكلم بالقدر(27)
واللالكائي نفسه يذكر في موطن آخر أن اسمه «سنسويه»(28). هذا الاختلاف في تسميته من قبل اللالكائي لا يعبّر ـ فيما نرى ـ عن خطأ في النسخ؛ لأنه ذكره مرة ثالثة باسم «سوسن»، يقول نقلاً عن الأوزاعي [ت: 157]: «أول من نطق في القدر رجلٌ من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانياً... فأخذ عنه معبد الجهني(29).
وفي مقابل الرواية السابقة يؤكد ابن حجر [ت: 852] أن الأسواري أول من تكلم بالقدر، وأن معبداً أخذ منه(30).
فهل سوسن أو سيسويه أو سنسويه، هو يونس الأسواري؟ أكان يدين بالمجوسية أم بالنصرانية؟
وسيسويه عند المحدثين مجهول كما يقول أبو حاتم الرازي [ت: 327]: «سيسويه... مجهول(31). يبدو مما سبق أن الشخص الذي أخذ عنه معبد هو بهذا الاسم الأخير» يونس الأسواري، ولعل يونس الأسواري هو المعاصر لمعبد، ومعبد أخذ منه القول بالقدر.
يونس الأسواري هذا، تعترف به المعتزلة، وتلقبه «بسيبويه»، يقول ابن حجر [ت: 852هـ]: «يونس الأسواري: أول من تكلم بالقدر، وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني، ذكره الكعبي [ت: 319] في طبقات المعتزلة، وذكر أنه كان يلقب بسيبويه»(32).
والذي يعضد هذا التوجه أن كثيراً من المعتزلة ينتسبون إلى الأسواري، منهم علي الأسواري [ت: ؟]، شيخ من شيوخ المعتزلة، وله مدرسة كاملة تسمى الأسوارية.
نجد بعد طول تمحيص أن مصدر هذه الرواية ما نقل عن الأوزاعي، عن طريق محمد بن شعيب بن شابور، وعليه ليس ببعيد أن يكون التركيب وضع على الأوزاعي قصد التشهير به، وتنفير الناس عنه، ويشهد لهذا الاحتمال أن الأوزاعي [ت: 157] كان شديد العداء للقدرية، كما أنه كان مُقرباً لبني أُمية، وهو الذي ناظره وأفتى بقتله(33)، وغيلان هذا تلقى القدرية من معبد الجهني، كما تبيّن سابقاً عن الأوزاعي نفسه، ويوجد تقاطع بين شخصية معبد [ت: 80] والأوزاعي [ت: 157]؛ فالأول كان قدرياً محارباً لبني أُمية، والثاني كان محافظاً معادياً للقدرية، موالياً لبني أُمية.
أما عن حسن العلاقة فقد وجد بعض رجال بني أُمية في الأوزاعي ـ إذا ما صحّ النقل ـ منفذاً لرغبتها في الحكم على غيلان الدمشقي بالقتل، وهو الذي أخذ القول بالقدر من معبد، وهذا الحكم ينبئ عن استغلال السلطة لبعض الشخصيات الفقهية لتنفيذ مآربها.
يتضح مما سبق أن القدرية ـ كطائفة كلامية ـ تنسب بشكل رسمي إلى معبد الجهني، وأخْذ معبد من يونس الأسواري ـ إن صح ـ يشبه أخْذَ واصل بن عطاء [ت: 131] أفكار الاعتزال والقول بالقدر ممن سبقه، ومع هذا يُعدُّ واصل المؤسس الرسمي للمعتزلة، والذين سبقوا واصل هم القدرية ومنهم معبد الجهني.
وإذا اتضح ذلك فإن العلاقة الجامعة بين معبد والمعتزلة هي القول بالقدر، ونقصد به مسؤولية الإنسان عن سلوكه، وقد تحول هذا المعنى على يد المعتزلة إلى نسق كلامي مترابط تحت عنوان «خلق الأفعال»، وقد أسهب المعتزلة في بيان هذه المسألة وما تعلّق بها(34)، مسخّرين لها جملة من الحجج العقلية والنقلية.
ولهذه المسألة بُعْدٌ إلٰهي، وهو أننا عندما نسند هذه التصرفات لأنفسنا؛ ننزه الله عمّا فيها من جورٍ وقبحٍ، وقد اهتم المعتزلة بهذا الجانب؛ لما فيه من تنزيه لله تعالى، وهذا ما يفسر وضع هذه المسألة تحت أصل من أصولهم، وهو «أصل العدل».
وتنزيه الله ـ وهو البُعد الآخر لمسألة خلق الأفعال ـ يظهر من خلال هذا الحدث الذي عاصره معبد الجهني [ت: 80]، وهذا الحدث يتمثل في قتْل يزيد بن معاوية [ت: 63] الحسينَ بن علي [ت: 61] وأكثر أهله، ثم مخاطبته عليَّ بن الحسين «يا علي، أبوك الذي قطع رحمي، وجهل حقي، ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما قد رأيت»(35)
أي كأن الله تعالى قلد يزيدَ الخلافة !
ولقد شعر معبد الجهني بخطورة الجبر فأخذ يحذر من هذا الوضع، وهذا ما دفعه للمجيء إلى الحسن البصري [ت: 110] برفقة عطاء بن يسار [ت: 103] قائلَين: «يا أبا سعيد إن هؤلاء الملوك، يسفكون دماء المسلمين، ويأخذون الأموال، ويفعلون ويفعلون، ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله، فقال: كذب أعداءُ الله»(36)
بعد أن تبيّن تأثير معبد الجهني القدري [ت: 80] بالمعتزلة في قضية القدر / خلق الأفعال، يتعين الحديث عن صلة الوصل التاريخية والفكرية بينهما، والمتمثلة بغيلان الدمشقي [ت: 99]؛ ليكون القول بالقدر متسلسلاً من معبد إلى غيلان إلى واصل بن عطاء.
فمنْ هو غيلان؟ وما المكانة الفكرية التي يحتلها؟ وما الأفكار التي تجمع غيلان مع معبد ومع المعتزلة وعلى رأسهم واصل؟
غيلان الدمشقي
هو غيلان بن مروان الدمشقي [ت: 99]، وقيل: غيلان بن مسلم(37)، كنيته أبو مروان(38)، من موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه (39)، كان فصيحاً بليغاً (40) وعنده حظ من العلم(41).
صنفه القاضي عبد الجبار [ت: 415] في طبقات المعتزلة، ووصفه بقوله: «له من الرسائل إلى إخوانه ما يدخل في مجلدات، تشتمل على التوحيد والعدل والوعد والوعيد والدعاء إلى الله، والتزهد في الدنيا»(42).
قتل غيلان على يد هشام بن عبد الملك [ت: 125](43) ، وإليه تنسب الغيلانية، كمدرسة من مدارس المتكلمين(44)، كانت له صلة بمعبد الجهني [ت: 80] فقد تعاصرا تاريخياً، وأثر معبد بغيلان فكرياً، فأخذ عن معبد القول بالقدر(45)، والقول بالقدر يمثل صلة الوصل التاريخية والفكرية بين معبد والمعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء [ت: 131](46).
وإذا ما صحّ قول القاضي عبد الجبار في ترجمته من أن له كتباً تشتمل على التوحيد والعدل والوعد والوعيد، يكون واصل قد تأثر به؛ إذ التوحيد والعدل والوعد والوعيد تُعدُّ أصولاً من أصول المعتزلة، ومفاد هذا أنّ واصلاً أخذ هذه الفكرة من غيلان الدمشقي، وقام بالتقعيد والتنظير لهذه الأصول، ولا سيما أن القاضي عبد الجبار [ت: 415] جعل واصل بن عطاء وغيلان الدمشقي من طبقة واحدة(47).
يضاف إلى هذا بقية آرائه التي تشكّل جسراً من التواصل بين غيلان [ت: 99] والمعتزلة، منها أن الإمامة غير حكْرٍ على قريش، فكل من كان قائماً بالكتاب والسُّنَّة يصلح أن يكون إماماً (48)، وهي مقولة أخذ بها المعتزلة، ومنهم واصل بن عطاء(49).
ومن آرائه أيضاً الخروج على السلطة الجائرة(50)، وقد قام بتطبيق هذا الرأي على صعيد الواقع، فأودى بحياته، والغريب في المسألة إفتاء الإمام الأوزاعي [ت: 157] بجواز قتل غيلان، واختيار السلطة للأوزاعي ـ كغطاء فقهي ـ دون غيره لم يكن عشوائياً، فقد استغلت الخلاف بين الأوزاعي وغيلان لتنفذ مرادها؛ وذلك أن غيلان ألَّف كتاباً في الردِّ على الأوزاعي، ومضمون هذا الكتاب يتعلّق بالقدر، وقد تأذى الأوزاعي من هذا الكتاب، ونال من سمعته أمام الناس، فأقدم على وضع كتاب ردَّ فيه على غيلان(51).
يروي ابن نباتة [ت: 374] محاكمة غيلان، حيث استُدعي من قبل هشام بن عبد الملك [ت: 125] فقال: «يا غيلان ما هذه المقالة التي بلغتني عنك في القدر؟ فقال يا أمير المؤمنين: هو ما بلغك، فأحضر منْ أحببت يحاجني، فإن غلبني ضربتَ رقبتي، فأحضرَ الأوزاعي، فقال له الأوزاعي: إن شئت ألقيت عليك سبعاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت ثلاثاً، فقال ألقِ ثلاثاً.
فقال له: أقضى الله على عبد ما نهى عنه؟ قال: ما أدري ما تقول.
قال: أفأمر الله بأمر حال دونه؟ قال: هذه أشدّ من الأولى.
قال: أفحرم الله حراماً ثم أحله؟ قال: ما أدري ما تقول ! قال فأمر به هشام فقطعت يداه ورجلاه فمات، وقيل: صُلِبَ حيّاً على باب كيسان بدمشق»، وبعد أن تم لهشام ما يريد سأل الأوزاعي قائلاً: «يا أبا عمر فسّر لنا ما قلت، قال: قضى الله على عبد ما نهى عنه، نهى آدم أنْ يأكل من الشجرة، ثم قضى عليه فأكل منها، وأمر إبليس أنْ يسجد لآدم، وحال بين إبليس وبين السجود، وقال ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ ثم قال: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾(52) فأحلها بعدما حرمها»(53).
هذه المحاكمة ـ إن صحت ـ تحمل في طياتها التُّهَم: وتبيّن أن القتل لا علاقة له بهذه الأسئلة، وقد صيغت على هذا الشكل لتغطي السلطة على فعلتها.
وفي سياق محاكمة غيلان يروي الطبري [ت: 310] محاكمة أخرى؛ وذلك أن هشاماً [ت: 125] قال لغيلان: ويحك يا غيلان قد أكثر الناس فيك، فنازعنا بأمرك، فإن كان حقَّا اتبعناك وإن كان باطلاً رجعت عنه، فدعا هشامٌ ميمونَ بن مهران (ت: 118) ليكلمه فقال له ميمون: سل فإن أقوى ما تكونون إذا سألتم، قال له: أشاء الله أن يُعصى؟ فقال له ميمون: أفعُصي كارهاً؟ فسكت، فقال هشام: أجبه فلم يجبه، فأمر هشام بقطع يديه ورجليه(54).
من الواضح أن سكوته ليس سبباً كافياً لقتل غيلان؛ إذ من السهولة أنْ يجيب غيلان بأن الله لم يُعصَ مكرهاً، بمعنى أنه كان قادراً على أن يحُول بين العبد وبين المعصية، ولكن جرت سُنته أن يترك للعبد حرية الاختيار. ويبدو أنَّ مسوغات قتله من قبل السلطة تتمثل في:
1 ـ تجويزه الخروج على السلطان في حالة ظلمه.
2 ـ موقفه من بني أُمية ورؤيته لهم على أنهم ظلمة.
3 ـ قوله بالقدر.
خشي هشام [ت: 125] من فكر غيلان أنْ يزعزع دولة بني أُمية، التي حاولت تكريس واقعٍ يتعارض مع هذا الفكر، فتجويز الخروج يجعل الحاكم في توجس دائم من رعيته، وموقف غيلان هذا يُعدُّ صلة وصل بينه وبين معبد [ت: 80]، كما أنَّ هذا العداء لبني أُمية من قِبل معبد الجهني وغيلان الدمشقي [ت: 99] قد نقل إلى شيوخ المعتزلة، وعلى رأسهم واصل بن عطاء [ت: 131]؛ حيث ينظرون إليهم على أنهم اغتصبوا الحكم(55)
وفي هذا السياق أطال القاضي عبد الجبار [ت: 415] في تبيان هذا الموقف، ويمكن تلخيصه بأن غيلان أرسل رسالة إلى عمر بن عبد العزيز [ت: 101]، بعد توليه الخلافة يعظه فيها، فدعاه عمر، وطلب منه أنْ يعينه على ذلك، فقال له غيلان: «ولِّني بيع الخزائن، ورد المظالم فولاه، فكان يبيعها وينادي عليها: هلموا إلى متاع... الظلمة، تعالوا إلى منْ خلف الرسول (ص) في أُمته بغير سيرته وسُنَّته، حتى كان فيما نادى عليه جوارب خز قيمتها ثلاثون ألف درهم.... فمر به هشام بن عبد الملك فقال: أرى هذا يعيبني ويعيب آبائي، والله لو ظفرت به لأقطعن يديه ورجليه [فلما تولى الخلافة]... قطع [يديه ورجليه]... فقال غيلان: قاتلهم الله كم من حق أماتوه، وكم من باطل قد أحيوه... فأرسل إليه [من] يقطع لسانه... فمات»(56)
هذه هي شخصية غيلان أحد القدريين، وسلف المعتزلة وصلة الوصل بينهم وبين معبد، والحديث عن القدرية يجرنا إلى شخصية الجعد بن درهم [ت: 120]، فمن هو الجعد؟ وما مركزه بين القدريين وعلاقته بهم؟ وما الصلة بينه وبين المعتزلة؟ ولماذا قتل؟
الجعد بن درهم
أصل الجعد بن درهم من خراسان(57)، وقيل: من حرَّان(58)، كان معلماً لمروان بن محمد [ت: 132] آخر خلفاء بني أُمية، حتى لقب بمروان الجعدي(59)، وكان الجعد من موالي بني مروان، ويسكن في دمشق(60)
يُعدُّ الجعد من عداد «التابعين [ولكنه في نظر ابن حجرت: 852هـ] مبتدع ضال»(61)، وهذا الابتداع والضلال يرجع إلى آرائه الفكرية التي يمكن حصرها فيما يلي:
1 ـ إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولا كلم موسى تكليماً، وهذا أشهر آرائه التي عرف بها، والتي كانت السبب المعلَن في قتله على يد خالد بن عبد الله القسري [ت: 125]، وذلك في قصة مشهورة نقلها من ترجم لخالد القسري، فقد وقف خالد القسري يوم عيد الأضحى بالكوفة(62)، وخطب في الناس، فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍّ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر»(63).
2 ـ يُعدُّ الجعد أول من أنكر كلام الله، يقول ابن تيمية [ت: 728هـ]: «وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل ، فأول من بدعها جعد بن درهم»(64).
3 ـ كان الجعد أول من أنكر صفات الله؛ يقول ابن تيمية عن التأريخ لهذه المسألة: «أول من أظهر هذا النفي في الإسلام الجعد بن درهم»(65).
4 ـ أسس الجعد لمسألة القول بخلق القرآن، فكان «أول من قال بخلق القرآن»(66).
5 ـ قوْل الجعد بالقدر، يقول ابن الجوزي [ت: 579] «ثم حدثت القدرية في زمن الصحابة وصار معبد الجهني [ت: 80] وغيلان الدمشقي [ت: 99] والجعد بن درهم [ت: 120] إلى القول بالقدر»(67).
إذاً القول بالقدر يعد بمثابة الرابط، الذي يربط بين الجعد وبين المعتزلة من جهة، وبين الجعد وبين معاصرَيه من القدرية من جهة ثانية، وهما معبد الجهني وغيلان الدمشقي.
6 ـ كان الجعد يتردد إلى وهب بن منبه [ت: 114]، ويسأله عن صفات الله، فقال له وهب يوماً: «ويلك يا جعد، اقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك، وأن له عيناً ما قلنا ذلك، وأن له نفساً ما قلنا ذلك، وأن له سمعاً ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك»(68).
هذه هي آراء الجعد بن درهم، وهناك منْ أضاف إليها الزندقة (69)، وهي ليست رأياً عقَدياً بقدر ما هي خروج عن المنظومة العقدية الإسلامية، وما نسب له من الزندقة بالإضافة إلى آرائه الأخرى يحتاج إلى تروٍ للحكم على مدى صحة نسبة هذه الآراء له.
يمكن القول: إن آراءه الأربعة الأولى حاملة لمضمون واحد، وهو إنكار كلام الله تعالى، وأن هذا القول يمثل جذراً للقول السادس، بينما يُعدُّ القول الخامس رابطاً بين الجعد والمعتزلة، وبين الجعد ومعاصرَيهْ، وهما معبد الجهني وغيلان الدمشقي.
على أنه ينبغي ألَّا يُفهم من ذلك أن الجعد ينكر كلام الله الذي هو القرآن؛ وإنما ينكر أنْ تكون لله صفة مستقلة تسمى صفة الكلام؛ أي ليست لله صفة على غرار صفة العلم والقدرة... ومن هنا يكون الجعد أول من أسس لنفي الصفات ـ كما يقول ابن تيمية ـ وتمخض عن هذا الرأي القول بخلق القرآن، فهو ليس قولاً مستقلاً للجعد بقدر ما هو لازم عن إنكار صفة الكلام.
يقول ابن تيمية [ت: 728]: في هذا السياق عن الجعد [ت: 80] وجهم بن صفوان [ت: 128] «وكانوا أول ما أظهروا بدعتهم، قالوا: إن الله لا يتكلَّم ولا يكلَّم، كما حكي عن الجعد، وهذه حقيقة قولهم، فكل من قال: (القرآن مخلوق) فحقيقة قوله أن الله لم يتكلَّم ولا يكلَّم»(70).
واختيار الآية الثانية من قبل القسري ـ ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164] ـ إشارة إلى صفة الكلام التي أنكرها الجعد، وكأن خالد القسري يقول للملأ: إن الله أثبت لنفسه صفة الكلام بهذه الآية (71).
وإذا ما صحَّ إنكار الجعد لصفة الكلام؛ فمفاد هذا أن الجعد هو المجذر للمعتزلة في هذه المسألة، وكانت زيادة المعتزلة على ذلك التدليل على نفي هذه الصفة عقلاً ونقلاً (72).
هذه هي صلة الوصل بين المعتزلة والجعد، ويضاف إلى هذه موقف الجعد من بقية الصفات الذاتية من العلم والسمع... وموقفه من الصفات الخبرية كالعين واليد... فما حقيقة موقفه؟
تفيد الرواية السابقة أن الجعد كان يتردد إلى وهب بن منبه [ت: 114]، وكانا يتذاكران في صفات الله الذاتية والخبرية، ويبدو أن الجعد كان يرى نفي هذه الصفات بفرعيها الذاتي والخبري، وأن وهباً يثبتها، ودليله على ذلك ورودها في القرآن: «لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك».
ونفْي الجعد لهذه الصفات بفرعيها تجعل منه مؤسساً للفكر الاعتزالي الذي تبنَّى هذه القضية، ودلل عليها.
نكران هذه الصفات الذاتية لا يفهم منه أن الجعد والمعتزلة ينكرون أن يكون الله عالماً أو سميعاً... وإنما ينكرون أن تكون له صفة مستقلة تُسمى العلم والقدرة...؛ لأن إثبات هذه الصفات لله يسوق ـ في نظرهم ـ إلى تعدد القدماء(73)، أما إنكارهم للصفات الخبرية فلأنه يخدش ـ في نظرهم ـ في توحيد الله؛ إذ فيه مشابهة بين الله ومخلوقاته(74).
ولكن لماذا يطلب وهب بن منبه من الجعد الكف عن الخوض في هذه المسألة، ويتوقع له الهلاك؟
يبدو أن توقعات وهب جاءت حصيلة قياس الجعد على معبد الجهني [ت: 80] وغيلان الدمشقي [ت: 99] اللذيْن قُتلا، والجامع بين الأشخاص الثلاثة القول بالقدر، فإنكار الجعد لهذه الصفات يضيف إلى رصيده تهمة جديدة تقربه من القتل.
أما ما قيل عن زندقة الجعد فمسألة تحتاج إلى تثبتٍ، ولا سيما في مسائل تقف وراءها السلطة، والتي قد تلفِّق من التهم ما تريد لمن ترى في فكْره منازعاً لها، وقد تروج ما هو صواب على أنه نوع من الزندقة لتجد في ذلك مبرراً للتخلص ممن تراه خصماً، وقد لا ينكشف ذلك للكثير، فمثل هذا قد يكون وراء الترويج بزندقة الجعد، أو قد يوجد مَنْ يعادي الجعد فكرياً فيفهم من بعض مواقفه أنها نوع من الزندقة، أو ربَّما يُنقل عنه من غير التثبت من صحة النقل، وفي سياق ذلك نفهم قول ابن حجر العسقلاني [ت: 852هـ]: «وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة، منها أنه جعل في قارورة تراباً وماء، فاستحال دوداً... فقال: أنا خلقت هذا؛ لأني كنت سبب كونه»(75).
ولا أدري أين الإشكال، ولماذا وصف فعله هذا بالزندقة ! ألأنه أسند عملية التحول إلى نفسه؟ ! مع العلم أن إسناد ذلك لا يراد منه مشاركة الله في عملية الخلق؛ بل المراد أنه كان سبباً في إيجاد كائن جديد متولد من الماء والتراب.
وربما كان المقصود بزندقة الجعد خروجه على المألوف، بنفيه لصفة من صفات الله، وهي صفة الكلام، فعُدَّ ذلك نوعاً من الزندقة، ولا سيما أنه استحق القتل على هذا النفي ـ بحسب الظاهر ـ ووجد من بارك لخالد القسري [ت: 125] هذا القتل، وهذه المباركة نوع من إعطاء المشروعية على القتل، والمشروعية هنا هي نفي صفة من صفات الله، وهذا النفي في نظر هؤلاء نوع من الزندقة.
يقول ابن تيمية [ت: 728هـ] عن الجعد: «فضحى به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق وما له يومئذٍ نكير»(76).
وعدم الإنكار يضع علامة استفهام، فلماذا عدم الإنكار؟ قد يكون ذلك خوفاً؛ إذ من المؤكد أن هذا الموقف المرعب في ذبحه أمام الناس ألجم الأفواه، وقد يكون بعضه خوفاً وبعضه رضى.
وعلى أيَّة حال لا ينبغي أن نجعل قَتْلَهُ جهاداً في سبيل الله أو حَسَنَةً من حسنات خالد القسري، يقول رجاء بن حيوة [ت: 112] المعاصر للجعد بعد سماعه بمقتل غيلان [ت: 99] ـ وغيلان ممن عاصر الجعد ـ يقول: «قتْلُهُ أفضل مِنْ قَتْلِ ألفين من الروم» !(77)، ويقول الذهبي [ت: 748هـ] عن قتْل خالدٍ الجعدَ: «هذه من حسناته»(78)، ويقول ابن العماد الحنبلي [ت: 1089هـ]: «فلله ما أعظمها وأقبلها من أضحية»! (79).
بعد هذا يتوجب علينا الإجابة عن سؤالين:
أنبع هذا القول منه شخصياً؟ أم استورده من غيره وتبناه؟.
هل هذا القول يعد سبباً كافياً لتبرير قتله؟ أم هناك أسبابٌ خفية؟
يبدو أن هذا القول نبع منه؛ إذ معظم المصادر التي تحدثت عن خالد القسري، أو عن الجعد بن درهم جعلت الجعد أول من قال بذلك، وهذا القول أولى مما قيل من أن الجعد أخذ هذه المقولة من بيان بن سمعان [ت: 119]؛ فابن كثير [ت: 774هـ] يرى أن الجعد أخذها من بيان بن سمعان، وأخذها بيان من طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وأخذها لبيد بن أعصم ـ الساحر الذي سحر الرسول (ص) ـ من يهودي باليمن(80).
فالمصدر المباشر الذي تلقى عنه الجعد ـ بحسب هذه الرواية ـ هو بيان بن سمعان، فمَنْ هو بيان بن سمعان؟ وما آراؤه؟ وهل يمكن أنْ يتلقى الجعد منه؟
عند الرجوع إلى كتب الكلام نجد أن بيان بن سمعان النهدي [ت: 119] رئيس فرقة من فرق الشيعة الغالية، وهي الفرقة المعروفة بالبيانية نسبة إليه، ومن آرائهم القول بنبوة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية [ت: 81].
ولما توفي أبو هاشم ادعى بيانٌ النبوة(81)، وأنه هو المقصود بقوله تعالى: ﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 138](82) ، وكان ـ علاوة على ذلك ـ مجسماً، ومن أقواله إن الله عز وجل على صورة الإنسان، وأنه يفنى كله إلا وجهه(83)، وكان يدعي ألوهية علي، وأن روح الله حلّت فيه(84).
بان مما سبق أن شخصية بيانٍ الفكرية مغايرة لشخصية الجعد، وعليه يستبعد أن يكون الجعد قد تأثر ببيان فيما يتصل بمسألة نفي كلام الله، ومما يعزّز هذا أنه لم ينسب ـ فيما اطلعت عليه ـ أحدٌ من المؤرخين أو المتكلمين جعداً إلى الجماعة البيانية، وزيادة على ذلك فإن الجعد فهم أنه من مقتضيات تنزيه الله تعالى نفيُ اليد والعين كصفاتٍ خبرية، وهذا مغاير لما كان عليه بيان من تجسيمٍ لله، فهما على طرفي نقيض.
ولعلَّ الذي دعا البعض إلى عزو هذه الفكرة لبيان وتلقي الجعد منه هو أن الجعد بن درهم وبيان بن سمعان تعاصراً زمنياً، وقُتل كلاهما على يد خالد بن عبد الله القسري [ت: 125]( 85)
بعد بيان أن أصل نفي صفة الكلام كان من الجعد، نعود للإجابة عن السؤال الثاني، وهو: أيُعدُّ القول الذي نسبه له خالد القسري كافياً لقتل الجعد؟ أم هناك أسباب خفية؟
الجواب عن هذا السؤال يستدعي منا أن نتحدث عن شخصية القاتل، وهو خالد بن عبد الله القسري.
خالد بن عبد الله القسري
قبل الشروع في الحديث عن خالد يتعين أن نذكر مسوغات الحديث عنه؛ لأنه ليس من القدرية، ويمكن إجمال هذه المسوغات في ثلاثة:
المسوغ الأول: إن خالداً نفذ عملية القتل في واحد من أبرز رجال القدرية، وهو الجعد بن درهم، والكشف عن خالد من حيث السيرة والأخلاق... يحدّد لنا مدى حرصه على حراسة الدين، التي ادعاها وجعلها مسوغاً لقتل الجعد.
المسوغ الثاني: إنه قد وُجِد في شخصية القسري ما لم يوجد في غيره، فقد طالت ولايته زمنياً، وتنقل من ولاية إلى ولاية في عهد الوليد بن عبد الملك [ت: 96] وسليمان [ت: 99] وهشام [ت: 125](86) ، إلى حد أن ولايته استمرت إحدى وثلاثين سنة(87).
وهذا يعني أن الكشف عن هذه الشخصية يعطي صورة واضحة عن حال بعض خلفاء بني أمية حسناً أو سوءًا؛ لأنهم كانوا راضين عن سلوك خالد، وإلّا لما كان هناك مبررٌ لإبقائه.
المسوغ الثالث: استمر خالد في الولاية في زمن هشام بن عبد الملك لمدة خمس عشرة سنة(88)، وقد قتل هشامٌ غيلان الدمشقي [ت: 99] بتهمة القدر.
فمن هو خالد بن عبد الله القسري؟
هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز(89) البجلي القسري الدمشقي، كنيته أبو الهيثم(90)، يرجع أصله إلى اليمن(91) وأمه نصرانية(92)
استنابه الوليد بن عبد الملك [ت: 96] والياً على الحجاز سنة تسع وثمانين إلى أن توفي الوليد، وبقي والياً عليها في عهد سليمان [ت: 99]، وفي سنة ست ومائة استنابه هشام على العراق إلى سنة عشرين ومائة(93)، وقد ضم له إلى جانب العراق المشرق كله(94).
مات خالد سنة خمس وعشرين ومائة تحت العذاب، بعد أن عاش ستين سنة(95)، وموته كان بعد عزْله عن العراق من قبل هشام بن عبد الملك [ت: 125](96).
عُرِف خالد بشدّته على الرعية، وعلى كل منْ يشتمُّ منه معارضة لحكم بني أُمية، وكان مما قاله أمام الرعية عندما تولى مكة: «والله ما أُوتى بأحدٍ يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم، إن الله جعل الخلافة منه بالموضع الذي جعلها، فسلموا وأطيعوا ولا تقولوا كيت وكيت، إنه لا رأي فيما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه... والله لو أعلم أن هذه الوحش التي تأمن في الحرم لو نطقت لم تقرّ بالطاعة لأخرجتها من الحرم، إنه لا يسكن حرم الله وأمنه مخالف للجماعة»(97).
وهو الذي اقتاد خيرة التابعين وأرسل بهم إلى الحجاج [ت: 95] منهم سعيد بن جبير [ت: 95] ومجاهد [ت: 103]، وقد قَتَلَ الحجاجُ سعيد بن جبير، وسُجن مجاهدٌ حتى مات الحجاج(98).
عرف خالد بثرائه الفاحش، وروى في ذلك المؤرخون قصصاً منها أنه سقط خاتم لجاريته رابعة في مكان قذر، وقيمة الخاتم ثلاثون ألف درهم، فسألت منْ يخرجه؟ فقال لها القسري: إن يدك أكرم علي من لبسه بعدما صار في هذا الموضع القذر، وأمر لها بخمسة آلاف دينار بدله، وقد كان لرابعة هذه من الحلي شيء عظيم، من جملة ذلك ياقوتة وجوهرة، كل واحدة بثلاثة وسبعين ألف دينار(99)، ومن ذلك أنه أعطى أعرابياً عشرة آلاف درهم مقابل بيتين من الشعر مدحه بهما(100).
وهذا يدلُّ على وضع أموال الأمة في غير موضعها، ويشير إلى تضخم ثروة خالد، حتى قيل: إنها بلغت «ثلاثة عشر ألف ألف»(101)، وقيل: «عشرين ألف ألف»(102)، وقد ترافق هذا التضخم في الثروة ومع الطاعة لخلفاء بني أُمية دون تبصُّرٍ، والشدة على الرعية، مع تجريح علماء الجرح والتعديل له، فخالد عند ابن حجر العسقلاني [ت: 852هـ] له «أقوال فظيعة»(103)، وفي نظر يحيى بن معين [ت: 233] «بغيض ظلوم... [و] رجل سوء يقع في علي»(104)، وقد روى أحاديث؛ ولكنه «ليس بالمتقن [و] ينفرد بالمناكير»(105)، والأحاديث التي رواها «لا يتابع عليها كلها لا إسناداً ولا متناً»(106).
إذاً خالد القسري ليس موطن ثقة من قبل علماء الجرح والتعديل، وهذا لم يأت من فراغ، وإنما من خلال سلوكه، ومن خلال الأحاديث التي رواها، ومن هذه الأحاديث ما رواه عن أبيه عن جده، وهو يخطب على المنبر: «حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ (ص) : «يَا يَزِيدُ بْنَ أَسَدٍ، أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ»(106).
يشتم من الحديث علامات الوضع، فخالد ضعيف جداً، وينفرد بالأحاديث المنكرة الشاذة، وقوله هذا على المنبر يراد منه الإعلاء من شأن نفسه أمام الملأ بأن جده صحابي، وبأن خالداً راوية للحديث، ومن المعروف أن جده لم تثبت صحبته للنبي (ص) إلا من خلال هذا الحديث(107)، ولا يعرف لجده إلا هذا الحديث(108)، ويزداد الشكّ في هذا الحديث ـ مما يرجح وضْعَهُ مِنْ قِبَل خالد ـ أن أهل خالد ينكرون أن يكون لجدهم هذا الحديث(109) «ولو كان جدهم لقي النبي (ص) لم يكن أهله ينكرونه»(110). أما عن مكانة المسلمين في قلبه فقد أذَل المسلمين؛ لأنه كان «يولي النصارى والمجوس على المسلمين، وكان أهل الذمة يشترون الجواري المسلمات ويطؤونهن»(111) في عهده.
هذه هي شخصية القسري: ظلْمٌ للرعية، وتبديدٌ لمال الأُمة، وإثراء غير مشروع، فهل مثل هذا الشخص يمكن أنْ يكون حارساً على الدين، ليقتل الجعد بن درهم، بتهمة أنه قال: إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاً، وما كلَّم موسى تكليماً؟!
استناداً إلى المعطيات المتصلة بشخصية خالد نستبعد أن يكون قول الجعد الذي نقله خالد عنه هو السبب وراء قتله؟ فما السبب إذاً؟ يرجع ذلك في الغالب إلى أحد السببين التاليين أو إلى كليهما:
الأول: الخلاف الشخصي بين الجعد وبين خالد القسري؛ فقد كان الجعد يرمي خالداً بالزندقة(112)
الثاني: خروج الجعد على خلفاء بني أُمية، وعداؤه لهم؛ فقد خرج علـى بـني أُمية مع يزيد بن المهلب [ت: 102] الذي استولى على البصرة، وخلع ابنُ المهلب يزيدَ بن عبد الملك [ت: 105](113) ، وتتمثل وظيفة الجعد آنذاك بتحريض الناس على قتال بني أُمية، في تلك الفترة كان الخلاف بين يزيد بن المهلب ـ الذي انضم له الجعد ـ وبين الحجاج [ت: 95] شديداً (114)، وكان الجعد معارضاً للحجاج، وربما عذبه الحجاج، ولهذا كان الجعد يقول للحجاج:
ليثٌ عليَّ وفي الحروب نعامة فتخاء(115)
تجفلُ من صفيرِ الصافرِ(116)
فخروج الجعد على يزيد بن عبد الملك وخلعه، ووقوفه أمام الحجاج، واتهامه خالد القسري بالزندقة، كانت وراء مقتل الجعد، وليس ما رماه به من مسألة نفي صفة الكلام، ولا أدلّ على هذا من الولاء المطلق الذي كان يبديه خالد القسري لخلفاء بني أُمية، إلى حد أنه كان يقول: «والله ما أُوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم... والله لو أعلم أن هذه الوحش التي تأمن في الحرم لو نطقت لم تقرّ بالطاعة لأخرجتها من الحرم»(117)
على أن هذا الخروج الفعلي على بني أُمية متأسس على الموقف النظري الذي كان يتبناه الجعد، وهو القول بالقدر، ومؤدى القول بالقدر ضرورة تحمل الإنسان كل ما ينجرّ عن تصرفاته.
إذاً الأسباب السابقة كانت وراء مقتل الجعد، والذي قام به القسري هو أنه أخفى هذه الأسباب، واتخذ قول الجعد بنفي صفة الكلام ـ على فرض صحة هذا القول له ـ مطيةً للوصول إلى قتله.
وإذا كان خالد بهذه الصورة فإنه يدلُّ ـ ولا سيما أنه تولى الإمارة أكثر من ثلاثين سنة ـ على الغلظة التي كان يتسم بها بعض خلفاء بني أُمية على رعيتهم.
هذه هي شخصية الجعد الذي قُتل على يد بني أُمية، وهناك شخصية رابعة، عاشت الفضاء الفكري والسياسي نفسه الذي عاشه الجعد، ولقيت المصير نفسه، وأثرت في المعتزلة أكثر.
هذه الشخصية هي شخصية الجهم بن صفوان، تلميذ الجعد بن درهم، فمن هو جهم؟ وما آراؤه؟ وكيف تأثر بالجعد؟ وأثر في المعتزلة؟ ولماذا قتل؟
جهم بن صفوان
يكنّى جهم بن صفوان بأبي محرز (126)، وأصله من سمرقند، ولم يرو شيئاً من أحاديث النبي (ص) (118).
قُتل جهم في أواخر دولة بني أُمية، سنة ثمان وعشرين ومائة [128](119) ، ويعود سبب قتله إلى موقفه المعارض لبني أُمية، فشأنه كشأن معبد الجهني [ت: 80] وغيلان الدمشقي [ت: 99] والجعد بن درهم [ت: 120].
وقد تجسَّم هذا الموقف المعارض للسلطة الأُموية بخروج جهم بن صفوان مع الحارث بن سريج [ت: 128] على بني أُمية في بلاد خراسان، وكانت دعوتهما إلى بني أُمية تحكيم كتاب الله وسُنَّة رسوله وجعل الأمر شورى بين المسلمين(120).
وفي الوقت نفسه كان الجهم يدعو الناس إلى السير وراء الحارث، ويقرأ عليهم سيرته في الجوامع والطرق حتى استجاب له جمع غفير(121)، فلما آلت الخلافة إلى مروان بن محمد [ت: 132] وجاءت البيعة له امتنع الحارث من قبولها، ودعا الحارثُ نصر بن سيار [ت: 131] قائد جيش بني أُمية إلى تحكيم الكتاب والسُّنَّة، فرفض نصر(122)، ثم اتفق نصر مع الحارث على التحكيم، فكان جهم مندوباً عن الحارث، ومقاتل بن حيان [ت: 150] مندوباً عن نصر، واتفق الحَكَمان على عزل نصر، وأن يكون الأمر شورى بينهم، فرفض نصر(123)، وقام نصر بقتال الحارث فقُتل الحارث، وأُسر جهم بن صفوان على يد سَلْمَ بن أحوز [ت: 132] أمير الشرطة في جيش نصر بن سيار، وبعد أن وقع جهم أسيراً طلب الفكاك، فقال له سلم بن أحوز: «والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، فقتله»(124).
يظهر مما سبق أن جهم بن صفوان كان يدعو ولاة بني أُمية إلى تحكيم كتاب الله وسُنَّة رسوله، ومع ذلك يجد الإعراض وعدم الموافقة من قبل بعض ولاة بني أُمية، وإنه لأمر غريب أن يُدعَى المرء إلى تحكيم الكتاب والسُّنَّة فيرفض، ولكن لا غرابة على مثل بعض ولاة بني أُمية(125)، ولكن الغريب حقّاً أن يأتي ابن كثير رحمه [ت: 774هـ] فيترحم على سلم بن أحوز؛ لأنه قتل جهم بن صفوان ـ مع أن المقتول يدعو إلى تحكيم الكتاب والسُّنَّة، ويرفض القاتل هذا التحكيم ـ يقول ابن كثير عن جهم: «قتله... سلم بن أحوز، رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً ! »(126).
هكذا تمَّ التخلص من جهم، ولكن آراءه لم تُمحَ، وبقيت مؤثرة ولا سيما في الفكر الاعتزالي، فما هي آراؤه؟ وكيف أثرت في المعتزلة عموماً، وفي موقفهم من السُّنَّة خصوصاً؟
قبل الشروع في تبيان آراء جهم لا بدَّ من التنبيه إلى أنه لم يصلنا شيء من آثار جهم، حتى يكون الحكم له أو عليه موضوعياً عادلاً، وكل ما قيل عن آرائه أُخذت عن المخالفين له فكرياً إلى حدِّ تكفيره(127)، وفي ظل غياب آثارٍ لجهم يصعب الاطمئنان إلى ما قيل عن فكره، فربما كانت بعض آرائه دَسّاً عليه قصْدَ التشويه لفكره، وربما كانت من لوازم أقواله، ولازم المذهب ليس بمذهب.
ولا بدَّ من التنبيه أيضاً أن القصد من الحديث عن جهم وآرائه هو إبراز تأثير جهم في المعتزلة، وذلك بإظهار العلاقة الفكرية الوشيجة التي تربط بين المعتزلة وجهم، بوصفه سلفاً من أسلاف المعتزلة، وتأسيساً على هذا لن نخوض في جزئيات آراء جهم، ولا الردّ عليها، ويمكن أن نصنف آراءه إلى ثلاث مجموعات طبقاً لتعلقها: [الإلهيات، الغيبيات، الإنسانيات].
1 ـ الإلٰهيات [الصفات]
نقصد بذلك آراءه المتعلقة بالله فقط، وقد قامت آراؤه على أساس نظري، مفادها أن الله لا يوصف بما يوصف به العباد؛ ولأجل هذا نفى أنْ يوصف الله بالحياة والعلم، وأجاز وصفه بالقدرة والفعل(128).
والملاحظ أن مقصد الجهم من هذا التأسيس النظري هو محاولة تنزيه الله تعالى في نظره، ـ مع الخطأ الذي وقع فيه ـ ولأجل هذا اعترض على وصف الله بالحياة والعلم؛ لأن المحدَث / المخلوق يشارك الله في هذا، وكأنَّ جهماً لم ينظر إلى الفارق بينهما في مستوى شمولية علم الله تعالى ومحدودية علم الإنسان، وفي بقاء الحياة لله كصفة متصلة بالوجود، وفناء الإنسان، ودليل جهم في إسناد بعض الصفات لله ونفي بعض الصفات عنه أن مجرد الاشتراك في الاسم يسوق إلى الاشتراك في الذات، ومن هنا نفى أن يوصف الله بالحياة والعلم، وأجاز وصفه بالقدرة؛ لأن القدرة عنده مقصورة على الله، بينما الإنسان في نظره عاجز، لا يوصف بالقدرة، ولذا يقول بأن الله عالم، وعلمه محدث مخلوق(129)، وقال بحدوث العلم؛ لأن إيجاب الأزلية لصفة العلم يؤدي إلى وضع شريك لله(130).
هذا التنزيه المبالغ فيه ـ الذي فهمه جهم وكان مخطئاً فيه ـ لم يأت من فراغ، ولا يمكن عزله عن الواقع الفكري آنذاك؛ فجهم «أقام ببلخ، وكان يصلّي مع مقاتل بن سليمان [ت: 150] في مسجده ويتناظران حتى نفي إلى ترمذ»(131)، ومقاتل هذا كان مجسماً، وله أصحاب يقولون بالتجسيم، ومن أقوالهم: «إن الله جسم... وإنه على صورة الإنسان، لحم ودم، شعر وعظم، له جوارحُ وأعضاءٌ من يد ورجل ورأس وعينين.... وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه...»(132).
هذه الصورة الحسيّة التي رسمها مقاتل لله هي التي دفعت بجهم إلى تبني منظومة فكرية حول صفات الله؛ فقد أنكر أن يقال عن الله تعالى بأنه «شيء»؛ خشية أنْ يقدح هذا في تنزيه الله؛ وذلك لإطلاق الشيئية على المخلوق(133)، ونفى أيضاً أنْ يوصف الله بصفة السمع والبصر(134)، بل نُقل عنه أنه كان «ينفي الصفات كلها عن الله سبحانه»(135).
إذاً هذا النفيُ من جهمٍ جاء بمثابة ردة فعلٍ على التجسيم الذي تبناه مقاتلٌ، وقام بنشره.
تأسيساً على ما سبق يُعدُّ جهم مؤسساً للمعتزلة في قضية نفي الصفات، مع اختلاف في التنظير واتحاد في الغاية، فكلاهما أنكر أنْ تكون لله صفاتٌ مستقلة عن الذات خشيةَ التشبيه، وإنكارُ المعتزلة لهذه الصفات كان مؤسَّساً على أن القول بها يَجُرُّ إلى تعدد الإله؛ لأن هذه الصفات في نظرهم ينبغي أن تتصف بما تتصف به الذات، من حيث الوجود والبقاء... ويجر ذلك إلى التعدد(136).
وإذا تأثرت المعتزلة بجهم؛ فجهمٌ قد تأثر بالجعد بن درهم [ت: 120] الذي أنكر أن يتصف الله بصفة الكلام، ولعل العلاقة تزداد متانة بين المعتزلة وجهم في قضية رؤية الله تعالى؛ فقد كان ينكر جهم رؤية الله تعالى(137)، وهذا ما تقول به المعتزلة مع زيادة في التنظير لهذه المسألة والاستدلال لها، إلى حدّ أن المعتزلة عُرفت بمسألة الرؤية أكثر من أي مسألة(138).
إنكار جهم للصفات الخبرية وردّه أو تأويله للأحاديث الواردة فيها ليس منفصلاً عن الواقع الفكري الذي عاصره جهم، فجهم؛ التقى بمقاتل بن سليمان [ت: 150] الذي كان يقول بالتجسيم، فاعترض عليه جهم نافياً أن تكون لله صفاتٌ خشيةَ التجسيم، ومقاتل «كان يكذب في الحديث»(139).
غير أن ردّ جهم ـ المتمثل بنفي الصفات ـ لا يخلو من غلو، فكان غلوه في التنزيه مقارباً لغلو مقاتل في التجسيم، وكما قال فيهما أبو حنيفة النعمان [ت: 150] المعاصر لهما: «أَفْرَطَ جهم في نفي التشبيه، حتى قال: إنه تعالى ليس بشيءٍ، وأفْرَطَ مقاتلٌ ـ يعني في الإثبات ـ حتى جعله مثل خلقه»(140).
تندرج مسألة خَلْق القرآن ضمن موقف جهم من الإلهيات، فقد نقل عن جهم أنه كان يقول بخلق القرآن(141) أو ما يُسمى بحدوث كلام الله(142)، وأنه تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، وأن الجعد تلقاه عن بيانٍ، وأن بياناً أخذه عن طالوت ابن أخت لبيد بن عاصم، وأخذها لبيد بن عاصم ـ الساحر الذي سحر (ص) ـ عن يهودي باليمن(143).
هذا ما أرادتْ إيصاله كتبُ الكلام والتاريخ، وقد تبين عند الحديث عن الجعد عدم صحة تلقي الجعد من بيان، ومؤدى هذا أن مصدر القول بخلق القرآن هو الجعد، ومن ثَمَّ أخذ جهم عن الجعد، والذي يهمنا من هذا هو أن جهماً كان بمثابة الوصل بين جعد والمعتزلة؛ فقد تلقى هذه المقولة عن الجعد، وصدّرها للمعتزلة، يقول ابن تيمية [ت: 728] عن هذه المقولة: «فأخذ منه [أي من الجعد] جهمُ بن صفوان هذا الكلام فبسطه وطراه، ودعا إليه، فصار به مذهباً لم يزل هو يدعو إليه الرجال، وامرأته زهرة تدعو إليه النساء، حتى استهويا خَلْقاً مِنْ خَلْقِ الله»(144)، والذين استهواهم هم المعتزلة، فجهم تبنى هذا المذهب ودعا إليه «ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة»(145).
2 ـ الغيبيات:
فناء الجنّة والنار:
يذكر عن جهم أنه يقول بفناء الجنّة والنار(146)وبفناء أهلهما،(147)، ولما كانت هناك آيات تعترضه، كقوله تعالى عن النار: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: 107] حملها على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد، كما يقال خلَّد اللهُ مُلْكَ فلان، والقصد من ورائه طولُ المدة، واستشهد على فناء النار بالآية السابقة، وعلى فناء الجنة بقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ [هود: 108] فالآيتان اشتملتا على الخلود، والخلود لا استثناء فيه(148).
الملائكة الذين يكتبون الأعمال: نسب إلى جهم أنه ينكر وجودهم(149)
عذاب القبر ومنكر ونكير: أنكر جهمٌ عذاب القبر ومنكراً ونكيراً (150).
الميزان: أنكر جهم أنْ يضع الله تعالى ميزاناً مادياً يزن به أعمال العباد(151)
الصراط: نقل عن جهم أنه أنكر الصراط الذي يمرُّ عليه العباد يوم القيامة (152).
الشفاعة: أنكر جهم شفاعة الرسول (ص) للعصاة من أُمته(153).
الكرسي، العرش: نفى جهم أن يكون لله كرسي، أو أن يكون له عرش(154).
3 ـ الإنسانيات:
نقل كلُّ مَنْ تحدث عن جهم أنه كان يقول بالجبر؛ أي إن الإنسان عاجز لا يقدر على فعل شيءٍ، مثله مثل الجماد، والفاعل الحقيقي هو الله وحده، وما يُنسب إلى الناس من أفعال فهي «على المجاز، كما يقال: تحركتْ الشجرةُ، ودار الفلكُ، وزالت الشمسُ، وإنما فَعَلَ ذلك بالشجرة والفلك والشمس اللهُ سبحانه، إلا أنه خَلَقَ للإنسان قوة كان بها الفعلُ، وخَلَقَ له إرادةً للفعل، واختياراً له... كما خلق له طولاً كان به طويلاً، ولوناً كان به متلوناً»(155).
وإذا كان الإنسان مجبراً على سلوكه فكيف سيحاسب عليه؟ يرى جهم أن الثواب والعقاب هو جبر أيضاً (156).
عندما ننظر إلى فكر جهم نظرة شمولية ـ اعتماداً على ما نقل عنه ـ لا نجد في تفكيره اتساقاً؛ ففي الجانب الإلٰهي نجده ينفي عن الله أن يتصف بصفات معينة؛ سعياً إلى التنزيه من وجهة نظره؛ بينما نجده في الجانب الإنساني يصيّر الإنسان جماداً، لا حول له ولا قوة، ألا يخدش تفكيرُه الإنساني في تفكيره الإلٰهي؟ ! إذ كيف يحاسب اللهُ الإنسانَ على أمرٍ قَسَرهُ عليه؟ ! وإذا كان جهم يقول بالجبر ـ كما نقل عنه ـ فلماذا لا يبرّر تصرفات الأمويين الذين خرج عليهم وحاربهم؟ ! كيف يدعوهم جهم إلى العمل بالكتاب والسُّنَّة، وفي الوقت نفسه يجعل الإنسان مجبوراً على تصرفه؟ ! فكيف يحاربهم ولا اختيار لهم؟ !
وعندما ننظر إلى تاريخ نشوء الفكر الإسلامي وتدرجه لا نعثر على من سبق جهماً بهذه المقولة الجبرية، التي جرّدت الإنسان من أعزّ ما يملك، وهي حرية الإرادة والاختيار ـ والتي قام عليها التكليف ـ وحشرتْهُ في زمرة الجماد، فهو دون مستوى الحيوان الذي قد يملك نوعاً من الاختيار. لم يكن هناك من نظّر لهذه المسألة قبل جهم. تبدو ـ بناءً على المعطيات السابقة ـ ضرورةُ إعادة النظر وعدم التسليم بكل ما نُقِل عن جهم، ولكي تتم هذه العملية لا بدَّ أن تكون:
· دراسة متكاملة عن الجهم تجمع بين الفكر الكلامي الذي نقل عنه والمتمثل بقوله بالجبر، وبين الفكر السياسي الذي نقل عنه، والمتمثل باعتراضه على بعض خلفاء بني أُمية، حيث كان الاعتراض سبباً في قتله.
وكل دراسة ـ في نظري ـ لا تجمع بين هذين الطرفين تبقى ناقصةً؛ إذ لا يمكن أن نجمع بين فكره الجبري، وبين خروجه على بني أُمية داعياً لهم إلى تحكيم الكتاب والسُّنَّة.
دراسة تأخذ بعين الاهتمام علاقة التهميش والإقصاء بين جهم وبين مَنْ نَقَلَ عنه من جهة، وبين جهم وسلطة بني أُمية من جهة أخرى، وإذا أخذنا بهذا الأمر فلن نستبعد أنْ تنسب سلطة بني أُمية أو مَنْ خالفه فكرياً لجهم القول بالجبر، قصد تشويه سمعته، والحط من مكانته.
· دراسة تأخذ بعين الاهتمام أنه لم يصلنا من جهمٍ أي مصنف له، ومؤدى هذا أخْذُ الحذر والحيطة مما نقله المخالفون عنه.
بعد تبيان ما سبق نختم الحديث عن جهم ببيان منزلة العقل عنده؛ فالشهرستاني [ت: 548] يرى أن مما وافق به جهم المعتزلة «إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع»(157)
يدلُّ هذا على أهمية العقل عند جهم كمصدر للمعرفة سابق للعقل، وهو توجه يمتِّن الروابط بينه وبين المعتزلة، ويضيف دليلاً آخر على مدى تأثر المعتزلة به، ولكن ما المقصود «بالمعارف» التي يستقل العقل بإدراكها؟ لعل المقصود بالمعارف هنا مقدرة العقل على إدراك حُسْن الأشياء وقُبْحها قبل ورود الشرع، وهو ما ذهبت إليه المعتزلة.
هذه هي آراء جهم وعلاقته بفضائه الفكري، وما يلفت الانتباه في علاقة جهم بفضائه الفكري أمران:
على الرغم من التوافق الفكري بين جهم والمعتزلة ـ ولا سيما في النظر إلى الصفات الإلٰهية والغيبيات ـ نجد جهماً والمعتزلة على طرفي نقيض في مسألة الحرية الإنسانية، فبينما يجعل جهمٌ كلَّ تصرفات الإنسان خَلْقاً لله، والإنسان فيها مسلوب الاختيار ـ كما نقل عنه ـ يجعل المعتزلة كل تصرفات الإنسان خَلْقاً للإنسان(158)، وهذا ما حدا بالمعتزلة إلى الردِّ على جهم(159).
الخاتمة
بعد جولةٍ قضيناها في هذه الدِّراسة بان لنا أنَّ الدراسة الحقيقية للمعتزلة تتطلب الاطِّلاع على فكر الأسلاف المتمثل بالقدرية الأوائل؛ حيث كان فكر هؤلاء بمثابة البذور التي أثرت في الفكر الاعتزالي، ثم أخذت بعد ذلك نسقاً كلامياً متكاملاً في الفكر الاعتزالي.
قضية القدر التي ينتسب إليها هؤلاء كان لها بُعْدٌ أخلاقي متمثل بضرورة أن يتحمل الإنسان تصرفاته، وليس القصدُ من وراء ذلك إبعادَ الله تعالى عن خَلْقِ الأفعال أو عدم علم الله تعالى بها.
وقد أظهرت الدراسة المبنيّة على الجوانب التاريخية والفكرية لعصر أولئك القدرية أنَّ بذور الجبر وارتكاب المعاصي من قِبَل بعض الناس ـ ومنهم بعض من ولّاهم خلفاء بني أُمية على الناس ـ كان لها أثرها في ظهور هذه الأفكار. كما أنَّ قَتْل هؤلاء مِن قِبَل بعض الولاة آنذاك كانت دوافعه سياسية، والتذرع بحماية العقيدة جاء لإضفاء صفة الشرعية على هذا القتل، وتهديدِ كلِّ من ينتهج هذا النّهج.
وقد سعى بعض الولاة لاستغلال الواجهات الفقهية لتبرير هذا الصنيع، كما تبيّن لنا أنَّ دراسة هذه الشخصيات من منطلق الكتب الكلامية يبقى قاصراً ولا يعطي صورة حقيقية؛ نظراً للخلاف بين أولئك ومَنْ كتب عنهم، وقد ساعدتنا كُتُب التاريخ في إعطاء صورة قريبة من واقعهم؛ لكن الصورة الحقيقية تحتاج إلى شيءٍ من تراثهم الذي لم يصلنا.
ومما ينبغي الانتباه إليه أنَّ التأثير الذي أشرنا إليه لا يعني عدم الرد من قبل المعتزلة على هؤلاء في بعض ما ذهبوا إليه، وهذا ما نفهمه من رد المعتزلة وغيرهم على جهم بن صفوان، مع أنه لم يكن من القدرية أصلاً إذا ما نظرنا إلى فكره الجبري وفكر غيره، وإنما تناولناه بالدرس هنا لوجود شيءٍ من العلاقة بينه وبين القدرية الثلاثة، وبينه وبين المعتزلة، تلك العلاقة التي أشرنا إليها في دراستنا لفكره، على أنَّ القول الفصل في فكر جهم يبقى ناقصاً، وتبقى بعض الأسئلة يصعب الإجابة عليها بشكلٍ كاملٍ انطلاقاً من التراث الكلامي الاعتزالي والسني؛ إذ كيف يقول بالجبر وهو في الوقت ذاته يتهم غيره بأنهم لا يحكِّمون شرع الله تعالى؟ ! بل كيف يقول بالجبر، وقد خرج هو نفسه على بعض ولاة بني أُمية.
ومما ظهر لنا أيضاً أن التنزيه لله تعالى المبالغ فيه مِنْ قِبلِ جهم جاء ردة فعلٍ عنيفة لظاهرة التجسيم الموجودة عند مقاتل بن سليمان، وبقيت هذه المبالغة في نظرنا في الفكر الاعتزالي، فالقول الاعتزالي بإنكار الصفات الذاتية لله تعالى خوفاً من تعدد القدماء يدخل في هذا السياق فيما نرى.
..........
المراجع والمصادر والهوامش:
(1) الأسفراييني، التبصير في الدين: 67.
(2)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/30.
(3) الإيجي، المواقف: 3/652 بناء على هذا لا يدخل جهم فيهم إذا عدَدْنا ذلك من باب الحدِّ والتعريف للقدرية؛ ولكننا أدخلناه نظراً لوجود تأثير له في الفكر الاعتزالي، أو على الأقل لوجود توافق بينه وبين هؤلاء القدرية وبينه وبين المعتزلة.
(4)ابن قتيبة، المعارف: 441
(5)مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم: 8.
(6)وكون معبد هو أول من تكلم بالقدر تجده عند: ابن الجوزي، تلبيس إبليس: 118. اليافعي، مرهم العلل المعضلة: 84. ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: 274. الذهبي، ميزان الاعتدال: 6/465.
(7)ابن عبد البر، الاستيعاب: 3/1426.
(8)الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/185.
(9) ابن كثير، البداية والنهاية: 9/34.
(10)الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/185.
(11)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/34. المزي، تهذيب الكمال: 28/248.
(12)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/34. ابن العماد، شذرات الذهب: 1/88.
(13)المزي، تهذيب الكمال: 28/88.
(14)الذهبي، ميزان الاعتدال: 6/465.
(15)ابن العماد، شذرات الذهب: 1/88.
(16)البداية والنهاية: 9/34. ابن العماد، شذرات الذهب: 1/88. المزي، تهذيب الكمال: 28/88.
(17)انظر في عبادته وزهده: ابن كثير، البداية والنهاية: 9/34.
(18)الذهبي، ميزان الاعتدال: 6/465. العجلي، معرفة الثقات: 2/286.
(19)الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/185. المزي، تهذيب الكمال: 28/245. أبو حاتم الرازي، الجرح والتعديل: 8/280.
(20)الذهبي، ميزان الاعتدال: 6/465.
(21)ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: 10/203، والحديث «إياكم والتمادح فإنه الذبح»، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب المدح، رقم: 3743.
(22)مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عثمان بن عفان، رقم: 432.
(23)البيهقي، شعب الإيمان: 4/226، رقم: 4870، 3/402، رقم: 3887.
(24)الطبراني، المعجم الكبير: 19/350، رقم: 815، 816.
(25)مجموع الفتاوى: 7/384.
(26)البخاري، خلق أفعال العباد: 75.
(27)اللالكائي، اعتقاد أهل السُّنَّة: 3/536.
(28)اللالكائي، اعتقاد أهل السُّنَّة 3/749.
(29)اللالكائي، اعتقاد أهل السُّنَّة 3/750.
(30)لسان الميزان: 6/335.
(31)الجرح والتعديل: 4/325، رقم: 1425.
(32)لسان الميزان: 6/335
(33)يقول ابن حجر العسقلاني [ت: 852هـ] «وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله»، لسان الميزان: 4/424.
(34)انظر على سبيل المثال: شرح الأصول الخمسة: 323 ـ 482.
(35)الطبري، تاريخ الطبري: 3/339.
(36)ابن قتيبة، المعارف: 441.
(37)ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: 4/424.
(38)ابن الجوزي، المنتظم (حتى 257هـ): 7/98.
(39)ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: 1/275.
(40)ابن النديم، الفهرست: 171، 181. ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: 4/424.
(41)ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: 1/275.
(42)القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال: 230. وفي هذا السياق يقول ابن المرتضى [ت: 463]: «كان واحد دهره في العلم والزهد والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله» انظر: المنية والأمل: 30. ويرى ابن النديم [ت: 385] أن رسائل غيلان تبلغ نحو ألفي صفحة: الفهرست: 171.
(43)ابن نباتة، سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون: 158
(44)الرازي، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 40
(45)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/34. الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/187.
(46)ابن الجوزي، تلبيس إبليس: 118. الأسفراييني، التبصير في الدين: 67. وراجع أقوال واصل في القدر: سليمان الشواشي، واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية: 175 ـ 180؛ وراجع قول غيلان في القدر في: الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/143؛ والشواشي. ص 48 ـ 49.
(47)القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال: 229.
(48)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/143، وانظر في بقية أقواله: المِلل والنِحل: 1/139، 1/146.
(49)الشواشي، واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية: 284 ـ 285.
(50)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/143، الإيجي، المواقف: 3/706
(51)القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال: 230.
(52)الموضعان من سورة المائدة، رقم الآية: 3.
(53)ابن نباتة، سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون: 158.
(54)الطبري، التاريخ: 4/219، وتابعه في ذكر هذه القصة على هذا النحو ابن كثير، انظر له: البداية والنهاية: 9/353.
(55)انظر في كراهية المعتزلة لبني أمية: الشواشي (سليمان)، واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية: 295 ـ 302.
(56)فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 230 ـ 233، ابن المرتضى، المنية والأمل: 30 ـ 33.
(57)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/350، بلاد خراسان تمتد من الهند حتى حدود العراق، انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 2/350.
(58)ابن تيمية، درء التعارض: 1/312، وحَّران مدينة في العراق على طريق الموصل، انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: 2/235.
(59)ابن النديم، الفهرست: 472، السيوطي، تاريخ الخلفاء: 254.
(60)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/350.
(61)لسان الميزان: 2/105.
(62)قتله خالد بالكوفة، وقيل بواسط، انظر: ابن تيمية، العقيدة الأصفهانية: 87، وكلتا المدينتين موجودتان في العراق.
(63)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/350، وقد نقل هذه القصة كل من ترجم لخالد أو تحدث عن الجعد، انظر: ابن النديم، الفهرست: 472؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: 5/432؛ ابن الأثير، الكامل: 4/466؛ ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: 1/277.
(64)ابن تيمية،. بيان تلبيس الجهمية: 1/277.
(65)ابن تيمية، درء التعارض: 1/312.
(66)ابن كثير، البداية النهاية: 9/350.
(67)ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص 118؛ ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: 1/277.
(68)ابن كثير، البداية النهاية: 9/350.
(69)ابن النديم، الفهرست: 472؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: 2/105.
(70)العقيدة الأصفهانية: 87.
(71)تُعدُّ هذه الآية من أدلة أهل السُّنَّة على وجود صفة الكلام لله، انظر على سبيل المثال: ابن تيمية: درء التعارض: 2/37.
(72)خصص القاضي عبد الجبار الجزء السابع من موسوعته «المغني في أبواب التوحيد» للتدليل على خلق القرآن، وعدم وجود صفة لله تسمى صفة الكلام.
(73)القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة: 195.
(74)القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة: 226 ـ 227.
(75)لسان الميزان: 2/105.
(76)ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: 1/277.
(77)ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: 4/424.
(78)الذهبي، سير أعلام النبلاء: 5/432، أو من أمثال ابن العماد الحنبلي [ت: 1089هـ] الذي قال: «فلله ما أعظمها وأقبلها من أضحية» ابن عماد، شذرات الذهب: 1/169، وقوله هذا جاء ردّاً على قول خالد «ضحوا فإني مضح بالجعد».
(79)شذرات الذهب: 1/169، وقوله هذا جاء رداً على قول خالد: «ضحوا فإني مضح بالجعد».
(80)ابن كثير، البداية والنهاية: 10/19، ابن نباتة، سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون: 159..
(81)النوبختي، فرق وطبقات الشيعة: 39.
(82)ابن حزم، الفصل: 1/91.
(83)الأشعري، مقالات الإسلاميين: 1/5، ابن حزم، الفصل: 1/91.
(84)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/152 ـ 153، الإيجي، المواقف: 3/679.
(85) قُتل بيان بن سمعان على يد خالد القسري، انظر: النوبختي، فرق وطبقات الشيعة: 34، ابن حزم، الفصل في الملل: 1/91، الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/153.
(86) ابن كثير، البداية والنهاية: 10/17.
(87) ابتدأت ولايته سنة تسع وثمانين في زمن الوليد، وانتهت ولايته سنة عشرين ومائة في زمن هشام، انظر: ابن كثير، البداية والنهاية: 10/17.
(88)الطبري، التاريخ: 4/189.
(89) الطبري، التاريخ: 4/185؛ ابن كثير، البداية والنهاية: 10/17.
(90) ابن كثير، البداية والنهاية: 10/17.
(91)ابن حبان، الثقات: 6/256.
(92) الطبري، التاريخ: 4/24، ابن كثير؛ البداية والنهاية: 10/17. وقد روي أنه بنى لأُمه كنيسة تتعبد فيها، وفيه يقول الفرزدق:
ألا قطع الرحمن ظهر مطية
أتتنا تهادى من دمشق بخالد
بنى بيعة فيها النصارى لأُمه
ويهدم مِنْ كُفْرٍ منار المساجد
وقال:
عليك أمير المؤمنين بخالد
وأصحابه لا طهر الله خالدا
بنى بيعة فيها الصليب لأُمه
ويهدم مِنْ بغض الصلاة المساجدا
(93) انظر: المبرد، الكامل في اللغة والأدب 3/65.
وهذا البيت في ديوان الفرزدق، والشطر الأول جاء باللفظ السابق، بينما الشطر الثاني جاء بهذا اللفظ: وهدّم من بغض الصلاة المساجدا، ديوان الفرزدق: ص 160.
(94)ابن كثير، البداية والنهاية: 10/17.
(95)الطبري التاريخ: 4/119.
(96)ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب: 1/169.
(97)ذكر المؤرخون أسباباً عدة وراء عزل خالد القسري، منها تضخم ثروته، ومنها أنه انتقص هشاماً، انظر في هذه الأسباب الطبري، التاريخ: 4/183 ـ 185، 188؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 4/436.
(98) الطبري، التاريخ: 4/8 ـ 9؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ: 4/262.
(99)الطبري، تاريخ الطبري: 4/24؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: 4/336.
(100)ابن كثير، البداية والنهاية: 10/19.
(101)ابن كثير: البداية والنهاية: 10/20.
(102)الطبري، التاريخ: 4/183؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 4/436.
(103)الطبري، التاريخ: 4/188، وقد ذكر المؤرخون أن خالداً شق أنهاراً تجبى ثمارها له، انظر: الطبري، التاريخ: 4/188
(104)ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: 3/88.
(105)الذهبي، ميزان الاعتدال: 2/415، الوصف الأول داخل القوسين لابن حجر العسقلاني، والثاني ليحيى بن معين [ت: 233].
(106)الذهبي، سير أعلام النبلاء: 9/410، هذا القول لأبي حاتم الرازي [ت: 327]، والمناكير جمع منكر، وهو الحديث الذي تفرد بروايته من ليس ثقة ولا ضابطاً، انظر: الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: 141؛ السيوطي، تدريب الراوي: 236.
(107)الذهبي، سير أعلام النبلاء: 9/410، وانظر: ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين: 1/251.
(108)أحمد بن حنبل، مسند أحمد، أول مسند المدنيين، حديث أسد بن كرز، رقم: 16220.
(109)الكيكلدي، جامع التحصيل: 300.
(110)ابن حبان، الثقات: 3/443.
(111)ابن حجر العسقلاني، الإصابة: 6/647.
(112)ابن أبي حاتم، المراسيل: 237.
(113)جمال الدين القاسمي، تاريخ الجهمية والمعتزلة: 40.
(114)ابن النديم، الفهرست: 472.
(115)الطبري، التاريخ: 4/75؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء: 247.
(116)الطبري، التاريخ 3/654، 4/35.
(117)أي ضعيفة ولينة، يقول ابن منظور [ت: 711هـ]: «الفَتَخُ: استرخاء المفاصل ولينها... وعُقاب فتْخاء: لينة الجناح»، لسان العرب: 3/40.
(118)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/350 ـ 351، ولم أطَّلع على صاحب هذا البيت.
(119)الطبري، التاريخ: 4/8 ـ 9، وانظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 4/262.
(120)الذهبي، ميزان الاعتدال: 2/159.
(121)الذهبي، ميزان الاعتدال: 2/159.
(122)القاسمي، تاريخ الجهمية والمعتزلة: 17؛ الطبري، التاريخ: 4/292.
(123)القاسمي، تاريخ الجهمية والمعتزلة: 12؛ ابن كثير، البداية والنهاية: 10/26.
(124)ابن كثير، البداية والنهاية. 10/27.
(125)ابن كثير، البداية والنهاية: 10/26.
(126)القاسمي، تاريخ الجهمية والمعتزلة: 16 ـ 17.
(127)الطبري، التاريخ: 4/294 ـ 295.
(128)انظر كنموذج لهؤلاء الولاة خالد بن عبد الله القسري.
(129)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/350.
(130)يقول البغدادي [ت: 429]: «وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته»، الفرق بين الفرق: 199.
(131)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/86.
(132)الأشعري، مقالات الإسلاميين: 280؛ الشهرستاني، الملل والنحل: 1/87.
(133)خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي: 108 ـ 109.
(134)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/350.
(135)الأشعري، مقالات الإسلاميين: 152، ويقول ابن حزم [ت: 456]: «وكان مقاتل يقول إن الله جسم ولحم ودم على صورة الإنسان»، الفصل: 4/155.
(136)الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص 181؛ المقدسي، البدء والتاريخ: 1/105.
(137)الملطي، التنبيه والرد: 121.
(138)الملطي، التنبيه والرد: 121.
(139)القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة: 195.
(140)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/88 وانظر: خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي: 96.
(141)خصص القاضي عبد الجبار كتاباً كاملاً ـ الجزء الرابع ـ لمسألة الرؤية، ضمن موسوعته الكلامية المسماة بـ «المغني في أبواب التوحيد والعدل».
(142)ابن الجوزي: الضعفاء والمتروكون: 3/137، وقال فيه البخاري [ت: 256] منكر الحديث، وجعله النسائي [ت: 301] من الكذابين المعروفين بوضع الحديث على الرسول؛ ابن الجوزي الضعفاء والمتروكون: 3/137، وقال فيه الذهبي [ت: 748]: «اجمعوا على تركه» الذهبي، سير أعلام النبلاء: 7/202
(143)الذهبي، ميزان الاعتدال: 6/505.
(144)الأشعري، مقالات الإسلاميين: 280.
(145)البغدادي، الفرق بين الفرق: 199
(146)ابن كثير، البداية والنهاية: 9/350.
(147)ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية: 1/277.
(148)ابن تيمية، منهاج السُّنَّة النبويّة: 1/309.
(149)البغدادي، الفرق بين الفرق: ص 199؛ ابن حزم، الفصل: 4/70.
(150)ابن حزم، الفصل: 4/70.
(151)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/87 ـ 88.
(152)خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي: ص 128.
(153)الملطي، التنبيه والرد: ص 121.
(154)خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي، ص 139.
(155)خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي، ص. 144.
(156)خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي، ص 145.
(157)خالد العلي، جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي، ص 87 ـ 90.
(158)الأشعري، مقالات الإسلاميين: 279؛ ابن حزم، الفصل: 2/99؛ الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/87.
(159)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 1/87.
(160)الشهرستاني، المِلل والنِحل: 88.
(161)القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة: 323 ـ 324.
(162)انظر: في رد المعتزلة على جهم بن صفوان في قضية الحرية الإنسانية: شرح الأصول الخمسة: 324، 363 ـ 364، نيبرغ في مقدّمته على كتاب «الانتصار والردّ على ابن الراوندي الملحد» لأبي الحسين الخياط: 53 ـ 54.