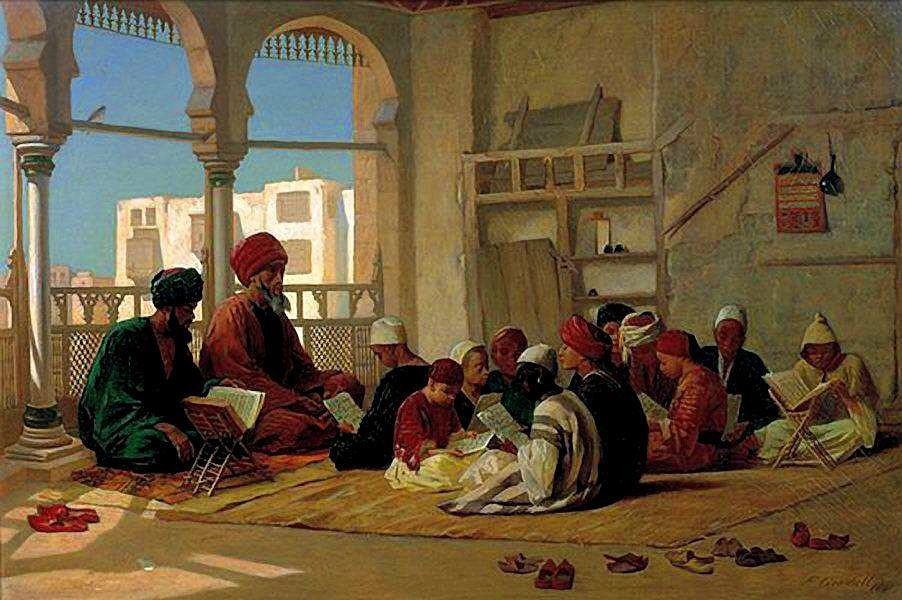سيبستيان غونتر | أستاذ كرسي اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة غوتنغن بألمانيا.
إن قِلَّة العلم بإنجازات الماضي التربوية تحول دون تمييز ما هو تقدم حقيقي في حقل التربية وما هو محض تكرار، أو بعبارةٍ أخرى أنه يمكن لجهلنا بالتاريخ التربوي أن نفشل في التوصل للمستوى الذي كان عليه أسلافنا، وأن ننشغل في الوقت ذاته بمشاكل مفترضة من جانبنا تقبع حلولها في مخازن المعرفة التاريخية.
من ذلك أنّ في الدراسات التربوية الغربية المعاصرة ميلاً إلى إغفال النظريات والفلسفات والحركات الفكرية التي لم تنبثق من حضارة الغرب وثقافته. ومن أمثلة ذلك أنّ الدراسات التربوية الغربية عادةً ما تنكبّ على الأسس اليونانية / الرومانية وأيضاً اليهودية / المسيحية للتاريخ التربوي من وجهة النظر الأوروبية، تاريخ تربوي أوروبي المركز، بينما لا تولي المفاهيم والممارسات التربوية للحضارات الأخرى اهتماماً كافياً. وذلك مدعاة استغراب نظراً إلى التحديات المعقدة التي تواجهها المجتمعات الغربية في مطلع الألفية الثالثة. والحق أن تزايد التنوع العرقي والديني لكلّ مدينةٍ كبيرةٍ في أوروبا وأميركا الشمالية (وفي معظم مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي) يحثّ على تغيير المقاربة التربوية على الصعيدين الوطني والدولي. وفي الوقت عينه ينبغي الإقرار بأن دراسة الفكر التربوي مفتاح من أجل تحسين فهمنا للثقافات والحضارات والأديان المختلفة عمَّا نحن عليه.
وأصحّ ما تنطبق الملاحظة الأخيرة عليه هو الإسلام لغير سببٍ واحد؛ فالحاجّة ماسّة في الغرب إلى دراسةٍ نقديةٍ منصِفة ومنظّمة تحيط بقيم الإسلام المتنوعة ومفاهيمه ومعتقداته، وبخاصّة تلك المتصلة بالنظريات والفلسفات التربوية التي وضعها العلماء المسلمون. لذا يُعنى مقالنا هذا بإيضاح عدّة مسائل في النظرية التربوية في الإسلام، ولعلّ شمولية تلك المسائل تجعلها محل اهتمام عامّة القراء إلى جانب المختصين. وفيما يلي عرض لأغراض المقال: أوّلاً: سيوفّر تصوّراً عن الآراء والفلسفات التربوية لبعض كبار العلماء المسلمين في القرون الوسطى. ومن شأن هذه إغناؤنا بفهمٍ دقيقٍ لأسسٍ الفكر التربوي في الإسلام وإبراز الإسهامات الفذة والمؤثرة للعلماء المسلمين في حقلَي التربية والتعليم. ثانياً: سيجذب المقال الانتباه إلى أن كثيراً من النظريات «الإسلامية الكلاسيكية» في التربية لا يمكن فهمها إلّا بعد الإلمام بخصائص .
تطوّرها في السياق الإسلامي وبمنزلتها في مسار التاريخ الفكري لشعوب البحر المتوسّط في العصرَيْن القديم والوسيط. وأخيراً، يرجى أن يساعد هذا المقال في فهم الغنى والتعقيد والتنوع الذي ميّز القول الفكري الإسلامي حول النظريات والممارسات التربوية، وفي أن يُشير إلى مدى «راهنية» أو «معاصَرة» بعض الأفكار التربوية التي طرحها العلماء المسلمون في القرون الوسطى.
من أهمّ شواهد التقوى في الإسلام إنفاقُ العمر في طلب العلم، وهو أساس التربية الإسلامية. ومع أن بغية هذا المفهوم هي تقوية إيمان الفرد الديني؛ فإنّ مجاله اتّسع ليشمل علوماً دنيوية أدبية وعلمية؛ لأنّه قصد إلى إثراء المجتمع الإسلامي بشخصيات متكاملة ثابتة الأصل في الإسلام. وهذه الفكرة العامّة متّصلة بالنظرية والممارسة في التربية الإسلامية الابتدائية والمتقدمة. فهي ظاهرة في القرآن والحديث حيث يُنسب إلى النبيّ محمّد (ص) أقوال؛ مثل: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة»؛ «اُطلب العلم من المهد إلى اللحد»؛ «اُطلبوا العلم ولو في الصين»(1). أمّا الإمام عليّ ـ صهر النبيّ (ص) وصاحب المقام الرفيع عند الشيعة ـ فيُنسب إليه الأبيات:
ما الفخرُ إلّا لأهلِ العِلْم إنَّهـم
على الهدى لمن استهدى أدلَّاءُ
ففُزْ بعلمٍ تَعِشْ حياً به أبداً
النَّاسُ موتى وأهلُ العِلْمِ أحْياءُ(2)
وثمّة آثارٌ وأمثال وحِكَم عدّة تُظهر علو شأن المعرفة والتربية في الإسلام، علاوة على الشعر والنثر في آداب الشرق الأوسط(3). وهي شديدة الوضوح في المؤلفات العربية في القرون الوسطى الكثيرة المؤصلة لمسائل التربية والتعليم. تهتدي هذه المصنّفات بتوجيهات القرآن والحديث في شرح وسائل التعليم، وكيف ينبغي له أن يكون، وغاياته وسبل تحقيقها. ومن ذلك سلوك الأساتذة والتلامذة وصفاتهم (الخلقية)، وعلاقتهم بعضهم ببعضٍ في أثناء التعلّم والإرشادات (وتشمل منهاج التعلّم وتنظيمه ومحتوياته) وسبل نقل المعرفة وتحصيلها.
يمكن إبداء ملاحظتين عامّتين حول هذه النصوص العربية من القرون الوسطى المتعلّقة بالتربية في الإسلام: أولاهما: إنّ عناصر من الثقافات القديمة العربية والفارسية ـ بل ومن التراث الإغريقي ـ الهلنستي ـ قد استوعبت وأُدمجت في النظرية التربوية الإسلامية. وأكثر ما يظهر ذلك في مصنّفات الفلاسفة المسلمين الذين بحثوا المراحل المختلفة لتطوّر الشخصية والطبائع البشرية وتربية الأطفال والتعلّم المتقدّم. ثانيتهما: أنّه كان من القرن الثامن حتىّ القرن السادس عشر تراثٌ متصل من المصنّفات العربية ـ الإسلامية يعنى بالموضوعات التربوية والتعليمية، ويعكس آراء المصنّف الكلامية وأصوله القومية وجذوره الجغرافية. وكان من علماء القرون الوسطى المشتغلين بالتربية متكلمون وفلاسفة وفقهاء وأدباء ومحدثون وعلماء متخصصون في العلوم الطبيعية. ولم يكن أحد منهم مختصّاً بالتربية والتعليم، مع أنّ كثيراً منهم قد مارسهما. بَيْدَ أنّ أفكارهم وفلسفاتهم التربوية أسهمت أيّما إسهام فيما يسمّى (تراث الإسلام التربوي الكلاسيكي أثناء العصر العباسي).
التعليم وتطوّر المنهاج في عصور الإسلام المتقدّمة: ابن سَحْنُون (817 ـ 870)
ويبدو أن أوّل عالم مسلم صنّف «دليلاً عملياً» للأساتذة كان الفقيه والقاضي المالكي العربي محمّد بن سحنون القيرواني مولداً وإقامة (4) . والقيروان مدينة في وسط الشمال التونسي، وهي من المدن الإسلامية ذات الشأن، وكانت في زمنَ ابن سحنون مركزاً اقتصادياً وإدارياً وثقافياً مزدهراً في المغرب الإسلامي.
كتاب ابن سحنون في التربية عنوانه أدب المعلِّمين ، (5) فقيه مالكي (محافظ) في مسائل قد يواجهها الأساتذة في المدارس الابتدائية أثناء قيامهم بعملهم. والكتاب ـ رغم مضي ألّف عام ونيف عليه ـ لا يزال مَعْلماً في تاريخ التربية والتعليم. فهو يزودنا بفكرة عن بدايات النظرية التربوية وتطوّر المنهاج في الإسلام، ويكشف عن مشكلات من القرن التاسع ما زالت مستمرة حتىّ يومنا هذا. والفصول الأربعة الأُول من (أدب المعلِّمين) مبنية على أحاديث نبوية في فضل تعلّم القرآن وتعليمه وفي حسن معاملة الأساتذة لتلامذتهم. أمّا الفصول الستّة الباقية فهي أسئلة وأجوبة كان ابن سحنون قد سألها أباه سحنون، وهو من كبار فقهاء المالكية. ويزود ابن سحنون أساتذة المدارس الابتدائية (في القرون الوسطى) بتوجيهات وقواعد محدّدة تتراوح بين مسائل في المنهاج والامتحانات وبين نصائح فقهية عملية في موضوعات مثل تعيين الأستاذ وراتبه، وتنظيم التعليم، وعمل الأستاذ، مع التلامذة في المدرسة والإشراف عليهم فيها، وما ينبغي على الأستاذ عمله بينما يعود التلامذة، إلى منازلهم والإنصاف في معاملتهم (ومنه سبل معالجة خلافاتهم) وتجهيزات الصفّ وتخرّج التلامذة(6)
والمنهاج الذي يحيل إليه ابن سحنون ـ يمثّل إلى حدٍّ ما ـ المدرسة الابتدائية الإسلامية في القرون الوسطى (تضمّ الأطفال من عمر ستّ إلى سبع سنوات). فهو يشمل الموضوعات الواجب تعليمها؛ كحفظ القرآن، وتلاوته تلاوة صحيحة، والفرائض، ومعرفة القراءة والكتابة، ومحاسن الأخلاق التي أوجبها الله. كذلك هناك موضوعات يحسن دراستها؛ مثل مبادئ اللغة العربية، والنحو، والخط، والحساب، والأمثال، والتاريخ وآداب العرب، والخطابة، وما وافقَ الأخلاق من الشعر. ويقتبس ابن سحنون آثاراً نبوية تُظهر مكانة حفظ القرآن وتعلّمه في الدراسة الإسلامية التقليدية التي تميل إلى الدين (مثلما كانت أوروبا القرون الوسطى تشدّد على دراسة الكتاب المقدّس):
خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه
من تعلّم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه، ومن تعلّمه في كبره وهو يتفلّت منه ولا يتركه؛ فله أجره مرتين.
عليكم بالقرآن فإنه ينفي النفاق كما تنفي النار خبث الحديد(7)
ويؤكّد ابن سحنون في مواضع عدّة من كتابه على أنّ التواضع والصبر وحبّ العمل مع الأطفال هي كلّها صفات ضرورية للأساتذة، وهو في هذا أيضاً يؤيّد كلامه بشواهد من الحديث النبوي؛ لكنّه يفصح عن أن العقاب الجسدي كان ممّا يؤدَّب به الأطفال في الإسلام إبان القرون الوسطى، وإنْ كان يجزم بأن العقوبة يجب ألّا تجاوز حدّها لئلّا يتأذى الولد.
أمّا في الجوانب العملية للتعليم والتعلم فينصح ابن سحنون الأساتذة بأن يحثّوا تلامذتهم على الدرس فرادى وجماعات وأنْ يحفّزوا أذهانهم بالمسائل الصعاب. من ذلك اقتراحه أن يملي التلامذة بعضهم على بعض، وأن يستفيد التلامذة؛ المجدّون من كتابة رسائل للكبار. وثمة ثناءٌ صريح على التنافس المنصف بين التلامذة، إذ يرى المصنّف أنّه يسهم في تشكيل شخصية التلامذة وفي تطوّرهم الفكري عامّةً.
وهناك قواعد وإرشادات تخصّ مسائل متفرّقة؛ منها أنّ الأساتذة المسلمين يُنصحون بألّا يعلّموا الفتيان والفتيات في آنٍ واحدٍ؛ لأنّ في الاختلاط مفسدة للشباب. ويظهر من هذا أوّلاً أنّ التعليم لم يكن مقتصراً علي الفتيان، وثانياً أنّه كان ثمّة تعليم مختلط في المدارس الابتدائية إلى حَدٍّ ما. وعلاوة على ذلك فإنّ ابن سحنون ينقل عن والده نهيَه عن تعليم أطفال النصارى القرآن. يُفهم من ذلك أوّلاً أنّ الأطفال المسلمين والنصارى كانوا يدرسون في الصفّ نفسه، وثانياً أنّ ابن سحنون التزم بحرفية النهي القرآني ﴿ {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ﴾[البقرة: 256] (8)
التعليل والاستنباط في مقابل الحفظ كأساليب تعليمية: الجاحظ (حوالى 776 ـ 868) ولقد صنف الأديب والمتكلّم المعتزلي المشهور أبو عثمان الجاحظ كتاباً في المعلمين مختلفاً إلى حدٍّ كبير عن كتاب ابن سحنون .(9)
والجاحظ المرجّح أنه من أصل حبشي، ولد في العراق، وبالتحديد في البصرة المتنوعة عرقياً وفكرياً مما أثّر في تفكيره وأخصب ذهنه في كتاباته وسائر أعماله.
وبخلاف متن ابن سحنون الفقهي لأساتذة المدرسة الابتدائية؛ فإن كتاب المعلمين للجاحظ يعالج مسائل التعليم والتعلم للتلامذة المتقدمين وذلك من جانب أدبي فلسفي(10) ولا يكتفي الجاحظ في مقالته هذه بالدفاع عن أساتذة المدارس بل يقرّظهم، ويصرّح بتفضيلهم على سائر أصناف المعلّمين والمؤدبين، وهو تقدير خَفِيَ عن الناس حيث كانت منزلة أساتذة المدارس شديدة الضعة. ويصوّر الجاحظ الأساتذة على أنهم عالمون ومثابرون ومُجِدّون، يشغفون بعملهم، ويكابدون المشاقّ إذا لم يتحسّن تلامذتهم كما يؤمَّل. لذا ينبغي على الأهل ألّا يلوموا الأساتذة على بلادة تلميذ؛ بل يجدر بهم تفحّص ذكاء أولادهم.
ومما يثير الاهتمام أن الجاحظ يلفت النظر إلى خطر عمل الأستاذ بتأكيده على الأثر العظيم للكتابة في الحضارة الإنسانية، وبجعله الكتابة والتدوين والحساب «عموداً» يتوقف عليه حاضر الحضارة ومستقبلها، و«صلاح الدين والدنيا». كذلك يصرّح بأن كبار المفكّرين الأحرار وأعلام السابقين أنكروا الحفظ الذي يؤدي إلى «إغفال العقل من التمييز» والاعتماد على ما أتى به الأسلاف دون محاولة الوصول إلى استنتاجات مستقلة. بَيْدَ أن الجاحظ يقرّ بأن قوة الحافظة حاجة ماسة للتعلّم، وإلّا لم تمكث ثمرات التحصيل؛ يقول:
وكرهت الحكماء الرؤساء أصحاب الاستنباط والتفكير جودةَ الحفظ؛ لمكان الاتكال عليه وإغفال العقل من التمييز، حتى قالوا: «الحفظ عذق الذهن»، ولأن مستعمل الحفظ لا يكون إلا مقلداً، والاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة.
والقضية الصحيحة والحكم المحمود أنه متى أدام الحفظ أضرَّ ذلك بالاستنباط، ومتى أدام الاستنباط أضر ذلك بالحفظ، وإن كان الحفظ أشرف منزلة منه. ومتى أهمل النظر لم تسرع إليه المعاني، ومتى أهمل الحفظ لم تعلق بقلبه، وقل مكثها في صدره.
وطبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط، والذي يعالجان به ويستعينان متفق عليه، ألا وهو فراغ القلب للشيء والشهوة له، وبهما يكون التمام وتظهر الفضيلة(11)
ويُعدّد الجاحظ أكثر ما ينبغي على التلميذ تعلّمه كما يلي: الكتابة، والحساب، والفِقه، والفرائض، والقرآن، والنحو، والعروض، والشعر. ومما ينبغي تعليمه أيضاً الجدلُ، ولعب الصوالجة، والفروسية، والرمي، والموسيقى، والشطرنج، وسائر الألعاب. كما ينصح الجاحظ بأن يعرَّف الأطفالُ حججَ الكُتّاب وتخلُّصهم باللفظ السهل القريب المأخذ إلى المعنى الغامض. وأن يعلّموا حلاوة الاختصار، وراحة الكفاية، ويحذّروا من التكلف واستكراه العبارة. كذلك يجب عليهم تقديم المعنى على اللفظ متى تعارضا. لذا على الأساتذة أن يزودوا التلامذة بأمثلة وأفكار بعيدة من التعقيد ومتصلة بعضها ببعض.
أما فيما يختص بعملية التربية والتعليم فإن الجاحظ ينصح الأساتذة بمراعاة قدرات التلامذة الذهنية؛ لذا ينبغي عليهم أن يكلموهم بلغة يفهمونها. كذلك على الأساتذة أن يعاملوا تلامذتهم بلطف ومحبة يتوصلون بهما إلى قلوبهم في تلقين المادة الدراسية. ويختم الجاحظ فى كتابه (كتاب المعلمين) بكلمة بليغة في فضل الرفق بالتلامذة، حاثّاً الأساتذة على التلطّف والعناية بالتلامذة، وعدم إكراههم على شيءٍ لئلا يمقتوا محاسن الأخلاق، وعدم إهمالهم؛ لأنهم جديرون بكل عناية وأشدّ اهتمام(12)
التعلم القائم على التلامذة وفن التعليم: الفارابي (ت 950)
يُعدّ أبو نصر الفارابي (المشتهر في أوروبا القرون الوسطى بألفاربيوس) أحد أبرز فلاسفة الإسلام، ولعّله حقاً أوَّلُ مناطقته (13)
ويسميه المفكرون المسلمون في القرون الوسطى «المعلّم الثاني» بعد المعلم الأول أرسطو. والفارابي تركيُّ الأصل، وُلد في تركستان؛ لكنه عاش سنوات طوالاً في بغداد وحلب، وتوفي في دمشق عن ثمانين ونيف. والفارابي من أوائل علماء المسلمين الذين اقترحوا منهاجاً متكاملاً لدراسة العلوم «الدخيلة»؛ أي تلك المبنية على الفلسفة اليونانية، والعلوم «الدينية»؛ أي القائمة على القرآن وتفسيره (14)
والمنهاج الذي اقترحه الفارابي «يلحظ بنية الكون الهَرمية ويفرّق بين العلمين الإنساني والإلهي» (15) ورغم أن هذه المقاربة التعليمية لم تصبح مكوّناً أساسًيا في الدراسة الإسلامية الرسمية، فقد كان لها أثر في الفلاسفة الذين احتذوها إلى حدٍّ ما في قراءاتهم الخاصة وحلقاتهم الدراسية (16) في رسالة البرهان للفارابي أفكارٌ من نظريته التعليمية مندرجة في قسم المنطق (17) يفتتح قوله في المسألة بتبيان خطأ الذين يستعملون ألفاظ «التعليم» و«التلقين» مرادفةً لـ «التأديب» و«التعويد». فالفارابي يرى أنّ التعليم نتيجته الفهمُ أو مَلَكةُ الفهم، أما التلقين فليست غايته اكتساب المعرفة بل تغذية الخصال المؤدية إلى الفعل. والاستعمال الخاطئ لهذه الألفاظ يمنع الناس من التمييز الصحيح بين مختلف السبل الضرورية لاكتساب المعرفة والعادات والمهارات والطباع. كما يؤكد الفارابي أن دقة الاصطلاح مطلبٌ رئيس في التعلم عامةً؛ لأنّ وضوح العبارة ثمرته وضوح الفكرة ومن ثَمَّ حُسْن التعلّم (18)
تلك إذاً أسباب كافية للفارابي ليحدّد «التعليم» تحديداً وافياً. وهو إذ يقرّ بأن ثمّة تعليماً إلهيّاً وإنسانيّاً فإنه يحصر اهتمامه بالتعليم الإنساني(19). وعنده أنّ التعليم الإنساني هو (أ) فعل بشري، (ب) يتناول المعقولات الإنسانية، لذا (ج) ينبغي فحصه في سياق الفلسفة، وليس هذا حال التعليم الإلهي. كذلك عنده أنّ التعليم الإنساني فعلٌ يهدف إلى غاية هي معرفة ما كان مجهولاً من قبل؛ وهو يحتاج إلى نوع علم سابق ومعرفة أُولى منهما يبدأ، كما أنه يقوم على أنّ زيادة العلم غريزة بشرية، ولا تُدرك تلك الغريزة إلا بعد تنبُّه المتعلِّم إلى جهله وإلى أنّ الجهل شرط أو مكوّن رئيس في التعليم؛وعنده أنّ التعليم الإنساني هو (أ) فعل بشري، (ب) يتناول المعقولات الإنسانية، لذا (ج) ينبغي فحصه في سياق الفلسفة، وليس هذا حال التعليم الإلهي. كذلك عنده أنّ التعليم الإنساني فعلٌ يهدف إلى غاية هي معرفة ما كان مجهولاً من قبل؛ وهو يحتاج إلى نوع علم سابق ومعرفة أُولى منهما يبدأ، كما أنه يقوم على أنّ زيادة العلم غريزة بشرية، ولا تُدرك تلك الغريزة إلا بعد تنبُّه المتعلِّم إلى جهله وإلى أنّ الجهل شرط أو مكوّن رئيس في التعليم؛ لأنّه مبدأه ومنطلقه (20) لكن تنبيه المرء على علمٍ له منسيٍّ لا يُسمّى «تعليماً». وفي شأن عملية التعليم يلحظ الفارابي أن:
التعليم قد يكون بسماع وقد يكون باحتذاء، والذي بسماع هو الذي يستعمل المعلم فيه القول، وهذا يسميه أرسطوطاليس التعليم المسموع. والذي يكون باحتذاء هو الذي يلتئم بأن يرى المتعلم المعلم بحالٍ ما في فعل أو غيره، فيتشبه به في ذلك الشيء أو يفعل مثل فعله، فيحصل للمتعلم القوة على ذلك الشيء أو الفعل (21) ويضيف: وإذاً كل تعليم فهو يلتئم بشيئين؛ بتفهيم ذلك الشيء الذي يُتعلَّم وإقامة معناه في النفس، ثم إيقاع التصديق بما فُهِم وأقيمَ معناه في النفس. وتفهيم الشيء على ضربين: أحدهما أن تُعقل ذاته، والثاني بأن يُتخيَّل بمثاله الذي يحاكيه. وإيقاع التصديق يكون بأحد طريقين: إما بطريق البرهان اليقيني وإما بطريق الإقناع (22)
يمكن من هذا ملاحظة أنّ التعليم يُنظر اليه على أنه عملية تفاعلية بين الأستاذ والتلميذ، فمسؤولية الأستاذ هي تقديم معرفة جديدة إلى التلميذ بأسلوب مفهوم، أما مسؤولية التلميذ فهي تفهّم الحقائق الجديدة جيداً حتى يستطيع استعمالها في سياقات مختلفة عما أَلِفَه في الدرس. كما أن أسلوب التعليم؛ الناجح هو الذي يضمن أنّ الأستاذ والتلميذ كليهما يشاركان في العملية مشاركة فعالة. ومن شأن العنصر التفاعلي في العملية أن يجعل التلميذ محور التعليم لأن غايته أن يُيسّر الأستاذ للتلميذ رحلته المعرفية.
يؤكد الفارابي على واجب الأستاذ في جعل الفهم والتفكير المجرد ميسوراً للتلميذ. ويقدّم نصائح عدة في هذا الشأن؛ فهو مثلاً يوصي بأن يشرح الأستاذ المادة التي سيعلّمها ويحدّدها باستخدام شتى وسائل الإيضاح. كما يحسُن ذكر مختلف نواحي موضوع الدراسة وبسط مزاياه أو الإشارة إلى ما يماثله نوعاً أو شكلاً. وفي هذا الجانب يمكن للأساتذة الاعتماد على سبل وطرائق مثل الترتيب والتصنيف والاستقراء والتمثيل والقياس؛ فهذه كلها تساعد التلميذ على التآلف مع موضوع الدراسة وتسهّل عليه فهمه، وبذلك تسهم في إغنائه بمعرفة أو فكرة. لذا فإن استعمال وسائل التعليم المتنوعة تسهّل على الأستاذ عمله في إثراء ذهن التلميذ بصورة أو فكرة عن شيء كان مجهولاً من قبل، وذلك مما يساعده في التعلّم. علاوة على ذلك فإنه ييسّر للتلامذة اكتساب معلومات جديدة. بَيْدَ أنّ هذا الأسلوب ينبغي هجرانه متى تمرّس التلامذة إلى حدّ القدرة على تعلّم الموضوع «مباشرة» من الأستاذ دون حاجة إلى مزيد شروح وتعليقات.
هنا يستشهد الفارابي مجدداً بأرسطو الذي ينقل عنه كراهة التعليم الذي يستبدل أعراض الشيء وصفاته الزائدة بالشيء نفسه؛ إذ إنّ في ذلك ابتعاداً من موضوع التعليم المطلوب فيزداد التلامذة حيرةً لا علماً. فهم سيضيعون وقتاً في فهم ما قاله الأستاذ أو سينصرفون عن التعلّم خائبين. لذا يحسن أن يكون تعلّم التلامذة المتقدمين قائماً على وضوح الفكرة والعبارة والمقاربة المباشرة، هادفاً إلى الجزم واليقين التام (23)
خصائص تربية الطفل ونفسيته: ابن سينا (980 ـ 1037)
وُلد ابن سينا قرب بخارى بأوزبكستان راهناً، وهو فيلسوف مسلم وطبيب وعالم طبيعي وإداري يشتهر في الغرب باسم أڤيسينّا. لم يغادر ابن سينا المشرق الإسلامي قط، وقد أمضى معظم سني عمله في مدن إيران مثل همَدان وأصفهان. ومع أن لغته الأمّ كانت الفارسية، فإنه صنّف أعماله الرئيسة بالعربية التي كانت لغة العلوم والثقافة في الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى. ورؤية ابن سينا للعالَم قامت على دعامتين: (أ) الفلسفة اليونانية و (ب) الوحي القرآني وفضائل الإسلام. وقد أبدع ابن سينا في تبنّيه أهم مبادئ الفلسفة اليونانية القديمة من خلال دمج دراسة الطبيعة بالفلسفة، وفي النظر إلى كمال الإنسان على أنه كامن في العلم والعمل معاً. لذا فإن مفهومه العام للتعلّم يشي بافتراضات أرسطية في العمق. وابن سينا كان على جانب من الأخلاق والدين، معتقداً أنّ التعليم والتعلّم ينبغي أن يؤديا إلى ترسيخ الإيمان في نفوس الأفراد؛ بَيْدَ أن قناعاته هذه لا تنافي كون كثيرٍ من كلامه في التربية طبياً أو نفسياً في جوهره ومبناه.
ذهب ابن سينا إلى أن عملية التعلّم إنما تبدأ من الحواس الخمس: السمع والبصر والشم واللمس والذوق. وهذه الحواس بلغت أوجها عند البشر ممّا ميّزهم عن الحيوانات. كما أن وجود النفس أضفى على البشر قدرتين عقليتين: العقل النظري والعقل العملي، حيث يتحكم العقل العملي بحركات الجسد ويسيطر العقل النظري على مستوى التعليل الأعلى وعلى العمليات الفكرية داخل النفس. ومما يلفت النظر أن ابن سينا يصرّح بأنّ قوام العقل النظري أربعُ عمليات متمايزة محصورة بالبشر. هذه العمليات هي ـ من أدناها إلى أعلاها:
1 ـ القدرة على اكتساب المعرفة (أي العقل الهيولاني)، وهي تخدم؛
2 ـ القدرة على استخدام المعرفة المكتسَبة ومن ثم التفكير (أي العقل بالملكة)، وهي تخدم؛
3 ـالقدرة على توليد النشاط العقلي لتعقُّل المفاهيم الأكثر تعقيداً (أي العقل بالفعل)، وأخيراً؛
4 ـ القدرة على استبطان المعرفة بالعالَم المعقول (أي العقل المستفاد، وهو الحاكم الذي تأتمر سائر عمليات العقل النظري بأمره). أما غاية العلم فهي تحصيل هذه القدرة وإحسان استخدامها (24)
ومع أن عرض هذه الأفكار متخم بالتنظير والتعقيد، فإنها شديدة الصلة بشتى نواحي التعلّم العملية. وهي أكثر ما تكون مفيدة فيما يتصل بتعليم الأطفال والفتيان، وبخاصة الأنشطة التي تتضمّن إشراك الأطفال الصغار في تجارب حسّية؛ لأنها تسهم في تحفيزهم للتعرّف على الأشياء، ومقارنتها وتصنيفها من خلال اكتشافهم للعالم من حولهم.
على سبيل المثال، يظهر اهتمام ابن سينا الشديد بتعليم الأولاد في كتابه الضخم القانون في الطب الذي هو خلاصة علم الطب في زمانه مزيداً ومنقّحاً بملاحظاته الشخصية (25)
وهو يتناول تعليم الأطفال في ثنايا دراسته لمراحل الحياة الأربع. أما منطلَقُه لاستكشاف أهم جوانب تعليم الأطفال من الطفولة إلى المراهقة فهو نظراته الثاقبة في شتى نواحي تطور الطفل فكرياً وجسدياً وعاطفياً (26)
يقول:
يجب أن تكون العنايةُ مصروفةً إلى مراعاة أخلاق الصبي، وذلك بأن يحفظ كيلا يعرض له غضب شديد، خوف شديد أو غم، أو سهر، وذلك بأن يتأمل كل وقت ما الذي يشتهيه ويحن إليه، فيقرّب إليه، وما الذي يكرهه فينحّى عن وجهه. وفي ذلك منفعتان، إحداهما في نفسه؛ بأن ينشأ من الطفولة على حسن الأخلاق ويصير ذلك له ملكة لازمة. والثانية لبدنه كما أنّ الأخلاق الرديئة تابعة لأنواع سوء المزاج، فكذلك إذ حدث حادث عن العادة استتبعت سوء المزاج المناسب لها... ففي تعديل الأخلاق حفظ الصحة للنفس والبدن جميعاً معا (27)
ويؤكد ابن سينا أن مراعاة خصائص العقل البشري (كما يراها) أمرٌ حيوي في تعليم الأولاد. علاوة على ذلك، يبدو أنه يلمح إلى أنّ لكيفية تطوّر الطفل أثراً في تعلُّمه. من ثَمَّ يلفت النظر إلى أهمية الاستقرار العاطفي؛ لأنه يحفظ للطفل نموّه الذهني والجسدي. من ذلك توصيته بأن يبدأ الأطفال بارتياد المدرسة الابتدائية متى تهيّأ عندهم قوة البدن ونضج الذهن. وفي رأيه أن هذا يشمل حيازة الأطفال لمهارات اللغة الضرورية وقدرتهم على التركيز والفهم؛ وعنده أن ذلك يكون عادة في عمر ست سنوات (28)
بَيْدَ أن تناغم مكوّنات التعليم الذهنية والجسدية يظل شرطاً رئيساً في مراحل التعلّم كلها. لذا فهو ينصح الأساتذة بالتنبه والتيقّظ إلى قدرات التلامذة «الطبيعية»، وباختيار مطالب دراسية تكافئ طاقتهم الذهنية ومبلغ علمهم. فعلى الأساتذة والمعلمين أن يضمنوا سهولة السبيل إلى المعرفة، وبخاصة عند ابتداء التعليم النظامي. ويتأتى منه وجوب إزاحة العقبات كلها وجعل التعلّم ممتعاً للتلامذة ومثيراً ومحفزاً. وهذا في رأي ابن سينا أنجح السبل لدفع التلامذة إلى التعلّم والتقدّم.
وفيما يلي مسألتان في منهاج التعلم عند الشروع بالمدرسة الابتدائية مأخوذتان من كتاب السياسة لابن سينا (29)
أولاهما: وجوب تقديم دراسة (أ) القرآن (أي البدء بتحفيظه للتلامذة)، (ب) القراءة والكتابة، و (ج) معالم الدين. ومما يسترعي الانتباه أن ابن سينا يشير إلى مبدأ تربوي مهم في أثناء توصيته الأساتذة بتعليم القراءة والكتابة في آن معاً. وهو يمثّل لهذه الفكرة بأن على الأستاذ كتابة الحروف (على اللوح) ليألفها التلامذة ومن ثَمَّ يطلب منهم نسخها حتى يحسنوا كتابتها (30)
ويبدو أن ابن سينا يعلّل ذلك بأن دراسة النصوص الدينية تغني التلامذة الصغار بكل ما يحتاجون إليه في حداثتهم من بلاغة وفهم للأشياء؛ وهو ما خلص إليه أيضاً عبد الأمير شمس الدين أحدُ أغزر الباحثين المسلمين المعاصرين إنتاجاً حول نظرية ابن سينا التربوية. كما أنّ شتى الموضوعات اللغوية والفكرية الحاصلة من دراسة القرآن تبعث الفكرَ على التأمل وتزيد طاقة التلميذ الذهنية. إضافة إلى ذلك، فإن النصّ الديني عامةً هو مصدرٌ رئيس لتعليم الأطفال محاسنَ الأخلاق ومكارم الأفعال ومرضيَّ السُّنن. وكل ذلك نافعٌ لإعانة الفتيان على أن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويبلغوا مراتبهم المستحَقة فيه (31)
أما ثانية هاتين المسألتين فهي أن ابن سينا ـ كسائر المفكرين المسلمين القرون الوسطى ـ يقدر الشعر تقديراً عالياً في كونه وسيلة تعليمية. والشعر مهم في تعليم الأطفال، لأسباب عدة:
(أ) فلغته متوازنة وتراكيبه مسبوكة، محبوكة مما يقوي ذاكرة الأطفال، ويمرّن أذهانهم، ويهيئهم لاستيعاب المفاهيم الأكثر تعقيداً فيما بعد.
(ب) يعوِّد الشعرُ التلامذةَ على فصيح الكلام وبليغه، مما يعينهم على المحادثة الصحيحة بانتقاء الألفاظ المناسبة، ويوسّع مخيلتهم، ويفتح آفاقهم الفكرية.
(ج) يعرّف الشعر التلامذة بـ «فضل الأدب ومدح العلم».
(د) إنشاد الشعر هو في نفسه متعة تجعل التعلّم منعشاً ومرفهاً للسامع والمنشد كليهما. بَيْدَ أن ابن سينا يجزم بأن على الأستاذ في بداية التعلّم اختيارَ قصائد قصيرة ذات بحور سهلة، ومن ثَمَّ يتدرّج نحو قصائد أطول وأصعب (32)
أما فيما يتعلق بتعليم التلامذة في المدرسة، فيشدد ابن سينا على وجوب أن يتشارك الأطفال الصف مع أتراب لهم. وهو يصرّح بتفضيله أن يكون زملاء الطفل في الصف من ذوي التربية الحميدة والسلوك الحسن؛ فإمضاء الوقت مع الأطفال ذوي السلوك الحسن يحفّز الطفل ويشجعه على التعلّم والتقدّم، كذلك فإن تواصل الأطفال وتحاورهم يفيد أذهانهم ويساعد في حلّ المشكلات (33)
أخيراً يوصي ابن سينا بأن يكون معلمو الأطفال فضلاء محمودين أولي قدرة على ممارسة التعليم، يقول:
وينبغي أن يكون مؤدب الصبي عاقلاً ذا دين، بصيراً برياضة الأخلاق، حاذقاً بتخريج الصبيان، وقوراً رزيناً بعيداً من الخفة والسخف، قليل التبذّل والاسترسال بحضرة الصبي، غير كَزٍّ ولا جامد، حلواً لبيباً ذا مروءة ونظافة ونزاهة (34)
الإرشاد في مقابل التأديب، ومبادئُ سلوك التلامذة والأساتذة: الغزالي (1058 ـ 1111)
الغزالي متصوف ومصلح ديني؛ بل لعله أعظم متكلّمي الإسلام، وهو أكبر نقّاد ابن سينا؛ وهو يقارب مسألة التعلّم من منظور مختلف جداً. ولد الغزالي في طوس قرب مدينة مشهد الإيرانية. وقد تيتّم وأخاه أحمد (الذي غدا متصوّفاً مرموقاً هو أيضاً) وهما بعدُ صغيران. أتمّ الغزالي جلّ تعليمه ودراسته في نيسابور وبغداد. وفي عام 1091 تولى ـ وهو في الثالثة والثلاثين ـ رئاسة التدريس بالمدرسة النظامية المؤسسة حديثاً آنذاك، التي هي أشهر مؤسسات التعليم العالي في بغداد وربما العالم الإسلامي كله في القرن الحادي عشر. وظل يدرّس الفِقه هناك لبضع مئات من الطلبة حتى عام 1095. وفي مرحلة لاحقة عاود التدريس، وإنْ في نيسابور وبعدها في طوس دون بغداد. لذا فإن أفكاره التعليمية تفصح عن خبرة حقيقية، وتُبرز التجربة التربوية لأستاذٍ مرموق، ولا تقتصر على أقوال شائعة أو أفكار مثالية لعالم متدين.
يُعرف عن الغزالي قبوله بالمنطق اليوناني أداةً تعليمية محايدة وتوصيته المتكلمين بذلك؛ لكن مصنفاته الصوفية هي التي تُظهر لنا أمرين متعلقين بالتعليم: أولهما: استدخاله قيماً أخلاقيةً أرسطية الأصل في قالب إسلامي وعدها قيماً صوفية. ثانيهما: إصراره على أن سبيل المعرفة الصوفية يبدأ بالمعتقدات الإسلامية التقليدية (35)
وعليه فإن «مؤلفاته والأسوة التي مثّلها أسهمت في جعل العلوم الدينية قوام الدراسة للراغبين بتحصيل التعليم العالي» (36)
يُعدُّ الغزالي الآن أحد أعظم بناة الفلسفة التعليمية الإسلامية وقيمها الأخلاقية؛ ففهمه للتعليم على أنه إرشادٌ للفتيان وليس تأديباً لهم بات مبدأً تربوياً ذائعاً في كثير من مؤلفات القرون الوسطى في التعليم الإسلامي، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. أما أكثر نظرياته التربوية والتعليمية تفصيلاً فقد ضمّنها إحياء علوم الدين (37)
الذي يُعدُّ «دليلاً متكاملاً للمسلم التقيّ في كل شؤون حياته الدينية وعباداته وشعائره وسلوكه وتصفية نفسه والسير في طريق التصوف» (38)
فالكتاب يعكس عمق اقتناع الغزالي بأن المعرفة والدراسة الدينية سبيلان للبشر في الدنيا للنجاة في الآخرة.
وأكثر ما تنكشف مقاربة الغزالي الكلامية ـ الصوفية للتعلّم في فهمه لـ «القلب» والإنسان حيث يرتبط اللاحق بالسابق ارتباطاً وثيقاً. وعند الغزالي أنّ القلب «لطيفة روحانية متصلة بالقلب الطبيعي؛ وهذه اللطيفة هي جوهر الإنسان، وهي التي تفهم وتتعلّم وتَعْلم» (39)
لذلك فهو يرى أن قلب الطفل في حاجة ماسة إلى العناية والاهتمام. فعنده أن قلب الطفل «جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له»؛ (40)
وهذه الفكرة لها تكملة في نصحه بأن يعلَّم القلب؛ لأنه «كما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم» (41)
ويجزم الغزالي بأنّ العلم ليس فقط استذكاراً للحقائق بل هو «نور يقذف في القلب». لذا فإن أولى غايات التعلّم وأعظمها دراسة: الإلهيات. ومن ثمّ يحثّ الغزالي التلامذة على تحصيل الجوهر النفيس الذي هو علم الآخرة لأن «أشرف العلوم العلم بالله عز وجل ... فإياك أن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه» (42)
ورغم ميل الغزالي إلى «علم الآخرة»، فهو لا يزدري بسائر العلوم؛ وإنما يجعلها أدنى مرتبة. فهو يمدح المشتغلين بها ويشبههم بـ «المتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في سبيل الله» (43)
ولأن من «قصد الله تعالى بالعلم ـ أيّ علم كان ـ نفعه ورفعه لا محالة»؛ فإن الغزالي يعرض عونه على السالكين الجدد وعلى الذين يرشدون غيرهم في طريق العلم الصوفي (44)
وهو يخصص الباب الأول من إحياء علوم الدين لـ «فضل العلم والتعليم والتعلم» ويُتبعه في الباب الخامس بنصيحة مفصلة عنوانها «أدب المتعلم والعالم» (45)
ونظراً إلى الشهرة التي حازها الإحياء في العالم الإسلامي منذ تصنيفه، يمكن القول بأنّ أفكار الغزالي التربوية وتوجيهاته التعليمية العملية المبسوطة فيه قد انتشرت في المجتمع الإسلامي عامةً.
يضع الغزالي وظائف عشراً للتلميذ:
1- طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف ليكون القلب وعاءً لائقاً للعلم.
2 ـ أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا، ويبعد عن الأهل والوطن؛ فإن العلائق شاغلة وصارفة؛ لأنّ «العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك» (46)
3 ـ ألا يتكبر على العلم، ولا يتأمر على معلم؛ بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصيحته، وهو يمثّل لذلك بقوله: «فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطراً غزيراً فتشربت جميع أجزائها» (47)
4 ـ أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس؛ بل ينبغي أن يتقن أولاً الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب الأخرى. وإن لم يكن أستاذه مستقلاً باختيار رأي واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن إضلاله أكثر من إرشاده (48)
5 - ألا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه، وتطرف من البقية؛ فإنّ العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض.
6 - ألا يخوض في فـن من فنون العلم دفعـة بـل يراعى الترتيب ويبتدئ بالأهم.
7- ألا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله؛ فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض. فينبغي ألا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه، ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه ولا بمخالفتهم موجب علمهم بالعمل.
8- أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم، وأن ذلك يراد به شيئان؛ أحدهما شرف الثمرة والثاني وثاقة الدليل وقوته.
9- أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي المآل القرب من الله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين، ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران.
10 ـ أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غيره (49)
ويُحدد الغزالي ثماني وظائف للأستاذ تكملةً لوظائف التلميذ:
1 ـ الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه (50)
2- أن يقتدي بـ «صاحب الشرع» (الرسول) فلا يطلب على إفادة العلم أجراً، ولا يقصد به جزاء ولا شكراً؛ بل يعلّم لوجه الله تعالى وطلباً للتقرب إليه .(51)
3- ألا يدع من نصح المتعلم شيئاً، وذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها، والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي، ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة والمنافسة.
4 ـ أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ؛ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة، ويورث الجرأة على الهجوم، بالخلاف ويهيِّج الحرص على الإصرار.
5- ينبغي على الأستاذ ألا يقبح في نفس المتعلم العلوم الأخرى؛ بل أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة.
6- أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله فينفره؛ لأنّ نجاح التلميذ مهم من حيث يبقيه مستمتعاً بطلب العلم.
7 ـ ينبغي على الأستاذ أن يلقي إلى المتعلم القاصر الجلي اللائق به، ولا يذكر له وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه؛ فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ويشوش عليه قلبه (52)
8- أخيراً وليس آخراً، على الأستاذ أن يكون عاملاً بعلمه، فلا يكذّب قولَه فعلُه.
من الجليّ أن نصائح الغزالي للتلامذة والأساتذة قمّةٌ سامقة في تراث الإسلام التعليمي الكلاسيكي، كما أنها تصوّره لنا معلّماً شديد الوعي بمسؤولياته، حفيّاً بتلامذته حريصاً على بلوغهم أقصى طاقتهم. كذلك فهو مهتم بحال مهنة التعليم. هذه الملاحظات تساعدنا في فهم السبب الذي حفظ لأفكار الغزالي التعليمية مكانتها قروناً عديدة وأبقاها محل اهتمام التربويين إلى يومنا هذا. لذا فليس مفاجئاً أن تكون وظائف الأستاذ والتلميذ كما رآها ظلّت تلهم أجيالاً متوالية من المسلمين، ومنهم مصنفون متأخرون في القرون الوسطى اشتغلوا بالتربية والتعليم. فعلى سبيل المثال، كان الفيلسوف والعالم والوزير الشيعي الإيراني نصير الدين الطوسي (ت 1274) يذهب إلى أن في التعليم أطرافاً ثلاثة: الأستاذ والتلميذ وأهل التلميذ، كما رأى أن تحصيل العلم هو في نفسه متعة قد تؤدي إلى السعادة الأبدية. كذلك فإن العلموي (ت 1573) ـ العالم والواعظ بالمسجد الأموي في دمشق ـ يشدد على أهمية الكتاب في التعليم. ولشدة ذيوع هذه الأفكار اليوم فإننا ننسى أنها كانت أمراً جديداً في الماضي (53)
الخلاصة
ثمّة نقاطٌ عدة واضحة من دراستنا: النقطة الأولى: هي أن العلماء المسلمين المتقدمين الذين صنفوا في التربية والتعليم كانوا واعين بأهمية التعليم الفعّال والميسور في مجتمعات سريعة التطور كالمجتمعات الإسلامية بين القرنين التاسع والثاني عشر. وهذا بيّنٌ في مناقشتهم للمسائل التربوية التي تشفّ عن معرفة بالمسائل الرئيسة، وعن مرونة فكرية وعن تفضيل للمنطق التحليلي. كما يبدو أنّ هؤلاء العلماء قد أبدعوا في بناء نظريات تربوية ممكنة التطبيق في سياق ثقافي متنوع كالسياقات التى عايشوها. هذه الخلاصات لها أهميتها في التاريخ الثقافي للإسلام. بَيْدَ أن لها دلالاتها أيضاً في إطار الديموقراطيات الليبرالية الحديثة التي تقدّر التعددية والتعليل المنطقي والاستجابة العلمية لحاجات المجتمع والفرد.
النقطة الثانية منبثقة من الأولى، وتتعلّق بالمكانة العليا التي يوليها العلماء المسلمون القرون الوسطى لـ «أخلاقيات» التعليم و«جمالياته»؛ فهم اعتقدوا بأن المسار التربوي الأخلاقي أساس للنجاح التعليمي كما سبق القول. لذا لم يقتصر التوجيه الفكري في نقل العلم على الحقائق والمعطيات، بل إن مسؤولية الأستاذ اتسعت ـ مثلما أنبأَنا الغزالي ـ لتشمل غرس القيم في نفوس التلامذة وتربيتهم على حبّ الخير. وممّا يلفت النظر أيضاً أن الجاحظ وابن سينا والغزالي وغيرهم يقترحون تغيير الإطار التربوي من كونه محصوراً بنقل المعارف والمهارات إلى كونه مادةً ممتعة ليصبح التعلم سائغاً ومسلياً للجميع فلا يتخلّف عنه أحد.
النقطة الثالثة: إنّ المنظّرين التربويين المسلمين في القرون الوسطى أعلوا من شأن الرغبة في التعليم وحبّ التعلّم. وكما يرى ابن سحنون، فإن التواضع والصبر وحب العمل مع الأطفال صفات ضرورية للأستاذ. ويصوّر الجاحظ الأساتذة على أنهم علماء ومجدّون يَحْدَبون على تلامذتهم؛ كذلك يذهب الفارابي إلى أنّ التلميذ ينبغي أن يكون مركز التعليم، ويساعده الأستاذ بأفضل السبل ليفهم، وينطلق في رحلته العلمية. أما ابن سينا فيوصي بألّا يكون عند الأساتذة مزايا تعليمية مناسبة فحسب؛ بل أن يكونوا خياراً محمودين. هذه الأفكار مشوّقة للتربوي المعاصر؛ لأنّ الجوانب الأخلاقية والعاطفية للتعلّم أوشكت على التلاشي في عالمنا المحكوم بالتكنولوجيا والبيروقراطية. كذلك فإن التربويين قد يستفيدون من إعادة الاعتبار إلى فكرة أنّ التعليم مهنة تتطلّب الحدَب والتعاطف.
رغم أنّ لكل عصر ميزاته وأهدافه ودوافعه الثقافية والتربوية؛ فإنّ ظروف كل عصر وقضاياه هي بدورها جزء من الصورة الكبرى لتطور البشرية؛ وكذا ينبغي رؤيتها. لذا علينا ألا نأمل في تحصيل حلول لمشاكل اليوم التربوية بمجرّد «استنباطها» من الماضي أو «استخراجها» من أي نظام فكري عالمي. بيد أن من الممكن لنا أن نكون أنجح في معالجة قضايا اليوم التربوية متى عرفنا سياقاتها التاريخية وفهمناها؛ حقّ فهمها، لأنّ «لمسائل اليوم التعليمية جذوراً ماضية في معظم الأحيان»، كما لاحظ فأصاب ألبرت ربل في مقدمة كتابه تاريخ التربية والتعليم (54)
علاوة على ذلك، فإن الوعي الكافي بما سبقَنا في حقل التربية يزيدنا ثقة في قدرتنا على تقييم التقدّم الحقيقي فيه، ومن ثمّ ما ينبغي فعله بعدها لكي «نزداد بصيرةً».
فيما يتعلّق بأهميتهم في تطوير التربية والتعليم، يشترك المفكرون المسلمون المتقدمون في كثير من أفكارهم العظيمة مع أعلام التراث التربوي الغربي مثل المعلم إيكهارت (حوالى 1260 ـ 1327). فالأخير كان مؤلفاً ولاهوتياً دومينيكيّاً وأحد عظماء المتصوفة الألمان؛ وهو مثل الغزالي في اعتقاده بأن على المتعلم المبادرة إلى «الانعتاق» و«خلع نفسه» من ربقة الأشياء والخَلق لينجح في طلب العلم (55)
ويخطر بالبال أيضاً أولى الرسائل التربوية المختصة في التاريخ الفكري الأوروبي في القرون الوسطى التي وضعها علماء إيطاليون من القرن الخامس عشر أمثال پـييرو پاولو ڤِيركِيريو (1370 ـ 1444) الذي كان طبيباً إنسانوياً مشتغلاً بالشرائط والطرائق الضرورية للتربية الذهنية والأخلاقية والبدنية. ومثل ابن سينا، يؤكد ڤِيركِيريو على ضرورة تكييف التعلّم ليلائم قدرات الطفل، وعلى الجمع بين الإرشاد الذهني والأخلاقي والتمرين البدني في أصغر سن ممكنة (56)
أما اللاهوتي الإنسانوي الهولندي ديزيديروس إيراسموس (ت 1536) فيأمل أن تُراعى فردية التلميذ، وتقوم صداقة بينه وبين الأستاذ مبنية على الثقة المتبادلة. وينصحنا إيراسموس بالاعتناء بالتلميذ واحترامه، مثلما نصحنا الجاحظ (57)
كذلك فإن أستاذ اللغة اليونانية والفلسفة والبلاغة بجامعة ڤيتبرك فيليپ ميلانكتون (1497 ـ 1560) ـ وهو أيضاً مصلح بروتستانتي و«معلّم ألمانيا» (كما كان يدعى نظراً لإصلاحاته التربوية بعيدة الأثر) ـ يستعمل مقاربة عقلانية للتعلّم كثيرة الشبه بما عند الفارابي، وبخاصة توسعة المنهاج في المراحل المتأخرة ليشمل حقولاً كالأدب والتاريخ والفلسفة والرياضيات. ويشير ميلانكتون إلى البلاغة كأداة وشرطٍ للتعلّم، وهو ما يذكّر بالجاح (58)
وعلى المنوال نفسه فإن الأسقف والمصلح التشيكي الكبير يوهان أموس كومينيوس (1592 ـ 1670) ـ وهو «أبو التربية المعاصرة»، يشدد مثل أسلافه المسلمين على الحاجة إلى تعليم مهارات اللغة كلها؛ لأنها ضرورة للتطور الفكري. علاوة على ذلك، يرى كومينيوس أن على التربية أن تستهدف تزويد صغار السن بمعرفة عميقة بالنصوص المقدسة والواجبات الدينية، وهذه أفكار رئيسة في التربية الإسلامية أوصى بها ابن سحنون وغيره. لكن المهم أيضاً أنّ كومينيوس يصرّح بوجوب أن يتيقن الأستاذ من سلاسة التعليم وشموله ويُسره، واتفاقه مع مسار الطبيعة في أن يتلازم النمو الروحي والذهني والعاطفي، وكل هذه آراء أسهب في بحثها الغزاليُّ وبعض السابقين له واللاحقين عليه في التراث التربوي الإسلامي الغني (59)
ابتدأ هذا المقال بإلقاء الضوء على تطور التراث التربوي الكلاسيكي في الإسلام، وذلك لإظهار أن علماء المسلمين فى القرون الوسطى أغنوا البشرية بإسهاماتهم في شتى مجالات التربية، وقد تبيّن في الصفحات السابقة أن المسائل النظرية التي تناولها المفكرون المسلمون فى القرون الوسطى أمورٌ فكرية بامتياز. بيد أنهم يظهرون اهتماماً بالحكمة العملية في التعليم والتعلّم، إضافة إلى العناية بجوانب التربية العاطفية والأخلاقية والمعنوية. وأخيراً فإن المكونات الدينية والروحية في اكتساب المعرفة والتعلّم شديدة الأهمية عندهم، حيث إن القرآن وفضائل الإسلام تقع من التربية الإسلامية في القلب. وإنني مؤمن بأن التربويين المسلمين في القرون الوسطى قد تعقّلوا تماماً عمق العلاقة التي تربط المعرفة والحِكْمَتين النظرية والعملية والتعليل المنطقي وأخلاق التعلّم وجمالياته والمحبة والعناية والروحانية. وإذا كانت الحداثة راغبة في التعلّم من الماضي، وفي أن «تَفهم التربية على أنها سيرورة بناء وجهات عاطفية وفكرية كبرى إزاء الطبيعة وسائر البشر»، كما عبّر المصلح التربوي والفيلسوف البراغماتي الأميركي الكبير جون ديوي (1859 ـ 1952)؛ فإننا واثقون بقدرتنا على استعادة ما يبدو أننا فقدناه، وبذلك نرمم تصوّرنا لنظام تربوي يؤمن بالتطور المتكامل للإنسان (60)
ــــــ
المراجع:
(1) يدين الحديث النبوي ـ وهو النص المرجعي في الإسلام ـ بكثير من طاقته التربوية الخلاقة إلى «الطبيعة النموذجية» للأحداث والرسائل المضمَّنة في الروايات التي يعتقد أنها حفظت ما قاله النبي وفعله وأقرّه. حول مفهوم التعلم في القرآن انظر:( P. E. Walker, “Knowledge and Learning,” in The Encyclopaedia of the Quran, ed. Jane D. McAuliffe, 5 vols. (Leiden: Brill, 2001-5), 3: 1-5;
وأيضاً: Sebastian Günther, “Teaching,” Ibid., 5: 200-205.)
(2) انظرها في الغزالي، إحياء علوم الدين (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1967)، 1: 17؛ وانظر ترجمتها الانجليزية في: (al-Ghazali, The Book of Knowledge, Being a Translation with Notes of the Kitab al‑_ilm of al‑Ghazzali’s (sic) Iḥyāʼ 'ulūm al‑dīn, trans. Nabih Amin Faris (Lahore: S. M. Ashraf, 1962), 14.)
(3) انظر: (Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam (Leiden: Brill, 1970). )
(4) المالكية: هم أتباع أحد المذاهب السُّنيَّة الأربعة، ونسبتهم إلى الفقيه المدني مالك بن أنس (حوالى 715 ـ 796). وهذا المذهب شديد الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويفضّل الأخذ بالحديث على الرأي والقياس. أما المذاهب الثلاثة الأخرى فهي الحنفي (نسبة إلى مؤسسه أبي حنيفة، حوالى 700 ـ 767)، والشافعي (نسبة إلى مؤسسه أبي عبد الله الشافعي، 767 ـ 820)، والحنبلي (نسبة إلى أحمد بن حنبل، 780 ـ 855).
(5) محمد بن سحنون، أدب المعلمين، تحقيق محمد العروسي المطوي، أعيد طبعه في عبد الرحمٰن عثمان حجازي، المذهب التربوي عند ابن سحنون، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1986)، 111 ـ 128؛ أما الترجمة الفرنسية ففي: (Gérard Lecomte, “Le Livre des Règles de Conduite des Maîtres d’École par Ibn Sahnun,” Revue des Études Islamiques 21 (1953): 77-105.)
(6) [Sebastian Günther, “Advice for Teachers: The 9th Century Muslim Scholars Ibn Sahnun and al‑Jahiz on Pedagogy and Didactics,” in Ideas, Images, and Methods of Portrayal: Insights into Classical Arabic Literature and Islam, ed. Sebastian Günther (Leiden: Brill, 2005): 95-110. ]
(7) ابن سحنون، أدب المعلمين، 113 ـ 114؛ وانظر أيضاً: Günther, “Advice,” 101
(8) تجدر ملاحظة أنه رغم اقتصار نصوص المسلمين التربوية في القرون الوسطى على تعليم الذكور، فإن ثمة دليلاً ـ بخاصة في المصادر التاريخية وكتب التراجم ـ على أن النساء لم يكنّ مستبعدات قط من التعليم الابتدائي والعالي، كما أنهن لم يكتفين بالتربية الأخلاقية في نطاق الأُسرة.
(9) المعتزلة هم أقدم المدارس الكلامية وأهمها. حازوا دعم الدولة العباسية (750 ـ 1258) أيام المأمون والمعتصم والواثق (813 ـ 847) وخسروه أيام المتوكل (847 ـ 861). لكنهم بقوا روّاداً في علم الكلام رغم انحسارهم أمام الأشاعرة. اشتهر المعتزلة بجعلهم العقل والجدل أساس العقيدة. وقد «أعيد اكتشاف» الاعتزال في بداية القرن العشرين، وبخاصة في مصر. انظر: [Daniel Gimaret, “Mu_tazila,” in Encyclopaedia of Islam, new ed. (Leiden: Brill, 1954 –), 7: 783-93. ]
(10) عمرو بن بحر البصري الجاحظ، كتاب المعلمين في (كتابان للجاحظ: كتاب المعلمين وكتاب في الرد على المشبهة) تحقيق وتقديم إبراهيم جريس، الطبعة الأولى (عكا: مطبعة السروجي، 1980)، 57 ـ 87.
(11) م. ن.، 62 ـ 63؛ وانظر أيضاً: Günther, “Advice,” 122.
(12) الجاحظ، كتاب المعلمين، 86 ـ 87. وانظر أيضاً:
Sebastian Günther, “Al-Jahiz and the Poetics of Teaching,” in Al-Jahiz: A Humanist for Our Time, ed. Tarif Khalidi (Beirut: Orient-Institute, 2006, forthcoming), and “Praise to the Book! Al-Jahiz and Ibn Qutayba on the Excellence of the Written Word in Medieval Islam,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam (Franz Rosenthal Memorial Volume) 31 (2006), forthcoming.
(13) آمن الفارابي بـ «تفوق العقل الإنساني على الإيمان الديني، ولذا وضع شتى الأديان المنزلة في مكانة دنيا؛ لأنها تقدم بالرموز سبيلاً إلى الحقيقة لغير الفلاسفة». ففي رأيه أن «الحقيقة الفلسفية كلية الصحة أما الرموز فتتفاوت بين أمة وأخرى» وهي من أعمال الأنبياء ـ الفلاسفة الذين كان منهم النبي محمد. انظر: R. Walzer, “Al-Farabi,” in Encyclopaedia of Islam, 2: 778-81.
(14) هذه الرؤية أجلى ما تكون في كتابه إحصاء العلوم؛ انظر: أبا نصر الفارابي، إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، الطبعة الثالثة (القاهرة: المطبعة الأنغلومصرية، 1968)؛ وكانت ترجمة ألمانية (مبنية على ترجمة لاتينية من القرن الثاني عشر) قد نشرت، انظرها في:
E. Wiedemann, “Über al‑Farabis Aufzählung der Wissenschaften (De Scientiis),” in Aufsätze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte: Mit einem Vorwort und Indices herausgegeben von Wolfdietrich Fischer, by Eilhard Wiedemann, 2 vols. (Hildesheim: Olms, 1970), 1: 323-50.
وثمة ملخص بقلم السيد حسين نصر في: Science and Civilization in Islam, with a preface by Giorgio de Santillana (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968), 60-62.
(15) Charles Michael Stanton, Higher Learning in Islam: The Classical Period, A.D. 700-1300 (Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1990), 84.
(16) م. ن.، 84. وانظر ايضاً:
David C. Reisman, “Al-Farabi and the Philosophical Curriculum,” in The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, ed. Peter Adamson and Richard C. Taylor (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 52-71. Sebastian Günther, “Education: Islamic Education,” in New Dictionary of the History of Ideas, ed. Maryanne Cline Horowitz (Detroit: Scribner’s, 2005), 2: 640-45;
وكذلك المقال الممتاز: Asma Afsaruddin, “Muslim Views on Education: Parameters, Purviews, and Possibilities,” Journal of Catholic Legal Studies 44, No. 1 (2005): 143-78.
(17) لفظ البرهان هو المعادل العربي لـ Analytica Posteriora أو Apodeictica، حيث إن كتاب البرهان لأرسطو كان معروفاً في المصادر العربية القروسطية. وكتاب أرسطو هذا من أكثر مصنفاته التي علّق عليها وأعاد صياغتها العلماء المسلمون القروسطيون؛ وكتاب البرهان للفارابي من أوليات تلك الصياغات. انظر للمقارنة المنطق عند الفارابي: كتاب البرهان وكتاب شرائط اليقين؛ مع تعاليق ابن باجة على البرهان، تحقيق ماجد فخري (بيروت: دار المشرق، 1987)، 1 (المقدمة).
وانظر ايضاً: Michael E. Marmura, “The Fortuna of the Posterior Analytics in the Arabic Middle East,” in Probing in Islamic Philosophy: Studies in the Philosophies of Ibn Sina, al‑Ghazali and Other Major Muslim Thinkers (Binghamton, NY: Global Academic Publishing, 2005), 355-73.
(18) أبو نصر الفارابي، كتاب البرهان في فخري، المنطق عند الفارابي، 17 ـ 96، وبخاصة 77 ـ 78.
وانظر أيضاً: Fuad Said Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication (Beirut: American University of Beirut Press, 1989), 123-24, 126-27.
(19) الفارابي، كتاب البرهان، 82؛ وانظر أيضاً: Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication, 125
(20) الفارابي، كتاب البرهان، 79 ـ 80؛ وانظر أيضاً:
Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication, 126.
(21) أبو نصر الفارابي، كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق، تحقيق وتقديم محسن مهدي (بيروت: دار المشرق [المطبعة الكاثوليكية]، 1968)، 86، الفقرة 40.
(22) أبو نصر الفارابي، كتاب تحصيل السعادة، تحقيق جعفر آل ياسين (بيروت: دار الأندلس، 1981)، 90. وانظر الترجمة الانجليزية:
Alfarabi’s Philosophy of Plato and Aristotle, translated and with an introduction by Muhsin Mahdi (New York: Free Press of Glencoe, 1962), 44.
(23) الفارابي، كتاب الألفاظ، 86 ـ 93؛ وانظر أيضاً:
Haddad, Alfarabi’s Theory of Communication, 134-37.
(24) هرمية التطور العقلي هذه مبسوطة في ابن سينا، كتاب النجاة من الغرق في بحر الضلالات، تحقيق محمد تقي دانش پـزوه (طهران: دانشكاه طهران، 1985 ـ 1986)، وبخاصة 333 ـ 343. وانظر أيضاً:
F. Rahman, Avicenna’s Psychology: An English Translation of Kitab al‑Najat, Book II, Chapter VI, with Historico-Philosophical Notes and Textual Improvements on the Cairo Edition (London: Oxford University Press, 1952), esp. 33-38, and Rahman’s comments, 87-95.
والدراسة الأخيرة أعيد نشرها في:
Fuat Sezgin et al., eds., Islamic Philosophy, vol. 34, Abū ῾Alī ibn Sīnā (d. 428/1037), Text and Studies Collected and Reprinted (Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1999), 39-175.
وانظر أيضاً: Stanton, Higher Learning in Islam, 86-87,
ولكن ليس ثمة مصادر هناك. وحول علاقة هذه المصطلحات بأرسطو والإسكندر الأفروديسي انظر أيضاً: O. N. H. Leaman, “Malaka,” in Encyclopaedia of Islam, 6: 220.
(25) A.-M. Goichon, “Ibn Sina,” in Encyclopaedia of Islam, 3: 941-47, esp. 942.
(26) عند ابن سينا أن المراحل العمرية أربع (أ) النمو أو الحداثة وهو إلى قريب من ثلاثين سنة. (ب) الوقوف وهو الشباب وهو إلى نحو من خمس وثلاثين أو أربعين سنة؛ (ج) الانحطاط مع بقاء من القوة وهو سن المكتهلين وهو إلى نحو من ستين سنة. و (د) الانحطاط مع ظهور ضعف في القوة وهو سن الشيوخ وهو آخر العمر. لكن سن الحداثة ينقسم إلى (أ) سن الطفولة وهو أن يكون المولود بعد غيرَ مستعد الأعضاء للنهوض والحركات؛ (ب) الصبا وهو بعد النهوض وقبل الشدة أي قبل نبات الأسنان؛ (ج) الترعرع وهو بعد الشدة ونبات الأسنان قبل المراهقة؛ (د) الغلامية وهو إلى حين نبات الشعر في الوجه؛ و (هـ) الفتوّة وهو حتى يقف النمو وإذ ذاك يبدأ طور الرجولة. انظرها في: الشيخ الرئيس أبو علي سينا، القانون في الطب، طبعة جديدة، تحقيق إدوار القش (بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، 1987)، 1: 25. وانظر ايضاً:
O. Cameron Gruner, A Treatise on “The Canon of Medicine” of Avicenna, Incorporating a Translation of the First Book (London: Luzac, 1930), 68-69.
(27) ابن سينا، القانون، 1: 208 ـ 209؛ الفقرة التي كانت مثبتة في أصل المقال الإنجليزي منقولة بتصرف من الترجمة التي في: Gruner, A Treatise on “The Canon of Medicine” of Avicenna, 379
(28) عبد الأمير شمس الدين، المذهب التربوي عند ابن سينا من خلال فلسفته العملية، الطبعة الأولى (بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1988)، 127 ـ 128، 130؛ على أساس القانون لابن سينا.
(29) قارن بالفصل المعنون «في سياسة الرجل ولدَه» من كتاب السياسة المنسوب لابن سينا والمنشور في التراث التربوي الإسلامي في خمس مخطوطات، تحقيق هشام نشابة (بيروت، دار العلم للملايين، 1988)، 25 ـ 45، وبخاصة 40 ـ 42.
(30) ابن سينا، كتاب السياسة، 40؛ وانظر ايضاً شمس الدين، المذهب التربوي عند ابن سينا، 131 ـ 132.
(31) شمس الدين، المذهب التربوي عند ابن سينا، 130 ـ 131.
(32) ابن سينا، كتاب السياسة، 40 ـ 41؛ وانظر ايضاً شمس الدين، المذهب التربوي عند ابن سينا، 134 ـ 135.
(33) ابن سينا، كتاب السياسة، 41.
(34) م. س. ن.
(35) Günther, “Education,” 643.
(36) Stanton, Higher Learning in Islam, 87.
وانظر أيضاً: M. E. Marmura, “Al-Ghazali,” in The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, ed. Peter Adamson and Richard C. Taylor (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 137-54.
(37) من المصنفات المهمة أيضاً لدراسة النظرية التربوية في الإسلام:
(أ) كتاب الغزالي السابق ذو النزعة شبه العقلانية ميزان العمل، تحقيق سليمان دنيا، (القاهرة: دار المعارف، 1964)؛ وثمة ترجمة فرنسية له في:
Hikmat Hachem, Critère de l’action (Paris: G.-P. Maisonneuve, 1945);
(ب) أيها الولد، وقد وضعه استجابة لتلميذ سابق له وفيه يشدد على عدة أفكار منها أن المعرفة تدل على قيمتها من خلال ثمرتها في الحياة؛ انظر مقدمة الترجمة الانجليزية في:
George Henry Scherer [Beirut: Imprimerie Catholique, 1951], xx;
و (ج) منهاج المتعلمين، وهي رسالة منسوبة للغزالي منشورة في التراث التربوي الإسلامي، تحقيق هشام نشابة (بيروت: دار العلم للملايين، 1988)، 55 ـ 92.
(38) W. Montgomery Watt, “Al-Ghazali,” in Encyclopaedia of Islam, 2: 1038-41, esp. 1040.
(39) Leon Zolondek, Book XX of al‑Ghazali’s Iḥyāʼ'ulūm al‑dīn (Leiden: Brill, 1963), 3-4.
وانظر أيضاً: Julian Obermann, Der philosophische und religiöse Subjektivismus Ghazalis: Ein Beitrag zum Problem der Religion (Vienna: Braumüller, 1921), 313-14.
(40) الغزالي، إحياء علوم الدين، 3: 92. هذه الفقرات كانت في أصل المقال الانجليزي منقولة بتصرف من الترجمة المشار اليها في الهامش السابق، 4؛ وانظر أيضاً:
Arent J. Wensinck, La pensée de Ghazzali (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1940), 44.
(41) الغزالي، إحياء علوم الدين، 3: 78؛ الترجمة الانجليزية، 5؛ وانظر أيضاً:
Wensinck, La pense´e de Ghazzali, 45.
(42) الغزالي، إحياء علوم الدين، 1: 76؛ وانظر الترجمة الإنجليزية:
Al-Ghazali, The Book of Knowledge, Being a Translation with Notes of the Kitab al‑_ilm of Al‑Ghazzali’s (sic) Iḥyāʼ 'ulūm al‑dīn, trans. Nabih Amin Faris (Lahore: S. M. Ashraf, 1962), 137.
(43) الغزالي، إحياء علوم الدين، 1: 76؛ وانظر الترجمة الإنجليزية:
Al-Ghazali, The Book of Knowledge, Being a Translation with Notes of the Kitab al‑ilm of Al‑Ghazzali’s (sic)
(44) م. س.
(45) تنبغي ملاحظة أن الغزالي في الإحياء يعاود مناقشة قضايا تربوية كان ناقشها في ميزان العمل (انظر الهامش 38) الذي هو كتاب سبق أن صنّفه قبل تصوّفه. لكن الأفكار التربوية في الكتابين لا تختلف إلا في التفاصيل.
(46) الغزالي، إحياء علوم الدين، 1: 72.
(47) م. س.، 73.
(48) م. س.، 73 ـ 74.
(49) م. س.، 76.
(50) م. س.، 79.
(51) م. س.، 80.
(52) م. س.، 82 ـ 83.
(53) ثمة ترجمة إنجليزية لكتابين في التربية صنّفهما علماء مسلمون من القرون الوسطى المتأخرة: إذ يضمّن العالم الحنفي الإيراني برهان الدين الزرنوجي (النصف الأول من القرن الثالث عشر) كتابه تعليم المتعلمين طرق التعلم توجيهات دينية مفصلة في دراسة علم الكلام. وهو يؤكد ـ مثل كثير من معاصريه والمتقدمين عليه ـ على نقل ما ثبتت صحته نقلاً علمياً أميناً؛ انظر الترجمة في:
G. E. von Grunebaum and Theodora M. Abel, Instruction of the Student: The Method of Learning, (New York: King’s Crown Press, 1947).
كذلك هناك كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لكبير قضاة الشافعية في مصر وسوريا ابن جماعة (ت 1333)؛ والكتاب ترجمه نور محمد غفاري في سلسلة مئة كتاب عظيم من الحضارة الإسلامية:
Noor Muhammad Ghifari, in the series One Hundred Great Books of Islamic Civilisation, vol. 10, Education and Pursuit of Knowledge (Islamabad: Pakistan Hijra Council, 1991).
(54) Albert Reble, Geschichte der Pädagogik, 21st ed. (Stuttgart: Klett-Cotta, 2004; 1st ed., 1951), 14-15.
(55) Winfried Böhm, Geschichte der Pädagogik: Von Platon bis zur Gegenwart (Munich: Beck, 2004), 41-42; H.-E. Tennorth, ed., Klassiker der Pädagogik, vol. 1, Von Erasmus bis Helene Lange (Munich: Beck, 2003), 88.
(56) Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 21-27.
(57) Böhm, Geschichte der Pädagogik, 45; Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 28-31.
(58) Böhm, Geschichte der Pädagogik, 51; Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 32-33.
(59) Böhm, Geschichte der Pädagogik, 53-54; Tennorth, Von Erasmus bis Helene Lange, 45-59. Hermann Weimer, Geschichte der Pädagogik, 19., völlig neu bearb. Auflage von Juliane Jacobi, Sammlung Göschen 2080 (Berlin: de Gruyter, 1992), 81-86.
(60) Jim Garrison, Dewey and Eros: Wisdom and Desire in the Art of Teaching (New York: Teachers College, Columbia University, 1997), introduction, xx.