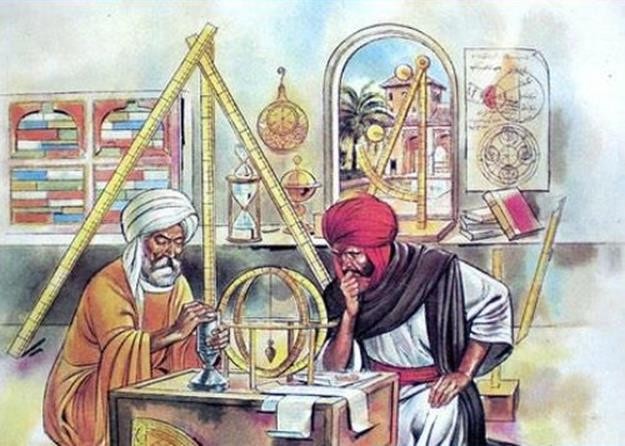يوسف بن عدي | أستاذ في الفلسفة العربية الإسلامية وقضايا الفكر العربي، المغرب.
مقدمة
أشرعُ بالقول: إنَّ ما يفرقُ بين الفيلسوفين الفارابي (ت: 339هـ/950م) وابن رشد الحفيد (ت: 595هـ/1198م) أكثر مما يجمعها، سواء على مستوى المذهب الفلسفي أو الطموح الأيديولوجي(1) الذي كان يراوِدهما. ويبدو هذا واضحاً حينما اختار الفارابي وسيلة الجمع بين رأيي الحكيمين أرسطو وأفلاطون الإلٰهيين كتعبير فلسفي ومذهبي على ما تعيشهُ الدولة العربية والخلافة من تفكك وتشتت بفعل تعدد التهديدات الخارجية والتشرذم الداخلي(2). مما دفعهُ إلى الرد على المتكلمة وبعض الفرق الجامحة رداً يتطلع منه إلى بيان أمرين هامين: الأمر الأول: هو وحدة الفلسفة ورفع الاختلاف بين الفلاسفة، والأمر الثاني: هو بيان العلاقة التكوينية والتاريخية بين الملّةِ والفلسفة. لنستمع إلى مبتدأ قول الفارابي في كتاب الجمع: «أما بعد فإني لما رأيت أكثر أهل زماننا قد تحاضوا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه وادعوا أن بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافاً في إثبات المبدع الأول وفي وجود الأسباب منه وفي أمر العقل والمجزات خيرها وشرها وفي كثير من الأمور المدنية والخلقية والمنطقية أردت في مقالتي هذه أن أشرع في الجمع بين رأييهما»(3)
وعلى الضفة الأخرى، نفهم قصد الشارحُ الأكبر ـ نعتقد أنه لا يختلف عن الفارابي في النزعة الصورية هذه الردود ـ من تأليفه لمكتوباته: «فصل المقال» و«الكشف» و«التهافت» الذي لم يهتجس بهاجس الوحدة بقدر ما كان غرضهُ هو محاولة تصحيح القول الفلسفي من جهة وتصحيح القول الملّي من جهة ثانية؛ بعدما نشأتْ فيهما من النوابت والشوك ما يبعث على الخطر على الإيمان والتفلسف في مدينة قرطبة والأندلس؛ والذي سوف يلقي بظلاله حتماً على الفرد وحرياته والدولة وعدالتها. وفضلاً عن ذلك يختلفُ أبو الوليد عن المعلم الثاني كذلك في العودة إلى أرسطو العلم والبرهان الخالص من شوائب الغنوصية والأفلاطونية(4).
فهذا الاختلاف بين فيلسوف المدينة الفاضلة وفيلسوف العدالة لا يمنعُ من وجود تقاطعات بين الفارابي وابن رشد الحفيد، ولعل أهم هذه التقاطعات التي يمكن أن نسوقَها في هذا المعرض: أنّ كلّاً من ابن رشد والفارابي قد تفرّد عن نظرائه من الفلاسفة المسلمين بالقول في العلم المدني والموجود «الإتيقي» و«الملّي ـ العملي»(5). النقطة الثانية المهمة أن الفيلسوفين قد اجتمعا على أن الموجود الإنساني مهدد (الوجود الأفضل والوجود الضروري) بسبب هيمنة أخلاق الطاعة وتوظيفها لصالح المتأله على جهة التناسب بين الإنسان والإلٰه، وبسبب أيضاً توظيف العدل والسعادة في عالم المثال لا في عالم الحياة الدنيوية. وهو الأمر الذي دفع المعلم الثاني للكلام عن العدل والعدالة في معرض الحياة السعيدة، وكلام فيلسوف قرطبة ومراكش عن العدالة في معرض نقد السياسة القائمة. وهذا هو العدل الفلسفي الذي تفرّد به هذان الفيلسوفان. الأول نشده في عالم المثال، والثاني في عالم الواقع(5).
من المفيد القول: إنّ العدل لم يكن غائياً في الثقافة العربية الكلاسيكية بمعنى الحكم بين الناس والاستقامة(6)؛ بَيْدَ أنه لم يعرف تطوراً مدنياً وحقوقياً في الاستعمالات اللغوية والدلالية وإنما بقي لفظ العدل مجالاً للحديث عن العدل التشريعي والفقهي، ليتحول بعد ذلك إلى تبرير لمشروعية الحاكم وأيديولوجيته(7). الأمر الذي نرنو إلى التشديد عليه هنا هو دور العدل الفلسفي الذي لم يكن له أثر كبير في الاستعمال الدلالي والقولي والمذهبي أيضاً، بالرغم من أنّ هذا العدل عند الفلاسفة يعمل على استعادة مطلب «كل» إنسان «إنها أفقية دائماً، وتزرع إمكانها مما هو محايث في البشر من قواهم واستعداداتهم وإرادتهم. أما السياسة فما إن تتعلّق بالسلطة حتى تصبح أخلاقاً متنكرة، تلتبس برغبات البشر وتخيلاتهم وأوهامهم»(8)، لنكون أمام العدل الفلسفي الذي ينشد كينونة الإنسان، والعدل الكلامي الذي ينشد الإلوهية، والعدل الفقهي والتشريعي الذي ينشد السلطة السياسية القائمة(9). وهذا ما يجعلنا نثير بعض الشكوك والتساؤلات في هذا الباب:
ما مبرر حديث الفارابي عن السعادة دون العدل؟ لماذا لا يكتب كتاباً في العدل والعدالة، في زمن الأحكام السلطانية وآداب نصيحة الملوك والأمراء؟ بل الأكثر من ذلك ـ وكأنّ المفارقة معكوسة ـ لماذا لم يترك لنا الشارح الأكبر كتاباً في السعادة على غرار نظيره الفارابي؟ أليس الباعث من أحد إلى أنّ زمن الفارابي هو زمن السعادة لا العدالة، وأنّ زمن ابن رشد هو زمن العدالة، لا السعادة؟ هل يعني هذا أنّ طريق العدالة غير طريق السعادة؟ الاستكمال يكون في الأولى أم في الثانية؟ وأخيراً وليس آخراً، هل يمكن أن نستفز الفارابي وابن رشد بالقول: إن الأول فشل في تحقيق العدالة، والثاني فشل في إنجاز العدالة؟
أولاً: العدل المدني والعدل الطبيعي: في معاني التعقّل
يميز الفارابي في نصوصه بين أربعة أنواعٍ من المتفلسفة: الفيلسوف الباطل والفيلسوف المزور، والفيلسوف البَهرجُ، والفيلسوف الحق. أما الفيلسوف الباطل فهو الذي قد تحصل له العلوم النظرية من غير أن يكون له ذلك كماله الآخر؛ أي أنْ يوجد ما قد علمه في غيره بالوجه الممكن فيه(10)، والفيلسوف المزور هو الذي يشرع في تعلم العلوم من غير أن يكون مُعَدّاً لها بالطبع(11). وأما الفيلسوف البَهرج فهو الذي تعلم العلوم ولم يتعلم الأفعال الفاضلة التي بحسب ملّةٍ ما أو بحسب الأفعال الجميلة التي في المشهور(12)
وأما الفيلسوف الحق فهو الذي يكون جيد الفهم والتصور للشيء الذاتي، وصبوراً على الكدِّ الذي يناله بالتعلم، وهو أيضاً محبٌّ للصدق والعدل وأهله، غير جموح ولا لجوج فيما يهواه ويكون غير شره في المأكول والمشروب، تهون عليه بالطبع الشهوات والدرهم والدينار وما جانس ذلك(13). ذلك الفيلسوف الحق أو الفلسفة بالحقيقة كما يقول الفارابي(14)، لا فرق بينه وبين الإمام وواضع النواميس من جهة العموم، وأما من جهة النظر فإنْ كانت في نفس واضع النواميس سميت فلسفة، وإنْ كانت في نفوس الجمهور تسمى ملّة(15)، وهي التي تعطي للجمهور المعقولات والتصورات عن طريق الأقاويل الإقناعية والمتخيّلة، والفلسفة تكون موضوعاتها للخاصة موضعها الأقاويل اليقينية البرهانية. ومن ثمة فـ «كلّ ما تبرهنه الفلسفة من هذه، فإنّ الملّة تقنع»(16)، أو بعبارة فارابية أدق: «وكل ما تعطي الفلسفة فيه البراهين اليقينية، فإنّ الملّة تعطي فيه الإقناعات، والفلسفة تتقدّم بالزمان الملّة»(17).
يتضح لنا أنّ هؤلاء الفلاسفة إنما يعبرون ـ عند المعلم الثاني ـ عن طبيعة السعادة(18) التي يروم إليها كلّ واحد منهم، لكن يعبرون أيضاً عن مدى قربهم أو بعدهم من الاعتدال والعدل في النفس والفرد(19)، الذي بدوره يعكس طبيعة المدينة التي يقطنها ويعيشُ فيها.
وأحسبُ أنَّ نظرية الخاصة والعامة هي من مقومات النظر في مسألة العدالة، ومن ثم السعادة التي من أجل ذاتها (الحقيقية)، والسعادة التي من أجل غيرها (ظنية). لذلك كان تمييز الفارابي بين فئات المدينة على أساس الاستقراء لأجزاء الاجتماع المدني بقدر ما كان للشرع والشريعة دور قوي ورائدٌ في توفير الأرضية الدلالية والفكرية. يقول الفارابي في هذا المعرض: «فالطرق الإقناعية والتخيلات إنما تستعمل إذن في تعليم العامة وجمهور الأمم والمدن. وطرق البراهين اليقينية في أن تحصل بها الموجودات أنفسها معقولة، تستعمل في تعليم من سبيله أن يكون خاصياً»(20).
وعلى هذا، يكون الفيلسوف الباطل والفيلسوف البهرج والفيلسوف المزور إنما ينسجمون مع المدينة الجاهلة(21) المضادة للمدينة الفاضلة وآرائها. فالفيلسوف الحق الموسوم بالعدل والفهم والعلم هو المؤهل لتحصيل الكمال النظري في المدينة على جهة ترتيب موجودات العالم، حيث ينال أهل المدن ـ بالاجتماع المدني ـ السعادة «كلّ واحد بمقدار ما له أعد بالفطرة»(22). وبهذه المناسبة ينبّهنا المعلم الثاني أنّ في حالة وجود إنسان لا يمكن أن يُزال الشر الكائن عنه، لا بفضيلة تمكن في نفسه ولا بضبط نفسه، فالحل لا يكون حلاً باجوياً (نسبة إلى ابن باجة) بخروج الفرد (المتوحد) من المدينة إذا غابتْ فيها الفضائل الخلقية والنظرية، بل يُخرَج هذا الإنسان الشِّرير من المدن(23).
وغنيٌّ عن البيان أنّ الفارابي يتطلعُ إلى مدينة فاضلة بالفعل ولو على المستوى الميتافيزيقي، لهذا السبب لم يرد أن يضحي بالمدينة على حساب الفرد، وإنما رغب في تهذيب هذه المدينة، من حيث إن المنزل لا يعبّر عن المسكن وحده؛ «لكن إنما يُعني به الذين يحويهم المسكن... (و) المساكن قد تولّد في أهلها أخلاقاً مختلفة»(24)، ويتحصل عن هذا أنّ الفيلسوف الحق ـ صاحب الفضائل النظرية والخلقية والعقلية ـ لا ينبغي أن يقتني ملكات فقط؛ وإنما يجدر به القيام بهذه الملكات عن طريق ترجمتها إلى الفعل. إذ بذلك يكتسب ذاك الفيلسوفُ الحق الطبائع الفائقة العظيمة، يقول صاحب كتاب الملّة: «وإن الكمال هو في أن يفعل لا في أنْ يقتني الملكات التي بها تكون الأفعال، كما أن كمال الكاتب أن يفعل أفعال الكتابة، لا أنْ يقتني الكتابة وكمال الطبيب أن يفعل أفعال الطب لا في أن يقتني الطب فقط، وكذلك كلّ صناعة»(25). وفوق هذا وذاك يصيرُ هذا الفيلسوف الحق هو المرشّح عقلياً وفكرياً(26) لتدبير المدينة الفاضلة، والعمل على قيادة أهلها إلى الكمال الأخير؛ أعني السعادة القصوى(27)، بعدما يتحلى بخصال فاضلة تدور حول مفهوم التعقل (phronesis)(28) الذي يتحصل به ما يسميه الفارابي بـ «التعقل المدني»؛ أي جودة الروية في تدبير المدن(29)، فينبغي أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه، وفي الجملة لا يكاد ينساه، ثم أن يكون محباً للصدق وأهله ومبغضاً للكذب وأهله. وثانياً أنْ يكون بالطبع محباً للعدل وأهلها، ومبغضاً للجور والظلم وأهلها يعطي النَّصَف من أهله ومن غيره ويحث عليه، ويؤتي من حل به الجور مؤاتياً لكل ما يراه حسناً وجميلاً ثم أن يكون عدلاً غير صعب القياد، ولا جموحاً ولا لجوجاً إذا دعي إلى العدل، بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيح(30)
لقد تحدث أبو نصر الفارابي في مسألة العدل في مناسبتين متضادتين: المناسبة الأولى هي محاولة بيان العروة الوثقى بين العدل والمحبة، حيث يقول الفارابي في ذلك: «والعدل تابع للمحبة، والمحبة في هذه المدينة تكون أولاً لأجل الاشتراك في الفضيلة»(31)، فضلاً عن تحديد العدل في دلالتين هما: أولاً: أنّ العدل هو قسمة الخيرات المشتركة (السلامة والكرامة والأموال) بين أهل المدينة، وحفظ ما تم قسمتهُ عليهم فضلاً عن ذلك أنّ النقص في ذلك جور على الفرد ذاته، والزيادة جور على المدينة أيضاً (32). والمعنى الثاني: إن العدل هو استعمال الإنسان أفعال الفضيلة فيما بينه وبين غيره أيّ فضيلة كانت(33).
أما المناسبة الثانية التي ورد فيها العدل عند الفارابي فقد كانت في معرض بيان علاقته بمدينة التغلب، في الباب الخامس والثلاثين من كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة. فكلام فيلسوفنا عن العدل الطبيعي(34) الذي ينشغلُ باليسار والكرامة واللذات، «فما في الطبع هو العدل. فالعدل إذاً التغالب. والعدل هو أن يقهر ما اتفق منها. والمقهور إما أن يُقهر على سلامة بدنه... فاستعباد القاهر للمقهور هو أيضاً من العدل. وأن يفعل المقهور ما هو الأنفع للقاهر هو أيضاً عدل، فهذه كلها هو العدل الطبيعي»(35). وقد أورد الفارابي بعض الأنواع من العدل من دون التفصيل فيها؛ مثل العدل الذي له علاقة بالبيع والشراء والودائع.
نخلص من هذا كلّهِ إلى أنّ العدل عند الفارابي ليس إلّا ترجمة ميتافيزيقية وعقلية للسعادة القصوى التي تمثل في الكمالين الأنطولوجي والمفارق؛ إذ إنّ النفس هي التي كانت وراء تحصيل العدل(36) كتجلٍّ للسعادة القصوى في المدن الفاضلة(37)، ولذلك لم يكن صادماً أو مستغرباً ألّا يتعرض لما يحصل في الواقع الاجتماعي والسياسي(38)؛ فهو ربما يرنو إلى كان يشعر بالمفارقة بين مطلب الفضائل كمطلب الإنسان وبين السياسة، التي هي تفاضلية وعمودية، بل تكاد تكون تحول حاجة البشر إلى اجتماع مدني يفقد الإنسان معه ممكناته واستعداداته وعناصر أنطولوجيته المتغيرة ! (39)
ثانياً: كتابٌ في العدالة أو الكمال الإنساني
قد لا نجانب الصواب إذا رأينا أنّ «الضروري في السياسة ـ مختصر السياسة لأفلاطون» لا يُقرأ إلّا على ضوء كتاب النفس لابن رشد، وإنْ ظَهر أن العِلْمين مختلفان، أعني العلم المدني (الأخلاق) والعلم الطبيعي(40)؛ فهما يعالجان موضوع السياسة ذاته الذي لا يخرج في الفلسفة العربية الإسلامية عن مسار البحث في قوى النفس وعالم العقول. بَيْدَ أنه لا ينبغي أن نغفل عن دور السيكولوجيا القديمة (علم النفس القديم) كنموذج علمي لعلميْ الأخلاق والسياسية(41). يقول ابن رشد: «وذلك لأن موضوع هذا العلم هو الأفعال الإرادية التي تصدر عنّا، ومبادئُها الإرادة والاختيار، كما أن موضوع العلم الطبيعي هو الأشياء الطبيعية، ومبادئُها الطبع والطبيعة، وموضوع العلم الإلٰهي الأمور الإلٰهية، ومبدأه الله سبحانه وتعالى»(42). ويستفادُ من هذا أنّ العلم المدني مهمته وغايته هو العمل فقط. وذلك ما ألمحَ إليه ابن رشد في كتاب النفس بالقول: «إلا أنّ الفرق بينهما أن نظر الجمهور إلى المعقولات العملية إنما هو من أجل أشخاصها المحسوسة وفي العلم النظري الأمر في ذلك بالعكس؛ أعني أن نظرهم إلى الأشخاص إنما هو من أجل المعقولات»(43). فضلاً عن ذلك دور العقل العملي أو الشريعة في تحقيق السعادة لدى الجمهور عن طريق الخيال، والقوة النزوعية في تحريك الإنسان نحو الخير، والفضائل الخلقية التي منها العدالة والعدل(44)، وهذا ما يسمى بـ «الوجود الضروري». وهذا في مقابل العقل النظري، الذي يحقق السعادة العقلية والميتافيزيقية، التي تستهدفُ الخاصة من الناس ووجودها هو وجود أفضل(45).
لقد كان هذا الكتاب (الضروري في السياسة) هو محاولة تأسيس أبي الوليد بن رشد السياسة على العلم والبرهان، وليس على الجدل والأقاويل الإقناعية، التي رأى فيها الكثير من الضلال والخطأ (46). وآية ذلك تصدير فيلسوفنا مقدمة كتابه بالقول: «قصدنا في هذا القول أن نجرد الأقاويل العلمية التي في كتاب السياسية لأفلاطون في العلم المدني، ونحذف الآراء والأقوال الجدلية سالكين سبيل الاختصار كما هي عادتنا في ذلك»(47). وهو الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك والاستفهامات على أساس أنّ السياسة اليوم فيها ما فيها من الجدل والمخاصمة والحرب والكر والفر وما إلى ذلك. لا سيما وأن فرادة هذا المختصر إنما تأتي من جهة قدرة ابن رشد على نقد الواقع السياسي الأندلسي، ونقد كذلك وضع المرأة السيئ الذي صار أبطل ـ حقيقة ـ للأفعال الإنسانية للنساء. تلك كانت أهم مميزات وسمات هذا الكتاب الرشدي.
يشيِّد ابن رشد مفهوم الكمال على كثير من المؤشرات الخلقية والسياسية والمدنية، مفهوم الكمال هو من لواحق الصورة والفعل والتمام والغاية، فهو يتجلّى في أصناف الكمال الأنطولوجي والكمال المفارق والكمال الإرادي والاستعدادي(48). ومن ذلك علاقة الكمال بالنفس، وعلاقة الكمال بالمدينة، وعلاقة الكمال بالعدل. يقول ابن رشد في هذا الأمر: «فقد ينبغي أن تكون ها هنا جماعة من الناس، تتكامل فيهم جميع أنواع الكمالات الإنسانية، فيتعاونون على بلوغ أقصى الكمالات، وذلك بأن يتَّبع أقلُّهم كمالاً أكثرهم كمالاً؛ قصد التهيؤ لكماله الخاص [...] مثال ذلك الفروسية وصناعة اللُجم (جمع لجام) فصناعة اللجم خادمة للفروسية من جهة أنها تمهيد لها، والفروسية تمكن صناعة اللجم من الصفة التي بها يكون اللجام على أحسن وجه، وهما معاً يعملان لغرض واحد»(49) وقد لا يتحصل لنا الكمال إلا شرط تحقق التناسب بين قوى النفس ذاتها، أو بين الفرد والمدينة، مما يؤدي إلى الاعتدال والانسجام وتحصيل العدل بمعنى القيام بوظائف وفق الطبع والمرتبة، فالمدينة الجماعية يبطلُ فيها مثلاً هذا الناموس، ويبدو هذا في تساوي هذه الفئات والطبقات أي بين العبيد والسادة والآباء والبنين ! يقول الشارح الأكبر مبيّناً ذلك: «فنسبة هذه الفضائل في أجزاء المدينة هي كنسبة القوى النفسانية في أجزاء النفس، فتكون هذه المدينة حكيمة في جزئها النظري الذي به يسود جميع أجزائها، على النحو الذي يكون به الإنسان حكيماً بجزئه الناطق، الذي يسود به على قواه النفسانية الأخرى»(50) يعني قوة العقل والقوة الغضبية والقوة الشهوانية. ليخلص إلى أنّ هذا التناسب والكمال هو شرط تحصيل العدل(51).
وقد أورد لنا ابن رشد أمثلة طبية لترسيخ القول بمعاني الاعتدال والانسجام والكمال، وكأنه يتحدث عن النوابت بلغة الفارابي(52) التي تعوق هذه الكمالات الإنسانية. يقول في هذا المعرض: «ولما كان الإنسان إنما خلق ليصير جزءًا من هذه المدينة؛ كي يقوم فيها بعمل؛ فإنه إذا انعدم منه هذا النفع صار موتُه أفضل من حياته. ولهذا يحاول الأطباء أن يبتروا من الجسم كل عضو تعفّن وبطل العمل به؛ كالأصابع المتعفنة والطواحن (الأضراس) الفاسدة. وأيضاً فعندما نترك أمثال هؤلاء في المدينة فإنهم يصيرون أحد الأسباب في ولادة ذوي العاهات، وهذا ما يحصل في الغالب»(53). ثم يشير ابن رشد إلى أنَّ الإنصاف هو فعلٌ من أفعال العدل(54)؛ يعني هذا أنّ على كلّ واحد من أهل المدينة أن «لا يقوم إلّا بعمل واحد من الأعمال التي تحتاجها، وهو العمل الذي أُعِدَّ له بالطبع، وهذه هي العدالة التي تمنح السلامة والبقاء طالما بقيت قائمة فيها... ولا تغرب نفسه فيما ليس له»(55). وهذا ما يسميه أبو الوليد بـ «العدل المدني»(56). الغريب أن يتصور ابن رشد أن الظلم والجور هو على مقياس تعريف العدل، إذ هو الانتقال من شيء إلى آخر، ومِنْ فِعْلٍ إلى فعل؛ ليقر أيما إقرار أنّ «الإساءة تكون بادية للعيان في تحول الأصناف (المراتب والطبقات) بعضها إلى بعض»(57). وقد حرصَ ابن رشد على أن يكون العدل بين قوى نفس الفرد أو بين الفرد والمدينة. يقول: «فقد تبين من ذلك أن العدل في نفس الفرد هو بعينه العدل في المدينة، وبذلك يكون الظلم والجور في نفس الفرد هما بعينهما الظلم والجور في المدن الجاهلة»(58). فالكمال الإنساني إذاً هو تحقيق الانسجام وفق الطبع والمرتبة، وإذا لم يتم احترام هذا الجزء الفكري أو التعقل يكون الأمر في منأى عن الكمالات(59) التي ننشدها. يقول ابن رشد: «لأنّ الاجتماع الفاضل إنما يقصد به أن يجعل لكل واحد من أهل المدينة نصيباً من السعادة على قدر ما في طبعه من ذلك»(60). وأما إنْ كانت المدينة مدينة الجور والتسلط فيكون الكمال غير نافع. وهذا ما صوره لنا ابن رشد في نص بليغ ورفيع حينما يكون الاختلال في قوى النفس ينعكس على المدن. يقول في هذا الباب: «ولو كانت أجزاء النفس لا يفضل بعضها بعضاً، ولم يكن أدناها من أجل أشرفها ـ كما يتهيأ أن يعتقد ذلك كثير من الناس ـ لكان الاجتماع الإنساني هو اجتماع أحرار. وكذا لو كانت أجزاء النفس من أجل الجزء الغضبي؛ لكان الاجتماع الكرامي أو الغضبي (التسلطي) هو الاجتماع الإنساني. وأيضاً لو كانت النفس الشهوانية هي القائد؛ لكان اجتماع اليسار أو اجتماع الشهوة هو الاجتماع الفاضل. وقد تبيّن ـ في العلم الطبيعي وفي هذا العلم أيضاً أن الأمر عكس ذلك كله، وأن السيادة على أجزاء النفس يجب أن تكون للجزء الناطق [العقلي]، والمدينة التي يحكمها هذا الجزء هي المدينة الفاضلة»(61).
وعلى هذا يوجّه ابن رشد سهام نقده القاسية إلى المدينة القائمة في زمانه، في معرض حديث عن تحول المدينة الجماعية إلى وحدانية التسلط. يقول: «يتبيّن لك هذا من المدينة الجماعية في زماننا؛ فإنها كثيراً ما تؤول إلى التسلط، مثال ذلك الرئاسة التي قامت في أرضنا هذه ـ أعني قرطبة ـ بعد الخمسمائة؛ لأنها كانت قريبة من الجماعية كلية، ثم آل أمرها بعد الأربعين وخمسمائة إلى تسلُّطٍ»(62). ثم يردفُ كذلك في منتهى (الضروري في السياسة): «قال [بسبب] طغيان المتسلط ذاك فإنه لا يستضيفه أحد من أهل المدينة حباً ووفاء حقيقيين، ولا يبادلهم هو حباً بحب. ولما كان هذا كما وصفنا، فإن نهج المتسلط هو نهج الذي هو في غاية الجور؛ لأن ذلك في غاية التناقض مع ما عرفنا من قبل أنه الأمر الصحيح، كما هو الحال في هذه المدن. وهذا هو الذي في غاية السوء والفساد، كما أن الذي يتمثل في الملك هو الذي يكون في غاية الطيبة والتعقل»(63) ومن ثمة، فهذا النقد الرشدي هو نقد مباشر للسياسات العربية والإسلامية واجتماعهم المدني.
لعل من أهم ما ورد عند أبي الوليد في الضروري في السياسة هو دفاعه البارز عن المساواة بين الرجال والنساء الذين يشتركون في الغاية الإنسانية والأفعال الإنسانية. وفي هذا يقول فيلسوف قرطبة ومراكش: «فإذا كان ذلك كذلك، وكان طبع النساء والرجال طبعاً واحداً في النوع، وكان الطبع الواحد بالنوع إنما يقصد به في المدينة العمل الواحد؛ فمن البيِّن إذن أن النساء يقمن في هذه المدينة بالأعمال نفسها التي يقوم بها الرجال، إلا أنه بما أنهن أضعف منهم فقد ينبغي أن يكلفن من الأعمال بأقلها مشقة»(64). والحال هذه أن الرجال والنساء يحقق بهما الكمال؛ حيث إن الموسيقى ـ كما يقول ابن رشد ـ تبلغ كمالها إذا أنشاها الرجال وعملتها النساء(65)، فضلاً عن ذلك رأى ابن رشد أنّ كفاية النساء تجعل منهن حكيمات أو صاحبات رئاسة(66). وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قدرة أبي الوليد على ربط العدالة بالمساواة والحقوق الفردية، التي لم يتم الانتباه إليها من قبل الفلاسفة العرب والمسلمين المتقدّمين(67)، هذا من جهة أولى، وأما من جهة ثانية فهو قدرتهُ أيضاً على تجاوز المعنى الأرسطي والأفلاطوني لمفهوم العدل من حيث هو اللامساواة والتفاوت(68) مع أنّ ابن رشد بقي يتعقل العدالة في سياق فهمه لقوى النفس ووظائفها، ومن ثم للفضائل ومراتبها، ثم لتصبح العدالة «مجرد انعكاس لعلاقات القوى القائمة اجتماعياً»(69). ومن هذا المنطلق كان غرض ابن رشد من حديثه عن النساء والرجال إبراز الأفعال الإنسانية وكمالاتها في الأفعال والآراء؛ إذ ليس من المعقول فحص مفهوم الكمال والاعتدال من دون فحص أجزائه ومكوناته.
خاتمة
نخلص من جميع ما تقدم أنّ رؤية الفارابي وابن رشد لمسألة العدل هما خطان قد لا يلتقيان؛ وذلك لأنّ الأول لم يكن غرضُه الكتابةَ السياسة من أجل ذاتها، بقدر ما كان الأمر أبعد من ذلك؛ فالغرضُ هو توظيف إمكانات الإنسان وقواه واستعداداته في تحصيل الاعتدال والانسجام بين قوى النفس، وهذا لا ينفصل حتماً عن عالمه الميتافيزيقي الذي يراهن فيه على ترتيب الموجودات على جهة التعقل. أما ابن رشد فقد تميزّ أيما تميز عن باقي الفلاسفة المسلمين السابقين بقدرته الكبيرة والفائقة على تحويل العدل من عالم الميتافيزيقا إلى عالم الطبيعة والواقع الاجتماعي والسياسي المشاهد، عن طريق نقْد منجز أفلاطون، الذي لا شك أنه يعبرُ عن مناسبات ثقافية يونانية معينة، ثم العمل ثانياً على نقد غياب العدالة في دولة المنصور، وتحويلها إلى وحدانية التسلط، بل الأكثر من ذلك أنّ فيلسوف قرطبة وجه انتقادات قاسية لمن تسبب في إبطال الفعل الإنساني للنساء بمعية الرجال، وهذه القضية لا تحضر بالكلية عند نصوص الفارابي لا من قريب ولا من بعيد! لكن لا بد من القول: إنّ تقاطع الفيلسوفين ـ الفارابي وابن رشد الحفيد ـ أجدهُ في خلفيتيهما البعيدتين، والتي قد نقول: إنها تحكم جلّ مكتوبات القدماء من فلاسفة ومتكلمين بصورة أو بأخرى، وهو مفهوم الاعتدال بين قوى النفس وكمالاتها الإنسانية. ويمكن القول: بكلمة جامعة: إنّ تصورات الفارابي وابن رشد لمسألة العدل والعدالة قد أسهمت في لفت الانتباه إلى دور الكمال والاعتدال والتعقل في تحصيل السعادة القصوى، إلّا أنها تصورات كانت تحتاج إلى محاولات فلسفية ونظرية متقدمة؛ لبيان أنّ سؤال العدل هو سؤال قيمة الإنسان وحريته، فلا عدالة من دون حرية، أعني ربط العدالة بالحقوق الفردية والجماعية على أساس المواطنة.
-----------------------------------
المراجع والهوامش:
1) قد لا نتفق مع فتحي المسكيني في قوله: إنّ نصوص الفلسفة الإسلامية قد تحولتْ إلى تراث؛ من حيث إنها تُستدعى إلى صراعات بين المادية والمثالية أو بين الفكر والواقع. وذلك أن أمر قراءة النصوص الفلسفية العربية الإسلامية له جاذبيتهُ حينما تروم كشف كينونة الموجود الإنساني بوجهيه العملي والنظري عند الفارابي وابن رشد وابن باجة لكن في كثير من الأحيان قد نقف عاجزين عن فهم بعض الأمور والمنجزات إذا لم نعد بالفعل إلى ما تحدّث عنه الجابري بالتمييز بين المحتوى المعرفي والأيديولوجي رغم ما قد يثيره من تحفظات على هذين المحتويين! يقول فتحي المسكيني: «ولكن أية «فلسفة إسلامية»؟ فأنْ نسميها «تراثاً» لهو أكبر سوء فهْم أقمناه دونها. ربّ تغليط حوّل نصوص الفلاسفة إلى وثائق «تراثية ضدهم، فيكون الفارابي شيعياً أو مادياً وابن سينا «رجعياً»... إلخ»، مرجع سابق، ص 69.
2) محمد عابد الجابري، مشروع قراءة جديدة لفلسفة الفارابي السياسية والدينية ضمن نحن والتّراث. قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة 1983، ص79 - 124.
3) الفارابي، كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين، قدم له وعلّق عليه: ألبير نصري نادر، الطبعة الرابعة، بيروت: دار المشرق، ص 79.
4) محمد عابد الجابري، الفصل التاسع: «لماذا أرسطو؟ وما الحاجة إلى شرحه؟ ضمن ابن رشد سيرة وفكر (دراسة ونصوص)، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الخامسة 2015، ص 153 إلى 166.
5) للوقوف عند مزيد من التفاصيل: محمد المصباحي، منزلة العقل العملي في فلسفة ابن رشد ضمن الوجه الآخر لحداثة ابن رشد، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1998، ص41 إلى 57.لم يكن ابن باجة يفكّر في إشكالية المدينة بقدر ما كان مشغلهُ هو البحث في موضع الفيلسوف وتدبيره كمتوحد مفرد ضمن أفق إنساني. يقول فتحي المسكيني: «إنّ غرض التفلسف إنما لم يعد افتراض مدينة فاضلة، الوجودُ لها أنها توفر الشروط السعيدة لتحقيق إمكانية الفيلسوف والوطن الفلسفي المفقود، بل صار مطلوباً الانكباب على واقعة الفيلسوف كما يوجد فعلاً في المدن غير الفاضلة»، فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1997، ص 92. يقول كذلك: «إشكالية النابتة إنما هي سبيل طريف للخروج من الأفق التقليدي لطرح مسألة الوجود المدني للفيلسوف، الذي هيمنتْ عليه إشكالية المدينة الفاضلة»، المرجع ذاته، ص 95.
6) لا بد من التنبيه أن أبا الوليد لم يترك كتاباً في «السعادة»؛ بَيْدَ أنّ سيرته الفلسفية قد تكون نوعاً من أنواع الكلام عن الإيتيقا الرشدية. فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1997، الهامش رقم 1، ص 70. قارن قول الجابري: «كلمة» النوابت» معناها المجازي منقول مباشرة عن معناها الحقيقي؛ أي الأشخاص «غير الفضلاء» في المدينة الفاضلة وهو المعنى المجازي ـ الفلسفي الذي قصده الفارابي وذلك تشبيهاً لهؤلاء بالشوك في حديقة الورد. غير أن ابن باجة ينبّهنا في النص الذي بين أيدينا إلى أنه لا يقصد هذا المعنى؛ بل يريد معنى آخر هو على النقيض من هذا تماماً؛ فهو يعني بـ «النوابت» الأشخاص الفضلاء في مدينة غير فاضلة»، محمد عابد الجابري، نحن والتّراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، طبعة مزيدة ومنقحة، 1983، ص 260.
7) يقول ابن منظور (630هـ/711هـ): «العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور... العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم»، ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، (د. ت.)، مادة عدل. قارن قول الجرجاني (740هـ/816هـ) في التعريفات: «العدل هو الاستقامة على الحق بالإجتناب (الابتعاد) عما هو محظور ديناً»، الجرجاني، أبو الحسن علي. التعريفات، تونس، الدار التونسية للنشر، 1971. وأما ابن فارس فيقول: «والعدل: الحكم بالاستواء. ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عِدْلُه»، ابن فارس (399هـ/395هـ)، معجم مقاييس اللغة، بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هرون، دار أحياء الكتب العربية، الجزء الرابع.
8) أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفقهي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 2000م، ص 19 و60. قارن قوله أيضاً: «فلا يجوز تقليد القضاء إلّا لمن كملت فيه سبع شرائط: الذكورية، والبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعدالة، والسلامة، في السمع والبصر، والعلم»، مصدر سابق، ص 60. قارن: الماوردي، أدب الوزير، صححه حسن الهادي حسين، القاهرة: الناشر مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية 1994، ص 4.
9) فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1997، ص 74.
10) يقول فهمي جدعان: «والواقع أنّ علم الكلام الكلاسيكي الذي خاض معارك مجيدة في وجه خصوم الإسلام، وحفظ للعقيدة الإسلامية تماسكها وصرامتها المنطقية وأصولها الراسخة ـ قد كان عاجزاً ـ في صورته المجردة الممنطقة ـ عن أن يقوم بدور حيوي فعّال في الحياة الزمنية والروحية للإنسان المسلم»، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية 1981، ص 188. قارن: محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية. محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1995.
11) الفارابي، تحصيل السعادة، قدم له وبوبه وشرحه د. علي بو ملحم، بيروت: دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى 1995، ص 97. الغريب أن هذا الفيلسوف يتصور أنَّ السعادة الظنية هي السعادة الحقيقية لهذا يسعى لطلبها. انظر أيضاً المصدر السابق، ص 97.
12) الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سابق، ص 97.
13) الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سابق، ص 96 - 97.
14) الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سابق، ص 95 - 96. قارن قوله أيضاً: «وأن يكون كبير النفس عما يشين عند الناس، وأن يكون ورعاً سهل الانقياد للخير والعدل عسر الانقياد للشر والجور»، الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سابق، ص 96 - 97.
15) «فهذه هي الفلسفة بالحقيقة والفيلسوف بالحقيقة»، تحصيل السعادة، مصدر سابق، ص 95.
16) «فإذن معنى الإمام والفيلسوف وواضع النواميس معنى واحد، إلّا أنّ اسم الفيلسوف يدلُّ على الفضيلة النظرية، إلا أنها إن كانتْ مزمعة على أن تكون الفضيلة النظرية على كمالها الأخير من كلّ الوجوه؛ لزم ضرورة أن تكون فيه سائر القوى»، الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سابق، ص 92. قارن تمييز الفارابي بين اسم الملك ـ المرادف للتسلط والاقتدار ـ والإمام. المصدر السابق، ص 92 - 94.
17) الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سبق ذكره، ص 89. يقول في كتاب الحروف في مسألة الملة الحقيقية والفلسفة الحقيقية: «إلا أنّ الملّة على الجهتين إنما تحدث بعد الفلسفة، إما بعد الفلسفة الحقيقية التي هي الفلسفة في الحقيقة، وإما بعد الفلسفة المظنونة، التي يظن بها أنها فلسفة من غير أن تكون فلسفة في الحقيقة، وذلك متى كان حدوثها فيهم عن قرائحهم وفطرهم ومن أنفسهم»، الفارابي، الحروف، حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدي، بيروت: دار المشرق، الطبعة الأولى 1970، ص 154. لمزيد من الاطلاع: محمد ايت حمو، الدين والسياسة في فلسفة الفارابي، بيروت: دار التنوير، الطبعة الأولى 2011، ص 29 - 37.
18) المصدر السابق، ص 90. يرى المعلم الثاني أنّ الفلسفة إذا لم تكتمل بالصنائع القياسية والبرهانية اليقينية خاصة؛ فإن أمر تبعية الملّة للفلسفة قد يكون مشوباً بالآراء الكاذبة، بل إنّ الفلسفة هذه لم تسلم من تلك الآراء. إذ تصيرُ فلسفة مظنونة ومموهة وبعيدة عن الحق ! يقول الفارابي في كتاب الحروف: «فإذا أُنشئت ملّة ما بعد ذلك تابعة لتلك الفلسفة وقعتْ فيها آراء كاذبة كثيرة، فإذا أُخذ أيضاً كثير من تلك الآراء الكاذبة وأخذت مثالاتها مكانها على ما هو شأن الملّة فيما عس وعسر تصوره على الجمهور كانتْ تلك أبعد عن الحق أكثر، وكانتْ ملّة فاسدة، ولا يُشعر فسادها»، الفارابي، الحروف، حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدي، بيروت: دار المشرق، الطبعة الأولى 1970، ص 153 - 154.
19) الجابلي سعيد، إشكالية السعادة عند الفارابي: بين النظري والعملي، منشور ضمن مجلة تبيّن القطرية العدد 25/7 صيف 2018. لا بد أن تطوير هذه الإشكالية ـ أي إشكالية السعادة ـ لم تكن إلا في معرض العقل العملي كعقل يراهن على الحياة السعيدة للفرد والإنسان، وليس على الحياة الدينية الجماعية. لذا كانت السعادة موضع تحصيل ممكنات البشر واستعداداتهم المحايثة، في مواجهة كل عملية لحصر وجود في وحدة تسلطية تنحو نحو الطاعة والأمر! انظر أيضاً كلام فتحي المسكيني: «ولذلك يبدو مبحث «الايتيقا» عند الفارابي ـ كما يقول أرسطو ـ مبحثاً مهتزاً وقلقاً؛ فهو يرتبط ـ من جهة الموضوع ـ بعناصر أنطولوجية متغيرة ومتقلبة هي أفعال البشر وتشوقاتهم واستعداداتهم. وهو ـ من جهة المنهج ـ مشروط بالطابع الكلي الذي يفرضه العقل النظري»، فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، مرجع سابق، ص 73 - 74.
20) «قد يقال على معنى آخر أعم، وهو استعمال الإنسان أفعال الفضيلة فيما بينه وبين غيره، أيّ فضيلة كانت»، الفارابي، فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه د. فوزي متري نجار، بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية، ص 71 - 72.
21) الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سبق ذكره، ص 85. يشير الفارابي في كتاب (فصول منتزعة) إلى أنّ الفضائل صنفان» فالنطقية هي فضائل الجزء الناطق؛ مثل الحكمة والعقل والكيس والذكاء وجودة الفهم. والخلقية هي فضائل الجزء النزوعي مثل العفة والشجاعة والسخاء والعدالة»، الفارابي، فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه د. فوزي متري نجار، بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية، ص 30. انظر أيضاً: (“Pour la plupart des hommes, cette connaissance doit prendre la forme d’une représentation imaginative de la vérité plutôt qu’une conception rationnelle de celle-ci”, Muhsin Mahdi, la fondation de la philosophie politique en Islam. la cité vertueuse d’Alfarabi, Traduit de l’américain par François Zabbal, éd, Flammarion, 2000, p. 182.)
22) المدينة الجاهلة «هي التي لم يعرف أهلها السعادة ولا خطرت ببالهم. إن أرشدوا إليها فلم يفهموها ولم يعتقدوها، وإنما عرفوا من الخيرات بعضاً من هذه التي هي مظنونة في الظاهر أنها خيرات من التي تُظن أنها هي الغايات في الحياة، وهي سلامة الأبدان واليسار والتمتع باللذات، وأن يكون مخلّى هواه وأن يكون مكرماً ومعظماً»، الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، قدم له وعلّق عليه وشرحه د. علي بو ملحم، بيروت: دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى 1995، ص 127. ومن المدن التي تحدث عنها الفارابي: المدينة الفاسقة، والمدينة البدالة (الأوليغارشية)، والمدينة الضالة، ومدينة الخسة والسقوط، ومدينة الكرامة (التيموقراطية)، ومدينة التغلب، والمدينة الجماعية (الديمقراطية). انظر التفاصيل: الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، مصدر سابق، ص 128 - 130.
23) الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سبق ذكره، ص 46. قارن قول الفارابي أيضاً: «فهذا هو الكمال النظري، وهو كما تراه يشتمل على علم الأجناس الأربعة التي بها تحصل السعادة القصوى لأهل المدن والأمم، والذي يبقى بعد هذه أن تحصل هذه الأربعة بالفعل موجودة في الأمم والمدن على ما أعطتها الأمور النظرية»، الفارابي، تحصيل السعادة، مصدر سبق ذكره، ص 47. قارن: محمد عزيز الحبابي، ورقات عن فلسفات إسلامية، الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 1998، ص 40.
24) الفارابي، فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه د. فوزي متري نجار، بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية، ص 35.
25) الفارابي، فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه د. فوزي متري نجار، بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية، ص 40. يقول الفارابي كذلك: «المدينة والمنزل قياس كلّ واحد منهما قياس بدن الإنسان، كما أنّ البدن مؤتلف من أجزاء مختلفة محدودة العدد، بعضها أفضل وبعضها أخس، متجاورة مرتبة يفعل كل واحد منها فعلاً ما فيجتمع من أفعالها كلّها التعاون على تكميل الغرض ببدن الإنسان ـ كذلك المدينة والمنزل يأتلف كلّ واحد منهما من أجزاء مختلفة، يفعل كلّ واحد منها على حياله فعلاً ما، فيجتمع من أفعالها التعاون على تكميل الغرض بالمدينة أو المنزل»، المصدر السابق، ص 41. قارن: [“Toutes constructions, cependant, ne sont pas aussi des habitations”, Martin Heidegger, Bâtir habiter penser, in: Essais et Conférences, éd, Gallimard, 1958, p. 170. ]
26) الفارابي، فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه د. فوزي متري نجار، بيروت: دار المشرق، الطبعة الثانية، ص 45 - 46.
27) نستعمل الجزء النظري والفكري هنا بالمعنى الذي يقدمه المعلم الثاني؛ أي إن الجزء النظري يتعلّقُ بالعلم والحكمة. والجزء الفكري يتعلّق بالعقل العملي والتعقل وجودة الرأي وصواب الظن. الفارابي، فصول منتزعة، مصدر سابق، ص 50.
28) ينبه الفارابي إلى النوابت التي كالشوك النابت فيما بين الزرع، أو سائر الحشائش غير النافعة والضارة بالزرع أو الغرس. الفارابي، السياسة المدنية، تحقيق فوزي متري النجار. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1964، ص 87. يقول: «ثم البهيميون بالطبع من الناس، فالبهيميون بالطبع ليسوا مدنيين، ولا تكون لهم اجتماعات مدنية أصلاً؛ بل يكون بعضهم على مثال ما عليه البهائم الإنسية، وبعضهم مثل البهائم الوحشية، فبعض هؤلاء مثل السباع... وهؤلاء ينبغي أن يجروا مجرى البهائم: فمن كان منهم إنسياً وانتفع به في شيء من المدن تُرك واستُعبد، واستعمل كما تستعمل البهيمة ومن كان منهم لا ينتفع به أو كان ضاراً عمل به ما يعمل بسائر الحيوانات الضارة»، المصدر السابق، ص 87.
29) يُعدّ التعقل من أرفع المفاهيم التي ترد عند الفارابي فهو «القدرة على جودة الروية واستنباط الأشياء التي هي أجود وأصلح فيما يُعمل؛ ليتحصل بها للإنسان خير عظيم في الحقيقة وغاية شريفة فاضلة، كانت تلك هي السعادة أو شيء مما له غناء عظيم في أن ينال به السعادة»، الفارابي، فصول منتزعة، مصدر سابق، ص 55. يقول في موضع آخر: «والتعقل هو الذي يُوقِف على ما ينبغي أن يُفعل حتى تحصل السعادة»، الفارابي، فصول منتزعة، مصدر سابق، ص 62.
30) يتحدث الفارابي عن أنواع كثيرة من أصناف التعقل. الفارابي، فصول منتزعة، مصدر سابق، ص 57. يرد في هذا الكتاب تعريفان لمفهوم التعقل: تعريف أول، وهو الذي يسميه الجمهور العقل، وهذه القوة إذا كانت في الإنسان سمى عاقلاً. والتعريف الثاني للتعقل: بمعنى الحكمة. والتعقل إذا كان إنما يدرك به الأشياء الإنسانية فليس ينبغي أن يكون حكمة اللهم إلّا أن يكون الإنسان هو أفضل ما في العالم وأفضل الموجودات، فإذا لم يكن الإنسان كذلك فالتعقل ليس بحكمة إلّا بالاستعارة والتشبيه. الفارابي، فصول منتزعة، مصدر سابق، 61 - 62. قارن: [«l’obtention du bonheur signifie la perfection de ce pouvoir de l’âme humaine qui est spécifique à l’homme à sa raison», Muhsin Mahdi, la fondation de la philosophie politique en islam. la citévertueuse d’Alfarabi, Traduit de l’américain par François Zabbal, Ed, Flammarion, 2000, p. 177.]
31) الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، مصدر سابق، ص 123 - 124. لمزيد من التفاصيل راجع الباب الثامن والعشرين: القول في خصال رئيس المدينة الفاضلة، المصدر السابق، ص 122 - 126.
32) الفارابي، فصول منتزعة، مصدر سابق، ص 70. قارن قوله أيضاً: «ثم من أجل اشتراكهم في الفضائل ولأن بعضهم نافع لبعض يلتذ بعضهم ببعض، فيتبع ذلك أيضاً المحبة التي تكون لأجل اللذة فبهذا يألفون ويرتبطون»، المصدر السابق، ص 71.
33) الفارابي، فصول منتزعة، مصدر سابق، ص 71 - 72.
34) المصدر السابق، ص 74.
35) المصدر السابق، ص 152.
36) المصدر السابق، ص 152. يشير المعلم الثاني من دون تفصيل في موضعهما إلى نوعين آخرين من العدل هو العدل في الشراء والبيع والعدل في رد الودائع. انظر: المصدر السابق، ص 153. قارن قوله كذلك: «وأما المضطرون والمقهورون من أهل المدينة الفاضلة على أفعال الجاهلية، فإن المقهور على فعل شيء لما كان يتأذى بما يفعله من ذلك؛ صارت مواظبته على ما قسر عليه لا تكسبه هيئة نفسانية مضادة للهيئات الفاضلة، فتكدر عليه تلك الحال حتى تصير منزلته منزلة أهل المدن الفاسقة، فلذلك لا تضره الأفعال التي أكره عليها، وإنما ينال الفاضل ذلك متى كان المتسلط عليه أحد أهل المدن المضادة للمدينة الفاضلة، واضطر إلى أن يسكن في مساكن المضادين»، المصدر السابق، ص 141. الملاحظ أن لفظ العدل لم يرد عند الفارابي وهو يتحدث عن مدينة التغلّب في كتابه السياسة المدنية. انظر: الفارابي، السياسة المدنية، تحقيق فوزي متري النجار. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1964، ص94 - 99.
37) ربما من المعقول أن نصوغ التساؤل التالي: لماذا تغيَّب العدل في المدينة الجماعية (الديمقراطية)؟ لنستمع إلى ما يقوله الفارابي عن مدينة الأحرار: ««ويكون أهلها أحراراً يعملون ما شاءوا ولا يكون لأحد على أحد منهم ولا من غيرهم سلطان، إلّا أن يعمل ما تزول به حريتهم. فتحدث فيهم أخلاق كثيرة وهمم كثيرة وشهوات كثيرة، والتلذذ بأشياء كثيرة لا تحصى كثرة، ويكون أهلها طوائف كثيرة متشابهة ومتباينة لا تحصى كثرة»، الفارابي، السياسة المدنية، مصدر سابق، ص 99. يردف: «فتجتمع في هذه المدينة تلك التي كانت متفرقة في تلك المدن كلها ـ الخسيس منها والشريف ـ وتكون الرئاسات بأي شيء اتفق من سائر تلك الأشياء التي ذكرناها... وإذا استقصي أمرهم لم يكن فيهم في الحقيقة لا رئيس ولا مرؤوس»، المصدر السابق، ص 99. قارن تعليق فتحي المسكيني: «فمن الطريف أن الفارابي إنما يجعل في الموجود بعامة (الفصول 1 - 10) والقول في النفس (الفصول 5 - 20: آراء أهل المدينة الفاضلة) مدخلاً أساسياً للقول في المدينة (الفصول 26 - 37) وهذا الاختيار يؤدي دوراً حاسماً في رسم طبيعة تصوّره لإشكالية المدينة الفاضلة»، فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1997، ص 91.
38) يتحدث الفارابي عن أصناف النوابت التي توجد في المدينة الفاضلة:
A. 1 ـ النوابت المتقنّصون (قصدهم السعادة في الكرامة واليسار... إلخ).
B. 2 ـ النوابت المحرفة (يؤولون بما يتوافق مع هواهم).
C. 3 ـ النوابت المارقون (سوء فهم لأقاويل السنة والشرع).
D. 4 ـ النوابت المزيفون المتخيلون (يزيفون ما لم يقتنعوا به).
E. 5 ـ النوابت المموهون (يزيفون القول على غير حقيقته).
F. 6 ـ النوابت المعاندون.
G. 7 ـ النوابت الجاهلون. يقول الفارابي: «فهؤلاء هم الأصناف النابتة في خلال أهل المدينة، ولا تحصل من آرائهم مدينة أصلاً، ولا جمع عظيم من الجمهور، بل يكونون مغمورين في جملة أهل المدينة»، المصدر السابق، ص 107. قارن قول ابن باجة: «يسمون النوابت... ونقل إليهم هذا الاسم من العشب النابت من تلقاء نفسه بين الزرع». [Ibn Bagga, Avempace. La conduite de l’isole et deux autres épitres, introduction édition critique du texte Arabe, traduction et commentaire par Charles Genequand, Paris, (librairie philosophique. J. Vrin, 2010), p. 106. ]
39) محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية. محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1995، ص 145.
40) فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، مرجع سابق، ص 74.
41) يقول الجابري: ««السياسة» إذن جزء من العلم المدني، وهي جزؤه الثاني. أما ما يؤسسه علمياً فهو ما يؤسس الأول نفسه: الأخلاق. وإذا شئنا قلنا: «علم الأخلاق» هو الذي يؤسس علم السياسة. فما الذي يؤسس «علم الأخلاق» نفسه؟ الجواب «علم النفس»؛ ذلك لأنّ موضوع علم الأخلاق هو «الملكات والأفعال الإرادية والعادات جملة، وهذه يبحث فيها بحثاً علمياً في علم النفس»، ابن رشد، الضروري في السياسة. مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية إلى العربية الدكتور أحمد شحلان مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التّراث الفلسفي العربي مؤلفات ابن رشد (4)، الطبعة الثالثة 2011، ص 46. قارن قول ابن باجة: «وليس هذا مناقضاً لما قيل في العلم المدني أن الاعتزال شرّ كله. ولكن هذا إنما هو بالذات، وأما بالعرض فخير، كما يعرض ذلك أكثر ما في الطبع. مثال ذلك أنّ الخبز واللحم غذاء بالطبع ونافع، وأن الأفيون والحنظل سموم قاتلة. لكن قد يكون للجسد أحوال غير طبيعية ينفع فيها هذان، فيجب أن يستعملا، وتضرّ فيها الأغذية الطبيعية فيجب أن تتجنب. ولكن هذا الأحوال هي ضرورة أمراض، وهي خارجة عن الطبع، فهي نافعة في الأقل وبالعرض، ونسبة تلك الأحوال إلى الأبدان كنسبة السير إلى النفس»، ابن باجة، رسائل ابن باجة الإلٰهية، حققها وقدم لها ماجد فخري، (بيروت: دار النهار للنشر، الطبعة الثانية 1991)، ص 90 - 91.
42) المصدر السابق، ص 48. انظر لمزيد من الاطلاع عن علاقة العدل بالمجال الفكري والسياسي والديني: عبد الله سيف الدين، مبادئ العدل ومجالاته عند ابن رشد ضمن مجلة عالم الفكر، مجلة دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت، العدد 174/2018، ص 43 إلى 70.
43) المصدر السابق، ص 72.
44) نقلاً عن الوجه الآخر لحداثة ابن رشد، محمد المصباحي، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1998، ص 48.
45) يميز بين المعقولات العملية التي مجالها الامكان والإرادة والحرية وهي كائنة وفاسدة، ومعقولات نظرية مجالها الضرورة والوحدة والثبات. لمزيد من التفاصيل: محمد المصباحي، الوجه الآخر لحداثة ابن رشد، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1998، ص 49. قارن قول ابن رشد في كتاب النفس: «فهذه القوة العملية المشتركة لجميع الأناسي التي لا يخلو إنسان منها وإنما يتفاوتون فيها الأقل والأكثر»، ابن رشد، أحمد فؤاد الأهواني، القاهرة، 1950، ص 69. يشير ابن رشد إلى أن الإفراط في الحرية بلا نهاية هو آفة على المدن الفاضلة؛ أعني تحول المدينة الجماعية التي ـ هي مدينة الأحرار ـ إلى وحدانية التسلط. ابن رشد، الضروري في السياسة. مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية إلى العربية الدكتور أحمد شحلان؛ مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التّراث الفلسفي العربي مؤلفات ابن رشد (4)، الطبعة الثالثة 2011، ص 192.
46) محمد المصباحي، الوجه الآخر لحداثة ابن رشد، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1998، ص 46، 52 - 53. انظر قول الفريد اعبري عن علاقة النفس بالعقلين النظري والعملي: [«Les deux intellects sont sollicités dans le choix et la volonté d’une personne, et il apparait clairement que l’intellect théorique est engagé dans toutes les actions entreprises par l’individu raisonnable (ou prudent).», Alfred L. Ivry, la logique de la science de l’âme Etude sur la méthode dans le Commentaire d’Averroès, in A. Sinaceur (éd), penser avec Aristote (Toulouse: éres-Unesco, 1991), pp. 687-700. ]
47) «وهذا هو الذي جعلنا نرى في مثل هذا ضلالاً وهو ليس شيئاً ضرورياً ليصير به الانسان فاضلاً إلا أنه [به قد] يكون أفضل وأسهل على الانسان أن يصير فاضلاً»، ابن رشد، الضروري في السياسة. مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية إلى العربية الدكتور أحمد شحلان مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التّراث الفلسفي العربي مؤلفات ابن رشد (4)، الطبعة الثالثة 2011، ص 207.
48) ابن رشد، الضروري في السياسة. مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، مصدر سابق، ص 71. ولا نغفل أنّ أرسطو عنده البرهان بمعنى الاتساق المنطقي والصدق الخارجي أي العلم الطبيعي، والبرهان كما يرد في الفلسفة العملية هو الذي يقوم على تحليل الواقع السياسي والاجتماعي. لمزيد من الاطلاع: محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1995، ص 135 إلى 140. يقول أيضاً: «وأما المقالة الأولى من هذا الكتاب فكلها أقاويل جدلية، وليس فيها برهان إلا ما كان عرضاً، وكذلك فاتحة [المقالة] الثانية. ولذلك لم نفسر شيئاً مما فيها»، المصدر سابق، ص 208.
49) محمد المصباحي، دلالات واشكالات، منشورات عكاظ، الطبعة الأولى 1988، ص 116 - 117
50) ابن رشد، الضروري في السياسة. مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية إلى العربية الدكتور أحمد شحلان مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التّراث الفلسفي العربي مؤلفات ابن رشد (4)، الطبعة الثالثة 2011، ص 76.
51) المصدر السابق، ص 76.
52) «فالعدل هو أن يفعل كلّ جزء من أجزائها ما عليه أن يفعل، بالقدر الذي يجب وفي الوقت الذي يجب. وهذا إنما يحصل بالضرورة في أجزاء النفس إذا قادها سلطان العقل. فالحال في المدينة كالحال في النفس»، المصدر السابق، ص 77.
53) انقلب مبحث المدينة مع ابن باجة من أفق فلسفة بالذات إلى أفق فلسفة بالعرض. فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1997، ص 99.
54) المصدر السابق، ص 100. في مجال القضاء يجب على القاضي العادل ألا يكون شرير النفس؛ لأن النفس الشريرة لا تعرف الفضيلة ولا جوهرها. المصدر السابق، ص 101. لعل الفرق الواضح بين أبي الوليد بن رشد وابن باجة أنّ الأول جعل من المدينة على الطريقة الأفلاطونية موضع تفكيره. في حين أن الثاني أخرج الفلسفة والتفلسف من الحدث الأفلاطوني على أساس أنّ كتاب تدبير المتوحد هو ابتكار فلسفي متميز في مدن ناقصة، وليس في المدينة الكاملة. لمزيد من التفاصيل: فتحي المسكيني، فلسفة النوابت، بيروت: دار الطليعة، الطبعة الأولى 1997، ص 95 - 96.
55) إنّ الفكر الفلسفي والسياسي المعاصر قد أنجز قفزات فكرية كبيرة في نظرية العدالة العادلة والعدالة المنصفة: [ John rawls, A theory of justice (1972)./ Justice as fairness (2001)./ Will Kymlicka, les théories de la justice (1999).]
56) المصدر السابق، ص 120.
57) العدل المدني «هو أن يفعل كل واحد من أهلها ما هو مخصوص بفعله»، المصدر السابق، ص 120.
58) المصدر السابق، ص 120.
59) المصدر السابق، ص 122.
60) يقول ابن رشد: «لما كانت أخلاق النفس تتوزع على ثلاثة أصناف [من الرجال] وكذا الحال في المدن ـ النوع الأول المحب للحكمة، والثاني: الغضبي إما بالعفة فيكون كرامياً، وإما بالإفراط فيكون متسلطاً، والثالث الشهوي المحب للربح ـ كانت أنواع اللذات هي بالضرورة ثلاثة أصناف، لكل واحدة من هذه؛ لأنه قد تبين أن هذه اللذات كالظل [لكل واحد منهم]»، المصدر سابق، ص 205.
61) ابن رشد، الضروري في السياسة. مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية إلى العربية الدكتور أحمد شحلان، مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التّراث الفلسفي العربي: مؤلفات ابن رشد (4)، الطبعة الثالثة 2011، ص 177.
62) المصدر السابق، ص 180. قارن قوله في تحول المدينة الفاضلة لمضاداتها: «فإنه بلا ريب يكره المال ما دام في ريعان الشباب، فإذا بدأت تتقدم به السن تولد في نفسه حب المال، وتعاظم أمر ذلك مع الزمان؛ وذلك لأنّ طبعه ليس طبعاً كاملاً فإذا هو آخر الأمر يصير ذا طبع محب للمال، بعد أن افتقد مقداراً من الفضيلة على نسبة ابتعاده عن سماع الأقاويل الموسيقية [الآداب]، التي إذا تحلتْ /ع 89/ بها النفس من مبدأ أمرها بقيت تفضل الفضيلة ما دامت في هذه الدنيا»، مصدر سابق، ص 182.
63) المصدر السابق، ص 195. يقول الجابري: ومن الواضح أن ابن رشد يشير هنا إلى ثورة قرطبة على المرابطين، وقيام حكم جماعي فيها من كبار القضاة والفقهاء والأعيان، وكان من بينهم جد ابن رشد، الذي كانت له الكلمة المسموعة. وقد انتهت تلك الثورة وما عرفته من حكم جماعي «جمهوري» باستيلاء ابن غانية على قرطبة سنة 541هـ، وهو من بقايا المرابطين، وقد مارس حكماً استبدادياً عانى منه أهل قرطبة الكثير، وكان قد تحالف مع ملك قشتالة النصراني. وقد تمكن عبد المؤمن مؤسس الدولة الموحدية من طرده عنها سنة 543 هجرية»، الجابري، المثقفون في الحضارة العربية. محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1995، ص 148.
64) المصدر السابق، ص 200. قارن: «وكما أنّ هذه المدينة في غاية الرعب فكذلك المتسلط. وكما لا يوجد في أي مدينة من الحزن والنواح أكثر مما هو في هذه المدينة، كذلك الأمر في نفس المتسلط المملوءة بالشهوات التي لا تنقضي والهوى الذي لا ينتهي»، المصدر سابق، ص 201.
65) المصدر السابق، ص 124. راجع تعليق الجابري: «ولا بد من الإشارة كذلك إلى أنّ الفارابي لم يهتم ـ من قريب أو بعيد بموضوع المرأة في مدينته الفاضلة وكتاباته السياسية الأخرى، على الرغم من أنه كان يقتبس من جمهورية أفلاطون، ويستحضر بعض جوانب الواقع العربي الإسلامي؛ ولكنه فقط على مستوى الآراء»، محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية. محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 1995، ص 141.
66) المصدر السابق، ص 124. يقدم لنا ابن رشد أمثلة من عالم الحيوان لبيان المساواة بين الرجال والنساء: «ولما كانت الآلات (= كالأنياب والمخالب) التي بها تهاجم الحيوانات التي من شأنها أن تهاجم هي في الذكر منها والأنثى في الأغلب على حدٍّ سواء فذلك دليل على أن الأنثى تفعل هي أيضاً نفس ما يفعله الذكر»، المصدر السابق، ص 125.
67) المصدر السابق، ص 125. ينتقد ابن رشد واقع المرأة في الأندلس بالقول: «وإنما زالت كفاية النساء في هذه المدن (= مدن الأندلس)؛ لأنهن اتُّخذن للنسل دون غيره وللقيام بأزواجهن، وكذا للإنجاب والرضاعة والتربية، فكان ذلك مبطلاً لأفعالهن»، ابن رشد، الضروري في السياسة. مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية إلى العربية الدكتور أحمد شحلان، مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الجابري، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة التّراث الفلسفي العربي: مؤلفات ابن رشد (4)، الطبعة الثالثة 2011، ص 125.
68) يقول عزمي بشارة: «لكن ربط العدالة بالمواطنة عبر مفهوم الحقوق هو الحديث في مفهوم العدالة. وهنا يكمن جوهر ثورة عصر الحداثة في تصور العلاقة بين المواطن والدولة»، مجموعة مؤلفين، ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى 2014، ص 27.ربما يعود تعثر ابن رشد وفلاسفة الإسلام والعصر اللاتيني الوسيط في بلورة العدالة والمساواة هو تمثلهم للعدالة من حيث هي فضيلة لا من حيث هي قيم سياسية ومدنية. يقول أرسطو: [“Quoi qu’il en soit, nous étudions la justice en tant qu’elle est une partie de la vertu. On peut la considéré comme une vertu spéciale, ]
69) «وهذا ما لم يكن ممكناً أن يخطر ببال أفلاطون مثلاً، فالمتوفر في مفهوم العدالة عنده هو ذلك الأساس الذي يبقى في أي حس أخلاقي بالعدالة، وهو الحس بالتناسق والملاءمة والاعتدال والتناظر وجميعها من الحقل الدلالي للتساوي والتماثل. وهي قائمة في الكون بشكل عام، ولكنه لا يعني المساواة بالحقوق والواجبات بعد. فالعدالة عنده هي أن يقوم كل إنسان بوظيفته بحسب كفاءاته ومقدراته المتلائمة مع بنيته الذهنية والطبيعة، وليس في إطار مساواة في الحقوق أو الفرص أو غيرها»، المرجع ذاته، ص 28 - 29.
70) المرجع السابق، ص 35. قارن قول فهمي جدعان: «العدل الفلسفي الأخلاقي الذي ينحدر من أفلاطون وأرسطو على وجه الخصوص، ويتعلّق به جميع فلاسفة الإسلام؛ إذ يجعلون العدل جماع فضائل النفس الإنسانية وكمالها وتوازنها واعتدالها: الحكمة والشجاعة أو النجدة والعفة والعدل. وفي هذا الصنف من العدل أيضاً لا ينفصل العدل عن الخير»، فهمي جدعان، العدل في حدود ديونطولوجيا عربية ضمن: ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى 2014، ص 66.