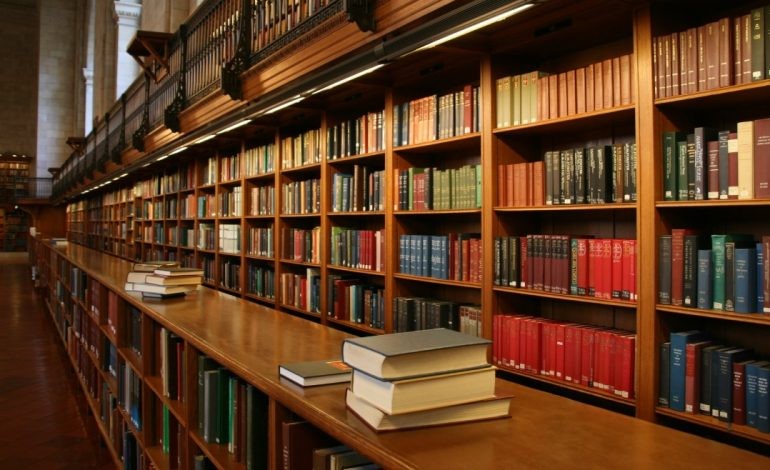التكامل المعرفي بين الفلسفة وعلم الكلام وعلم أصول الفِقه من خلال المفاهيم الرحّالة «مفهوم العِلَّة أنموذجاً»
بلال شيبوب | باحث في الفِقه وأصوله، المغرب.
التكامل المعرفي ضرورة، وهو آيل ـ في معناه العام ـ إلى تعاون العلوم والخواطر على بيان أمرٍ ما، وهذه حقيقة ينطق بها تاريخ العلم؛ فإن كثيراً من العلوم ما كانت لتصل إلى مراحل متقدّمة من نضجها لولا تكاملها مع غيرها؛ فعلم الطبّ مثلاً ما كان ليصير علماً متقناً مرتباً لولا تعاون الخواطر في الأزمنة المتطاولة، ولكانَ أذكى الناس يفتقر إلى عمرٍ طويلٍ في علاج علةٍ واحدةٍ، فضلاً عن الجميع(1)
1 ـ أنماط التكامل المعرفي: علم أصول الفِقه أنموذجاً
ينقسم التكامل المعرفي إلى قسمين: تكامل داخلي، وهو الذي حصل بين العلوم الإسلامية بعضها مع بعض، والثاني خارجي، وهو الذي تمَّ بين هذه العلوم وعلوم أخرى منقولة، تمَّ تقريبها لتنسجم مع قواعد المجال الأصلي المنقول إليه(2)
وقد وقع الاختيار للتمثيل لهذين النمطين من التكامل على علم أصول الفِقه؛ لما يمتاز به من قدرةٍ عاليةٍ على التداخل مع غيره من العلوم، حيث استطاع إذابة علوم منقولة ومأصولة في بوتقته، حتى توقع السبكي أن يقدح بعضهم في استقلاليته بدعوى أنه نُبذ علومٍ وأبعاضُها؛ فقال: «فإن قلت: قد عظمت أصول الفقه، وهل هو إلا نُبذٌ جُمِعت من علوم متفرقة، نبذة من النحو،... والكلام في الاستفتاء،... ونبذة من علم الكلام،... ونبذة من اللغة،... ونبذة من علم الحديث... والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في الإحاطة بها، لم يبقَ من أصول الفِقه إلَّا الكلام في الإجماع وهو من أصول الدين أيضاً، وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه، فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جداً، بحيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان إلا شيئاً يسيراً»(3)
وليس الأمر كذلك؛ فقد دقّق الأصوليون في تلك العلوم، ووصلوا إلى أشياء لم يصل إليها أرباب تلك الصنائع؛ ثم إن تلك القضايا المستمدة لم تبق في بيئة أصول الفِقه على هيئتها الأولى؛ بل تمَّ تكييفها لتنسجم مع علم أصول الفِقه موضوعاً ومنهجاً ومقاصد.
أ ـ التكامل الداخلي:
تكامَلَ علمُ أصول الفِقه مع علوم إسلامية كثيرة بدرجات متفاوتة، وذلك بمقتضى انتمائها إلى سياق تداولي واحد؛ فقد تكامل مع علْم الكلام، والفِقه، واللغة؛ فالفقيه محتاجٌ ـ في تقرير الأحكام ـ إلى قواعد استنباطية يضعها الأصولي، كما أن الأصولي مضطر إلى الفِقه للتمثيل لمسائل في علمه؛ ولقد أشار الغزالي إلى أهمية الفِقه في النسق الأصولي، حينما شرط على مطالع كتابه شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل أن يحصِّل أمراً مهمّاً، وهو «الارتياض بمجاري كلام الفقهاء في مناظراتهم، ومراقي نظرهم في مباحثاتهم»(4)
وبتأمل طفيف في بنية علم أصول الفقه؛ يجد الناظر أن شطراً مهمّاً منه متعلّق بعلوم العربية نحواً ولغة وأدباً؛ فالأصولي مضطر إلى الكلام في الحقيقة والمجاز، والمنطوق والمفهوم، وغيرها من المباحث الدلالية التي تؤخذ مُسَلَّمة من علوم العربية.
ثم إن الأصولي «إنما ينظر في أدلة الشرع، ووجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل، والذي يثبت له وجوه الشرع ودليل الشرع والحكم إنما هو المتكلم»(5)
فمهمَّة علْم الكلام إثباتُ مبادئ العلوم الدينية كلها، بما فيها علم أصول الفقه؛ وبذلك فالأصولي لا يخوض في المسائل الكلامية ـ كحدوث العالم، وإثبات الباري وصفاته ـ وإنما يأخذ ذلك مُسَلَّماً من علم الكلام، ويستمد منه الحجج على الأدلة الإجمالية؛ ليسلم له الاستناد عليها.
ب ـ التكامل الخارجي:
اعلم أنه إذا كان تفاعلُ علومٍ تنتمي إلى مجال تداولي واحد أمْراً مطلوباً ومستحسنا؛ فإن الخَطْب ليس كذلك حينما يقع التفاعل بين علوم لا تنتمي إلى المجال التداولي نفسه؛ فقد أصدرت طائفة من الفقهاء أحكاماً شرعية تحرِّم مجرد الاشتغال بالفلسفة اليونانية، بوصفها عِلْماً أجنبياً عن التربة الإسلامية، فكيف إذا تعلق الأمر بخلطها بعلوم المِلة؟
ولقد أبانت الفلسفة أن بعض أجزائها تتسم بالكفاءة العلمية والعمومية والتجريد، الأمر الذي شجع بعض مفكري الإسلام ـ وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي ـ على توظيف بعض الآليات المنطقية اليونانية في سياقات متنوعة، كان على رأسها علم أصول الفِقه؛ حيث سعى إلى تقريبها من التداول الإسلامي وتكييفها لتنسجم مع قواعد المجال الأصلي. وتُعدُّ المقدّمة المنطقية التي صدر بها كتابه المستصفى مرحلةً فاصلةً في تاريخ علم أصول الفِقه، وتنبيهاً واضحاً إلى تكامل العلوم التراثية الأصلية مع العلوم الأجنبية المنقولة.
لكن ابن رشد الحفيد استدرك عليه إدراج المنطق في الأصول، وعدّه إقحاماً وفضولاً يجب تخليص أصول الفقه منه؛ وذلك حينما حذف من كتابه الضروري في أصول الفِقه(6)، ـ الذي لخَّص فيه المستصفى ـ المقدمةَ المنطقية، وتلك إشارةٌ خفية منه أن المنطق لا يصلح إلا للعلوم البرهانية، أما العلوم الشرعية فالأليق بها سلوك المسالك الخطابية والجدلية.
هذا رغم احتفال الغزالي بها، وعدّها مقدّمة للعلوم كلها، «ومن لا يحيط بها، فلا ثقة له بعلومه أصلا»(7). فجدوى المنطق ـ بـحسب الغزالي يشمل «جميع العلوم النظرية، العقلية منها والفقهية؛ فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات، في ترتيبه وشروطه وعياره؛ بل في مآخذ المقدّمات فقط»(8).
ومن خلال تتبعي لهذه المسألة عند الغزالي بان أن قصده من إدخال المنطق في علم أصول الفِقه هو إغناء التفكير الأصولي، ومده بآليات نظرية من شأنها الرفع من إنتاجيته(9). ولذلك أستطيع أن أقرر مع طه عبد الرحمٰن أن علم الأصول «من العلوم النقلية بمنزلـة المنطق من العلوم العقلية، والعكس بالعكس؛ فكأن العلمين صنوان افترقا، فكان لا بدَّ أن يلتقيا»(10) وهو المشروع الذي جاء الغزالي داعياً إليه، ببيان أنه لا شيء من المنطق يأتي على قواعد الشرع بالنقض، وأنه ليس فنّاً مخصوصاً باليونان(11)
2 ـ ضوابط التكامل المعرفي بين العلوم:
تقرر فيما سبق أن العلوم يجب ألا تنكفئ على ذاتها، زاعمة كفايتها المعرفية؛ فقد يحصل لعلم من العلوم أن تتوفر له من الآليات ما يستطيع به حلَّ القضايا التي تندرج داخل مجال اشتغاله، ولكنَّ ادعاءه التمامِيَّةَ المطلَقة في الزمن أمرٌ يجانب الصواب؛ ذلك أن العلوم الموازية لذلك العلم تتطور في علاقتها بالواقع، وفي علاقتها مع علوم أخرى، فتقوم بتعديل مناهجها؛ حتى تستطيع الاستمرار والوفاء بمعالجة القضايا المستجدة التي تمثل موضوع اشتغالها، في حين يبقى العلم المنكفئ على ذاته جامداً لا يبرح مكانه، إلى أن يأتي عليه حين من الدهر لا يكون فيه شيئاً مذكوراً.
ولقد رصدت ـ من خلال ما مضى ـ وعياً كبيراً بأهمية التكامل المعرفي عند مفكري الإسلام، تجلّى في سعيهم الحثيثِ إلى تأطيره علمياً بوضع ضوابطه، حتى يستمدَّ نظرُ كلٍّ مَنْ رام الاستمداد من علمٍ آخر «منقولاً» كان أو «مأصولاً»، ويتحققَ مقصدُ التكامل في زيادة العلم من «الإحكام العلمي والبرهاني لمفاهيمه وتصوراته، ولمسائله وأحكامه»(12)
ولقد أوقفني ترديد النظر في مصادرَ تراثيةٍ على خمسة ضوابط للتكامل المعرفي، لا أزعم أنها محصورة فيها؛ بل قد تكون وراءها ضوابطُ أُخر لم أقف عليها:
أولاً: ضابط الأهلية:
ويعني استجماع المستأهلِ لمشروع التكامل المعرفي الكفايةَ العلميةَ، وذلك من خلال الشرطين التاليين:
الشرط الأول: أن يكون عالماً بقواعد المجال الأصلي، حتى لا يُدخل ما يصدم أصلاً من أصول الدين، فيُفسد من حيث يريد الإصلاح.
الشرط الثاني: أن يصل في العلوم التي منها استمداده إلى درجة يساوي بها أعلم الناس فيها، ويعرف مسائلها مبرهنة كما هي في مظانها(13)
ثانياً: ضابط التناسب:
ويقضي أن يكون بين العلوم المتكاملة تناسبٌ في مستوىً من مستويات العلم؛ إما على مستوى المادة، أو المقصد، أو المنهج؛ فالتكامل لا يحصل اتفاقاً أو انطلاقاً من رغبة ذاتية للعالم؛ بل هو مسلكٌ ضروري يلجأ إليه عن قصْدٍ وترتيب؛ فعلى سبيل المثال، نجد أن علم الكلام، والفِقه، والتفسير، والحديث، والأصول تشترك جميعها في كونها علوماً شرعية، وبعضها مفتقر إلى بعض، ووجه التناسب بينها متفاوت؛ فتناسب الحديث والتفسير أقوى من تناسب التفسير وعلم الكلام، وتناسب علم الكلام وعلم أصول الفقه أوضح من تناسب علم الكلام والفِقه...
وكذلك يُشاكلُ علمُ الكلام الفلسفةَ في مبحث الإلٰهيات، الذي يطلب ماهيات الأشياء، وجملة ما ينظر فيه: «الواحد والكثير ولواحقهما، والعلة والمعلول، والقديم والحادث، والتام والناقص، والفعل والقوة...»(14). وبإنعام النظر في الكتب الكلامية نجدها تعالج الموضوعات نفسها، الأمر الذي يسوغ تداخلهما وتكاملهما؛ فـ «متى جاز وجود التشاكل بين علمين اثنين، لم يمتنع قيام تداخل بينهما، ليس بالضرورة على أساس نقْل العناصر من أحدهما إلى الآخر؛ وإنما على أساس مقايسة البنيات بعضها ببعض»(15)
وتظهر فائدة هذا الضابط في أن ما يَثْبت لعلْمٍ يثبت للعلم الآخر، وما يُنفى عن علم ينفى عن الآخر؛ بمقتضى تشاكلهما، الأمر الذي يفيد العلوم في الاختصار، بتجنب افتتاح معالجة مسائل تم تحقيقها في العلم المشابه، ويساعد على اتساع «البنية في الواحد منهما بالاسترشاد بما يقابلها في الثاني، فضلاً عن أن هذا التشاكل يسهل تحصيل العلمين فأكثر»(16)، دون أن يُفهم من ذلك أن تلك العلوم لا تتوفر على بنية خاصة تمتاز بها عن غيرها؛ فلا يسوغ تبعاً لذلك إذابة علمٍ في بوتقة علمٍ آخر لمجرد حصول نوع مشاكلة بينهما.
ثالثاً: ضابط الإفادة أو الإنتاج:
إن أيَّ تكامُلٍ بين عِلْمين فصاعداً يكون خِلْواً من خاصية الإفادة؛ فوضعه ـ باصطلاح الشاطبي ـ: «عارية»؛ أي وديعة ينبغي أن تُرد إلى مَحِلِّها؛ فمتى لم تنهض المسائلُ المستمدة بخدمة العلم المستمِد إثباتاً لحكْمٍ، أو شرحاً وتفسيراً لمستغلِقٍ فيه، أو إمداداً له بآلياتٍ منهجية ترفع مستوى إنتاجيته؛ فإهماله أوْلى من إعماله؛ لأنه لا تُستجلب به أية فائدة عِلْمية أو عملية.
ولقد دعا ابن حزم إلى الانفتاح على بعض العلوم اليونانية؛ لإفادتها في تحقيق مطالب كلامية نظرية، ومطالب فقهية عملية؛ فحَثَّ متطلبَ معرفةِ الباري سبحانه وحِكْمتِه على قراءة كتاب إقليدس قراءَة متفهمٍ؛ لأنه من العلوم الرفيعة التي يتوصّل بها «إلى معرفة نصبة الأرض ومساحتها وتركيب الأفلاك ودورانها ومراكزها وأبعادها، والوقوف على براهين كل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج، فهذا علم رفيع جداً يقف به المرء على حقيقة تناهي جرم العالم، وعلى آثار صنعة الباري في العالم، فلا يبقى له إلا مشاهدة الصانع فقط»(17)
كما رغَّبه في النظر «في الطبيعيات، وعوارض الجو، وتركيب العناصر، وفي الحيوان والنبات والمعادن، و [أن] يقرأ كتب التشريح؛ ليقف على محكم الصنعة، وتأثير الصانع، وتأليف الأعضاء، واختيار المدبر وحكمته وقدرته»(18)
أما الفقيه الذي ينظر في النصوص الشرعية ـ لاستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية ـ فينبغي أن ينفتح على عِلْم الحساب؛ ليستطيع تحقيق مطالبه الفقهية؛ كـ «قسمة الفرائض والمواريث، وأن يعرف من المَطَالع ما يعرف به أوقات الصلوات ودخول شهر رمضان ـ شهر الصوم ـ ووقت الحج...»(19)
والغرض أن حصول التكامل بين عِلْمين فصاعداً يجب أن يكون بناءً على حاجات علمية ملحة، لا على سبيل الترف أو التزويق؛ لما في ذلك من انشغال بالفضول وتضييع للأصول، وكفى بذلك تضييعاً لبنية العلم، وسلباً لوصف العلمية منه.
رابعاً: ضابطُ أخذِ المسائل المستمدة مسلماتٍ:
ويقضي هذا الضابط بأخذ المسائل المستمدة مسلمات دون خوض في براهينها؛ «ذلك أنه ما من عِلْمٍ من العلوم الجزئية إلا وله مبادئ تؤخذ مسلَّمة بالتقليد في ذلك العلم، ويُطلب برهانُ ثبوتها في علمٍ آخر.
فالفقيه يَنظر في نسبة فِعْل المكلَّف إلى خطاب الشرع، في أمره ونهيه، وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال الاختيارية للمكلفين... ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع، وأن لله كلاماً قائماً بنفسه هو أمرٌ ونهيٌ، ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله ـ تعالى ـ وثبوت الفعل من المكلف على سبيل التقليد، وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب، فيكون قد قام بمنتهى علمه»(20).
وبالرغم من عَدِّ جمعٍ غفير من مفكري الإسلام عِلمَ الكلام علماً كليّاً، أو هو بعبارة الإيجي «العلم الأعلى»(21)، الذي منه تُستمد العلوم، ولا يُستمد هو من غيره، فإنه يجب على صاحب العلم الجزئي ملازمةُ الاقتصاد في عملية الاستمداد منه، على نهجٍ لا تنطمس فيه معالم علمه الجزئي وتندرس؛ إذ التجاوز في إقحام مسائل علم في علمٍ يُوقع فيما سماه الغزالي في مستصفاه بـ «الخلط»(22)، وحدُّه: مجاوزةُ الحدِّ في سَوْقِ مسائلَ غيرِ منتِجةٍ في النسق الذي استُضيفت إليه.
وعليه، فإن التكامل المعرفي في فلسفته العامة يجافي استئناف معالجة القضايا المستمدة والتفصيل فيها استشكالاً واستدلالاً، ويحرِص على أن يحتفظ كلُّ علم ببنيته الموضوعية والمنهجية؛ ولذلك أرى ـ موافقاً حمو النقاري ـ أنْ تبقى العلوم النظرية «نظريةً فقط، وإن عرض لها أن كان موضوعها تنظر فيه أيضاً بعضُ العلوم العملية، أو كان بعضُ ما تشتمل عليه من أحكام متحققاً في عالم التجربة»(23).
خامساً: ضابط مراعاة ثقافة المتلقي المستهدف:
ويقضي هذا الضابط بضرورة مراعاة ثقافة المتلقي، الذي قد يَستهجن ـ بحكم الإلف ـ دمجاً لعلومٍ غريبة عن بيئته بعلومه الأصلية، فيكون واجبُ العالم حينئذٍ أن يتوسل بكافة الإجراءات الضامنة للتطبيع مع العلوم المنقولة على وجه الخصوص(24).
ولقد كان بعضُ مفكري الإسلام موفَّقين في ذلك إلى حدٍّ بعيد؛ فهذا أبو حامد لما رأى الهمم في عصره مائلةً من العلوم إلى الفِقه، بل مقصورة عليه؛ عمل ـ في سياق التكامل بين علوم الملة وعلوم الحكمة ـ على التمثيل للمنطق بالأمثلة الفقهية، إذ يقول في معيار العلم: «ولعلَّ الناظر بالعين العوراء ـ نظر الإزراء ـ ينكر انحرافنا عن العادات، في تفهيم العقليات القطعية، بالأمثلة الفقهية الظنية؛ فليكف عن غلوائه، في طعنه وإزرائه، وليشهد على نفسه بالجهل، بصناعة التمثيل وفائدتها؛ فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الخفي، بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد؛ ليقيس مجهولهَ إلى ما هو معلومٌ عنده، فيستقر المجهولُ في نفسه.
فإن كان الخطاب مع نجارٍ، لا يحسن إلا النجْر، وكيفية استعماله آلاته، وجب على مرشده ألّا يضرب له المثل إلا من صناعة النجارة؛ ليكون ذلك أسبق إلى فهمه، وأقرب إلى مناسبة عقله.
وكما لا يحْسُن إرشادُ المتعلم إلا بلغته، لا يحسن إيصال المعقول إلى فهمه، إلَّا بأمثلة هي أثبت في معرفته»(25).
وكذلك فَعَلَ ابنُ حزم في رسالته المشهورة في المنطق: التقريب لحدِّ المنطق.
لم ينشغل مفكرو الإسلام ـ في عملية تقريب بعض العلوم المنقولة ـ بالجوانب الضامنة لقواعد المجال الأصلي أن تُنقض، أو الحفاظ على بني العلوم أن تختلط بغيرها فقط؛ بل كانوا مرتبطين بواقعهم، مستشعرين ضرورة تقريب المنقول بطريقة تراعي الثقافة السائدة في المجتمع، فذلك أحرى أن يُؤْدَمَ بين المنقول والمأصول بزواجٍ سعيد، وأن يقبل في المجتمع.
وبهذا الاجتهاد الإبداعي أنجز الغزالي ـ ومعه ابن حزم ـ مشروعه في جَعْل المنطق معياراً لجميع العلوم، العقلية منها والشرعية؛ وذلك بسبب مراعاته لقواعد التكامل النظرية والتنزيلية.
3 ـ التكامل المعرفي بين الفلسفة والعلوم الإسلامية: بحـثٌ في المشروعية
لم ينشب أيُّ خلاف حول مبدأ تفاعل العلوم الإسلامية وتكاملها؛ وذلك لانتمائها إلى سياق تداولي واحد، ولتقارب موضوعاتها وأغراضها؛ وإنما أثيرت إشكالاتٌ تفصيلية تهُمُّ حدود توظيف تلك العلوم لبعضها. وليس الأمر كذلك حينما يقع تكاملٌ بين علوم لا تنتمي إلى السياق التداولي نفسه؛ ففي هذه الحالة يجب طَلَبُ المشروعية لذلك التكامل حتى يكتسب مقبوليةً داخل المجتمع.
منهجية مفكري الإسلام في تقريب الفلسفة من علومهم الأصلية:
سلك مفكرو الإسلام مسلكين اثنين في طلب المشروعية لتكامل الفلسفة مع علومهم الأصلية:
المسلك الأول:
كان منهجُ مفكري الإسلام في بناء مواقفهم من تقويم العلوم الأصلية والمنقولة، وبناء مواقفهم منها إعمالاً وإهمالاً: الإحاطةَ بها، ومعرفةَ مداركها أولاً؛ حتى لا يُتجنى عليها بحكمٍ مِنْ غير جهة العلم؛ يقول الغزالي في هذا المعنى: «فإن الوقوف على فساد المذاهب قبل الإحاطة بمداركها مُحالٌ، بل هو رميٌ في العماية والضلال»(26).
وبتأمل صنيع الغزالي ـ في تقويم العلوم الفلسفية وتقريبها من التداول الإسلامي ـ يلاحظ أن منهجه يقضي برفض إنكار العلوم دون التفتيش فيها؛ لما ينجم عنه من مفاسد كثيرة تجاوز العد؛ حيث يقول: «فلو فتحنا هذا الباب، وتطرقنا إلى أن يُهجَر كلُّ حقِّ سبق إليه خاطرٌ مبطل؛ للزمنا أن نهجر كثيراً من الحق، ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن، وأخبار الرسول، وحكايات السلف، وكلمات الحكماء والصوفية؛ لأن صاحب كتاب «إخوان الصفا» أوردها في كتابه مستشهداً بها، ومستدرجاً قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله، ويتداعى ذلك إلى أن يَستخرج المبطلون الحقَّ من أيدينا بإيداعهم إياه كتبهم»(27)
لأجل ذلك لم يتجه بالنقض على شيءٍ من علوم اليونان لا يصدم الدين، وقد ذكر في مقدمة تهافت الفلاسفة أنه لن يخوض في ذلك؛ «إذ لا يتعلق به غرضٌ، ومن ظنَّ أن المناظرة في إبطال هذا من الدين، فقد جنى على الدين وضعَّف أمره؛ فإن هذه الأمور تقوم عليها براهينُ هندسيةٌ حسابية، لا يبقى معها ريبة»(28)
وقد انتهى ـ في تقويمه للإنتاج الفلسفي اليوناني ـ إلى أن علومهم أربعة: الرياضيات، والمنطقيات، والطبيعيات، والإلٰهيات؛ فالرياضيات «نظرٌ في الحساب والهندسة، وليس في مقتضيات الهندسة والحساب ما يخالف العقل، ولا هي مما يمكن أن يقابل بإنكار وجحْدٍ، وإذا كان كذلك فلا غرض لنا في الاشتغال بإيراده.
أما الإلهيات: فأكثر عقائدهم فيها على خلاف الحق، والصواب نادر فيها.
وأما المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب، والخطأ نادر فيها؛ وإنما يخالفون أهل الحق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني والمقاصد؛ إذ غرضنا تهذيب طرق الاستدلالات، وذلك مما يشترك فيه النُظَّار.
وأما الطبيعيات: فالحقُّ فيها مشوب بالباطل، والصواب فيها مشتبه بالخطأ، فلا يمكن الحكم عليها بغالب ومغلوب»(29)
ومن ثمَّ فالغزالي هنا يؤسس لمشروعية تكامل العلوم التراثية الأصلية مع العلوم المنقولة ما دامت لا تتعرض بالنقض للأصول التداولية الإسلامية، عائباً على فئة مناوئة من المجتمع الإسلامي ردَّها حقائقَ في أسرار الدين بكونها من كلام الأوائل، ومع أن بعضها من مولدات الخواطر، وأن بعضها يتنزل بمنزلة وقوع الحافر على الحافر، مقرراً أن كلام الأوائل إذا كان «معقولاً في نفسه، مؤيداً بالبرهان، ولم يكن على مخالفة الكتاب والسُّنَّة؛ فلِمَ ينبغي أن يهجر ويترك؟»(30)
انطلاقاً من تلكم الرغبة، أكَّد على أن الحق في العلوم أحقُّ أن يُتبع، بغضِّ النظر عن مصدرية؛ فلا ينبغي أن يعاف العسلُ المصفى، «وإن وجد في محجمة الحجام»(31)؛ فاشتغل ـ في كتابه معيار العلم ـ على مشروع التقريب التداولي لبعض المعارف الفلسفية المنقولة عبر آلية التمثيل الفقهي؛ حتى تتلقى بالقبول في مجتمع سَبقتْ إليه أقاويلُ منفرةٌ من كل شيء غير «مأصول»، كما عمل ـ في كتابه القسطاس المستقيم ـ على استخراج الموازين المنطقية من القرآن الكريم، وذلك في سعْي حثيثٍ لبيانِ أن المنطق اليوناني ـ في بعض أبعاده التي تمثل قوانين الفكر العلمية ـ لا يناقض قواعد الإسلام.
ومن يُطالع كُتبَ مفكري الإسلام يجد أن انفتاحهم على العلوم اليونانية لم ينحصر في الاستمداد؛ بل تعداه إلى مستوى الإمداد، وبذلك كان لهم «فضل عظيمٌ جداً في تكوين التراث اليوناني: الصحيح منه والمنحول، وفي تحقيق النصوص الصحيحة الباقية لنا من هذا التراث باللغة اليونانية، وفي استرداد شيء مما فقد من هذا التراث... ولهذا فإن فضل العرب على التراث اليوناني ـ من كل نواحي الفضل ـ أكبر من فضل أية أمة أخرى»(32).
المسلك الثاني:
بالإضافة إلى المسلك السابق، انتهج مفكرو الإسلام أسلوباً آخر في طلب المشروعية؛ لتعلُّم الفلسفة وتوظيف بعض معطياتها في العلوم الأصلية، قائماً على بيان الفائدة العملية من وجهة نظر مقاصدية، ترقب مآلات توظيفها على الواقع؛ فقد بدا جلياً كيف أن الانفتاح على العلوم الفلسفية حصل استجابة لظروف تاريخية مشكلة مرَّ منها المجتمع الإسلامي، وعوائق إبستيمولوجية معرفية تتعلق بالعلوم نفسها.
فهذا أبو حامد الغزالي يؤلف كتابه المشهور فضائح الباطنية، قياماً بواجب الذود عن عقيدة المجتمع المسلم، وفيه يشير ـ من طرْفٍ خفيٍّ ـ إلى أن التكوين العلمي القائم على علْمٍ واحدٍ لا يفي بقيام العالم بواجباته تجاه مجتمعه، سواءٌ كان نصحاً له، أو ردّاً على الشبهات التي تُهدِّد عقيدة أفراده؛ حيث يقول: «رأيت المسارعة إلى الإذعان والامتثال في حقي من فروض الأعيان؛ إذ يقِلُّ على بَسيطِ الأرض مَنْ يستقل في قواعد العقائد بإقامة الحجة والبرهان بحيث يرقيها من حضيض الظن والحسبان إلى يفاع القطع والاستيقان؛ فإنه الخطب الجسيم والأمر العظيم الذي لا تستقل بأعبائه بضاعة الفقهاء، ولا يضطلع بأركانه إلا مَن تخصَّص بالمعضلة الزَّبَّاء(33)، لِما نَجَمَ في أصول الديانات من الأهواء، واختلط بمسالك الأوائل من الفلاسفة والحكماء، فمِنْ بواطن غيِّهم كان استمداد هؤلاء؛ فإنهم بين مذاهب الثنوية والفلاسفة يترددون، وحول حدود المنطق في مجادلاتهم يدندنون»(34).
فهو يرى أن المستأهل لهذه المعضلة العظيمة ينبغي أن يكون صاحب شخصية علمية، تداخلت في صياغتها علوم كثيرة؛ حتى يستطيع تحصين المجتمع من طوائف تُموِّهُ على العوام بتزويقات لفظية؛ إخفاءً لأصولها، فبيَّن ـ بحكم تكوينه التكاملي الموسوعي ـ أن عقائدهم متلقاةٌ من الفلاسفة وغيرهم.
والظن الغالب أنه ما كان لمشروع الغزالي في الرد على أهل البدع أن يَنجز لولا تكوينُه العلمي الموسوعي؛ إذ كُلَّما كان المشروع الفكري والمجتمعي للعالم أوسع مدى؛ اضطره ذلك إلى توسيع مداركه المعرفية والمنهجية.
وفي سياق تحصين الشخصية الإسلامية من الانجراف؛ فإن طائفةً من مفكري الإسلام لم تَرَ بأساً في مجرد مطالعة العلوم وإن لم تكن نافعة، من باب قول الشاعر:
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
فعِلْم النجوم ـ مثلاً ـ وإن كان خِلْواً عن الفائدة؛ فإن ابن حزم يرى ضرورة الاطلاع عليه؛ ليعرف الباحث أغراض أصحابه، «وليفيق من دعاويهم ومخرقتهم، ويزيل عن نفسه الهمَّ إذا عرف أنه لا فائدة فيه»(35)
هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى فإن صاحب التخصص العلمي الواحد لا يستطيع الوفاء بجميع مسائل علمه متى اكتفى بعلم واحد؛ لأنه يعزّ وجدانُ عِلْمٍ مستقل برأسه، لا يتكامل مع علوم أخرى. وكأن في العلوم فاقةً وعَوَزاً لا يرتفعان إلا بضم علوم أخرى إليها؛ يقول ابن حزم في حق صاحب التخصص الواحد: «وإنه إن لم يضف غيره من العلوم إلى علمه كان ناقصاً، لا يُنتفع به كبيرَ منفعةٍ؛ بل لعله يُستضر به جدّاً»(36).
حقيقة التكامل المعرفي بين الفلسفة وعلم الكلام:
لا تخطئ العينُ الفاحصة مدى التشابه الحاصل بين مواضيع الفلسفة في شقها الإلٰهي ومواضيع علم الكلام، وإن كانت طرائقُهما في تقرير المسائل مختلفة؛ كما أن كُلّاً منهما «ينزل من إحدى الثقافتين ـ المنقولة والأصلية ـ منزلة الآخر في الثقافة الثانية؛ فكلُّ واحد منهما علمٌ نظري، ويتبوأ في ترتيب العلوم النظرية في إحدى الثقافتين المرتبة التي يتبوأها الآخر في الثقافة الثانية؛ فمكانة الإلٰهيات من العلوم النظرية المنقولة كمكانة الكلاميات من العلوم النظرية الأصلية»(37)
فموضوع العلم الإلٰهي في الفلسفة كليٌّ هو «الوجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومبادئه، وينتهي في التفصيل إلى حيث تبتدئ منه سائر العلوم، وفيه بيان مبادئها»(38)، وعلم الكلام أيضاً ـ في عرف أهله ـ علم كليٌّ مُهِمَّتُه إثباتُ مبادئ العلوم الدينية كلها؛ «لأن المتكلم هو الذي ينظر في أعم الأشياء»(39)، وهو علم «ليست له مبادٍ تَبين في علم آخر، بل مباديه إما بيّنة بنفسها أو بيِّنةٌ فيه، فهي مسائل له، ومباد لمسائل أُخر منه لا تتوقف عليها؛ لئلا يلزم الدور؛ فمنه تستمد العلومُ، وهو لا يستمد من غيره، فهو رئيس العلوم على الإطلاق»(40).
لأجل هذا التشابه الكبير حصل تداخلٌ بينهما؛ فليس يخفى على مُطالع مصنـفات المتكلمين ـ ولا سيمـا المعتزلة(41) ـ تـأثُّرهُم الواضح بالفلسفة اليونانية؛ فقد مثلت الفلسفة بالنسبة لهم مَرْجعاً رئيساً في استمداد آليات الاستدلال وطرائق البرهان؛ لمواجهة الخصوم، سواء أكانوا أصحاب الملل الأخرى، أو الفرق الإسلامية المخالفة، أو الفلاسفة أنفسهم، كما أفادوا منها منهجياً في تقنين معارفهم وتنظيمها.
ورغم عدِّ الفلاسفةِ المسلمين الفلسفةَ حائزةً ـ بسبقها علوم الدين تفضيلاً، وإقرارهم أن مسالك الفلسفة أشرف؛ لأنها تعتمد البرهان، أما العلوم الشرعية ـ بما فيها علم الكلام ـ فمبناها على الطرق الخطابية والوعظية (42)؛ فإن الباحث يلحظ استفادتهم من العلوم الشرعية ـ ولا سيما علم الكلام ـ في مباحثهم الإلٰهية؛ إنْ استمداداً لمعطيات عقدية منه، بقصْد التوفيق بين مقتضيات العقيدة الإسلامية ومقتضيات النظر الفلسفي، أو تعقيباً ونقضاً لآرائهـم؛ كما أسهم علم الكلام ـ بحسب طه عبد الرحمٰن ـ «أيما إسهام في تهذيب المصطلحات الفلسفية، وتسهيل تداولها، عن طريق دمجها في العلاقات الدلالية والبنيات الاستدلالية الطبيعية، التي ينبني عليها التكلم باللغة العربية، حتى إننا نجد أن أوْفَقَ الفلاسفةِ تعبيراً فلسفياً أكثرُهم دربةً على لغة الكلام»(43).
وجديرٌ بالبيان أن منهجية تكامُلِ الفلسفة مع علم الكلام تختلف عن منهجية تكامله معها؛ فالفلاسفة دمجـوا مقتضيات العقيدة الإسلامية في الفلسفة، أو قُلْ ـ بعبارة أخرى ـ: إنهم جعلـوا الفلسفة حاكمة على غيرها، وليـس العكس؛ فانتـهى بهم ذلك ـ رغم حرصهم على الموافقـة بيـن مقتضيات العقيدة الإسلامية والمقتضيـات الفلسفية ـ إلى تمحلات تقريبية، وشذوذات عقدية، كالقول بقدم العالم، وعلم الله تعالى بالكليات دون الجزئيات.
أما المتكلمون ـ ممثلين للعلوم الإسلامية ـ فدمجوا العلوم المنقولة في العلوم الإسلامية؛ لأنهم عايروا المنقول الأجنبي بمعيار العلوم الأصلية. والقاعدة أنه إن كان عِلْمان، وكان «أحدهما أصلياً والآخر منقولاً، فإن دمْج العِلْم الأصلي في العلم المنقول من شأنه أن يَبْعُدَ عن مجال التداول الأصلي؛ بينما دمج العلم المنقول في العلم الأصلي من شأنه أن يقرُبَ إلى هذا المجال»(44)
والخلاصة الجامعة: أنه لا مانع من الانفتاح على العلوم الفلسفية، ما دام الباحث فيها ينظر نظرَ متبصر بمسائلها، عارضاً إيّاها على «قواعد المجال التداولي اللغوية والعقدية والمعرفية»؛ حتى يستطيع استخراج الترياق من سُمِّ الأفعى، لا نظرَ مقلد مُسْتَلَبِ الشخصية، مهملٍ لقواعد مجاله الأصلي، معتقدٍ أن ما قاله الفلاسفة يستحيل أن يكون غير صحيح، بناءً على حُسْنِ الظن فيهم؛ لأنهم أرباب الصنائع النظرية.
أما ما يلاحظه بعضُ المغْرِضين في كتب التراث من زَجْرٍ عن ممارسة العلوم الفلسفية، أو نقْضٍ لبعض مقولاتها(45)؛ فينبغي أن يُفهم في سياقِ سَدِّ الذريعة على مَنْ كان ركيكَ العقل، لا مِرَان له بها، ولا دراية عنده بغوائلها؛ لئلا يتطرق إليه طارقُ الآفات، فينخلع من الدين أسوةً بالفلاسفة. وقد أكد الغزالي هذا المعنى بقوله: «فهذه آفة عظيمة، لأجلها يجب زجْرُ كلِّ مَنْ يخوض في تلك العلوم؛ فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين، ولكن لما كانت من مبادئ علومهم سرى إليه شرُّهُم وشؤمهم، فَقَلَّ مَنْ يخوض فيها إلا وينخلع من الدين، وينحلُّ عن رأسه لجامُ التقوى»(46)
انتقال المفاهيم ورحلتها أثر من آثار التكامل المعرفي بين الفلسفة وعلم الكلام وعلم أصول الفِقه: مفهوم العلة أنموذجاً
يُعدُّ انتقال المفاهيم ورحلتها أبرزَ نتيجةٍ للتكامل المعرفي الذي حصل بين الفلسفة وعلم الكلام وعلم أصول الفقه. واعتناء الورقة بهذا الأثر دون غيره من الآثار ليس من باب التمثيل أو الاختصار فحسب؛ بل لأهمية المفاهيم القصوى؛ إذ تكاد وظيفةُ العلوم تُختصر في توليد المفاهيم؛ فالفلسفة مثلاً: «هي فن تكوين وإبداع، وصنع المفاهيم»(47)؛ ومن ثمَّ فمن أراد تحصيل علم من العلوم، فينبغي أن ينظر أولاً في مفاهيمه ويُحكِمها، ومَنْ رَغِبَ في تقويم علْم، فيجب أن يتجه رأساً إلى مفاهيمه؛ لأنها عتباته، ومن أحبَّ أن يبلغ في علم شأواً بعيد المدى، فعليه الإسهام في إبداع مفاهيمه.
وبالرجوع إلى موضوع المحور؛ فإن رحلة المفاهيم بين العلوم ليست محض خلط تزويقي لا مبرر له، أو انحرافاً منهجياً بالعلوم عن مسارها الحقيقي، أو اختراقاً لها؛ بل إنها عملية تتم ـ أو يجب أن تتمّ ـ وفق رؤية منهجية تطرد «توقيع أصحابها»(48)؛ ذلك أن المفهوم لا يرحل من حقلٍ معرفي إلى آخر بوصفه مجرد لفظة بريئة، وإنما يحمل معه نمط توظيفه الأول، ويسترجع دائما ذكريات ولادته الأولى.
ولقد قرر جيل دولوز وفليكس غتاري ـ نقلاً عن نيتشه ـ أن الفيلسوف ينبغي أن يعوّض ثقته بالمفاهيم بالحيطة، «ما دام لم يبتكرها هو نفسه»(49)، وهذا يقضي بضرورة وضعها تحت مجسات عملية تُلاحظ بدقة خلفياتها المضمرة والدقيقة، وتتنبأ بنتائج توظيفها في المجال الجديد، والعمل تبعاً لذلك على إدخال تعديلات جذرية عليها، حذفاً وزيادة، توسيعاً وتضييقاً (50)، ليس لغرض طمس هويتها الأولى أو مسخها؛ بل من أجل تأمين إنتاجيتها داخل السياق الجديد، وعدم إضرارها ببنية الحقل المعرفي المستضيف، أو بقواعد المجال التداولي عموماً.
إن المفهوم لا يقف عند حدود النظر إلى المفهومية بمعناها المبتذل؛ أي بيان المعنى وتوضيحه؛ بل يفتح مساحات استشكالية واستدلالية تبرز فيها إجرائيته(51). وكذلك الأمر بالنسبة لمفهوم العلة؛ فقد أبرز قدرة إنتاجية عالية، سواء في تفاعله مع مفاهيم أخرى، أو توليده لاستشكالات وأحكام كثيرة في الفلسفة وعلم الكلام وعلم أصول الفِقه.
وفيما يأتي تعقب لانتقال مفهوم العلة من المجال الفلسفي إلى المجالين الكلامي والأصولي، بوصفه أثراً للتكامل المعرفي بين تلك الحقول، ورصداً لمنهجية تقريبها التداولي؛ تحليةً بمعطيات جديدة، وتخليةً من عناصر من شأنها معارضة قواعد المجال الأصلي، كل ذلك في نهاية الاقتضاب.
أ ـ مفهوم العلة عند الفلاسفة:
تُعَدُّ العلّة من «المفاهيم الرحّالة» التي اعتنى بها الفكر الإنساني عموماً؛ ذلك أنها تكاد تحضر في كل ممارسة عقلية، فأدنى عقل بشري يعتقد أنه لا يوجد شيء من دون علة، ويميل إلى ربط المعلولات بعللها. ولقد سبق الفلاسفةُ اليونان إلى دراستها؛ لكن تصوّرهم لها لم يبلغ النهاية في الشمول، بحيث يصير ملزماً لكل الأمم، فقد تضمّن جوانب موضوعية يمكن التجوز في وصفها بالكونية، وتضمن في المقابل جوانب ذاتية لا يصح تعميمها على جميع الأُمم.
وبالرجوع إلى المرحلة اليونانية ـ التي انعكست تصوراتها على مشارب علمية مختلفة في التداول الإسلامي ـ نلاحظ إرهاصات أولية لتشكل المفهوم، تجلّت في مواقف جزئية ومضطربة لفلاسفة
كُـثر قـبل أرسطـو Aristote (384 ـ 322 ق.م): كطـاليس Thales (624 ـ 546 ق.م)، وانكسيمندر Aniximander (610 ـ 547 ق.م)، وانكسيمانس Aniximenes (588 ـ 475 ق.م)، وهيراقليطس Heraclitus (540 ـ 475 ق.م)، وأمباذوقلـيس Empedocles (490 ـ 430 ق.م)، وديمقـريطس Democritus (470 ـ 361 ق.م)...
لكنّ ظهور المفهوم واستواءه على نهج دام لقرون ـ إن لم نقل إلى عصرنا الحالي ـ كان مع أرسطو(52)، الذي عمل على نقد مواقف مَنْ سَبَقَهُ ودراستها، وحاول إذابة ما تفرق عند آحادهم في بوتقةٍ نظرية متسقة (53).
وقد احتفى أرسطو بمفهوم العلة أيما احتفاء، وأسس عليه مذهبه الفلسفي عموماً؛ فعرض لها في الفلسفة الأولى، وفلسفة الطبيعة، والمنطق، وخصص لها حيزاً مهماً في كتاباته. كما عدّها أهم مسلكٍ موصل إلى العلم(54)؛ فالمعرفة الحقيقية عنده ليست تلك التي تكتفي بوصف الجزئيات؛ بل التي تحيط خُبراً بأسبابها وعللها.
وإذا كان الفلاسفة السابقون لأرسطو قد ركّزوا على نوعٍ واحدٍ من العلل هي العلل المادية، وفسروا بها الكون، وإن كانوا قد اختلفوا في تعيين طبيعتها ـ بين قائل: إنها الماء، وقائل: إنها الهواء، وقائل: إنها النار، وقائل: إنها الأرض، وذاهب إلى أنها ـ مجتمعةً ـ علّةُ الطبيعة، كما أن منهم مَنْ افترض علة خارجية هي التي تحرك تلك العناصر، ومن عدَّ تلك العلل تعمل آلياً وذاتياً دون غائية (55) ـ فإن تصوُّرَ أرسطو للعلّة جاء أكثر شمولية، فجعل العلة أربعة أنواع: العلّة الهيولية أو المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية (56)؛ لكن هذه الأربع «إذا أضيفت تصير أقل»(57)؛ وذلك بإرجاع ثلاث عللٍ إلى واحدة؛ أي بالمزج بين العلل الصورية والغائية والفاعلة، وجمعها في علة هي الصورة؛ فالفاعل لا يفعل إلّا من أجل شيءٍ هو الغاية، والغاية هي النهاية أو الصورة، أو قُل: الوجود المكتمل الذي تستهدفه الحركة، ومن ثمَّ فالصورة تشمل العلتين: الفاعلة والغائية.
والملاحظ أن تنقيص العِلل تمهيد لمنظور أرسطو الميتافيزيقي؛ لأن العِلل لا تتناسل إلى ما لا نهاية، بل لها نهاية تسير نحوها، هي الصورة أو المثال النهائي الذي تتجه نحوه جميع الأشياء(58).
وحري بالذكر أن أرسطو يُدخل البَخْت وتلقاء النفس في عداد الأسباب العرضية، ويتعجب من نفي فلاسفة البخت وتلقاء النفس عن عالم الحيوان، وإقرارهم أن لها سبباً، في مقابل اعتقادهم أن السماء والأجسام المرئية الإلٰهية إنما كانت من تلقاء أنفسها. وموضع العجب في هذه المقالة تجويز وقوع العوالم العليا بالبخت، وهي متناهية الدقة، جارية على سنن واحدة، وإثبات علل للأشياء الطبيعية، مع أنها، أحياناً، تند عن النظام فيقع اختلال في تكونها...(59)
هذا ـ بإجمالٍ شديد ـ أبرزُ ما عرَضَ له أرسطو في معالجته للعلّة، ولقد اتبع الفلاسفة المسلمون هذا التصور حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة، وأعملوا معطياته بحذافيرها في مباحث الطبيعيات والمنطقيات والإلٰهيات، خلا تعديلاتٍ طفيفة إذا قورنت بالقضايا المستمدة لم تَعد شيئاً.
والملاحظ أن سؤال مشروعية استجلاب مفاهيم من سياقات تداولية أجنبية كان مصاحباً للفلاسفة المسلمين؛ يقول الكندي ـ في معرض تقريره العلة ـ : «وينبغي ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا والأُمم المباينة لنا؛ فإنه لا شيء أولى بطالب الحقّ من الحق»(60) وهذا ما يشير إلى أن إكراهاتٍ ما فرضت تبرير أو قُل: استحسان اقتناء مباحث علمية من مجالات تداولية أجنبية.
ولأهمية مفهوم العلّة ـ ومركزيته في الفلسفة ـ أفرده بعض الفلاسفة المسلمين برسائل خاصة؛ بينما خصّه آخرون بفصولٍ ضِمْن كُتبهم. وقد بيّن الفارابي أنه بعد استيفاء الصنائع العملية والعامية؛ تشتاق النفوس إلى معرفة أسباب الأمور المحسوسة التي استنبطتها الصنائع العملية، فينشأ البحث عن علل هذه الأشياء(61)
ونبَّه إلى أن هناك تفاصيل كثيرة متعلّقة بالعلّة، سَلَكَ فيها الفلاسفة المسلمون مسلك أرسطو(62)، ليست الدراسة مجال بسطها؛ وإنما أجتزئ بذِكْر أثر توظيف هذا التصور على مباحثهم الإلٰهية، وأُشير إلى تعديلات وتكييفات قليلة أدخَلوها على التصور الأرسطي للعلة:
إن التصور الأرسطي للعلة ليس موضوعياً أو بريئاً كما يبدو ببادئ النظر؛ فقد أسهم في تشكّل مقولات ميتافزيقية، بدءًا من منهجية إثبات وجود الله تعالى؛ فإذا كان المتكلمون يَسْلُكون في ذلك منهجاً قائماً على الاستدلال بحدوث الأجسام والأعراض ـ أي الاستدلال بالمعلول على العلة ـ فإن الفلاسفة ينتحون طريقاً آخر، رأوه أشرف وأوثق من سابقه، مستدلين بالوجود نفسه، بناءً على التصور العلي الأرسطي(63)
وقد استعان ابن سينا ـ ومعه الفلاسفة المسلمون ـ بفكرة الوجود وتقسيمه إلى قسمين: ممكن وواجب؛ لإثبات وجود الله تعالى؛ حيث يقول: «لا شك أن هنا وجوداً، وكل وجود فإما واجب وإما ممكن»(64) وانطلق من هذا التصور الثنائي للوجود موظِّفاً التصور العلي؛ ليقرر أن الشيء إما أن يكون وجودُه بعِلَّةٍ أو يكون بذاته، فإن كان بذاته فهو واجب الوجود لا ممكن، وإن كان بعلّة فعلَّتُه معه لا محالة... فإنه إن لم يقف عند علّة واجبة الوجود حصلت علل ومعلولات ممكنة، إما بغير نهاية وإما دائرة؛ فظهر أن إثبات انتهاء الوجود إلى واجب الوجود يقوم على مقدمتين: إبطال التسلسل، وإبطال الدور؛ لأن «العلل لا تذهب إلى غير نهاية، ولا تدور»(65)
إن هذا الخلاف المنهجي ـ حول إثبات واجب الوجود ـ لا يقارن بفداحة مواقف عقدية صريحة المخالفة للنصوص الشرعية، ناتجة عن الوفاء للتصور الأرسطي للعلّة، أذكر منها اثنين دون تعقيب عليهما؛ لإسهاب المتكلمين في نقضها:
الأول: علم الله تعالى بالجزئيات: فواجب الوجود ـ بحسب الفلاسفة ـ يعلم الأشياء لكن على نحو كلي لا جزئي؛ لأنه يعرف ذاته، ويعرفها سبباً للموجودات، ويعرف ما يلزم عن ذاته من جزئيات، كل ذلك يعرفه لكن بعلله وأسبابه؛ إذ إن العلم بالأسباب لا يتغيّر؛ بل يكون كليّاً؛ لأن لكل سبب جزئي مشخـص مبدأً كليّاً يستند إليه(66)
وعليه، فلا يجوز أن يعقل واجب الوجود الأشياء من الأشياء، وإلا كانت ذاته منفعلة بما يعقل، فيكون تقومها بالأشياء، ولأنه إذا عقل المتغيرّات ـ من حيث هي متغيرات ـ فيكون علمه زمانياً ومستحيلاً ومتغيراً، «فتارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة ـ وتارة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة، ولكل واحدٍ من الأمرين صورة عقلية على حِدَةٍ، ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية، فيكون واجب الوجود متغيّر الذات»(67)
الثاني: القول بقدم العالم: وقد نتج عن القول بمبدأ العلية الأرسطي، القاضي بالتلازم الحتمي بين العلّة والمعلول، دون أن ينقضي بين وجودهما زمان؛ فالعالم أبديٌّ قديم مساوق لواجب الوجـود في الوجـود؛ لأنه إذا وجد واجب الوجود ولم يصدر عنه العالم، ثم حدث بعد ذلك، فيلزم عن ذلك أقاويل تنافي تنزيه الباري: من عدم وجود المرجح ثم طروئه، وفقدان آلة ثم وجدانها، وغيرهما من الأقاويل المفيدة طروء التغيّر على الباري سبحانه(68)
لكنهم لم يقولوا بالقدم المطلق للعالم؛ بل ميّزوا بين نوعين فيه، وإذا علم أن العلة تتقدّم المعلول، وعلم معه أن الله علّة لوجود العالم، فيلزم كون العالم متأخراً عن الله؛ لكنه يرى أن تقدّم العلّة في وجود الذات لا في الزمان؛ يقول في ذلك: «لأن كل علّة أقدم في وجود الذات من المعلول، وإن لم يكن في الزمان، فلكل واحد منهما في الذات شيء آخر يقوم به أقدم من ذاته، وليس ذات أحدهما أقدم من ذات الآخر»(69)
والملاحظ في كلا المثالين أن الفلاسفة المسلمين راموا تنزيه الذات العلية، وقاموا بمحاولات للتأليف بين الفلسفة ومقتضيات العقيدة الإسلامية؛ لكن ذلك تمّ انطلاقاً من أرضية يونانية غير إسلامية، كما سبقت الإشارة.
وبالقدوم إلى التعديلات والتكييفات التي أدخولها على التصور الأرسطي للعلّة تجدها قليلة محتشمة، منها: اجتهادهم في تكييف التصور الأرسطي للعلل لينسجم مع مقررات عقدية إسلامية؛ فميّزوا ـ مثلاً ـ بين نوعين من الفاعل: فاعل حقيقة، وفاعل مجازاً؛(70) يقول ابن سينا: «ولا شك أن المهيئ مبدأ الحركة؛ والمتمم أيضاً هو مبدأ الحركة؛ لأنه المخرج بالحقيقة من القوة إلى الفعل»(71)، فعبارته «المخرج بالحقيقة» تفترض مخرجاً آخر بالمجاز، كما يفهم من كلمة «المطلقة» في النصِّ الثاني علة أخرى نسبية، وإشارتهم في مبحث البخت وتلقاء النفس إلى أمور تؤكد العناية والتدبير الإلٰهيين(72).
ومنها توظيفهم مبدأ ربط العلل وتنقيصها الأرسطي منهجياً، دون أن يأخذوا بجميع لوازمه؛ فأعلوا من قيمة الغائية، مُرْجعين الفاعلة والصورية إليها، خلافاً لأرسطو الذي ردَّ تلك العلل الثلاث إلى الصورة، ولعلَّ ذلك راجع إلى استحضارهم خصوصية التداول الإسلامي، الذي يحظى فيه التفكيرُ الغائي بمكانة سامقة، ولأن ذلك يخدم تصورهم عن واجب الوجود لذاته؛ فقد عدُّوه الفاعل والغاية من خلال قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: 3]؛ «فهو أول لفعله، وآخر لغاية؛ وغايته هي ذاته؛ ولأن مصدر كل شيء ومراجعه إليه»(73). ولو جعل الباري صورة أو مادة لأّدى ذلك به إلى إبطال ثوابت عقدية.
نقد وتقويم:
اعتقد الفلاسفة المسلمون بأن مفهوم العلة ـ كما قرره أرسطو ـ غير مختصّ به، بل إنه مفهوم كوني عالمي، مركوز في جميع الفطر الإنسانية، فلم يقوموه بالاحتكام إلى قواعد التداول الإسلامي، ولم يروا ضيراً في توظيف معطياته في تقرير مسائل عقدية إسلامية، وجهلوا أو تجاهلوا ـ اغتراراً بأرسطو ـ أن تصوره للعلّة كان يحمل معه نمط وظيفته في موطنه الأول، فنتج عن ذلك القول بمقولات مستشنعة عقدياً، كالقول بقدم العالم، ونفي علم الله تعالى بالجزئيات.
ب ـ العلة عند المتكلمين:
لقد استمد علم الكلام مفاهيم كثيرةً من الفلسفة، واستطاع ـ في الجملة ـ النجاح في استدماجها في التداول الإسلامي؛ وتُعدُّ العلّة إحدى أهم المفاهيم التي انتقلت من الفلسفة إلى علم الكلام، مثيرة نقاشات حادة، لا سيما بين المعتزلة والأشاعرة.
ولمركزيتها وسطوتها على الفكر الإنساني، تنامى عند بعض المتكلمين وعيٌ بضرورة تكييفها مع المجال التداولي الأصلي؛ وذلك بتخليتها من الرواسب التي من شأنها نقض أصل ديني، وتحليتها بمعطيات جديدة؛ لتستجمع في النهاية شرائط تنزيلها على المجال الإسلامي.
أما المعتزلة فقد تبنوا كثيراً من المعطيات الفلسفية، من قبيل إقرارهم قانونَ التلازم العلي الذي ينطبق على العالم الطبيعي؛ إذ من كل موجود من الموجودات إلا وله خواص يضطر إلى الانسجام مع قوانينها. ورأوا ـ تفريعاً على أصلهم في القول بوجوب الأصلح، والتحسين والتقبيح العقليين ـ تعليل أفعال الله تعالى، ذاهبين إلى أنه ـ سبحانه ـ لا يجوز أن يفعل شيئاً جزافاً؛ بل لا بدَّ أن يكون له داع أو غاية، وإن كان لا يفعل لداعي الحاجة؛ بل لداعي الحكمة. وذلك لا ينافي غناه سبحانه(74)
ورغم موافقة المعتزلة الفلاسفةَ في مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالعلة؛ فإنهم لم يقبلوا بلوازمها كاملة، لا سيما إذا كانت تتعرض بالنقض لأصل عقدي ثابت بالنصوص الشرعية. من ذلك رفْضُهم تسمية الباري ـ سبحانه ـ علّةً، ولقد أشار إلى ذلك موسى بن ميمون ـ توفي 603هـ ـ قائلاً: «الفلاسفة ـ كما علمت ـ يسمون الله تعالى العلة الأولى والسبب الأول، وهؤلاء المشهورون بالمتكلمين يهربون من هذه التسمية جدّاً، ويسمونه الفاعل، ويظنون أن فرقاً عظيماً بين قولنا: سبب وعلة، وبين قولنا: فاعل.»(75) وما ذاك. إلا لِمَا يلزم عنه من وجوب ثان معه، والقول بقدم العالم؛ فـ «الأحكام إنما تصدر عن العلل، والله تعالى ليس بعلة؛ لأنه لو كان كذلك ـ ومعلوم أن المعلول لا ينفكّ عن علته ـ أدى إلى وجوب ثان معه فيما لم يزل»(76)
أما الأشاعرة فرغم إنكارهم العلة والتعليل؛ خوفاً من التَّضَمُّخ بعقائد الفلاسفة والمعتزلة؛ فإن المطلع على كتبهم يجد أنهم عالجوا مسائل العلة، وعمل بعضهم على تقريبها من التداول الإسلامي؛ فقد عمل أبو حامد الغزالي ـ وهو المفكر الأشعري ـ على تكييف التصور العلي الأرسطي، وتنسيبه إلى المجال التداولي الإسلامي عبر آلية التمثيل الفقهي؛ فبيّن أن العلل الأربع وتقاسيمها تجتمع في كل ما له علة، وكذا في الأحكام الفقهية، ممثلاً لكل واحدة من الفِقه(77)؛ حيث يقول: «هذه العلل تجتمع في كل ما له علة، وكذا في الأحكام الفقهية... فإذا فرض النكاح: فالزوج أهل، والبضع محل، والحل غاية، وصيغة العقد كأنها الصورة. وما لم تجتمع هذه الأمور لا يتمّ النكاح»(78).
وهذا الجهد التقريبي لا يعني تبنيهم المطلق للتصور الفلسفي للعلّة، فقد أحالوا ـ خلافاً للمعتزلة ـ مبدأ الحتمية بين العلل ومعلولاتها؛ احترازاً من نفي الفاعلية عنه سبحانه(79)، مقترحين مصطلح الأمارة (80) بديلاً؛ لعدم إفادته لأي تلازم عقلي ضروري بين الأشياء، وما يلاحظ من تكرار بعض الأشياء؛ فهو واقع على جهة الإمكان لا الضرورة؛ فلا علاقة بين الحوادث إلا بإجراء العادة لحكمة أرادها الله من ذلك.
كما رفضت طائفةٌ لا يُستهان بها من الأشاعرة تعليلَ أفعال الله تعالى؛ لاستلزامه نفْي الكمال الإلٰهي؛ فلو كانت له بواعث على الفعل لاستلزم ذلك النقصَ والاحتياجَ، واستكمالَ الذات بحصول تلك الأغراض والبواعث(81). وإن كانت طائفة منهم تجوز تعليل أفعاله تعالى بالحكمة فيما يرجع فيه الصلاح للناس، لا على وجه الوجوب(82)
والخلاصة أن الأشاعرة قاموا بتثوير الفكر الكلامي، حينما أبدعوا تصورات لم يسبقوا إليها انطلاقاً من مفهوم العلّة؛ لعلَّ أهمها قولهم ـ في سياق إحالة الحتمية بين العلة والمعلول ـ: إن العلل لا توجب بذاتها، وإنما توجب بجعل الله تعالى لها كذلك؛ إذ لو كانت موجبة بنفسها؛ لكانت كلما تكررت وكثرت؛ تكررت المعلولات وكثرت، وَفقاً لقانون زيادة النتيجة مع زيادة السبب، وهذا غير حاصل.
.....
الهوامش:
(1) انظر: ميزان العمل، ص 227.
(2) انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 75، 76.
(3) الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق وتعليق: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط 1، 1981م، ج 1، ص 7.
(4) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق: حمد الكبيسي، مطبعة الرشاد، 1390هـ/1971م، ص 7.
(5) أبو الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي، كتاب لباب العقول في الردِّ على الفلاسفة في علم الأصول، تقديم وتحقيق وتعليق: فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة، مصر، ط 1، 1977م، ص 8.
(6) أبو الوليد بن رشد، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي، تصدير: محمد علال سيناصر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1، 1994م.
(7) المستصفى، دراسة وتحقيق: حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، جدة، دون تاريخ، ج 1، ص 30.
(8) معيار العلم، ص 60، وانظر توظيف الغزالي المنطق فيما عبر عنه بالبراهين العقلية الجارية في المسائل الفقهية في كتابه: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 435.
(9) تعرضتُ بتفصيل لهذه المسألة في كتابي: مسالك التعليل عند الإمام أبي حامد الغزالي: جمعاً ودراسةً وتحليلاً، مرجع سابق.
(10) تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 128.
(11) انظر: تهافت الفلاسفة، ص 85.
(12) حمو النقاري، نظرية العلم عند أبي نصر الفارابي، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2011م، ص 161.
(13) استفدت هذا الضابط من نص الغزالي الآتي: «ثم إني ابتدأت ـ بعد الفراغ من علم الكلام، بعلم الفلسفة ـ وعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم مَنْ لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته؛ فيطلع على ما يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة»، المنقذ من الضلال، ص 74.
(14) أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاهرة، مصر، 1387هـ/1968م، ج 3، ص 18.
(15) تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 129.
(16) المرجع السابق نفسه.
(17) مراتب العلوم، ص 69.
(18) المصدر السابق، ص 72.
(19) المصدر السابق، ص 87.
(20) المستصفى، ج 1، ص 16، 17.
(21) عضد الدين عبد الرحمٰن بن أحمد الإيجي، كتاب المواقف، بشرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: عبد الرحمٰن عميرة، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 1، 1417هـ/1997م. ج 1، ص 43.
(22) انظر: المستصفى، ج 1، ص 27.
(23) نظرية العلم عند أبي نصر الفارابي، مرجع سابق، ص 161.
(24) يقول الغزالي في سياق تفهيم ما خفي من قوانين النظر العقلي: «وأضرب لك مثلاً من الفقهيات، فلعله أقرب إلى فهمك...»، القسطاس المستقيم، قرأه وعلق عليه: محمود بيجو، المطبعة العلمية، دمشق، 1413هـ/1993م، ص 44.
(25) معيار العلم، ص 61.
(26) مقاصد الفلاسفة،، تحقيق: محمود بيجو، ط 1، 1460هــ/2000م، ص 10.
(27) المنقذ من الضلال، ص 88.
(28) تهافت الفلاسفة، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط 6، بدون تاريخ، ص 80.
(29) مقاصد الفلاسفة، ص 10، 11.
(30) المنقذ من الضلال، ص 88.
(31) المصدر السابق، ص 89.
(32) عبد الرحمٰن بدوي، الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية: 1، دار المعارف، سوسة، تونس، بدون تاريخ، ص 10، 11.
(33) الداهية الشديدة.
(34) فضائح الباطنية، حققه وقدّم له: عبد الرحمٰن بدوي، دار القومية، القاهرة، 1383هـ/1964م، ص 4.
(35) مراتب العلوم، ص 71.
(36) المصدر السابق، ص 87.
(37) تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 142.
(38) المِلل والنِحل، ج 3، ص 18.
(39) كتاب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول، ص 8.
(40) كتاب المواقف، ج 1، ص 43.
(41) يقول الشهرستاني: «ثم طالع بعد ذلك شيوخُ المعتزلة كتبَ الفلاسفة حين فًسِّرت أيام المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام، وأفردتها فنّاً من فنون العلم وسمتها باسم الكلام»، المِلل والنِحل، ج 3.
(42) انظر: أبا نصر الفارابي، كتاب الحروف، حققه وقدّم له وعلّق عليه: محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط 2، 1990م، ص 153.
(43) تجديد المنهج في تقويم التراث، ص 145.
(44) المرجع السابق، ص 126.
(45) انظر مثلاً: عقيل يوسف عيدان، شؤم الفلسفة: الحرب ضد الفلاسفة في الإسلام، دار العين للنشر، القاهرة، مصر، ط 1، 1431هـ/2010م. والكاتب من أول صفحة فيه إلى آخر صفحة فيه يتحامل على المفكرين المسلمين، الذين قاموا بنقض بعض المقولات الفلسفية التي رأوا فيها ضرباً من الإخلال ببعض قواعد المجال التداولي الإسلامي.
(46) المنقذ من الضلال، ص 80.
(47) جيل دولوز، فليكس غتاري، ما هي الفلسفة، ترجمة ومراجعة وتقديم: مطاع صفدي وفريق مركز الإنماء القومي، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، اليونيسكو ـ باريس، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط 1، 1997م، ص 28.
(48) المرجع السابق، ص 30.
(49) المرجع السابق، ص 31.
(50) راجع: طه عبد الرحمٰن، فقه الفلسفة: القول الفلسفي: كتاب المفهوم والتأثيل، المركز العربي الثقافي، المغرب، لبنان، بيروت، لبنان، ط 3، 2008م، ج 2، ص 120. ومحمد مفتاح، المفاهيم معالم: نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط 1، 1999م، ص 15.
(51) أصل هذه الفكرة عند: طه عبد الرحمٰن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط 3، 2014م، ص 308، 309.
(52) وقد اعتبر الباحث ولتر ستيس تصور أرسطو للعلّة أكثر رحابة من التصور الحديث؛ لأن بعض التعاريف تقصي بعض العلل، كما هو الأمر بالنسبة لتعريف الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت مل للعلة. ولعل هذا مبرر بكون العلم الحديث لا ينظر إلى هذه العلل لعدم ارتباطها بمجاله. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، مجد ( = المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)، بيروت ـ لبنان، ط 2، 1425هـ/2005م، ص 176.
(53) راجع: تعقيب أرسطو على من سبقه من الفلاسفة في حيثية العلة: المقالتين الأولى والثانية من كتاب ما بعد الطبيعة، وكتاب الطبيعة، عند الحديث عن البخت وتلقاء النفس.
(54) انظر: أرسطو، ما بعد الطبيعة، اللاذقية، دار ذو الفقار، ط 1، 2008م، ص 10، ومنطق أرسطو، تحقيق وتقديم: عبد الرحمٰن بدوي، الكويت، وكالة المطبوعات، لبنان، دار القلم، ط 1، 1980م، ج 2، ص 431.
(55) انظر: ما بعد الطبيعة، ص 16.
(56) انظر: أرسطو، الطبيعة، ترجمة: إسحاق بن حنين، مع شروح: ابن السمح، ابن عدي، متى بن يونس، أبي الفرج بن الطيب، حققه وقدم له: عبد الرحمٰن بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1404هـ/1984م، ج 1، ص 101، 102.
(57) ما بعد الطبيعة، ص 87.
(58) انظر: ما بعد الطبيعة، ص 85، الطبيعة، ج 1، ص 141.
(59) انظر: الطبيعة، ج 1، ص 115، 116.
(60) رسائل الكندي الفلسفية، حققها وخرّجها وأخرجها: عبد الهادي أبو ريدة، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، جامعة فرانكفورت، ألمانيا، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1419هـ/1999م، ص 103.
(61) انظر: كتاب الحروف، ص 150.
(62) انظر: السماع الطبيعي، تحقيق: جعفر آل ياسين، لبنان، دار المناهل، ط 1، 1417هـ/1996م، ص 111.
(63) عقد ابن سينا فصْلاً بيّن فيه ضعْف دليل المتكلمين: «فصلٌ في أن علة الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث على ما يتوهمه ضعفاء المتكلمين». النجاة، تحقيق: محمد عثمان، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، ط 1، 1434هـ/2013م، ص 269.
(64) المصدر السابق، ص 298.
(65) المبدأ والمعاد، تحقيق: محمد عثمان، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، ط 1، 1434هـ/2013م، ص 52.
(66) انظر: النجاة، ص 312، 313.
(67) ابن سينا، المبدأ والمعاد، ص 41.
(68) انظر: التعليقات، تحقيق وتقديم: حسن مجيد العبيدي، سوريا، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 2008م، ص 270، 271.
(69) النجاة، ص 290.
(70) الأمر نفسه سبق إليه الكندي في رسالتين: «الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد»، و«الفاعل الحق الأول التام، والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز».
(71) السماع الطبيعي، ص 111.
(72) انظر: المصدر السابق، ص 124.
(73) التعليقات، ص 300.
(74) انظر: عبد الجبار بن أحمد، الأصول الخمسة، تعليق: الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، حققه وقدم له: الدكتور عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط 3، 1416هـ/1996م، ص 116، 159.
(75) موسى بن ميمون القرطبي، دلالة الحائرين، عارضه بأصوله العربية والعبرية: حسين أتاي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط 1، 1428هـ/2007م، ص 17.
(76) الأصول الخمسة، ص 89.
(77)وقد سبقت الإشارة إلى هذا عند الحديث عن ضوابط التكامل المعرفي.
(78) انظر: معيار العلم، ص 260.
(79) انظر: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، كتاب التمهيد، عنى بتصحيحه ونشره: الأب رتشر ويوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، 1957، منشورات جامعة الحكمة في بغداد، سلسلة علم الكلام: 1، ص 43.
(80) انظر: محمـد بن الحسـن بـن فورك، مقالات الشيخ أبـي الحسن الأشعـري، تحقيق وضبط: أحمد عبد الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط 1، 1425هـ/2005م، ص 100، 101.
(81) انظر: سيف الدين الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق: أحمد محمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط 2، 1424هـ/2004م، ج 1، 316.
(82) المقبلي، العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ويليه الأرواح النوافح لآثار إيثار الآباء والمشايخ، مصر، ط 1، 1328هـ، ص 145.