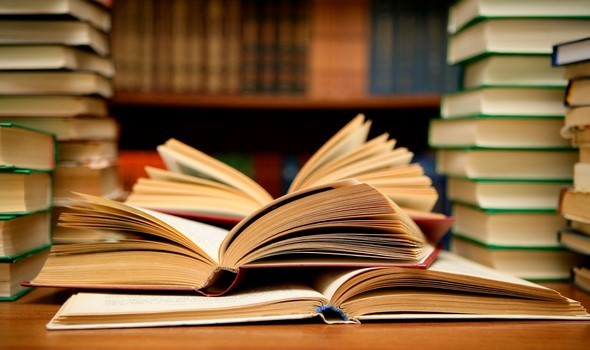أحمد درويش | أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بجامعة القاهرة.
تحت هذا العنوان ظهر في حقول الدراسات الأدبية والنقدية فرعٌ جديدٌ من فروع البحث الأدبي والنقدي، على مستوى الآداب العالمية في بدايات الربع الثاني من القرن التاسع عشر في فرنسا؛ أي منذ حوالى قرنين من الزمان.
وتحديد فترة ظهور هذا الفرع «الجديد» بهذه الفترة الزمنية يمكن أن يجعله فرعاً حديثاً نسبياً، إذا قيس بفروع أخرى تنتمي إلى حقول الدراسات الأدبية والنقدية مثل البلاغة، التي تصعد ـ ومعها النقد الأدبي وتاريخ الأدب ـ إلى عصور تاريخيه بعيدة سواء في التراث العربي أو تراث الآداب الأخرى، لكن هذا التحديد يمكن أيضاً أن يجعل هذا الفرع «قديماً» نسبياً، إذا وضعنا في الاهتمام «الثورة الكبرى» التي شهدتها فروع الدراسات الأدبية والنقدية، بدءًا من القرن التاسع عشر نفسه، ومروراً بالقرن العشرين، ووصولاً إلى الألفية الثالثة، حيث تقترب مجالات العلم والأدب، وتتزايد الابتكارات وتقنيات الإرسال والاستقبال وتكوين الشفرات وحلّها، مما يتشكّل معه فروع جديدة معرفية في مجال الدراسات الأدبية والنقدية، يمكن أن توصف بأنها أكثر «حداثة» إذا قيست بفرع الأدب المقارن، لكنها ـ في الوقت ذاته ـ تقوِّي من شبكات التواصل بين اللغات والآداب التي يقوم هذا الفرع على أساس منها، مما يجعل منه فرعاً نقدياً من فروع «الضرورات»، بعد أن كان في القرن التاسع عشر وجزء من القرن العشرين من فروع «الكماليات».
إن الموضوع الرئيس لهذا العلم هو «العلاقات المتبادلة بين الآداب المختلفة التي كتبت بلغات متعدِّدة»، وذلك يعني أن اختلاف اللغة بين الأدبين أو الآداب ـ موضوع الدراسة في هذا الفرع ـ شرطٌ ضروري لا بُدَّ منه لتندرج الدراسة تحت مظّلة «الأدب المقارن»، وفي غياب هذا الشرط يمكن أن تدرج الدراسة في إطار الموازنات أو «النقد الأدبي» أو «تاريخ الأدب القومي»، وهما فرعان لصيقان بالأدب المقارن، ويُشكِّلان معه تداخلاً في كثير من الأحيان، ويؤثِّران على مناهج الدرس فيه، وتمثّل «العلاقات بين الأدب» في الواقع جوهر «الظاهرة» التي يهتم بها هذا الفرع، وهي ظاهرة قديمةٌ قِدَمَ الحضارات الأدبية الكبرى في العالم، ولا يقتصر وجودها على فترة القرنين الماضيين اللذينْ وُجد فيهما هذا الفرعُ أو العلم (الأدب المقارن)، هذه الفترة هي فترة ظهور «قوانين» دراسة هذه الظاهرة التي هي موجودة أصلاً منذ القِدَم.
وهذا التعاقب بين «الظواهر» و«القوانين» التي تدرسها معروف في كل فروع المعرفة، حيث وُجدت الظواهر الكونية والفضائية منذ نشأة الكون، ولكن تأخَّرت علوم الجغرافيا والفلك والفضاء في وضع قوانينها بحسب تطوّر المعرفة، وكذلك الشأن في الظواهر المتصلة بحياة الإنسان والحيوان والنبات والمياه واليابسة، التي تشهد كل حين «قوانين» جديدة لظواهر قديمة.
ونحن في مجال الآداب القديمة نعرف مجالات التواصل بين الشرق بآدابه التي نشأت في المجتمعات المستقرّة حول أحواض الأنهار الكبرى، ومساقط المياه في مصر والعراق والشام والجزيرة العربية، وتواصلاتها عبر البحار والمحيطات مع الشعوب الغربية والشرقية، حيث انطلقت من منطقة «الشرق» ما أُطْلِق عليه فيما بعد «فجر الضمير الإنساني» على حَدِّ تعبير الكاتب الأمريكي بريستيد، أو جَعْل مُدُنِ الشرق وآدابها المنبعَ الحقيقي لجذور الحضارة الإغريقية في أثينا، كما فصَّل ذلك «مارتن برنال» في موسوعته، من خلال مجلدات أطلق عليها عنوان «أثينا السوداء» وقد تُرجمت مؤلفات بريستيد وبرنال إلى العربية.
ولو ألقينا «نظرة طائر» على الجانب المدوّن من تاريخ العربية وآدابها في نحو سبعة عشر قرناً مضت؛ لوجدنا كثيراً من الدلالات التي تؤكد وجود تواصلٍ لم ينقطع بين العربية وجاراتها، سواء من اللغات السامية ـ وهي العائلة التي تنسب إليها العربية الشمالية والحميرية والعبرية والأمهرية والأشورية والبابلية وغيرها من لغات الشرق ـ أو بينها وبين لغات العائلات الأخرى التي كانت تمرّ بالأرض «العربية» في طريق رحلاتها التجارية، أو مغامراتها الحربية. ومع قلة شيوع الكتابة في هذه الفترات القديمة فإن الباحثين يَرَوْن أن أحْرُفَ الكتابة العربية كانت أقدم من نظيراتها العبرية واليونانية والفينيقية. كما يرى الأستاذ العّقاد أن تسمية هذه اللغات لحروفها بالألفبائية، وبقاء هذا المصطلح حتى الآن في اللغات الغربية المعاصرة، يدلُّ على صحة هذه الفرضية، وامتداد جذور العربية التأثيرية إلى فترات تاريخية سحيقة؛ لكن التاريخ الأكثر قرباً لمسيرة اللغة والأدب العربي ـ وخاصة بعد ظهور الإسلام ونزول القرآن بلغة العرب ـ يُظهر لنا حَجْم التفاعل الكبير بين الأدب العربي والآداب العالمية، وفي مقدمتها الأدب البهلوي (الفارسي الوسيط)؛ حيث ظهر التأثير الواضح في مجال الشعر والنثر على اختلاف في درجات التلقي، حيث يبدو الشعر العربي والنثر الفارسي أقوى تأثيراً على نظيريهما في الأدب المقابل. وحيث تداخلت المواهب، وظهرت طائفة مَن عُرِفوا بأصحاب اللسانيْن، وهم الذين يجيدن اللغتين وينتجون بهما معاً أدباً مؤثراً، وما زالت هذه الفترة تمثل مجالاً خصباً لدراسات الأدب المقارن؛ حيث تُشكِّل ـ مع امتداداتها ـ التاريخية النسيج الثقافي لجوانب مهمة من الأدبين العربي والفارسي، أو لموضوعات من الآداب الشرقية الأخرى عبرت إلى الأدب العربي عن طريق الأدب الفارسي، ثم أكملت نضجها الأدبي داخل الأدب العربي نفسه، حتى أصبحت جزءًا من تراثه الأدبي الذي يعتزّ به، وعَبَرَتْ من خلاله إلى الآداب العالمية، وتركت تأثيرات مدوية فيها، وهناك أثران أدبيان مهمّان يشار إليهما في هذا المجال هما:
1 ـ كليلة ودمنة:
وهي تمثِّل النصّ الرئيس العالمي لأدب «القصة على لسان الحيوان»، ولهذا فإن دراسة الأدب المقارن الحديثة تتبّعت مسارها، وترجماتها، وموجات الإضافة فيها، وتنوّع الوسائل الفنية في أدائها وانتقالها من أدب إلى أدب آخر، عبر المحور المركزي الذي استقرت فيه، وهو الأدب العربي الوسيط.
وقد بدأت خيوط هذا الجنس الأدبي الكبير مع بدايات التدوين البشري للتجارب الإنسانية، وتوظيف رموز الحيوانات من خلال دلالاتها الثابتة، كدلالة المكر عند الثعلب، والغدر عند الذئب، والخوف عند الأرنب، والشجاعة عند الأسد، والغباء عند الحمار، والعناد عند البغل، وغير ذلك من الدلالات المتّفق عليها عالمياً.
وظهرت رموز متفرّقة مدوّنة من كتابات التراث الإغريقي تنسب إلى شخصية إيسوب، وهي شخصية تنتمي إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويغلفها مناخ أسطوري، وتُروى عنها قصص قصيرة على ألسنة الحيوانات تثير التسلية وتستخلص الحكمة، لكن الدارسين الغربيين أنفسهم يقولون إن شخصية إيسوب تتداخل بشدة مع شخصية «لقمان» المعروفة في التراث الشرقي، والتي ورد ذِكْرُها في القرآن الكريم. ويقول عنها بعض المفسرين: إنها شخصية عَبْدٍ من سودان مصر أُعطي الحكمة ولم يُعْطَ النبوّة، ويروي عنه المفسرون قصصاً يتصل بعضها بعالم الحيوان، وهذا التدخل بين شخصيتي إيسوب ولقمان يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً من تداخل الثقافتين: الإغريقية والمصرية القديمة ويفسر مفهوم «أثينا السوداء». وعلى أية حال فإن مدونة إيسوب عرفت طريقها للثقافة الغربية في العصور الوسطى وما بعدها، وشكّلت رافداً من روافد جنس القصة على ألسنة الحيوان في الآداب الحديثة.
لكن الرافد الأكبر لهذا الجنس ـ والذي أثرى الآداب العالمية من خلال الأدب العربي ـ جاء من مصدر شرقي خالص، امتزج فيه التراث الهندي والفارسي والعربي، وتأتي بدايته مع كتاب الفيلسوف «بيدبا» «البانكاتانترا» أو الحكايات الخمس، والتي ألَّفها للملك دبشليم؛ لتشكِّل أساساً أدبياً وخُلُقياً للمجتمعات العادلة ولأسرار الحكمة، وقد كانت الهند تَوَدُّ أن تؤثر نفسها بأسرار الحكمة والسياسة المتاحة في الكتاب، ولكن جيرانها الفرس عندما سمعوا به حرصوا على الوصول إليه بأي وسيلة، وجنَّد أحدُ علمائهم نفسه، ورصد حياته من أجل السعي إلى ترجمة الكتاب إلى الفارسية عن النسخة الوحيدة الموجودة في مكتبة ملك الهند. ونجحت رحلة الطبيب برزويه في تحقيق هدفها، وعاد إلى بلاط كسرى وقد حمل نسخة مترجمة من الحكايات الخمس، بعد أن أضاف إليها حكاية سادسة هي «رحلة الطبيب برزويه»، وتغيّر عنوان الكتاب ليصبح «كليلة ودمنة»، وهو اسم الثعلبين اللذين يحكيان القصة الرئيسة.
وهذه الترجمة هي التي نقلها إلى العربية «روزبه بن داذويه»، الذي اشتهر باسم عبد الله بن المقفع، بعد أن اعتنق الإسلام في أواخر عهد الدولة الأموية وبداية العباسية، وقد أضاف ابن المقفع إلى الكتاب مقدّمات وحكايات إضافية، حتى بلغ الكتاب خمس عشرة حكاية، وأربع مقدّمات، وعُدّتْ ترجمة ابن المقفع أصلاً يُرجع إليه، بعد أن فُقِدَ الأصلُ الهندي، والترجمة الفارسية أو البهلوية بتعبير أدق.
وربما كانت هذه الترجمة من الأسباب التي دفعت رجال الخليفة المنصور إلى قتل ابن المقفع في شبابه لما تَحْمِلُهُ من هجوم سياسي قاسٍ يجيئ على ألسنة الحيوانات ضد الملوك وحاشيتهم وصحابتهم؛ لما يتصّفون به من الخديعة والظلم والخسّة والجشع.
وقد لقيت هذه الترجمة رواجاً كبيراً لدى قراء الأدب العربي، ونُسجت على منوالها مؤلفات تحاكيها نثراً وشعراً؛، لكنها كذلك عرفت طريقها إلى آداب العالم المختلفة عبر حركة الترجمة التي نشطت في العصر العباسي الأول، فترجمت إلى لغات العصر مثل اللاتينية والعبرية والسريانية والفارسية والقشتالية والتركية. ثم حدثت ترجمات غير مباشرة عن هذه اللغات وعن العربية إلى لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية والإنجليزية والألمانية والروسية والإسبانية والبرتغالية وغيرها من اللغات، حتى وصل عدد اللغات التي انتقلت إليها (كليلة ودمنة) نحو سبعين لغة عالمية.
وكان من أبرز تأثيرات هذه الترجمات في عصر النهضة الترجمة الفرنسية، التي قرأها شاعر العصر الكلاسيكي الكبير «لافونتين»، الذي كان مولعاً بكتابة القصص على ألسنة الحيوانات، وكان قد قرأ (إيسوب) وكتب الجزء الأول من ديوانه، فلما قرأ ترجمة (كليلة ودمنه) تأثر بها كثيراً، واعترف بذلك في مقدّمة الجزء الثاني من ديوانه وألَّف بعض القصص التي تمثل حكاياتها، وقد تُرجمت حكايات لافونتين إلى العربية في القرن التاسع عشر على يد محمد عثمان جلال، وتأثر أمير الشعراء أحمد شوقي بها فأنشأ جنس قصص الأطفال شعراً، والقصص على ألسنة الحيوانات، وخصص لها قسماً كبيراً في ديوانه «الشوقيات»، ثم امتدّ التأثير الأدبي إلى الشعراء المعاصرين والناثرين المهتمين، بما أصبح يطلق عليه أدب الطفولة.
2 ـ ألف ليلة وليلة:
هذا هو العمل الأدبي الكبير الثاني الذي اهتمّ به فرع «الأدب المقارن» بوصفه ممثلاً بارزاً لتفاعل الأدب العربي مع الآداب السابقة عليه والموازية له في ناحية، ثم بوصفه نتاجاً تمّ تمثله والإضافة إليه والنمو به، حتى أصبح في ذاته أحد أكبر ممثلي الأدب العربي نفسه لدى الآداب الأخرى، وأحد أشهر الكتب في الآداب العالمية.
وتتتبع دراسات الأدب المقارن المسارات المتوالية والمتداخلة لهذا العمل الأدبي الكبير، عبر القرون الكثيرة التي حَمَلَ فيها هذا العملُ نَبْضَ الشعوب واللغات، واجتاز الحواجز عبر الترجمات. وكاد يسجّل لشعوب الشرق تاريخاً نابضاً بالحياة يهتم بالفقراء وعامة الناس في مقابل التاريخ الرسمي، الذي يركز على القادة والحكام وعِلْية القوم، ويخط رواياته بحسب رغباتهم.
وقد اهتمّ علماء الأدب المقارن بهذا العمل الأدبي الكبير اهتماماً بالغاً، وكتبوا حوله مئات الدراسات والمؤلّفات، وعقدت ـ وما زالت تُعقد ـ حوله الكثير من الندوات وحلقات البحث في كبرى الجامعات العالمية.
وهم يرون أن (ألف ليلة وليلة) عملٌ جماعي وضعته أجيال متتابعة، وشعوب مختلفة، وأن بذرته الكتابية الأولى تكمن في كتاب صغير ترجم من الفارسية إلى العربية في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، كان يحمل عنوان «هزار افسانه»؛ أي «ألف خرافة»، وقد أشار إليه المؤرخ المسعودي في كتابه «مروج الذهب»، وأن مادته الأولى كانت تحكي قصة الملك شهريار واكتشافه لخيانة زوجته مع أحد عبيده، وقَتْلهما معاً، وَفَقدِه الثقةَ في جنس النساء مع عدم الاستغناء عنهن، وقراره أن يتزوج كل ليلة امرأة ثم يأمر بقتلها مع طلوع الفجر حتى لا تتمكن من خيانته، ويستمر على هذا الحال فترة من الزمن حتي يجيئ الدور على «شهرزاد»، فتحكي له في ليلتها الأولى قصة مشوقة، وتتوقف مع طلوع الفجر، وهو يتلهف إلى الاستكمال فيبقيها إلى الليلة التالية، وتتفرّع القصص وتتشابك ليلة بعد ليلة، حتى تصل إلى الليلة الأولى بعد الألف، فتنتهي الحكايات وتكون شهرزاد قد أنجبت من الملك طفلاً يمشي وطفلاً يحبو وطفلاً يرضع. وتصطحبهم معها، وتطلب من الملك أن يأمر بقتلها كالأخريات، فيجيبها بأنه أحبّها وعفا عنها وعن جنس النساء.
وتحمل القصة مغزىً عالمياً حول قدرة الكلمة على الإقناع أكثر من قدرة السيف، وقوة المرأة الناعمة التي لا تقل فعالية عن قوة الرجل الخشنة، وبين الليلة الأولى والليلة الأخيرة تتوالى مئات الحكايات الشعبية التي ينطلق فيها عنان الخيال، وتدور في ممالك الإنس والجنّ، وعوالم الحقيقة والسحر وطبائع النفوس الإنسانية خيراً أو شرّاً، سلماً أو حرباً، مغامرة أو استسلاماً، وتلم بعادات كل الحِرَفِ والطوائف والطبقات، التي نسيها التاريخ ولم يدونها التاريخ الرسمي المكتوب.
وانتهت دراسات الأدب المقارن إلى أن «ألف ليلة وليلة» ظلّت كتاباً مفتوحاً، تضيف إليه الأجيال حكاياتها، منذ ترجم إلى العربية كتاب «هزار افسانه» في القرن العاشر حتى تمّ تدوينه في مصر في القرن السادس عشر على يد رواة ومدونين مجهولين، وأنه خلال هذه الفترة الطويلة المفتوحة تعاقبت عليه أطياف من الحكايات والليالي يمكن أن تقسم على النحو التالي:
1 ـ الليالي الهندية والفارسية، وهي تمثل القسم الأول، وحكاية شهريار وشهرزاد.
2 ـ الليالي العراقية، وهي تمثل إضافات الحياة الاجتماعية والتجارية والفنية في عصر الخلافة العباسية في بغداد والبصرة، وامتداداتها في الخليج العربي وخليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي وما وراءه.
3 ـ الليالي المصرية، وهي تضيف الحياة المهنية والتجارية والصناعية، وعلاقات الشرق والغرب في عصر الحملات الصليبية، وصورة الإفرنجة في مخيلة شعوب الشرق.
وقد لاحظ دارسو الأدب المقارن أن الحكايات ظلّت تُسمى «ألف ليلة» فقط حتى تُرجمت إلى اللغة التركية، فأصبحت تُسمى «ألف ليلة وليلة»، انطلاقاً من أن المبالغة في العدد في اللغة التركية يتمّ التعبير عنها بكلمة «بنْ بر» وهي تترجم بألف وواحد، فأصبح العنوان التركي «بن بر ليلة» معادل «ألف ليلة وليلة».
وقد أخذت «ألف ليلة وليلة» أبعادها العالمية في الشهرة الواسعة، بعد الترجمة الفرنسية التي قام بها أنطوان غالّان في مطلع القرن الثامن عشر سنة 1705، وأصدر طبعة كاملة لها بالفرنسية سنة 1712، قبل أن تطبع باللغة العربية ذاتها بأكثر من مائة وعشرين عاماً سنة 1832 في مطبعة بولاق بمصر.
وقد أتاحت هذه الطبعة الفرنسية المبكرة للكتاب في القرن الثامن عشر انتشاراً واسعاً في معظم لغات العالم التي ترجمته عن الفرنسية أو عن العربية مباشرة، كما أتاحت لعشرات الدراسات العلمية حول قضاياه فرصة الحوار والبحث عن الحقيقة التاريخية الكامنه وراء الحكايات.
ومن أبرز هذه الدراسات الحديثة التي تنطلق من حكايات ألف ليلة وليلة الدراسة العملية التي ساندتها سلطنة عُمان وأمر جلالة السلطان قابوس بتمويلها ومشاركة الخبراء العُمانيين فيها، وكانت فكرتها تدور حول «رحلات السندباد» التي وردت في حكايات ألف ليلة وليلة، وانطلق فيها البحارة العربي المغامر السندباد البحري في سبع رحلات متتالية ليكتشف فيها آفاق خليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي وبحر الصين وما يحيط بها من جزر وبلدان، وما يجري فيها من العجائب والغرائب، ومع أن كل رحلة كانت تنتهي بتحطّم سفينته وتعرضه للغرق، فإنه لم يستسلم لليأس وواصل الإبحار والاكتشاف والتدوين.
وقد اهتمّ المستشرق الأيرلندي تيم سيفرن بهذه الرحلات، وطرح من خلالها سؤالاً مهماً حول مدى تعبير هذه الرحلات عن طموح البحارة العرب القدماء في اكتشاف آفاق الشرق الأقصى؛ تحقيقاً لطموح الإمبراطورية العربية المهيمنة على العالم آنذاك؟
وكانت إجابة السؤال العلمية تتطلب إعادة القيام برحلات السندباد، بالوسائل نفسها التي كانت متاحة لها، ووفقاً لخريطته، وتسجيل النتائج المعاصرة، ومعرفة مدى مطابقتها للنتائج القديمة في (ألف ليلة وليلة).
وقد وافقت سلطنة عُمان على تبني الفكرة العلمية، وتمّ اختيار مدينة صُحار لبناء سفينة مماثلة تماماً لسفينة السندباد من كل أوجهها وإمكانياتها الفنية، وانطلقت الرحلة من «صُحار» متتبعة خريطة السندباد القديمة تماماً، ومسجلة ملاحظاتها التي تقترب كثيراً من ملاحظاته، والصعوبات الملاحية والكائنات البحرية والبشرية في الجزر التي عبرتها، حتى وصلت إلى مدينة «كانتون» في الصين، بعد نحو تسعة أشهر من الإبحار، وسط انبهار العالم بالتجربة العلمية التي اقترحها «سيفرن» وساندتها سلطنة عُمان.
ولا تزال السفينة رابضة في مسقط بالقرب من فندق البستان، وما زال الكتاب الذي طُبع عن تفاصيل الرحلة بالعربية والإنجليزية والفرنسية يملأ مكتبات العالم كله، مؤكداً الأهمية البالغة لهذا العمل الكبير.
هذان النموذجان الشهيران يجسِّدان جانباً من جوانب حركة دراسات الأدب المقارن، التي تكشف عن حركة الأجناس الأدبية المتنوعة من أدبٍ إلى أدبٍ آخر، وهما ليسا النموذجين الوحيدين اللذيْن شارك بهما الأدب العربي في حركات الأجناس والتيارات والموضوعات الأدبية بين الآداب العالمية، وإن كانا يُعَدَّان من أكثر الموضوعات والأجناس الأدبية شهرة وأوسعها انتشاراً بين آداب العالم، ويمكن أن نشير إشارات عابرة إلى موضوعات أخرى كثيرة عُنيتْ بها الدراسات المقارنة لتاريخ الأدب العربي القديم والوسيط، وتابعت حركة انتقالها بين الآداب العالمية، وتأثيراتها على الآداب الأوروبية الوسيطة خاصة.
وقد حدث هذا مع جنس «المقامة» العربية، وهو الجنس الذي يعالج ـ من خلال النثر ـ موقفاً قصصياً غريباً، يقوم به أحد «الشطار»، ويُحدث من خلاله تأثيراً سريعاً خاطفاً مبهراً ثم يختفي.
وقد ابْتُكِرَ هذا الجنسُ في القرن الرابع الهجري على يد بديع الزمان الهمذاني، متأثراً بأستاذه العُماني أبي بكر ابن دريد، الذي كان قد أنشأ فن «الأحاديث»، في كتابه الضخم «أحاديث ابن دريد»، الذي ضاعت معظم أجزائه، ولم يبق منه إلا ما دونه تلميذه أبو علي القالي في كتابه «الأمالي»، وقد جمعْنا هذا القسم، وأعدْنا تصنيفه في كتابنا «ابن دريد رائد فن القصة العربية».
لكن بديع الزمان الهمذاني نجح في أن ينطلق من فكرة هذه الأحاديث، ويكتب مجموعة من المقامات الرشيقة الحادة حول فن «الكدْية» أو السؤال والاحتيال، وجعل لها بطلاً واحداً، هو أبو الفتح السكندري، وراوياً واحداً هو عيسى بن هشام.
وقد لقي هذا الفن رواجاً كبيراً في الأدب العربي، وتُرجم منه الكثير إلى اللغات الأخرى، وحذا حذوه الأدبُ الفارسي في كتابة مقامات مماثلة مثل «مقامات البلخي»، وظلَّ هذا الفن يحيا في اللغة العربية على استحياء حتى العصر الحديث في عُمان في شكل كتابات مقامات الشيخ عبد الله الخليلي ومقامات أبي الحارث البرواني، وانتقل عبر الترجمة إلى اللغة اللاتينية ولهجاتها المتفرعة عنها في القرون الوسطي، ويربط بعض الباحثين بين هذا الفن القصصي وظهور ما عُرف في الآداب الأوروبية «بقصص الشطار»، وهو النواة الأولى لفنِّ القصة القصيرة في الآداب الغربية.
يقول الدكتور محمد غنيمي هلال ـ رائد دراسات الأدب المقارن في الأدب العربي ـ: «في القرنين السادس عشر والسابع عشر وُجد في أوروبا جنسٌ أدبي جديد من القصص، خَطَا بالقصة خطوات نحو الواقع، يطلق عليه قصص الشطار، ووُجد أول ما وُجد في إسبانيا، وهو قصص العادات والتقاليد للطبقات الدنيا للمجتمع، وتسمى في الإسبانية «الپيكارسكا» Picaresca، وتختصَّ بأن المؤلف فيها يحكيها على لسانه كأنها حدثت له، وهي ذات صيغة هجائية للمجتمع وَمنْ فيه، ويسافر فيها المؤلف على غير منهج في سفره، وحياته فقيرة بائسة يحياها على هامش المجتمع... ويوجد وجوه شبه قوية بين قصص الشطار وبين المقامات العربية كما نعلمها عند بديع الزمان الهمذاني ثم الحريري».
ولا تقتصر تأثيرات القصص العربية المحتملة على الآداب الأوروبية على القصص الموغلة في الواقع؛ بل إنها تمتد أيضاً إلى احتمالات التأثير في القصص الموغلة في الخيال، كما هو الشأن فيما يعرف بأدب الدار الآخرة، المتصل بعالم ما بعد الحياة الدنيا، وتخيل مصائر البشر في الحساب والعقاب والثواب والجحيم والنعيم، وقد عرف الأدب العربي كياناً مهماً في هذا المجال، لعل من أقدمه ما كتبه الحارث المحاسبي في القرن الثاني الهجري تحت عنوان «التوهم»، وهو كتاب وعظيٌّ صغير، يُرغّب الصالحين في الجنة ونعيمها بأسلوب تخيلي تجسيدي أدبي رفيع، لكن من أشهر هذه الكتب دون شكّ ما كتبه أبو العلاء المعري في القرن الخامس الهجري تحت عنوان «رسالة الغفران»، في شكل رحلة إلى الدار الآخرة، يتخيل فيها مصير الشعراء والعلماء السابقين عليه، وموقعهم من النعيم أو الجحيم، وما كتبه معاصره الأندلسي ابن شهيد في رسالته التوابع والزوابع.
وقد ظهرت بعد عدة قرون الفكرة نفسها في الآداب الأوروبية على يد الشاعر الإيطالي «دانتي»، في عمله الكبير «الكوميديا الإلٰهية»، الذي ظلت الآداب الأوروبية جميعا تعتزّ به، وتعدُّه قمة ابتكار الخيال البشري الخلاق، حتى أتى المستشرق الإسباني «أسين بلاثيوس» ليثبت شدة الصلة بين هذا العمل الأوروبي الكبير ورسالة الغفران لأبي علاء المعري، التي سبقته بعدة قرون، وأثبت وجود مخطوطات مترجمة لها، ولأحاديث المعراج، ترجمت إلى اللاتينية، ووقعت بين يدي دانتي قبل أن يكتب رسالته.
ولا يقلّ اهتمام الأدب المقارن بمجال التأثيرات المتبادلة بين الشعر العربي وشعر الآداب الأخرى، وإن كان الشعر أثقل حركة بين اللغات؛ لارتباطه بخصائص شكلية يصعب ترجمتها على خلاف النثر، ومع ذلك فقد رصدت دراسات الأدب المقارن ملامح مشتركة قوية بين الشعر العربي والفارسي من حيث الشكل والمضمون في فترة التقائهما خلال العصر العباسي الأول، بل وامتداد ذلك في شعر اللاتينية واللهجات المتفرعة عنها، خاصة في مجال شعر الغزل؛ إذ تبنت الدراسات المقارنة وجودَ لونٍ من الشعر الأوروبي اشتهر باسم «شعر التروبادور»، يتمّ أداؤه على يد فريق من الشعراء يسمون «الشعراء الجوالون»، وتمتزج فيه الكلمات اللاتينية والعربية، وتظهر فيه ألوان من الموسيقى الشعرية قريبة من موسيقى شعر الموشّحات الأندلسية، وقد شاع هذا الشعر في معظم اللغات الأوروبية من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر.
وإذا كانت دراسات الأدب المقارن قد وقفت أمام صفحات الأدب العربي الكبير، وهي تتفاعل وتمدّ روافدها إلى الآداب العالمية، تمتص من الآداب السابقة عليها والموزاية لها، وتؤثر في الآداب التالية لها؛ فإن دراسة الأدب المقارن وقفت كذلك أمام الصفحة المقابلة من الموجة المتبادلة بين الحضارات، موقنة أن الحضارات العظيمة والآداب الكبرى تعرف كيف تأخذ وتتمثل وتهضم، وتجدد نفسها بالقدرة نفسها التي تعطي بها أو تؤثر في غيرها في فترات القوة والمدّ.
ومن هنا فقد خضعت فترة الصحوة العربية في الأدب ـ والتي بدأت منذ الربع الثاني من القرن التاسع عشر في مرحلة مواكبة لميلاد علم الأدب المقارن نفسه في أمريكا وأوروبا ـ وخصصت هذه الفترة لدراسات مقارنة لمعرفة أثر اتصال الآداب العربية ـ بعد فترة العزلة والركود ـ بآداب الأُمم الأخرى، التي كانت قد قطعت شوطاً في التقدم والرقي، مستفيدة من علاقاتها بالآدب والفكر والعلم والفلسفة العربية في القرون الوسطى وترجماتها، التي مثلت نقطة انطلاق النهضة الفكرية في الغرب.
وقد بدأت الدراسات تتبع أثر البعثات والاتصالات في القرن التاسع عشر على يد الأدباء والمفكرين في منطقة مصر والشام والعراق على نحو خاص، وما نجم عنها من ترجمات، ونشأة أجناس أدبية أو فنية جديدة، كما حدث مع رفاعة الطهطاوي ورحلته التي سمّاها (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) وما نتج عنها من نشأة الصحافة والمسرح وترجمات كثيرة في مجالات مختلفة أدبية وفكرية.
ما يترتّب على ذلك من دعوة إلى إنشاء مدرسة للألسن، يتم فيها تدريس اللغات المختلفة، وتنشط من خلال خريجيها حركة ترجمة كبرى يقوم بها الأدباء في مصر والشام، متدرجين من ترجمة المسرح وتعريبه تقريباً لفحواه من أذهان الجمهور. وفي هذا الإطار نشط المهاجرون الشوام المقيمون في مصر في نقل مسرح موليير وشكسبير، ونشأتْ حولهم حركةٌ مسرحية كبيرة، كما نشطوا في إنشاء الصحافة بألوانها المختلفة، والتي اختلطت فيها العربية بالتركية في بادئ الأمر، ثم استقلت العربية وتدرّجت مستوياتها، من الصحف الفكاهية التي تسلّي الجمهور إلى المجلات الأدبية والفلسفية التي تناقش أرقى القضايا وأعقد الأفكار.
وكانت من نتائج هذه الاتصالات ـ كما رصد علماء الأدب المقارن ـ أن جنس «النثر» الأدبي الحديث بدأ في الظهور على النظام الموازي له في الآداب الأوروبية، فبدأت محاولات كتابة الرواية والقصة القصيرة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكان من المحاولات المبكرة في هذا الإطار ما قدّمه أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي حاول أن يكون رائداً في مجال كتابة الرواية النثرية كذلك، فاهتمّ بالتاريخ القديم الفرعوني والعربي، وكتب حولهما بعض الروايات التي نشرت في شكل حلقات مسلسلة في صحف العصر مثل جريدة الموسوعات؛ استجابة لرغبة قراء الصحف اليومية، وخاصة شريحة النساء اللاتي أظهرن حرصاً على القراءة والمتابعة، ومن خلال هذه المسلسلات تجمعت روايات مثل «عذراء الهند» و«دل وتيمان» و«آخر الفراعنة» و«ورقة الآس» و«أسواق الذهب»، وقد أقامت الدراسات المقارنة علاقة قوية بين الروايات الفرعونية عند شوقي خاصة، وإنتاج الشاعر الفرنسي السابق عليه «تيوفيل جوتيه»، كما أقامت هذه الدراسات المقارنة أيضاً علاقة كذلك بين الإنتاج الروائي التالي له، وأبرزه رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل، وإنتاج الأديب الفرنسي جان جاك روسو الذي كان هيكل قد أعجب به كثيراً، وكتب عنه في مؤلفاته.
ولا يُعدُّ هذا التأثير في ذاته لدى علماء الدراسات المقارنة أمراً معيباً في ذاته، ما دام قد صاحبه تمثلٌ واستيعابٌ وانتقاءٌ وتشرّبٌ ومزجٌ بروح الأدب المتأثر، وفي هذا المجال تَرِدُ العبارة المشهورة في الأدب المقارن، والتي تنسب للشاعر الفرنسي الشهير بول فاليري: «إن الليث ليس إلا عِدَّةَ خِرَافٍ مهضومة»، لكن هَضْم هذه الأعمال وتمثلها وخَلْع طابع كاتبها ولغته عنها عناصر ضرورية لكي يفلت من شبهة التقليد أو السرقة.
وفي جُهْدٍ موازٍ لظهور أثر الاتصال بالآداب الأجنبية في مسيرة الأدب العربي، ظهرت دراساتٌ نظرية في مجال التمهيد لعلم الأدب المقارن، كان من أهمها ما كتبه الأديب الفلسطيني روحي الخالدي حول «علم الأدب بين الفرنجة والعرب» وما كتبه الأديب اللبناني «سليمان البستاني» في مقدّمته لترجمته للعمل التراثي الإغريقي الكبير «الإلياذة»، وما كتبه علي مبارك ـ في أواخر القرن التاسع عشر ـ حول أهمية حوار الحضارات والآداب في الشرق والغرب، في كتابه الحواري القصصي «علم الدين»، والذي يدور الحوار فيه بين مستشرق إنجليزي وشيخ أزهري اسمه «علم الدين»، حول المقارنة بين الحضارتين والأدبين، وإمكانية انتقاء الجوانب المفيدة المشتركة، على النحو الذي أشار إليه رفاعة الطهطاوي في كتابه الرائد تخليص الإبريز في تلخيص باريز.
ثم شكّلت نهضة الشعر العربي ـ في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ـ خطوات واسعة لدراسات الأدب المقارن، وإضافة إلى ما أشرنا إليه ـ من تأثّر أحمد شوقي الملموس بكبار الشعراء الفرنسيين من أمثال لافونتين وڤكتور هوغو ولامرتين وتيوفل جوتيه ـ ظهرت الآثار الإيجابية للأدبين الفرنسي والإنجليزي في إنتاج شاعر فحل ومثقف لبناني هو خليل مطران الذي لعب دوراً مهمّاً في ربط الثقافة العربية بالثقافة الفرنسية خاصة، وعُدَّ رائداً حقيقياً لمدرسة الرومانسية العربية في الربع الثاني من القرن العشرين، كما عُدَّ رائداً للمسرح الراقي من خلال ترجمات لمسرحيات وليم شكسبير وراسين وكورناي.
وفي خطٍ موازٍ تأثّرت مدرسة شعرية عربية بأعلام الرومانتيكية في الأدب الإنجليزي؛ فكان شعراء مدرسة الديوان متأثرين بأعلام الشعر الإنجليزي الرومانسي، من أمثال كوليردج ووردزورث وشيللي وكيتس، وظهر هذا واضحاً في كتابات العقاد وشكري والمازني الشعرية والنقدية.
وجاءت مدرسة «أپوللو» في الشعر لتجمع بين الرافدين، وتشكّل عطاء شعرياً عربياً لا ينفصل عن المنابع العالمية، ولكنه لا يذيب شخصيته الذاتية ويضحي بها.
وفي خطوط موازية نمت أجناس أدبية واتجاهات نقدية عربية في ظلال التواصل بين الآداب، وهو التواصل الذي يرعاه ويتبنّاه الأدب المقارن، فتطور فن القصة القصيرة العربية بتأثير مع الكُتَّاب الفرنسيين والروس، وخاصة «غي دي موباسان»، والكتَّاب الروس، وخاصة «تشيكوف». وظهرت مدرسة الأخوين محمد ومحمود تيمور وفريق المدرسة الحديثة في القصة، وامتدادات مماثلة في فن الرواية، التي اعترف بها كبار الأدباء بعد نجاح تجربة رواية «زينب» لهيكل، فشارك في تطويرها أصحاب الأقلام البارزة مثل طه حسين وتوفيق الحكيم وإبراهيم المازني، إلى جانب انشغالهم بكتابات نقدية، لم تخلُ بدورها مِنْ تأثُّرٍ بثقافات أجنبية، أو حتى انحياز فريق منهم للون من هذه الثقافة كالفرنسية، وانحياز فريق آخر لثقافة أخرى كالإنجليزية، وأُطلق على النوع الأول من التأثر مصطلح «لاتينيون»، وعلى النوع الثاني مصطلح «سكسونيون»، وأصبح وجود هذين المصطلحين في ذاتهما وتقابلهما دليلاً على شدة تفاعل الأدب العربي مع الآداب الغربية الكبرى الموازية له، وحاجته إلى وجود فرع مستقل يدرس هذه العلاقات ويسمى «الأدب المقارن»، وهو ما لم يكن موجوداً في مناهج دراسات الأدب والنقد في العالم العربي حتى الثلث الثاني من القرن العشرين.
ظهر مصطلح «الأدب المقارن» للمرة الأولى في العالم العربي عام 1935، في مجموعة المقالات التي كتبها في مجلة الرسالة الأستاذ فخري أبو السعود، وكان مدرسا للغة الإنجليزية، عائداً من بعثة قصيرة إلى إنجلترا يطمح إلى عقد مقارنات ودراسات بين الأدبين العربي والإنجليزي، فكتب سلسلة من المقالات بلغت نحو خمسين مقالة في مجلة «الرسالة»، التي كان يديرها أحمد حسن الزيات وكانت واسعة الانتشار في أرجاء العالم العربي كله آنذاك. وجعل عنوان مقالاته «الأدب المقارن»، وخصص كل مقال لإحدى زوايا التقابل أو التماثل أو التضاد بين الأدبين العربي والإنجليزي؛ مثل «الحب» و«الصداقة» و«الحرب» و«الكرم» و«المرأة»، ونادى بإدراج هذا الفرع ـ الذي كان يدرّس بالفعل في الجامعات الغربية منذ 1826 ـ إلى الجامعات العربية، ولكنه توفّى في شبابه قبل أن يتحقّق ما كان يدعو إليه.
وكانت أول كلية جامعية عربية استجابت لمقترحه بعد وفاته هي كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، حيث أدخلت في مناهجها سنة 1947 هذا المقرر على طلابها، وأوفدت أحد أبنائها للحصول على درجة من جامعة السوربون بفرنسا، وعاد هذا المبعوث ـ وهو الدكتور محمد غنيمي هلال ـ ليقدّم أول كتاب منهجي عربي عن «الأدب المقارن» سنة 1952.
مع النصف الثاني من القرن العشرين دخل «الأدب المقارن ـ على المستوى العربي والعالمي ـ مرحلة جديدة؛ فعلى المستوى العربي انتشرت هذه المادة الجذابة في كل الجامعات العربية، وأصبحت لا تخلو كلية جامعية مهتمهة بالآداب من فروع «الأدب المقارن»، واتسع في الوقت ذاته عطاء الباحثين والدارسين في مجالها، فتجاوز العطاء مجالات البحث والتواصل القديمة في مصر والشام والعراق، وانضمّ إليها مجالات العطاء في المغرب العربي، والخليج العربي وزاد حجم التواصل والترجمات والإثراء والتطبيقات، مما جعل من هذا الفرع فرعاً رئيساً في الثقافة الأدبية والنقدية.
وقد واكب ذلك على المستوى العالمي تطورٌ رئيسٌ في مناهج البحث في فروع الأدب المقارن خلال مؤتمر «أزمة الأدب المقارن» سنة 1958، حيث تمت مناقشة مسار البحث فيه، والذي بات يُعرف بالاتجاه الفرنسي أو المدرسة التاريخية، والذي يعدّ الأدب المقارن فرعاً من فروع «تاريخ الأدب». وتمَّ اقتراح توسيع المجال ليدخل في إطاره «المنهج النقدي»، الذي بات يعرف بالاتجاه الأمريكي. ويعدُّ «الأدب المقارن» لصيق الصلة بالنقد الأدبي، ولا يكتفي بمجرد دراسة أوجه التأثير والتأثر، أو السبق أو اللحاق التاريخي، ودفع هذا المنهج إلى مشروعية دراسة الأعمال الأدبية المتوازية أو المتشابهة، دون أن يتمّ بالضرورة تلمُّسُ الصلات التاريخية بها، أو سَبْقِ إحداهما للآخر، أو حتى التقائها به؛ فالمهم أنها تدور جميعاً في إطار روح إنسانية أدبية مشتركة، وقد عبَّر عن الملامح الرئيسة لهذا المنهج أحد كبار منظريه، وهو الفرنسي «ايتيامبل» في كتابه «مقارنات بلا وسائط»، وتمت دراسة أعمال عالمية كبرى مثل «ألف ليلة وليلة» والآداب الشعبية على ضوء مبادئه.
إن الأدب المقارن تتسع آفاقه لكي يتجاوز التحديد الصارم للمقارنة بين نصّين أدبيين أو نصوص أدبية تنتمي إلى لغتين أو لغات مختلفة، كما هو المفهوم الشائع، ولكن رحابة الأفق تسمح أيضاً بالمقابلة بين النص الأدبي والحالة التاريخية أو الجغرافية أو البشرية في أدب آخر، ومدى انعكاسها على هذا النصّ أو درجات تأويله لها، وفي هذا الإطار يدخل في الأدب المقارن فرعٌ مهمٌ يتمثل في «صورة أُمة أو شخصية تاريخية في أدب أُمة أخرى».
ويفتح هذا التصور كثيراً من المجالات، ومن بينها مجالات أدب الرحلات وانعكاس الأُمم الأخرى في كتاباتهم، ومن أشهر النماذج في هذا الصدد الدراسة الموسّعة التي أعدّها الكاتب الفرنسي «جون ماري كاريه» حول «صورة مصر في كتابات الأدباء والرحالة الفرنسيين»، من أوائل القرن السادس عشر حتى أواخر القرن التاسع عشر، وقد أشرفتُ على ترجمتها للعربية وقدّمت لها، وصدرت عن مؤسسة البابطين بالكويت، ومثْلُها الدراسة التي أعدَّها تلميذه «أنور لوقا» عن «صورة فرنسا لدى الكتّاب والرحالة المصريين»، وقد صدرت كذلك مترجمة عن المؤسسة نفسها.
وفي هذا الإطار تأتي دراسة الدكتور هلال الحجري، عن صورة عُمان في كتابات المستشرقين الإنجليز، وتأتي اهتماماته المتواصلة بهذا الجانب الحيوي من جوانب الأدب المقارن.
وفي المجال التاريخي ظهرت أعمال في هذا الاتجاه؛ مثل «صورة صلاح الدين الأيوبي في الآداب الشعبية الأوروبية في القرون الوسطى»، وهو عنوان كتاب صدر لنا منذ فترة قليلة، وكانت قد سبقته دراسة لنا أيضاً حول صورة المسلمين في أنشودة رولان، وهي أقدم الملاحم الشعبية الفرنسية، ودراسة حول صورة الفرنجة في (ألف ليلة وليلة).
إن مجال دراسات الأدب المقارن ينبغي أن يأخذ على أقلام الدارسين ـ من أبناء الأُمة العربية والإسلامية ـ أبعاداً أوسع آفاقاً، دون أن يتجاهل المسارات التقليدية لهذا الفرع في منابعها الغربية الأولى، وهي المنابع التي حاولت أن تسم الآداب الغربية بالمركزية دائماً، وتصف غيرها بالهامشية، وظلّت تنطلق من هذا التصور فترة زمنية طويلة، وتمّ إنتاج كثير من الدراسات في إطاره، لكن نزعة الثورة على الانحسار في هذا الاتجاه عرفت في العقود الأخيرة، ولعل كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق كان أحد الكتب التي ناقشت تصورات ما بعد الكولونيالية أو الاستعمار، وأظهرت أن فكرة المركزية والهامشية من الأشياء التي وضعها الغرب المستعمر المستغل، وأنه ينبغي التحرّر منها، وإقامة ألوان أخرى من العلاقات ليس من الضروري أن يكون الغرْب هو مركزها الوحيد، بل إن العلاقات بين الأطراف بعضها مع بعض الآخر، أو بينها وبين بعض المراكز تكون واردة في الاهتمام والحسبان.
ولدينا ـ نحن المفكرين العرب والمسلمين ـ فرصة في إقامة دراسات خطّية متميزة بين آداب الشعوب الإسلامية بلغاتها المختلفة المتقاربة، خاصة أن بعض هذه اللغات كانت ذات نبع واحد أو متطابقة في الأصل، وأن حروف الكتابة بها كانت هي الحروف العربية في كثير من الأحيان، وأن بعضها وُلد مباشرة من رحم العربية ونسيجها، كما هو الشأن في اللغة السواحلية في شرق أفريقيا، التي وُلدت في ظلِّ الوجود العُماني الحضاري في هذه المناطق، أو مثل اللغة الأُردية التي اشتقت معظم مصطلحاتها من اللغة العربية، وكذلك الشأن في لغات آسيا الوسطى وجمهوريات الاتحاد السوڤييتي السابقة، التي كانت تكتب جميعها بحروف عربية، شأنها شأن اللغة التركية القريبة منها حتى سنة 1924، عندما ألغى كمال أتاتورك الحروف العربية من التركية، واستبدل بها الحروف اللاتينية، فتاهت معظم هذه اللغات بين الحروف اللاتينية وحروف الكيريل الروسية وكاد أهلها يفقدون هوياتهم، ويعجزون عن قراءة وصايا أسلافهم التي كتبت بحروف عربية، حتى وإن كانت بكلمات غير عربية.
إننا نستطيع أن ننظّم جهودنا العلمية انطلاقاً من إعادة الاهتمام بفرع الأدب المقارن، وتخصيص جانب من اهتمامنا من خلاله لدراسة العلاقات بين «آداب الشعوب الإسلامية»، ولا أريد أن أقول: بين «الآداب الإسلامية»؛ لكيلا يُساء فهم المصطلح، واتخاذنا منطلقات تقارب جذور القضايا والشواغل ووسائل التعبير أو حرية الاختلافات التي تمليها تنوعات الثقافات، واحترام هذه الحريات، وعدم تأطيرها سلفاً في أي منظور محدّد مهما كانت ميولنا.
لو استطعنا أن نصنع هذا ونجحنا في أن نعيد «الحرف العربي» والاستئناس به من خلال اقتراح أن تكون اللغة العربية لغة تعليمية ثانية في مدارس شعوب هذه الكتلة الواسعة والمهمّة من العالم، الذي هو مهيأ الآن، لاستقبال هذا المدّ الثقافي لو أحسنّا التخطيط والتنظيم الهادئ؛ لو نجحنا في النمو بهذه الفكرة لوجدنا أن «فرع الأدب المقارن» هو أنسب فرع يمكن أن نتخذ منه أداة ثقافية راقية لصناعة التقارب والمودة والإخاء في عالم يسود فيه العداء والشقاق، ويوجّه إلينا أصابع الاتهام بأننا لا نستطيع استثمار الكنوز التي بين أيدينا، وفي مقدّمتها كنوز الدراسات الأدبية والإنسانية، وعلى رأسها «الأدب المقارن».