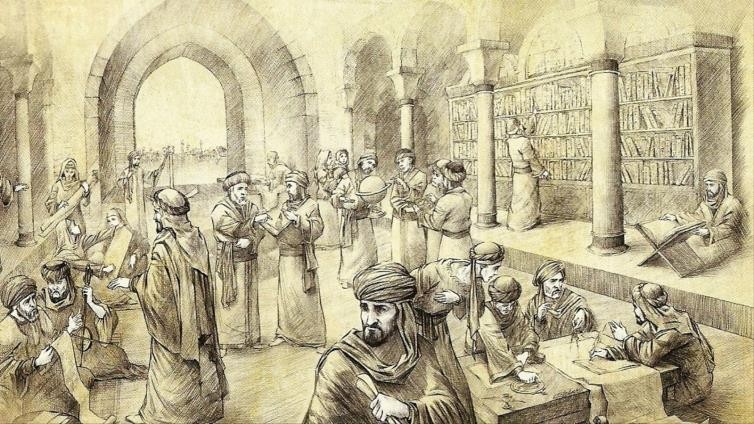رضوان ضاوي
"وحدها المعرفة تبقى حية بالتعلم، وتؤمِّن السبيل إلى الجنة" سباستيان غونتر
في إحدى كتب التأْريخ العربي (عرض تاريخي) التي تعود إلى القرن العاشر عن تاريخ مدينة بخارى في أوزباكستان الحالية نجد التقرير التالي: ((وفي أيام الأمير السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل شب حريق أيضاً في بخارى في شهر رجب سنة خمس وعشرين وثلاثمائة (937م) واحترقت جميع الأسواق، وكانت بدايته من دكان طابخ هريسة اللحم مع القمح في باب سمرقند حمل الرماد من تحت القدر وصعد به إلى السطح ليملأ به حفرة كانت على السطح، وكان بين الرماد جمرة ولم يكن يعرف، وحملها الريح وألقى بها على سياج من الشوك، فاشتعل جميع السوق، واحترقت محطة باب سمرقند بأجمعها. وكانت النار تسير في الجو كالسحاب وقد احترقت محلة "بكار"، وسُقيفات السوق، ومدرسة، "فاربك"، وسقف سوق "كفشكران" (أي الإسكافية)، وسوق الصيارفة والبزارين، وكل ما كان في بخارى بأجمعها حتى حافة النهر، وطارت شرارة فاشتعل مسجد ماخ واحترق جميعه، وظل مشتعلا ليلتين ويوما. وحار أهل بخارى في أمره ورأوا كثيراً من العنت إلى أن أطفأوه في اليوم الثالث. وظلت الأخشاب تحترق شهرا تحت التراب وخسر أهل بخارى أكثر من مائة ألف درهم، ولم يستطيعوا أبدا بناء عمارات بخارى كما كانت)).(2)
تطورت بخارى الواقعة على طريق الحرير، والمعروفة أصلا في القرون الوسطى، ابتداء من القرن الثامن- التي أصبحت الآن تحت الحكم الإسلامي- إلى مركز اقتصادي وفكري وثقافي مهم في آسيا الوسطى، وأصبحت من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر عاصمة للسامانيين، وهي سلالة إيرانية، مثلها مثل غيرها من الحكام المحليين، استقلت بالحكم عن الخلفاء العباسيين في بغداد، وأصبحت خاضعة لهم بالاسم فقط. ومع أن المعلومات شحيحة عن العديد من الأسواق والثروة الاقتصادية في بخارى؛ إلا أن هذا الوصف المقدم في البداية ينبغي أن يشكل مقدمة توضيحية إضافية لدراستنا هذه.
إن الأمر المهم في إشكالية هذه الدراسة هو المدرسة Madrasa (أو في الألمانية(Medrese ، لهذا تحتوي هذه المدرسة عن تاريخ بخارى في أوائل القرن العاشر على أقدم دليل تاريخي معروف عن وجود مدرسة؛ أي مؤسسة للتعليم العالي الديني والشرعي، والتي أثرت أساسًا وبشكل حاسم وحتى زمننا الحاضر في التاريخ الفكري والثقافي للإسلام منذ القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر وما بعده.
ولكن قبل الخوض بمزيد من التفصيل في المدرسة في إسلام العصور الوسطى، نريد أن نلقي نظرة على ما قبل التاريخ وسياق ولادة وتطوير هذه المؤسسة التعليمية المهمة. سنتعامل في الجزء الأول من هذه الورقة مع بعض المبادئ الأساسية للتعلّم الإسلامي في الإسلام المبكر، بما في ذلك المسجد بوصفه مكانا للصلاة والتعلم. أما الجزء الثاني فهو مخصص للجامعة-المدرسة وخصائصها من جانب التنظيم الإداري والتعليمي.
1. مبادئ التكوين ومثالياته
1.1 القرآن والسنة النبوية
بالنسبة للمسلمين فإن المفاهيم الأساسية للتعليم – التي نفهمها بشكل عام عمليةً كانت أو مسلسلاً أو نتيجةً للتدريس واكتساب المعرفة والقيم والقدرات - موجودة بالفعل في القرآن؛ أي في الكتاب المقدس للإسلام الذي بلّغه النبي محمد في القرن السابع. على سبيل المثال، تؤكد بعض الآيات القرآنية على أهمية العقل في التعليم عندما يقول الله تعالى:"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ" (سورة الزمر، الآية 9). كما ينص القرآن على أن الحاكم السياسي النموذجي- المتمثل في طالوت، الملك الأول والمشهور لإسرائيل- يجب أن يكون ذلك الشخص الذي اصطفاه الله "وزَادَهُ الله بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ"(سورة البقرة، الآية 246).
وعلى القدر نفسه من الأهمية بالنسبة للمسلمين حتى يومنا هذا، تكون الرؤى النبوية الواردة في أحاديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلّم) وفي تقارير عن سيرته النموذجية، وتشمل هذه الرؤى النبوية المقتبسة في كثير من الأحيان:" اطلبوا العلم ولو في الصين" و"طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة". تؤكد هذه المبادئ من هذا النوع على المثالية الإسلامية في اكتساب المعرفة التي لا تعرف حدوداً جغرافية أو ثقافية أو جندرية.
مع ذلك كان الالتزام باكتساب العلم مرتبطا بدرجة أقل أو أكثر بالآخرة في فترة الإسلام الكلاسيكية (من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر). في الآخرة فقط ومن خلال القرب الأعظم من الله يجد المؤمنون -وفق نظرة المسلمين التقليديين- سعادتهم الحقيقية ويحققون طموحهم الدنيوي.
1.2 الكتابات العربية الكلاسيكية
طور العلماء المسلمون ذوو الاهتمامات العلمية المختلفة والتخصصات اللاهوتية والفلسفية أو القانونية الآراء العلمية في التعليم في المجالات الدينية والعلمانية في العديد من الكتابات العربية، وخاصة بين القرنين 9 و13، وعمّقوها جزئيا في بعض النظم الفكرية بدرجات متعددة. بالنسبة لهذا التفكير العلموي لعبت مُثُل التعليم -التي عدّها المسلمون ربانية، ووردت في القرآن الكريم والتقليد النبوي- دورًا مركزيًا، فالتصورات التربوية والتعليمية في الإسلام لم تكن قليلة التأثير، فقد أدخلت المسلمين في السياق التربوي الإسلامي من خلال التلقي الإبداعي للتراث الفكري اليوناني والبيزنطي والإيراني والهندي القديم في القرنين التاسع والعاشر، ومن ثم أسلمة هذا التراث(3). ويشهد على ذلك بشكل خاص تلك الكتابات العربية الكلاسيكية االمكرسة عن وعي لمسائل النظريات والممارسات التعلميّة والتي يمكن عدّها كتابات تربوية مبكرة باللغة العربية(4)
2. معهد التعلّم وأشكال التعليم
كانت الجوامع في البداية أماكن تلقين المعرفة ذات التوجه الديني في بدايات الإسلام؛ ولكن المنازل الخاصة بالعلماء كانت تعمل بوصفها مراكز تعليمية حيث يتم تدريس طالبي المعرفة القرآن وتفسير القرآن والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي والقانون واللغة العربية وآدابها. وكانت حلقات التدريس في المساجد وفي منازل العلماء -من ناحية- مجالس غير رسمية يتلو فيها شيخ أو أستاذ للطلاب وحدة تعليمية في موضوع ما أو جزءًا من كتاب على شكل محاضرة بمساعدة شروحاته. ومن ناحية أخرى، كانت هناك حلقات تعليمية أو دراسية، يدّرس فيها أساتذة مضمون درس محدد، أو يعمقون الشرح فيه، أو يقوم الطلاب مع معلمهم أو المساعدين له بمراجعة المحاضرات التي يشرف التلامذة بعضهم على بعض في تدوينها، فيحفظون نصوص الدرس عن ظهر قلب، ويناقشون القضايا ذات الصلة بها(5).
يتجلى منهاج التعلم الكثيف نسبيا والتسلسل الموضوعاتي للمواد على سبيل المثال في الحلقة العلمية للفقيه الكبير محمد بن إدريس الشافعي (767-820)، الذي يعدّ مؤسس المذهب الشافعي، وقد نقل أحد طلابه بعض الأفكار من حياة الشافعي التعلمية، وبهذا المعنى يمكن عدّها ممثلين للإسلام المبكر(6).
بعدها تبدأ الدروس مبكرًا جدًا عند الفجر، وبعد صلاة الصبح كان الطلاب يأخذون أولاً دروساً في تلاوة القرآن وحفظه وبعد شروق الشمس يبدأ تلقين الطلاب السنة النبوية. كما تجري دروس في الشريعة الإسلامية مع مناقشات وحلقات الجدل في الصباح تالياً، ثم تدريس اللغة العربية، واللحن، وقواعد اللغة والشعر في وقت الظهيرة، ومن ثم تختتم بها دورة الدرس اليومية. بعدها يستغل التلامذة حصص ما بعد الظهر والمساء من أجل مراجعة الدروس والتعلم الذاتي. بالطبع أثناء سير الدرس كان هناك مجالات حرة بالنظر إلى التفضيلات الموضوعية للأستاذ أو الوضع العام المحلي للدرس.
2.1 المدرسة الابتدائية والمدارس المبكرة
بالإضافة إلى هذه الأشكال من التعليم غير الرسمي -ومعظمها على طريقة النقل الشفاهي- تطورت في وقت مبكر -يعني بداية من النصف الثاني من القرن السابع، وخاصة في القرنين الثامن والتاسع- مدارس بمعنى مؤسسة مرتبطة بمكان أو شخص معين، تخدم بشكل واضح أغراضا تعليمية. يتعلق الأمر هنا بالأماكن أو الغرف في الجوامع (منطقة جانبية في المسجد أو في ساحة المسجد) بالإضافة إلى منازل خاصة ومكتبات. وفي ظل ظروف معينة يمكن أن تكون مثل هذه "المدرسة" مماثلة للجامع، وهذا يفسره كون هذا الجامع معروفًا؛ لأنه يحمل اسم عالم معين.
وفي حين إن بعض هذه المباني ذات الأهداف التعليمية لم تكن لديها إشارة مميزة، فإن المدارس الابتدائية المبكرة كانت تسمى عادةً بكُتّاب أو مكتب؛ أي "مكان الكتابة" أو "المكان الذي يتم فيه تدريس الكتابة". ولا تخبرنا المصادر العربية بالشيء الكثير عن عدد الطلاب، والهندسة المعمارية، والمناهج الدراسية لهذه المدارس الابتدائية المبكرة، التي من المرجح استخدامها في التدريس القرآني، والتلاوة القرآنية، والقراءة والكتابة، وتبليغ المعارف الأساسية للممارسة الدينية، وكذلك أيضا معارف في قواعد اللغة العربية والتاريخ الإسلامي والشعر العربي والنثر، كما ورد في الكتاب المخطوط المؤلَّف في القرن التاسع وكتبه محمد بن سحنون القيرواني (817-870) الذي انتهت إليه الرئاسة في الفقه في تونس الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين يتسلمون أجورهم من آباء التلاميذ(7).
إن الانطباع عن الإمكانات التعليمية الهائلة للمدن العربية في العصور الإسلامية المبكرة، والتي لم تقتصر على النخب فحسب، بل شملت أيضا عامة السكان، وصفه في القرن التاسع عشر مؤرخ بغداد اليعقوبي (توفي عام 905) الذي كتب في كتابه الكبير "تاريخ بغداد" أنه في بغداد في القرن التاسع، كان هناك 30000 مسجد في الجانب الغربي من العاصمة العباسية و15 ألف مسجد آخر في الجانب الشرقي. في حين إن هذه الأرقام لا يمكن عدّها مبالغاً فيها بالمطلق، فهي تعطي صورة رائعة وشاملة للتعليم في الإسلام في العصور الوسطى، خاصة إذا أخذنا بعين الاهتمام أن كل مسجد لا يستخدم فقط كمكان للصلاة ولكن أيضًا كمكان للتدريس(8).
2.2 التعليم العالي
كانت الدروس في التعليم الديني العالي -سواء في مسجد أو في منزل خاص- مرنة وغير رسمية؛ فلم تكن هناك مناهج دراسية ثابتة ولا اختبارات، ومع ذلك فقد تم تحديد مواعيد ومكان جلسات التدريس وتثبيت أسماء الحاضرين كتابة، ونجد هذا الأمر باستمرار مثبتاًذ في "السماعات"(شهادة الحضور) المكتوبة على المخطوطة المستخدمة للتدريس.
السماعات (شواهد الحضور)
من ناحية تؤكد السماعات(شواهد الحضور) الحضور المادي المعين لبعض الأشخاص في وحدة التدريس، من ناحية أخرى تثبت حقيقة أن هؤلاء الأشخاص "سمعوا" النص أو النص الذي تم الاشتغال به في هذه الوحدة التعليمية، مما يعني أنه قد تم تدريس هذا المضمون في تلك الوحدة. وغالبًا ما يتم تعيين السماعات(شواهد الحضور) بخطوط لمنع إضافة أسماء طلبة من وحدة تدريس لاحقة إلى أسماء الأشخاص الآخرين الذين لم يحضروا الفصول الدراسية(9).
مثال قد يوضح هذا الأمر: يتعلق الأمر سماع (شهادة الحضور)، وهي موجودة في مخطوطة عربية فريدة من نوعها تحمل عنوان "رياض المتعلمين". كُتِبَ المخطوط في القرن العاشر بدمشق على يد عالم الدين ابن السني (توفي عام 974)، ويحتوي الكتاب على مجموعة من سبعة فصول مصنفة بحسب المواضيع، من أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تهتم تمهيديا بكيفية تدريس وتعلّم حقول مختلفة من المعرفة، وبالاشتغال تعليما وتعلّماً في بالمجالات الدينية مثل القرآن والسنة النبوية، وكذلك في التخصصات الدنيوية مثل الشعر العربي، وعلم الأنساب، والهندسة، والهندسة المعمارية.(10)

بشكل عام يمنح المدّرس الطالبَ أو الطلبة حق نقل نص واحد أو أكثر مرفوقاً عادة بتقرير شفهي أو مكتوب، يطلق عليه في اللغة العربية مصطلح "إجازة"("تصريح"، "شهادة"). وللحصول على هذا الإذن -على سبيل المثال، خصوصا من مدرّس بارز- غالبًا ما كان الطلاب يسافرون لمسافات طويلة. إن النموذج العملي المركزي للتعلّم العابر للأقاليم وللبلدان والدراسة في كل من العلوم الدينية وغير الدينية -وهو ما يُعرف في الإسلام بمصطلح "طلب العلم" ("البحث عن المعرفة")- أصبح عبارة سائرة؛ فلم يقتصر هذا النوع من التعلّم عبر الإقليمي على اكتساب المعرفة فقط؛ ولكن ظهرت أيضا شبكات تعليمية واسعة النطاق(11)
"محاضرات عمومية ضخمة"
بالإضافة إلى المحاضرات وحلقات الدروس الفردية التي يحضرها عدد محدود من الطلبة، كانت هناك محاضرات منظمة مفتوحة أمام الجماهير. ومن أبرز الأمثلة على ذلك عالم الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، والذي- كما يوحي اسمه- جاء من بخارى. اشتهر البخاري بمراجعته النقدية ونشره للنصوص التي تحتوي على أحاديث النبي أو تقارير عن سيرته في القرن التاسع. بالنسبة لغالبية المسلمين حتى اليوم، نال كتاب البخاري التجميعي أعلى مرتبه بوصفه أصحّ كتب الحديث والسنة النبوية.
يُذكر أن محاضرات البخاري في السيرة النبوية في بغداد كان يحضرها ما لا يقل عن 20،000 طالب. على الرغم من أن هذه الأرقام المطلقة مبالغ فيها بالتأكيد، فإنها تعطي انطباعًا عن المدى المدهش والشعبية الكبيرة لطرق نقل المعرفة الدينية العامة هذه في الإسلام في القرون الوسطى. وقد تم تقديم هذه الأنشطة بطريقة تنظيمية بحيث قام الطلاب بتجميع أنفسهم في صفوف حول العالم، وتم تكليف "مبلّغ" على فترات منتظمة لكي يكرر قول العالم بصوت عال على أسماع المحاضرين الذين يجلسون خلفه، وبهذه الطريقة تتم إعادة نقل الكلام(12).
حلقة للاستماع والإملاء والاستملاء (في المسجد)
ويمكننا الحديث بطبيعة الحال عن حلقة الاستماع العمومية الضخمة؛ ففي هذه الحالة يؤثر وجود "مساعد إملاء" (مُستمْلٍ) مدرّب بشكل جيد، وغالباً ما يكون مهنياً محترفا، أو حتى وجود العديد من الأشخاص الذين وظفهم الشيخ أو المدرّس في هذه الوظيفة، فيقوم بإملاء نصوص محاضرة الشيخ من مكان مرتفع على الطلاب، كما يهتم "المُستمْل" بوصفه مقربا من الشيخ (وحاصلا على ثقة الشيخ) بضمان الهدوء والنظام قبل وأثناء المحاضرة (13).
على سبيل المثال عندما زار البخاري مدينة البصرة العراقية لتشييد معهد للإملاء مثل هذا المعهد الكبير، تم الإخبار عن هذه المعلومة علنا من قبل مناد في المدينة. فقد ثبت أن النداء هو أفضل طريقة للإعلان؛ لأن هذه المعاهد الجماهيرية لم تكن مقتصرة على المساجد فحسب، ولكن كانت الدروس تُلَّقن أيضًا في الشوارع والميادين العامة، مما جعلها حدثًا حضاريًا كبيرًا. فإلى أي مدى يمكن إذاً الحفاظ على الأمانة اللغوية للنص الأصلي في هذه الحالة وفي هذا اللون من التعلّم(14)؟
حلقات الدرس الفردية
فضّل المتصوفة المسلمون أشكالاً أخرى للتعلّم مثل التدريس في المجموعات ذات الأعداد المحدودة من أجل أنواع روحية أخرى من التعليم، ووجدوا أن الخانقاه أو الخلوات المشتملة على قاعات الدرس فضلاً عن الأماكن المشابهة التي تم استخدامها للتنوير الروحي والتأمل الصوفي والتعليم (الزاوية، الرباط) هي الأنسب لأغراض التدريس والإقامة، كما تم استغلال أضرحة العلماء أو الشهداء والمساجد الصغيرة والمناطق والمساكن بالعلماء من أجل التعليم الديني. وبالمثل جرى التكوين الفلسفي وكذلك التعليم في العلوم الطبيعية في دائرة صغيرة نوعا ما، وهذا يعني في المنازل الخاصة والمكتبات والمراصد أو - عندما يتعلق الأمر بالتعليم الطبي- في مستشفيات مثيرة للدهشة مجهزة تجهيزا جيدا في ذلك الوقت(15).
الجامع المدرسة (الجامع أو المسجد الذي يستخدم للتدريس)
كان المسجد وما زال مكانًا مهما للتعليم خلال القرون الأولى للإسلام، ويعدّ مسجد الزيتونة أحد أقدم وأشهر جامع- مدرسة في تونس اليوم. يؤرخ لبدايات جامعة الزيتونة بأوائل القرن الثامن. وفي وقت لاحق، تطور إلى مؤسسة مهمة للتعليم الإسلامي العالي في المغرب العربي، واليوم يعدّ الزيتونة أقدم جامعة في العالم الإسلامي.
وبالمثل نذكر جامع القرويين في المدينة العتيقة بفاس. هذا الجامع بنته فاطمة الفهرية في سنة 859، وهي الابنة التقية لتاجر ثري اسمه محمد الفهري الذي كان في الأصل من مدينة القيروان التونسية. سمي هذا المسجد على اسم حي يوجد فيه في فاس، ويعيش في هذا الحي المهاجرون من القيروان، ولهذا عُرف المسجد باسم القرويين(16). وقد تم توسيع مجمع القرويين على نطاق واسع من قبل السلالات البربرية المحلية الحاكمة في المغرب في القرنين العاشر والثاني عشر. ومنذ ذلك الحين لعب جامع القرويين دورا مهما في المنطقة المغاربية بوصفه مركزاً للتعليم الديني والثقافي والاجتماعي(17).
أسس الفاطميون (909-1171 في شمال إفريقيا) الأزهر في القاهرة في 970، ويعني الاسم المُشْرِق أو المزهر. كان الأزهر في البداية مسجدًا للإمام الخليفة ومحكمته، وبعد ذلك -وفي وقت مبكر من سنة 988- أمر وزير دولة الفاطميين ابن كلّس -توفي991) )- ببناء مبنى ملاصق لجامع الأزهر مخصص لأغراض تعليمية فحسب، ما يعني أنه مخصص لخدمة تدريس الشريعة الإسلامية. ومع استلام الأيوبيين (1171-1250) السلطة في مصر أصبح الأزهر مسجدًا سنيّا وجامعة تعليمية، وظل كذلك حتى يومنا هذا. تعدّ هذه المؤسسة التعليمية -التي مضى عليها أكثر من ألف عام عند العديد من المسلمين -أهم جامعة دينية في العالم الإسلامي(18).
لقد كان هناك ارتباط وثيق بين الجامع والجامعة في الإسلام في العصور الوسطى؛ يقدم جورج مقدسي- في كتابه "نشأة الكليات، معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب" الرائد حتى يومنا الحالي دراسة كلاسيكية عن المؤسسات المركزية للتعليم الإسلامي، ويلخص المؤلف هذه الظاهرة؛ إذ يرى أنه على يقين من أن "الجامع هو النوع الأول للمعهد [أو للمدرسة] في الإسلام"(19). لكن المقدسي يشير إلى جانب آخر مهم عندما يذكّر بأن المدرسة هذه المخصصة للتعليم العالي كانت تُسيّرها المؤسسات التي تدفع رواتب هيئة التدريس أو المعلم من ثروتها. وفي معظم الحالات، يكون إمام المسجد (أو نائبه في الصلاة) نفسه هو الشخص الذي يُدرّس فيها. أما التلامذة فيستفيدون من المؤسسة طالما أنهم لا يدفعون أية رسوم مقابل دراستهم. ومع ذلك كان على التلامذة التكفل بسكنهم وبمعيشتهم(20). وبعبارة أخرى، موّل في الغالب أفراد أثرياء مدارس الجوامع المبكرة أو على الأقل قدموا لها الدعم من الناحية المالية، وهذا الدعم المالي الممنوح للتعليم الجامعي في الجوامع يختلف كثيراً عن هذه الاجتماعات غير الرسمية والحلقات الدراسية ذات الدلالة، والمجالس والحلقات التي تقدّم في المساجد، التي لم تكن ممولة من قبل داعم متبرع.
3. المدرسة
3.1 عن المفهوم
المدرسة هي المؤسسة التعليمية للتعليم الإسلامي الأعلى بامتياز. تشتق كلمة المدرسة العربية من الجذع الأساسي للفعل درس darasa الذي يعني في الشعر العربي القديم والعربية الكلاسيكية "ترويض الحيوان" أو بشكل عام يعني "علّم"، ويعني الشكل الثاني من الفعل "درّس"- darrasa - "ترك شخص ما يقرأ" أو "دعوته للدراسة". ومن ثم، فإن المدرسة تعني "مكانًا للقراءة" أو مكانا "يحدث فيه التدريس والدراسة".(21) ومن الناحية اللغوية ليس لكلمة "مدرسة" بالضرورة دلالة دينية، وفي المدرسة العربية الحديثة تعني مدرسة بسهولة "مكان الدراسة".أما في الفترة الكلاسيكية من الإسلام فإن كلمة المدرسة تشير قبل كل شيء إلى تأسيس تعليم متخصص ومهني في الشريعة الإسلامية والمجالات ذات الصلة. وهذا هو السبب أيضا في أن المدرسة تُترجم في الغالب إلى اللغة الإنجليزية (والآن باللغة الألمانية أيضًا) كـ"جامعة" أو "معهد للشريعة" أو "معهد للشريعة الإسلامية".
المدارس القائمة على الأفراد
تعود الدلائل المبكرة لمدارس التعليم العالي التي يشار إليها باسم "مدرسة" كما ذكرنا إلى بداية القرن العاشر. ربما تعلق الأمر في المقام الأول بالمؤسسات التعليمية الأصغر حجماً، التي كانت توجد في الجوار المباشر لجامع أو تتبع له، وقد وُجدت المدارس في وقت مبكر ملحقة بالبيوت الخاصة بالعلماء أو كانت موجودة مباشرة في جوارها، وقد تم تأسيس هذه المدارس الدينية المبكرة إما من قِبَل العالم نفسه أو من قبل مساعده، وكانت مهيّئة كليّا وبشكل خاص من الناحية التقنية لهذا العالم ولمذهبه الفقهي(22).
وعلى ما يبدو لعبت المدن والمناطق الواقعة إلى الشرق من الإمبراطورية الإسلامية دوراً رائداً في تشييد وتطوير المدرسة؛ فبالإضافة إلى مدينة بخارى نذكر في المقام الأول مدينة نيسابور في شمال شرق إيران، التي تعدّ في المصادر العربية المبكرة مكاناً يضم العديد من المدارس الدينية بامتياز، إن لم تكن المهد الفعلي لهذه المؤسسة التعليمية، ولم تكن نيسابور (مثل بخارى) مدينة تجارية معروفة على طول طريق الحرير فحسب، ولكن كانت أيضًا مركزًا عسكريًا وإداريًا مهمًا. في الواقع تعدّ نيسابور ما بين 950 و 1050 أكبر مدينة في العالم الإسلامي- بعدد سكانها الذي وصل إلى مائتي ألف نسمة- رغم أنها لا تقع على نهر يجري فيها أو منفذ على البحر، ومن المرجح أن يكون هذا هو الدافع الذي جعل منها أرضاً خصبة لتشييد العديد من المدارس(23).
والسؤال المطروح هو: لجأنا وصلنا في الإسلام إلى الجامع من أجل إنشاء المدرسة بوصفها مؤسسة للتعليم العالي الديني والقانوني، هذا سؤال لم يتم الإجابة عنه بشكل نهائي في الدراسات الإسلامية. وفي رأيي يجب النظر هنا في ثلاثة جوانب على الأقل:
أولاً: إن التطور الديناميكي للغاية للثقافة والحضارة الإسلامية في عهد العباسيين -ابتداء من منتصف القرن الثامن- جعل من الضروري أن تتكيف أساليب التدريس والتبادل العلمي الملموس مع الاحتياجات الاقتصادية والثقافية المتنامية، وأن "تدعمها" إلى حد ما في مجال التعليم. وفي هذا السياق -في النصف الثاني من القرن الثامن- انتقل الجدل والمناظرة بوصفهما نوعين جديدين من التبادل الأكاديمي النشط للآراء إلى قصر العباسيين أولا. وسرعان ما اتخذتا مكانة حسّاسة في القصر، وأصبحت تمَارس باستمرار من قبل علماء خارج القصر أيضا، وينطبق هذا الأمر أيضاً على النقاشات المثيرة للجدل بين الاتجاهين الرئيسين للاهوت الإسلامي في ذلك الوقت: التقليديين (الأرثوذكس) والأشعريين من جهة والمعتزلة العقلانيين من جهة أخرى.
غير أن مجالات رئيسة أخرى للعلم الإسلامي بدأت أيضا في اكتشاف الجدل في ذواتها: كما عند النحويين والنقاد الأدبيين، وكذلك علماء العلوم الطبيعية والأطباء. وعلاوة على ذلك فإن النقاش والمناظرة والحوار كسبل للتدريس والتعلم "التفاعلي" -كما نقول اليوم- قد تم الاعتراف بها واستخدامها من قبل العلماء والمتعلمين، بوصفها وسائل دفاع فعّالة للدفاع عن العقيدة في وجه المعارضين أو وسيلة لتعميق وترسيخ ما تم تعلّمه.
وعلى مدار التاريخ زادت أهمية طرق التعليم هذه بالمقارنة مع طرق التدريس التقليدية التي تقتصر فيها وظيفة الطلاب على إعادة نسخ وحفظ النص المنقولة شفاهة(24). ومع ذلك بقي الجامع غير مناسب للدروس "التفاعلية" مع أعداد كبيرة من الطلبة، ويمكن القيام به بشكل أفضل في المدارس - المدارس الدينية - خارج الجوامع والمنازل الخاصة، على الرغم من أن المباني المدرسية التي تم بناؤها حديثًا كانت في الغالب قريبة مباشرة من الجامع أو من منزل خاص لأحد العلماء. لذا يبدو أن الأمر يتعلق هنا بظاهرة التاريخ التعليمي التي بموجبها تتطلب الأهداف الجديدة والأشكال للتدريس تشجيع وتطوير بناء مؤسسة تعليمية جديدة-المدرسة في حالتنا-(25). وثانياً: كان القرنان التاسع والعاشر الميلاديان عصرا للتفاعل الحيوي بين كليات الشريعة السنية المتنافسة، ونظرًا لأن المدرسة المبكرة كانت مصممة خصيصًا لشخص عالم واحد وما يمثله من رأي تعليمي أو مذهب شرعي؛ فقد عزز هذا النوع من التعليم - الذي أصبح مؤسسيًا - مكانة الطقوس الشرعية ووضعية التدريس الشرعية الذي يتم تدريسها هنا، وأسهم في انتشارها.
ثالثًا: هناك أيضًا سبب عملي أهم للانتشار السريع للمدرسة، ويرتبط ذلك بحقيقة أن التلاميذ غالبًا ما يسافرون على نطاق واسع للانضمام إلى عالم معين لفترة معينة من الزمن. أخذت المدارس (Madrassa-Schulen) هذا بعين الاهتمام فأصبحت تضم مبنيين أحدهما للتدريس والثاني لإيواء الأساتذة والتلامذة. فبالنسبة لهذه المجموعة المعيّنة من الناس في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى -الذين يطلق عليهم اسم "أهل العلم"-، قدمت لهم المدارس خدماتها بصفتها ليس فقط مؤسسة تعليمية؛ بل أيضاً بصفتها نُزُلاً(26).
في كثير من الأحيان كانت المدارس الدينية - وكذلك بعض المساجد المستخدمة لأهداف تعليمية - تابعة للخان، والخان كلمة ذات أصل فارسي تعني "موضع سكن" أو "نُزل"، وتشير إلى الغرف التي تخصص لإقامة الطلاب وكذلك المسافرين بشكل عام وأحيانًا للفقراء. هذه الحقيقة تؤكد أنه في القرن الرابع عشر كان الرحّالة المشهور -الكثير الرحلات- ابن بطوطة (1304- 1377) قد ذكر في رحلته الكبيرة والمعروفة بالعنوان القصير "رحلة ابن بطوطة" العديد من المدارس الدينية التي كانت تقدم خدمة الإقامة.
3.3 المدرسة بوصفها جامعة عامة
النظامية
ارتبطت هذه الخطوة النوعية المهمة في تاريخ المدرسة باسم نظام الملك (1018-1092) في القرن الحادي عشر. وكان نظام الملك وزير الدولة المؤثر في دولة السلاجقة، وهم سلالة من الأمراء الأتراك السنة التي حكمت أجزاء واسعة من سوريا والعراق وإيران وآسيا الوسطى في القرنين الحادي عشر والثاني عشر تحت السيادة الاسمية للخلفاء العباسيين. وقد نجح السلاجقة الأتراك (1040-1194) في إعادة الوحدة السياسية للعالم الإسلامي المتشرذم بشكل متزايد في الشرق.
كان وزير دولتهم- اسمه الشرفي نظام الملك، وهو اسم يعني "منظم المملكة" أو "نائب الملك" -سبباً في إنشاء جامعات دينية في بغداد أولاً، عاصمة الإمبراطورية العباسية، ثم في مدن أخرى في العراق وإيران. تم تأسيس أكبر وأهم هذه المدارس في بغداد في عام 1067 وسميت على اسم مؤسسها "المدرسة النظامية" أو حتى باختصار "النظامية" - وهو الاسم الذي تم نقله فيما بعد إلى مدارس أخرى من هذا النوع.
تعود أصول نظام الملك إلى نيسابور على الأرجح، وكان قد تعرف على مؤسسة المدرسة في مسقط رأسه وأعجب بها، وربما أدى به هذا الإعجاب إلى إنشاء هذه المؤسسة التعليمية في بغداد وأجزاء أخرى من الإمبراطورية. لكن على خلاف المدارس الدينية المبكرة التي أسسها بشكل خاص عالم ما، والتي تم تصميمها خصيصًا لشخص هذا العالم، فقد قام ممثل الدولة بإنشاء النظامية والاهتمام بها (وبجامعاتها ذات التوجه الديني المقارن). فمن ناحية كانت مباني هذه الجامعات الجديدة أكبر بمرات عديدة من مباني المدارس الصغيرة الخاصة. ومن ناحية أخرى، تم توظيف هيئة تدريس محترفة في هذه الجامعات الجديدة تحصل على رواتبها من مؤسسة خيرية، وتم تنظيم العملية التعليمية مؤسساتيا بها. وقد أصبح هذا الشكل الجديد من الجامعات الدينية -التي كانت تميز الإسلام الكلاسيكي- مكمّلة للجامع في مجالات علمية مهمة بوصفها مؤسسة تعليمية، ولكن دون أن تزيحه أو تزيح مدارس الجامع من مكانتها باعتبارها فضاء للتعلم. على العكس من ذلك، كان العديد من التلامذة والأساتذة ينتقلون بحرية بين هذين النوعين من المؤسسات التعليمية، تدفعهم في ذلك طموحاتهم واهتماماتهم الأكاديمية فوحسب(27). وتم استدعاء عالم الدين الفقيه الشافعي أبي إسحق الشيرازي (1003-1083) ليتولى أول كرسي تعليمي للفقه الشافعي في مدرسة النظامية البغدادية، وشغل هذا المنصب لمدة 16 عاما. ومع ذلك فإن أشهر أستاذ وعضو في النظامية، هو -بلا شك- عالم الدين المهم الفقيه الشافعي والصوفي أبو حامد الغزالي (1058-1111).
وبالنسبة للغزالي فإنه يرى أن نقل واكتساب المعرفة الدينية والروحانية بوصفها الصلة الأساسية للإنسان مع الله هما أهم المضامين الأساسية في حياة المسلم المتديّن. وقدمت التصورات ذات الصلة بالموضوعات الرئيسة لإبداعه الفكري، وهذه الحقيقة واضحة في عمله الكبير بعنوان"إحياء علوم الدين"، وكذلك في العديد من كتاباته اللاهوتية الصوفية التي تهتم بالقضايا التعليمية والتربوية أيضا. وفي الحقيقة إن هذه المواضيع لم تكن مجرد أسئلة عن التأمل النظري عند الغزالي؛ فقد نجح في تطبيقها، وهو ما تظهره على الأقل الشعبية الكبيرة لدروسه التي كان يشارك فيها 300 طالب أو أكثر في كل محاضرة علمية له.
المستنصرية
وهناك مؤسسة أخرى مشهورة للتعليم العالي في بغداد هي المدرسة المستنصرية وهي مدرسة للشريعة الإسلامية. ولأول مرة في تاريخ المدارس الإسلامية العامة أصبحت المستنصرية مدرسة عالمية؛ ذلك أن التدريس فيها لم يكن مقتصراً على مذهب ديني واحد من المذاهب الفقهية السنية الأربعة، ولكن كانت منفتحة على تلقين المذاهب الأربعة كلها.
وفي نفسه الوقت؛ فإن المستنصرية هي المؤسسة المدرسية الوحيدة التي يملكها الخليفة العباسي، فقد تم تشييد مؤسسة المستنصرية على الضفة الشرقية لنهر دجلة عام 1227 بناء على أوامر الخليفة العباسي السابع والثلاثين المستنصر بالله (1226-1242)، وعندما اكتمل البناء عام 1234، أمر الخليفة وزيره المؤيد بالدين ابن العلقمى (1197-1258) بتعيين أول "أستاذ للدار"؛ أي أول رئيس لهذه المؤسسة. كان هناك أربع قاعات كبيرة مستطيلة الشكل متصلة بمبنى من طابقين، وكانت مغطاة بقبة أسطوانية، وكل قاعة من هذه القاعات كانت محجوزة من أجل استخدامها من قبل واحدة من المدارس السنية الرئيسة الأربعة: الشافعية، والحنفية، والحنبلية والمالكية.
أمّا الأساس المالي للمستنصرية فقد كان مؤسسة ضخمة للخليفة تدر مداخيل من عدة عقارات وقرى. وفرت هذه المؤسسة رعاية ما يقرب من 400 عضو في المدرسة، منهم حوالي 300 يقطنون بالمدرسة(28) وقد زار ابن بطوطة المستنصرية في القرن الرابع عشر وأعطانا مؤلف "رحلة ابن بطوطة" انطباعًا حيًا عن المستنصرية حين تحدث عن الجانب الشرقي من بغداد ، فكتب ابن بطوطة:
"وهذه الجهة الشرقية من بغداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب، وأعظم أسواقها سوق تُعرف بسوق الثلاثاء، كلّ صناعة فيها على حدة، وفي وسط هذا السوق المدرسة النظامية العجيبة التي صارت الأمثال تُضرب بحسنها، وفي آخره المدرسة المستنصرية ونسبتها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله أبي جعفر بن أمير المؤمنين الظاهر بن أمير المؤمنين الناصر، وبها المذاهب الأربعة، لكلّ مذهب إيوَان في المسجد، وموضع التدريس، ويكون جلوس المُدرّس في قبّة خشب صغيرة على كرسيّ، عليه البسط، ويقعد المدرّس، وعليه السكينة والوقار، لابساً ثياب السواد معتمّاً، وعلى يمينه ويساره مُعيدان يُعيدان كلّ ما يـُمليه، وهكذا ترتيب كلّ مجلس من هذه المجالس الأربعة"(29).
وبالنسبة لقاعات الدراسة وقاعات الاجتماعات نجد في المستنصرية خمس قاعات كبيرة للمحاضرات وقاعة محاضرات صغيرة ومكتبة للقراءة وغرفة تخزين وقاعة للصلاة ومطبخ مع مخبز وقبو تخزين ومستشفى يضم غرفة للعلاج الطبي ومستوصف وصيدلية، بالإضافة إلى مرافق أخرى مثل الحمام والفناء والحديقة. وحتى قبل الافتتاح الرسمي للمستنصرية زار نائب وزير الدولة الجامعة برفقة رئيس الجامعة وقام بتقبيل العتبة عند مدخل المبنى أولاً، ثم قام بتفتيش المبنى، وبعدها بتسليم ثوب الشرف إلى المدير وأخيه، بالإضافة إلى صندوق يحتوي على مصاحف، ومجموعة كبيرة من الكتب القيمة.(30)
احتاج الأمر بالضرورة 160 حاملا لتوضع عليها كتب الجامعة التي تم تسجيلها هناك على الفور بدعم من أمين مكتبة الخليفة العباسي الذي زار بنفسه بعد بضعة أيام الكلية في إطار احتفالي أكبر. ولكن يبدو أن حفل الافتتاح الرسمي للمؤسسة في 6 أبريل 1234 قد تجاوز كل شيء يمكن تخيله،(31) وإضافة إلى مشاركة أغلب ممثلي الدولة العباسية في الحفل، اجتمع هناك أيضا العديد من مديري إدارة الخزينة، والقضاة، والمعلمين، والشخصيات الدينية، والمتصوفة، والخطباء، وقراء القرآن، والشعراء وعدد كبير من التجار الأجانب، كل هؤلاء كانوا هناك معا.
وكان الجزء المركزي من الاحتفال مأدبة كبرى في ساحة الجامعة، حيث تم تقديم العديد من الهدايا إلى هيئة التدريس والموظفين الإداريين وباقي الحضور. عندما قام المسؤولون الحكوميون وكبار الشخصيات في نهاية النشاط وغادروا مسرح الحفلة، كان الخليفة يشاهد مقتطفات لضيوف الشرف من خلال نافذة في وسط القاعة المركزية الفخمة (الإيوان)(32).
وفي حين تم تدمير معظم المؤسسات التعليمية في العصور الوسطى في العراق خلال الغزو المغولي في عام 1258، تم إنقاذ المستنصرية من هذا المصير. ومع ذلك فقد سُرقت مكتبتها وتم إغلاقها مؤقتًا، ثم تم إصلاحها بعد عقد من الزمن، لتستأنف تقديم خدماتها بصفتها مؤسسة تعليمية حتى أواخر القرن السابع عشر. وفي منتصف القرن العشرين تم ترميم مجمع المباني الذي يضم الآن متحفًا للثقافة والفنون الإسلامية.
4.3 دوافع بناء مؤسسات الجامعات الدينية
توجد العديد من الدوافع المهمة التي دعت إلى إنشاء مثل هذه المرافق الأكبر حجماً في القرنين الحادي عشر والرابع عشر. أولاً: ازدادت حاجة الحكام لموظفي الدولة المتعلمين أكاديمياً في مجالات مختلفة، من أجل خلق إدارة وظيفية وفعّالة في ظل السياقات المعقّدة المتزايدة اجتماعياً وسياسياً (تحت السيادة الاسمية للعباسيين).
وثانياً" يسمح الأساس المالي الذي يقدمه الأفراد أو المسؤولون الحكوميون في شكل مؤسسات بالتدبير المالي السليم والطويل الأجل لمثل هذه المرافق. ثالثاً وليس آخراً: أسهم على ما يبدو التنافس الديني والثقافي بين بغداد السنية والقاهرة الخاضعة لحكم الشيعة الفاطميين - والتي كانت في ذلك الوقت قوية اقتصادياً- في تكاثف جهود الحكّام في بغداد، من خلال مبادرات سنية متظافرة في مجال التعليم المؤسساتي لمواجهة التأثير الشيعي المتزايد.
3.5 المنهاج وأهداف الدراسة
يضم المنهاج الدراسي في الجامعات المدرسية في العادة خمس مجالات تعليمية:
(1) الدراسات الدينية، بما في ذلك:
أ) القرآن: التفسير والقراءات المختلفة للقرآن.
ب) السنة النبوية (الحديث)، والتي تتضمن كذلك السير الذاتية للرواة (التراجم ).
ج) أسس الدين الإسلامي (علوم الدين).
(2) الشريعة الإسلامية (الفقه)، ويشمل:
أ) أسس الفقه الإسلامي القائم على الدين (علوم الفقه) مع مبادئ ومصادر ومنهجية الشريعة بشكل عام، وخاصةً المدارس الدينية (المذاهب) التي ينتمي إليها الطالب.
ب) الفروقات بين المدارس السنية الرئيسة الأربعة (السلف).
(3) اللغة العربية، قواعد اللغة (النحو) والأدب.
(4) المنطق (الجدل).
(5) الحساب (الرياضيات) وأصول الفلك (علم النجوم)،
بالإضافة إلى الدورات العادية التي تدرس محتويات هذه المواد، قدّم الأساتذة أيضا المشورة التشريعية في شكل فتوى أو موعظة أو جولات نقاش للمعلمين والطلاب المتقدمين (المناظرات)(33).
يُنظر إلى هذه العلوم الإسلامية المحلية الدينية والفقهية وأيضاً ما يصاحبها من التخصصات الأخرى من الموضوعات المصاحبة على أنها أساسية لنشاط موظفي الدولة(34). وكان تصميم المواد الدراسية يهدف إلى ضمان استعداد خريجي المدرسة الجيدة للقيام بهذه المهمة وفي الوقت نفسه يكتسبون الإيمان الحقيقي. ويجب التنويه على أن تلقين المعرفة الكافية في المجال الديني يتم من خلال تدريس القرآن الكريم، وتفسير القرآن والسنة النبوية. كذلك لم يكن يستغنى عن مهارات التعبير اللغوي الجيد في تطور الأفكار المنهجي والمنطقي في المسائل الفقهية؛ وكانت هناك حاجة ملحّة للمعرفة الرياضية والفلكية من أجل الإدارة الفعّالة لمرافق الدولة وكذلك من أجل تطوير العديد من المجالات الحيوية الأخرى في المجتمعات الدينية، مثل تحديد أوقات الصلاة.
كانت المواد الأجنبية غير الإسلامية في الأصل- خاصّة الفلسفة العربية الإسلامية المبنية على الفلسفة اليونانية القديمة- مفقودة في المناهج الدراسية العادية للمدرسة الكلاسيكية. أحد الأسباب الرئيسة لذلك هو أنه كان يُنظر إلى بعض المبادئ الفلسفية على أنها متناقضة مع المذاهب التوحيدية المركزية للإسلام: ("الله قادر وعليم"، "الله هندس بداية العالم، والعالم لن يبقى للأبد"، "هناك بعث بعد الموت")(35)
ويبدو مع ذلك أن العلوم الرياضية والفلسفية وكذلك اللاهوتية الاستطرادية (علم الكلام) قد وجدت طريقها إلى الفصل الدراسي في مرحلة مبكرة نسبيًا في بعض المدارس الدينية الإيرانية في مجال حكم الإمارة السلجوقية، وهو تأكيد يخفف نسبياً من صورة منهاج المدارس الجامد وغير المتغير إلى الأبد-(36).
ولا يبدو أن التسلسل اليومي للدورات الدراسية في المدرسة مختلفا عن التدريس في المساجد أو الحلقات الخاصة للعلماء؛ فبعد صلاة الصبح يكون البدء بالقرآن والتفسير، متبوعًا بالسنة النبوية والشريعة الإسلامية والمنطق والعربية والقواعد والأدب. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من العلماء يتنقلون لإلقاء دروسهم بين إحدى المدارس الدينية والجامع وفي بيوتهم الخاصة.
وعن الأهداف العامة لاكتساب المعرفة في المدرسة يتحدث عالم الشريعة المشهور وقاضي القضاة في دمشق والقاهرة ﺑـﺪر اﻟـﺪﻳﻦ بن جماعة (1241-1333) في مذكرته "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" للتلامذة والأساتذة، فيقول التالي:
"إنّ المدارس وأوقافها لم تُجعل لمجرَّد المقام والعشرة ولا لمجرَّد التعبّد بالصلاة والصيام كالخوانك، بل لتكون مُعينةً على تحصيل العلم والتفرّغ له والتجرُّد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب، والعاقل يَعلم أن أبرك الأيّام عليه يومٌ يزداد فيه فضيلةً وعلمًا ويُكسِب عدوّه من الجنّ والإنس كربًا وغمًّا"(37).
"ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه؛ فإنّ ذلك علامة قصور الِهمّة وعدم الفلاح وبُطء التنبّه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطاً وتعليقاً ونقلاً إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتّى كأنّ كلَّ درس منها له(38).
إن ما يميز المدرسة بوصفها مؤسسة تعليمية عن الجامع هو تفرّد المناهج وتركيزها على القليل من المجالات المعرفية، والتي توجد في مركزها الشريعة الإسلامية كنواة، حيث يستمر في هذه الأخيرة التنوع في المواد التقليدية الملقّنة واستمرارية المرونة في التدريس. وحتى وقت لاحق امتدت المناهج الدراسية ذات التوجه الديني لتشمل مواضيع أخرى مثل التاريخ الإسلامي والعلوم الرياضية والفيزيائية.
من الملاحظ أن ما يسمى العلوم الأجنبية مفقودة في المجالات المعرفية التي تلقّن في المدارس الكلاسيكية وكذلك في الجوامع. وتشمل هذه العلوم الأجنبية تخصص الفلسفة وأغلبية التخصصات العلمية التي عرفها المسلمون عبر تلقي العلوم اليونانية القديمة في القرن الثامن إلى القرن العاشر، وترسخت بقوة في الشريعة العلمية الإسلامية، وقد تم تدريس هذه العلوم الغريبة في حلقات خاصة في بيوت العلماء الخاصة أو في مؤسسات شبه عامة تحمل أسماء تميزها مثل بيت أو دار أو خزانة. ويعدّ بيت الحكمة - أي مكتبة الخلفاء العباسيين في بغداد على الخصوص- من الأمثلة البارزة لهذه الأخيرة (مع فرص البحث العلمي في علوم اللغة والعلوم الطبيعية والتبادل العلمي)، ومثلها "دار الحكمة" المقارنة، وهي أكاديمية ومكتبة الفاطميين في القاهرة (39) نلاحظ أنه هنا أيضاً في هذا السياق يتم استخدام المكتبات والمراصد والمستشفيات - كما سبق ذكره- في الأغراض التعليمية.
لم يكن مسموحاً للنساء بولوج المدارس ومع ذلك، كنّ قادرات على المشاركة في المحاضرات والحلقات الدراسية في الجوامع، وهي حقيقة تشهد عليها أسماء النساء اللواتي دوّن ملاحظاتهن في مذكرات المستمع في المخطوطات العربية في العصور الوسطى، والتي كانت بمثابة الأساس النصي لمثل هذه المحاضرات(40).
3.6 التنظيم الإداري
كان تنظيم المدرسة على النحو التالي: تقوم إحدى المؤسسات (وقف) بتأمين الأساس المالي، وتدفع رواتب المعلمين والموظفين الإداريين، وفي بعض الأحيان تصرف منحاً للطلاب. وكانت الجهة الخيرية المانحة تملك الحرية في أن تقرر بشكل عام كيفية إنفاق إسهاماتها المالية، تحديد أي مدرسة دينية (مذهب ديني) يُفضّل تدريسها في المدرسة. تم تسجيل هذه القوانين من هذا النوع في الوثيقة التأسيسية، التي في وقت لاحق كان على المانح نفسه الالتزام بها، والالتزام بإحضار الأساتذة إليها. ومع ذلك لم يكن له تأثير كبير على حرية هيئة التدريس فيما يتعلق بالمحتوى الملموس للدروس. كانت المؤسسة تسيّر إدارياً من قبل متولّ (أمين) وفي المسائل القانونية من قبل قاضٍ. أمّا المدرسة فكانت تسيّر أكاديميا من قبل أستاذ-إمام يترأس هيئة التدريس المهنية ومدرّس معيّن في وظيفة رئيس المدرسة.
وكان المعلم يسمى "مدرسّا" (محاضراً)، ولديه في الغالب مساعد أو ناسخ أو كاتب أو عدة أشخاص يقومون بكل هذه الوظائف مجتمعة. كان المتعلّم في بداية الدراسة يدعى طالباً، والطالب المتقدم يسمى مثقفاً (متعلماً جيداً) أو فقيهاً (أكثر دراية [في الشريعة الإسلامية]) وكان الطلاب أحرارًا إلى حد كبير في اختيارهم لمحتوى الدراسة ومنهاج التعلم ومدة الدراسة، علاوة على أن الدراسة في المدرسة الكلاسيكية لم تكن تعرف أي نوع من الامتحانات الرسمية.
راقب الحكام السياسيون تولي المناصب الرئيسة في المدارس الدينية، ومع ذلك فعادة لا يكون لهم أي تأثير مباشر على توظيف أو تعيين أعضاء هيئة التدريس. ومن وجهة نظر اجتماعية كانت المدرسة الكلاسيكية مؤسسة خاصة؛ لكنها كانت تستهدف الجمهور ومتاحة لجميع المسلمين(41).
لم تكن المدرسة مؤسسة حكومية بهذا المعنى حتى في الحالات التي قام فيها ممثلو الدولة بالإشراف على بنائها، ولكن ربما تكون النقاط التالية هي الأكثر أهمية: أولاً: اتسمت الدراسة في مؤسسة المدرسة بالطابع الشخصي في أعلى درجاته للتدريس في المساجد وفي الحلقات الدراسية والفضاءات الخاصة. وهذا يعني أنه حتى في المدارس استمرت العلاقة المباشرة بين الأستاذ والتلميذ، والتي هي سمة مميزة للمنشآت التعليمية للإسلام المبكر والوسيط(42). ولكن من ناحية أخرى يمكن أن يستفيد أشخاص من الذين لا ينتمون إلى نخبة علماء الدين والشريعة من المدرسة بوصفها مؤسسة للتعليم العالي في مدينة معينة أو الذين هاجروا إليها من مناطق أخرى؛ إذ جذبت المدارس الناس من طبقات اجتماعية متفاوتة، ومن أصول جغرافية وتقاليد تربوية مختلفة، وهي نتيجة جعلت هذه المؤسسات تعزز المساواة في التعليم العالي على الصعيد الاجتماعي، ومن الناحية التنظيمية جعلت منها رابطة من العلماء عابرة للحدود على نطاق أوسع، وشبكة متطورة من العلماء خاصة في الدين والشريعة، وهي شبكة تمتد على أجزاء واسعة من الإمبراطورية الإسلامية(43).
3.7 قواعد السلوك في الحصة وفي الدراسة
طُلب من الطلاب في إحدى المدارس تعميق وتثبيت التعلمات باستمرار بواسطة شروحات إضافية لمعلميهم؛ لذلك كان الاتصال الشخصي بين الطلاب والأستاذ ذا أهمية مركزية، فكان ينظر إليه على أنه ضمان لصحة التعليم أو اكتساب للمعرفة الدينية. لذلك توجّب على التلامذة في دراستهم ألا يقتصروا على الكتب وحدها مصدراً للمعلومات حتى لو كانت تلك الكتب تحظى في التعليم الإسلامي في العصور الوسطى بأولوية عالية. ومن أجل بداية موفقة لدراستهم كان على التلامذة أن يركزوا أولاً على الأفكار الرئيسة المقبولة بشكل عام في تخصص علمي معيّن، ويتجنبوا الاختلافات في الرأي بين العلماء، فتوجّب أولاً دراسة موضوع أو مجال موضوعاتي أو كتاب في موضوع معين بشكل مكثف ونهائي قبل أن يكون من الممكن الانتقال إلى مجال معرفي آخر من المعرفة أو إلى دراسة مجالات موضوعاتية مختلفة في الوقت نفسه. ويتطلب الاهتمام بمجالات موضوعاتية مختلفة استشارة المدرس وموافقته إذا كان الطالب يرغب بشكل صريح في هذه الطريقة في الدراسة.
كان الإشراف على مراقبة ما تم تعلمه من دروس الأستاذ (أو لشخص معين من قبله) بالإضافة إلى التكرار المنتظم من المكونات الشائعة في التدريس بالمدرسة. تجري هذه التكرارات للتأكد من أن الطلاب قد ختموا بشكل صحيح المواد. ومع ذلك على الرغم من أن المعلم كان يتمتع بخبرة رسمية لعملية التعلم هذه، فقد كان مطلوبًا من الطلاب في التخصصات الدينية اتخاذ موقف نقدي معيّن تجاه محتوى دراستهم والتحقّق من صحتها. على أي حال كان العرض المقدّم في المدرسة هو تنفيذ أنشطة التعلّم في الوقت المناسب وعدم تأجيلها، وقد تم الاعتراف بالأداء الدراسي بوضوح في مرحلة الشباب بوصفه على الخصوص شرطا مشجعا على التعلم وتم تنبيه الطلاب إلى ذلك كما أن التحذير من أن تأجيل أنشطة الدراسة يحمل في طياته خطر اعتياد الطلاب على تأخير أمور مهمة كان حاضرا أيضا. وقام الطلاّب بشكل نموذجي بشراء وسائل التعليم المدرسية أو الكتب (أو تمت إعارتهم إياها) التي شكلت موضوعًا لوحدة تعليمية، وقد تم ذلك بسبب عدِّ نسخ كتاب ما مضيعةً للوقت، لهذا فُرض على التلامذة استغلال الوقت للاهتمام بمحتوى منهاج التعلم.
بالإضافة إلى هيئة التدريس كانت الكتب تتمتع بسمعة عالية خاصة في مجال التدريس الإسلامي في العصور الوسطى، وقُدّمت النصيحة للطلاب بعدم ترك الكتب مفتوحة على الأرض، وبالتعامل مع كتبهم بعناية، وحفظها على المكتب أو في خزانة الكتب حتى لا تتلف، مع التركيز على ضرورة إرجاع الكتب المعارة إلى مالكها وهي في أفضل حالة ممكنة.
وكان السلوك المهذب والمحترم داخل الفصل وفي محيطه جزءًا من مدونة السلوك العامة التي تسري على الأساتذة والتلامذة في علاقتهم بعضهم ببعض كما بين التلامذة، ومع ذلك كان اجتهاد التلامذة وتواضعهم جزءًا من خصائص التعلم الديني في المدرسة الكلاسيكية(44).
3.8 التوسع الجغرافي
واقتفاء لأثر النظامية في بغداد بوصفها نموذجا لمؤسسات التعليم العالي السنية الأخرى سرعان ما تم إنشاء مدارس مماثلة في أجزاء أخرى من العراق، وفي إيران وآسيا الوسطى وفي أفغانستان الحالية، وفي البصرة، وأصفهان، ومرو، وتوس، وكذلك في بلخ وهراة.كما تم تأسيس المدارس الدينية في الأناضول وسوريا وفلسطين ومصر وشبه الجزيرة العربية من قبل السلالات المحلية ابتداء من القرن الحادي عشر والثاني عشر. جدير بالذكر هنا المؤسسات التعليمية في قونية وحلب ودمشق والقاهرة ومكة. وقد ذكر الجغرافي والرحالة الأندلسي ابن جبير(1145-1217) في مذكرات رحلته بعنوان (الرحلة) في القرن الثاني عشر ست مدارس في حلب وعشرين في دمشق على سبيل المثال.
تفاصيل أكثر من ذلك بكثير نجدها في تعليقات قاضي ومؤرخ دمشق عبد القادر النعيمي الدمشقي (1442-1521) في كتابه "دليل دراسة تاريخ المؤسسات التعليمية العليا". في هذا الكتاب المكون من مجلدين يتناول بالدراسة طبوغرافية المشهد التعليمي لمدينة دمشق في الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر، لم يقتصر المؤلف على ذكر عدد كبير من المؤسسات وأماكن التعليم الديني العالي بالاسم فحسب؛ بل قدم أيضًا معلومات مفصلة عن وضعيتها، وهندستها المعمارية، وهيئة التدريس وبرنامج التدريس. وبعض البيانات الإحصائية الأساسية - التي يمكن الحصول عليها من هذه الخلاصة- مدرجة أدناه لإلقاء الضوء على قدرتها التعليمية الخاصة بمدينة إسلامية في العصور الوسطى مثل دمشق(45).
وبعبارة أخرى من بين 629 مسجدًا تستخدم لأغراض التدريس في دمشق بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر، هناك ما مجموعه 128 مدرسة من مدارس المذاهب الرئيسة الأربعة (حيث تشكل الشافعية غالبيتها بـــ 61 مدرسة). وعلاوة على ذلك ذكر النعيمي ما مجموعه 26 مؤسسة تعليمية لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية، و155 من الأديرة والنزل والأضرحة تستخدم فضاءً للتدريس أيضا. ومن المثير للاهتمام وجود ثلاث مدارس أخرى كانت مخصصة لدراسة الطب. وهذا يعني -في النهاية- أنه كان موجوداً في دمشق في الفترة المذكورة ما مجموعه 941 مدرسة أو فضاء للتعليم العالي ذي التوجه الديني. ومع ذلك يجب الأخذ بعين الاهتمام أن هذه المؤسسات لم تكن كلها موجودة في وقت واحد أو أنها كانت في الخدمة باستمرار(46).
وإذا اتجهنا نحو الغرب -في القدس تحديداً- فإن السلطان صلاح الدين المشهور (1171-1193 -في مصر- وابتداء من 1174 في سوريا) أشهر مؤسس للمدارس إلى جانب نظام الملك، فبعد طرده للصليبيين بنيت العديد من المدارس الدينية في1187(47). وبالنسبة لمكة والحجاز في القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر، فإن المؤرخيْن تقي الدين الفاسي ونعيم الدين بن فهد (كلاهما في القرن الخامس عشر) يذكران وجود 23 مدرسة، وقد قدموا لها وصفا جزئيا. وهنا ينبغي التأكيد على أن المسجد الكبير في مكة -المسجد الحرام- الذي كان بمثابة مكان للصلاة ومكان للدراسة منذ العصور الإسلامية الأولى -هو بمثابة نموذج يحتذى به ومصدر إلهام لبناء المدارس في المنطقة بسبب امتيازاتها الدينية(48). وجدير بالذكر أن المماليك (1250-1517) في القاهرة -وهم سلالة حاكمة من أصل تركي وقوقازي استعبدهم الجيش في البداية- قاموا بإنشاء مؤسسات تعليمية مهمة سعت من خلالها إلى الموازنة بين بنية السلطة المحلية في مجالات التعليم والدين من خلال تعيين أساتذة أجانب(49).
أما بالنسبة لسوريا فقد كان هناك تراجع كبير في التعليم المؤسساتي خصوصاً في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. ويفسر هذا الأمر من جهة إلى التنافس الداخلي على الحكم في سلالة المماليك في مصر وسوريا. ولكن الأكثر مأساوية من هذا التراجع كان غزو المغول في سوريا في 1260 و 1299، وفي 1400، والذي تم خلاله نهب العديد من المساجد والمدارس وتدميرها. وعلاوة على ذلك، فإن تخريب الأسواق والأراضي الفلاحية قد حرم البلد من أساسه الاقتصادي، الأمر الذي كان له أثر سلبي خطير على تمويل التعليم الرسمي المرتبط بالمؤسسات.
أمّا في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية فقد استمر التعليم الديني بالدرجة الأولى في المساجد والمدارس القرآنية وفي البيوت الخاصة بالأساتذة، ومع تسلم سلالة الموحدين للسلطة (1147-1269) وضعت المدرسة قدمها في المغرب الإسلامي وفي إسبانيا الإسلامية كمؤسسة تعليمية، فتم في القرن الثاني عشر بناء المدرسة الدينية بجوار الجامع الكبير في سلا في المغرب، وفي القرن الرابع عشر تم بناء مدرسة كبيرة في فاس المغربية على الجانب الشمالي من مسجد القرويين. وهذه المدرسة في فاس هي واحدة من أجمل المباني من نوعها في المغرب العربي وتعرف اليوم بمدرسة العطارين ("المعهد في [حي] تجار العطور") أو كما هي التهجئة الفرنسية.
أما الشيعة فقد اعترفوا أيضاً بالنموذج السني للتعليم من خلال النجاح الذي عرفته الجامعات الدينية خاصة في القرنين السادس عشر والثامن عشر، فتم تشييد العديد من المدارس الإسلامية للشيعة في إيران، بهدف مواجهة التأثير السني المتزايد في هذه المنطقة بواسطة التعليم العالي ذي التوجه الشيعي(50) في الوقت نفسه راهن الشيعة على معاهدهم اللاهوتية، التي ربما تكون قد تأسست في القرنين التاسع والعاشر، وارتبطت أساساً باسم العالم الشيعي الشهير الشيخ العاصي (995-1067)، وتوجد اليوم في المقام الأول في النجف العراقية وفي قم الإيرانية تحت اسم الحوزة، وتعني "مكان الحماية [للمعرفة الدينية]"(51).
وانتشرت المدارس ابتداء من القرن الثالث عشر في جنوب آسيا، فتأسست أشهر الجامعات الإسلامية في التقليد الكلاسيكي بالهند في عام 1866 وهي دار العلوم " الديوبنديَّةDeoband " في ولاية أتر برديش.
4- ملاحظة ختامية
يجب ذكر النقاط التالية في نهاية هذا العرض: أولا: أسهم إنشاء شبكة واسعة من المدارس العليا (الجامعات) بين القرن الحادي عشر والرابع عشر -أي في فترة ازدهار هذه المؤسسة للتعليم العالي- في إضفاء الطابع المهني المرئي والطابع المؤسسي على التعليم الإسلامي ذي التوجه الديني. ويتعلق الأمر أولاً بالمناطق الشرقية من العالم الإسلامي في العصور الوسطى، ولكن فيما بعد أيضًا المغرب الإسلامي والأندلس. ثانيا: مكنت هذه المدارس من توفير التعليم العالي والتعليم العام ليس فقط للنخب المتعلمة ولكن أيضا للطبقات المحرومة اجتماعيا. وقد أصبح هذا ممكناً بفضل الولوج المفتوح نسبياً إلى المدرسة، فضلاً عن توفير منح دراسية للطلاب الأكثر فقراً. وأدت وظيفة الجامعات هذه في النهاية إلى تحقيق مستوى معيّن من التعليم العام في الإسلام في القرون الوسطى، كما حقق أيضًا مهمة اجتماعية إضافية من خلال توفير السكن للفقراء والمسافرين لفترة من الوقت، حتى لو لم يكن هؤلاء المستفيدون تلامذة. ثالثًا: عززت المدارس البنية الاقتصادية للمدينة أو للمنطقة التي تقع فيها هذه المؤسسات.
كان لتدفق الغرباء المستمر تأثير محفز وكبير على الوضع الاقتصادي للمناطق المعينة الذين توجب عليهم إلى دفع تكلفة المعيشة، واحتاجوا إلى السكن، واشتروا الكتب، واستخدموا المكتبات، لكل ذلك تأثير محفز وكبير على الوضع الاقتصادي للمناطق المعنية. أضف إلى ذلك حقيقة أن المدارس جذبت أيضًا أساتذة بارزين، وهي وضعية كسبت بدورها ديناميتها وجاذبيتها على ضوء الاقتصاد والثقافة وسمعة المنطقة. وأخيرا وليس آخرا، غالباً ما كان يتم دفن المانحين المتبرعين المتوفين بالقرب من مدرسة ما، مما سمح بتطوير مقابرهم إلى أضرحة لزيارتها، مما طوّر الحوافز الاقتصادية والثقافية المناسبة للوضع(52).
لكن ظهور المدرسة وانتشارها لم يكن له آثار إيجابية فقط على المؤسسات العلمية والتعليم في الإسلام وحسب؛ فقد كان للمنهج الدراسي الموجه دينياً بصرامة والمقيّد للمدرسة -فوق كل ذلك- تأثير سلبي متزايد على التوازن الموضوعاتي وتنوع التعليم الإسلامي في مجرى التاريخ الفكري والثقافي. أدى هذا الظرف جزئياً إلى تقوية المحافظة الفكرية عند بعض العلماء، والرفض العام للمجالات العلمانية في التعلم من طرف بعض الأساتذة(53).
إن هذه القيود المناهضة للمؤسسات، وزيادة التحفظ الثقافي عند بعض العلماء، لم يؤد إلى انخفاض تطوير التعليم الإسلامي في العصور الوسطى نفسها فحسب، وإنما إلى تعطيل للتطورات الاقتصادية والثقافية في المجتمعات الإسلامية في العالم الإسلامي قبل العصر الحديث (54) وفي الواقع، امتد تأثير هذه الظاهرة التاريخية في التعليم الإسلامي إلى العصر الحديث، رغم أن غالبية الدول العربية والإسلامية اليوم تعتمد على تعليم ذي مناهج علمانية مرتبطة بالمعايير الدولية في الجامعات والمعاهد.(55)
لكن حتى هذا الجانب النقدي في التطور المتعدد الأوجه للمؤسسات التعليمية الإسلامية في العصور الوسطى - مع المدرسة كمؤسسة تعليم ديني عال بامتياز- لا يقلل من الأهمية المركزية لهذه المؤسسات بالنسبة للتاريخ الفكري والثقافي للإسلام ككل حتى يومنا هذا. وقد تحدث في هذا الصدد عالم الدين والصوفي الكبير الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين"، في الفصل المميز عن"فضل التعليم"، الذي به ننهي دراستها التي تناولنا فيها مشكلة التعليم والدين في الإسلام الكلاسيكي؛ يكتب الغزالي(56)
"إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الجنّة، فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا. فيقول الله عزّ وجلّ: أنتم عندي كبعض ملائكتي؛ اشفعوا تُشَفَّعوا، فيشفعون. ثمّ يدخلون الجنّة، وهذا إنّما يكون بالعلم المتعدّي بالتعليم لا العلم اللازم الذي لا يتعدّى".
هوامش:
- ترد الأسماء والمصطلحات العربية الكثيرة والمعروفة في متن المقالة بخط ألماني مبسط. وترد المصطلحات التقنية والمعلومات البيبليوغرافية في الملاحظات وفي لائحة البيبليوغرافيا وفق قواعد الكتابة الصواتية للجمعية الألمانية للاستشراق. بالنسبة للنصوص القرآنية تم الاعتماد على ترجمة رودي بارت (2010) مع تصرف هيِّن. الترجمات الأخرى من العربية والفارسية هي للكاتب. الاقتباس في العنوان تم تثبيته في آخر المقال. تتبع كل التواريخ التقويم الميلادي. (ملاحظة المترجم: في النص الأصلي وضع الكاتب النص العربي وترجمته للألمانية، واكتفى المترجم بوضع النص العربي بين قوسين ((...)) ).
- "تاريخ بخارى" كتبه بالعربية المؤرخ أبو بكر بن جعفر النرجسي (959-899) من قرية قرب بخارى. أهدى الكتاب في سنة 943 أو 944 للحاكم الساماني نوح بن ناصر (حكم بين 943-954). تُرجمت نسخة ملخصة (مصغرة) من هذا المصدر المهم عن التاريخ المبكر للإسلام في آسيا الوسطى إلى الفارسية في القرن 12. ثم فيما بعد تم إتمامها واختصارها من جديد بشكل مختلف. ولأن النسخة العربية الأصلية لهذا الكتاب قد ضاعت، نقلت هذا الاقتباس من النسخة الفارسية القديمة –وقد اطلعت على الترجمة الإنجليزية وإعادة نقلها إلى العربية الحديثة عن الفارسية لهذا الغرض-. انظر النرسي، 1970، 113. وله 1954 (إنجليز.)، 96. و1965 (عر.) 127-129. وبخصوص الأماكن والمنشآت الواردة في هذا الاقتباس انظر بارتولد Barthold، 1928، 103، هالم Halm (1977)، 438، الذي أثار الانتباه مشكورا إلى معلومة مهمة ومصدر في سياق تاريخ التعليم الإسلامي. (ملاحظة المترجم: هذا الاقتباس منقول من ترجمة أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر عن الفارسية لكتاب "تاريخ بخارى"، دار المعارف، القاهرة، 1965، ص. 133-134.).
- Gutas 1998و Biesterfeldt 2003انظر على الخصوص:
- Günther 2016, 222–225; ders. 2017a, 29f.
- Makdisi 1981, 17; Schoeler 1985, 204.
- Makdisi 1981, 81.
- Günther 2005, 92–119; ders. 2017a, 74–76.[1]
- Günther 2017b, 34f. [1]
- لقد حظيت السماعات(شواهد الحضور) في الآونة الأخيرة بالاعتراف والتقدير بشكل متزايد من قبل الدراسات الإسلامية بوصفها وثائق تاريخية عن تاريخ العلم والثقافة الإسلامية، انظر: Leder, 1999, 147-150.
- انظر أيضا: Schoeler 1990, 42.
- Ephrat 2000, 114f
- عن وظيفة المبلّغ أنظر: Weisweiler 1951, 36–38
- نفسه، 28، 30f: يقول ابن السني عن وظيفة المستمل: "حين يكبر الرجال في العمر لا يضر أن يلتمسوا لهم المساعدة من مستمل يسهل عليهم فهم الدرس بأن ينقل(مادة الدرس) من أقرب مستمع يجلس عند المدرس إلى أبعدهم. ولأن المستمعين لا يجب ألا يسألوا العالم (أن يتحدث بصوت مرتفع) حتى يستطيعوا سماع كل شيء منه. هذا الاقتباس هو علامة على تحول مثالية التعلم الطويل في الإسلام الكلاسيكي. ويجب على المستملي أن يدعو الناس (إلى الهدوء) عند الاستماع قبل أن يبدأ العالم درسه"، انظر ابن السني، رياض المتعلمين، 38 B،Folie.
- فايسفايلر 1951، 36، يعطي أمثلة كثيرة من مصادر موثقة على أن الجامعات الشعبية كانت موجودة في الإسلام في العصر الوسيط. في حالة جامعة أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله القاضي (815-904) عالم الحديث من البصرة، على سبيل المثال، لم تكفه قاعة في ساحة شاهان في بغداد من أجل تقديم محاضرة الإملاء، وتوجب على الطلبة الوقوف ليكتبوا معه. Günther 2016, 2014f
- Günther 2016, 2014f
- ابن خلدون 2000، 5، 20. عن حقيقة أن النساء هن أيضا يتبرعن متطوعات للمدارس انظر Jacobi 2009, 153–166.
- Brandenburg 1978, 56
- خلافاً للرأي المعبّر عنه في الكتابات الجديدة بكون الأزهر بوصفه جامعا أسسته السلالة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية (909-1171 في شمال إفريقيا ومصر) قد لعب دوراً مهماً في البروباغاندا الإسماعيلية، يشير هالم Halm، 1995، f99، إلى أن الحديث هو فقط للفقهاء في المصادر العربية بخصوص بإنشاء المؤسسة التعليمية بجانب الأزهر. وحتى "مجالس الحكمة" الفئوية الإسماعيلية لم تعقد هنا، ولكن في قاعة القصر، كما يشير هالم في مقاله المذكور في هذه الدراسة، وكما يشرح هاينز هالم Heinz Halm في إسهامه في هذا الكتاب.
- المقدسي 1981، 29 المقدسي يحقق هذه الوظيفة الرائدة في تاريخ التعليم الإسلامي، رغم أن بعض آرائه تقلل منها أو تغيرها نتائج أبحاث جديدة –عند بركاي Berkey 1992، شمبرلين 2002، إفارت Ephart. 2000
- Makdisi 1981, 28f.
- Lane 1893, 870f.
- Günther 2017b, 36بعض الأمثلة موجودة في:
- Bulliet 2006, II, 562f.
- مثلاً يرى الشافعي في النقاشات في القرن 8 و9 شكلا فعالا وخاصا للتبادل الأكاديمي. وهو يستعمل هذا الشكل باستمرار مع طلبته في الدرس. وقد قام المعجمي المشهور الخليل بن أحمد (718-791) بتمثيل هذه المنهجية في القرن الثامن. انظر: Günther 2017b, 35.
- الرأي نفسه نجده عند سوزان تلباردون بالنسبة لليهودية في العصور القديمة المتأخرة. أنظر مقال Talabardo في هذا الكتاب. عن النماذج من خارج الإسلام التي يمكن أن تلعب دورا في تأسيس المدارس، فهي غير واضحة بعد. الفكرة أن مباني الأديرة البوذية -كما يقول ماكس فان بيرشم 1903 وفيلهيلم بارتولد (1927، أنظر لايزر 1986، 16-17)- في وجهة نظر معمارية تعمل كنماذج للمدرسة، هي بحسب علمي غير معروفة في الدراسات الإسلامية بعد. بإلقاء نظرة على تاريخ تشييد المدارس في الأماكن البعيدة شرق الإمبراطورية الإسلامية فإن لهذه الفكرة على كل حال قيمة وهي جديرة بالاتباع. إن القبول بأن شبيه الكلمة العربية مدرسة له علاقة بالمصطلح السرياني "مدراسmadrāšê " (نشيد شعري تعليمي) هو أمر مرفوض. بالنسبة للمدرسة تستعمل المسيحية السريانية كلمة سكوالا (scolar التي تعود إلى الكلمة اليونانيةσχολή). هذا البيان يظهر أن العلاقة المفاهيمية بين المدرسة الإسلامية والمسيحية الشرقية هي أقل احتمالا. بخصوص الإشارة إلى المفهوم السرياني أشكر زميلي في جوتنغن السيد الدكتور Dr. Dmitrij Bumazhnov..
- Makdisi 1981, 21.23f; Ahmed 1968, 106.
- Tibawi 1972, 212–227.
- Schmid 1980, 1f.
- ابن بطوطة 1994، 2، 109، و1962، 2، 332. وعن عمارة المستنصرية يقدم كتاب شميدSchmid 1980 معلومات قيمة.
- Schmid 1980, 56
- تذكر المصادر العربية أن "الخميس، 5 ربيع 631" هو تاريخ افتتاح المستنصرية، انظر معلومات المؤرخ ابن الفَواطي (توفي سنة 1323)، 2003، 58f، وأيضا ابن كثير ( توفي في 1373)، 1998، ج. 17، f212. تحويل التواريخ من التقويم الإسلامي إلى التقويم الميلادي قام به فستنفلد Wüstenfeld 1961.
- Awad 1945, 13f.
- قارن مثلا المقدسي 1981،و1991، نظرة علمية في مكون الدرس الإسلامي في الهند في القرن 17 قدمها سبرينغر في مقاله المنشور سنة 1878: "المواد الدراسية والفلسفة المدرسية للمسلمين". وقد لاحظ في نتائج تقييمه لدليل مخطوطات المكتب الهندي بأن الفارسية كانت لغة المحكمة ولغة المسلمين والمتعلمين، وبأن القيمة الكبيرة هي في التعليم الدنيوي وبأنه "لا القرآن ولا التفسير ولا السنة... تنتمي إلى الدراسات في المدرسة" (سبرينغر، 1878، 1-2.10). من الواضح ذكر سبرنغر لكتب مدرسية تستعمل في المؤسسة التعليمية المذكورة: "الكتب الدراسية"- حيث يلقي أسئلة مهمة عن البحث المعاصر في الكتاب المدرسي، ما يجعله صالحا أن يكون كتابا تعليميا في هذا السياق، وإذا ما كان هذا المصطلح أو التصور المرتبط به يملك نظيرا في المؤسسة التعليمية الإسلامية.
- بالنسبة للعلوم الإسلامية المحلية وضعت المصطلحات "العلوم الشرعية" (العلوم المستندة إلى الشريعة الإلهية) والعلوم التقليدية (العلوم الشفهية). من الناحية المعرفية نميز بين علوم الأوائل (وهي على الخصوص العلوم اليونانية القديمة) أو العلوم العقلية وتضم الفلسفة وعلم الفلك والطب والرياضيات.
- وعن أقدم الاعترافات الإيمانية في المسيحية، Makdisi 1981, 75–78.80–84 انظر أيضا: Feldmeier/Spieckermann 2017, 49–202 (Kapitel 5: „Der Allmächtige“).
- Endress 2016, 379–383.
- ابن جماعة، 2009، 195.
- ابن جماعة، 2009، 132. وعن سيرته انظر ملخصا لـمحتوى "تذكرة" عند روزنتهال 1970، 296-298.
- Gutas/Bladel, Bayt al-hikma (online); Janos 2014, 439–441.
- ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام على ذلك ملاحظة المستمع على المخطوطة الفريدة لبدايات تاريخ العقيدة الإسلامية "شرح السنة". ربما هذا هو أقدم عمل لتحديد معنى السنة، أي ما هو المعيار المنقول والسائد عند أغلبية المسلمين؟ قام عبد الله أحمد بن محمد البهلي المعروف بغلام خليل بكتابته. في نهاية هذا المخطوط نجد الملاحظة من كل الكتاب الذي يضمه المخطوط وتتم قراءتها على عموم الناس في مسجد مخصص في سنة 1112 (في بغداد على الأرجح). حدث هذا في حضور الإمام أبي الحسن عبد الحق (توفي سنة 1179) ، أصغر وآخر مبلّغ مجاز مذكور في هذه المخطوطة المذكورة. يملي مساعدو الإمام النص على العموم. وقد حضر دائرة الدراسة أربعة عشر شخصًا، من بينهم امرأة تدعى هزار بنت الهراوي. وهذه الأخيرة هي واحدة من بين أدلة أخرى عديدة تشير إلى أن المرأة كانت في بعض الأحيان قادرة على المشاركة في الدروس ضمن دوائر التدريس المحافظة. انظر Jarrar / Günther 2003,3.، أنظر أدناه أيضا ليدر Leder 1999, 150f
- يقول المقدسي عن هذا الموضوع: "كانت المدرسة ...فى أساس الأمر مؤسسة وقفية أهلية فى خدمة العامة؛ لكنها (كانت هكذا) طبقا لأهواء مؤسسها بصفته الفردية، الذي استحدث المدرسة وحدد أغراضها العامة." انظر: Makdisi 1981, 300 (Kursiv wie im Original) und 229f.281.
- [1]يقدم شامبرلاين نظرة مفيدة عن الاختلافات في الدراسات الإسلامية عن تطور ووظيفة المدرسة (2002، 70-90) في (فصل: "المدرسة إنتاج المعرفة وإعادة إنتاج النخبة"
- Ephrat 2000, 114f
- انظر جماعة 2009، الفصل 4 (قواعد السلوك في التعامل مع الكتب) والفصل 5 (قواعد السلوك لطلبة المدرسة) 151–172.173–208; ders. 2006, 87–98.99–109.
- استعملنا نسخة النعيمي لسنة 1988
- الاسم الكامل: أبو المفاخر محي الدين عبد القادر بن محمد بن عمر النعيمي الشافعي. لمزيد من المعلومات عن حياة ومؤلفات هذا الكاتب الذي لم يستوف حقه من البحث حتى الآن، انظر: Brockelmann 1996, II, 165 S II, 164 (orig. II, 133)وǦunndail 2013, 2-6، العمل المذكور له عنوان طويل: "تنبيه الطالب وإرشاد الدارس فيما في دمشق من الجوامع والمدارس" انظر أيضا Sauvaire 1894-1896.
- Brandenburg 1978, 23-54; Hillenbrand 1986, 136-54; Mahamid 2013, 602, 610f.
- Mortel 1997, 236f., 250-52.
- Fernandes 1987, 98. وMauder 2012, 10, 52, 131f. و 166f.
- عن عمارة وتاريخ الجوامع ومباني المدارس في عهد القاجاريين المبكر في إيران (1785-1848) انظر الكتاب المهم لـ ريتر Ritter 2006.
- يدرس مقال هيرن عام 2017 مسألة الأسس التاريخية للرأي الشيعي بأن الحوزة في النجف قد تجاوز عمرها ألف عام، وتصنف ضمن تطور المعاهد الدينية اللاهوتية الشيعية في السياق العام لتطور المؤسسات التعليمية الإسلامية، بما في ذلك المدارس الدينية. اختتم Moazzen 2017 فجوة بحثية بدراسته المهمة هذه عن تاريخ التعليم الشيعي العالي في عهد الصفويين (1501-1722).
- يؤكد باليتش (2005، 80) باهتمام بالغ أن إدماج أضرحة المؤسسين في المدرسة مثال للمؤسسات اللاتينية.
- Makdisi 1981, 153; Makdisi 1961, 14f; Fück 1999, 161–184; Berkey 1992, 44–94; Chamberlain 2002, 72–90. 106–7
- Sammelband von Sukurai 2011للمزيد عن المدرسة في العصر الحالي انظر المجموعة الكاملة لـ سوكوراي